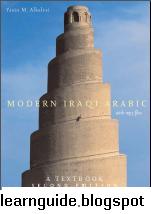الأدب العربي في العصر الأندلسي
[الأندلس والمغرب وشمالي إفريقية وصقلية]
الأندلس
والمغرب جزءان مترابطان من عالم واحد كان يعرف في القديم عند المشارقة
بالمغرب الإسلامي، وقد ظلا يتمثلان طوال العصور الوسطى حضارة واحدة مشتبكة
العلاقات في السياسة والفكر والاجتماع. وفي العلاقات البشرية المستمرة من
هجرة واختلاط وتزاوج.
وقد كونت صقلية مع بلاد المغرب وشمالي
إفريقية والأندلس وحدة ثقافية ذات طابع خاص جوهره التراث الثقافي العربي
الإسلامي، وساعد في حفظه كثرة الانتقال والاتصال.
وقد أدت
الأندلس وصقلية دوراً بارزاً في النهضة الأوربية عن طريق نقل هذا التراث
كما يشهد بذلك الباحثون، مما يجعل الحديث عن فضل الحضارة العربية الإسلامية
من الوقائع التاريخية الثابتة.
الأندلس
الحياة
السياسية والاجتماعية في الأندلس
أطلق العرب لفظ الأندلس AL-
Andalus على القسم الذي سيطروا عليه من شبه جزيرة إيبرية (إسبانية
والبرتغال) واستقروا فيه زهاء ثمانية قرون (منذ فتحها عام 92هـ/ 711م
بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير، وآخرين، حتى سقوط غرناطة عام
897هـ/1492م) فجاؤوا بلغة حية تأثرت بها اللغتان الإسبانية والبرتغالية،
وبمد حضاري حمل عبارة تتصدر معاهد العلم وهي: «العالم يقوم على أربعة
أركان: معرفة الحكيم، وعدالة العظيم، وصلاة التقي، وبسالة الشجاع».
حكم الأندلس مدة ستة وأربعين سنة (92-138هـ/711-755م) ولاة كان يعينهم
الخليفة في دمشق، أو عامله على إفريقية، ولما قوض العباسيون صرح الدولة
الأموية، فر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن مروان من الشام في مغامرة
طويلة حتى وصل إلى الأندلس سنة 137هـ/755م، واستطاع بحذقه السياسي أن يؤسس
إمارة حاضرتها قرطبة Cordoba استمرت من عام 138 حتى عام 300هـ/756-912م،
ولقب «بالداخل» و«بصقر قريش».
وفي عهد عبد الرحمن الثالث الذي
لقب «الناصر» وحكم من سنة 300 حتى 350هـ/ 912-961م، تحولت الإمارة إلى
خلافة، وفي هذا الدور بلغت الأندلس أوج مجدها السياسي والأدبي ونافست قرطبة
بغداد.
ثم انتثر عقد البلاد، فاستبدّ رؤساء الطوائف بالولايات،
وقامت دويلات بلغت العشرين عدّاً عرف حكامها بملوك الطوائف
(403-536هـ/1012-1141م) منها الدولة العبادية في إشبيلية، ودولة بني الأفطس
في بطليوس، والدولة الجهورية في قرطبة.
ومع انشغال الحكام
بشؤونهم عن تدبير الملك، وازدياد ضغط الإسبان الشماليين على هذه الولايات،
فزع الأندلسيون إلى يوسف بن تاشفين (500هـ/1106م) أمير الملثمين
(المرابطين) في المغرب، فأنجدهم سنة 479هـ بعد انتصاره في معركة الزلاقة،
ثم استقل بحكم الأندلس التي تحولت إلى ولاية تابعة للمغرب في زمن المرابطين
والموحدين.
وبعد هزيمة الموحدين سنة 609هـ/1212م في موقعة
العقاب Las Navas de Tolosa التي جرت مع الإسبان، استطاع الإفرنجة أن
يستولوا على الحصون والمدائن ومنها قرطبة التي سقطت سنة 623هـ/1235م، بعد
أن لبثت خمسمئة وعشرين سنة عاصمة الملك. وحصرت الدولة في مملكة غرناطة التي
حكمها بنو نصر (بنو الأحمر)، وشيدوا فيها قصور الحمراء Al- Hambra،
وحافظوا على السلطان العربي في الأندلس زهاء قرنين ونصف القرن
(635-897هـ/1218-1492م). ثم اتحدت مملكتا قشتالة Castilla، وأرغون Aragon
في مواجهة بني نصر، وسقطت غرناطة، وسلم أبو عبد الله الصغير مفاتيح الحمراء
إلى المنتصرين.
كان قوام المجتمع الأندلسي في بداية الأمر من
الفاتحين العرب والبربر، وقد وحدت بينهم راية الحرب، والدعوة إلى الجهاد.
ودخل قسم كبير من أهل البلاد في الإسلام، وتمتع باقي السكان من النصارى
واليهود بحياة مطمئنة، ومارسوا شعائرهم الدينية بكل حرية.
وكان
للأندلسيين عناية خاصة باللغة وعلومها وآدابها، إضافة إلى الفقه وعلوم
الشريعة، وقد استقدم الخلفاء العلماء من المشرق لينقلوا معهم كنوزهم
الأدبية فيتأدب بها الكثيرون. وكان للفقهاء في الأندلس سلطان عظيم لدى
الدولة، ولدى عامة الناس.
واحتلت المرأة في الأندلس منزلة
عظيمة، ونالت حظاً وافراً من التعليم، ونبغت في العلوم والآداب والفنون
كثيرات: قيل إن مئة وسبعين امرأة بضاحية قرطبة الشرقية كن يعملن يومياً في
نقل نسخ من القرآن الكريم بالخط الكوفي، وإن «إشراق العروضية» (القرن
الخامس الهجري) كانت تحفظ «الكامل» للمبرد، و«النوادر» للقالي، وكان يعهد
إلى النساء بتربية أبناء الأمراء والأغنياء وتأديبهم، فابن حزم تلقى ثقافته
الأولى على يد نساء قصر أبيه، وهن علمنه القرآن، وروينه الأحاديث الشريفة،
ودربنه على الخط.
وكانت الشواعر ملمحاً بارزاً من ملامح الشعر
الأندلسي لوفرتهن ونبوغهن، وقد ارتبط سحر شعر النساء باسم ولادة (ت484هـ)
بنت الخليفة المستكفي (ت 416هـ) فقد غشي منتداها فرسان النظم والنثر، ومنهم
ابن زيدون (ت463هـ) الذي نعم بوصلها، وشقي بهجرها، فقال فيها أجمل الغزل
وأرقه.
الأدب العربي في الأندلس
الشعر
فنون الشعر الأندلسي: نظم الأندلسيون الشعر في الأغراض التقليدية كالغزل
والمجون والزهد والتصوف والمدح والهجاء والرثاء، وقد طوروا موضوع الرثاء
فأوجدوا «رثاء المدن والممالك الزائلة» وتأثروا بأحداث العصر السياسية
فنظموا «شعر الاستغاثة»، وتوسعوا في وصف البيئة الأندلسية، واستحدثوا فن
الموشحات والأزجال.
وكان الغزل من أبرز الفنون التقليدية، يستهل
به الشعراء قصائدهم، أو يأتون به مستقلاً،وبحكم الجوار أولاً، ولكثرة
السبايا ثانياً، شاع التغزل بالنصرانيات، وكثر ذكر الصلبان والرهبان
والنساك. كذلك شاع التشبيب بالشعر الأشقر بدلاً من الشعر الفاحم، وكما أن
الشعراء جعلوا المرأة صورة من محاسن الطبيعة. قال المقَّري: «إنهم إذا
تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً، ومن النرجس عيوناً، ومن الآس أصداغاً، ومن
السفرجل نهوداً، ومن قصب السكر قدوداً، ومن قلوب اللوز وسرر التفاح مباسم،
ومن ابنة العنب رضاباً».
ولم يظهر المجون الذي يخلط فيه الجد
بالهزل في عهد الدولة الأموية في الأندلس لانشغال الناس بالفتوح، من جهة،
ولأن الوازع الديني كان قوياً في النفوس، من جهة ثانية. لكن، منذ عصر ملوك
الطوائف حتى نهاية حكم العرب في الأندلس، اتخذ بعضهم المجون مادة شعرهم،
وأفرطوا فيه إلى حد الاستهتار بالفرائض، مع أنه ظهر في القرن الخامس الهجري
في ظل دول الطوائف عدد غير قليل من الشعراء الذين نظموا في الزهد، كأبي
إسحق الإلبيري (ت460هـ)، وعلي بن إسماعيل القرشي الملقب بالطليطل، والذي
كان أهل زمانه (المئة السادسة) يشبهونه بأبي العتاهية.
ولئن كان
الزهد دعوة إلى الانصراف عن ترف الحياة، فإن التصوف شظف وخشونة وانعزال عن
الخلق في الخلوة إلى العبادة. ويتخذ الشعر الصوفي الرمز أداة للتعبير عن
مضمونه وحقائقه. ومن متصوفة الأندلس ابن عربي (ت638هـ) وقد لقب «بمحيي
الدين» و«بالشيخ الأكبر» وابن سبعين (ت669هـ) وكان يلقب «بقطب الدين».
وفي المدح حافظ الشعراء على الأسلوب القديم، فاعتنوا بالاستهلال وحسن
التخلص، وربما بدؤوا قصائدهم بوصف الخمر أو الطبيعة، أو بلوم الزوجة زوجها
لسفره للقاء الممدوح كما في شعر ابن درَّاج القسطلي (ت421هـ)، وهم لم
يغرقوا في استعمال الغريب ما عدا ابن هانئ (ت362هـ) الذي حاول تقليد
المتنبي.
ولم يختلف رثاء الأندلسيين عن رثاء المشارقة، فكانوا
يتفجعون على الميت، ويعظمون المصيبة، وكثيراً ما كانوا يبدؤون بالحكمة صنيع
ابن عبد ربه (ت328م).
فنون الشعر الأندلسي المتطورة
الشعر التعليمي: ويراد به الأراجيز والمنظومات التاريخية والعلمية، وهو لا
يلتقي مع الشعر الفني الذي يغلب عليه عنصرا الخيال والعاطفة إلا في صفة
النظم، ويستقل في الرجز كل شطر بقافية. من الأراجيز التاريخية أرجوزة يحيى
ابن حكم الغزال (ت250هـ) شاعر عبد الرحمن الثاني (الأوسط) وهي في فتح
الأندلس، وأرجوزة تمام بن عامر بن علقمة (ت283هـ) في فتح الأندلس وتسمية
ولاتها والخلفاء فيها ووصف حروبها، وأرجوزة ابن عبد ربه في مغازي عبد
الرحمن الثالث، وأرجوزة أبي طالب عبد الجبّار (القرن الخامس الهجري) وكان
مواطنوه يلقبونه بالمتنبي وقد قصر شعره على الوصف والحرب والتاريخ، وأرجوزة
لسان الدين بن الخطيب (ت776هـ) «رقم الحلل في نظم الدول» وهو تاريخ شعري
للدولة الإسلامية في المشرق والأندلس. ويلي كل قصيدة شرحها.
ومن
الأراجيز العلمية أرجوزة ابن عبد ربه في (العروض) وأرجوزة الشاطبي، القاسم
بن فيّرة (ت590هـ) في القراءات وعنوانها «حرز الأماني». وألفية ابن مالك
(ت بدمشق سنة 672هـ) في النحو، وأرجوزة لسان الدين بن الخطيب المسماة
«المعتمدة» في الأغذية المفردة، وأرجوزة أبي بكر محمد بن عاصم (829 هـ) في
القضاء وعنوانها «تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام»، وتذكر في نطاق
الشعر التعليمي منظومة حازم القرطاجني (ت684هـ) وهي منظومة ميمية في النحو
عدد أبياتها سبعة عشر ومئتان، وبديعية ابن جابر الضرير (ت780هـ) التي نظمها
في مدح الرسول الأعظم e، وضمنها نحو ستين فناً بديعياً، وسماها «الحلة
السيرا في مدح خير الورى».
وصف الطبيعة: ألهبت طبيعة الأندلس
الجميلة قرائح الشعراء، فرسموا لوحات شعرية متنوعة أودعوها أخيلتهم
وعواطفهم.
رأى عبد الرحمن الداخل نخلة بالرصافة (شمالي قرطبة)،
فلم يصفها في طولها ولا في التفافها ولا في ثمرها، وإنما عقد بينه وبينها
شبهاً في النوى والبعد عن الأهل. ووصف ابن عبد ربه الطبيعة بمعناها العام
المتمثل في الرياض وأزهارها فخلع على صياغته من نفسه ومهارته ما جعلها
مصورة البيئة الأندلسية أدق تصوير وأحلاه. وقد ردد ابن حمديس (ت527هـ)
أصوات القدماء في الطبيعة كما ردد أصوات المحدثين، ووصف الخيل والإبل
والغيث والبرق، وأقحم عبارات امرئ القيس، ثم حاكى أبا نواس في الدعوة إلى
نبذ الوقوف على الأطلال، ودعا إلى الشراب، وكثيراً ما وصف ترحاله وتغربه عن
صقلية التي أبعد عنها وهو حدث (471هـ) لما غزاها النورمان.
تغنى الشعراء الأندلسيون بجمال الطبيعة الأندلسية، فابن سفر المريني يتعلق
بالأندلس فيراها روضة الدنيا وما سواها صحراء، وابن خفاجة الذي لقب
«بالجنّان» و«بصنوبري الأندلس» يشبهها بالجنة فهو يقول:
يــا أهــل
أندلـــس لله دركـــم
مــاء وظل وأنهار وأشــــجار
مـا
جنة الخلد إلا في دياركـم
ولـــو تخيرت هذي كنت
أختار
ووصف شعراء الأندلس أقاليم الأندلس وربوعها وصفاً دقيقاً،
فحمدة بنت زياد (من شواعر القرن الخامس الهجري) تصف وادي آش Guadix القريب
من غرناطة فترسم أكثر من صورة متحركة.
وبدافع من التطور
الحضاري أدخل الأندلسيون إلى قصورهم المنيعة الماء ليملأ البرك في باحتها،
ولينتشر من أفواه التماثيل كما في وصف ابن حمديس بركة في قصر المتوكل بن
أعلى الناس بإفريقية.
أما وصف مجالس الأنس فقد بدأ ظاهرة
اجتماعية في أخريات الدولة الأموية في الأندلس،ثم أخذت المجالس بالانتشار
والشيوع ويغلب على هذا الشعر الارتجال، وفيه وصف للساقي والخمر.
كذلك رأى الشعراء الأندلسيون في المرأة صورة من محاسن الطبيعة، وقد ألح
ابن زيدون في ديوانه على ثنائية ولادة والطبيعة.
وفي بعض
أشعارهم ميل إلى النزعة القصصية، ومن ذلك قول جعفر بن عثمان المصحفي
(ت372هـ) في سفرجلة تتبع وصفها مذ كانت تختال على شجرتها إلى أن ذبلت في كف
الشاعر.
ويغلب على الوصف في الشعر الأندلسي التشبيهات
والاستعارات ويمثل لها بشعر ابن سهل (ت649هـ)، فقد صور الشاعر الطبيعة
فأحسن المزج بين الألوان، وجمع بين الحس المرهف، والملاحظة الدقيقة.
رثاء الممالك الزائلة: وهو تجربة إنسانية قل نظيرها في الأدب العربي لما
اتصف به من حدة وحماسة، وجرأة في نقد المجتمع، ودعوة لاسترجاع ما ذهب.
لقد رثى المشارقة المدن التي استبيح حماها، كما صنع ابن الرومي حين رثى
مدينة البصرة عندما أغار عليها الزنج سنة 255هـ، لكن هذا اللون لم يظهر في
الأدب المشرقي كما ظهر في الأدب الأندلسي فناً قائماً بذاته يسير في ثلاثة
اتجاهات: الأول هو رثاء المدن التي كانت عامرة فخربت أو ضاعت، ويمثل لـه
بشعر أبي إسحق الألبيري يصف إلبيرة Elvira وما أصابها من دمار وخراب. أما
الثاني فرثاء الدويلات التي زالت في أثناء الحكم العربي في الأندلس وفيه
يعدد الشعراء ما حل بأرباب نعمتهم من أسر أو قتل أو تشريد كما في رثاء ابن
اللبانة (ت507هـ) دولة بني عباد، ورثاء ابن عبدون (ت527هـ) دولة بني الأفطس
في قصيدته الرائية «البسّامة» وأما الاتجاه الثالث فهو الشعر الذي نظمه
أصحابه في رثاء المدن الضائعة مما سقط في يد العدو كما في قصيدة أبي البقاء
الرندي (ت684هـ) التي تتوزعها ثلاث فكر هي الاعتبار بزوال الدول، وتصوير
سقوط المدن، ثم دعوة المسلمين إلى الجهاد.
شعر الاستغاثة: ويقوم
على استنهاض عزائم ملوك المغرب والمسلمين لنجدة إخوانهم في الأندلس أو
التصدي للاجتياح الإسباني.
وقد أورد المقّري في نفح الطيب قصيدة
ابن الأبَّار (ت658هـ) التي استغاث فيها بسلطان تونس أبي زكريا الحفصي سنة
636هـ ومطلعها:
أدرك بخيلك خيــل الله أندلســـا إن
الســبيل إلى منجاتها درســا
فاستوعبت معظم الاتجاهات والمعاني
التي أتى بها شعراء الاستغاثة.
الموشحات والأزجال:
أحدث الأندلسيون فناً جديداً يتجاوب مع البيئة التي شاع فيها الغزل والشراب
والغناء وهو الموشح الذي يعتمده أكثر من وزن وأكثر من قافية، فيعمد الوشاح
فيه إلى ضرب من التنويع والافتنان العروضي.
نشأ هذا الفن في
القرن الثالث الهجري على يد رجلين من قرية قبرة cabra بالأندلس هما: محمد
بن حمود الضرير، ومقدم بن معافى، كما قال ابن بسام وابن خلدون. وإن كان بعض
الدارسين، ومنهم المستشرقان الإسبانيان خوليان ريبيرا Ribera وغارثيا غومث
Garcia Gomez، يرون أن الموشح تقليد لشعر رومانسي كان الإسبان يتغنون به،
وقد أبقوا منه الخرجة الأعجمية، فالموشح يتألف من مطلع ومجموعة أدوار
وخرجة، فالمطلع هو القفل الأول، أما الدور فيتألف من مجموع القفل والغصن.
ويأتي القفل على سمط أو اثنين أو أكثر، وكذلك الغصن، أما الخرجة فهي القفل
الأخير من الموشحة.
نظم الموشح في الأغراض المختلفة، وظهرت
أسماء لامعة لوشاحين كان أغلبهم شعراء من أمثال أبي بكر عبادة بن ماء
السماء (ت422هـ)، وعبادة القزاز (ت484هـ)، وابن اللبانة (ت507هـ)، والأعمى
التُّطيلي (ت520هـ)، وابن بقي (ت540هـ)، وابن زهر الحفيد (ت595هـ)، وابن
سهل الإشبيلي (ت659هـ)، وأبي الحسن الششتري (ت668هـ)، وأبي حيان الغرناطي
(ت745هـ)، ولسان الدين بن الخطيب (ت776هـ)، وابن زمرك (ت797هـ)، وابن عاصم
الغرناطي.
ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس، نسجت العامة على
منواله بلغة غير معربة قريبة إلى اللغة التي يتكلم بها الناس في مخاطباتهم
اليومية ما سموه بالزجل.
وقد مرت الأزجال بأدوار متلاحقة أولها
دور الأغنية الشعبية، ثم دور القصيدة الزجلية، واتسعت الأزجال لأغراض
كثيرة كالمديح والغزل والتصوف والوصف.
ومن أشهر الزجالين ابن
قزمان (554هـ)، وله ديوان أزجال كبير ويخلف بن راشد، وكان إمام الزجل قبل
ابن قزمان، ومدغلّيس (أحمد ابن الحاج) الذي كان شاعراً وشاحاً، والششتري
وقد برع في القصيدة والموشح، وهو أول من استخدم الزجل في التصوف كما استخدم
محيي الدين بن عربي التوشيح فيه.
خصائص الشعر الأندلسي: مر
الشعر الأندلسي بأطوار ثلاثة: فكان منذ الفتح حتى أوائل القرن الخامس
الهجري يمثل شعر التقليد لأدب المشرق، ولم يكن التقليد عجزاً عن الابتكار،
وإنما لشعور الانتماء إلى الأصل كشعر ابن عبد ربه، وابن هانئ وابن شهيد،
وابن دراج القسطلي.
وفي القرن الخامس الهجري جمع الشعراء بين
التجديد والأخذ بشيء من التقليد، ويمثل هذا التطور شعر ابن زيدون، وابن
عمار،والمعتمد بن عباد، وابن الحداد، والأعمى التطيلي.
أما في
القرن السادس الهجري وما بعده، فقد صور الشعراء بيئتهم، وبرزت العوامل
الأندلسية الذاتية كما في شعر ابن حمديس، وابن عبدون، وابن خفاجة، وابن
سهل، وأبي البقاء الرندي، وابن خاتمة الأنصاري، ولسان الدين بن الخطيب،
وابن زمرك، ويوسف الثالث ملك غرناطة، وابن فركون، وعبد الكريم القيسي
البسطي.
لقد أولع الأندلسيون بكل ما هو شرقي، وفي هذا يقول ابن
بسام (ت542هـ): «إن أهل هذا الأفق - يعني الأندلس - أبوا إلا متابعة أهل
المشرق، يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة، حتى لو نعق
بتلك الآفاق غراب، أو طن بأقصى الشام أو العراق ذباب. لجثوا على هذا صنماً،
وتلوا ذلك كتاباً محكماً».
وبسبب هذه المحاكاة للمشارقة في
أساليبهم ومعانيهم قيل للرصافي ابن رومي الأندلس، ولابن دراج متنبي المغرب،
ولابن هانئ متنبي الأندلس، ولابن زيدون بحتري المغرب والأندلس.
وكانت ظاهرة الانتقاء من التراث من خصائص الأدب الأندلسي، فكانوا يضمنون
قصائدهم أقوال السابقين وأشعارهم وأمثالهم وما صادف هوى في نفوسهم.
كما لقي حب الجديد صدى مستحباً في نفوس الأندلسيين، فلم يتقيد أغلبهم
بأساليب الأعراب ومعانيهم وأوصافهم، ولم تكن لغتهم محكمة كلغة المشارقة
والأقدمين لبعد صقعهم عن البادية، ولوجود جيل لم يكن عربياً صرفاً، وقد
نفروا من الألفاظ الوحشية إلى الألفاظ المأنوسة الرقيقة، وكانت القافية
الواحدة، وأوزان العروض الستة عشر ومثلها أكثر المعاني والأساليب المتوارثة
قوام الشعر التقليدي في الأندلس.
أعلام الشعراء: لم يهتم الناس
في عصر الولاة بصناعة الأدب لانشغالهم بالفتوح وإن لم يخل العصر ممن نظموا
الشعر في بعض المناسبات.
فقد حفظت المصادر اسم أبي الأجرب
جعونة ابن الصمة، وأبي الخطار حسام بن ضرار الذي وفد على الأندلس والياً
سنة 125هـ/742م.
وفي عصر الإمارة نشط الشعر، وكان العدد الأكبر
من الأمراء الأمويين في الأندلس شعراء منهم عبد الرحمن الداخل (113-172هـ)
وتبدو في شعره رقة الشعر الأموي وجزالته، وقد طرق موضوعات عدة لكنه تعمق في
الفخر والحنين.
كما اشتهر من العامة يحيى بن حكم الغزال، وقد
ترك شعراً يصنف في ثلاث مراحل: الأولى: مرحلة الشباب، وتغلب عليها موضوعات
الغزل وما يتصل بذلك من دعابة ومجون، وقد سافر إلى بلاد النورمان أيام عبد
الرحمن الأوسط فأعجب بملكتهم «تيودورا» وابنها فوصفها في شعره، والثانية هي
مرحلة التعقل والأناة، وتغلب عليها موضوعات النقد الاجتماعي، ثم تأتي
المرحلة الثالثة وهي مرحلة الزهد التي يذكّر فيها بالموت والفناء.
وفي عصر الخلافة ظهر ابن عبد ربه الذي طرق الأغراض الشعرية المعروفة، ولما
تناهت به السن نظم «الممحصات» وهي قصائد نقض فيها ما قاله في الصبا، فجاء
بأشعار تغص بالمواعظ والزهد.
أما جعفر بن عثمان المصحفي، وقد
استخدمه الحكم المستنصر في الكتابة، فهو الحاجب الشاعر الذي فتن بالطبيعة
فوصفها، وله أشعار يشكو فيها الزمان. وأما ابن فرج الجيَّاني فقد اشتهر
بالكتابة والتأليف، وله أشعار غزلية تمثل الغزل العذري العفيف.
وأما ابن هانئ، ويقال له الأندلسي تمييزاً له من ابن هانئ الحكمي (أبي
نواس)، فقد نشأ بإشبيلية ثم غادرها إلى المغرب لتألب الناس عليه بسبب
أفكاره الفلسفية، فلقي جوهراً قائد المعز لدين الله الفاطمي ومدحه، ثم اتصل
بالمعز، وغادر معه إلى مصر بعد أن بنى جوهر القاهرة، ثم استأذن بالعودة
إلى المغرب لاصطحاب أسرته، لكنه قتل في الطريق فقال المعز لما علم بنبأ
قتله: «هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا».
وفي مرحلة الحجابة عرفت طائفة من الشعراء عاصر بعضهم المرحلة السابقة
كالمصحفي، ولمع آخرون منهم المرواني الطليق (ت400هـ) وكان شاعراً مكثراً.
قال عنه ابن حزم «إنه في بني أمية كابن المعتز في بني العباس».
ومنهم يوسف بن هرون الرمادي (ت403هـ) اشتهر عند الأندلسيين بلقب (متنبي
المغرب) لغوصه على المعاني، وفنون شعره هي المدح والوصف والغزل.
ومنهم ابن دراج القسطلي (نسبة إلى قسطلة دراج من أعمال مدينة جيَّان) وهو
يعد من أوفر الأندلسيين نتاجاً، وقد تقلب في ظلال نعمة المنصور بن أبي
عامر، وخلد الكثير من غزواته.
وفي عصر الفتنة كان الشعراء أقل
عدداً من شعراء المراحل السابقة، وقد مزج بعضهم الشعر بكثير من النثر لأنهم
عملوا في الدواوين، وكان بعض الخلفاء شعراء كالخليفة المستعين.
من شعراء هذه المرحلة ابن شهيد، وابن حزم.
شهد ابن شهيد
(ت406هـ) عصر الفتنة الذي كان فاصلاً بين توحد الأندلس تحت ظل العامريين
(حجّاب دولة بني أمية) وبين ظهور دول الطوائف، وقد ترك آثاراً نثرية
وشعرية.
أما ابن حزم (ت456هـ) فقد ولد بقرطبة سنة 384هـ ونهل من
معين الثقافة مبكراً، وكان عالماً بالشعر، وصاحب مذهب حر في النقد، وكان
في عصره صوتاً يغاير ما كان عليه جمهرة فقهاء الأندلس (كان المذهب السائد
هو مذهب مالك) فقد تمذهب أول حياته بمذهب الشافعي، ثم مال إلى المذهب
الظاهري، فاحتج له، وألف فيه، فأمر المعتمد بن عباد بحرق كتبه بتحريض
الفقهاء.
واجتهد ملوك الطوائف في رد قرطبة الغربية إلى المشرق
فتشبهوا بخلفاء المشرق، وتباروا في اجتذاب العلماء والأدباء والشعراء.
من شعراء هذه المرحلة أبو إسحاق الإلبيري وكان فقيهاً زاهداً له قصيدة حرض
فيها صنهاجة (قبيلة باديس بن حبوس) على الوزير المتنفذ في غرناطة ابن
النغريلة اليهودي، فكانت السبب في قتله. ومنهم ابن زيدون وكان متقدماً في
علوم العربية وفي رواية الشعر. أدرك أواخر عهد الدولة المروانية، وخدم
دولتي بني جهور في قرطبة، وبني عباد في إشبيلية. أحب ولادة ابنة المستكفي،
وتغنى بحبها. ومن فنونه الشعرية الوصف والمدح والاستعطاف والشكوى، ومنهم
ابن عمار (ت477هـ) الذي صحب المعتمد بن عباد منذ صباه ثم ساءت العلاقة
بينهما، فلقي حتفه على يد المعتمد. له شعرفي الوصف والغزل والمدح والشكوى
والاستعطاف.
ومنهم ابن الحداد الوادي آشي (ت480هـ) صاحب
إشبيلية، نفاه يوسف بن تاشفين إلى أغمات في المغرب بعد تغلبه على الأندلس.
من فنونه الشعرية الغزل والوصف والشكوى.
ومنهم ابن اللبانة
(نسبة إلى أمه التي كانت تبيع اللبن) اختص بمدح عدد من ملوك الطوائف ومنهم
المعتمد.
من شعراء عصر المرابطين الأعمى التطيلي، وابن خفاجة،
وابن الزقاق. نبغ الأعمى التطيلي في الشعر والموشحات، إلا أن شهرته في
الموشحات أكثر منها في القصائد.
أما ابن خفاجة (ت532هـ) فهو
شاعر الوصف الأول في الأندلس، وقد لقب بالجنان، وبصنوبري الأندلس. وقد مدح
شخصيات معاصرة له.
وأما ابن الزقاق (ت529هـ) فقد نزع منزع خاله
ابن خفاجة في الغزل ووصف الطبيعة، وله مدح ورثاء وهجاء.
وفي عصر
الموحدين سيطر على الناس حب الأدب، وقرض الشعر. فالرصافي البلنسي (ت572هـ)
ولد في رصافة بلنسية، وبها قضى شطراً من حياته، ثم تحول إلى مالقة وترسم
خطوات أستاذه ابن خفاجة في الوصف والمدح، وله شعر في الحنين.
وابن مرج الكحل (ت634هـ) كان شاعراً مطبوعاً يغلب على شعره الوصف والغزل.
وابن عربي، محيي الدين كان شاعراً ووشاحاً. من آثاره الشعرية ديوانه
وترجمان الأشواق.
وابن سهل الإشبيلي، إبراهيم كان والده
يهودياً، وقد أسلم وحسن إسلامه. اشتهر بقوة الحافظة والقدرة على نظم الشعر،
وقد ضم ديوانه قصائد في الغزل والوصف والزهد، واشتهر بموشحاته.
وابن الأبار عرفت أشعاره في موضوعات الوصف والغزل والرثاء، وشعر
الاستغاثة.
ومنهم حازم القرطاجني الذي كان شاعراً ونحوياً
وناقداً، وفنون شعره المدح والغزل والوصف. ومن شعراء بني الأحمر: أبو
البقاء الرندي، واسمه صالح بن يزيد، اشتهر برثاء الأندلس، وله شعر في المدح
والغزل. وابن جزي (ت758هـ) أبو عبد الله محمد بن محمد، وكان كاتباً بارعاً
وشاعراً مشهوراً يغلب على شعره المدح، وهو الذي دون رحلة ابن بطوطة وصاغها
بقلمه بأمر من أبي عنان المريني سلطان المغرب.
وابن خاتمة
الأنصاري اشتهر مؤلفاً مصنفاً، وشاعراً، وأبرز أغراضه الشعرية التأمل
والنسيب والغزل والإخوانيات ووصف الطبيعة، وقد أكثر من التورية في شعره،
وجمعها ابن زرقاله تلميذه في مصنف سماه «رائق التحلية في فائق التورية».
ومنهم لسان الدين بن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ولسان الدين
لقب عرف به، كما عرف بذي العمرين، وذي الميتتين، وذي الوزارتين. وقد ولد في
لوشة Loja على مقربة من غرناطة - ترك أكثر من ستين مؤلفاً في الأدب
والتاريخ والتصوف والطب والرحلات وديوان شعر عنوانه «الصَيِّب والجهام
والماضي والكهام». وابن زمرك، وقد شارك في فنون أدبية مختلفة كالكتابة
والشعر والموشحات، ويعرف بشاعر الحمراء لأن مقر الحمراء في غرناطة مزدان
بشعره.
ويوسف الثالث (ت820هـ) اشتهر أميراً ثم ملكاً شجاعاً،
وشاعراً أصيلاً تبدو في أشعاره الحماسة العارمة والروح الدينية الوثابة.
وابن فركون القيسي، وقد أدرك شطراً من القرن الثامن الهجري، وقدراً من
القرن التاسع. ومن ممدوحيه يوسف الثالث، وجمع ما قيل فيه في كتاب سماه
«مظهر النور الباصر في أمداح الملك الناصر». ترك ديوان شعر فيه المدح
والغزل والوصف والإخوانيات والعتاب.
وعبد الكريم القيسي البسطي
من شعراء القرن التاسع الهجري، وكانت ثقافته شرعية وأدبية، ويصور شعره
جوانب العصر (أيام الأندلس الخيرة) التاريخية والاجتماعية.
النثر
فنون النثر الأندلسي: تعددت فنون النثر العربي في
الأندلس، فتناول الأندلسيون ما كان معروفاً في المشرق من خطب ورسائل
ومناظرات ومقامات، وزادوا عليها بعض ما أملته ظروف حياتهم وبيئاتهم، وقد
شاع فيهم تصنيف كتب برامج العلماء، التي تضمنت ذكر شيوخهم ومروياتهم
وإجازاتهم. وكان للكتاب مزية الجمع بين الشعر والنثر والإجادة فيهما.
الخطابة: كانت الخطابة وليدة الفتح، فقد استدعت الغزوات التي قام بها
العرب المسلمون قيام الخطباء باستنهاض الهمم، وإذكاء روح الحماسة للجهاد في
سبيل الله.
ولما تمزقت البلاد، واستحالت إلى دويلات كثيرة،
واستعان بعض أصحابها بالأعداء، كان الخطباء يقفون في المحافل العامة للدعوة
إلى لم الشمل وترك التناحر.
ومنذ عصر المرابطين، حتى آخر أيام
المسلمين في الأندلس، ظهرت الخطب المنمقة، ومنها التي تتضمن التورية بأسماء
القرآن الكريم كما في خطبة للقاضي عياض (544هـ) التي يقول فيها: «الحمد
لله الذي افتتح بالحمد كلامه، وبين في سورة البقرة أحكامه، ومد في آل عمران
والنساء مائدة الأنعام ليتم إنعامه...».
الرسالة: كانت
الرسالة في القرن الأول من الفتح ذات أغراض محددة أملتها ظروف العصر، وكان
لا يلتزم فيها سجع ولا توشية. ثم حظيت كتابة الرسائل بكتاب معظمهم من فرسان
الشعر استطاعوا بما أوتوا من موهبة شعرية وذوق أدبي أن يرتقوا بأساليب
التعبير وأن يعالجوا شتى الموضوعات، فظهرت الرسائل المتنوعة ومنها
الديوانية والإخوانية.
فمن الرسائل الديوانية رسالة أبي حفص
أحمد بن برد (ت428هـ) (المعروف بالأصغر تمييزاً له من جده الأكبر) من كتاب
ديوان الإنشاء في دولة العامريين، وقد وجهها لقوم طلبوا الأمان من مولاه.
واستخدم فيها الأسلوب الذي يخيف بالكلمة المشبعة بالوعيد.
ومن
الرسائل الإخوانية رسالتا ابن زيدون الهزلية والجدية، ورسالة لسان الدين بن
الخطيب إلى صديقه ابن خلدون في الشوق إليه.
وقد شاع استعمال
لفظ «كتاب» عوضاً عن الرسالة، كما ورد في رسالة جوابية كتبها ابن عبد البر
(ت458هـ) إلى أحد إخوانه يعبر فيها عن مدى إعجابه بأدبه.
المناظرة: وهي فن يهدف الكاتب فيه إلى إظهار مقدرته البيانية وبراعته
الأسلوبية، وهي نوعان خيالية وغير خيالية.
فمن المناظرات
الخيالية مناظرة بين السيف والقلم لابن برد الأصغر، وقد رمز بالسيف لرجال
الجيش، وبالقلم لأرباب الفكر، ثم أجرى الحوار بينهما، وانتهى فيه إلى ضرورة
العدل في المعاملة بين الطائفتين.
ومن المناظرات غير الخيالية
ما تجري فيه المناظرة بين مدن الأندلس ومدن المغرب كمفاخرات مالقة وسلا
للسان الدين بن الخطيب، وكانت مالقة أيام الدولة الإسلامية من أعظم الثغور
الأندلسية، أما سلا فهي مدينة رومانية قديمة في أقصى المغرب، وقد فضل
الكاتب مالقة.
المقامة: وهي نوع من النثر الفني نشأ في المشرق
على يد بديع الزمان الهمذاني، ثم حذا حذوه الحريري. وفي الأندلس عارض أبو
طاهر محمد التميمي السرقسطي (توفي بقرطبة سنة 538هـ) مقامات الحريري
الخمسين بكتاب الخمسين مقامة اللزومية، وهي المعروفة بالمقامات السرقسطية،
ولزم في نثرها المسجوع ما لا يلزم. كتب أبو محمد عبد الله بن إبراهيم
الأزدي (ت750هـ) «مقامة العيد» التي استكدى فيها أضحية العيد من حاكم مالقة
الرئيس أبي سعيد فرج بن نصر.
كما ألَّف لسان الدين بن الخطيب
مقامات كثيرة منها مقامته في السياسة، وقد بناها على حوار بين بطلين هما
الخليفة هارون الرشيد وحكيم فارسي الأصل عربي اللسان، وقد تضمّنت آراؤه
وتجاربه الشخصية فيما ينبغي أن تكون عليه سياسة الحكم.
كتب
برامج العلماء: وتضم شيوخ مؤلفيها، وما أخذوه عنهم من الروايات، وما قرؤوه
عليهم من الكتب، وما حصلوا عليه من الإجازات.
واختلفت تسمية
البرنامج بحسب المؤلِّفين، فيقال له المعجم، والمشيخة، والفهرس، والثبت،
والسند والتقييد.
ومن هذه الكتب فهرس ابن خير الإشبيلي
(ت575هـ)، وبرنامج المجاري (ت862هـ)، وثبت البلوي الوادي آشي (ت938هـ).
تطور النثر في مختلف أطوار العصر الأندلسي: عرفت في الصدر الأول من الفتح
نماذج قليلة من النثر اقتضتها ظروف الفتح، كالخطابة التي تطلبتها مناسبات
سياسية ودينية، والكتابة التي اقتضتها ظروف الحكم، وكتابة العهود والرسائل
والتوقيعات. وهو نثر تغلب عليه المسحة المشرقية من حيث الميل إلى الجزالة
وقوة العبارة وعدم اللجوء إلى المحسنات، ما عدا خطبة طارق بن زياد التي
يدور الشك حول نسبتها إليه.
وفي عهدي بني أمية والطوائف ظهر نوع
من النثر المتأثر بنثر الجاحظ، وكان للحكام دور في تشجيع الأدباء على
التأليف، وإسناد الوزارة إلى أصحاب الحذق والمهارة، فقد ألف ابن فرج
الجيّاني كتاب «الحدائق» وقدمه للحكم المستنصر، وقد انتدب المعتضد العبادي
الأديب الشاعر ابن زيدون لرئاسة الوزارة وإمارة الجيش فسمي بذي الوزارتين:
وزارة السيف، ووزارة القلم.
وفي عهدي المرابطين والموحدين ظهرت
طائفة من الكتاب عنيت بالكتابة الإنشائية والتأليف في مختلف الأغراض، كما
انتشرت في عهد الموحدين المكتبات التي تضم الكتب النفيسة. وعكفت طائفة من
الكتّاب على تأليف كتب جديدة منها «المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحية
(ت633هـ)، أو اختصار القديمة منها «اختصار الأغاني» للأمير أبي الربيع
الموحدي (ت604هـ)، أو تدوين رسائل تشيد بما وصلت إليه الأندلس من تقدم
ثقافي وازدهار علمي منها «رسالة في فضل الأندلس» للشقندي (ت629هـ).
وفي عهد بني الأحمر اتسعت النماذج النثرية فصدر عن الكتاب النثر الديواني
الذي يضم الرسائل، والكتابات على شواهد القبور، والعلامة السلطانية والنثر
الإخواني بين الكتاب وذوي السلطة، أو بين الكتاب أنفسهم، والنثر الوصفي
الذي يتناول وصف الشخصيات والاعلام، ووصف المدن والرحلات مثل رحلة البلوي
خالد بن عيسى (ت768هـ) وعنوانها «تاج المفرق في تحلية علماء المشرق»، ورحلة
القلصادي علي بن محمد (ت891هـ).
وكثر التأليف في المقامات التي
عنيت بتسجيل هموم الحياة، وخرجت عن الكدية والاستجداء إلا في القليل ومنها
«مقامة العيد» التي استكدى فيها الأزدي خروف العيد ليرضي زوجته.
خصائص النثر الأندلسي: على الرغم من تأثّر الكتّاب الأندلسيين بأساليب
المشارقة، وطرائقهم الفنية، فقد كانت هناك خصائص امتاز بها نثرهم ولاسيما
الترسل، فقد اتخذت رسائلهم في بنائها شكلاً فنياً يختلف في بعض جزئياته عن
الرسائل المشرقية التي تبدأ في الغالب بالبسملة والتحميد والصلاة على
الرسول الكريم، فصارت تخلو من الاستفتاح المعروف وتبدأ بالدعاء للمرسل
إليه، وتعظيمه، أو بالمنظوم، أو بالدخول في الموضوع مباشرة.
وتنوعت أساليب الإنشاء بتنوع الموضوعات، إلا أنَّ الكتاب حرصوا على
الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف، وأكثروا من استعمال الجمل
الدعائية والمعترضة، وبالغوا في إبراز الصور البيانية، واهتموا باستعمال
المحسنات البديعية، وارتقوا بأسلوب التعبير حتى لتبدو بعض رسائلهم وكأنها
شعر منثور كما في رسائل ابن زيدون.
وفي العصور الأخيرة تنوعت
أساليب الأداء الفني فاتخذت مستويين: أولهما مستوى الكاتب نفسه كما في نثر
ابن الخطيب المُرْسَل، والمسجع، والثاني الاختلاف على مستوى الكتاب، وقد
سار في اتجاهين يغلب على الأول الإفراط في الزخرفة اللفظية ورائده إسماعيل
بن الأحمر (ت807هـ) في كتبه «نثير الجمان» و«نثير فرائد الجُمان» و«مستودع
العلامة». ويغلب على الثاني الميل إلى الأسلوب المرسل، ويبدو في رسالة
القاضي أبي الحسن النباهي التي يعدد فيها معايب لسان الدين بن الخطيب، وفي
كتاب «الخيل» لعبد الله بن محمد بن جُزَيّ،وقد صدر الكتاب بنبذة عن تاريخ
ثمانية من ملوك بني الأحمر، ثم تحدث عن صفات الخيل وأحوالها.
أعلام الكتّاب في الأندلس: من أبرز أعلام الكتاب في الأندلس:
ابن عبد ربه (ت328هـ): وكان شاعراً وكاتباً، وله في النثر كتاب «العقد
الفريد» الذي قسمه إلى خمسة وعشرين باباً، وجعل لكل بابين منها اسم جوهرة
لتقابلهما في العقد، وهو يجمع بين المختارات الشعرية والنثرية، ولأن أكثر
مواده تتصل بالمشرق، فقد قال الصاحب بن عباد لما اطلع عليه: بضاعتنا ردت
إلينا.
ابن شهيد (ت426هـ): كان شاعراً وكاتباً. من آثاره
النثرية «رسالته في الحلواء» ورسالته المسماة «حانوت عطار» و«رسالة التوابع
والزوابع» وهي قصة خيالية يحكي فيها رحلته إلى عالم الجن واتصاله بشياطين
الشعراء والكتاب، وقد عرض من خلالها آراءه في اللغة والأدب.
ابن
حزم (ت438هـ): اشتهر شاعراً وكاتباً، ومؤلفاته النثرية كثيرة تتناول شتى
الموضوعات في الفقه والأدب والأنساب والتاريخ.
ابن سيْدَة
(ت458هـ): وكان أعلم الناس بغريب اللغة من أشهر مؤلفاته كتابي «المخصص»
و«شرح مشكل أبيات المتنبي». وابن عبد البر وكان من أهل قرطبة، واشتهر
برسائله التي يغلب عليها الاتجاه السياسي والحديث عن الصداقة والمودة، وقد
وصف الشطرنج.
ابن زيدون (463هـ): وقد افتنَّ برسائله، فكتب
الهزلية على لسان ولادة إلى ابن عبدوس يسخر منه كما سخر الجاحظ في رسالة
التربيع والتدوير من الكاتب أحمد بن عبد الوهاب وقد ساق ابن زيدون تهكمه في
سيول من الأشعار والأمثال وأسماء الرجال، وحرص على تناسق الإيقاع، فكان
السجع نائباً عن الأوزان والقوافي. كما كتب الرسالة الجدية يستعطف فيها قلب
ابن جهور فيخرجه من السجن، وقد بدأها بالنثر وختمها بالشعر، وهي من حيث
القيمة الفنية لا تقل عن الهزلية.
تمام بن غالب بن عمر
(ت436هـ): وهو من أعلام النحويين واللغويين ويعرف بابن التياني نسبة إلى
التين وبيعه. من كتبه «الموعب في اللغة» و«تلقيح العين» وقد وجه صاحب دانية
Denia، والجزائر الشرقية (جزائل البليار) الأمير أبو الجيش مجاهد العامري
(ت436هـ)، وكان من أهل الأدب، إلى أبي غالب أيام غلبته على مرسية، وأبو
غالب ساكن بها، ألف دينار أندلسية على أن يزيد في ترجمة كتاب ألفه تمام
لأبي الجيش مجاهد فلم يفعل ورد الدنانير وقال: «ولله لو بذل لي ملء الدنيا
ما فعلت ولا استجزت الكذب، لأني لم أجمعه له خاصة لكن لكل طالب».
ومنهم أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى (ت476هـ): المعروف بالأعلم لأنه
كان مشقوق الشفة العليا، والشنتمري نسبة إلى شنتمرية من بلاد الأندلس وله
شروح على الكتب المشرقية، وعلى دواوين بعض الشعراء الجاهليين.
ومن كتّاب القرن الخامس الهجري ابن الدبّاغ الذي نشأ في سرقسطة وترعرع
فيها، وقد أعلى المقتدر بن هود منزلته لفصاحته وبلاغته. له رسائل يغلب
عليها الاتجاه الاجتماعي، وقد جاءت معظم رسائله مملوءة بالشكوى من الزمان.
ومنهم ابن طاهر (ت507هـ): وقد تناول كثيراً من موضوعات أدب الرسائل
وأغراضه بحكم إمارته لمرسية، فكتب في الجهاد والصراع مع الصليبيين وفي
موضوعات الرسائل الإخوانية، وفي الفكاهة والهزل.
ومنهم ابن أبي
الخصال الغافقي (استشهد سنة 540هـ): وقد شغل مناصب إدارية في دولة
المرابطين، وألف في المقامات، وشارك في نمط من الرسائل عرفت بالزرزوريات.
ومنهم ابن بسام صاحب كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»، وضمنه محاسن
أدباء الأندلس من بُعيد الدولة المروانية إلى عصره.
ومنهم محمد
بن عبد الغفور الكلاعي (ت545هـ) وقد ألف كتاب «إحكام صنعة الكلام» في النثر
وفنونه.
ومنهم ابن طفيل (ت581هـ) وكان طبيباً وأديباً
وفيلسوفاً اشتهر بقصته «حي بن يقظان» التي تعد من أعظم الأعمال القصصية
الفكرية في العصور الوسطى، والهدف منها الوصول إلى معرفة الخالق والإيمان
به.
ومنهم أبو الحجاج بن محمد البلوي (ت604هـ) ويعرف بابن
الشيخ، وكان موفور الحظ من علم اللغة والأدب، مشاركاً في النقد والأصول. من
مؤلفاته كتاب «ألف باء» وهو أشبه بموسوعة جامعة لفنون الثقافة العامة
صنّفه ليتأدب به ابنه عبد الرحيم (ت638هـ).
ومنهم ابن جبير
(ت614هـ) أبو الحسين محمد، وكان شاعراً وكاتباً له الرحلة المشهورة وقد
دونها بأسلوب رصين جزل الألفاظ سهل التراكيب وهي من رحلاته المشرقية
الثلاث.
ومنهم محيي الدين بن عربي صاحب المؤلفات الصوفية ومنها
«الفتوحات المكية» و«فصوص الحكم». وله «الوصايا».
وابن الأبّار:
ومؤلفاته تربو على خمسة وأربعين كتاباً وصلنا منها «تحفة القادم»
و«التكملة» لصلة ابن بشكوال، و«المعجم» و«درر السمط في خبر السبط».
ومنهم حازم القرطاجي: وكان شاعراً ونحوياً وناقداً، وأشهر كتبه «منهاج
البلغاء وسراج الأدباء» الذي يمثل قمة من قمم النقد الأدبي.
ومنهم أبو الطيب (أبو البقاء) الرندي: وكان أديباً شاعراً ناقداً. من كتبه
«الوافي في نظم القوافي» وهو من كتب النقد والبلاغة.
وابن سعيد
(ت685هـ): الذي نظم الشعر وارتحل ودوّن مذكراته، وترك آثار أدبية تدل على
ثراء في الموهبة، واستقامة في التعبير. ومن كتبه المطبوعة «المُغرب في حلى
المَغرب» و«القدح المُعَلَّى». و«رايات المبرّزين وغايات المميّزين»،
و«عنوان المُرقصات والمُطربات»، و«الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة
السابعة»، وله «رسالة في فضل الأندلس».
ومنهم ابن الجيّاب
(ت749هـ) وقد تدرج في الخدمة في دواوين بني الأحمر حتى صار رئيس كتاب
الأندلس، وتخرج على يديه عدد من أهل العلم والأدب.
ومنهم لسان
الدين بن الخطيب: من آثاره «الإحاطة في أخبار غرناطة» و«اللمحة البدرية في
الدولة النصرية» و«نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» و«خطرة الطيف ورحلة
الشتاء والصيف» و«معيار الاختيار في أحوال المعاهد والديار»، وله رسائل
كثيرة جمع قسماً منها في كتابه «ريحانة الكتّاب ونجعة المنتاب».
أثر الأدب الأندلسي في آداب الغرب
إن صنوف التأثير الأدبية هي
بذور فنية تستنبت في آداب غير آدابها متى تهيأت لها الظروف والأسباب، وهذا
ما حصل في اللقاح الفكري بين الأدبين العربي والإسباني الذي وصل إلى مدن
فرنسة الجنوبية، ومدن اللورين الكائنة في الشرق عند حدود ألمانية، فوجد
فيها تربة خصبة جرى نسغها إلى ألمانية وإنكلترة لتكون ركائز النهضة
الأوربية.
وقد كتب نائب الأسقف في هيتا El Arcipreste de Hita
واسمه خوان رويث Juan Ruiz (ق14) «كتاب الحب الشريف» Libro Buen Amor
متأثراً بكتاب ابن حزم «طوق الحمامة في الألفة والألاف» في المضمون، وفي
طريقة التعبير والسرد، وفي تنويع الشخصيات.
وفي سنة 1919نشر
المستشرق الإسباني ميجيل أسين بالاثيوس Miguel Asin Palacios في مدريد
نظرية في كتابه «أصول إسلامية في الكوميديا الإلهية» La Escatalogea
Musulmana en la Divina Comedia تقول إن الأديب الإيطالي دانتي Dante
(1265-1331م) استوحى في ملهاته الأدب العربي، وحادثة الإسراء والمعراج،
وكان ملك قشتالة ألفونسو العاشر Alfonso x الملقب بالعالم El Sabio
(1253-1284م) قد أمر بنقل كتب العرب إلى القشتالية، فترجم معراج الرسول.
كذلك غزت المقامات العربية قصص الشطار أو القصة الأوربية الساخرة
Bicaresque بنواحيها الفنية وعناصرها الواقعية،وكان لقصة ابن طفيل «حي بن
يقظان» أكبر الأثر في قصة «النقّادة» للكاتب الإسباني بلتسار غراثيان
Baltasar Gracian (1601-1658م).
وكان للموشحات والأزجال الأثر
الأكبر في شعر «التروبادور» وهم شعراء العصور الوسطى الأوربية ظهروا في
نهاية القرن الحادي عشر الميلادي في جنوبي فرنسة ووسطها، وعاشوا في بلاط
الملوك والأمراء يتغنون بالحب، وقد يكون بين شعراء التروبادور ملك أو أمير.
لقد استقى التروبادور من الشعر الأندلسي نبعاً من الحقائق النفسية عملوا
بها وطوروها. فقد صور ابن حزم حبّه الذي لم يكن وليد الساعة، وإنما سرى على
مهل واستقر عماده، وبالمقابل فإن دوق أكيتانية غيوم التاسع (ت1127م) وصف
شعوره في حبه وطول انتظاره بقوله: «ليس على الأرض شيء يوازي هذا الطرب، ومن
شاء أن يتغنى به كما يستأهل فلا بد أن تنقضي سنة كاملة قبل أن يحقق ما
يريد».
كذلك وجد التروبادور في الشعر العربي رقياً ونضجاً من
حيث التنوع في الوزن والصقل والتعبير اللغوي، فحاولوا السير على منواله،
ومن ذلك أن متوسط المقطوعات التي تتألف منها قصيدة التروبادور سبع وهو
العدد الغالب على الموشح أو الزجل،وأن مجموع الغصن والقفل يسمى عند
التروبادور بيتاً، وهو الاسم ذاته في الموشحات والأزجال.
إن هذا
التشابه من حيث البساطة في المعنى، والأوزان والقوافي في الأسلوب، يدل على
تأثير التروبادور بالنماذج العروضية والعاطفية في الشعر العربي، وقد انتقل
هذا التأثير إلى أوربة فكان للعرب اليد الطولى في إغناء الشعر الأوربي
وإترافه برائع الصور والأساليب.
المغرب والشمال الإفريقي العربي
الحياة السياسية والاجتماعية في المغرب وشمالي إفريقية
قبل أن يظهر
العرب المسلمون على مسرح التاريخ، كان البحرالمتوسط يسمى بحر الروم، وكان
البربر في المغرب قوماً وثنيين ظلمهم الروم فثاروا عليهم، واتصل زعماؤهم
بالعرب وفاوضوهم في مقاتلة الروم معهم، وقد استغرق الفتح الإسلامي للمغرب
نحو سبعين عاماً بدأ ببعث استطلاعي قام به عقبة بن نافع الفهري (21هـ/642م)
وانتهى بحملة موسى بن نصير التي أخضع فيها المغرب الأقصى سنة 90هـ/708م،
وصارت بلاد المغرب تابعة للدولة الأموية، بل ولاية من ولايات الدولة إلى أن
قوض بنو العباس صرح الدولة الأموية سنة 132هـ، فآل المغرب إلى ولاية
عباسية.
ثم قامت دويلات في المغرب الأقصى والأوسط والأدنى. ففي
المغرب الأقصى قامت دولة الأدارسة واستمرت حتى القرن الرابع، ثم ظهر
المرابطون في القرن الخامس، وبعدها سيطر الموحدون (المصامدة) على بلاد
المغرب، ثم انقسمت إلى ثلاث دول: دولة بني مرين في المغرب الأقصى،ودولة بني
عبد الوادي (بني زيّان) في المغرب الأوسط، ودولة بني حفص في المغرب
الأدنى.
وصارت القيروان، التي أسسها عقبة بن نافع معسكراً
لجنوده، العاصمة الإسلامية الأولى للمغرب العربي، فيها ازدهرت الحضارة التي
وضع أسسها وأحكم دعائمها أمراء الدولة الأغلبية، وقد آتت هذه الحضارة
أكلها زمن الصنهاجيين في منتصف القرن الخامس الهجري زمن المعز بن باديس بن
يوسف (ت453هـ)، وكان أديباً مثقفاً غصّ بلاطه بالأدباء والعلماء منهم ابن
أبي الرجال الذي ألف كتاب «البارع في أحكام النجوم» وقد أمر ألفونسو العاشر
ملك قشتالة بنقله إلى اللغة القشتالية.
بعد أن خرّب الأعراب
القيروان، لجأ المعز إلى المهدية، واتخذها عاصمة له، ثم ازدهرت مدن أخرى
منها تلمسان وبجاية وصفاقس وفاس التي اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة،
إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس، وكانت القيروان حاضرة المغرب، فلما اضطرب أمر
القيروان بعبث الأعراب فيها، واضطربت قرطبة باختلاف بني أمية بعد موت
المنصور محمد بن أبي عامر وابنه، رحل عن هذه وهذه من كان فيها من العلماء
والفضلاء فنزلوا فاس وتلمسان، كما رحل بعضهم إلى مصر وأقطار أخرى.
وقد اتخذ المرابطون والموحدون مدينة مراكش دار مملكة لقربها من جبال
المصامدة وصحراء لمتونة، لا لأنها خير من فاس. ثم بنى الموحدون مدينة رباط
الفتح، وبنوا فيها مسجداً عملوا له مئذنة على هيئة منارة الاسكندرية. وقد
كانت مدن المغرب مراكز ثقافية وجسراً عبرت عليه تيارات الثقافة في طريقها
من المشرق إلى إسبانية.
الشعر
فنونه وخصائصه: الحديث
عن الشعر المغربي في عصوره وأقطاره يستنفد صفحات طوالاً، ذلك أنه من
الناحية الزمنية يساير الأدب الأندلسي، ثم يستمر بعد سقوط الأندلس إلى
العصور الحديثة، وهو من حيث أقطاره يستوعب النتاج الأدبي في المغرب الأدنى
والأوسط والأقصى إلى مناطق أخرى مثل شنقيط (موريتانية) وغيرها.
أصاب الكساد عالم الشعر والأدب في العصور الأولى وفي ظل المرابطين، لأن
العصر كان عصر جهاد وكفاح وحرب، وليس عصر ترف ورفاهية، وفي عصر الموحدين
كثر الشعراء تحت رعاية الخلفاء والأمراء، وتعددت أغراضهم وفنونهم، واتسعت
مجالاتهم، وامتزج المديح بالشعر السياسي. فقد واكب الشعر التطورات
العقائدية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع في عهد الموحدين، وعبر الشعر
عن دعوتهم وما يتعلق بها من مهدوية أو عصمة، وإمامة. وكان الخلفاء يطلبون
إلى الشعراء أن ينظموا الشعر في مواضيع تخدم دعوتهم،فتخلصت قصيدة المدح
من المقدمات التقليدية، وافتتحت بالحديث عن سيرة المهدي بن تومرت وخليفته
عبد المؤمن بن علي.وقد تستهل القصيدة بطريقة الكتابة الديوانية فيذكر فيها
التحميد والتصلية على الرسول والترضية عن المعصوم المهدي كما في قصيدة أبي
عمر بن حربون في الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بعد انتصاره على
المخالفين المرتدين بالمغرب سنة 563هـ.
وتنوع الغزل في شعر
المغاربة، فكان فيه العفيف والماجن، كما نشط شعر وصف الطبيعة. ولم يكتف
الشعراء بجعله مطية لغرض آخر، ومتكأ له، وإنما أفردوا للطبيعة قصائد
لوصفها، فصوروا مفاتنها، ووقفوا عند كل جزئية من جزئياتها. ووصفوا الخمر،
وافتنّوا في وصف مجالس الشراب والندمان والسقاة، وعبّروا عن تعلّقهم الشديد
بها.
كما لقي فن الرثاء رواجاً لديهم ولاسيما رثاء المدن
الأندلسية التي سقطت في أيدي النصارى، وفي رثاء مدنهم التي خربت
(القيروان). وازدهر شعر الزهد والتصوف وشعر المدائح النبوية،وممن اشتهر به
أبو العباس محمد ابن العزفي السبتي المغربي (ت633هـ).
ونظم
الشاعر المغربي الموشح، فابن غرله الذي اشتهر بعشقه رميلة أخت الخليفة
الموحدي عبد المؤمن بن علي نظم الموشح والزجل والمرنم (الزجل الذي يدخله
الإعراب)، ومن موشحاته الطنانة الموسومة بالعروس. كما عرف المغاربة «عروض
البلد»، وقد ذكر ابن خلدون أن أول من استحدثه رجل من الأندلس نزل بفاس هو
أبو بكر بن عمير، فنظم قطعة على طريقة الموشح، ولم يخرج فيها عن مذهب
الإعراب إلا قليلاً، فاستحسنه أهل فارس، وولعوا به، ونظموا على طريقته.
لقد شارك أدباء المغرب في فنون القول شعراً ونثراً، وحكم على التراث
الأدبي في المغرب بأنه مطبوع بالطابع الأندلسي في شكله وموضوعه وكان
لانتشار المذهب الفاطمي في المغرب أثر في وجود بعض المعاني الفلسفية
والجدلية في الشعر كالذي ظهر في شعر ابن هانئ الأندلسي وكان من شعراء المعز
لدين الله الفاطمي.
وقد تخلف شعراء المغرب عن اللحاق بشعراء
المشرق ثم الأندلس في قوة الأفكار وعمق المعاني (باستثناء شعراء العصر
الفاطمي) لكن شعرهم لم يخل من جمال الصيغ اللفظية وأناقتها، وقد برعوا في
الملاءمة بين مواضيع القصائد وأوزانها كما في قصيدة الحصري «يا ليل الصب»،
وأكثروا من رثاء المدن المنكوبة، وفي هذا الباب تظهر قوة خاصة في الشعر
المغربي وهي قوة التأثير العميق الصادق.
أعلام الشعراء: من أبرز
شعراء المغرب بكر بن حماد (200-296هـ): التاهرتي (نسبة إلى تاهرت
بالجزائر)، فنون شعره المديح والهجاء والزهد والغزل والوصف، وقد رحل إلى
المشرق وكان من العلماء والرواة.
تميم بن المعز (337-374هـ):
شاعر الدولة الفاطمية، ولد في المهدية بتونس، وتوفي بمصر، أبرز أغراضه
الشعرية المديح والغزل والطرد، والرثاء والإخوانيات.
ابن رشيق
القيرواني (390-456هـ): ولد بالمسيلة (الجزائر) ورحل إلى القيروان، وأتم
بقية حياته في صقلية، وتوفي بمازر. تعددت جوانبه العلمية والأدبية. له
ديوان شعر، ومن مؤلفاته «أنموذج الزمان في شعراء القيروان».
ابن
شرف القيرواني (390-460هـ): الناقد الكاتب الشاعر، له ديوان شعر.
علي بن عبد الغني الحصري (424-488هـ): يكنى أبا الحسن. برز في علوم
القرآن، له الرائية المشهورة في القراءات، وله المعشرات وهي قصائد منظومة
على حروف المعجم، كل قصيدة بها عشرة أبيات مبتدأة، ومقفاة بحرف من حروف
الهجاء، وله ديوان شعر عنوانه «اقتراح القريح، واجتراح الجريح» وأغلبه في
رثاء ابنه عبد الغني. ومن أشهر قصائده «يا ليل الصب متى غده؟» وهي طويلة
تقع في تسعة وتسعين بيتاً، وقد عارضها كثيرون لإشراق معانيها وعذوبة
ألفاظها.
تميم بن المعز الصنهاجي (422-501هـ): كان رجل سياسة
وعلم. كشفت أشعاره عن مقدرته الشعرية وغزارة إنتاجه الذي يدور أغلبه حول
الغزل والوصف والزهد والحماسة.
الأمير أبو الربيع الموحدي
(552-604هـ): أحد أمراء الدولة الموحدية جمع بين السياسة والأدب. ترك ديوان
شعر عنوانه «نظم العقود ورقم البرود».
مالك بن المرحَّل
(604-699هـ): ولد بمالقة واكتسب شهرة في الأدب والشعر وبرع في علوم كثيرة.
له منظومات في القراءات، والفرائض، والعروض، ومخمسات في مدح الرسول الكريم،
وشعر في الاستنجاد. توفي في فاس.
ابن خميس التلمساني
(625-708هـ): شاعر عالم رحل إلى سبتة ثم إلى الأندلس، وفي غرناطة التحق
بخدمة الوزير أبي عبد الله بن حكيم ثم قتل مع مخدومه.
الشريف
الغرناطي (697-760هـ): ولد بسبتة ونال فيها علماً كثيراً، وقدم إلى غرناطة
واستقر بها، ولهذا اشتهر بالغرناطي، وله ديوان شعر.
وابن زاكور
(1075-1120هـ): كان كاتباً وشاعراً ولغوياً - من كتبه «شرح على لامية
العرب» وله ديوان شعر مرتب على الأغراض، ونظم موشحات ذكر بعضها في «المنتخب
من شعر ابن زاكور».
ومن شعراء شنقيط أحمد بن محمد بن المختار
اليعقوبي المعروف بأحمد بن الطلب، ينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب. لقب
بيته بالطلب لأنهم أعلم أهل ناحيتهم، فكانت الناس ترحل إليهم في طلب العلم،
وكان جيد الشعر.
النثر
فنونه وخصائصه
الكتابة الرسمية: وهي تلك الكتابات الصادرة عن الخلفاء والأمراء والولاة
والقادة، وعمودها الكتابة الديوانية التي تختص بالعلامة السلطانية التي
يصدرها الخليفة إلى عماله وولاته وقضاته ورعيته، وموضوعاتها متنوعة تكاد
تشمل مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية والتاريخية. فمن
الموضوعات الاجتماعية والسياسية محاربة الآفات الاجتماعية ومكافحة الظلم
والدعوة إلى وحدة الصف وإطاعة أولي الأمر. ومن الموضوعات الدينية الأمر
بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، فقد كتب الفقيه المتصوف ابن
عباد الرندي (792هـ) إمام جامع القرويين إلى أبي فارس عبد العزيز المريني
مستنكراً تصرفات عماله مع المسلمين.
ومن الموضوعات التاريخية
سجلت الرسائل الرسمية الغزوات والفتوح والحملات العسكرية، وقد كتب المغاربة
الرسالة الديوانية بإحكام وروية، واعتنوا بالعبارة واتكأت الرسالة في كثير
من ملامحها على الرسالة الديوانية المشرقية، ثم بدأت في العصور المتأخرة
تحاول أن ترسم لنفسها ملامح جديدة، فهي تفتتح بالمقام، ثم وصف عظمته، ثم
يذكر المتن أو مضمون الرسالة، وقد غلب السجع عليها لتناسب فخامة المقام.
الكتابة الوصفية: ويقصد بها الكتابات التي كانت تدور حول المناظرات
والمفاخرات بين المدن، وبين الأزهار، وبين الأطيار، كما شملت أدب الرحلات
(رحلة ابن بطوطة، ورحلة ابن رشيد، ورحلة ابن خلدون).
واعتمد
أغلب الكتاب أسلوب المقامة من حيث التوشية والزخرفة البديعية ومنها السجع،
فقد أكد محمد بن عبد الغفور الكلاعي في كتاب «إحكام صنعة الكلام» ضرورة
السجع للنثر، واستحسان الإتيان به مع مراعاة الابتعاد عن التكلف فيه حتى لا
يثقل على الأذن، وينبو عنه الذوق السليم، كما كتب آخرون بالأسلوب المرسل:
صنيع ابن خلدون.
الكتابة الذاتية: ويدخل ضمنها الكتابة
الإخوانية، ومنها الرسائل المتبادلة بين الكاتب وذوي السلطان، وبين الكاتب
وإخوانه، كما تندرج فيها المدائح النبوية، والخواطر التأملية، ولاسيما في
الرسائل النبوية. فابن خلدون يحدثنا عن سفر أبي القاسم البرجي إلى التربة
المقدسة حاملاً رسالة من أبي عنان المريني إلى الضريح الكريم كتبها أبو
عنان بخط يده.
وحرص أغلب الكتاب على العناية بظاهرة الزينة
اللفظية، وإن كان بعضهم قد تصدّوا لظاهرة سيطرة البديع على النثر، أو
استقبحوا الإكثار منه كما فعل ابن خلدون، فحين تولى ديوان الإنشاء أيام أبي
سالم المريني (ت762هـ) فضّل الكلام المرسل على انتحال الأسجاع في الكتابات
الرسمية.
أعلام الكتّاب: جمع المغاربة والأندلسيون بين مزيتي
الشعر والنثر، وكان للتأليف شأن عظيم لديهم في شتى العلوم والآداب، ومن
أعلام الكتاب:
إبراهيم بن علي الحصري (ت453هـ): ويكنى بأبي
إسحاق، شهر بالحصري نسبة إلى صناعة الحصر أو بيعها، أو نسبة إلى «الحصر»
وهي قرية كانت قرب القيروان. نشأ في القيروان في أواخر عهد الفاطميين
بإفريقية، وكان له ناد يقصده الأدباء والمتأدبون. من مؤلفاته «جمع الجواهر
في الملح والنوادر» و«زهر الآداب» وهو كتاب ذو قيمة أدبية وتاريخية، يشبه
«البيان والتبيين» للجاحظ في طريقته.
علي بن عبد الغني الحصري
(ت488هـ): وكان شاعراً وكاتباً وله رسائل أثبتها ابن بسام في «ذخيرته»
كنماذج من نثره يخاطب بها أصدقاءه وأعداءه، وهي لا تخرج عن طريقة عصره في
أسلوب التحرير المسجوع المرصع بألوان التورية والجناس.
الشريف
الإدريسي: ولد في سنة 493هـ، ودرس في قرطبة، ثم طوّف في البلاد، وانتهى به
التجوال إلى صقلية، ونزل على صاحبها روجار الثاني وألف له كتاب «نزهة
المشتاق في اختراق الآفاق»، وفيه شرح لكرة الفضة التي أمر الملك بصنعها،
توفي في صقلية سنة 560هـ.
ابن رشيق القيرواني (ت463هـ): كان
شاعراً وكاتباً. اتصل ببلاط المعز في القيروان وتعرف كاتبه أبا الحسن علي
بن أبي الرجال فألحقه بديوان الإنشاء الذي كان رئيسه، وقد رفع إليه كتاب
«العمدة في صناعة الشعر ونقده».
ابن شرف القيرواني (ت460هـ):
كان كاتباً وشاعراً. ألحقه المعز بديوان المراسلات وجعله من خاصته فانقطع
إليه، ونافس ابن رشيق في الحظوة عنده، من مؤلفاته النثرية: رسائل الانتقاد،
ورسائل المهاجاة، وابتكار الأفكار.
أبو الفضل التيجاني
(ت718هـ): صاحب الرحلة المشهورة، وكان أعلى الكتبة مرتبة وأسلمهم قافية. له
رسالة مشهورة كتبها إلى ابن رشيد الفهري (ت721هـ) صديقه حين نزل بتونس في
أثناء رحلته إلى الحج وعودته منه يقول فيها: «أقول والله المسعف المنان:
اللهم بلغ صاحبنا وجميع المسلمين إلى أوطانهم وأماكنهم سالمين في النفس
والأهل والمال. اللهم كن لهم في حلهم وترحالهم، وسلّمهم ولاتسلمهم..»
والرسالة تسجيل لمخاطر الطرق إلى الحج والرحلة في ذلك الزمن.
الشريف الغرناطي: تولى في الدولة النصرية عدة مناصب مثل كتابة الإنشاء وخطة
القضاء والخطابة. ومن تآليفه المشهورة: «رفع الحجب المستورة عن محاسن
المقصورة» وهو شرح على مقصورة حازم القرطاجني التي مدح فيها المستنصر
الحفصي، وقد جاء الشرح بأسلوب مسجع تحس معه جلال الفكرة وتوقد الذهن.
ابن خلدون، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن: ولد بتونس سنة 730هـ، وتوفي في
القاهرة سنة 808هـ، كان ينظم الشعر، لكن ملكته تخدشت من حفظ المتون
المنظومة في الفقه والقراءات. اعتمد في نثره الأسلوب المرسل مخالفاً أسلوب
العصر في الميل إلى السجع من آثاره: «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السطان الأكبر». ويقع في مقدمة
وثلاثة كتب، وقد ارتقى بالتاريخ من السرد والقصص الساذج إلى درجة العلم
المفلسف، وسجل سيرة حياته بقلمه في آخر جزء من العبر وطبع بعنوان: «التعريف
بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً».
الأدب العربي في صقلية:
الحياة السياسية والاجتماعية:
صقلية Sicilia جزيرة مقابل ساحل
تونس، تبعد عن البر الإيطالي ثلاثة كيلومترات. ضبطها ياقوت في معجمه بثلاث
كسرات وتشديد اللام والياء، ولكنه ذكر أن أكثر أهلها يفتحون الصاد، وضبطها
ابن دحية بفتح الصاد والقاف، وقال النحوي ابن البر التميمي الصقلي: اسمها
باللسان الرومي سَكَّةِ كِلّية وتفسيرها: تين وزيتون، وإلى هذا المعنى أشار
ابن رشيق حين مدحها فقال:
أخــت المدينة في اســم لا يشــاركها
فيه ســواها من البلدان والتمـــس
وعظّـــم الله
معنــــى لفظهـا قســــماً
قلّد إذا شــئت أهل
العلم أو فقـــس
فتح المسلمون صقلية سنة 212هـ/728م بقيادة الفقيه
أسد بن الفرات (ت213هـ) الذي تولّى قضاء إفريقية في عهد الأغالبة، وكانت
القيروان (تونس اليوم ) تابعة للخلافة العباسية في بغداد.
ولما
قامت الدولة المهدية في ظل الفاطميين، تأسست دولة الكلبيين في صقلية فبلغت
الجزيرة عهدها الذهبي.
احتلها النورمان بقيادة ملكهم روجار
الأول، فهجرها أغلب سكانها إلى مصر والقيروان والأندلس، وكانت عادة
الانتقال والارتحال بين الأقطار الإسلامية معروفة أيام المحن، فقد شتتت
نكبة القيروان، بعد الخلاف بين الفاطميين والمعز ابن باديس، أهل القيروان
وخرج الأدباء والعلماء منها إلى صقلية والأندلس ومصر، وها هنا التاريخ يعيد
نفسه بخروج العرب من صقلية بعد انتهاء الحكم العربي فيها الذي استمر لغاية
450هـ.
تعايش من بقي من المسلمين في صقلية مع النورمان مدة
ثلاث وتسعين ومئة سنة، وظلت اللغة العربية إحدى اللغات التي أقرتها الدولة
في سجلاتها إلى جانب اللاتينية واليونانية.
وفي سنة 643هـ احتل
الجرمان الجزيرة بقيادة فردريك الثاني الذي نكل بالمسلمين ليدفعهم إلى
الجلاء سنة 647هـ/ 1249م، ثم قضى عليهم بتحريض الملك شارل دانجو عام
700هـ/1300م، لكن اللغة العربية لم تمح آثارها، فثمة أسماء كثيرة في صقلية
لها أصول عربية.
الشعر
اعتمد الشعر الصقلي محاكاة
المشارقة والمدرسة الإفريقية في القيروان، وكان تأثيره بالأندلس أقل من
تأثيره بإفريقية والمشرق، وقد غذي بالدراسات الإسلامية، ولاسيما الفقه،
واللغة، وامتلأ بالألغاز والتلاعب اللفظي بالأسماء، وكان هناك أخذ بأسباب
الدين والزهد والتصوف إلى جانب التيار المعاكس المتمثل بالحديث عن الخمر،
وبائعها، وشاربها، والتغني بذكر الصليب والزنار.
وقد شارك بعض
الأمراء الكلبيين في النشاط الأدبي ولاسيما الشعري.
فنونه
وخصائصه: في العصر الإسلامي، وصف الشعراء القصور، والمتنزهات، والخمر، وكثر
التغزل بأسماء تقليدية مثل سلمى، وسعاد، وبثينة، كما كثرت الرسائل الشعرية
نتيجة هجرة الناس من صقلية وإليها.
أما في العصر النورماني، أو
مرحلة التعايش بين العرب والصقليين فالشعر الباقي يمثل اتجاهين: أما
الاتجاه الأول فهو الشعر الذي يتصل بالملك النورماني وبلاطه وأبنائه
وحاشيته، ومنه قصيدة أبي الضوء سراج في رثاء ولد روجار.
ويصوّر
الاتجاه الثاني الشعر الذي يمثل حياة المسلمين وعلاقاتهم فيما بينهم، وقد
انفرد محمد بن عيسى بذكر العيد وحال السرور والتحدث عن الملائكة. وكثيراً
ما نفر الناس من الشعر ذي الاتجاه الأول، فقد كان ابن بشرون شاعراً فحلاً
أحبه الناس، فأراد الملك روجار الأول أن يضفي على اغتصابه الجزيرة أسمال
الشرعية موهماً الناس بقبوله من وجهائهم، فاستدعى ابن بشرون وطلب إليه أن
ينشده مديحاً فلما ارتجل الشاعر أبياته ابتعد عنه الناس.
ولما
اطلع العماد الأصفهاني على كتاب ابن بشرون الذي خصص فيه فصلاً لشعراء صقلية
قال بعد أن حذف الشعر الذي وجده في مديح الكفار: «واقتصرت من القصيدتين
على ما أوردته لأنهما في مدح الكفار، فما أثبته».
أعلام
الشعراء: من شعراء القرنين الرابع والخامس: ابن الخياط الصقلي: أبو الحسن
علي بن محمد، كان شاعراً نابهاً أيام حكم الكلبيين في صقلية. يكثر في شعره
المدح والغزل ووصف الطبيعة.
أبو العرب مصعب بن محمد بن أبي الفرات
القرشي: ولد في صقلية سنة 423هـ، ثم غادرها إلى الأندلس سنة 463هـ مع من
هاجر منها إثر الاحتلال النورماني، فلحق بالمعتمد بن عباد، ثم بناصر الدولة
صاحب جزيرة ميورقة بعد أن دالت دولة العباديين، وبقي هناك إلى وفاته سنة
506هـ. أهم أغراضه الشعرية المدح وجلّه في المعتمد كما دعا إلى التمتع
بمباهج الحياة فقال:
متّع شـــبابك واســـتمتع بجدّتـــه
فهـــو الحبيـــب إذا مــا بان لـم يؤب
ابن القطاع،
أبوالقاسم علي بن جعفر بن علي السعدي: ولد سنة 433هـ بصقلية، ثم هاجر إلى
مصر بعد اشتداد ضغط النورمان. كان شاعراً عالماً باللغة والأدب والتاريخ.
من مؤلفاته «تاريخ صقلية» و«أبنية الأسماء والأفعال» و«البارع في العروض
والقوافي» و«الدرة الخطيرة في المختار من شعراء الجزيرة» وقد اشتمل على مئة
وسبعين شاعراً، وعشرين ألف بيت من الشعر. عالج في شعره مجالس الخمر بالوصف
والإثارة، وأبدع في الغزل.
ومن شعراء القرن السادس:
البَلَّنوبي، أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أبي البشر: ينسب إلى
بَلَّنوبة وهي بُليدة بجزيرة صقلية ذكرها ياقوت تسمى اليوم فيلانوفا Villa
Nova كان والده مؤدباً لأبي الطاهر التجيبي (ت445هـ).
أقام أبو
الحسن مدة في صقلية ثم غادرها إلى مصر مع جملة من المهاجرين، وهناك اتصل
بعدد من رجال الدولة ومدحهم منهم بنو الموقفي، وابن المدبّر واليازوري
(نسبة إلى يازور من قرى فلسطين). فنون شعره كثيرة.
عبد الجبار
بن أبي بكر بن حمديس: ولد في سرقوسة على الساحل الشرقي من صقلية وفيها قضى
شطراً من حياته، ثم انتقل إلى تونس في طريقه إلى الأندلس بعد هجرة العلماء
من بلده. قصد المعتمد بن عبَّاد واستمر في رعايته إلى أن دالت دولة
العباديين، فارتحل إلى إفريقية، وبقي في رعاية بني حمَّاد في بجاية إلى أن
توفي سنة 527هـ. اشتهر بشعر الحنين، ووصف الطبيعة.
النثر
فنونه وخصائصه: أنتجت صقلية نثراً خصباً يوازي نشاطها في الشعر، فقد نبغ
فيها كتّاب، وسعوا أغراض النثر وفنونه، ووضع بعضهم مقامات كانت ذائعة
مشهورة منها مقامات «الطوبي» التي بلغ فيها الغاية في الفصاحة.
كما ألف بعضهم كتباً في تاريخ صقلية وأرخوا لرجال الفكر والعلم و الأدب.
وظهر عدد من اللغويين والنحويين حاولوا الحفاظ على الفصحى، وتخليصها مما
لحقها من تصحيف، ولاسيما في مرحلة التعايش بين العرب المسلمين والصقليين،
فقد استمرت السيادة للغة العربية والثقافة العربية الإسلامية بعد أفول نجم
السيادة العسكرية والسياسية نحو قرنين من الزمن.
أعلام الكتّاب:
أبو عبد الله محمد بن الحسن الطوبي كاتب الإنشاء: كان له شعر في الغزل
والزهد، لكن النثر غلب عليه. وصفه العماد الأصبهاني بقوله: «إمام البلغاء
في زمانه».
أبو حفص عمر بن حسن النحوي: كان إماماً من أئمة
النحو، استشهد به وبآرائه ابن منظور (ت711هـ) صاحب معجم لسان العرب.
ابن البر، محمد بن علي بن الحسن التميمي: من أعلام القرن الخامس، ولد في
صقلية، وارتحل في طلب العلم إلى المشرق فنزل مصر وأفاد من الهروي (ت433هـ)
وابن بابشاذ النحوي (ت454هـ) وصار إماماً في علوم اللغة والآداب. لما عاد
إلى صقلية، استقر بمازر، ثم في بالرمو.
أبو حفص عمر بن خلف، ابن
مكي الصقلي المتوفى سنة 501هـ: ولد في صقلية، ثم هاجر إلى تونس فولي
القضاء بها سنة 460هـ. كان شاعراً مجوّداً نظم في أدب المجالس والصداقة،
وتغلب على أشعاره معاني الوعظ والإرشاد والحكمة. وكان كاتباً بليغاً اشتهر
بتبحره في اللغة، صنّف «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان»، وجعله في خمسين
باباً، جمع فيه ما يصحف الناس من ألفاظهم وما يغلط فيه أهل الفقه والحديث،
وأضاف أبواباً مستطرفة، ونتفاً مستملحة، وقد نقد المغنين لأنهم كانوا
يحرصون على أداء النغم ويحرفون النص. ومقصد الكتاب في أعماقه رد اللغة
العربية إلى الفصحى. وعدم إقرار المحلية، وقد كانت صقلية ملتقى شعوب، وليست
وطناً لشعب