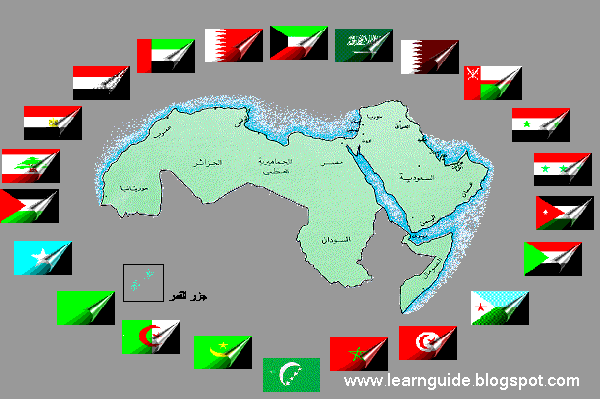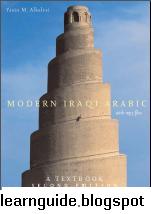+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 18:33|
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 17:36|
. أباطيل وأسمار محمود شاكر http://www.megaupload.com/?d=TBUMJEJA
2. ابن سلام وطبقات الشعراء http://www.megaupload.com/?d=W5SZBI0W
3. أحمد شوقي http://www.megaupload.com/?d=CDXCM5IO
4. أخبار الحمقى والمغفلين http://www.megaupload.com/?d=82Z9LY4G
5. أخبار الظراف والمتماجنين http://www.megaupload.com/?d=6KRI7YEC
6. أدب الإملاء والاستملاء http://www.megaupload.com/?d=U8V00AR5
7. أدب الكاتب http://www.megaupload.com/?d=20Y7993A
8. ادب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العى وتعليم الاعراب وغير ذلك http://www.megaupload.com/?d=OYDUZSQZ
9. أدب الوزير للماوردي http://www.megaupload.com/?d=T7K88QQG
10. أسواق العرب في الجاهلية والإسلام http://www.megaupload.com/?d=RJDUCFD6
11. أصول الشعر العربي http://www.megaupload.com/?d=MXCUQJJ2
12. إعتاب الكتاب لابن الأبار http://www.megaupload.com/?d=TLSRR910
13. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر http://www.megaupload.com/?d=MJXN1WZW
14. الامالي للقالي ويليه الذيل والنوادر وكتاب التنبيه لابي عبيد البكري http://www.megaupload.com/?d=LZAD1MYZ
15. الأمثال العربية والعصر الجاهلي http://www.megaupload.com/?d=UZ3Q2KJ9
16. التطفيل وحكايات الطفيليين http://www.megaupload.com/?d=3E2M2OK3
17. الخطابة و اعداد الخطيب http://www.megaupload.com/?d=REV2W66Y
18. الأمثال للرامهرمزي http://www.megaupload.com/?d=B5MQ5N72
19. البيان والتبيين http://www.megaupload.com/?d=7U48A30O
20. الانشاء السهل http://www.megaupload.com/?d=N2XE49YB
21. البخلاء http://www.megaupload.com/?d=AI442JMU
22. التطفيل والطفيليين http://www.megaupload.com/?d=QP8WUAF8
23. الخطبة العصرية للجمعة والعيدين لأحمد الجمل http://www.megaupload.com/?d=F161PVER
24. الخياميات http://www.megaupload.com/?d=AQAZ777E
25. الدر النضيد في شرح القصيد http://www.megaupload.com/?d=JPEJXUA3
26. الرسائل العباسية في العصر العباسي الأول http://www.megaupload.com/?d=9C04JQQL
27. الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي http://www.megaupload.com/?d=PXLGKYM9
28. الزجاجي حياته وأثره http://www.megaupload.com/?d=RQL7SPRO
29. الشعر والشعراء http://www.megaupload.com/?d=ITKC9G79
30. العبرات للمنفلوطي http://www.megaupload.com/?d=08AP7BDC
31. العثمانية http://www.megaupload.com/?d=UPQFS8TS
32. العقد الفريد http://www.megaupload.com/?d=41KYD5AP
33. ألف قصة وقصة من قصص الصالحين والصالحات http://www.megaupload.com/?d=B5WEAK1G
34. الفخري في الآداب السلطانية http://www.megaupload.com/?d=TG21KDWW
35. القوس العذراء http://www.megaupload.com/?d=Q2E3LXZF
36. الكامل للمبرد http://www.megaupload.com/?d=S0WYJJLZ
37. اللغة الشاعرة http://www.megaupload.com/?d=BH3A56VF
38. المدارس والأنواع الأدبية http://www.megaupload.com/?d=T8OFPJSH
39. المطالع النصرية http://www.megaupload.com/?d=1MYFZVWS
40. المعلقات العشر وأخبار شعرائها http://www.megaupload.com/?d=G72ORD9V
41. المفضليات http://www.megaupload.com/?d=2H0TQS3F
42. المؤتلف والمختلف للآمدي http://www.megaupload.com/?d=3C3HJNT1
43. النابغة الذبياني لمحمد العشماوي http://www.megaupload.com/?d=GABPPQSM
44. النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري http://www.megaupload.com/?d=X7FHO2SK
45. أوجز الكلام http://www.megaupload.com/?d=S51KMTC4
46. باب الهجاء http://www.megaupload.com/?d=ZQ1QP8MI
47. بلال بن جرير وما تبقى من شعره http://www.megaupload.com/?d=7RHJTH82
48. بين أوهام الادعاء العريضة والحقائق الصلبة ل محمد مندور http://www.megaupload.com/?d=YKQSGMGA
__________________
49. تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعى http://www.megaupload.com/?d=2NW9O5OD
50. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان http://www.megaupload.com/?d=UPN9GI8Z
51. تاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف http://www.megaupload.com/?d=I7RIQMX7
52. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن http://www.megaupload.com/?d=86CHT8YG
53. تحقيق و شرح المفضليات http://www.megaupload.com/?d=JNI6S771
54. تمام المتون بشرح رسالة ابن زيدون http://www.megaupload.com/?d=CV9XGJ6P
55. تيسير الإنشاء http://www.megaupload.com/?d=YVNU45FV
56. جحا الضاحك المضحك http://www.megaupload.com/?d=5NEFYB4M
57. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام http://www.megaupload.com/?d=QWW3M73T
58. جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر http://www.megaupload.com/?d=CDETHOGR
59. جنى الجنتين http://www.megaupload.com/?d=V1DLNZSX
60. جؤنة العطار http://www.megaupload.com/?d=WFIH0EH6
61. حياة قلم للعقاد http://www.megaupload.com/?d=FNCBV1HL
62. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب http://www.megaupload.com/?d=19YZKEPP
63. خواطر كشك http://www.megaupload.com/?d=WLL8BM8O
64. دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة http://www.megaupload.com/?d=DGPEEG0R
65. دراسة في مصادر الأدب http://www.megaupload.com/?d=6FTSG76X
66. ديوان أبي العتاهية http://www.megaupload.com/?d=XQQ8CUZF
67. ديوان أحمد شوقي الشوقيات http://www.megaupload.com/?d=9244OTQM
68. ديوان مهلهل بن ربيعة http://www.megaupload.com/?d=07K1NH7P
69. رجال عرفتهم للعقاد http://www.megaupload.com/?d=WIEAA6ME
70. رجعة أبي العلاء للعقاد http://www.megaupload.com/?d=1XYAHW9J__________________
71. رحله الحج الى بيت الله الحرام الشنقيطي http://www.megaupload.com/?d=LMNKT2KM
72. رسائل الرافعي http://www.megaupload.com/?d=AN48Z5RT
73. سيرة ممهدة للعقاد http://www.megaupload.com/?d=OORCS7RE
74. شرح المعلقات http://www.megaupload.com/?d=3JFUE6YD
75. شرح المعلقات السبع http://www.megaupload.com/?d=8BJYLOT0
76. شرح ديوان زهير بن أبي سلمى http://www.megaupload.com/?d=XZRE9JWA
77. شرح لزوم مالا يلزم http://www.megaupload.com/?d=Y2OCNH61
78. شروح سقط الزند الجزء الثالث http://www.megaupload.com/?d=WYL5M9IE
79. شعراء قتلهم شعرهم http://www.megaupload.com/?d=226ALNFN
80. شعراء مصر http://www.megaupload.com/?d=OXDEH92B
81. صبح الأعشى في كتابة الإنشا http://www.megaupload.com/?d=4H69D4W0
82. عبقرية خالد http://www.megaupload.com/?d=3EVEXKOF
83. فرائد الخرائد في الأمثال http://www.megaupload.com/?d=V6UUH9TT
84. في اللغة والأدب دراسات وبحوث http://www.megaupload.com/?d=I233BU9F
85. قصص الحيوان في القرآن http://www.megaupload.com/?d=AO7ROP32
86. قصص العرب موسوعة تراثية جامعة لقصص ونوادر وطرائف العرب في العصرين الجاهلي والإسلامي http://www.megaupload.com/?d=TONNIH7M
87. قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام http://www.megaupload.com/?d=C8QK8EGG
88. كتاب البرصان و العرجان و العميان و الحولان http://www.megaupload.com/?d=ECSM5ZZ0
89. كتاب القوافي للقاضي أبي يعلى التنوخي http://www.megaupload.com/?d=987PQ2HU
90. لباب الألباب http://www.megaupload.com/?d=K30XJ54Y
91. ليلى والمجنون http://www.megaupload.com/?d=YQ8LVR39
92. مبلغ الأرب في فخر العرب http://www.megaupload.com/?d=BNQE8DWE
93. مجالس العلماء للزجاجي http://www.megaupload.com/?d=9MUXAQLS
94. مجموعة العقاد http://www.megaupload.com/?d=543ANX32
95. مجموعة القصائد الزهديات http://www.megaupload.com/?d=RZUSCT8U
96. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء http://www.megaupload.com/?d=S55VN6OF
97. مشاهير الشعراء العرب المازني http://www.megaupload.com/?d=1BY6GXZ1
98. مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارى http://www.megaupload.com/?d=0FCHMU9S
99. معارك أدبية http://www.megaupload.com/?d=V5Z84DUK
100. معجم أجمل ما كتب شعراء العربية http://www.megaupload.com/?d=OTA05AW7__________________
101. مقالات العلامة الطناحي http://www.megaupload.com/?d=QTFY7W9R
102. مقالات في البلاغة والأدب http://www.megaupload.com/?d=RSI5P54I
104. مقالات في كلمات الجزء الثاني لعلي الطنطاوي http://www.megaupload.com/?d=06LJ3RBU
105. من قصص العرب http://www.megaupload.com/?d=6OHX3WHK
106. موسوعة روائع الشعر العربي http://www.megaupload.com/?d=HYINK26P
107. ميزان الأدب في صناعة شعر العرب http://www.megaupload.com/?d=OLNBEVW5
108. ميزان الذهب في صناعة شعر العرب http://www.megaupload.com/?d=NBQUG6MO
109. نغمة الأغاني في عشرة الأخوان http://www.megaupload.com/?d=BMH86S5L
110. نقطة تفتيش http://www.megaupload.com/?d=T93LE19F
111. وحي القلم http://www.megaupload.com/?d=QNIIX2Z0
كتب شوقي ضيف
http://www.megaupload.com/?d=S2RBXVE7
113. البطولة في الشعر العربي http://www.megaupload.com/?d=VXBJ24IV
114. الرحلات http://www.megaupload.com/?d=Y462MNDK
115. الشعر وطوابعه الأدبية على مر العصور http://www.megaupload.com/?d=WGJX57PE
116. الفن ومذاهبه http://www.megaupload.com/?d=1H2IWJIU
117. تاريخ الأدب العربي6 الشام http://www.megaupload.com/?d=IOJWNQKL
118. تاريخ الأدب العربي 1 العصر الجاهلي http://www.megaupload.com/?d=MA3J60DQ
119. تاريخ الأدب العربي 2 العصر الإسلامي http://www.megaupload.com/?d=ZYXGY00A
120. تاريخ الأدب العربي 10 موريتانيا والمغرب الجزائر تونس http://www.megaupload.com/?d=U52C1FVZ
121. تحريفات العامية للفصحى http://www.megaupload.com/?d=UD9J3KM4
122. تيسيرات لغوية http://www.megaupload.com/?d=G2VBU5K9
123. في التراث والشعر واللغة http://www.megaupload.com/?d=CPXYWM0U
124. مجمع اللغة العربية في خمسين عاما http://www.megaupload.com/?d=XSRHS381
125. محاضرات مجمعية http://www.megaupload.com/?d=SG5V1Y6H
126. من المشرق والمغرب بحوث في الأدب http://www.megaupload.com/?d=UGHUH8QA
كتب الشيخ علي الطنطاوي
http://www.megaupload.com/?d=YTMKCS93
128. بغداد_ذكريات http://www.megaupload.com/?d=I5T2FLE3
129. دمشق صور من جمالها http://www.megaupload.com/?d=UQSLX3SG
130. رجال من التاريخ http://www.megaupload.com/?d=B7LTML56
131. صور من شرق أندونيسيا http://www.megaupload.com/?d=092UYZGC
132. قصتنا مع اليهود http://www.megaupload.com/?d=9HMTVCNJ
133. قصص من التاريخ http://www.megaupload.com/?d=KNKYE4SO
134. من شوارد الشواهد http://www.megaupload.com/?d=ELGKLQDE
135. من نفحات الحرم http://www.megaupload.com/?d=B3BYXL40__________________
136. اسرار البلاغة فى علم البيان http://www.megaupload.com/?d=37UVQB3F
137. اسرار البلاغه لعبد القاهر الجرجانى تعليق محمود شاكر http://www.megaupload.com/?d=5ZTVIS2B
138. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية http://www.megaupload.com/?d=D3YJIDPZ
139. الاستعارة فى النقد الادبى الحديث الابعاد المعرفية والجمالية http://www.megaupload.com/?d=1BXQYUXL
140. الاسس الجمالية للايقاع البلاغى فى العصر العباسى http://www.megaupload.com/?d=XY621RQ9
141. الايضاح في علوم البلاغة المعانى والبيان والبديع http://www.megaupload.com/?d=MFE2DRRK
142. البلاغة تطور وتاريخ http://www.megaupload.com/?d=93SAITNH
143. البلاغة الاصطلاحية لعبده قليقلة http://www.megaupload.com/?d=P4AG8CN9
144. البلاغة الشعرية فى كتاب البيان و التبيين للجاحظ http://www.megaupload.com/?d=SAQETOQ8
145. البلاغة العالية علم المعانى http://www.megaupload.com/?d=49VZP72C
146. البلاغة الواضحة المعاني البيان البديع http://www.megaupload.com/?d=PO7Z7NPM
147. البلاغة والأسلوبية http://www.megaupload.com/?d=1O3KNAVJ
148. البلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب http://www.megaupload.com/?d=QYU9D70H
149. التركيب اللغوي للأدب دراسة فلسفية في اللغة http://www.megaupload.com/?d=6VWQZ4QT
150. التعبير عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=UBWCQ9AK
151. التلخيص في وجوه البلاغة http://www.megaupload.com/?d=WIIRMGEV
152. الفوائد الغياثية في علوم البلاغة http://www.megaupload.com/?d=WHSAPHQ8
153. المجاز المرسل في لسان العرب عند ابن منظور http://www.megaupload.com/?d=QEM0CWPQ
_________________
154. بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة http://www.megaupload.com/?d=PPBG0W2E
155. بلاغة النص http://www.megaupload.com/?d=LKPQ0267
156. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع http://www.megaupload.com/?d=KN0Z8VYA
157. دراسة البلاغة العربية في ضوء النص الأدبي لغير الناطقين http://www.megaupload.com/?d=XPHNUVVE
158. دلائل الإعجاز http://www.megaupload.com/?d=Q7D3W05Y
159. دليل البلاغة الواضحة http://www.megaupload.com/?d=DYOH5AR3
160. شرح التلخيص http://www.megaupload.com/?d=QBTMP1WE
161. علم المعاني دراسة وتحليل http://www.megaupload.com/?d=Z4H473Y7
162. فلسفة البلاغة بين بين التقنية التطور http://www.megaupload.com/?d=JHYY55FA
163. في البلاغة العربية علم البيان http://www.megaupload.com/?d=I8IJ7W7N
164. لباب الآداب http://www.megaupload.com/?d=SG9OE61G
165. للآلئ التبيان في المعاني والبديع والبيان http://www.megaupload.com/?d=WFA2AZH3
166. متن موطأة الفصيح http://www.megaupload.com/?d=Z3BIY0FQ
167. معجم البلاغة العربية عرض ونقض http://www.megaupload.com/?d=H34CE27G
168. مفتاح العلوم للسكاكي http://www.megaupload.com/?d=XZ1S6KGK
169. مملكة البيان لعايض القرني http://www.megaupload.com/?d=UULV9R8D
170. من بلاغة العرب http://www.megaupload.com/?d=HQZV46O8
171. منع جواز المجاز-الشيخ محمد الامين الشنقيطي http://www.megaupload.com/?d=4ILYTEA1
172. موسوعة المصطلح النقدي http://www.megaupload.com/?d=TYC7ICUU
173. الاملاء العربى نشأته و قواعده و مفرداته و تمريناته http://www.megaupload.com/?d=YHTKI11V
174. الإملاء والترقيم في الكتابة العربية http://www.megaupload.com/?d=UUE7HGEX
175. الخطوط العربية http://www.megaupload.com/?d=306A70DM
176. المقصور والممدود لنفطويه http://www.megaupload.com/?d=RJD4PUNK
177. منظومة المقصور والممدود http://www.megaupload.com/?d=TLFQJVV5
178. تعليم الإملاء فى الوطن العربى اسسه وتقويمه وتطويره http://www.megaupload.com/?d=8TK8CV7F
179. الاستدراك على المعاجم العربية http://www.megaupload.com/?d=E31MPPKO
180. التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ الفارسية http://www.megaupload.com/?d=F46RGO8H
181. الصحاح http://www.megaupload.com/?d=ND950YNP
182. المعجم الإسلامي http://www.megaupload.com/?d=OUDJB56C
183. المعجم العربي بين الماضي و الحاضر http://www.megaupload.com/?d=4J21AF79
184. المعجم المفصل فى المذكر والمؤنث http://www.megaupload.com/?d=5L7NARP8
185. المعجم الوافى فى ادوات النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=WLK9WUWO
186. المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=AX87KKKB
187. المعجم الوسيط http://www.megaupload.com/?d=D32A8N4V
188. تاج العروس من جواهر القاموس http://www.megaupload.com/?d=N4LYRPE0
189. تاج اللغة وصحاح العربية http://www.megaupload.com/?d=5GRY3JVG
190. دراسات في المعجم العربى http://www.megaupload.com/?d=FI6GRU2O
191. قاموس المصطلحات في الحضارة الإسلامية http://www.megaupload.com/?d=0Y8IWQA4
192. قاموس رد العامي للفصيح http://www.megaupload.com/?d=H24PPJON
193. كلمات القرآن التي نستعملها http://www.megaupload.com/?d=V9GONIST
194. كناشة النوادر http://www.megaupload.com/?d=WUSS9IJL
195. لسان العرب http://www.megaupload.com/?d=OH3N0J9K
196. متى يتكلم العلم العربية http://www.megaupload.com/?d=TNSSTY1G
197. معجم أعلام المورد http://www.megaupload.com/?d=L34NWZ20
198. معجم الأخطاء الشائعة http://www.megaupload.com/?d=GFFAHXDS
199. معجم الالقاب والاسماء المستعارة فى التاريخ العربى والاسلامى http://www.megaupload.com/?d=HGP0K3H0_
200. معجم ألفاظ القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=T01ANWC3
2. ابن سلام وطبقات الشعراء http://www.megaupload.com/?d=W5SZBI0W
3. أحمد شوقي http://www.megaupload.com/?d=CDXCM5IO
4. أخبار الحمقى والمغفلين http://www.megaupload.com/?d=82Z9LY4G
5. أخبار الظراف والمتماجنين http://www.megaupload.com/?d=6KRI7YEC
6. أدب الإملاء والاستملاء http://www.megaupload.com/?d=U8V00AR5
7. أدب الكاتب http://www.megaupload.com/?d=20Y7993A
8. ادب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العى وتعليم الاعراب وغير ذلك http://www.megaupload.com/?d=OYDUZSQZ
9. أدب الوزير للماوردي http://www.megaupload.com/?d=T7K88QQG
10. أسواق العرب في الجاهلية والإسلام http://www.megaupload.com/?d=RJDUCFD6
11. أصول الشعر العربي http://www.megaupload.com/?d=MXCUQJJ2
12. إعتاب الكتاب لابن الأبار http://www.megaupload.com/?d=TLSRR910
13. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر http://www.megaupload.com/?d=MJXN1WZW
14. الامالي للقالي ويليه الذيل والنوادر وكتاب التنبيه لابي عبيد البكري http://www.megaupload.com/?d=LZAD1MYZ
15. الأمثال العربية والعصر الجاهلي http://www.megaupload.com/?d=UZ3Q2KJ9
16. التطفيل وحكايات الطفيليين http://www.megaupload.com/?d=3E2M2OK3
17. الخطابة و اعداد الخطيب http://www.megaupload.com/?d=REV2W66Y
18. الأمثال للرامهرمزي http://www.megaupload.com/?d=B5MQ5N72
19. البيان والتبيين http://www.megaupload.com/?d=7U48A30O
20. الانشاء السهل http://www.megaupload.com/?d=N2XE49YB
21. البخلاء http://www.megaupload.com/?d=AI442JMU
22. التطفيل والطفيليين http://www.megaupload.com/?d=QP8WUAF8
23. الخطبة العصرية للجمعة والعيدين لأحمد الجمل http://www.megaupload.com/?d=F161PVER
24. الخياميات http://www.megaupload.com/?d=AQAZ777E
25. الدر النضيد في شرح القصيد http://www.megaupload.com/?d=JPEJXUA3
26. الرسائل العباسية في العصر العباسي الأول http://www.megaupload.com/?d=9C04JQQL
27. الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي http://www.megaupload.com/?d=PXLGKYM9
28. الزجاجي حياته وأثره http://www.megaupload.com/?d=RQL7SPRO
29. الشعر والشعراء http://www.megaupload.com/?d=ITKC9G79
30. العبرات للمنفلوطي http://www.megaupload.com/?d=08AP7BDC
31. العثمانية http://www.megaupload.com/?d=UPQFS8TS
32. العقد الفريد http://www.megaupload.com/?d=41KYD5AP
33. ألف قصة وقصة من قصص الصالحين والصالحات http://www.megaupload.com/?d=B5WEAK1G
34. الفخري في الآداب السلطانية http://www.megaupload.com/?d=TG21KDWW
35. القوس العذراء http://www.megaupload.com/?d=Q2E3LXZF
36. الكامل للمبرد http://www.megaupload.com/?d=S0WYJJLZ
37. اللغة الشاعرة http://www.megaupload.com/?d=BH3A56VF
38. المدارس والأنواع الأدبية http://www.megaupload.com/?d=T8OFPJSH
39. المطالع النصرية http://www.megaupload.com/?d=1MYFZVWS
40. المعلقات العشر وأخبار شعرائها http://www.megaupload.com/?d=G72ORD9V
41. المفضليات http://www.megaupload.com/?d=2H0TQS3F
42. المؤتلف والمختلف للآمدي http://www.megaupload.com/?d=3C3HJNT1
43. النابغة الذبياني لمحمد العشماوي http://www.megaupload.com/?d=GABPPQSM
44. النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري http://www.megaupload.com/?d=X7FHO2SK
45. أوجز الكلام http://www.megaupload.com/?d=S51KMTC4
46. باب الهجاء http://www.megaupload.com/?d=ZQ1QP8MI
47. بلال بن جرير وما تبقى من شعره http://www.megaupload.com/?d=7RHJTH82
48. بين أوهام الادعاء العريضة والحقائق الصلبة ل محمد مندور http://www.megaupload.com/?d=YKQSGMGA
__________________
49. تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعى http://www.megaupload.com/?d=2NW9O5OD
50. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان http://www.megaupload.com/?d=UPN9GI8Z
51. تاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف http://www.megaupload.com/?d=I7RIQMX7
52. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن http://www.megaupload.com/?d=86CHT8YG
53. تحقيق و شرح المفضليات http://www.megaupload.com/?d=JNI6S771
54. تمام المتون بشرح رسالة ابن زيدون http://www.megaupload.com/?d=CV9XGJ6P
55. تيسير الإنشاء http://www.megaupload.com/?d=YVNU45FV
56. جحا الضاحك المضحك http://www.megaupload.com/?d=5NEFYB4M
57. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام http://www.megaupload.com/?d=QWW3M73T
58. جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر http://www.megaupload.com/?d=CDETHOGR
59. جنى الجنتين http://www.megaupload.com/?d=V1DLNZSX
60. جؤنة العطار http://www.megaupload.com/?d=WFIH0EH6
61. حياة قلم للعقاد http://www.megaupload.com/?d=FNCBV1HL
62. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب http://www.megaupload.com/?d=19YZKEPP
63. خواطر كشك http://www.megaupload.com/?d=WLL8BM8O
64. دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة http://www.megaupload.com/?d=DGPEEG0R
65. دراسة في مصادر الأدب http://www.megaupload.com/?d=6FTSG76X
66. ديوان أبي العتاهية http://www.megaupload.com/?d=XQQ8CUZF
67. ديوان أحمد شوقي الشوقيات http://www.megaupload.com/?d=9244OTQM
68. ديوان مهلهل بن ربيعة http://www.megaupload.com/?d=07K1NH7P
69. رجال عرفتهم للعقاد http://www.megaupload.com/?d=WIEAA6ME
70. رجعة أبي العلاء للعقاد http://www.megaupload.com/?d=1XYAHW9J__________________
71. رحله الحج الى بيت الله الحرام الشنقيطي http://www.megaupload.com/?d=LMNKT2KM
72. رسائل الرافعي http://www.megaupload.com/?d=AN48Z5RT
73. سيرة ممهدة للعقاد http://www.megaupload.com/?d=OORCS7RE
74. شرح المعلقات http://www.megaupload.com/?d=3JFUE6YD
75. شرح المعلقات السبع http://www.megaupload.com/?d=8BJYLOT0
76. شرح ديوان زهير بن أبي سلمى http://www.megaupload.com/?d=XZRE9JWA
77. شرح لزوم مالا يلزم http://www.megaupload.com/?d=Y2OCNH61
78. شروح سقط الزند الجزء الثالث http://www.megaupload.com/?d=WYL5M9IE
79. شعراء قتلهم شعرهم http://www.megaupload.com/?d=226ALNFN
80. شعراء مصر http://www.megaupload.com/?d=OXDEH92B
81. صبح الأعشى في كتابة الإنشا http://www.megaupload.com/?d=4H69D4W0
82. عبقرية خالد http://www.megaupload.com/?d=3EVEXKOF
83. فرائد الخرائد في الأمثال http://www.megaupload.com/?d=V6UUH9TT
84. في اللغة والأدب دراسات وبحوث http://www.megaupload.com/?d=I233BU9F
85. قصص الحيوان في القرآن http://www.megaupload.com/?d=AO7ROP32
86. قصص العرب موسوعة تراثية جامعة لقصص ونوادر وطرائف العرب في العصرين الجاهلي والإسلامي http://www.megaupload.com/?d=TONNIH7M
87. قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام http://www.megaupload.com/?d=C8QK8EGG
88. كتاب البرصان و العرجان و العميان و الحولان http://www.megaupload.com/?d=ECSM5ZZ0
89. كتاب القوافي للقاضي أبي يعلى التنوخي http://www.megaupload.com/?d=987PQ2HU
90. لباب الألباب http://www.megaupload.com/?d=K30XJ54Y
91. ليلى والمجنون http://www.megaupload.com/?d=YQ8LVR39
92. مبلغ الأرب في فخر العرب http://www.megaupload.com/?d=BNQE8DWE
93. مجالس العلماء للزجاجي http://www.megaupload.com/?d=9MUXAQLS
94. مجموعة العقاد http://www.megaupload.com/?d=543ANX32
95. مجموعة القصائد الزهديات http://www.megaupload.com/?d=RZUSCT8U
96. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء http://www.megaupload.com/?d=S55VN6OF
97. مشاهير الشعراء العرب المازني http://www.megaupload.com/?d=1BY6GXZ1
98. مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارى http://www.megaupload.com/?d=0FCHMU9S
99. معارك أدبية http://www.megaupload.com/?d=V5Z84DUK
100. معجم أجمل ما كتب شعراء العربية http://www.megaupload.com/?d=OTA05AW7__________________
101. مقالات العلامة الطناحي http://www.megaupload.com/?d=QTFY7W9R
102. مقالات في البلاغة والأدب http://www.megaupload.com/?d=RSI5P54I
104. مقالات في كلمات الجزء الثاني لعلي الطنطاوي http://www.megaupload.com/?d=06LJ3RBU
105. من قصص العرب http://www.megaupload.com/?d=6OHX3WHK
106. موسوعة روائع الشعر العربي http://www.megaupload.com/?d=HYINK26P
107. ميزان الأدب في صناعة شعر العرب http://www.megaupload.com/?d=OLNBEVW5
108. ميزان الذهب في صناعة شعر العرب http://www.megaupload.com/?d=NBQUG6MO
109. نغمة الأغاني في عشرة الأخوان http://www.megaupload.com/?d=BMH86S5L
110. نقطة تفتيش http://www.megaupload.com/?d=T93LE19F
111. وحي القلم http://www.megaupload.com/?d=QNIIX2Z0
كتب شوقي ضيف
http://www.megaupload.com/?d=S2RBXVE7
113. البطولة في الشعر العربي http://www.megaupload.com/?d=VXBJ24IV
114. الرحلات http://www.megaupload.com/?d=Y462MNDK
115. الشعر وطوابعه الأدبية على مر العصور http://www.megaupload.com/?d=WGJX57PE
116. الفن ومذاهبه http://www.megaupload.com/?d=1H2IWJIU
117. تاريخ الأدب العربي6 الشام http://www.megaupload.com/?d=IOJWNQKL
118. تاريخ الأدب العربي 1 العصر الجاهلي http://www.megaupload.com/?d=MA3J60DQ
119. تاريخ الأدب العربي 2 العصر الإسلامي http://www.megaupload.com/?d=ZYXGY00A
120. تاريخ الأدب العربي 10 موريتانيا والمغرب الجزائر تونس http://www.megaupload.com/?d=U52C1FVZ
121. تحريفات العامية للفصحى http://www.megaupload.com/?d=UD9J3KM4
122. تيسيرات لغوية http://www.megaupload.com/?d=G2VBU5K9
123. في التراث والشعر واللغة http://www.megaupload.com/?d=CPXYWM0U
124. مجمع اللغة العربية في خمسين عاما http://www.megaupload.com/?d=XSRHS381
125. محاضرات مجمعية http://www.megaupload.com/?d=SG5V1Y6H
126. من المشرق والمغرب بحوث في الأدب http://www.megaupload.com/?d=UGHUH8QA
كتب الشيخ علي الطنطاوي
http://www.megaupload.com/?d=YTMKCS93
128. بغداد_ذكريات http://www.megaupload.com/?d=I5T2FLE3
129. دمشق صور من جمالها http://www.megaupload.com/?d=UQSLX3SG
130. رجال من التاريخ http://www.megaupload.com/?d=B7LTML56
131. صور من شرق أندونيسيا http://www.megaupload.com/?d=092UYZGC
132. قصتنا مع اليهود http://www.megaupload.com/?d=9HMTVCNJ
133. قصص من التاريخ http://www.megaupload.com/?d=KNKYE4SO
134. من شوارد الشواهد http://www.megaupload.com/?d=ELGKLQDE
135. من نفحات الحرم http://www.megaupload.com/?d=B3BYXL40__________________
136. اسرار البلاغة فى علم البيان http://www.megaupload.com/?d=37UVQB3F
137. اسرار البلاغه لعبد القاهر الجرجانى تعليق محمود شاكر http://www.megaupload.com/?d=5ZTVIS2B
138. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية http://www.megaupload.com/?d=D3YJIDPZ
139. الاستعارة فى النقد الادبى الحديث الابعاد المعرفية والجمالية http://www.megaupload.com/?d=1BXQYUXL
140. الاسس الجمالية للايقاع البلاغى فى العصر العباسى http://www.megaupload.com/?d=XY621RQ9
141. الايضاح في علوم البلاغة المعانى والبيان والبديع http://www.megaupload.com/?d=MFE2DRRK
142. البلاغة تطور وتاريخ http://www.megaupload.com/?d=93SAITNH
143. البلاغة الاصطلاحية لعبده قليقلة http://www.megaupload.com/?d=P4AG8CN9
144. البلاغة الشعرية فى كتاب البيان و التبيين للجاحظ http://www.megaupload.com/?d=SAQETOQ8
145. البلاغة العالية علم المعانى http://www.megaupload.com/?d=49VZP72C
146. البلاغة الواضحة المعاني البيان البديع http://www.megaupload.com/?d=PO7Z7NPM
147. البلاغة والأسلوبية http://www.megaupload.com/?d=1O3KNAVJ
148. البلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب http://www.megaupload.com/?d=QYU9D70H
149. التركيب اللغوي للأدب دراسة فلسفية في اللغة http://www.megaupload.com/?d=6VWQZ4QT
150. التعبير عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=UBWCQ9AK
151. التلخيص في وجوه البلاغة http://www.megaupload.com/?d=WIIRMGEV
152. الفوائد الغياثية في علوم البلاغة http://www.megaupload.com/?d=WHSAPHQ8
153. المجاز المرسل في لسان العرب عند ابن منظور http://www.megaupload.com/?d=QEM0CWPQ
_________________
154. بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة http://www.megaupload.com/?d=PPBG0W2E
155. بلاغة النص http://www.megaupload.com/?d=LKPQ0267
156. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع http://www.megaupload.com/?d=KN0Z8VYA
157. دراسة البلاغة العربية في ضوء النص الأدبي لغير الناطقين http://www.megaupload.com/?d=XPHNUVVE
158. دلائل الإعجاز http://www.megaupload.com/?d=Q7D3W05Y
159. دليل البلاغة الواضحة http://www.megaupload.com/?d=DYOH5AR3
160. شرح التلخيص http://www.megaupload.com/?d=QBTMP1WE
161. علم المعاني دراسة وتحليل http://www.megaupload.com/?d=Z4H473Y7
162. فلسفة البلاغة بين بين التقنية التطور http://www.megaupload.com/?d=JHYY55FA
163. في البلاغة العربية علم البيان http://www.megaupload.com/?d=I8IJ7W7N
164. لباب الآداب http://www.megaupload.com/?d=SG9OE61G
165. للآلئ التبيان في المعاني والبديع والبيان http://www.megaupload.com/?d=WFA2AZH3
166. متن موطأة الفصيح http://www.megaupload.com/?d=Z3BIY0FQ
167. معجم البلاغة العربية عرض ونقض http://www.megaupload.com/?d=H34CE27G
168. مفتاح العلوم للسكاكي http://www.megaupload.com/?d=XZ1S6KGK
169. مملكة البيان لعايض القرني http://www.megaupload.com/?d=UULV9R8D
170. من بلاغة العرب http://www.megaupload.com/?d=HQZV46O8
171. منع جواز المجاز-الشيخ محمد الامين الشنقيطي http://www.megaupload.com/?d=4ILYTEA1
172. موسوعة المصطلح النقدي http://www.megaupload.com/?d=TYC7ICUU
173. الاملاء العربى نشأته و قواعده و مفرداته و تمريناته http://www.megaupload.com/?d=YHTKI11V
174. الإملاء والترقيم في الكتابة العربية http://www.megaupload.com/?d=UUE7HGEX
175. الخطوط العربية http://www.megaupload.com/?d=306A70DM
176. المقصور والممدود لنفطويه http://www.megaupload.com/?d=RJD4PUNK
177. منظومة المقصور والممدود http://www.megaupload.com/?d=TLFQJVV5
178. تعليم الإملاء فى الوطن العربى اسسه وتقويمه وتطويره http://www.megaupload.com/?d=8TK8CV7F
179. الاستدراك على المعاجم العربية http://www.megaupload.com/?d=E31MPPKO
180. التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ الفارسية http://www.megaupload.com/?d=F46RGO8H
181. الصحاح http://www.megaupload.com/?d=ND950YNP
182. المعجم الإسلامي http://www.megaupload.com/?d=OUDJB56C
183. المعجم العربي بين الماضي و الحاضر http://www.megaupload.com/?d=4J21AF79
184. المعجم المفصل فى المذكر والمؤنث http://www.megaupload.com/?d=5L7NARP8
185. المعجم الوافى فى ادوات النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=WLK9WUWO
186. المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=AX87KKKB
187. المعجم الوسيط http://www.megaupload.com/?d=D32A8N4V
188. تاج العروس من جواهر القاموس http://www.megaupload.com/?d=N4LYRPE0
189. تاج اللغة وصحاح العربية http://www.megaupload.com/?d=5GRY3JVG
190. دراسات في المعجم العربى http://www.megaupload.com/?d=FI6GRU2O
191. قاموس المصطلحات في الحضارة الإسلامية http://www.megaupload.com/?d=0Y8IWQA4
192. قاموس رد العامي للفصيح http://www.megaupload.com/?d=H24PPJON
193. كلمات القرآن التي نستعملها http://www.megaupload.com/?d=V9GONIST
194. كناشة النوادر http://www.megaupload.com/?d=WUSS9IJL
195. لسان العرب http://www.megaupload.com/?d=OH3N0J9K
196. متى يتكلم العلم العربية http://www.megaupload.com/?d=TNSSTY1G
197. معجم أعلام المورد http://www.megaupload.com/?d=L34NWZ20
198. معجم الأخطاء الشائعة http://www.megaupload.com/?d=GFFAHXDS
199. معجم الالقاب والاسماء المستعارة فى التاريخ العربى والاسلامى http://www.megaupload.com/?d=HGP0K3H0_
200. معجم ألفاظ القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=T01ANWC3
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 17:34|
201. معجم الكيمياء والصيدلة الصادر من مجمع اللغة
العربية http://www.megaupload.com/?d=KA7FNACW
202. معجم المصطلحات والالقاب التاريخية http://www.megaupload.com/?d=D3VGC3B2
203. معجم الهيدرولوجيا http://www.megaupload.com/?d=728R0BPR
204. معجم فصاح العامية http://www.megaupload.com/?d=6KH2PVST
205. معجم قواعد اللغة العربية فى جداول ولوحات http://www.megaupload.com/?d=E1BQNJFJ
206. معجم مقيدات ابن خلكان http://www.megaupload.com/?d=FC23S6S0
207. معركه المصطلحات بين الغرب و الاسلام http://www.megaupload.com/?d=5CXT609M
208. نشأة المعاجم اللغوية وتطورها http://www.megaupload.com/?d=UKRI28VR
209. ابن هشام النحوي 708-761ه عصره, بيئته, فكره, مؤلفاته, منهجه ومكانته في النحو http://www.megaupload.com/?d=W02BCUVV
210. ابن هشام و اثره فى النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=WDMU8BZ0
211. ابن يعيش النحوى دراسة http://www.megaupload.com/?d=AVG6YYL7
212. أبنية الأسماء والأفعال والمصادر http://www.megaupload.com/?d=F90KRFVM
213. ابنية الافعال دراسة لغوية قرآنية http://www.megaupload.com/?d=JQR42DEZ
214. ابو القاسم السهيلى و مذهبة النحوى http://www.megaupload.com/?d=MV92US5V
215. اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات اللغوية http://www.megaupload.com/?d=N74OLRWT
216. اثر القراءات فى الاصوات والنحو العربى - ابوعمرو بن العلاء http://www.megaupload.com/?d=4PPL2F09
217. إحياء النحو http://www.megaupload.com/?d=20EADY8A
218. أخبار المصحفين http://www.megaupload.com/?d=DVGBTTMM
219. أسرار العربية http://www.megaupload.com/?d=KB1A8HPW
220. اسلوب اذ فى ضوء الدراسات القرآنية و النحوية http://www.megaupload.com/?d=VFH5GLY7
221. اشتقاق الاسماء http://www.megaupload.com/?d=B15EOEKA
222. أصالة الإعراب ودلالته على المعنى http://www.megaupload.com/?d=PM80L4GA
223. اصول النحو العربى فى نظر النحاة و رأى ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث http://www.megaupload.com/?d=6LK3ZJ98
224. اعراب الجمل واشباه الجمل - شوقي المعري http://www.megaupload.com/?d=7BJFP8KK
225. اعراب الجمل واشباه الجمل - قباوة ,فخر الدين http://www.megaupload.com/?d=6CWJRV26
226. الأساليب الإنشائية في النحو العربي http://www.megaupload.com/?d=LTR32H6N
227. الاستدلال بالاحاديث النبوية الشريفة على اثبات القواعد النحوية http://www.megaupload.com/?d=S5MQSEUO، http://www.megaupload.com/?d=X7G17DQI
228. الاسس النحوية والاملائية فى اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=5MFXTWM1
229. الاسلوب و النحو دراسة تطبيقية فى علاقة الخصائص الأسلوبية ببعض الظاهرات النحوية http://www.megaupload.com/?d=RKA53EW2
230. الأسلوب والنحو http://www.megaupload.com/?d=SUZFBCDC
231. الاسم و الصفة فى النحو العربى والدراسات الاوروبية http://www.megaupload.com/?d=DD0J1GMJ
232. الاشباه والنظائر فى النحو http://www.megaupload.com/?d=HJPE3FD8
233. الأشتقاق http://www.megaupload.com/?d=N30AX1KY
234. الاشتقاق - ابن دريد -- طبعة ألمانيا 1854 http://www.megaupload.com/?d=0Y8MQY7W
235. الاصول فى النحو http://www.megaupload.com/?d=8LUN4UAT
236. الإعراب الميسر والنحو http://www.megaupload.com/?d=C8BTMI9Z
237. الإعراب الواضح http://www.megaupload.com/?d=RJWM3KUV
238. الاعراب الواضح مع تطبيقات عروضية و بلاغية http://www.megaupload.com/?d=9U2EHG4T
239. الاعراب و التركيب بين الشكل و النسبة دراسة تفسيرية http://www.megaupload.com/?d=OTNHW7A5
240. الافعال العربية الشاذة http://www.megaupload.com/?d=VGUAODLV
241. الافعال غير المتصرفة و شبه المتصرفة http://www.megaupload.com/?d=L0WEUS8M
242. الاقتضاب فى غريب الموطأ و اعرابه على الابواب http://www.megaupload.com/?d=6YLZP4L2
243. الالغاز النحوية http://www.megaupload.com/?d=920WSDAY
244. الانشاء الواضح اجود الانشاء فصاحة فى التعبير و وضوح فى التفكير وجمال فى التصوير http://www.megaupload.com/?d=CQJTM7KM
245. البلاغة الاصطلاحية http://www.megaupload.com/?d=Q9IWKQ1B
246. البلاغة العربية فى ضوء منهج متكامل http://www.megaupload.com/?d=1M6A48N5
247. التدريبات اللغوية فى النحو والصرف والاخطاء الشائعة http://www.megaupload.com/?d=2TAMX6GN
248. التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر http://www.megaupload.com/?d=APQW424L
249. التطبيق النحوى http://www.megaupload.com/?d=3ZOIDWC4
250. التطبيق فى الاعراب والصرف http://www.megaupload.com/?d=1WMIN5NM
251. التطور النحوى للغة العربية http://www.megaupload.com/?d=TIW9OCHH
252. التنوير فى تيسير التيسير فى النحو وفق المنهج المقرر على الصف الاول الاعدادى http://www.megaupload.com/?d=9R6MKOIW http://www.megaupload.com/?d=N0A0A67A
253. الجمل في النحو http://www.megaupload.com/?d=WQJ8FN08
254. الجنى الدانى فى حروف المعانى http://www.megaupload.com/?d=6928GGEV
255. الحسن والإحسان فيما خلا عنه اللسان http://www.megaupload.com/?d=CL7L0EN7
256. الحقول الدلالية الصرفية للافعال العربية http://www.megaupload.com/?d=2EX9AMZB
257. الحلقة المفقودة فى تاريخ النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=T5Q9A9LK
258. السير الحثيث http://www.megaupload.com/?d=R1RKISL3
259. الشافية في علم التصريف http://www.megaupload.com/?d=NNPNWOJJ
260. الضمائر المنعكسة في اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=ID9CWVX0
261. العربية للصيداوي http://www.megaupload.com/?d=NFBHOMWT
262. العمد كتاب في التصريف http://www.megaupload.com/?d=KM1RWSY9
263. العين للخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي http://www.megaupload.com/?d=0UHCNDR0
264. ألفية ابن مالك http://www.megaupload.com/?d=0CABTUE0
265. ألفية ابن مالك في النحو طبعة 1833 http://www.megaupload.com/?d=2HWQQQ10
266. القواعد الأساسية في النحو والصرف لطلاب المرحلة الثانوية http://www.megaupload.com/?d=U6S5SEH0
267. القواعد الأساسية للغة العربية http://www.megaupload.com/?d=EAOZ15SS
268. القواعد الثلاثون في علم العربية http://www.megaupload.com/?d=6VJNJWW4
269. الكتاب لسيبويه http://www.megaupload.com/?d=IAVAH38N
270. اللغة العربية أداء ونطقا وإملاء وكتابة http://www.megaupload.com/?d=CL6VSHS0
271. اللغة العربية أصل اللغات كلها http://www.megaupload.com/?d=WU8PE85K
272. اللغة بين المعيارية واللوصفية http://www.megaupload.com/?d=WM4NZR3T
273. اللؤلؤة في علم العربية http://www.megaupload.com/?d=TL5M5YB6
274. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر_ابن الأثير http://www.megaupload.com/?d=1226HFIE
275. المحكم والمحيط الأعظم http://www.megaupload.com/?d=XC9X6GD0
276. استرجاع المعلومات في اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=9VPU0D0X
277. المختار فى القواعد والاعراب http://www.megaupload.com/?d=96BVOKDR
278. المختصر فى النحو والاملاء والترقيم http://www.megaupload.com/?d=OVROS76O
279. المدارس النحوية http://www.megaupload.com/?d=5LRF5FRC
280. المدارس النحوية أسطورة وواقع http://www.megaupload.com/?d=GXAEHK06
281. المدخل الصرفى تطبيق وتدريب فى الصرف العربى http://www.megaupload.com/?d=QH7PYY55
282. المدخل النحوى تطبيق وتدريب فى النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=70SNBFHD
283. المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين http://www.megaupload.com/?d=GI9GGWOK
284. المصطلح الصرفى مميزات التذكير والتأنيث http://www.megaupload.com/?d=AXO9556X
285. المصطلح النحوى نشأتة وتطوره حتى اواخر القرن الثالث الهجرى http://www.megaupload.com/?d=VT2LW97G
286. المصطلح النحوي دراسة نقدية تحليلية http://www.megaupload.com/?d=BAJPUU3L
287. المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=534DGQTO
288. المعجم المفصل في علم الصرف http://www.megaupload.com/?d=1TL1LKYN
289. المقدمة الجزولية فى النحو http://www.megaupload.com/?d=SFXQGNPR
290. الممنوع من الصرف فى اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=DGWHRQ36
291. المنجد فى الاعراب والبلاغة والاملاء تطبيقات وقاعدات http://www.megaupload.com/?d=8RA1NMJH
292. المنظومة النحوية المنسوبة الى الخليل بن احمد الفراهيدى http://www.megaupload.com/?d=OL8EXCO5
293. المنظومة النحوية دراسة تحليلية http://www.megaupload.com/?d=1Q5NNIHG
294. الموجز في قواعد اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=MB5K73AJ
295. النحو الأساسي http://www.megaupload.com/?d=KEENIFU3
296. النحو الشافي http://www.megaupload.com/?d=Z7MURQ2T
297. النحو العصرى http://www.megaupload.com/?d=FIHVMEGT
298. النحو العصري http://www.megaupload.com/?d=RT73GN7F
299. النحو المنهجى http://www.megaupload.com/?d=JD6TFP5D
300. النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية http://www.megaupload.com/?d=OUPLYN46
301. النحو الوافي http://www.megaupload.com/?d=9635MEBP
302. النحو في ظلال القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=35K14QW1
303. الورد الصافي http://www.megaupload.com/?d=SWBSRG9F
304. بحوث ومقالات http://www.megaupload.com/?d=BMCBQC0S
305. تطور الآراء النحوية عند ابن هشام الانصارى http://www.megaupload.com/?d=7J8MG2IG
306. تقويم اللسان لابن الجوزي http://www.megaupload.com/?d=ER2EFF9U
307. جامع الدروس العربية http://www.megaupload.com/?d=J7MD3XHW
308. دليل السالك شرح ألفية ابن مالك http://www.megaupload.com/?d=VN2B7JPO
309. سلم اللسان في النحو والصرف والبيان http://www.megaupload.com/?d=9OEATN7Z
310. شذا العرف في فن الصرف http://www.megaupload.com/?d=FGOL7UEI
311. شرح ابن عقيل - ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل http://www.megaupload.com/?d=J7NEX3M0
312. شرح الشيخ حسن الكفراوي على متن الاجرومية http://www.megaupload.com/?d=1PBQ369I
313. شرح العلامة الشيخ حسن الكفراوي على الأجرومية http://www.megaupload.com/?d=UKUAHMP8
314. شرح القصيدة الكافية في التصريف http://www.megaupload.com/?d=46VWDTT5
315. شرح المفصل http://www.megaupload.com/?d=UFZBT9OV
316. شرح المكودى على الالفية فى علمى الصرف والنحو http://www.megaupload.com/?d=N7X48270
317. شرح المكودى على الفية ابن مالك http://www.megaupload.com/?d=A7UUCMT6
318. شرح حسن الكفراوى على متن الاجرومية فى علم النحو http://www.megaupload.com/?d=N5DI5FIQ
319. شرح قصيدة الكافية في التصريف http://www.megaupload.com/?d=IUDQVC1C
320. شرح قواعد الاعراب لابن هشام http://www.megaupload.com/?d=G19IWW92
321. شرح كتاب الحدود في النحو http://www.megaupload.com/?d=V82ZYSJU
322. شرح مختصر التصريف العزى فى فن الصرف http://www.megaupload.com/?d=E16TFVTO
323. شرح ملحة الاعراب http://www.megaupload.com/?d=TYSABFVV
324. شرح منظومة الالغاز النحوية للملا عصام الاسفراييني http://www.megaupload.com/?d=EUBF28UW
325. ظاهرة الاعراب فى النحو العربى وتطبيقها فى القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=5Z8W5UY0
326. ظاهرة التخفيف فى النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=GXORGXON
327. ظاهرة المجاورة فى الدراسات النحوية وموقعها فى القران الكريم http://www.megaupload.com/?d=WYS09L5C
328. علم نفسك الخطوط العربية http://www.megaupload.com/?d=0CPQ2FQ0
329. عناصر النظرية النحوية فى كتاب سيبويه محاولة لاعادة التشكيل فى ضوء الاتجاه المعجمى الوظيفيى http://www.megaupload.com/?d=DTOPRKCH
330. عنوان الشرف الوافى فى علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافى http://www.megaupload.com/?d=JE65LROA
331. فضل العرب و التنبيه على علومها http://www.megaupload.com/?d=2PV448LJ
332. فهارس كتاب الاصول فى النحو http://www.megaupload.com/?d=2NFR4XAO
333. فى ادلة النحو http://www.megaupload.com/?d=EE1WA6HH
334. في أصول النحو http://www.megaupload.com/?d=SFRBLQSR
335. في التطبيق النحوي والصرفي http://www.megaupload.com/?d=XH06KCGB
336. في علم اللغة لطليمات http://www.megaupload.com/?d=PMOZO6KO
337. قواعد الإملاء العربي http://www.megaupload.com/?d=ZXZHO2YH
338. قواعد تحويلية للغة العربية http://www.megaupload.com/?d=O63JHREL
339. كتاب الاصول الوافية الموسومة بانوار الربيع في الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع http://www.megaupload.com/?d=UC0K88TV
340. كتاب الأصول في النحو لابن السراج (وفهارسه للطناحي http://www.megaupload.com/?d=E8E1KJ4M
341. كتاب الأوائل http://www.megaupload.com/?d=G6YHJ7KO
342. كتاب الجمل فى النحو المنسوب للخليل بن احمد دراسة تحليلية http://www.megaupload.com/?d=M3Y871DU
343. كتاب العين http://www.megaupload.com/?d=B8FWWLOK
344. كتاب العين مرتباً على حروف المعجم http://www.megaupload.com/?d=WHYT1JHN
345. كيف تكون فصيحا http://www.megaupload.com/?d=BFHQ2SJE
346. لغة القران الكريم فى سورة النور دراسة فى التركيب النحوى http://www.megaupload.com/?d=LM8XVTQN
347. ما ينصرف وما لا ينصرف http://www.megaupload.com/?d=KOHKDQA2
348. مدارس النحاة البصريين والبغداديين http://www.megaupload.com/?d=I6M3PZ9I
349. مراكز الدراسات النحوية http://www.megaupload.com/?d=HDE8A6R0
350. مسألة خلافية في النحو http://www.megaupload.com/?d=UOFPVJV1
351. مسائل خلافية http://www.megaupload.com/?d=Z35QC9HA
352. مصنفات اللحن و التثقيف اللغوي http://www.megaupload.com/?d=CEVIZJWC
353. معين الطلاب فى قواعد النحو والاعراب http://www.megaupload.com/?d=C27FAMGQ
354. ملخص قواعد اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=NGA84E5P
355. منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني http://www.megaupload.com/?d=U20HWUCX
356. نتائج الفكر فى النحو http://www.megaupload.com/?d=CH932EMT
357. نحو اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=UP1AJ4KY
358. نحو اللغة العربية كتاب فى قواعد النحو والصرف مفصلة موثقة مؤيدة بالشواهد والامثلة http://www.megaupload.com/?d=EGGU2RTU
359. نشأة النحو وأشهر النحاة http://www.megaupload.com/?d=KZZZZ6YJ
360. نصوص عربية نصوص ومراجعات وتدريبات فى النحو والاملاء http://www.megaupload.com/?d=8H0ZRNDY
361. نصوص ومسائل نحوية وصرفية http://www.megaupload.com/?d=2FBYRRJ8
362. نظم مثلث قطرب http://www.megaupload.com/?d=6OK6A299
362. هداية الطالب قسم الصرف http://www.megaupload.com/?d=ERTVLBAM
363. أقرب المقاصد في شرح القواعد الصغرى في النحو لابن هشام الأنصاري http://www.megaupload.com/?d=5TZKL7G0
364. الإهمال في النحو العربي http://www.megaupload.com/?d=PC6RXIRH
365. الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهم http://www.megaupload.com/?d=2HITSWK8
366. المقصد الجليل في علم الخليل لابن الحاجب http://www.megaupload.com/?d=L6LBQGXT
367. الوظيفة الدلاليّة في ضوء مناهج اللسانيات http://www.megaupload.com/?d=64QNTRY0
368. تأملات في كتاب الخاطريات http://www.megaupload.com/?d=ZTP65U5H
369. جماليات تحوُّل الوحدة الصرفيَّة لدى النُّحاة والبلاغيين http://www.megaupload.com/?d=0V35TX9U
370. حاشية الحموي على شرح قواعد الإعراب لابن هشام http://www.megaupload.com/?d=3Y6WE3GR
371. دور التنغيم في تحديد معنى الجملة العربية http://www.megaupload.com/?d=Q2591OZG
372. ديوان أوس بن حجر تحقيق ونقد http://www.megaupload.com/?d=7D82757D
373. رسالة فهرست مؤلفاتي في علوم اللغة السيوطي http://www.megaupload.com/?d=8G7DJD50
374. شرح جمل الزجاجي ابن خروف http://www.megaupload.com/?d=Q40GT9XE
375. شرح ديوان رؤبة بن العجاج http://www.megaupload.com/?d=0WAAIJV1
376. شعر ابن رواحة الحموي الشاعر http://www.megaupload.com/?d=RXO4UGDU
377. صورة الذات المتفردة في شعر الفتوحات http://www.megaupload.com/?d=W3QS3OE3
378. ظاهرة العذل في شعر حاتم الطائي http://www.megaupload.com/?d=8LWEC71R
379. فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي http://www.megaupload.com/?d=NBCOQYW5
380. في سبيل منحى لساني براغماتي تداولي للترجمة http://www.megaupload.com/?d=VECCOW3O
381. معلقة عمرو بن كلثوم دراسة وتحليلاً http://www.megaupload.com/?d=42OQVUPO
382. موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد http://www.megaupload.com/?d=OP43QNIW
383. وسائل التعريف في مسائل التصريف لبدر الدين العيني http://www.megaupload.com/?d=BOFSTYKC
384. اتحاد المجامع اللغوية العربية في خمس عشرة سنة http://www.megaupload.com/?d=SPAKNJ61
385. أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب و الاذاعيين http://www.megaupload.com/?d=YGO72QJT
386. أسباب حدوث الحروف http://www.megaupload.com/?d=IYZX7UIA
387. استخدامات الحروف العربية - معجميا, صوتيا, صرفيا, نحويا, كتابيا http://www.megaupload.com/?d=PW1HDEEG
388. اسرار الحروف http://www.megaupload.com/?d=LNFPVC9Q
389. الأداء الصوتي في العربية http://www.megaupload.com/?d=GIZH7LB7
390. الأضداد في كلام العرب http://www.megaupload.com/?d=Z43LQQAY
391. الألسنة التحليلية والتوليدية http://www.megaupload.com/?d=XPQDB626
392. الالسنيه والتوليديه والتحويليه وقواعد اللغه العربيه (الجمله البسيطه http://www.megaupload.com/?d=A5ES9HVY
393. الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى http://www.megaupload.com/?d=VP3Q7R5I
394. الدلالة الصوتية والصرفية فى لهجة الاقليم الشمالى http://www.megaupload.com/?d=JV18BNOR
395. اللغة العربية بين المعيارية والوصفية http://www.megaupload.com/?d=O42L84KV
396. اللغة واللون http://www.megaupload.com/?d=8DA94B9S
397. علم الدلالة http://www.megaupload.com/?d=4AS0XEA8
398. لغة قريش http://www.megaupload.com/?d=EBAFCPMN
399. ما اختلفت ألفاظه و اتفقت معانيه للأصمعي http://www.megaupload.com/?d=E27MI427
400. مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما http://www.megaupload.com/?d=Y2XTJ301
401. مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع http://www.megaupload.com/?d=QJ7L698G
402. من حاضر اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=P6C2MQOD
403. من قضايا اللغة http://www.megaupload.com/?d=LBJ65OLR
404. مجلة مجمع اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=HFUIHLSG
405. أثر اللغة في اختلاف المجتهدين http://www.megaupload.com/?d=GNDLM5K6
406. أبدع الأساليب في إنشاء الرسائل والمكاتيب http://www.megaupload.com/?d=L91F59VB
407. الآدب الاسلامي بين النظرية والتطبيق http://www.megaupload.com/?d=6TVAAVEM
408. آدب الأطفال في العالم المعاصر http://www.megaupload.com/?d=MKOV7ZEG
409. الأدب العربي بين البادية والحضر http://www.megaupload.com/?d=GKCJOES4
410. شرح أدب القاضي للخصاف http://www.megaupload.com/?d=L1NNOQXX
411. أدب القاضي 1-2 http://www.megaupload.com/?d=USZUA7YH
412. أرتشاف الضرب من لسان العرب http://www.megaupload.com/?d=AMM0UO7K
413. الاسلام والشعر http://www.megaupload.com/?d=SF924D33
414. أسلوب الإستفهام في القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=5KKFCP2L
415. اعراب الحديث النبوي_ - ابو البقاء العكبري - تحقيق عبد الاله نبهان http://www.megaupload.com/?d=EGJVPY3A
416. إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية http://www.megaupload.com/?d=QOJ473IU
417. إعراب جزء قد سَمِعَ http://www.megaupload.com/?d=QMTH1JNX
418. الأعلام الممنوعة من الصرف في القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=QZDUMRLB
419. الإعلام بمثلث الكلام http://www.megaupload.com/?d=JJ2WHS1F
420. الأغاني http://www.megaupload.com/?d=O07796DE
421. الأغاني للأصفهاني http://www.megaupload.com/?d=9PTO3KTO
422. الامالي لابن الشجري http://www.megaupload.com/?d=3UA9A1V5
423. الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي http://www.megaupload.com/?d=BI8ZS6BE
424. الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله 1-3 http://www.megaupload.com/?d=UXEGLP1O
425. الأمثال في الحديث النبوي http://www.megaupload.com/?d=F4BI6NZJ
426. الأمثال في القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=RBPSXQ7Q
427. أمالي السهيلي http://www.megaupload.com/?d=T39CXV7J
428. أمالي الشريف المرتضى http://www.megaupload.com/?d=3JEMOIW6
429. تجريد الأغاني 1-3 http://www.megaupload.com/?d=G1AFLZO3
430. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك http://www.megaupload.com/?d=UNBL5OJ4
431. دليل السالك إلى ألفية ابن مالك- عبدالله الفوزان http://www.megaupload.com/?d=OOPEAOSE
432. مجمع الأمثال 1 - 2 http://www.megaupload.com/?d=UHQUIVZA
202. معجم المصطلحات والالقاب التاريخية http://www.megaupload.com/?d=D3VGC3B2
203. معجم الهيدرولوجيا http://www.megaupload.com/?d=728R0BPR
204. معجم فصاح العامية http://www.megaupload.com/?d=6KH2PVST
205. معجم قواعد اللغة العربية فى جداول ولوحات http://www.megaupload.com/?d=E1BQNJFJ
206. معجم مقيدات ابن خلكان http://www.megaupload.com/?d=FC23S6S0
207. معركه المصطلحات بين الغرب و الاسلام http://www.megaupload.com/?d=5CXT609M
208. نشأة المعاجم اللغوية وتطورها http://www.megaupload.com/?d=UKRI28VR
209. ابن هشام النحوي 708-761ه عصره, بيئته, فكره, مؤلفاته, منهجه ومكانته في النحو http://www.megaupload.com/?d=W02BCUVV
210. ابن هشام و اثره فى النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=WDMU8BZ0
211. ابن يعيش النحوى دراسة http://www.megaupload.com/?d=AVG6YYL7
212. أبنية الأسماء والأفعال والمصادر http://www.megaupload.com/?d=F90KRFVM
213. ابنية الافعال دراسة لغوية قرآنية http://www.megaupload.com/?d=JQR42DEZ
214. ابو القاسم السهيلى و مذهبة النحوى http://www.megaupload.com/?d=MV92US5V
215. اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات اللغوية http://www.megaupload.com/?d=N74OLRWT
216. اثر القراءات فى الاصوات والنحو العربى - ابوعمرو بن العلاء http://www.megaupload.com/?d=4PPL2F09
217. إحياء النحو http://www.megaupload.com/?d=20EADY8A
218. أخبار المصحفين http://www.megaupload.com/?d=DVGBTTMM
219. أسرار العربية http://www.megaupload.com/?d=KB1A8HPW
220. اسلوب اذ فى ضوء الدراسات القرآنية و النحوية http://www.megaupload.com/?d=VFH5GLY7
221. اشتقاق الاسماء http://www.megaupload.com/?d=B15EOEKA
222. أصالة الإعراب ودلالته على المعنى http://www.megaupload.com/?d=PM80L4GA
223. اصول النحو العربى فى نظر النحاة و رأى ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث http://www.megaupload.com/?d=6LK3ZJ98
224. اعراب الجمل واشباه الجمل - شوقي المعري http://www.megaupload.com/?d=7BJFP8KK
225. اعراب الجمل واشباه الجمل - قباوة ,فخر الدين http://www.megaupload.com/?d=6CWJRV26
226. الأساليب الإنشائية في النحو العربي http://www.megaupload.com/?d=LTR32H6N
227. الاستدلال بالاحاديث النبوية الشريفة على اثبات القواعد النحوية http://www.megaupload.com/?d=S5MQSEUO، http://www.megaupload.com/?d=X7G17DQI
228. الاسس النحوية والاملائية فى اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=5MFXTWM1
229. الاسلوب و النحو دراسة تطبيقية فى علاقة الخصائص الأسلوبية ببعض الظاهرات النحوية http://www.megaupload.com/?d=RKA53EW2
230. الأسلوب والنحو http://www.megaupload.com/?d=SUZFBCDC
231. الاسم و الصفة فى النحو العربى والدراسات الاوروبية http://www.megaupload.com/?d=DD0J1GMJ
232. الاشباه والنظائر فى النحو http://www.megaupload.com/?d=HJPE3FD8
233. الأشتقاق http://www.megaupload.com/?d=N30AX1KY
234. الاشتقاق - ابن دريد -- طبعة ألمانيا 1854 http://www.megaupload.com/?d=0Y8MQY7W
235. الاصول فى النحو http://www.megaupload.com/?d=8LUN4UAT
236. الإعراب الميسر والنحو http://www.megaupload.com/?d=C8BTMI9Z
237. الإعراب الواضح http://www.megaupload.com/?d=RJWM3KUV
238. الاعراب الواضح مع تطبيقات عروضية و بلاغية http://www.megaupload.com/?d=9U2EHG4T
239. الاعراب و التركيب بين الشكل و النسبة دراسة تفسيرية http://www.megaupload.com/?d=OTNHW7A5
240. الافعال العربية الشاذة http://www.megaupload.com/?d=VGUAODLV
241. الافعال غير المتصرفة و شبه المتصرفة http://www.megaupload.com/?d=L0WEUS8M
242. الاقتضاب فى غريب الموطأ و اعرابه على الابواب http://www.megaupload.com/?d=6YLZP4L2
243. الالغاز النحوية http://www.megaupload.com/?d=920WSDAY
244. الانشاء الواضح اجود الانشاء فصاحة فى التعبير و وضوح فى التفكير وجمال فى التصوير http://www.megaupload.com/?d=CQJTM7KM
245. البلاغة الاصطلاحية http://www.megaupload.com/?d=Q9IWKQ1B
246. البلاغة العربية فى ضوء منهج متكامل http://www.megaupload.com/?d=1M6A48N5
247. التدريبات اللغوية فى النحو والصرف والاخطاء الشائعة http://www.megaupload.com/?d=2TAMX6GN
248. التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر http://www.megaupload.com/?d=APQW424L
249. التطبيق النحوى http://www.megaupload.com/?d=3ZOIDWC4
250. التطبيق فى الاعراب والصرف http://www.megaupload.com/?d=1WMIN5NM
251. التطور النحوى للغة العربية http://www.megaupload.com/?d=TIW9OCHH
252. التنوير فى تيسير التيسير فى النحو وفق المنهج المقرر على الصف الاول الاعدادى http://www.megaupload.com/?d=9R6MKOIW http://www.megaupload.com/?d=N0A0A67A
253. الجمل في النحو http://www.megaupload.com/?d=WQJ8FN08
254. الجنى الدانى فى حروف المعانى http://www.megaupload.com/?d=6928GGEV
255. الحسن والإحسان فيما خلا عنه اللسان http://www.megaupload.com/?d=CL7L0EN7
256. الحقول الدلالية الصرفية للافعال العربية http://www.megaupload.com/?d=2EX9AMZB
257. الحلقة المفقودة فى تاريخ النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=T5Q9A9LK
258. السير الحثيث http://www.megaupload.com/?d=R1RKISL3
259. الشافية في علم التصريف http://www.megaupload.com/?d=NNPNWOJJ
260. الضمائر المنعكسة في اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=ID9CWVX0
261. العربية للصيداوي http://www.megaupload.com/?d=NFBHOMWT
262. العمد كتاب في التصريف http://www.megaupload.com/?d=KM1RWSY9
263. العين للخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي http://www.megaupload.com/?d=0UHCNDR0
264. ألفية ابن مالك http://www.megaupload.com/?d=0CABTUE0
265. ألفية ابن مالك في النحو طبعة 1833 http://www.megaupload.com/?d=2HWQQQ10
266. القواعد الأساسية في النحو والصرف لطلاب المرحلة الثانوية http://www.megaupload.com/?d=U6S5SEH0
267. القواعد الأساسية للغة العربية http://www.megaupload.com/?d=EAOZ15SS
268. القواعد الثلاثون في علم العربية http://www.megaupload.com/?d=6VJNJWW4
269. الكتاب لسيبويه http://www.megaupload.com/?d=IAVAH38N
270. اللغة العربية أداء ونطقا وإملاء وكتابة http://www.megaupload.com/?d=CL6VSHS0
271. اللغة العربية أصل اللغات كلها http://www.megaupload.com/?d=WU8PE85K
272. اللغة بين المعيارية واللوصفية http://www.megaupload.com/?d=WM4NZR3T
273. اللؤلؤة في علم العربية http://www.megaupload.com/?d=TL5M5YB6
274. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر_ابن الأثير http://www.megaupload.com/?d=1226HFIE
275. المحكم والمحيط الأعظم http://www.megaupload.com/?d=XC9X6GD0
276. استرجاع المعلومات في اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=9VPU0D0X
277. المختار فى القواعد والاعراب http://www.megaupload.com/?d=96BVOKDR
278. المختصر فى النحو والاملاء والترقيم http://www.megaupload.com/?d=OVROS76O
279. المدارس النحوية http://www.megaupload.com/?d=5LRF5FRC
280. المدارس النحوية أسطورة وواقع http://www.megaupload.com/?d=GXAEHK06
281. المدخل الصرفى تطبيق وتدريب فى الصرف العربى http://www.megaupload.com/?d=QH7PYY55
282. المدخل النحوى تطبيق وتدريب فى النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=70SNBFHD
283. المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين http://www.megaupload.com/?d=GI9GGWOK
284. المصطلح الصرفى مميزات التذكير والتأنيث http://www.megaupload.com/?d=AXO9556X
285. المصطلح النحوى نشأتة وتطوره حتى اواخر القرن الثالث الهجرى http://www.megaupload.com/?d=VT2LW97G
286. المصطلح النحوي دراسة نقدية تحليلية http://www.megaupload.com/?d=BAJPUU3L
287. المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=534DGQTO
288. المعجم المفصل في علم الصرف http://www.megaupload.com/?d=1TL1LKYN
289. المقدمة الجزولية فى النحو http://www.megaupload.com/?d=SFXQGNPR
290. الممنوع من الصرف فى اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=DGWHRQ36
291. المنجد فى الاعراب والبلاغة والاملاء تطبيقات وقاعدات http://www.megaupload.com/?d=8RA1NMJH
292. المنظومة النحوية المنسوبة الى الخليل بن احمد الفراهيدى http://www.megaupload.com/?d=OL8EXCO5
293. المنظومة النحوية دراسة تحليلية http://www.megaupload.com/?d=1Q5NNIHG
294. الموجز في قواعد اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=MB5K73AJ
295. النحو الأساسي http://www.megaupload.com/?d=KEENIFU3
296. النحو الشافي http://www.megaupload.com/?d=Z7MURQ2T
297. النحو العصرى http://www.megaupload.com/?d=FIHVMEGT
298. النحو العصري http://www.megaupload.com/?d=RT73GN7F
299. النحو المنهجى http://www.megaupload.com/?d=JD6TFP5D
300. النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية http://www.megaupload.com/?d=OUPLYN46
301. النحو الوافي http://www.megaupload.com/?d=9635MEBP
302. النحو في ظلال القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=35K14QW1
303. الورد الصافي http://www.megaupload.com/?d=SWBSRG9F
304. بحوث ومقالات http://www.megaupload.com/?d=BMCBQC0S
305. تطور الآراء النحوية عند ابن هشام الانصارى http://www.megaupload.com/?d=7J8MG2IG
306. تقويم اللسان لابن الجوزي http://www.megaupload.com/?d=ER2EFF9U
307. جامع الدروس العربية http://www.megaupload.com/?d=J7MD3XHW
308. دليل السالك شرح ألفية ابن مالك http://www.megaupload.com/?d=VN2B7JPO
309. سلم اللسان في النحو والصرف والبيان http://www.megaupload.com/?d=9OEATN7Z
310. شذا العرف في فن الصرف http://www.megaupload.com/?d=FGOL7UEI
311. شرح ابن عقيل - ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل http://www.megaupload.com/?d=J7NEX3M0
312. شرح الشيخ حسن الكفراوي على متن الاجرومية http://www.megaupload.com/?d=1PBQ369I
313. شرح العلامة الشيخ حسن الكفراوي على الأجرومية http://www.megaupload.com/?d=UKUAHMP8
314. شرح القصيدة الكافية في التصريف http://www.megaupload.com/?d=46VWDTT5
315. شرح المفصل http://www.megaupload.com/?d=UFZBT9OV
316. شرح المكودى على الالفية فى علمى الصرف والنحو http://www.megaupload.com/?d=N7X48270
317. شرح المكودى على الفية ابن مالك http://www.megaupload.com/?d=A7UUCMT6
318. شرح حسن الكفراوى على متن الاجرومية فى علم النحو http://www.megaupload.com/?d=N5DI5FIQ
319. شرح قصيدة الكافية في التصريف http://www.megaupload.com/?d=IUDQVC1C
320. شرح قواعد الاعراب لابن هشام http://www.megaupload.com/?d=G19IWW92
321. شرح كتاب الحدود في النحو http://www.megaupload.com/?d=V82ZYSJU
322. شرح مختصر التصريف العزى فى فن الصرف http://www.megaupload.com/?d=E16TFVTO
323. شرح ملحة الاعراب http://www.megaupload.com/?d=TYSABFVV
324. شرح منظومة الالغاز النحوية للملا عصام الاسفراييني http://www.megaupload.com/?d=EUBF28UW
325. ظاهرة الاعراب فى النحو العربى وتطبيقها فى القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=5Z8W5UY0
326. ظاهرة التخفيف فى النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=GXORGXON
327. ظاهرة المجاورة فى الدراسات النحوية وموقعها فى القران الكريم http://www.megaupload.com/?d=WYS09L5C
328. علم نفسك الخطوط العربية http://www.megaupload.com/?d=0CPQ2FQ0
329. عناصر النظرية النحوية فى كتاب سيبويه محاولة لاعادة التشكيل فى ضوء الاتجاه المعجمى الوظيفيى http://www.megaupload.com/?d=DTOPRKCH
330. عنوان الشرف الوافى فى علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافى http://www.megaupload.com/?d=JE65LROA
331. فضل العرب و التنبيه على علومها http://www.megaupload.com/?d=2PV448LJ
332. فهارس كتاب الاصول فى النحو http://www.megaupload.com/?d=2NFR4XAO
333. فى ادلة النحو http://www.megaupload.com/?d=EE1WA6HH
334. في أصول النحو http://www.megaupload.com/?d=SFRBLQSR
335. في التطبيق النحوي والصرفي http://www.megaupload.com/?d=XH06KCGB
336. في علم اللغة لطليمات http://www.megaupload.com/?d=PMOZO6KO
337. قواعد الإملاء العربي http://www.megaupload.com/?d=ZXZHO2YH
338. قواعد تحويلية للغة العربية http://www.megaupload.com/?d=O63JHREL
339. كتاب الاصول الوافية الموسومة بانوار الربيع في الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع http://www.megaupload.com/?d=UC0K88TV
340. كتاب الأصول في النحو لابن السراج (وفهارسه للطناحي http://www.megaupload.com/?d=E8E1KJ4M
341. كتاب الأوائل http://www.megaupload.com/?d=G6YHJ7KO
342. كتاب الجمل فى النحو المنسوب للخليل بن احمد دراسة تحليلية http://www.megaupload.com/?d=M3Y871DU
343. كتاب العين http://www.megaupload.com/?d=B8FWWLOK
344. كتاب العين مرتباً على حروف المعجم http://www.megaupload.com/?d=WHYT1JHN
345. كيف تكون فصيحا http://www.megaupload.com/?d=BFHQ2SJE
346. لغة القران الكريم فى سورة النور دراسة فى التركيب النحوى http://www.megaupload.com/?d=LM8XVTQN
347. ما ينصرف وما لا ينصرف http://www.megaupload.com/?d=KOHKDQA2
348. مدارس النحاة البصريين والبغداديين http://www.megaupload.com/?d=I6M3PZ9I
349. مراكز الدراسات النحوية http://www.megaupload.com/?d=HDE8A6R0
350. مسألة خلافية في النحو http://www.megaupload.com/?d=UOFPVJV1
351. مسائل خلافية http://www.megaupload.com/?d=Z35QC9HA
352. مصنفات اللحن و التثقيف اللغوي http://www.megaupload.com/?d=CEVIZJWC
353. معين الطلاب فى قواعد النحو والاعراب http://www.megaupload.com/?d=C27FAMGQ
354. ملخص قواعد اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=NGA84E5P
355. منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني http://www.megaupload.com/?d=U20HWUCX
356. نتائج الفكر فى النحو http://www.megaupload.com/?d=CH932EMT
357. نحو اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=UP1AJ4KY
358. نحو اللغة العربية كتاب فى قواعد النحو والصرف مفصلة موثقة مؤيدة بالشواهد والامثلة http://www.megaupload.com/?d=EGGU2RTU
359. نشأة النحو وأشهر النحاة http://www.megaupload.com/?d=KZZZZ6YJ
360. نصوص عربية نصوص ومراجعات وتدريبات فى النحو والاملاء http://www.megaupload.com/?d=8H0ZRNDY
361. نصوص ومسائل نحوية وصرفية http://www.megaupload.com/?d=2FBYRRJ8
362. نظم مثلث قطرب http://www.megaupload.com/?d=6OK6A299
362. هداية الطالب قسم الصرف http://www.megaupload.com/?d=ERTVLBAM
363. أقرب المقاصد في شرح القواعد الصغرى في النحو لابن هشام الأنصاري http://www.megaupload.com/?d=5TZKL7G0
364. الإهمال في النحو العربي http://www.megaupload.com/?d=PC6RXIRH
365. الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهم http://www.megaupload.com/?d=2HITSWK8
366. المقصد الجليل في علم الخليل لابن الحاجب http://www.megaupload.com/?d=L6LBQGXT
367. الوظيفة الدلاليّة في ضوء مناهج اللسانيات http://www.megaupload.com/?d=64QNTRY0
368. تأملات في كتاب الخاطريات http://www.megaupload.com/?d=ZTP65U5H
369. جماليات تحوُّل الوحدة الصرفيَّة لدى النُّحاة والبلاغيين http://www.megaupload.com/?d=0V35TX9U
370. حاشية الحموي على شرح قواعد الإعراب لابن هشام http://www.megaupload.com/?d=3Y6WE3GR
371. دور التنغيم في تحديد معنى الجملة العربية http://www.megaupload.com/?d=Q2591OZG
372. ديوان أوس بن حجر تحقيق ونقد http://www.megaupload.com/?d=7D82757D
373. رسالة فهرست مؤلفاتي في علوم اللغة السيوطي http://www.megaupload.com/?d=8G7DJD50
374. شرح جمل الزجاجي ابن خروف http://www.megaupload.com/?d=Q40GT9XE
375. شرح ديوان رؤبة بن العجاج http://www.megaupload.com/?d=0WAAIJV1
376. شعر ابن رواحة الحموي الشاعر http://www.megaupload.com/?d=RXO4UGDU
377. صورة الذات المتفردة في شعر الفتوحات http://www.megaupload.com/?d=W3QS3OE3
378. ظاهرة العذل في شعر حاتم الطائي http://www.megaupload.com/?d=8LWEC71R
379. فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي http://www.megaupload.com/?d=NBCOQYW5
380. في سبيل منحى لساني براغماتي تداولي للترجمة http://www.megaupload.com/?d=VECCOW3O
381. معلقة عمرو بن كلثوم دراسة وتحليلاً http://www.megaupload.com/?d=42OQVUPO
382. موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد http://www.megaupload.com/?d=OP43QNIW
383. وسائل التعريف في مسائل التصريف لبدر الدين العيني http://www.megaupload.com/?d=BOFSTYKC
384. اتحاد المجامع اللغوية العربية في خمس عشرة سنة http://www.megaupload.com/?d=SPAKNJ61
385. أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب و الاذاعيين http://www.megaupload.com/?d=YGO72QJT
386. أسباب حدوث الحروف http://www.megaupload.com/?d=IYZX7UIA
387. استخدامات الحروف العربية - معجميا, صوتيا, صرفيا, نحويا, كتابيا http://www.megaupload.com/?d=PW1HDEEG
388. اسرار الحروف http://www.megaupload.com/?d=LNFPVC9Q
389. الأداء الصوتي في العربية http://www.megaupload.com/?d=GIZH7LB7
390. الأضداد في كلام العرب http://www.megaupload.com/?d=Z43LQQAY
391. الألسنة التحليلية والتوليدية http://www.megaupload.com/?d=XPQDB626
392. الالسنيه والتوليديه والتحويليه وقواعد اللغه العربيه (الجمله البسيطه http://www.megaupload.com/?d=A5ES9HVY
393. الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى http://www.megaupload.com/?d=VP3Q7R5I
394. الدلالة الصوتية والصرفية فى لهجة الاقليم الشمالى http://www.megaupload.com/?d=JV18BNOR
395. اللغة العربية بين المعيارية والوصفية http://www.megaupload.com/?d=O42L84KV
396. اللغة واللون http://www.megaupload.com/?d=8DA94B9S
397. علم الدلالة http://www.megaupload.com/?d=4AS0XEA8
398. لغة قريش http://www.megaupload.com/?d=EBAFCPMN
399. ما اختلفت ألفاظه و اتفقت معانيه للأصمعي http://www.megaupload.com/?d=E27MI427
400. مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما http://www.megaupload.com/?d=Y2XTJ301
401. مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع http://www.megaupload.com/?d=QJ7L698G
402. من حاضر اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=P6C2MQOD
403. من قضايا اللغة http://www.megaupload.com/?d=LBJ65OLR
404. مجلة مجمع اللغة العربية http://www.megaupload.com/?d=HFUIHLSG
405. أثر اللغة في اختلاف المجتهدين http://www.megaupload.com/?d=GNDLM5K6
406. أبدع الأساليب في إنشاء الرسائل والمكاتيب http://www.megaupload.com/?d=L91F59VB
407. الآدب الاسلامي بين النظرية والتطبيق http://www.megaupload.com/?d=6TVAAVEM
408. آدب الأطفال في العالم المعاصر http://www.megaupload.com/?d=MKOV7ZEG
409. الأدب العربي بين البادية والحضر http://www.megaupload.com/?d=GKCJOES4
410. شرح أدب القاضي للخصاف http://www.megaupload.com/?d=L1NNOQXX
411. أدب القاضي 1-2 http://www.megaupload.com/?d=USZUA7YH
412. أرتشاف الضرب من لسان العرب http://www.megaupload.com/?d=AMM0UO7K
413. الاسلام والشعر http://www.megaupload.com/?d=SF924D33
414. أسلوب الإستفهام في القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=5KKFCP2L
415. اعراب الحديث النبوي_ - ابو البقاء العكبري - تحقيق عبد الاله نبهان http://www.megaupload.com/?d=EGJVPY3A
416. إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية http://www.megaupload.com/?d=QOJ473IU
417. إعراب جزء قد سَمِعَ http://www.megaupload.com/?d=QMTH1JNX
418. الأعلام الممنوعة من الصرف في القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=QZDUMRLB
419. الإعلام بمثلث الكلام http://www.megaupload.com/?d=JJ2WHS1F
420. الأغاني http://www.megaupload.com/?d=O07796DE
421. الأغاني للأصفهاني http://www.megaupload.com/?d=9PTO3KTO
422. الامالي لابن الشجري http://www.megaupload.com/?d=3UA9A1V5
423. الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي http://www.megaupload.com/?d=BI8ZS6BE
424. الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله 1-3 http://www.megaupload.com/?d=UXEGLP1O
425. الأمثال في الحديث النبوي http://www.megaupload.com/?d=F4BI6NZJ
426. الأمثال في القرآن الكريم http://www.megaupload.com/?d=RBPSXQ7Q
427. أمالي السهيلي http://www.megaupload.com/?d=T39CXV7J
428. أمالي الشريف المرتضى http://www.megaupload.com/?d=3JEMOIW6
429. تجريد الأغاني 1-3 http://www.megaupload.com/?d=G1AFLZO3
430. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك http://www.megaupload.com/?d=UNBL5OJ4
431. دليل السالك إلى ألفية ابن مالك- عبدالله الفوزان http://www.megaupload.com/?d=OOPEAOSE
432. مجمع الأمثال 1 - 2 http://www.megaupload.com/?d=UHQUIVZA
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 17:33|
الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر خاصة ـ د/ سويف
http://www.zshare.net/download/12884406ea6fc05f/
خصائص الأدب العربى فى مواجهة نظريات النقد الأدبى الحديث ـ أنور الجندى
http://www.zshare.net/download/1288582182212085/
نظرية الجاحظ فى النقد
الأدبى
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=014211.pdf
دراسات فى النقد المسرحى والأدب المقارن
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=003061.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=014211.pdf
دراسات فى النقد المسرحى والأدب المقارن
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=003061.pdf
المنهج الموضوعى فى النقد الأدبى ـ محمد عزام
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=016927.pdf
مناهج النقد الأدبى ـ ترجمة الطاهر مكى
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=011632.pdf
دراسات فى الأدب والنقد ـ أبو القاسم كرو
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=008801.pdf
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 17:23|
كتب شروح ألفية ابن مالك وما يتعلق بها (القديمة والحديثة ) نسخة وورد
:-
1- ألفية ابن مالك .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alfyat.zip
2- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .
http://www.almeshkat.net/books/archi...0-%20ageel.zip
3- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alkhdry.zip
وهذه نسخة ألكترونية .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...yatKhudari.rar
4- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/ashmuni.zip
وهذه نسخة ألكترونية .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...ar7Ashmoni.rar
5-حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ، وهو من أفضل الشروح وأوسعها .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../alashmwny.zip
وهذه نسخة ألكترونية .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...hyatSabban.rar
6- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، من أشهر ، وأفضل شروح الألفية ، وهو لابن هشام الأنصاري ، وهذه النسخة pdf غير مرتبة .
.
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2340&type=l
وهذا كتاب ألكتروني ممتاز .
http://www.daraleman.net/uploads/AwdahMasalek.rar
7- الأجوبة الجلية لمن سأل عن شرح ابن عقيل على الألفية لحسين بن أحمد بن عبد الله آل علي.
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alkeel5.rar
8- المذكرات النحوية ، لعبد الرحمن الأهدل ، وهو شرح لألفية ابن مالك ، والدكتور حديث ، وهذا الكتاب ألكتروني .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...kratNhwyya.rar
ما يتعلق بالآجرومية وشروحها ( كتب الوورد والإكترونية) :
1- متن الآجرومية .
http://www.saaid.net/book/3/607.zip
2- المقدمة الآجرومية لابن آجروم.
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/ajromih.zip
3 مفاتيح العربية على متن الآجرومية لفيصل آل مبارك .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/f22.rar
4- متممة الآجرومية للرعيني .
http://www.almeshkat.net/books/archi..._jarroumia.zip
5- الدرر السنية في دراسة المقدمة الآجرومية ، لماهر علوش .
http://www.saaid.net/book/8/1739.zip
6- شرح الآجرومية لحسن حفظي ، وهو كتاب الكتروني .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...2&d=1138740341
7- المفهوم على مقدمة ابن آجروم لحمد النابت المري .
http://www.saaid.net/book/9/2004.zip
8- متن الدرة البهية نظم الأجرومية ، للعمريطي ، وهي قصيدة تناول فيها أبواب النحو على غرار الآجرومية لابن آجروم .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alamreti.zip
مؤلفات ابن هشام الأنصاري وما يتعلق بها ( كتب الوورد والإلكترونية):-
1- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، اسم على مسمى ، ولو لم يؤلف ابن هشام إلا المغنى لكفاه ، وحق على كل طالب علم في النحو أن يقتنيه ، وعن نفسي أقتني كتابا في مكتبتي الخاصة بأفضل تحقيق وهو للأستاذ عبد اللطيف الخطيب ، ونسخة في جهاز الحاسب ، ونسخة في هاتفي النقال .
http://www.almeshkat.net/books/archi...i%20labeb1.zip
2- مختصر مغني اللبيب للشيخ ابن عثيمين ، وهو كتاب إلكتروني .
http://www.almeshkat.net/books/archi...hnaAlabeeb.zip
3- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، من أشهر ، وأفضل شروح الألفية ، وهو لابن هشام الأنصاري ، وهذه النسخة pdf غير مرتبة
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2340&type=l
وهذا كتاب ألكتروني رائع .
http://www.daraleman.net/uploads/AwdahMasalek.rar
4- شرح شذور الذهب لان هشام ، وهو شرح لمتن كتابه (شذور الذهب ) الصغير ، وينصح به لمن أراد البدء في الولوج في النحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...r%20aldhab.zip
5- شرح قطر الندى وبل الصدى ، لابن هشام ، وقد شرح فيه متن كتابه الصغير (قطر الندى وبل الصدى ) .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/sadaa.zip
6- تعجيل الندى في شرح قطر الندى ، وهو لعبد الله الفوزان ، كتاب حديث يشرح متن قطر الندى لابن هشام ، وهذا كتاب ألكتروني .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...Ta3jilNada.rar
رسالة (اعتراض الشرط على الشرط) لابن هشام .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/shart.zip
7- رسالة ( إعراب لا إله إلا الله) لابن هشام ، ذكر فيها كل الأوجه المتعددة في إعرابها وآراء العلماء السابقين فيها .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/111.zip
8- رسالة (نكت الإعراب ) لابن هشام ، وهي مختصرة لتعليم طريقة الإعراب للطلاب .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/nkta.zip
9- رسالة ( المباحث المرضية في من الشرطية) لابن هشام .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5779&type=l
ما يتصل بالقرآن وإعرابه ( كتب الوورد والإلكترونية) :-
1- معاني القرآن للفراء ، كتاب ألكتروني رائع التصميم .
http://www.aldoah.com/upload/uploade...1173588142.rar
وهذه نسخة وورد لمعاني القرآن للفراء .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alqraan.zip
2- معاني القرآن للأخفش ، تلميذ سيبويه .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alakfsh.zip
3- معاني القرآن للنحاس .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alnhaas.zip
4- الكشاف ، للزمخشري ، وهو كتاب تفسير إلا أنّ اللمحات البلاغية ، والفوائد النحوية هي الطاغية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/kashaf.zip
5- تفسير البحر المحيط ، لأبي حيّان ، يعد المرجع في القراءات وتوجيهها، والإعراب أيضا ، مع أنه كتاب تفسير للقرآن .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/muheet.zip
6- الإعراب المحيط من تفسر البحر المحيط ، لياسين المحيمد ، وهو كتاب حديث قام بجمع أعاريب المفردات والآيات التي وردت في تفسير البحر المحيط لأبي حيّان ، ووضعها في هذا الكتاب ، وقد توهم البعض وظنوا أنه كتاب جديد لأبي حيّان .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alqraan.zip
7- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبي ، مرجع في القراءات وتوجيهها ، وإعراب القرآن، حيث يذكر الآراء المختلفة والممكنة في إعراب بعض المفردات ، سواء ألهذه التوجيهات أصحاب أم لا .
وهو تلميذ أبي حيّان وقد تتبع شيخه في تفسير البحر المحيط وخالفه في بعض الآراء ، لاغنى للنحوي عنه .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20almason.zip
8- إعراب القرآن للسيوطي ، ولم يعرب القرآن إعرابا كاملا ، لكن فيه بعض الجوانب بلاغية ، وبعض الإعرابات ، وبعض اللفتات النحوية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/e3rab.zip
9- إعراب القرآن للباقولي ، وهو الكتاب المنسوب للزجاج خطأ ,
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20algraan.zip
10- الإغفال ، لأبي علي الفارسي ، تتبع فيه الأخطاء اللغوية التي وقع بها الزجاج في كتابه (معاني القرآن وإعرابه )، والنسبة خاطئة للزجاج .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alekfaal.zip
11- مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب ، وقد تناول فيه ما يشكل من إعراب القرآن ، وتوجيه القراءات ، ونسبتها إلى أصحابها .
http://www.almeshkat.net/vb/attachme...&postid=201859
12- المجتبى في مشكل إعراب القرآن ، للخراط ، وهو كتاب حديث ـ اختصر فيه كتاب مكي بن أبي طالب (مشكل إعراب القرآن) ، وقد أزال من المشكل كل التوجيهات المتعددة للقراءات المختلفة ، واعتمد على إعراب قراءة واحدة فقط ، واختصار عبارات مكي القيسي ، فكأنّ الكتاب جديد .
وقد توهم بعض الناس وظنوا أنّ هذا الكتاب هو مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ، وليس بصحيح .
http://www.almeshkat.net/books/archi...earabguran.zip
13- إملاء ما من به الرحمن ، لأبي البقاء العكبري ، وللكتاب أكثر من اسم منها التبيان ، والكتاب مشهور في إعراب القرآن .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alabkri.zip
1- ألفية ابن مالك .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alfyat.zip
2- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .
http://www.almeshkat.net/books/archi...0-%20ageel.zip
3- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alkhdry.zip
وهذه نسخة ألكترونية .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...yatKhudari.rar
4- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/ashmuni.zip
وهذه نسخة ألكترونية .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...ar7Ashmoni.rar
5-حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ، وهو من أفضل الشروح وأوسعها .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../alashmwny.zip
وهذه نسخة ألكترونية .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...hyatSabban.rar
6- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، من أشهر ، وأفضل شروح الألفية ، وهو لابن هشام الأنصاري ، وهذه النسخة pdf غير مرتبة .
.
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2340&type=l
وهذا كتاب ألكتروني ممتاز .
http://www.daraleman.net/uploads/AwdahMasalek.rar
7- الأجوبة الجلية لمن سأل عن شرح ابن عقيل على الألفية لحسين بن أحمد بن عبد الله آل علي.
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alkeel5.rar
8- المذكرات النحوية ، لعبد الرحمن الأهدل ، وهو شرح لألفية ابن مالك ، والدكتور حديث ، وهذا الكتاب ألكتروني .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...kratNhwyya.rar
ما يتعلق بالآجرومية وشروحها ( كتب الوورد والإكترونية) :
1- متن الآجرومية .
http://www.saaid.net/book/3/607.zip
2- المقدمة الآجرومية لابن آجروم.
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/ajromih.zip
3 مفاتيح العربية على متن الآجرومية لفيصل آل مبارك .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/f22.rar
4- متممة الآجرومية للرعيني .
http://www.almeshkat.net/books/archi..._jarroumia.zip
5- الدرر السنية في دراسة المقدمة الآجرومية ، لماهر علوش .
http://www.saaid.net/book/8/1739.zip
6- شرح الآجرومية لحسن حفظي ، وهو كتاب الكتروني .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...2&d=1138740341
7- المفهوم على مقدمة ابن آجروم لحمد النابت المري .
http://www.saaid.net/book/9/2004.zip
8- متن الدرة البهية نظم الأجرومية ، للعمريطي ، وهي قصيدة تناول فيها أبواب النحو على غرار الآجرومية لابن آجروم .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alamreti.zip
مؤلفات ابن هشام الأنصاري وما يتعلق بها ( كتب الوورد والإلكترونية):-
1- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، اسم على مسمى ، ولو لم يؤلف ابن هشام إلا المغنى لكفاه ، وحق على كل طالب علم في النحو أن يقتنيه ، وعن نفسي أقتني كتابا في مكتبتي الخاصة بأفضل تحقيق وهو للأستاذ عبد اللطيف الخطيب ، ونسخة في جهاز الحاسب ، ونسخة في هاتفي النقال .
http://www.almeshkat.net/books/archi...i%20labeb1.zip
2- مختصر مغني اللبيب للشيخ ابن عثيمين ، وهو كتاب إلكتروني .
http://www.almeshkat.net/books/archi...hnaAlabeeb.zip
3- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، من أشهر ، وأفضل شروح الألفية ، وهو لابن هشام الأنصاري ، وهذه النسخة pdf غير مرتبة
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2340&type=l
وهذا كتاب ألكتروني رائع .
http://www.daraleman.net/uploads/AwdahMasalek.rar
4- شرح شذور الذهب لان هشام ، وهو شرح لمتن كتابه (شذور الذهب ) الصغير ، وينصح به لمن أراد البدء في الولوج في النحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...r%20aldhab.zip
5- شرح قطر الندى وبل الصدى ، لابن هشام ، وقد شرح فيه متن كتابه الصغير (قطر الندى وبل الصدى ) .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/sadaa.zip
6- تعجيل الندى في شرح قطر الندى ، وهو لعبد الله الفوزان ، كتاب حديث يشرح متن قطر الندى لابن هشام ، وهذا كتاب ألكتروني .
http://www.daraleman.org/forum/uploa...Ta3jilNada.rar
رسالة (اعتراض الشرط على الشرط) لابن هشام .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/shart.zip
7- رسالة ( إعراب لا إله إلا الله) لابن هشام ، ذكر فيها كل الأوجه المتعددة في إعرابها وآراء العلماء السابقين فيها .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/111.zip
8- رسالة (نكت الإعراب ) لابن هشام ، وهي مختصرة لتعليم طريقة الإعراب للطلاب .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/nkta.zip
9- رسالة ( المباحث المرضية في من الشرطية) لابن هشام .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5779&type=l
ما يتصل بالقرآن وإعرابه ( كتب الوورد والإلكترونية) :-
1- معاني القرآن للفراء ، كتاب ألكتروني رائع التصميم .
http://www.aldoah.com/upload/uploade...1173588142.rar
وهذه نسخة وورد لمعاني القرآن للفراء .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alqraan.zip
2- معاني القرآن للأخفش ، تلميذ سيبويه .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alakfsh.zip
3- معاني القرآن للنحاس .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alnhaas.zip
4- الكشاف ، للزمخشري ، وهو كتاب تفسير إلا أنّ اللمحات البلاغية ، والفوائد النحوية هي الطاغية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/kashaf.zip
5- تفسير البحر المحيط ، لأبي حيّان ، يعد المرجع في القراءات وتوجيهها، والإعراب أيضا ، مع أنه كتاب تفسير للقرآن .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/muheet.zip
6- الإعراب المحيط من تفسر البحر المحيط ، لياسين المحيمد ، وهو كتاب حديث قام بجمع أعاريب المفردات والآيات التي وردت في تفسير البحر المحيط لأبي حيّان ، ووضعها في هذا الكتاب ، وقد توهم البعض وظنوا أنه كتاب جديد لأبي حيّان .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alqraan.zip
7- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبي ، مرجع في القراءات وتوجيهها ، وإعراب القرآن، حيث يذكر الآراء المختلفة والممكنة في إعراب بعض المفردات ، سواء ألهذه التوجيهات أصحاب أم لا .
وهو تلميذ أبي حيّان وقد تتبع شيخه في تفسير البحر المحيط وخالفه في بعض الآراء ، لاغنى للنحوي عنه .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20almason.zip
8- إعراب القرآن للسيوطي ، ولم يعرب القرآن إعرابا كاملا ، لكن فيه بعض الجوانب بلاغية ، وبعض الإعرابات ، وبعض اللفتات النحوية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/e3rab.zip
9- إعراب القرآن للباقولي ، وهو الكتاب المنسوب للزجاج خطأ ,
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20algraan.zip
10- الإغفال ، لأبي علي الفارسي ، تتبع فيه الأخطاء اللغوية التي وقع بها الزجاج في كتابه (معاني القرآن وإعرابه )، والنسبة خاطئة للزجاج .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alekfaal.zip
11- مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب ، وقد تناول فيه ما يشكل من إعراب القرآن ، وتوجيه القراءات ، ونسبتها إلى أصحابها .
http://www.almeshkat.net/vb/attachme...&postid=201859
12- المجتبى في مشكل إعراب القرآن ، للخراط ، وهو كتاب حديث ـ اختصر فيه كتاب مكي بن أبي طالب (مشكل إعراب القرآن) ، وقد أزال من المشكل كل التوجيهات المتعددة للقراءات المختلفة ، واعتمد على إعراب قراءة واحدة فقط ، واختصار عبارات مكي القيسي ، فكأنّ الكتاب جديد .
وقد توهم بعض الناس وظنوا أنّ هذا الكتاب هو مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ، وليس بصحيح .
http://www.almeshkat.net/books/archi...earabguran.zip
13- إملاء ما من به الرحمن ، لأبي البقاء العكبري ، وللكتاب أكثر من اسم منها التبيان ، والكتاب مشهور في إعراب القرآن .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alabkri.zip
__________________
أمهات الكتب النحوية المشهورة ( كتب
الوورد والإلكترونية) :-
1- الكتاب ، لسيبويه ، ولا مزيد حديث فيه .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alketaab.zip
2- الخصائص ، لابن جني ، مرجع في أصول النحو ، وفقه اللغة ،وعلم الأصواب ، مع الفوائد النحوية المنتشرة في طياته .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ebn%20geni.zip
3- الأصول في النحو لابن السراج ، وهو كتاب في أبواب النحو المعروفة ، و ليس في أصول النحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...fe%20alnho.zip
4- اللمع ، لابن جني ، من أشهر كتبه بعد الخصائص ، وهو يتناول أبواب النحو المعتادة إلا أنّه لم يفصل بأقوال العلماء ، وقد شرحه علماء عدة .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/lammaa.zip
5- المقتضب ، للمبرد ، من أشهر كتبه بعد الكامل في اللغة والأدب ، تناول فيه أبواب النحو المعتادة كسيبويه في كتابه ، ويعتبر من المراجع المهمة .
http://www.almeshkat.net/vb/attachme...&postid=196821
6- الصاحبي في اللغة ، وهي لابن فارس ، يعتبر مرجع في فقه اللغة ، وقد تناول في طياته بعض المفردات النحوية ومعانيها ، لذا أوردته هنا .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alsahbi.zip
7- المفصل ، لجار الله الزمخشري ، أشهر كتبه بعد تفسير الكشاف ، تناول فيه أبواب النحو المعتادة ، وقد قام بشرحه أكثر من نحوي ، أفضل شروحه وأشهرهم شرح ابن يعيش .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../almufsel7.zip
8- إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ، للعكبري ، حيث تناول بعض الأحاديث مشكلة الإعراب ، فأخذ يعربها ويوضح ما فيها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alakbri2.zip
9- مسائل خلافية في النحو ، لأبي البقاء العكبري ، تناول فيه المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين على غرار الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/massail.zip
10- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ن كتاب لاغني للنحوي عنه ، لما فيه من جمع لآراء السابقين ، وطريقة عرضه كعرض النحويين الآخرين لأبواب النحو المعتادة مع اختلاف وإضافات في المفردات .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alhwama.zip
11- الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب ، وهو لابن عدلان الدمشقي ، وقد تناول فيه إعراب الأبيات الصعبة الإعراب ، كقول الفرزدق : وما مثله في الناس ...
الكتاب مفيد جدا .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../meshklh_e.zip
12- مجالس ثعلب ، فيه الفوائد الجمة في الأدب والنحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/thalaab.zip
13- شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور الإشبيلي ، من أفضل شروح جمل الزجاجي ، وهذا الكتاب يفوق الكثير من الكتب لما فيه من تعليلات بارعة لابن عصفور ، وحسن العرض تشهد بعلو مكانته في النحو ، وسعة اطلاعه، وأنا أنصح به .
http://www.almeshkat.net/books/archi...20alzjajy2.zip
14- الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية ، لجمال الدين الإسنوي ، ذكر فيه الأحكام الفقهية التي ترتبط بالنحو ، وتتوقف عيه في بعض الأحيان .
http://www.almeshkat.net/books/archi...kokb%20dri.zip
15- الجنى الداني في حروف المعاني ، لأبي القاسم المرادي ، وهذا الكتاب جدا مشهور ، ومهم ، تناول فيه المفردات على غرار ابن هشام في أول المغني ، ولكن المرادي سابق لابن هشام ، وقد استفاد منه ابن هشام كثيرا في المغنى حتى أنه نقل نقولا في المغني دون أن ينسبها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...i%20aldani.zip
16- الجمل في النحو ، لعبد القاهر الجرجاني ، وهو غير جمل الزجاجي .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/k%20j1.zip
17- التتمة في النحو ، لعبد القاهر الجرجاني ، كتاب التتمة كتاب مختصر جمع فيه مافاته في كتاب الجمل من تعريف لبعض الأصول النحوية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/t%20n.zip
18- الكليات ، للكفوي ، وهو كتاب مشهور حيث تناول فيه تعريفات ، ومصطلحات أغلب علوم اللغة والعلوم الأخرى ، بما فيها مصطلحات النحو، والصرف ، وأصول النحو ، وهو مبوب على ترتيب حروف المعجم ، ذاكرا معاني بعض المفردات أيضا ، وذاكرا آراء العلماء .
http://www.almeshkat.net/books/archi...lklyaat_mf.zip
19- الأمالي، لابن الشجري ، تناول فيه كثيرا من الفوائد النحوية حين تعرضه للأبيات ، أو الآيات .
http://www.almeshkat.net/books/archi...i%20shagri.zip
20- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة ، لابن عابدين ، وهو كتاب قديم تناول مؤلفه إعراب الكلمات ، والعبارات التي شاعت في عصره ، وكثر استعمالها لدى الناس .
http://www.almeshkat.net/books/archi...d%20aljebh.zip
21- ملحة الإعراب ، للحريري ، وهي منظومة شعرية في النحو لا تتجاوز الثمانين بيت ، وعليها شروح كثيرة عند المعاصرين لسهولة الملحة ، فهي للمبتدئين .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20aliarab.zip
22- علل التثنية ، لابن جني ، وهي رسالة صغيرة تناول فيها آراء العلماء في إعراب المثنى .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../ebn%20gny.zip
23- الجمل في النحو ، كتاب منسوب للخليل ، وهو لابن شقير ، وهو الكتاب المنسوب للخليل خطأ ، تناول فيه أبواب النحو المعروفة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...al_joumale.zip
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/algumal.zip
24- اللباب علل البناء والإعراب للعكبري ، تناول فيه أسباب بناء بعض المفردات ، وإعراب بعضها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/al_lubab.zip
25- الحدود في النحو للرماني ، وهي رسالة صغيرة تناول فيه حدود بعض الوظائف والمصطلحات النحوية .
http://www.almeshkat.net/books/archi...rif_romani.zip
26- اللامات ، للزجاجي ، وهي رسالة صغيرة تناول فيها حرف اللام ومعانيه واستعمالاته في اللغة والنحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...tab_laamat.zip
27- معاني الحروف ، للزجاجي ، وقد تناول فيه معاني الحروف واستعمالاتها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ni_zajjaji.zip
28- شرح أبيات (لاسيّما) للسجاعي ، لمحمد الأمير ، وهو المشهور صاحب حاشية الأمير على مغنى اللبيب ، ففي هذا الكتاب الصغير الحجم عظيم الفائدة تناول أبيات للسجاعي في (لاسيّما) فقط ، فأخذ الأمير يشرحها وبين آراء العلماء السابقين بطريقة رائعة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alsugaei.zip
29- رسالة الحروف ، للفارابي ، تناول فيه الحروف ومعانيها ، واستعمالاتها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alfrabi.zip
30- الحدود ، للرماني ، وهي رسالة مختصرة تضع حدود لبعض الوظائف والمصطلحات النحوية .
http://www.almeshkat.net/vb/images/banners/hdood_r.zip
31- أجوبة لمسائل سألها الإمام النووي في ألفاظ الحديث ، وهي رسالة بينه وبين ابن مالك ، والكتاب قديم ومؤلفه غير معروف ، والرسالة تعرض أسئلة سألها النووي لابن مالك في بعض ألفاظ الحديث ، وخصوصا في يخص الإعراب ، والأوجه المختلفة ، الرسالة قيمة .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/nwawi2.rar
32- العدد في اللغة ، لابن سيدة الأندلسي ، صاحب المخصص ، والمحكم في اللغة ، وقد تناول في هذا الكتاب الصغير أحكام العدد ، وبعض ما يتصل به .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/add.zip
33- منازل الحروف ، للرماني ، وهو اختصار لكتابه معاني الحروف .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/hourouf.zip
34- شرح أبيات المفصل للسيد الشريف ، حيث قام بشرح أبيات المفصل للزمخشري وإعرابها ، الكتاب مفيد جدا وهو مكون من خمسة أجزاء وهذه الوصلات الخمس .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5696&type=l
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5697&type=l
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5698&type=l
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5699&type=l
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5700&type=l
35- سر صناعة الإعراب ، لابن جني ، من مشاهير كتبه بعد الخصائص واللمع ، بل هو يفوق اللمع ، وهو في أبواب النحو ، وهذه النسخة pdf غير مرتبة .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2346&type=l
36- إعراب لامية العرب للشنفري ، وهي لأبي البقاء العكبري ، حيث قام بإعراب أبيات قصيدة الشنفرى :
أقيموا بني أمي ...
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2324&type=l
37- رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع الأزمنة ، لأحمد بن قاسم الصباغ .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2342&type=l
38- الحلل في شرح أبيات الجمل ، لابن السيد البطليوسي ، حيث قام بشرح أبيات جمل الزجاجي ، وإعرابها ، ونسبتها .
http://jewar.com/book/go.php?id=4540&type=l
39- الأشباه والنظائر ، للسيوطي ، وميزة هذه النسخة أنها بالتشكيل .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...2&d=1111420821
40 - شرح كافية ابن الحاجب ، للرضي ، من أعظم الكتب ، وأنفعها في النحو .
http://www.daraleman.net/uploads/Shar7RadhiKafyya.rar
الكتب الصرفية القديمة والحديثة ( كتب الوورد والإلكترونية) :-
1- مختصر التصريف ، لأبن جني ، وهو المسمى بالتصريف الملوكي ، وهو غير شرح تصريف المازني لابن جني ، وكلاهما في الصرف .
http://www.almeshkat.net/books/archi...Mokhtassar.zip
2- الشافية في علم التصريف ، وهو لابن الحاجب ، تناول فيه الصرف ، معنى ، ثم أبوابه كالأوزان وغيرها ، والكتاب مهم جدا في الصرف ومن المراجع وعليه للرضي ، كما شرح الكافية في النحو لابن الحاجب .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/shafya1.zip
3- شرح شافية ابن الحاجب ، للرضي ، ومن من أعظم الكتب ، وأنفعها مع شرح الكافية له أيضا .
http://www.daraleman.net/uploads/Shar7Shaafiyah.rar
4- لامية الأفعال ، لابن مالك ، وهي منظومة شعرية تناول فيها الأفعال وتصريفها ، أي المسائل الصرفية المتعلقة بالأفعال ، وعلى اللامية شروح عديدة ، منها من المحدثين الصعيدي .
http://www.almeshkat.net/books/archi...tt%20afaal.zip
5- فتح المتعال على القصيدة المسمّاة بلامية الأفعال ، وهي لحمد الصعيدي ، ولامية الأفعال لابن مالك .
http://www.almeshkat.net/books/archi...20almutaal.zip
6- شذا العرف في فن الصرف ، من أشهر كتب الصرف الحديثة ن مع أنه صغير إلا أنه عظيم الفائدة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ha%20alarf.zip
7- كتاب الأفعال ، لابن القطاع ن تناول فيه تصريف الأفعال .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alafaal.zip
8- نقعة الصديان فيما جاء على الفعلان ، للصاغاني ، وهي رسالة صغيرة جمع فيها ما جاء على وزن فعلان من الأسماء ، وقد رتبها ترتيب المعجم .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/sdysn.zip
9- نزهة الطرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف ، لصادق البيضاني ، كتاب حديث في علم الصرف وتيسيره .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/altef.zip
كتب تاريخ النحو وتراجم النحاة القديمة والحديثة ( كتب الوورد والإلكترونية) :-
1- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي ، من أشهر كتب تراجم النحاة ، وهو مرجع في معرفة النحاة ومؤلفاتهم ، سواء المعروفين ، والمغمورين .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alwaaah.zip
2- تاريخ العلماء النحويين ، للتنوخي ، تناول فيه تراجم النحاة إلا أنه لا يتسم بالشمول .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../tarek%20n.zip
3- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، للفيروز آبادي ، صاحب القاموس المحيط ، تناول فيه تراجم أئمة النحو يعتبر مرجع لكن ليس كبغية الوعاة .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../albulkh22.zip
4- أخبار النحويين ، لأبي طاهر المقرئ ، تناول فيه أخبار بعض النحاة ، ويعتبر مرجع في أخبار بعض النحاة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/taheer_n.zip
5- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات الأنباري ، من كتب تراجم النحاة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...zht%20odba.zip
6- من تاريخ النحو ، لسعيد الأفغاني ، وهو من الكتب الحديثة تناول فيه نشوء النحو ، والخلافات والفروق بين المدرستين البصرية ، والكوفية ، وأصول كل مدرسة ، وذكر أمثلة لخلافاتهم ، وبعض أعلامهم ، الكتاب بصيغة pdf .
http://www.fikr.com/freebooks/pdf/history.pdf
الكتب والبحوث الحديثة والمعاصرة في النحو العربي وأصول النحو (كتب الوورد والإلكترونية) :-
1- النحو الوافي ، لعباس حسن ، من أشهر الكتب الحديثة في النحو ، ولا غنى للنحوي عنه لما فيه من تفصيل فضله على غيره من كتب المعاصرين على كثرتها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...aho%20wafi.zip
2- جامع الدروس العربية ، لمصطفى الغلاييني ، كتاب غني عن التعريف ، ينصح به لمن أراد البدء في النحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...os%20arbia.zip
حروف المعاني بين الأصالة والحداثة ، لحسن عباس ، تناول فيها حروف المعاني .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/hroof_m.zip
3- النحو إلى أصول ، لعبد الله العتيق ، بحث جيد تناول فيه أصول النحو مختصرا .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/naho.zip
4- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ، وهو للشيخ خالد لأزهري ، وقد شرح فيه قواعد الإعراب لابن هشام .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/MUSEL3.zip
5- الهداية في النحو ، هذا الكتاب موجودٌ على النت، وقد عمله المجمع العلمي الإسلامي لتيسير النحوعلى الطلاب ، و الكتاب ألكتروني
http://www.daraleman.net/uploads/HidaayaFiNahu.rar
6- الحدود في علم النحو لأحمد الأبذي ، تناول فيه تعريفات لبعض المصطلحات النحوية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/hudod3.zip
7- لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20aleerab.zip
8- الخصائص اللغوية لقراءة حفص ( دراسة صرفية نحوية ( وهي رسالة علمية ، لعلاء الحمزاوي ،دراسة في القراءات القرآنية تعرض للخصائص الصرفية والنحوية لرواية حفص عن عاصم ¡ وتبين عن الأسباب التي أدت إلى شهرة رواية حفص عن عاصم في المشرق الإسلامي .
http://abooks.tipsclub.com/index.php...ownload&id=727
9- خصا ئص الحروف العربية ومعانيها ، بحث حديث لحسن عباس ، تناول الحروف ومعانيها ، واستعمالاتها ، وهو بحث قيّم .
http://www.almeshkat.net/books/archi...i%20alhrof.zip
10- معجم قواعد اللغة العربية، لعبد الغني الدقر، كتاب حديث تناول النحو والصرف والإملاء باختصار وتيسير .
http://www.almeshkat.net/books/archi...m%20arabia.zip
11- الموجز في قواعد اللغة العربية ، لسعيد الأفغاني ، تناول فيه أبواب النحو والصرف بصورة سلسلة سهلة ، غرضها تيسير النحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/afghani.zip
12- قواعد اللغة العربية المبسطة ، لعبد اللطيف السعيد ، وهي كتاب حديث تناول فيه قواعد النحو والإملاء باختصار وللتيسير .
http://www.almeshkat.net/books/archi...eed%20luka.zip
13- دخول ( أل ) بمعنى الذي على الفعل المضارع دراسة نحوية نقدية في معنى الضرورة ، لعامر العلواني ، وهو بحث حديث تناول هذه المسألة التي تعد ضرورة عند النحاة .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/1582.zip
14- مقصوصات صرفية ونحوية ، لثامر المصاروة ، وهو كتاب حديث تناول فيه بعض المسائل الصرفية ، وبعض المنصوبات في النحو ، وقام بعرضها بصورة سهلية ، قصده التيسير لطلاب المدارس.
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/mksosat.zip
15- معجم الأفعال المتعدية بحرف ، لموسى بن محمد بن الملياني ، وهو حديث ، جمع مؤلفه فيه الأفعال المتعدية بحرف من المعاجم المختلفة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/afaal_h.zip
16- نظم شذور الذهب في كلام العرب ، لمحمد اليعقوبي ، وهو حديث حيث قام بنظم كتاب شذور الذهب لابن هشام شعرا ، ما يقارب خمسمائة بيت .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/shzoor.zip
17- النحاة وحروف الجر ، للزعبلاوي ، بحث قيم تناول فيه حروف الجر .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alnoha.zip
18- التحفة الوفيّة بمعاني حروف العربيّة لإبراهيم بن محمد السفاقسي ، تناول فيه معني الحروف في العربية على اختلافها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...fa%20wafia.zip
19- كتاب الحروف ، لأبي الحسين المزني ، تناول فيه معاني الحروف واستعمالاتها في العربية .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alhroof2.zip
20- الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، أبو سعيد العلائي الشافعي ، تناول فيها مسألة الواو الزائدة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ol%20mzedh.zip
21- المنظومة المختصرة في النحو ، لسعيد المري ، وهو حديث ، تناول فيها النحو مختصرا كمنظومة شعرية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/nho2.zip
22- المختصر الفريد على نظم الشيخ سعيد ، لحمد المري ، وهذه منظومة شعرية مختصرة لا تتجاوز الستين بيتا في النحو ، وهو حديث .
http://www.almeshkat.net/books/archi...zm%20saaed.zip
23- لب الإعراب في تيسير علم النحو للطلاب ، لفيصل آل مبارك ، وهو كتاب حديث مختصر لتيسير النحو للطلاب http://www.almeshkat.net/books/archive/books/f14.rar
24- قواعد اللغة العربية (الكفاف) ، ليوسف الصيداوي ، كتاب حديث ، وتناول فيه أبواب النحو مختصرا تيسيرا للطلاب .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/kwaed22.zip
25- علامات الإعراب ( عرض بورباوينت) ، لإسماعيل السحيباني ، وهو لطيف للمدرسين في المدارس ن فهو يساعدهم على تفهيم الطلاب علامات الإعراب دون عناء ، بواسطة هذا العرض الجيد .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/eeraab.rar
26- إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل ، للصديقي .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alfaeel.zip
27- بحث في أسباب ظهور الحواشي والشروح في النحو العربي .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=4961&type=l
28- النحو الواضح ، للجارم ، وأمين ، و هو من الكتب المعروفة في النحو للطلاب ، وهذا موقع منسق على أبواب الكتاب .
http://zahra1.com/Nah_Em_7att_balagah/F_ALNAHW.html
29- نزع الخافض في الدرس النحوي ، لحسين الحبشي ، وهو بحث قيم تناول فيه مسألة نزع الخافض ، أي حذف حرف الجر ونصب الاسم المجرور .
http://www.saaid.net/book/8/1536.zip
30- دور اللهجات في التقعيد النحوي ، لعلاء الحمزاوي ، وهو بحث قيم تناول اللهجات فيه عن طريق كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ، مبينا دور اللهجات في التقعيد النحوي .
http://www.saaid.net/book/8/1433.zip
31- موقف شوقي ضيف من الدرس النحوي ، لعلاء الحمزاوي ، وهو بحث تناول فيه موقف شوقي ضيف من ابن مضاء ، ومدى توافقه معه في الدعوة إلى تيسير النحو ومخالفة النحاة المتقدمين والمتأخرين .
http://www.saaid.net/book/8/1428.zip
1- الكتاب ، لسيبويه ، ولا مزيد حديث فيه .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alketaab.zip
2- الخصائص ، لابن جني ، مرجع في أصول النحو ، وفقه اللغة ،وعلم الأصواب ، مع الفوائد النحوية المنتشرة في طياته .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ebn%20geni.zip
3- الأصول في النحو لابن السراج ، وهو كتاب في أبواب النحو المعروفة ، و ليس في أصول النحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...fe%20alnho.zip
4- اللمع ، لابن جني ، من أشهر كتبه بعد الخصائص ، وهو يتناول أبواب النحو المعتادة إلا أنّه لم يفصل بأقوال العلماء ، وقد شرحه علماء عدة .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/lammaa.zip
5- المقتضب ، للمبرد ، من أشهر كتبه بعد الكامل في اللغة والأدب ، تناول فيه أبواب النحو المعتادة كسيبويه في كتابه ، ويعتبر من المراجع المهمة .
http://www.almeshkat.net/vb/attachme...&postid=196821
6- الصاحبي في اللغة ، وهي لابن فارس ، يعتبر مرجع في فقه اللغة ، وقد تناول في طياته بعض المفردات النحوية ومعانيها ، لذا أوردته هنا .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alsahbi.zip
7- المفصل ، لجار الله الزمخشري ، أشهر كتبه بعد تفسير الكشاف ، تناول فيه أبواب النحو المعتادة ، وقد قام بشرحه أكثر من نحوي ، أفضل شروحه وأشهرهم شرح ابن يعيش .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../almufsel7.zip
8- إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ، للعكبري ، حيث تناول بعض الأحاديث مشكلة الإعراب ، فأخذ يعربها ويوضح ما فيها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alakbri2.zip
9- مسائل خلافية في النحو ، لأبي البقاء العكبري ، تناول فيه المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين على غرار الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/massail.zip
10- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ن كتاب لاغني للنحوي عنه ، لما فيه من جمع لآراء السابقين ، وطريقة عرضه كعرض النحويين الآخرين لأبواب النحو المعتادة مع اختلاف وإضافات في المفردات .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alhwama.zip
11- الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب ، وهو لابن عدلان الدمشقي ، وقد تناول فيه إعراب الأبيات الصعبة الإعراب ، كقول الفرزدق : وما مثله في الناس ...
الكتاب مفيد جدا .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../meshklh_e.zip
12- مجالس ثعلب ، فيه الفوائد الجمة في الأدب والنحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/thalaab.zip
13- شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور الإشبيلي ، من أفضل شروح جمل الزجاجي ، وهذا الكتاب يفوق الكثير من الكتب لما فيه من تعليلات بارعة لابن عصفور ، وحسن العرض تشهد بعلو مكانته في النحو ، وسعة اطلاعه، وأنا أنصح به .
http://www.almeshkat.net/books/archi...20alzjajy2.zip
14- الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية ، لجمال الدين الإسنوي ، ذكر فيه الأحكام الفقهية التي ترتبط بالنحو ، وتتوقف عيه في بعض الأحيان .
http://www.almeshkat.net/books/archi...kokb%20dri.zip
15- الجنى الداني في حروف المعاني ، لأبي القاسم المرادي ، وهذا الكتاب جدا مشهور ، ومهم ، تناول فيه المفردات على غرار ابن هشام في أول المغني ، ولكن المرادي سابق لابن هشام ، وقد استفاد منه ابن هشام كثيرا في المغنى حتى أنه نقل نقولا في المغني دون أن ينسبها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...i%20aldani.zip
16- الجمل في النحو ، لعبد القاهر الجرجاني ، وهو غير جمل الزجاجي .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/k%20j1.zip
17- التتمة في النحو ، لعبد القاهر الجرجاني ، كتاب التتمة كتاب مختصر جمع فيه مافاته في كتاب الجمل من تعريف لبعض الأصول النحوية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/t%20n.zip
18- الكليات ، للكفوي ، وهو كتاب مشهور حيث تناول فيه تعريفات ، ومصطلحات أغلب علوم اللغة والعلوم الأخرى ، بما فيها مصطلحات النحو، والصرف ، وأصول النحو ، وهو مبوب على ترتيب حروف المعجم ، ذاكرا معاني بعض المفردات أيضا ، وذاكرا آراء العلماء .
http://www.almeshkat.net/books/archi...lklyaat_mf.zip
19- الأمالي، لابن الشجري ، تناول فيه كثيرا من الفوائد النحوية حين تعرضه للأبيات ، أو الآيات .
http://www.almeshkat.net/books/archi...i%20shagri.zip
20- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة ، لابن عابدين ، وهو كتاب قديم تناول مؤلفه إعراب الكلمات ، والعبارات التي شاعت في عصره ، وكثر استعمالها لدى الناس .
http://www.almeshkat.net/books/archi...d%20aljebh.zip
21- ملحة الإعراب ، للحريري ، وهي منظومة شعرية في النحو لا تتجاوز الثمانين بيت ، وعليها شروح كثيرة عند المعاصرين لسهولة الملحة ، فهي للمبتدئين .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20aliarab.zip
22- علل التثنية ، لابن جني ، وهي رسالة صغيرة تناول فيها آراء العلماء في إعراب المثنى .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../ebn%20gny.zip
23- الجمل في النحو ، كتاب منسوب للخليل ، وهو لابن شقير ، وهو الكتاب المنسوب للخليل خطأ ، تناول فيه أبواب النحو المعروفة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...al_joumale.zip
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/algumal.zip
24- اللباب علل البناء والإعراب للعكبري ، تناول فيه أسباب بناء بعض المفردات ، وإعراب بعضها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/al_lubab.zip
25- الحدود في النحو للرماني ، وهي رسالة صغيرة تناول فيه حدود بعض الوظائف والمصطلحات النحوية .
http://www.almeshkat.net/books/archi...rif_romani.zip
26- اللامات ، للزجاجي ، وهي رسالة صغيرة تناول فيها حرف اللام ومعانيه واستعمالاته في اللغة والنحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...tab_laamat.zip
27- معاني الحروف ، للزجاجي ، وقد تناول فيه معاني الحروف واستعمالاتها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ni_zajjaji.zip
28- شرح أبيات (لاسيّما) للسجاعي ، لمحمد الأمير ، وهو المشهور صاحب حاشية الأمير على مغنى اللبيب ، ففي هذا الكتاب الصغير الحجم عظيم الفائدة تناول أبيات للسجاعي في (لاسيّما) فقط ، فأخذ الأمير يشرحها وبين آراء العلماء السابقين بطريقة رائعة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alsugaei.zip
29- رسالة الحروف ، للفارابي ، تناول فيه الحروف ومعانيها ، واستعمالاتها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/alfrabi.zip
30- الحدود ، للرماني ، وهي رسالة مختصرة تضع حدود لبعض الوظائف والمصطلحات النحوية .
http://www.almeshkat.net/vb/images/banners/hdood_r.zip
31- أجوبة لمسائل سألها الإمام النووي في ألفاظ الحديث ، وهي رسالة بينه وبين ابن مالك ، والكتاب قديم ومؤلفه غير معروف ، والرسالة تعرض أسئلة سألها النووي لابن مالك في بعض ألفاظ الحديث ، وخصوصا في يخص الإعراب ، والأوجه المختلفة ، الرسالة قيمة .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/nwawi2.rar
32- العدد في اللغة ، لابن سيدة الأندلسي ، صاحب المخصص ، والمحكم في اللغة ، وقد تناول في هذا الكتاب الصغير أحكام العدد ، وبعض ما يتصل به .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/add.zip
33- منازل الحروف ، للرماني ، وهو اختصار لكتابه معاني الحروف .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/hourouf.zip
34- شرح أبيات المفصل للسيد الشريف ، حيث قام بشرح أبيات المفصل للزمخشري وإعرابها ، الكتاب مفيد جدا وهو مكون من خمسة أجزاء وهذه الوصلات الخمس .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5696&type=l
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5697&type=l
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5698&type=l
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5699&type=l
http://www.jewar.com/book/go.php?id=5700&type=l
35- سر صناعة الإعراب ، لابن جني ، من مشاهير كتبه بعد الخصائص واللمع ، بل هو يفوق اللمع ، وهو في أبواب النحو ، وهذه النسخة pdf غير مرتبة .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2346&type=l
36- إعراب لامية العرب للشنفري ، وهي لأبي البقاء العكبري ، حيث قام بإعراب أبيات قصيدة الشنفرى :
أقيموا بني أمي ...
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2324&type=l
37- رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع الأزمنة ، لأحمد بن قاسم الصباغ .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=2342&type=l
38- الحلل في شرح أبيات الجمل ، لابن السيد البطليوسي ، حيث قام بشرح أبيات جمل الزجاجي ، وإعرابها ، ونسبتها .
http://jewar.com/book/go.php?id=4540&type=l
39- الأشباه والنظائر ، للسيوطي ، وميزة هذه النسخة أنها بالتشكيل .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...2&d=1111420821
40 - شرح كافية ابن الحاجب ، للرضي ، من أعظم الكتب ، وأنفعها في النحو .
http://www.daraleman.net/uploads/Shar7RadhiKafyya.rar
الكتب الصرفية القديمة والحديثة ( كتب الوورد والإلكترونية) :-
1- مختصر التصريف ، لأبن جني ، وهو المسمى بالتصريف الملوكي ، وهو غير شرح تصريف المازني لابن جني ، وكلاهما في الصرف .
http://www.almeshkat.net/books/archi...Mokhtassar.zip
2- الشافية في علم التصريف ، وهو لابن الحاجب ، تناول فيه الصرف ، معنى ، ثم أبوابه كالأوزان وغيرها ، والكتاب مهم جدا في الصرف ومن المراجع وعليه للرضي ، كما شرح الكافية في النحو لابن الحاجب .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/shafya1.zip
3- شرح شافية ابن الحاجب ، للرضي ، ومن من أعظم الكتب ، وأنفعها مع شرح الكافية له أيضا .
http://www.daraleman.net/uploads/Shar7Shaafiyah.rar
4- لامية الأفعال ، لابن مالك ، وهي منظومة شعرية تناول فيها الأفعال وتصريفها ، أي المسائل الصرفية المتعلقة بالأفعال ، وعلى اللامية شروح عديدة ، منها من المحدثين الصعيدي .
http://www.almeshkat.net/books/archi...tt%20afaal.zip
5- فتح المتعال على القصيدة المسمّاة بلامية الأفعال ، وهي لحمد الصعيدي ، ولامية الأفعال لابن مالك .
http://www.almeshkat.net/books/archi...20almutaal.zip
6- شذا العرف في فن الصرف ، من أشهر كتب الصرف الحديثة ن مع أنه صغير إلا أنه عظيم الفائدة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ha%20alarf.zip
7- كتاب الأفعال ، لابن القطاع ن تناول فيه تصريف الأفعال .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alafaal.zip
8- نقعة الصديان فيما جاء على الفعلان ، للصاغاني ، وهي رسالة صغيرة جمع فيها ما جاء على وزن فعلان من الأسماء ، وقد رتبها ترتيب المعجم .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/sdysn.zip
9- نزهة الطرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف ، لصادق البيضاني ، كتاب حديث في علم الصرف وتيسيره .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/altef.zip
كتب تاريخ النحو وتراجم النحاة القديمة والحديثة ( كتب الوورد والإلكترونية) :-
1- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي ، من أشهر كتب تراجم النحاة ، وهو مرجع في معرفة النحاة ومؤلفاتهم ، سواء المعروفين ، والمغمورين .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alwaaah.zip
2- تاريخ العلماء النحويين ، للتنوخي ، تناول فيه تراجم النحاة إلا أنه لا يتسم بالشمول .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../tarek%20n.zip
3- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، للفيروز آبادي ، صاحب القاموس المحيط ، تناول فيه تراجم أئمة النحو يعتبر مرجع لكن ليس كبغية الوعاة .
http://www.almeshkat.net/books/archi.../albulkh22.zip
4- أخبار النحويين ، لأبي طاهر المقرئ ، تناول فيه أخبار بعض النحاة ، ويعتبر مرجع في أخبار بعض النحاة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/taheer_n.zip
5- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات الأنباري ، من كتب تراجم النحاة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...zht%20odba.zip
6- من تاريخ النحو ، لسعيد الأفغاني ، وهو من الكتب الحديثة تناول فيه نشوء النحو ، والخلافات والفروق بين المدرستين البصرية ، والكوفية ، وأصول كل مدرسة ، وذكر أمثلة لخلافاتهم ، وبعض أعلامهم ، الكتاب بصيغة pdf .
http://www.fikr.com/freebooks/pdf/history.pdf
الكتب والبحوث الحديثة والمعاصرة في النحو العربي وأصول النحو (كتب الوورد والإلكترونية) :-
1- النحو الوافي ، لعباس حسن ، من أشهر الكتب الحديثة في النحو ، ولا غنى للنحوي عنه لما فيه من تفصيل فضله على غيره من كتب المعاصرين على كثرتها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...aho%20wafi.zip
2- جامع الدروس العربية ، لمصطفى الغلاييني ، كتاب غني عن التعريف ، ينصح به لمن أراد البدء في النحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...os%20arbia.zip
حروف المعاني بين الأصالة والحداثة ، لحسن عباس ، تناول فيها حروف المعاني .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/hroof_m.zip
3- النحو إلى أصول ، لعبد الله العتيق ، بحث جيد تناول فيه أصول النحو مختصرا .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/naho.zip
4- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ، وهو للشيخ خالد لأزهري ، وقد شرح فيه قواعد الإعراب لابن هشام .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/MUSEL3.zip
5- الهداية في النحو ، هذا الكتاب موجودٌ على النت، وقد عمله المجمع العلمي الإسلامي لتيسير النحوعلى الطلاب ، و الكتاب ألكتروني
http://www.daraleman.net/uploads/HidaayaFiNahu.rar
6- الحدود في علم النحو لأحمد الأبذي ، تناول فيه تعريفات لبعض المصطلحات النحوية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/hudod3.zip
7- لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20aleerab.zip
8- الخصائص اللغوية لقراءة حفص ( دراسة صرفية نحوية ( وهي رسالة علمية ، لعلاء الحمزاوي ،دراسة في القراءات القرآنية تعرض للخصائص الصرفية والنحوية لرواية حفص عن عاصم ¡ وتبين عن الأسباب التي أدت إلى شهرة رواية حفص عن عاصم في المشرق الإسلامي .
http://abooks.tipsclub.com/index.php...ownload&id=727
9- خصا ئص الحروف العربية ومعانيها ، بحث حديث لحسن عباس ، تناول الحروف ومعانيها ، واستعمالاتها ، وهو بحث قيّم .
http://www.almeshkat.net/books/archi...i%20alhrof.zip
10- معجم قواعد اللغة العربية، لعبد الغني الدقر، كتاب حديث تناول النحو والصرف والإملاء باختصار وتيسير .
http://www.almeshkat.net/books/archi...m%20arabia.zip
11- الموجز في قواعد اللغة العربية ، لسعيد الأفغاني ، تناول فيه أبواب النحو والصرف بصورة سلسلة سهلة ، غرضها تيسير النحو .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/afghani.zip
12- قواعد اللغة العربية المبسطة ، لعبد اللطيف السعيد ، وهي كتاب حديث تناول فيه قواعد النحو والإملاء باختصار وللتيسير .
http://www.almeshkat.net/books/archi...eed%20luka.zip
13- دخول ( أل ) بمعنى الذي على الفعل المضارع دراسة نحوية نقدية في معنى الضرورة ، لعامر العلواني ، وهو بحث حديث تناول هذه المسألة التي تعد ضرورة عند النحاة .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/1582.zip
14- مقصوصات صرفية ونحوية ، لثامر المصاروة ، وهو كتاب حديث تناول فيه بعض المسائل الصرفية ، وبعض المنصوبات في النحو ، وقام بعرضها بصورة سهلية ، قصده التيسير لطلاب المدارس.
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/mksosat.zip
15- معجم الأفعال المتعدية بحرف ، لموسى بن محمد بن الملياني ، وهو حديث ، جمع مؤلفه فيه الأفعال المتعدية بحرف من المعاجم المختلفة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/afaal_h.zip
16- نظم شذور الذهب في كلام العرب ، لمحمد اليعقوبي ، وهو حديث حيث قام بنظم كتاب شذور الذهب لابن هشام شعرا ، ما يقارب خمسمائة بيت .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/shzoor.zip
17- النحاة وحروف الجر ، للزعبلاوي ، بحث قيم تناول فيه حروف الجر .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alnoha.zip
18- التحفة الوفيّة بمعاني حروف العربيّة لإبراهيم بن محمد السفاقسي ، تناول فيه معني الحروف في العربية على اختلافها .
http://www.almeshkat.net/books/archi...fa%20wafia.zip
19- كتاب الحروف ، لأبي الحسين المزني ، تناول فيه معاني الحروف واستعمالاتها في العربية .
http://www.almeshkat.net/books/archi...s/alhroof2.zip
20- الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، أبو سعيد العلائي الشافعي ، تناول فيها مسألة الواو الزائدة .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ol%20mzedh.zip
21- المنظومة المختصرة في النحو ، لسعيد المري ، وهو حديث ، تناول فيها النحو مختصرا كمنظومة شعرية .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/nho2.zip
22- المختصر الفريد على نظم الشيخ سعيد ، لحمد المري ، وهذه منظومة شعرية مختصرة لا تتجاوز الستين بيتا في النحو ، وهو حديث .
http://www.almeshkat.net/books/archi...zm%20saaed.zip
23- لب الإعراب في تيسير علم النحو للطلاب ، لفيصل آل مبارك ، وهو كتاب حديث مختصر لتيسير النحو للطلاب http://www.almeshkat.net/books/archive/books/f14.rar
24- قواعد اللغة العربية (الكفاف) ، ليوسف الصيداوي ، كتاب حديث ، وتناول فيه أبواب النحو مختصرا تيسيرا للطلاب .
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/kwaed22.zip
25- علامات الإعراب ( عرض بورباوينت) ، لإسماعيل السحيباني ، وهو لطيف للمدرسين في المدارس ن فهو يساعدهم على تفهيم الطلاب علامات الإعراب دون عناء ، بواسطة هذا العرض الجيد .
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/eeraab.rar
26- إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل ، للصديقي .
http://www.almeshkat.net/books/archi...%20alfaeel.zip
27- بحث في أسباب ظهور الحواشي والشروح في النحو العربي .
http://www.jewar.com/book/go.php?id=4961&type=l
28- النحو الواضح ، للجارم ، وأمين ، و هو من الكتب المعروفة في النحو للطلاب ، وهذا موقع منسق على أبواب الكتاب .
http://zahra1.com/Nah_Em_7att_balagah/F_ALNAHW.html
29- نزع الخافض في الدرس النحوي ، لحسين الحبشي ، وهو بحث قيم تناول فيه مسألة نزع الخافض ، أي حذف حرف الجر ونصب الاسم المجرور .
http://www.saaid.net/book/8/1536.zip
30- دور اللهجات في التقعيد النحوي ، لعلاء الحمزاوي ، وهو بحث قيم تناول اللهجات فيه عن طريق كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ، مبينا دور اللهجات في التقعيد النحوي .
http://www.saaid.net/book/8/1433.zip
31- موقف شوقي ضيف من الدرس النحوي ، لعلاء الحمزاوي ، وهو بحث تناول فيه موقف شوقي ضيف من ابن مضاء ، ومدى توافقه معه في الدعوة إلى تيسير النحو ومخالفة النحاة المتقدمين والمتأخرين .
http://www.saaid.net/book/8/1428.zip
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 17:23|
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 17:21|
| موسوعة
النحو والإعراب | |||||||||||||||||
| مقدمة الموسوعة | تمهيد | ||||||||||||||||
| الجزء الأول | الباب الأول ( الإعراب والبناء ) | ||||||||||||||||
| الباب الثاني ( المبني من الأسماء ) | |||||||||||||||||
| الباب الأول ( علامات الإعراب الفرعية ) | |||||||||||||||||
| الباب الثاني ( الفعل اللازم والمتعدي ) | |||||||||||||||||
| الجزء الثالث | الباب الأول | المبتدأ | الخبر | ||||||||||||||
| كان وأخوتها | ما يعمل عمل ليس | ||||||||||||||||
| الباب الثاني | إن وأخوتها | لا النافية للجنس | |||||||||||||||
| الفاعل | نائب الفاعل | ||||||||||||||||
| الجزء الرابع | الباب الأول ( المنصوبات ) | المفعول به | الاختصاص | المفعول المطلق | |||||||||||||
| المفعول فيه | المفعول معه | المفعول لأجله | |||||||||||||||
| الاستثناء | المنادى | الاستغاثة | |||||||||||||||
| الحال | التمييز | ||||||||||||||||
| الجزء الخامس | الباب الأول | المجرورات ج1 - ج2 - ج3 | |||||||||||||||
| الباب الثاني | حروف المعاني ج1 - ج2 - ج3 - ج4 | ||||||||||||||||
| الباب الثالث | الجمل ج1 - ج2 | ||||||||||||||||
| الباب الرابع ( التوابع ) | العطف والنعت | التوكيد والبدل | |||||||||||||||
| الجزء السادس | الباب الأول ( أساليب النحو ) | أسلوب الشرط ج1 - ج2 | أسلوب الاستفهام | أسلوب القسم | |||||||||||||
| أسلوب الإغراء والتحذير | أسلوب التعجب | أسلوب المدح والذم | |||||||||||||||
| الباب الثاني ( المشتقات والمصادر ) | اسم الفاعل وصيغ المبالغة | الصفة المشبهة | اسم المفعول | ||||||||||||||
| اسم التفضيل | اسما الزمان والمكان واسم الآلة | المصادر ج1 - ج2 | |||||||||||||||
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 17:18|
ادونيس..الصوفية والسوريالية
ادونيس.. مفرد بصيغة
الجمع.
ادونيس..أوراق في الريح.
ادونيس..الاعمال
الشعريه..اغانى مهيار الدمشقى وقصائد اخرى
ادونيس..الاعمال
الشعريه..مفرد بصيغة الجمع وقصائد اخرى.
ادونيس..الاعمال
الشعريه..هذا هو اسمى وقصائد اخرى
دونيس..الثابت و المتحول
بحث في الاتباع و الابداع عندالعرب..3-صدمة الحداثة.
ادونيس..الثابت و
المتحول..بحث في الابداع و الاتباع عند العرب..1-الاصول.
ادونيس..الثابت و
المتحول..بحث في الابداع و الاتباع عند العرب..2-تاصيل الاصول.
ادونيس..الثابت و
المتحول.بحث في الابداع و الاتباع عند العرب..4-صدمة الحداثة و سلطةالموروث
الشعرى.pdf
ادونيس..الشعريه العربيه.
ادونيس..المسرح و
المرايا 1965-1967
ادونيس..المطابقات
والأوائل.
ادونيس..اوراق في الريح
1955-1960
ادونيس..ديوان الشعر
العربي.
ادونيس..قصائد اولي
1929-1955.
ادونيس..كتاب التحولات و
الهجره في اقاليم النهار و الليل.
ادونيس..كتاب
الحصار..حزيران 82 حزيران 85.
ادونيس..هذا هو اسمي.
اعمال اخرى..ترجمة
ايف بونفوا..الأعمال الشعرية الكاملة.. ترجمة أدونيس.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 17:17|
دانلود 15 درس صوتی با کیفیت بالا برای یادگیری مکالمه عربی به لهجه لبنانی
 لهجه زیبای لبنانی از دسته لهجه های شامی بوده و حدود 80 در صد از کلمات
آن با لهجه سوریه مشترک است. در این لهجه کلمه های انگلیسی، فرانسه، ترکی و
فارسی زیادی هم یافت می شود و علت آن هم تلاقی اقوام و ملل مختلف در این
منطقه در طول تاریخ است.
لهجه زیبای لبنانی از دسته لهجه های شامی بوده و حدود 80 در صد از کلمات
آن با لهجه سوریه مشترک است. در این لهجه کلمه های انگلیسی، فرانسه، ترکی و
فارسی زیادی هم یافت می شود و علت آن هم تلاقی اقوام و ملل مختلف در این
منطقه در طول تاریخ است.این لهجه در ایران طرفداران زیادی دارد و اکثر کسانی که می خواهند یک لهجه عامیانه عربی را یاد بگیرند، لهجه لبنانی را انتخاب می کنند.
در این پست 15 درس صوتی گذاشته ام که می تواند شروع خوبی برای علاقه مندان به این لهجه باشد، چون اکثر مباحث مقدماتی این لهجه در این پانزده درس موجود است. البته لازم به ذکر است که معنای لغتها و جملات در این درسها به انگلیسی گفته می شود و برای استفاده بهتر از درسها باید کمی با انگلیسی آشنایی داشته باشید.
حجم 11
مگابایت/ سرور: 4shared
مواد لتعلم و
تعليم اللهجة اللبنانية - اللهجة الشامية - 15 دروس صوتية لتعلم اللهجة
اللبنانية Lebanese Colloquial: Ultimate Arabic Beginner-Intermediate
آموزش لهجه عامیانه لبنانی - لهجه های عامیانه دارجه لهجه دارجه لبنان عربی
لبنانی عربی شرقی -
.................................................................................................................
دانلود آموزش مکالمه عربی (لهجه شامی) به روش پیمسلر (نصرت)

روش پیمسلر
یکی از رائج ترین و ساندویچی
ترین روشهای آموزش زبانهای خارجی در دنیاست. این روش توسط یه روانشناس
با نام دکتر پیمسلر ابداع شده و در ایران بیشتر به نام "نصرت" شناخته می شود.تا کنون دهها دوره و کورس آموزشی برای دهها
زبان دنیا با استفاده از این روش ساخته شده است. ویژگی این کورسها سرعت و
اعتماد انها بر تعامل فعال
شنیداری_گفتاری با زبان اموز است.
مجموعه ای که در این پست تقدیمتان می کنیم سلسله درسهای آموزش مکالمه عربی به لهجه شامی (سوریه،اردن،فلسطین، لبنان) است که بر اساس همین روش تولید شده است. امیدوارم که برای شما دوست عزیز مفید باشد. لازم به ذکر است که15 قسمت از این درسها را سابقا در وبلاگ گذاشته بودم (اینجا )، پس مواظب باشید آنها را دوباره دانلود نکنید.
این را هم باید اضافه کنم که مثل همیشه برای استفاده از این درسها هم باید کمی زبان انگلیسی آشنا باشید.
مجموعه ای که در این پست تقدیمتان می کنیم سلسله درسهای آموزش مکالمه عربی به لهجه شامی (سوریه،اردن،فلسطین، لبنان) است که بر اساس همین روش تولید شده است. امیدوارم که برای شما دوست عزیز مفید باشد. لازم به ذکر است که15 قسمت از این درسها را سابقا در وبلاگ گذاشته بودم (اینجا )، پس مواظب باشید آنها را دوباره دانلود نکنید.
این را هم باید اضافه کنم که مثل همیشه برای استفاده از این درسها هم باید کمی زبان انگلیسی آشنا باشید.
بخش اول شامل 30 درس
Lessons 1-10: Pimsleur Arabic Eastern lessons 1-10.rar (66.58 MB)
Lessons 11-20: Pimsleur Arabic Eastern lessons 11-20.rar (94.2 MB)
Lessons 21-30: Pimsleur Arabic Eastern lessons 21-30.rar (98.32 MB)
بخش دوم شامل چند درس تقویتی
Lessons 1-9: Pimsleur Arabic II lessons 1-9.rar (61.87 MB)
Lessons 10-19: Pimsleur Arabic II lessons 10-19.rar (67.79 MB)
Lessons 20-29: Primsleur Arabic II lessons 20-29.rar (75.25 MB
Lessons 1-10: Pimsleur Arabic Eastern lessons 1-10.rar (66.58 MB)
Lessons 11-20: Pimsleur Arabic Eastern lessons 11-20.rar (94.2 MB)
Lessons 21-30: Pimsleur Arabic Eastern lessons 21-30.rar (98.32 MB)
بخش دوم شامل چند درس تقویتی
Lessons 1-9: Pimsleur Arabic II lessons 1-9.rar (61.87 MB)
Lessons 10-19: Pimsleur Arabic II lessons 10-19.rar (67.79 MB)
Lessons 20-29: Primsleur Arabic II lessons 20-29.rar (75.25 MB
......................................................................................................................
ده درس کوتاه برای آموزش لهجه اردنی (با فایلهای صوتی)
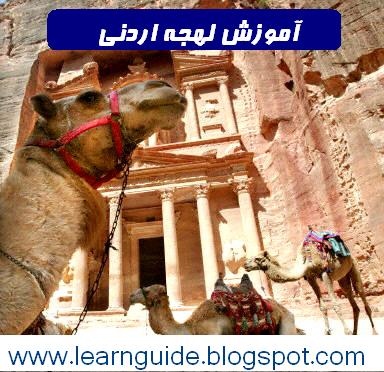 لهجه اردنی از زیرمجموعه های لهجه شامی بوده و از قشنگترین لهجه
های عربی است. این لهجه شباهت زیادی هم به لهجه های فلسطینی ، لبنانی و
سوری دارد. مجموعه زیر شامل ده درس آموزش مقدماتی لهجه اردنی بوده و حاوی
فایلهای صوتی برای هر درس هم می باشد.
لهجه اردنی از زیرمجموعه های لهجه شامی بوده و از قشنگترین لهجه
های عربی است. این لهجه شباهت زیادی هم به لهجه های فلسطینی ، لبنانی و
سوری دارد. مجموعه زیر شامل ده درس آموزش مقدماتی لهجه اردنی بوده و حاوی
فایلهای صوتی برای هر درس هم می باشد.»»:دانلود
کتاب ( پی دی اف):««
دانلود فایلهای صوتی به تفکیک درسها:Lesson 1: Greetings & Personal Identification
Lesson 2: Physical State
Lesson 3: Family
Lesson 4: Useful Expressions
Lesson 5: Communication Difficulties
Lesson 6: Food
Lesson 7: Directions
Lesson 8: Numbers & Money
Lesson 9: Question Words
Lesson 10: Time Sense
.................................................................................................................................
دانلود فایلهای صوتی به تفکیک درسها:Lesson 1: Greetings & Personal Identification
Lesson 2: Physical State
Lesson 3: Family
Lesson 4: Useful Expressions
Lesson 5: Communication Difficulties
Lesson 6: Food
Lesson 7: Directions
Lesson 8: Numbers & Money
Lesson 9: Question Words
Lesson 10: Time Sense
.................................................................................................................................
دانلود کتاب آموزش مکالمه عربی به لهجه لبنانی با فایلهای صوتی (Spoken Lebanese - Audio Book )
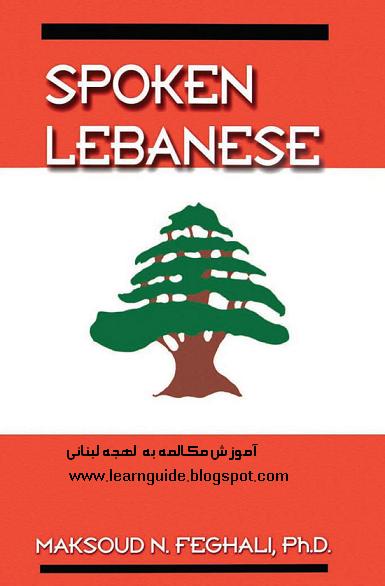 کتاب
Spoken Lebanese دوره ای مختصر و مفید برای یادگیری مکالمه به لهجه
لبنانی است. البته طبق معمول برای استفاده از این کتاب نیاز به اشنایی نسبی
با زبان انگلیسی دارید چون کلمات هر درس به زبان انگلیسی توضیح داده شده
اند. ضمنا حروف استفاده شده در این کتاب برای محاورات، عربی نیست بلکه
لاتینی-عددی است که توسط جوانان این دوره زمونه! اختراع شده است و یک چیزی
شبیه به فینگلیش خودمانه! (این قسمت به لهجه همدانی بود که به زودی کتبش هم
تالیف می شود)
کتاب
Spoken Lebanese دوره ای مختصر و مفید برای یادگیری مکالمه به لهجه
لبنانی است. البته طبق معمول برای استفاده از این کتاب نیاز به اشنایی نسبی
با زبان انگلیسی دارید چون کلمات هر درس به زبان انگلیسی توضیح داده شده
اند. ضمنا حروف استفاده شده در این کتاب برای محاورات، عربی نیست بلکه
لاتینی-عددی است که توسط جوانان این دوره زمونه! اختراع شده است و یک چیزی
شبیه به فینگلیش خودمانه! (این قسمت به لهجه همدانی بود که به زودی کتبش هم
تالیف می شود)مثلا به جای ح می نویسند 7 و محمد را به صورت Mo7ammad می نویسند.
البته من خواندن این کتاب را فرصت مناسبی برای شما می دانم تا با این حروف عربی قرن 21 هم آشنا شوید چون در خیلی از وبلاگها و چت رومهای عربی از ان استفاده می شود.
راستی قیمت این کتاب در فروشگاههای اینترنتی 25 دلار است.
دانلود کتاب (5 مگابایت )
دانلود فایلهای صوتی کتاب(15 مگابایت)
ٍ
This book is designed to teach Lebanese Arabic; it teaches conversational Lebanese Arabic by making use of a specially designed phonetic system.
![[download.png]](http://3.bp.blogspot.com/_SYandHDvpd4/SdKATiI8d9I/AAAAAAAAABs/JCe_7JjRfVE/s1600/download.png)
PDF ( 6 MB )
http://www.multiupload.com/E9RFD1X7UF
MP3 (15MB )
http://www.multiupload.com/RGEOARW5N8
..................................................................................................
دانلود بخش دوم فایلهای آموزش لهجه شامی(فلسطینی سوری لبنانی) به روش نصرت
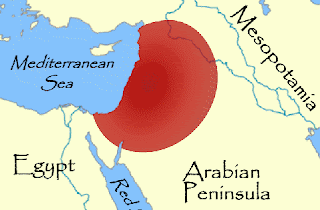 A
free eastern arabic course
A
free eastern arabic course دانلود بخش یکم ( 10.5 مگابایت)
دانلود بخش دوم (10.4 مگابایت)
دانلود بخش سوم با درسهایی پیشرفته تر (15 مگابایت)
..............................................................................................................
چند درس صوتی برای آموزش مکالمه عربی به لهجه شامی (لبنان سوریه اردن فلسطین) به روش پیمسلر و نصرت
مجموعه
ای که تقدیم تان خواهد شد شامل چند درس صوتی همراه با یک کتاب برای آموزش
لهجه شامی است. لهجه شامی از شیرینترین لهجه های عامیانه عربی بوده و در
کشورهای زیادی بویژه سوریه, اردن, لبنان و فلسطین قابل استفاده می باشد.
توجه: فرمت فایلهای صوتی amr است و برای پخش آن باید از گوشی موبایل (مثلا نوکیا یا سونی اریکسون) یا پلیرهایی مثل kmplayer یا nokia multimedia player استفاده کنید. به زودی درسهای دیگری هم برای علاقه مندان به لهجه شام آپلود خواهم کرد.
توجه: فرمت فایلهای صوتی amr است و برای پخش آن باید از گوشی موبایل (مثلا نوکیا یا سونی اریکسون) یا پلیرهایی مثل kmplayer یا nokia multimedia player استفاده کنید. به زودی درسهای دیگری هم برای علاقه مندان به لهجه شام آپلود خواهم کرد.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 23:10|
کتاب یالله ندردش بالعربي یک کتاب
بسیار عالی و بی نظیر آموزش لهجه مصری است. این کتاب توسط دو تن از استادان
دانشگاه آمریکایی قاهره به نامهای مونا کمال و أحمد حسنین به زبان انگلیسی
تالیف شده است و به علت درسها و روش آموزشی عالی آن به زبان روسی هم
ترجمه گردیده است. این کتاب دارای 20 درس است و از ویژگی های ان داشتن
تمرینات عملی و درسهای آموزش دستور زبان لهجه مصری است.
علاوه بر آن، این کتاب
دارای یک سی دی است که در آن فایلهای صوتی همه درسها قرار داده شده است.
پس پیش بروید مصری ها!
دانلود کتاب (انگلیسی-عربی)
دانلود کتاب
(روسی-عربی)
دانلود فایلهای
صوتی (انگلیسی-عربی)
Part1: Let's Chat
In Arabic(en-ar) part 1.rar (243.67
MB)
Part2 : Let's Chat In Arabic(en-ar) part 2.rar (221.76 MB
Part2 : Let's Chat In Arabic(en-ar) part 2.rar (221.76 MB
برای اجرای فایل کتاب نیاز به برنامه WinDjView دارید که از لینک زیر قابل دانلود است
Download WinDjView
..............................................................................................................
مجموعه آموزشیliving arabic زندگی با زبان عربی / فایلهای صوتی آموزشی برای یادگیری و تقویت مکالمه عربی فصیح و عامیانه
درسهای این مجموعه از آموزش تلفظ حروف الفبای عربی آغاز شده و
سپس به موضوعات متفاوتی چون خرید کردن، اجاره منزل، مسافرت و... می
پردازد.
این بسته آموزشی
چهار بخش دارد که بخش اول و دوم آموزش عربی فصیح برای مبتدیان بوده و دو
بخش دیگر حاوی دهها فایل صوتی مکالمه و تمرین برای علاقه مندان به یادگیری
لهجه های عامیانه است.
باید
این را هم اضافه کنم که بخشهای سوم و چهرام برای مبتدیان کمی سخت است و
کلمات و عبارات درسها به انگلیسی ترجمه می شود.
تنها مشکل این است که آپلود کننده این
فایلها آنها را در سایت فورشرد آپلود کرده و شاید برای بعضی ها دانلود از
این سایت سخت باشد.
هر
قسمت از این مجموعه بین 22 تا 24 مگابایت حجم دارد.
آپلود شده
توسط: Mastering Arabic
.........................................................................................................
دانلود رایگان آموزش مكالمه زبان عربي 90 روز به روش pimsleur method لهجه مصری

دانلود کتابچه همراه(4.5 مگابایت)
multiupload or mediafire or Download
آموزش مقدماتی گرامر عربی
Arabic Grammar.hlp 148.37 KB
دانلود فایلهای صوتی (در سه بخش)
Part1 (39 MB)
mediafire OR multiupload OR click here
Part2 (58 MB)
mediafire OR multiupload OR click here
Part3 (45 MB)
mediafire OR multiupload OR click here
Egyptian self-taught Arabic
.................................................................................................
multiupload or mediafire or Download
آموزش مقدماتی گرامر عربی
Arabic Grammar.hlp 148.37 KB
دانلود فایلهای صوتی (در سه بخش)
Part1 (39 MB)
mediafire OR multiupload OR click here
Part2 (58 MB)
mediafire OR multiupload OR click here
Part3 (45 MB)
mediafire OR multiupload OR click here
Egyptian self-taught Arabic
.................................................................................................
دانلود یک سی دی آموزشی دیگر برای مکالمه به لهجه مصری (سی دی کله تمام / آموزش مکالمه به لهجه مصری)
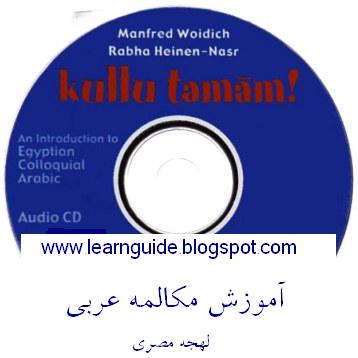
قبلا در این وبلاگ یک سی دی آموزش لهجه مصری
قرار داده بودم که مورد استقبال بازدیدکنندگان وبلاگ قرار گرفته بود.
اینبار هم یک سی دی جدید برای علاقه مندان به مکالمه عربی و بویژه لهجه
مصری دارم . حجم این سی دی از سی دی قبلی کمتر است و در چند سرور آپلود شده
است. نام این سی دی آموزشی "کله
تمام" است که در لهجه مصری به معنای " خوبه، درسته و همش عالیه" است.
امیدورام از استفاده از این سی دی لذت
ببرید.
»»:دانلود کتاب(37 مگابایت) :««
لینک اصلاح شد
»»:دانلود فایلهای صوتی کتاب(54مگابایت):««
...................................................................................................................................................................
»»:دانلود کتاب(37 مگابایت) :««
لینک اصلاح شد
»»:دانلود فایلهای صوتی کتاب(54مگابایت):««
مختصری درمورد لهجه مصری همراه با دانلود سی دی آموزشی آن

لهجه مصری یکی از لهجه های زبان عربی است.نشأت این لهجه در منطقه دلتای نیل(مصر سفلی) و در قلب تمدن مصر(قاهره و اسکندریه امروزی) صورت پذیرفته است و هم اکنون بیش از 79 ملیون نفر به آن صحبت می کنند. (دانلود آموزش لهجه مصری)
هرچند که این لهجه در اصل برای گفتار و مکالمه های روزمره و کوچه و بازاری است ولی بسیاری از هنرمندان و نویسندگان از آن برای نوشتن رمان,فیلمنامه,اشعار عامیانه و داستانهای طنز و ترانه های محلی و امثال آن استفاده می کنند. ولی با این حال زبان رائج روزنامه ها , کتابها و بیشتر برنامه های تلوزیون همان عربی فصیح است.
لهجه یا زبان؟
بیشتر مصری ها لهجه ی خودشان را یکی از لهجات زبان
عربی می دانند و نه یک زبان مستقل و جدا. ولی بعضی از زبان شناسان و
اساتید زبان عربی نیز معتقدند که باوجود اینکه لهجه مصری از زبان عربی ریشه
گرفته است ولی تفاوت آن با زبان عربی بقدری هست که بتوان آنرا زبانی مستقل
در کنار زبان عربی شمرد.چرا که این زبان(به قول انها) از زبانهای دیگری هم
کم و بیش تاثیر پذیرفته است از جمله زبانهای
قبطی,یونانی,ترکی,فارسی,ایتالیایی,و فرانسوی.
و اینک نمونه هایی از این تاثیر پذیری و ورود لغات بیگانه به لهجه مصری را بررسی می کنیم:
و اینک نمونه هایی از این تاثیر پذیری و ورود لغات بیگانه به لهجه مصری را بررسی می کنیم:
قبطی
o إدّي/يـِدّي = إعطي/يعطي داد می دهد
o بسة = قطة گربه
o إدّي/يـِدّي = إعطي/يعطي داد می دهد
o بسة = قطة گربه
* ايتالیایی:
o جمبري Gamberi = روبيان میگو
o جمبري Gamberi = روبيان میگو
* ترکی:
o أوضة oda= غرفة که از کلمه اتاق در ترکی گرفته شده است
دغري(به کسر دال و ضم آن): مستقیم، مستقیما، فورا که در عربی فصیح به جای آن از فورا و مباشرة استفاده می شود. مثلا: روح دغري : مستقیم برو
افندم: قربان ، آقا (گاهی مجازا به معنای ببخشید استفاده می شود مانند اینکه بخواهید کسی را صدا بکنید که در فارسی می گوییم: ببخشید)
تز: که برای تحقیر و مسخره کردن و اهمیت نشان ندادن استفاده می شود. استعمال این کلمه مانند استعمال کلمه زرشک در فارسی است که گاهی برای مسخره کردن استفاده می شود با این فرق که تز اهانت بیشتری دارد.(در مورد این کلمه بیشتر بدانید)
o أوضة oda= غرفة که از کلمه اتاق در ترکی گرفته شده است
دغري(به کسر دال و ضم آن): مستقیم، مستقیما، فورا که در عربی فصیح به جای آن از فورا و مباشرة استفاده می شود. مثلا: روح دغري : مستقیم برو
افندم: قربان ، آقا (گاهی مجازا به معنای ببخشید استفاده می شود مانند اینکه بخواهید کسی را صدا بکنید که در فارسی می گوییم: ببخشید)
تز: که برای تحقیر و مسخره کردن و اهمیت نشان ندادن استفاده می شود. استعمال این کلمه مانند استعمال کلمه زرشک در فارسی است که گاهی برای مسخره کردن استفاده می شود با این فرق که تز اهانت بیشتری دارد.(در مورد این کلمه بیشتر بدانید)
* فارسی
o أستاذ = همان استاد فارسی
برنامج: برنامه
البته این دوکلمه وارد عربی فصیح هم شده اند.
o أستاذ = همان استاد فارسی
برنامج: برنامه
البته این دوکلمه وارد عربی فصیح هم شده اند.
* فرانسوی
o چيبة jupe = تنورة دامن
انگلیسی
o فاول \ يفاول to foul= ركلة خاطئة كرة قدم خطا یا همان فول در ورزش
لهجه مصری چگونه نوشته می شود؟
o چيبة jupe = تنورة دامن
انگلیسی
o فاول \ يفاول to foul= ركلة خاطئة كرة قدم خطا یا همان فول در ورزش
لهجه مصری چگونه نوشته می شود؟
در بین مردم رائج است که لهجه مصری را با حروف
عربی بنویسند ولی بسیاری هم هستند که این لهجه را با حروف لاتین می
نویسند.مثال:
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر به
لهجه مصری (حروف عربی و لاتینی)
اول به فارسی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر,ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند .(ای بابا چه دل خوشی دارند!)
اعلامیه جهانی حقوق بشر,ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند .(ای بابا چه دل خوشی دارند!)
با حروف عربی:
((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
المادة الأولانيه:
البنيأدمين كلهم مولودين حرين ومتساويين فالكرامة والحقوق. إتوهبلهم العئل و الضمير، والمفروض يعاملوا بعض بروح الأخويه.))
البنيأدمين كلهم مولودين حرين ومتساويين فالكرامة والحقوق. إتوهبلهم العئل و الضمير، والمفروض يعاملوا بعض بروح الأخويه.))
با حروف لاتینی:
Il Iħlan il Ħalemi li Ĥoxux il Insan, il medda-l ewweleniyya
Il benixedmiin kollohom mewludiin ĥorriin wi mitsewyiin fi-k karama wi-l ĥoxux. Itweheblohom il ħexl wi-d damiir, wi-l mafrud yiħemlo baħd bi roĥ il eķewiyya.
Il Iħlan il Ħalemi li Ĥoxux il Insan, il medda-l ewweleniyya
Il benixedmiin kollohom mewludiin ĥorriin wi mitsewyiin fi-k karama wi-l ĥoxux. Itweheblohom il ħexl wi-d damiir, wi-l mafrud yiħemlo baħd bi roĥ il eķewiyya.
در بین بعض از مردم هم رائج شده
که بعضی از حروف را درلهجه مصری و حتی لهجه های دیگر عربی با اعداد
بنویسند. البته در اینترنت بعضا می بینم که عربی فصیح را هم بعضی ها
بدینصورت می نویسند. مثلا به جای ح از 7 استفاده می کنند.
((Ele3lan el3alami le72oo2 elensan elmadda elola: kol elnas mawloodeen a7rar we motsawyeen fi elkarama we el72oo2 ، etwahablohom el3a2l we eldameer we elmafrood ye3amlo ba3dh beroo7 a7`away))
شاید یکی از عواملی که باعث شده بسیاری از مصری ها و غیر مصری ها لهجه مصری را زبان مستقلی به حساب نیاورند این است که این لهجه کلمات عربی فراوانی دارد و از قواعد عربی هم در آن استفاده شده است و بسیاری از عربهای غیر مصری هم این لهجه را به خوبی می فهمند حتی گاهی اتفاق می افتد که دو عرب از دو کشور متقاوت مثل موریتانی و عربستان لهجه همدیگر را نفهمند و برای فهماندن منظور خود از لهجه مصری استفاده کنند! البته در این زمینه فراوانیِ فیلمها و شبکه های ماهواره ای مصری را بی تاثیر نمی بینم. لازم به ذکر است که گروههای زیادی در مصر خواهان ترویج لهجه مصری با حروف لاتین و یا قبطی و زبان مستقل شمردن آن هستند.
مختصری از قواعد لهجه مصری
((Ele3lan el3alami le72oo2 elensan elmadda elola: kol elnas mawloodeen a7rar we motsawyeen fi elkarama we el72oo2 ، etwahablohom el3a2l we eldameer we elmafrood ye3amlo ba3dh beroo7 a7`away))
شاید یکی از عواملی که باعث شده بسیاری از مصری ها و غیر مصری ها لهجه مصری را زبان مستقلی به حساب نیاورند این است که این لهجه کلمات عربی فراوانی دارد و از قواعد عربی هم در آن استفاده شده است و بسیاری از عربهای غیر مصری هم این لهجه را به خوبی می فهمند حتی گاهی اتفاق می افتد که دو عرب از دو کشور متقاوت مثل موریتانی و عربستان لهجه همدیگر را نفهمند و برای فهماندن منظور خود از لهجه مصری استفاده کنند! البته در این زمینه فراوانیِ فیلمها و شبکه های ماهواره ای مصری را بی تاثیر نمی بینم. لازم به ذکر است که گروههای زیادی در مصر خواهان ترویج لهجه مصری با حروف لاتین و یا قبطی و زبان مستقل شمردن آن هستند.
مختصری از قواعد لهجه مصری
یکی از قواعد این لهجه در تلفظ تخفیف حروف(تلفظ
راحت آنها)است. مصری ها همانند سوری ها و لبنانی ها و بعضی ملتهای عربی
دیگر فرقی بین ضاد و ذال و ظا در تلفظ قائل نیستند و همه را "ز" تلفظ می
کنند. گاهی وقتها هم اگر تلفظ ظا یا ذال برایشان سخت باشد آنرا به "ث"
تبدیل می کنند.
برای روشنتر شدن این قاعده به مثالهای زیر توجه کنید:
برای روشنتر شدن این قاعده به مثالهای زیر توجه کنید:
ذبابة = دبابة مگس
ذرة = درة (به ضم ذال:ذرت – به فتح ذال: اتم)
ظلام = ضلمة تاریکی
ظل = ضل باقی ماند
ثانوية عامة = سانوية عامة دبیرستان عمومی(دولتی)
ثوم = توم سیر
ذرة = درة (به ضم ذال:ذرت – به فتح ذال: اتم)
ظلام = ضلمة تاریکی
ظل = ضل باقی ماند
ثانوية عامة = سانوية عامة دبیرستان عمومی(دولتی)
ثوم = توم سیر
اگر به صحبت کردن یک مصری گوش کنید
احساس می کنید که تا حد امکان سعی می کند زبانش با دندانهایش برخورد نکند! و
به خاطر همین کلمه ها را خیلی له و لورده می کند.
ما عليه شيء = ماعليهشي = معلش عیبی
ندارد یا لابأس به
ما أكلت شيء = ماأكلتش = ماكلتش چیزی نخوردم
ما أكلت شيء = ماأكلتش = ماكلتش چیزی نخوردم
فعل مضارع در لهجه مصری مانند بسیاری از
لهجه های عربی دیگر با اضافه کردن "ب" به اول فعل مضارع فصیح و و سبک تلفظ
کردن علامت مضارع(مثلا همزه در صیغه متکلم وحده) ساخته می شود.مثال:
أنا أشرب الآن => بَشرب می
نوشم(الان)
أنا أنام الآن => بَنام می خوابم(الان)
أنا أحبك => بَحبك دوستت دارم(این دیگه ان شا الله همیشگیه و مربوط به الان نیست!) (نفى : مبحبكش!)
أنا أنام الآن => بَنام می خوابم(الان)
أنا أحبك => بَحبك دوستت دارم(این دیگه ان شا الله همیشگیه و مربوط به الان نیست!) (نفى : مبحبكش!)
فعل مستقبل(آینده) در لهجه مصری با
تبدیل سین به "ه" و در بعضی مناطق"ح" ساخته می شود.مثال:
سأشرب => هشرب یا حشرب
سأقتل => هقتل یا حقتل
سأنام => هنام یا حنام
سأشرب => هشرب یا حشرب
سأقتل => هقتل یا حقتل
سأنام => هنام یا حنام
ادات نفی در لهجه مصری همانطور که گفته
شد "مش" است.البته استفاده از این کلمه هم قواعد سردرد آور خودش را دارد.
مثلا اگر بخواهید از "مش" به جای "لن" و "لیس" در فصیح استفاده می کنید
آنرا باید در ابتدا بیاورید. اما اگر بخواهید از آن مانند "لم" یا "لا" نفی
فعل استفاده کنید "م" را در اول فعل و "ش" را در آخر می آورید. مثال:
لن أشرب = مش هشرب (مش به جای لن و "ه" به جای سین البته عرب هیچ موقع نمی گوید لن ساشرب!)
لا أشرب = مابشربش
لم أشرب = مشربتش
لم يجي = مجاش نیامد
حروفی که تلفظشان در لهجه مصری با عربی فصیح متفاوت است
ث = که بعضا "ت" و در بعضی کلمات "س" تلفظ می شود.
ج = که معمولا مانند قاف تلفظ می شود.
ذ = مانند "د" و بعضا مانند "ز" تلفظ میشود.
ظ = به صورت "ز" ولی کمی با تفخیم
ق = مانند همزه تلفظ می شود مثال: قمَر=> أمَر
لن أشرب = مش هشرب (مش به جای لن و "ه" به جای سین البته عرب هیچ موقع نمی گوید لن ساشرب!)
لا أشرب = مابشربش
لم أشرب = مشربتش
لم يجي = مجاش نیامد
حروفی که تلفظشان در لهجه مصری با عربی فصیح متفاوت است
ث = که بعضا "ت" و در بعضی کلمات "س" تلفظ می شود.
ج = که معمولا مانند قاف تلفظ می شود.
ذ = مانند "د" و بعضا مانند "ز" تلفظ میشود.
ظ = به صورت "ز" ولی کمی با تفخیم
ق = مانند همزه تلفظ می شود مثال: قمَر=> أمَر
بعضی از کلمات مصری برای حسن ختام
ميت =بلدة ( به معنای سرزمین و دهکده)
ترابيزة = طاولة ( میز)
الحوسة = الفوضى (شلوغی بی نظمی و اغتشاش ) مانند: ايه الحوسة دي؟ که در فارسی می گوییم: این چه وضعیه؟
غيط = زمین زراعی
الحكومة = علاوه بر حکومت به معنای پلیس هم استعمال میشود
عيش = خبز (نان)
عبيط = يعني بلا عقل أو أبله
لت وعجن = يعني كثرة الكلام بلا فائدة أو خير (حرف زیاد بدون فائده یا همون شرو ور خودمون)
شاكوش (قادوم) = مطرقة (چکش)
أجزاخانة = صيدلية (داروخانه)
..........................................................................................................
ترابيزة = طاولة ( میز)
الحوسة = الفوضى (شلوغی بی نظمی و اغتشاش ) مانند: ايه الحوسة دي؟ که در فارسی می گوییم: این چه وضعیه؟
غيط = زمین زراعی
الحكومة = علاوه بر حکومت به معنای پلیس هم استعمال میشود
عيش = خبز (نان)
عبيط = يعني بلا عقل أو أبله
لت وعجن = يعني كثرة الكلام بلا فائدة أو خير (حرف زیاد بدون فائده یا همون شرو ور خودمون)
شاكوش (قادوم) = مطرقة (چکش)
أجزاخانة = صيدلية (داروخانه)
..........................................................................................................
آموزش کامل مکالمه عربی به لهجه مصری به روش نصرت_ با کتاب و درسهای صوتی_ تعليم اللهجة المصرية!!!!
إليکم هذه المرة کتاب "کلّميني عربي!" لتعلم
اللهجة المصرية.تحتوي هذه السلسلة التعليمة کتابا يشمل الکثير من الجمل و
الحوارات باللهجة المصرية مع ملفات الصوت الخاصة لکل الدروس و التدريبات.
ملحوظة: قم بتحميل جميع الملفات الصوتية
فارسی
لهجه مصری را با استفاده از کتاب عالی و بی نظیر "کلمیني عربي" ياد بگير!
این مجموعه شامل یک کتاب مفصل همراه با فایلهای صوتی همه گفتگوها و تمرینهاست . بهتون قول می دهم که با کمی تلاش می توانید لهجه مصری را با این کتاب یاد بگیرید.
لینکهای دانلود:
دانلود کتاب و برنامه اجرا کننده آن
دانلود فایلهای صوتی درسها (1)
دانلود فایلهای صوتی درسها (2)
دانلود فایلهای صوتی درسها(3)
توجه: هر سه قسمت را دانلود کنید.
...............................................................................................
ملحوظة: قم بتحميل جميع الملفات الصوتية
فارسی
لهجه مصری را با استفاده از کتاب عالی و بی نظیر "کلمیني عربي" ياد بگير!
این مجموعه شامل یک کتاب مفصل همراه با فایلهای صوتی همه گفتگوها و تمرینهاست . بهتون قول می دهم که با کمی تلاش می توانید لهجه مصری را با این کتاب یاد بگیرید.
لینکهای دانلود:
دانلود کتاب و برنامه اجرا کننده آن
دانلود فایلهای صوتی درسها (1)
دانلود فایلهای صوتی درسها (2)
دانلود فایلهای صوتی درسها(3)
توجه: هر سه قسمت را دانلود کنید.
...............................................................................................
دانلود سه کتاب آموزشی برای لهجه های عامیانه عراقی و مصری - ثلاثة کتب لتعليم اللهجتين العراقية و المصرية
کتابهای زیر واقعا عالین. مخصوصا
کتاب آموزش مکالمه عربی با لهجه عراقی که واقعا کتاب شامل و جامعی است و در
یکی از سایتها دیدم که از این کتاب برای آموزش لهجه عراقی به سربازان
آمریکایی استفاده می شود.
حتما
دانلودش کنید
برای
اجرای یکی از کتابها به برنامه djvu نیاز دارید که از لینک زیر قابل تهیه
است:
لتشغيل أحد الملفات یلزمک برنامج djvu الموجود في الرابط
التالي
http://djvu.org/resources
فایلهای صوتی (کلمات به انگلیسی توضیح داده می شود)
Part1: Let's Chat In Arabic part 1.rar (243.67 MB)
Part2 : Let's Chat In Arabic part 2.rar (221.76 MB)
لینکهای جدید کتاب یالله ندردش بالعربي(آموزش
لهجه مصری):
فایلهای صوتی (کلمات به انگلیسی توضیح داده می شود)
Part1: Let's Chat In Arabic part 1.rar (243.67 MB)
Part2 : Let's Chat In Arabic part 2.rar (221.76 MB)
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:57|
دانلود کارتونهای عربی اسلامی شبکه فجر

شبکه ماهواره ای فجر
کارتونهای اسلامی
کارتونهای اسلامی
أدب الــزيارة

http://www.archive.org/details/AdabAz-ziyarah
أكــل مـــال اليـــتـــيم
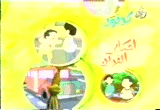
http://www.archive.org/details/AkluMalAl-yatim
الأضــحيـــة

http://www.archive.org/details/AlUdhiyah
التجــسـس
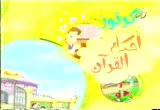
http://www.archive.org/details/Tajassus
التـــكبــر

http://www.archive.org/details/Takabbur
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:55|
مناظره دکتر
جمال بداوی و دکتر شروش در مورد حضرت محمد صلی الله عليه و آله به زبان
عربی
کیفیت
عالی (364 مگابایت)
..............................................................................................
کارتون های عربی ،فرمت این کارتونها 3gp و با کیفیت صدای خوب است. در عین حال حجم این فایلها کم بوده و به راحتی قابل دانلود و استفاده می باشد.
1-الأسد و الفأر (شیر و موش)
2-غطاء الضخم (روکش_پتوی_ گنده)
3-خروج الأخطبوط (خروج اختاپوس)
4-القمر و الأرنب (ماه و خرگوش)
5-قاطع الحجارة (مرد سنگبر)
6-قرد الأدغال (میمون جنگلی)
7-السحابة الوحيدة الماطرة (ابر بارانی تنها)
8-سونيل النمر المخطط (سونیل ببر خط خطی)
9-اليقطينة الضخمة (کدو تنبل بزرگ)
10-الزر اللامع (دکمه براق)
کارتون داستانی زیر جذاب و در مورد زندگی دو برادر است که مادرشان را از دست داده و با پدرشان زندگی می کنند، و اینکه چگونه در برابر مشکلات بی مادری استقامت می کنند.
در صورتیکه بعد از کلیک وارد صفحه ای به زبان عربی شدید، منتظر تمام شدن شمارش معکوس شده و سپس روی عبارتی که به رنگ آبی نوشته شده کلیک کنید.
الحلقة 8 القناع
الحلقة9 كيف أصبح بطلاً
الحلقة 10 كيف أرتدي ثيابي
الحلقة11 المهرجان الرياضي
الحلقة 12 مخاوف وسيم
الحلقة 13 الأرنب الصغير
الحلقة14مفاجأة مدير الحضانة
الحلقة 15 ما هو عمل والد ريما
الحلقة16 مرض سامي
الحلقة 17 مهرجان التنكر
الحلقة 18 لجنة الحفاظ على البيئة
الحلقة 19 شهية وسيم
الحلقة 20 الكلب الضائع
الحلقة 21دعوة علاءالحلقة 22
فكرة السيدة نظيرة
الحلقة 23 أحلام رويدة
الحلقة 24 صديق والدي القديم
الحلقة 25 زيارة هاني
الحلقة 26 من سيفوز اليوم
الحلقة 27 جدة حسان
الحلقة 28 البطل الشجاع وسيم
الحلقة 29 هدية أخي سامي
الحلقة 30 سيارتي الجميلة
الحلقة 31 ذكريات أبي
الحلقة 32 رحلة في سيارة
الحلقة 33 إجازة أبي
الحلقة 34 وسيم و الببغاء
الحلقة 35 رحلة التزلج على الثلج
.........................................................................................................
حضرت آدم عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...e63a6bc365747c
حضرت يعقوب عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...0968dab14de395
حضرت داود عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...333b943afcb727
حضرت نوح عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...382104c37ce984
حضرت سليمان عليه السلام قسمت اول
http://www.egyptfiles.com/download.p...a64dee4899d237
حضرت سليمان عليه السلام قسمت دوم
http://www.egyptfiles.com/download.p...a6a28ab59b9105
سيدنا يوسف عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...0bfda547d676f2
حضرت موسى عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...01b201670fd071
حضرت شعيب عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...85236dc66fc766
حضرت عزیر عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...2eea78f09cf0f3
حضرت زكريا و حضرت يحیى عليهما السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...1d8140c051e705
سيدنا هود عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...b44e306c77f42c
سيدنا اسماعيل عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...018472a4dfde92
سيدنا يونس عليه السلام الجزء الاول
http://www.egyptfiles.com/download.p...edc3a56998a929
سيدنا يونس عليه السلام الجزء الثانى
http://www.egyptfiles.com/download.p...46ffd69a4584ab
سيدنا عيسى عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...aecc225104500c
الجزء الاول سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...289171126d0abe
الجزء الثانى سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...a67addcf14b2f8
الجزء الثالث سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...8ec08f0a80462a
الجزء الرابع سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...1176c5cfe853b7
..............................................................................................
کارتون های عربی ،فرمت این کارتونها 3gp و با کیفیت صدای خوب است. در عین حال حجم این فایلها کم بوده و به راحتی قابل دانلود و استفاده می باشد.
1-الأسد و الفأر (شیر و موش)
2-غطاء الضخم (روکش_پتوی_ گنده)
3-خروج الأخطبوط (خروج اختاپوس)
4-القمر و الأرنب (ماه و خرگوش)
5-قاطع الحجارة (مرد سنگبر)
6-قرد الأدغال (میمون جنگلی)
7-السحابة الوحيدة الماطرة (ابر بارانی تنها)
8-سونيل النمر المخطط (سونیل ببر خط خطی)
9-اليقطينة الضخمة (کدو تنبل بزرگ)
10-الزر اللامع (دکمه براق)
کارتون داستانی زیر جذاب و در مورد زندگی دو برادر است که مادرشان را از دست داده و با پدرشان زندگی می کنند، و اینکه چگونه در برابر مشکلات بی مادری استقامت می کنند.
در صورتیکه بعد از کلیک وارد صفحه ای به زبان عربی شدید، منتظر تمام شدن شمارش معکوس شده و سپس روی عبارتی که به رنگ آبی نوشته شده کلیک کنید.
الحلقة 8 القناع
الحلقة9 كيف أصبح بطلاً
الحلقة 10 كيف أرتدي ثيابي
الحلقة11 المهرجان الرياضي
الحلقة 12 مخاوف وسيم
الحلقة 13 الأرنب الصغير
الحلقة14مفاجأة مدير الحضانة
الحلقة 15 ما هو عمل والد ريما
الحلقة16 مرض سامي
الحلقة 17 مهرجان التنكر
الحلقة 18 لجنة الحفاظ على البيئة
الحلقة 19 شهية وسيم
الحلقة 20 الكلب الضائع
الحلقة 21دعوة علاء
الحلقة 23 أحلام رويدة
الحلقة 24 صديق والدي القديم
الحلقة 25 زيارة هاني
الحلقة 26 من سيفوز اليوم
الحلقة 27 جدة حسان
الحلقة 28 البطل الشجاع وسيم
الحلقة 29 هدية أخي سامي
الحلقة 30 سيارتي الجميلة
الحلقة 31 ذكريات أبي
الحلقة 32 رحلة في سيارة
الحلقة 33 إجازة أبي
الحلقة 34 وسيم و الببغاء
الحلقة 35 رحلة التزلج على الثلج
.........................................................................................................
دانلود مجموعه کارتون عربی قصص الأنبيا (داستان پیامبران) تولید کشور مصر
حضرت آدم عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...e63a6bc365747c
حضرت يعقوب عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...0968dab14de395
حضرت داود عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...333b943afcb727
حضرت نوح عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...382104c37ce984
حضرت سليمان عليه السلام قسمت اول
http://www.egyptfiles.com/download.p...a64dee4899d237
حضرت سليمان عليه السلام قسمت دوم
http://www.egyptfiles.com/download.p...a6a28ab59b9105
سيدنا يوسف عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...0bfda547d676f2
حضرت موسى عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...01b201670fd071
حضرت شعيب عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...85236dc66fc766
حضرت عزیر عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...2eea78f09cf0f3
حضرت زكريا و حضرت يحیى عليهما السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...1d8140c051e705
سيدنا هود عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...b44e306c77f42c
سيدنا اسماعيل عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...018472a4dfde92
سيدنا يونس عليه السلام الجزء الاول
http://www.egyptfiles.com/download.p...edc3a56998a929
سيدنا يونس عليه السلام الجزء الثانى
http://www.egyptfiles.com/download.p...46ffd69a4584ab
سيدنا عيسى عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...aecc225104500c
الجزء الاول سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...289171126d0abe
الجزء الثانى سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...a67addcf14b2f8
الجزء الثالث سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...8ec08f0a80462a
الجزء الرابع سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...1176c5cfe853b7
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:53|
الحلقه رقم 1
الحلقه رقم 2
الحلقه رقم 3
الحلقه رقم 4
الحلقه رقم 5
الحلقه رقم 6
الحلقه رقم 7
الحلقه رقم 8
الحلقه رقم 9
الحلقه رقم 10
الحلقه رقم 11
الحلقه رقم 12
الحلقه رقم 13
الحلقه رقم 14
الحلقه رقم 15
الحلقه رقم 16
الحلقه رقم 17
الحلقه رقم 18
الحلقه رقم 19
الحلقه رقم 20
الحلقه رقم 21
الحلقه رقم 22
الحلقه رقم 23
الحلقه رقم 24
الحلقه رقم 25
الحلقه رقم 26
الحلقه رقم 27
الحلقه رقم 28
الحلقه رقم 29
الحلقه رقم 30
الحلقه رقم 31
الحلقه رقم 32
الحلقه رقم 33
الحلقه رقم 34
الحلقه رقم 35
الحلقه رقم 36
الحلقه رقم 37
الحلقه رقم 38
الحلقه رقم 39
الحلقه رقم 40
الحلقه رقم 41
الحلقه رقم 42
الحلقه رقم 43
الحلقه رقم 44
الحلقه رقم 45
الحلقه رقم 46
الحلقه رقم 47
الحلقه رقم 48
الحلقه رقم 49
الحلقه رقم 50
الحلقه رقم 51
الحلقه رقم 52
الحلقه رقم 53
الحلقه رقم 54
الحلقه رقم 55
الحلقه رقم 56
الحلقه رقم 57
الحلقه رقم 58
الحلقه رقم 59
الحلقه رقم 60
الحلقه رقم 61
الحلقه رقم 62
الحلقه رقم 63
الحلقه رقم 64
الحلقه رقم 65
الحلقه رقم 66
الحلقه رقم 67
الحلقه رقم 68
الحلقه رقم 69
الحلقه رقم 70
الحلقه رقم 71
الحلقه رقم 72
الحلقه رقم 73
الحلقه رقم 74
الحلقه رقم 75
الحلقه رقم 77
الحلقه رقم 78
الحلقه رقم 79
الحلقه رقم 80
الحلقه رقم 105
الحلقه رقم 128
الحلقه رقم 129
الحلقه رقم 2
الحلقه رقم 3
الحلقه رقم 4
الحلقه رقم 5
الحلقه رقم 6
الحلقه رقم 7
الحلقه رقم 8
الحلقه رقم 9
الحلقه رقم 10
الحلقه رقم 11
الحلقه رقم 12
الحلقه رقم 13
الحلقه رقم 14
الحلقه رقم 15
الحلقه رقم 16
الحلقه رقم 17
الحلقه رقم 18
الحلقه رقم 19
الحلقه رقم 20
الحلقه رقم 21
الحلقه رقم 22
الحلقه رقم 23
الحلقه رقم 24
الحلقه رقم 25
الحلقه رقم 26
الحلقه رقم 27
الحلقه رقم 28
الحلقه رقم 29
الحلقه رقم 30
الحلقه رقم 31
الحلقه رقم 32
الحلقه رقم 33
الحلقه رقم 34
الحلقه رقم 35
الحلقه رقم 36
الحلقه رقم 37
الحلقه رقم 38
الحلقه رقم 39
الحلقه رقم 40
الحلقه رقم 41
الحلقه رقم 42
الحلقه رقم 43
الحلقه رقم 44
الحلقه رقم 45
الحلقه رقم 46
الحلقه رقم 47
الحلقه رقم 48
الحلقه رقم 49
الحلقه رقم 50
الحلقه رقم 51
الحلقه رقم 52
الحلقه رقم 53
الحلقه رقم 54
الحلقه رقم 55
الحلقه رقم 56
الحلقه رقم 57
الحلقه رقم 58
الحلقه رقم 59
الحلقه رقم 60
الحلقه رقم 61
الحلقه رقم 62
الحلقه رقم 63
الحلقه رقم 64
الحلقه رقم 65
الحلقه رقم 66
الحلقه رقم 67
الحلقه رقم 68
الحلقه رقم 69
الحلقه رقم 70
الحلقه رقم 71
الحلقه رقم 72
الحلقه رقم 73
الحلقه رقم 74
الحلقه رقم 75
الحلقه رقم 77
الحلقه رقم 78
الحلقه رقم 79
الحلقه رقم 80
الحلقه رقم 105
الحلقه رقم 128
الحلقه رقم 129
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:53|
امپرسيونيسم
اولين بار لفظ امپرسيونيسم را منقدان فرانسوي
براي تمسخر و هجو نقاشان جواني مانند مونه،رنوار،پيسارو،سيسلي،س
زان،دگا،گيومن و موريزو به صورت امپرسيونيست ها به كار بردند كه اين واژه
را از نام تابلوي از مونه به نام امپرسيون:طلوع آفتاب گرفتند.
امپرسيونيسم به علت بدعتي كه در هنر نقاشي بوجود آورد،نخستين جنبش مدرن محسوب ميشود.
هدف
امپرسيونيسم ها دستيابي به نوعي طبيعت گرائي متعالي بود كه از طريق تجزيه
ي شدت و ضعف رنگ و ارائه ي بازي نور بر سطح اشياء حاصل ميشد.
استفاده
از لكه هاي رنگي كوچك و روشن و فقدان خط كناري،ثبت فوري و بازنمايي دقيق
جلوه هاي نوري كار در فضاي آزاد(البته اگر عمر كفاف داد در مطالب بعدي
راجع به هنرمندان امپرسيونيسمي ميگم كه بودند هنرمنداني مانندادگار دگا
ولوترك كه محيط هاي بسته را براي مضامين خود انتخاب ميكردند )و انتخاب
مضاميني از طبيعت يا مشهودات روزمره همگي از ويژگي ها ي مشترك آثار
امپرسيونيسمي است.
تكه هاي رنگ با ضربات كوتاه قلم كنار هم گذاشته
ميشدند و از طرق مجاورت و تاثير گذاري بر هم بود كه رنگ نهايي در نگاه
بيننده شكل ميگرفت.
دلمشغولي هنرمند امپرسيونيستي بيان و انتقال دريافت آني و مستقيمي بود كه از لحظه ي يگانه ي انگيزش احساساتشان حاصل ميشود.
مقدمه
یکی از سبکهای هنری در تاریخ هنر، سبک
امپرسیونیسم (دریافتگری) است. این اصطلاح برای نخستین بار از عنوان نقاشی
کلود مونه با عنوان «دریافت (امپرسیون) طلوع خورشید» اقتباس شد و همچون
بسیاری از نامگذاریها، به منظور هجو و استهزا آثار هنری مونه، به این
اثر او اطلاق شد. اما پس از وی، به تدریج این عنوان به سبکی خاص اطلاق شد
که ویژگیهایی را در خلق اثر هنری مورد لحاظ قرار میداد. در ابتدا در سال
1874 م.، عدهای از نقاشان فرانسوی که مونه، سزان، دگا، رنوار و سیسلی از
این دسته به شمار میآیند، نقاشیهای خود را عرضه کردند و به عنوان
سردمداران این سبک مطرح شدند. سپس به تدریج عدهای دیگر از هنرمندان همچون
ادوارد مانه، پیسارو و بازیل به این سبک پیوستند، به طوری که هنرمندان
بزرگی که تعدادی از آنان، بعدها از بنیانگذاران سایر سبکهای بزرگ هنری
بودند به این جریان هنری پیوستند؛ افرادی همچون گوگن، وان گوگ، کاندینسکی،
هنری ماتیس، مونش و پیکاسو از این دسته هنرمندان هستند که هر یک از آنان،
خود به وجودآورنده دیگر سبکهای هنری در تاریخ هنر تلقی میشوند. گوگن پس
از این دوره، به سوی هنر بدوی گرایش یافت یا فردی همچون پل سزان و پیکاسو
به سوی کوبیسم گرایش یافتند و یا وان گوگ، اکسپرسیونیسم و هنری ماتیس،
فوویسم را بنا نهادند.
نکته جالب توجه این است که بسیاری از این
بزرگان، پیش از تأسیس سبکی جدید، تحت تأثیر امپرسیونیسم بودند و شاید به
سبب ویژگیهای این سبک و یا به خاطر این که چیزی در این سبک نیافتند به
سوی سبک جدید گرایش پیدا نمودند.
هنرمندان امپرسیونیست در این
دوران بر خلاف هنرمندان گذشته، نقاشی خود را در محیطهای کارگاهی و بسته
انجام نمیدادند و برای خلق اثر هنری به فضای آزاد، در کنار رودخانهها،
جنگلها، محیطهای طبیعی و یا کافهها و مکانهای عمومی میرفتند و به
نقاشی میپرداختند، امری که پیش از آن بیسابقه بود. موضوع نقاشیها
برگرفته از طبیعت و شواهد اطرافشان بود، به گونهای که استفاده از میزان
نور و چگونگی صحنههای طبیعی، تفاوت تابش نور و در حالتهای متفاوت روز به
چه صورتی باشد، یکی از مهمترین ویژگیهای سبک امپرسیونیسم به شمار
میرفت. هنرمندان این سبک به دنبال ترسیم تصاویر لغزان و گذرای طبیعت
بودند، تصاویری که به طور پایدار و ثابت در طبیعت به چشم نمیخورد و با
ارتعاشات لغزان نور، به ادراک و حس بینننده تیزبین امپرسیونیسم میآمد و
خیلی زود هم زوال مییافت.
تأثیر سبکهای پیشین بر امپرسیونیسم
سبک
امپرسیونیسم، بعد از دو سبک رمانتیسم و رئالیسم شکل گرفت، دو جریانی که
یکی بر بیان احساسات، عواطف و تخیلات هنرمند در آثار هنری تأکید داشت و
دیگری بر بیان واقعیت صرف و آنچه در پیرامون ما هست، تأکید مینمود.
هنرمندان امپرسیونیست به هر دو سبک یادشده توجه داشتند و مولفههای هنری
موجود در آن سبکها را در آثار خویش استفاده مینمودند. امپرسیونیستها از
طرفی به توصیف و ترسیم عالم واقعیت میپرداختند و از طرف دیگر واقعیت را
آن چنان که هست، ترسیم نمینمودند. آثار خود را در لحظه خاص و تحت شرایط
ویژهای به تصویر میکشیدند، و از آن جا که واقعیت را ترسیم مینمودند، در
حقیقت همچون رئالیستها به سوی عالم خارج متوجه میشدند، اما چون در
انتخاب عالم خارج گزینش مینمودند و عالم واقعیت را در لحظهای خاص و با
زمان و یا نورپردازی خاص ارائه مینمودند، از این رو به سوبژکتیویسم و
عالم درونی هنرمند رمانتیسم نزدیک میشدند. هنرمندان امپرسیونیسم به تعبیر
دیگر به مثابه روانشناسان معتقدند که واقعیت همان احساس ماست و بر
احساسات ما استوار است. به گونهای که باید دید که عالم واقعیت در هر آن و
لحظه و در شرایط جوی و نورپردازی خاص چگونه خود را به ما عرضه میکند.
ویژگیهای سبک امپرسیونیسم
به تعبیر برخی از
مورخان، هنر افرادی همچون ادوارد مانه و دیگر طرفداران امپرسیونیست، در
واقع با به کار گرفتن سبک و شیوه خود در عرصه هنر، گویا این پرسش را مطرح
نمودند که آیا آنچه را ما میبینیم، به این که چگونه آن را میبینیم،
بستگی دارد؟ در واقع امپرسیونیستها همانند رمانتیستهای پیش از خود، با
دلدادگی به احساسات و عواطف درونی، تنها به حکایتگری و توصیف منفعلانه
عالم خارج بسنده ننمودند، بلکه عالم خارج و واقعیت را از منظر و نگاه
هنرمند و دریافت او از عالم واقع ترسیم کردند به طوری که به تعبیر گاردنر،
امپرسیونیستها به یک معنا نوعی «امپرسیونیسم ناتورالیستی» را مطرح کردند؛
با این استثنا که این بار هنرمند سوبژکتیویست در درک خود از عالم خارج، به
حس بصری بیش از ادراکات و تخیلاتش، تکیه میکند.
سبک
امپرسیونیسم در قرن 19، آغاز حرکتی به سوی سوبژکتیویسم بود که هر چه به
سوی جلوتر پیش میرویم و به قرن 20 نزدیک میشویم، به سوی هنر انتزاعی و
نارئالیستی پیش میرود؛ به گونهای که هنرمند در خلق اثر هنری، به سمت
ترسیم عالم درون و جهان خویشتن میرود و از عالم عینیت فاصله میگیرد و
این فاصله را به جهت بها دادن به ابداع، نوآوری و خلاقیت میپذیرد.
نگاهی
به سبکهای هنری قرن بیستم، به ویژه پس از سبک فوویسم، تأیید این امر است
که با وجود آن که امپرسیونیسم در آغاز با وفاداری به عالم رئالیسم آغاز
شد، اما به تدریج به سبکهایی همچون هنر انتزاعی، اکسپرسیونیسم انتزاعی، و
هنر مفهومی منتهی شد، که ردپای فضای درونی هنرمندان وفادار به این سبکها،
بیش از ردپای عالم واقعیت احساس میگردد.
یکی از ویژگیهای مورد توجه امپرسیونیستها در نقاشی و
مجسمهسازی، به کارگیری نور و ترسیم عالم خارج در لحظههای آنی است. در
واقع، گاهی اگر یک منظره، رودخانه و یا هر صحنه طبیعی در تاریکی شب یا
ابتدای روز و یا در زمان تابش نیمروزی خورشید دیده شود، به نظر میرسد که
تصویر یکسانی از آنان حاصل نمیگردد و حتی شاید تصور شود که تصاویر این
منظرهها متفاوت هستند. بدیهی است که گاهی یک صحنه طبیعی در هنگام تابش
نور شدید، ویژگیهایی را مییابد که منحصر به فرد است و اثر با آن ویژگی،
نمای خاصی را مییابد.
از این رو، هنرمندان امپرسیونیست در آثار
خود از نورپردازی استفاده میکردند و با استفاده از رنگهای روشن، این
روشنایی حاصل از نور را به خدمت میگرفتند. آنان ضربات سریع قلممو و
رنگهای روشن را مورد استفاده قرار میدادند و رنگهایی همچون خاکستری،
سیاه و قهوهای را از طیف رنگها خارج نموده و از رنگهای زرد، سبزآبی،
قرمز و نیلی استفاده مینمودند، به گونهای که استفاده از این رنگهای
روشن و تلالو یافته در نور خورشید، فضای خاص، با نشاط و شاد را در آثار
آنان دامن زده است.
امپرسیونیستها میکوشیدند در ترسیم مناظر
طبیعی، آن لحظههایی را که شرایط جوی و نور خورشید حالت خاصی را به طبیعت
میدهد به نمایش گذارند و همچون عکاسی که ممکن است، ساعتها به انتظار
بنشیند تا لحظه طلوع خورشید را صید کند، در انتظار لحظههای نابی بودند تا
بتوانند مناظر را در نور خاصی به تصویر کشند. استفاده از نور در آثار آنان
امری تفکیکناپذیر است و ادوارد مانه میگفت که بازیگر اصلی در نقاشی نور
است، و هنرمند تصاویر را در دریایی از نور و هوا به مخاطبان و بینندگان
خود القا مینماید، به طوری که آنچه نور بر ما آشکار میسازد جنبهای تنها
تصادفی و لحظهای پیدا میکند.
با وجود بازنمایی و واقعگرایی در آثار امپرسیونیستها، ضبط
فوری و آنی ارتعاشات حاصل از نور در طبیعت، در آثار آنان به چشم میخورد.
در این باب گفته شده است که کار امپرسیونیستها ثبت تحریک عصب بینایی حاصل
از نور است.
لذا میتوان گفت که مهمترین ویژگیهای سبک امپرسیونیسم عبارت است از:
1 دریافت آنی و مستقیم از طبیعت که احساس برانگیز باشد؛
2 الگوی لحظهای نور و بازی نور خورشید؛
3 ادراک مستقیم بصری و تحریک بصری به وسیله نور؛
4 تصویر عالم واقعیت بر اساس گزینش و نگرش به آن، از منظر انسانی؛
5 طرد رنگهای تیره و استفاده از رنگهای روشن؛
6 ثبت عالم واقعیت در لحظهای گذرا، آنی و ناپایدار؛ و
7
تأثیرگذاری، گزینشگری و حضور هنرمند در ترسیم عالم واقعیت (در رئالیسم
کوربه، هنرمند آنچه را وجود دارد، تصویر میکند اما در رئالیسم
امپرسیونیسم، هنرمند آنچه را که در یک لحظه خاص از واقعیت احساس میکند و
یا به تعبیری آن را مییابد، به تصویر میکشد(
هنرمندان
امپرسیونیسم علاوه بر خلق اثر هنری در عرصه نقاشی، در حوزه مجسمهسازی نیز
به فعالیت پرداختند، هنرمندانی همچون رودن پیکرهساز، کلودل و روسو و یا
هنرمندان نقاش ـ پیکرهسازی همچون دگا و رنوار ویژگیهای هنری
امپرسیونیستی را در عرصه مجسمهسازی نیز به کار بستند. رودن که مهمترین
مجسمهساز امپرسیونیست تلقی میگردد، تنها در بخشی از آثار خود بر اساس
این سبک کار نموده است و ویژگیهای امپرسیونیستی همچون سایه ـ روشن، سرعت
عمل، حرکت و استفاده دقیق از لحظات آنی و گذرا را در مجسمههای خود به
نمایش گذارده است
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 11:36|
ناتوراليسم
طیعیتگرایی یا ناتورالیسم(naturalism) ، اندیشهای در فلسفه است که موضوعات فراطبیعی را یا غیر واقعی میداند یا جدا از طبیعت نمیداند. عبارت است از مکتب ادبی که تا سرحد امکان طرفدار بیان واقعیات است و مانند خود طبیعت، البته از اصل طرفداری می کند. اما بیان زشتی های طبیعی و اخلاقی را ترجیح می دهد. در رأس این مکتب امیل زولا نویسنده بزرگ فرانسوی قرار دارد. مکتب ناتورالیسم در واقع با نوشته های فلوبر آغاز شد. گویا وی به شدت اصطلاحاتی مانند رئالیسم و ناتورالیسم را طرد و رد می کرده است. ناتورالیست ها بیشتر در زمینه داستان نویسی فعالیت می کردند.
ناتورالیسم از نظر فلسفی به قدرت کامل و محض طبیعت که نظم بی نظیری داشته باشد گفته می شود. از جهت ادبی تقلید موبه مو و دقیق از طبیعت را گویند.
برخی از نویسندگان ناتورالیست معتقدند که ادبیات و هنر بایستی جنبه علمی داشته باشد. به گفته امیل زولا همانطور که زیست شناس درباره موجود جاندار به بررسی می پردازد نویسنده باید شیوه یک زیست شناس را پیروی کند و روش تجربی باید مورد توجه نویسندگان قرار گیرد.
اختصاصات سبک ناتورالیسم عبارتند از:
1- فرد و اجتماع دارای هیچگونه امتیاز خارجی نمی باشد قانون تنازع بقاء در کلیه کارها و اتفاقات به چشم می خورد، پس اگر موجودی کار خوب یا بدی دست بزند نتیجه اراده اش نیست بلکه جبر و قوانین طبیعت او را به این کار وادار می کند.
2- در نوشته های ناتورالیستی بیش از حد و اندازه به جزئیات توجه می شود. این باریک بینی و ریزه کاری و ذکر عوامل و حوادث بسیار جزئی گاهی خسته کننده و بیهوده می شود.
این ذکر جزئیات شامل کوچکترین حرکات قهرمان داستان تا جزئی ترین چیز در محیط او و فرعی ترین حادثه را شامل می شود.
3- در این سبک، جسم بیش از روح ارزش دارد یعنی هر نوع نظم یا بی نظمی مربوط به جسم آدمی است که آن هم نتیجه توارث است و روان و روح فقط حکم سایه را دارد.
4- در سبک ناتورالیسم مکالمه های طولانی و بی مورد چنان موضوع رمان و نمایشنامه را اشغال می کند که آن را از حقیقت نمایی و لطف می اندازد این مکالمه به صورت عامیانه یا به هر صورتی که
گوینده مناسب می داند آورده و گفته می شود.
شاعران و نویسندگان ناتورالیست برخی از کشورها عبارتند از:
1. امیل زولا پیشوای ناتورالیست های فرانسه
2. جرج مور از انگلستان
3. وان لانپ امانتس از هلند
4. کرتزر، هولتس شلاف، هوپتمان از آلمان
ناتورالیسم زاده فلسفه اثباتی "اگوست کنت" و شارح و مفسر آن هیپولیت تن نقاد معروف فرانسوی است. تن می گوید همان طور که زندگی به وسیله علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می گیرد، هنر و ادبیات نیز باید به قوانین علمی تطبیق کند. او معتقد است آنچه نویسنده به وجود می آورد اجباراً به عواملی وابسته است و فکر انسان از قوانین نیرومندی که رفتار او را تعیین می کند اطاعت می نماید.
ناتورالیسم پا به پای رئالیسم به وجود می آید. بزرگ ترین نماینده ناتورالیسم فرانسه امیل زولا است. او و یارانش سعی دارند به هنر و ادبیات جنبه علمی بدهند.
به عقیده او نویسنده باید تخیل را کنار بگذارد و دارای حس واقع بینی باشد و مانند یک شیمی دان یا فیزیک دان که درباره مواد بی جان کار می کند و یا چون فیزیولوژی دان که اجسام زنده را مورد آزمایش قرار می دهد، نویسنده هم باید راجع به صفات و مشخصات و رفتار و عادات افراد و اجتماعات بشری به همان طریق کار کند.
ناتورالیسم معتقد به جبر علمی است و می گوید حوادثی که در دنیا اتفاق می افتد، مطابق قوانین علمی و تحت تأثیر علل جبری است و مطابق این جبر از شرایط معین نتایج معین به دست می آید.
به عقیده این گروه کیفیت روانی و رفتار اشخاص را در اجتماع، شرایط جسمی آنها تعیین می کند. زولای دنیای بشیری را تابع همان جبری می داند که بر سایر موجودات طبیعت حکمفرماست. وی رمان نویس را تشریح کننده ی وضع فردی و اجتماعی بشر می داند و تاثیر وراثت را در تکوین شخصیت می پذیرد. شخصیت در رمانهای زولا تحت تاثیر وضع مزاجی و ارثی و عوامل دیگری از این قبیل است از این
رو مجبور به انجام دادن کارهایی معین می شود.
نویسنده ناتورالیسم به توصیف جزئیات می پردازد و این جزئیات را برای اثبات نظر علمی خاص خودش مورد توجه قرار می دهد. او وضع روانی را نتیجه مستقیم وضع جسمی می داند. وضع جسمی هم از نظر او چیزی است که به ارث به او رسیده است. از نکات مهمی که در شیوه ناتورالیسم هست یکی توجه به آنها زبان است و دیگر توجه به توصیف زشتیها، نویسنده سعی می کند در نقل گفتار هر یک از شخصیت های داستانی همان جملات و عباراتی را بیارود که طبعاً باید به زبان آورد. اگر چه آن عبارات و کلمات زشت و ناهنجار باشد.
از کسانی که با زولا دوست و همکار هستند و تا حدی شیوه او را می پسندند یکی "گوستاو فلوپر" است و دیگر "موپاسان". با این همه فلوبر در بسیاری موارد با زولا موافق نیست و به او اعتراضی دارد و "گی دو ماپاسان" که در واقع نخستین بار داستان کوتاه را در ادبیات فرانسوی وارد می کند، هر چند با زولا دوست و هم عقیده است اما ناتورالیسم او نوعی رئالیسم اغراق آمیز است و با آنچه زولا می گوید تفاوت دارد
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 11:35|
بازتاب رمانتیسم در عرصه ادبیات منظوم ایران
اگرچه «رمانتیسم » ۱ ، اصطلاحی است که تاکنون تعریفی در مورد آن ارائه نشده است . اما خصوصیات عمده آن عبارت است از: تخیل ، احساس گرایی ، درهم ریختن ساختار ادبی کلاسیک و مخالفت با قاعده و چهارچوب و... نهضت «رمانتیسم » مربوط به اروپا است اما «حس رمانتیک » در سایر ملل از جمله شرق ، از دیرباز وجود داشته است . در اروپا بزرگانی همچون «ویلیام بلیک » ۲ ، «کالریج » ۳ ، «گوته » ۴ ، «هوگو» ۵ ، «لامارتین » ۶ ، بانی این نهضت بودند. در ایران رمانتیک در اشعار شاعرانی چون «نیما»، «توللی »، «فروغ »، «نادرپور» و... جلوه گر می شوند، سبک های ادبی دیگری را نیز می توان یافت که عرصه تجلی ویژگی های ادب رمانتیک است .
سبک خراسانی که از آن به سبک کلاسیک (به معنی خاص ) تعبیر می شود، در مقابل سبک عراقی قرار می گیرد که حداکثر جلوه های رمانتیسم و ادب احساس گرا در آن قابل توجه است . رهاورد رمانتیسم ادب غنایی است و پایگاه ادب غنایی در ادبیات کهن ایران ، سبک عراقی ، خصوصیاتی چون : احساس گرایی ، حساسیت و غم گرایی ، اسطوره گریزی ، جولان خیال ، توصیف ، گرایش به مذهب و عرفان ، ساختار شکنی فکری در ادب رمانتیک سبک عراقی مشهورند. سبک هندی به جز تخیل غنی و برخی توصیفات چندان نشانه ای از ادب رمانتیک ندارد و سبک بازگشت ادبی نیز سبکی انعکاسی است که فاقد خصوصیات رمانتیسم است . اوج رمانتیسم در اشعار ایران در دوره بعد از مشروطیت جلوه گر می شود.
● نگاهی به سابقه رمانتیسم در ایران
با وجود آنکه در قرن هیجدهم در اروپا نهضت «رمانتیسم » با ویژگی هایی از قبیل : احساس گرایی ، فردگرایی ، ادب غنایی ، تخیل وسیع و در هم شکستن چهارچوب ها و قاعده ها و... عام شمول شد، اما رگه های اندیشه رمانتیک همزاد بشریت است و برخی ویژگی ها نظیر: تخیل و احساسات در تمام انسان ها در طول تاریخ و در گوشه و کنار جهان وجود دارد. آثار باقی مانده از گذشتگان ادبیات جهان گاه آنقدر از نظر تخیل و احساس (که دو ویژگی عمده به شمار می روند) متعالی هستند که ما را به یاد رمانتیک های قرن هیجده اروپا می اندازد.
در اقصی نقاط جهان وقتی آثار ادبی گذشتگان و پیشکسوتان ادب و فرهنگ ، مورد مطالعه و ژرف نگری و نقد قرار می گیرد، ویژگی های رمانتیک در آثار و اشعار آنان به طور پراکنده قابل درک است و حتی نقادان بزرگ گاهی عوامل بروز نهضت رمانتیسم در اروپا را ریشه در دیگر فرهنگ ها، خصوصاً شرق می دانند. مثلاً «سیلییر» ۷ (منتقد فرانسوی که از معارضان سرسخت رمانتیسم است ) تلاش کرده که منشأ «رمانتیسم » را (که او آن را بیماری می نامد) شرق جلوه دهد و اعتقادش بر این است که میراث افلاطون با مسیحیت (که آن هم شرقی است ) در هم می آمیزد و با مکتب نوافلاطونی نیروی بیشتری گرفته و دوران جدید رمانتیسم را پدید آورده است . ۸ در هر حال نمی توان جاذبه خاص شرق را در نظر شاعران و نویسندگان قرن هیجده اروپا، کتمان کرد. سفر به شرق ، ترجمه کتاب های شرقی ( ترجمه هزار و یک شب ) و نیز انتشار سفرنامه هایی در باب ایران و هند ۹ و انتشار کتاب های : قصه های ایرانی ، قصه های ترکی ، افسانه عربی واثق (۱۷۸۶) و... را می توان گواهی بر این مدعا دانست . ۱۰ شاعرانی همچون : «هوگو»، «لامارتین » و «موسه » ۱۱ به آثار ترجمه فارسی توجه نشان داده اند و حتی «هوگو»، قسمتی از کتاب زنان شرقی را با الهام از ادب فارسی نگاشت . ۱۲
● مفهوم شعر غنایی
شعر غنایی عمدتاً، شعری است احساس گرا و مبتنی بر عشق و زیبایی و سرچشمه گرفته از عواطف درونی . در نظر ارسطو معیار دقیقی برای شعر غنایی وجود ندارد، زیرا به عقیدهٔ وی ، شعر غنایی با موسیقی آمیخته است و لذّات حاصل از آنها را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد. ادب غنایی نزد اروپاییان به ادبیات «لیریک » مشهور است و «لیر» نوعی آلت موسیقی است مانند چنگ که یونانیان قدیم اشعاری همراه با «لیر» خوانده اند که به آنها «لیریک » گفته می شد و در ایران نیز نظیر این ساز یافته می شد. ۱۳ جلوه های شعر غنایی در ادب کهن ایران را می توان در گاهان ۱۴ (سرودهای مذهبی زرتشت ) و نیز سرودهای خسروانی ۱۵ ، فهلویات و نیز بخش هایی از درخت آسوریک مشاهده کرد. ۱۶ در ایران ، غزل ، قالب شاخص شعر غنایی به شمار می رود و به صورت تغزلات در اول قصاید شاعران سبک خراسانی نیز جلوه گر شده است . از قرن ششم به بعد، سیر غزل ، راه صعود طی می کند و در قرن هفتم و هشتم به اوج خود می رسد و تا عصر ما نیز این قالب ادامه می یابد. «بسیاری از محققان منشأ اشعار غنایی را ادبیات فلکلوریک دانسته اند.» ۱۷
● جایگاه رمانتیسم در سبک های ادبی ایران
براساس علم سبک شناسی ، سبک های رایج در شعر فارسی را می توان به چند دسته عمده تقسیم کرد ۱۸ که عرصه جولان رمانتیسم واقعی را می توان درسبک حد وسط و جدید یعنی ادبیات دوره مشروطه به بعد دانست . ۱۹
در این دوره است که رمانتیسم در ایران به تبع رمانتیسم اروپایی رشد کرد و تا حدودی شکل واقعی به خود گرفت و کسانی چون : نیما یوشیج ، فروغ فرخزاد، فریدون توللی و نادر نادرپور را نماینده خود در ایران ساخت . ۲۰ اما اگر با دقت به سبک های دیگر نیز نظر بیندازیم متوجه برخی خصوصیات رمانتیکی در آثار شاعران برجسته آن سبک ها می شویم .
جلوه های رمانتیسم در سبک خراسانی بسیار ناچیز است . از آن رو که سبک خراسانی بر پایه عقل و خرد بنا شده و می توان از آن به عنوان دوره «کلاسیک » ادب پارسی نام برد.
آثار و شاعران عمده این عصر از قبیل : رودکی ، فرخی سیستانی ، عنصری ، منوچهری دامغانی ، فردوسی و سایر شعرای سبک خراسانی ، رنگ و بویی واقع گرا و یا بعضاً حماسی دارد. جز برخی از شاعران ، آن هم در مواردی معدود (که عمدتاً در تغزلات قصاید است ) به شعر غنایی روی نیاورده اند.
انعکاس صریح احوال اجتماعی و زندگی شاعران و وضع دربارها و جریانات سیاسی و نظامی ، از عمده ویژگی های این سبک است . و علت این امر واقع بینی و آشنایی شاعران با محیط مادی و خارجی و توجه کمتر آنان به عوالم خیالی و اوهام است . ۲۱
با این وجود شعر غنایی در این دوره جلوه هایی (هر چند اندک ) دارد. در آثار «رودکی » و «شهید بلخی »، «عنصری »، «فرخی سیستانی » و «دقیقی » و «رابعه بلخی »، جلوه هایی از شعر غنایی به چشم می خورد از ویژگی های رمانتیسم دراین دوره به جز برخی غزل ها و تغزلات غنایی و نیز نمود گرایش به احساس (البته به صورت بسیار محدود)، چیز دیگری نمی توان یافت .
وامق و عذرا (عنصری )، ورقه و گلشاه (عیوقی )، ویس و رامین (فخرالدین اسعد گرگانی ) ۲۲ ، بیشترین نزدیکی را در میان آثار این سبک (خراسانی ) به رمانتیسم دارند و آن هم به دلیل گرایش به احساسات و داستان های عاشقانه آنها است .
ما سبک دوره خراسانی را سبکی مبتنی بر واقع گرایی می شناسیم و رگه های وجود برخی از جلوه های رمانتیسم درسبک خراسانی ، به علت جزئی بودن توان دادن رنگ و بویی رمانتیک به آثار این سبک را ندارند. شعر فارسی در این دوره «بنا بر تأثری که از اصل کلی و شایع خردگرایی پذیرفته ، شعری واقع گراست . شاعران عهد از دریچه ذهنی اندیشمند و ظاهرین به واقعیت های ملموس پیرامون خود نگریسته ، تصویری واقع بینانه از آنها ارائه می کنند از این رو، تشبیهات شعر این عصر براساس روابطی محسوس شکل گرفته است
در باره ی واژه ی «رمانتیسم»
سر آغاز:
یک. تصوری نسبتاً رایج در ایران
هست که رمانتیسم را با پاره ای ژست های عاشقانه و مقداری آه و افسوس و اشک
و حسرت و به ذهن می آورد و به لحاظ اجتماعی نیز پدیده ای ضد رئالیستی و
مبتنی بر خیال اندیشی و ذهنی گرایی صرف در صورتی که نه تنها مکتبی ادبی
بلکه نهضتی جهانی است که ادبیات، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی معماری،
نقاشی سینما و و جز آن را در بر می گیرد.
دو. به معنی خاص و تاریخی آن، «رمانتیسم»
اساساً پدیده ای اروپائی است. که بر بخشی از دوره ی گذر از جهان کلاسیک به
جهان مدرن دلالت می کند. زمان آن، اواخر قرن هجدهم و نیمه ی نخست قرن
نوزدهم است.
این پدیده در همان عصر و عمدتاً در دوره های بعد به سرزمین
های دیگر هم راه یافت و بر جنبه های زندگی اجتماعی آنان نیز تاثیر گذاشت و
نهضتی جهانی شد و این تاثیر، گذشته از تقلید، عوامل و دلایل اجتماعی و
فکری خاص خود را دارد؛ گویی رمانتیسم اصولاً هم ذات عصر جدید است و اهمیت
آن در همین است؛ زیرا این برهه دوره ای است که انسان سنتی از جهان معقول و
مألوف کهن وارد یک دنیای جدید می شود که بحران زده و آشفته است و نتیجه ی
طبیعی آن، کشمکش میان بیزاری از وضع موجود - از یک سو- و به یاد روزگاران
گذشته اشک حسرت ریختن- از سویی دیگر- است (اشتیاق روزگار بهتر در آینده هم
زمان با نوستالژی گذشته).
پس بدون شناخت رمانتیسم نمی توان به فهم درستی از ریشه های جهان نو و بسیاری از مکاتب و مسائل عصر جدید و دوران ما بعد رمانتیک رسید.
متن: چند نکته در باب واژه ی رمانتیسم
یک.
اغلب تعریف کنندگان این اصلاح به دشواری ناشی از تعریف این اصطلاح و
ناممکنی ارائه ی تعریفی جامع (علی رغم تعدد تعاریف) اشاره و اعتراف دارند.
دو. چهار نکته ی مهم در باب سیر کاربرد این واژه:
الف. در قرون وسطی: romance [رمان]: بر زبان های بومی تازه ی مشتق شده از لاتین دلالت می کند؛
ب.
صفت رمانتیک: نخستین بار در زبان انگلیسی، به سال 1650، در زبان فرانسوی
به سال1661 و آلمانی در 1663 به کار رفته است که در ابتدا به معنی «منسوب
به رمانی (آثار تالیف شده به زبان بومی)» است و در حقیقت یعنی «همچون
رمانس یا رمانس وار. این آثار (رمان، رمانس) عمدتاً ماهیتی خیال انگیز و
پر احساس داشتند و مبتنی از صحنه های پرشور و احساسات بهتر واقع گرایانه
که خواننده نمی توانست احتمال ان ها تناسب چندانی با فضای عقلانی قرن
هفدهم ندارد پس بار منفی دارد و بر مفاهیمی چون «اغراق آمیز بودن»، «مضحک
بودن»، «خیالاتی بودن»، «کودکانه بودن» و «نامعقول بودن» دلالت می کند.
ج.
در دهه ی 1660 در انگلیس از دلالت بر داستان رمانس وارد فراتر می رود و بر
مناظر طبیعی نیز اطلاق می شود. دکتر جانسون در 1735 از منظره ی رمانتیک به
عنوان یک کلیشه ی تثبیت شده ی شعری یاد می کند.
د. از نیمه ی دوم قرن
18 با تحولات فکری و اجتماعی، «رمانتیک» نیز بار مثبت تری پیدا می کند و
این زمانی است که «عصر خود» جای خود را به عصر احساس می دهد. در این دوره
کلمه ی «رمانتیک» یاد آور لذت ها و سرخوشی های بکر و اصیل گذشته در قلمرو
و پاک طبیعت است و نقد ادبی تبدیل می شود و برای تکامل این سیر باید تا
سال های پایانی سده ی هجدهم منتظر بود و از انگلیس به آلمان رفت.(سیر این
واژه در فرانسه و آلمانی تحت تاثیر زبان انگلیسی است).
سه. با عنایت به نکات پیش گفته، منتقدان سیر معنایی واژه ی رمانتیک را به چهار دوره تقسیم کرده است:
1- از 1700 معنای شماره ی 1؛¬تا اواخر قرن 18
2-
از 1798 تاسیس مجله آتئوم و پیدایش تئوری «شعر رمانتیک» در تقابل با «شعر
کلاسیک» توسط برادران شگل (فردریش و برادرش و ویلهلم)؛
3- دلالت
دقیق این واژه در سال های 8-1807 بر گروه های خاص رمانتیک و کاربرد
معاصرتر و مدرن تر کلمه که گهگاه همراه با بدگوئی و جنبه ی استهزا هم بوده
است (در ادب معاصر آلمان آن دوره توسط مخالفین و به عنوان استهزا این
عنوان به آن ها داده شده است).
4- پس از فروکش کرد دعوای رمانتیک ها
و کلاسیست ها و تثبیت تدریجی معنای واژه به عنواناصطلاحی غیر ارزشی که
اکنون هم در تاریخ های ادبیات آلمان دیده می شود.
چهار.
تعریف های رمانتیک و رمانتیسم نه تنها در دوره ی رمانتیک همراه با ابهام و
عدم وضوح و تشتت بوده است بلکه در دوره ی بعد (ما بعد رمانتیک) هم نه
تنها کاسته نمی شود بلکه افزوده هم می شود. هیچ یک از تعریف ها نه کاملاً
قانع کننده نیستند و برای همین ماریو پرز واژه ی «رمانتیسم» را صرفاً «بر
چسب غیر دقیقی» می داند که «موقتاً قابل استفاده است و حالت دل بخواهی و
اختیاری دارد و اصطلاحی تقریبی و غیر قطعی است.» حتی ایخنر از محققانی نام
می برد که معتقدند این اصطلاح باید به کلی به دور افکنده شود.
پنج. یکی از مهم ترین نتایج این ابهام ها و دشواری ها، عبادرت است از تعدد رمانتیسم ها.
آرتور
لاوجری با مقاله ی در باب تشخیص رمانتیسم ها سردم دارِ تمایز قائل شدن
میان انواع آن هاست و می گوید برای رهایی از آشفتگی ها باید این واژه را
به صورت جمع به کاربرد و به این ترتیب تمایز رمانتیسم های مختلف در
کشورهای مختلف نیز در نظر گرفته می شود.
اما به عکس او رنه ولک و
نوتروپ فرای، رمانتیسم اروپایی را دارای وحدت اساسی می دانند. آن سان که
فرای تاکید می کند، «رمانتیسم» دال بر یک مرکز ثقل تاریخی است در حدود سال
های 179 تا 1830 فرود می آید. همچنین، او بر آن است که با وجود نسبیت این
اصطلاح از نویسنده ای به نویسنده ی دیگر و از ملیت به ملت دیگر، در مجموع
در باب معنای رمانتیسم (به عنوان نام تازه ای برای شعری که در تقابل با
شعر تئوکلاسیک قرار دارد)، سوء فهمی وجود ندارد و در سراسر اروپا نیز قابل
مشاهده است.
به علاوه ولک، به تصورات یک سان در باب شعر کاربرد و
ماهیت تخیل شاعرانه را در میان تمام رمانتیک ها قائل است و اشتراک این عده
را در تخیل در تلقی از شعر، طبیعت در تلقی از جهان و سمبول و اسطوره در
سبک شاعرانه می داند و در کتاب نظریه ی ادبیات رمانتیسم را با استفاده از
اصطلاح کانت، «مفهومی یا انتظام دهنده» و تاریخ نگارانه می شمارد و به هر
حال نتیجه می گیرد که رمانتیسم به عنوان یک اصطلاح برای نام گذاری دوره ای
از ادبیات به راستی ارزش خود را حفظ می کند
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 11:35|
سوررئاليسم
فراواقع گرايى
در ابتداى قرن بيستم، پس از جنگ جهانى اول، نويسندگانى چون آندره برتون كه از شرايط دوران جنگ و پس از آن نا اميد، خسته و دلزده شده بودند، گروهى را شكل دادند كه انقلابى در جهان ادبيات و عرصه هنر به وجود آورد.
اين گروه تحت تأثير مكتب دادائيسم جنبشى به نام سوررئاليسم به وجود آوردند. سوررئاليسم يا فراواقع گرايى در واقع عصيانى اساسى ضد تمدن است. بهتر بگوييم، اين جنبش تنها انقلابى فكرى و هنرى نيست، بلكه در عين حال انقلابى اجتماعى و بويژه آزادى كامل بشريت را ترسيم مى كند. سوررئاليسم در پى آن نيست كه رشته اى از استدلالات انتزاعى را تحميل و اثبات كند.
واژه سوررئاليسم نوعى فلسفه است كه به كشف راز كيهان اعتقاد دارد. در واقع سوررئاليسم نوعى فراواقع گرايى است كه بر كشفيات عينى بنا شده است. براى شناخت سوررئاليسم بايد به اين نكته توجه كرد كه اين جنبش و يا عصيان، حاصل هوى و هوسهاى روشنفكرانه نيست، بلكه برخوردى تراژيك بين قدرتهاى روح و شرايط زندگى در دوران جنگ جهانى اول و پس از آن است.
اين جنبش فكرى نه تنها در ادبيات و شعر، بلكه در هنر نقاشى نيز تأثير فراوانى به همراه داشت.
از ديرباز تأثير نقاشى بر ادبيات و ادبيات بر نقاشى در عرصه هنر مورد توجه بوده است، اما اين تأثير در سالهاى پس از جنگ جهانى اول به اوج خود رسيد و در جنبش سوررئاليستى بيشترين تأثير خود را گذاشت. نويسندگان فرانسوى مانند برتون كه از نظرات زيباشناسى غيرعقلانى آرتور رمبو، كنت دولوترامون و آلفرد دوژارى و همچنين آپولينير استفاده مى كردند، توانستند تحولى شگرف در عرصه هنر نيز به وجود آورند.
سوررئاليسم در پى آن است كه اسرار جهان و پيوندهايى كه اين جهان را با انسان مربوط مى كند، به شيوه اى بسيار شگفت انگيز توصيف كند. شناخت كامل، آرمان و هدف مكتب سوررئاليسم است.
در واقع با شناخت كامل جهان مى توان همديگر را نيز فهميد و اين درست همان چيزى است كه فلاسفه همواره به دنبال آن بودند. سوررئاليسم به سوى ادراك هماهنگ فاعل شناسا (سوژه) و به موضوع شناسايى (ابژه) مى رود.
سوررئاليسم برخلاف رئاليسم قرون وسطايى كه تفاوتى بين عناصر انديشه و عناصر جهان قائل نبود، نوعى مرزگشايى ذهنى دنياى خارج است كه انسان براى رسيدن به آن در تلاش است تا رمز و راز ذهنى دنياى خارج را درك كند. برتون مى گويد: «روح بايد در غرقابهاى خويشتن غوطه زند، هنر كه درطول قرون مجبور بوده است، از راههاى طى شده من و ابرمن فاصله بگيرد، كارى نمى توان كرد، جز اينكه حريصانه در همه جهات زمين، وسيع و تقريباً بكر و دست نخورده خويشتن را بكاود.»
آندره برتون در بيانيه اول سوررئاليسم كه در نوامبر سال ۱۹۲۴ نوشته شده، مى گويد: «انسان موجود خيالبافى است»، «اما امروز ديگر نمى تواند تخيلات خود را آزاد بگذارد و حال آنكه زمان به اين انسان داده شده است كه از آن استفاده كند و زبان را آيينه و بيانگر فوق واقعيت كند.» از نظر ادبى فوق واقعيت يا فراواقعيت عبارت است از نوعى اعجاز كه زاييده آفرينش آزاد و شخصى است ونيز نوعى حساسيت مدركه كه در لحظات خاص در هر تجربه انسانى، همراه حيرت و شگفتى است.
همواره لحظات خاصى وجود دارد كه در آنها ايجاد اين وجود تازه، الهام را ممكن مى سازد و در اين حال است كه اسرار هنر جادويى سوررئاليستى آشكار مى شود، بويژه اين حالت با استفاده از رؤيا و نگارش و ترسيم خودكار به بهره بردارى از صور خيال سوررئاليستى مى پردازد و آن را بالاترين درجه استقلال فكر معمولى مى كند. رئاليسم ادبى در واقع با درازگويى هاى غير لازم و دروغ پردازيهايش نمى تواند به شكلى واقعى كه درخور توصيف انسانى است، انسان را توصيف كند. با درهم آميختن رؤيا و واقعيت و فراواقعيت مى توان بهتر و زيباتر به توصيف انسان پرداخت و اين كارى است كه فرويد روانكاو مشهور اتريش نيز آن را انجام داده است.
صورت خيالى از طريق نگارش خودكار، از اعماق ضمير پنهان وناخودآگاه بيرون مى آيد و واقعيت انديشه انسان ها را بيان مى كند.
سوررئاليست ها مانند ماركسيست ها و رمانتيك هاى قرن نوزدهم به فكر كشف قوانينى بودند كه رهيافت تازه اى به انسان دهد.
در بيانيه دوم سوررئاليست ها، برتون، سوررئاليسم را نه تنها تلاشى براى شناخت، بلكه نوعى پويايى براى رسيدن به همان نقطه روحى مى داند كه در همه تضادهاى ظاهرى از ميان مى روند. چنين اقدامى به ديالكتيك هگل و در عين حال به سنت عرفانى متكى است و نيز خواهان برخورد جدى و شدت عمل، از جمله براى محكوم كردن انواع انحرافات است كه بتواند نهضت را در بالاترين نقطه اوج خود قرار دهد كه در آن متعهد سياسى و پژوهش هاى نظرى بتوانند همزيستى كنند بى آنكه همديگر را از بين ببرند.
سوررئاليسم از جنبه سياسى با توجه به تفكرات بيان شده با نظام هاى فاشيستى و توتاليتر سخت مخالف است زيرا به آزادى كامل انديشه اعتقاد دارد. به همين دليل در دوران نازيسم در اروپا، برتون
همواره مخالفت خود را با اين نظام فاشيستى بيان مى كرد به همين دليل اروپا را ترك كرده اما نهضت او تا سال هاى سال ادامه پيدا كرد و بعد از مرگ او سوررئاليسم كمابيش در عرصه ادبيات نمايان بوده و هست ولى اين نهضت در هنر نقاشى هنوز در عرصه جهانى به گونه اى بسيار قدرتمند راه خود را ادامه داده و پيروان بسيار زيادى دارد.
سوررئاليسم يا فراواقع گرايى نه تنها ادبيات بلكه هنر نقاشى را نيز دستخوش تحولى كلى كرد، نقاشى سوررئاليستى از هر گونه تحليل زيبايى شناختى و فنى گريزان است. در انتخاب هر شكل و شيوه اى آزاد است. مشخصه نقاشى سوررئاليستى همانا نيروى فوق العاده اى است كه با توسل به آن انقلاب شاعرانه اى به وجود مى آورد. نقاشى سوررئاليستى تابع اشكال ادبى نيست بلكه تابع روح شاعرانه است كه به همه اشكال هنرى شكل مى بخشد.
در واقع نقاشى از ديدگاه سوررئاليستى، مانند نردبانى است كه نگاه با استفاده از آن، واقعيت جزيى را به سوى واقعيت كلى سوق مى دهد. منظور ستايش ظواهر نيست بلكه نقاشى سوررئاليستى پرده بردارى از صورت و ظاهر را بيان نمى كند، اما سوررئاليسم يا فراواقع گرايى، سبك هاى نقاشى قبل از خود را انكار نمى كند اما برداشتى تازه از نقاشى را بيان مى كند، نقاشى سوررئاليستى را مى توان در دوران هاى قبل در نقش ها و طرح هاى كيمياگران نيز ديد كه همواره با واقعيت ظاهرى اشياء تناقض دارد. همان نقاشى سوررئاليستى همانا فرافكنى تناسخ ها پنهان در دنياى اشياء است. اين گونه نقاشى تصور درونى را به مفهوم مطلق آن بيان مى كند. تصورات درونى در همزيستى با بازنمودهاى بيرونى ظاهر مى شود. آنچه كه نقاشى سوررئاليستى در پى آن است، بيرون كشيدن لحظه ها و يا صحنه هايى است كه قدرت هاى درونى روح در آنها با همه نيرو متظاهر مى شوند.
برتون مى گويد: «آفرينش هاى ظاهراً بسيار آزاد نقاشان سوررئاليست طبعاً نمى تواند ظاهر شوند مگر با بازگشت شان به بقاياى بصرى كه از ادراك خارجى مايه گرفته است...»
«بلوغ احتمالى اين نقاشان پيش از اينكه در تازگى موادى باشد كه وارد اثر مى كنند، در ابتكار كم و بيش بزرگى است كه در استفاده از اين مواد به كار مى گيرند.» برتون مى نويسد: «سوررئاليسم چه به صورت شفاهى و چه به صورت نوشتارى به هر نحو ممكن، بيان كننده و عملكرد واقعى از انكار انسانى است و به مسائل زيبايى شناختى و اخلاقى توجهى ندارد.» و اين همان مسأله اى است كه در شعر سوررئاليستى نيز شاهد آن است، هستيم. شاعر سوررئاليست بر آن است كه تخيلات و صور خيال خود را به هر گونه كه مى تواند، بيان كند. سپس درنتيجه مى توان گفت كه وجه مشترك اثر كلامى و اثر تجسمى در مكتب سوررئاليسم به خوبى به چشم مى خورد. شعر در نقاشى ميدان عمل و سيعترى پيدا مى كند و چنان به خوبى در آن مستقر شده است كه امروزه نقاشى مى تواند
بيشترين موضوعات شعرى را در آن دخالت دهد. شعر و نقاشى مكمل هم هستند. در واقع مى توان گفت تابلو نقاشى و شعر به سبك سوررئاليستى به طور عينى تعبير همانندى را نمايش مى دهند و موضوع آنها به گونه اى كاملاً عميق و درونى گسترش مى يابد.
نقاشى مانند شعر بيانگر زندگى ثانوى انسان ها است. نقاشان سوررئاليست با الهام گرفتن از اشياى بهتر مى توانند به درون خويش باز گردند.
طلايه دار نقاشى سوررئاليستى پابلوپيكاسو است. اين نقاش اسپانيايى كه در كشور فرانسه مى زيست، با توسل به بازى با رنگ ها، شكل ها و نورها توانست تحولى بزرگ در نقاشى قرن بيستم به وجود آورد. پيكاسو براى نشان دادن درون يك شىء به اينگونه سبك از نقاشى دست يافت. پيكاسو كه نخست مورد توجه آندره برتون قرار گرفت، با جدا كردن اشيا از مفهوم هاى رايج شان آنها را عارى از مكان كرده و به هنر، نوعى جنبه قانون شكنى را تحميل كرد. اما بايد گفت كه نقاشى پيكاسو به صورت نقاشى خودكار نيست و اراده او را نيز در بر مى گيرد اما او در پى زيبايى نقاشى اش نيست بلكه انسان و اشيا را از ديدگاه ديگرى كه همانا درونى است، بيان مى كند. در واقع بايد ذكر كرد لئوناردو داوينچى نيز قريب به پانصدسال پيش به تخيل خلاق اهميت فراوان داده است.
درواقع تركيب ادراكات، تنها سكوى پرتابى هستند تا به غير واقعى بپيونديم. او نيز مانند نقاشان سوررئاليست قرن بيستم تمايل داشت تا با استفاده از رنگ ها و شكل ها جهان درونى خود را بيان كند.
ماركس ارنست آلمانى نيز از جمله ديگر نقاشان سوررئاليست قرن بيستم است. او كه خود از طلايه داران مكتب دادائيسم بود شگفت انگيزترين روش ها، فنون مختلف را در نقاشى هاى خود ايجاد كرد. او از روش كولاژ استفاده مى كند، اوراق كاغذ به گونه اى تصادفى به سوى تخته كف و ماليدن به سوى آن طرح هاى متعددى به دست مى آورد و با نگاه دقيق به اين شكل ها، شكل هاى مختلف ديگرى نيز در آنها مشاهده مى كرد. درواقع اين همان نگارش خودكارى است كه سوررئاليست ها به آن اعتقاد دارند. ارنست درواقع دخالت خود را در تكوين تابلو كمتر مى كند و بيشتر از طريق فعاليت هاى نيروى وهمى روح و خيالات، افكار خود را ترسيم مى كند.
البته سال هاى طلايى نقاشى سوررئاليست ها از زمان سالوادور دالى شروع مى شود. بى اغراق بدون وجود او نقاشى به سبك سوررئاليسم هيچ بود. دالى نابغه نقاشى قرن بيستم در نقاشى به هركارى دست مى زد تا ما را به دنياى ديگرى هدايت كند. واقعيت هاى روزمره در نقاشى دالى بى معنا است. او اشيا را به گونه طبيعى در كنار هم قرار نمى دهد و بيشتر موضوع هاى ملموس و
مشهود را به صورتى عرضه مى كند كه تضاد بين رؤيا و واقعيت از ميان مى رود. او امر غيرعقلانى را نه با تصويرها و ساخت هايى كه از هرگونه نام و شناسه گريزانند، بلكه با نمايش اشياى واقعى عين تصويرهاى رنگى، نقاشى و هنر خود را عرضه مى كند. سبك سوررئاليسم در هنر و ادبيات تحول بزرگى را در جهان به وجود آورده است. آزادى فكر و انديشه، طنز سياه و عينى و خردگرايانه امور شگفت و جادو، نگارش و ترسيم خودكار از رؤيا و صور خيال، رؤيا و خيال تخيلى و هذيان گونه، تصادف عينى، بازتاب بيرونى و درونى اشيا. همه و همه نشأت گرفته از سبك و مكتب سوررئاليسم است.
سوررئاليست ها از هنر زبانى ساختند كه بيان ناشدنى ها هدف هاى راستين آن را بيان مى كند. اين جست وجوى بى غرضانه هنرمند سوررئاليست، واقعيت ديگرى است كه هنر را تشكيل مى دهد و كم و بيش در زير ظواهر فردگرايى مانده است با خودآگاهى گسترش مى دهد و به صورت فراواقعيتى انكارناپذير درمى آورد. نويسنده، شاعر و نقاش سوررئاليست بر آن است كه كشف و شهود خويش را در قالبى كه قابل فهم همه باشد بيان نكند بلكه او آشفته و خسته از وضعيتى كه براى بشر بعد از جنگ هاى جهانى اول و دوم به وجود آمده و به آن تحميل نيز شده است، خود را به دست اوهام مى سپارد و خويشتن را از عالم واقع دور و دورتر مى كند. او از اين طريق وسيله اى به وجود مى آورد تا به ناشناختنى هاى درون هرچيز پى ببرد و شرايط خود را در جهان ناپايدار به گونه اى ديگر بيان كند.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 11:34|
مكتب كلاسيسيسم
مكتب «كلاسيسيسم» اولين سبك ادبي است كه در قرن هفدهم، بعد
از دوران باروك در فرانسه به وجود آمد. نهضت اومانيسم (انسانگرايي ) را كه
در قرن چهاردهم درايتاليا شكل گرفت، تاحدودي مي توان زمينه ساز مكتب
كلاسيسيسم فرانسه دانست. كلاسيسيسم مكتب قانونها، قواعد و اصول است كه
بايدها ونبايدهاي بسياري را شامل مي شود. پيروان اين مكتب، مطابق قواعد
وقوانين قدما عمل مي كنند و در ادبيات به تقليد از ادبيات يونان و روم مي
پردازند. در قرن هفدهم ، آثار نويسندگان به دو دسته كلاسيك و غيركلاسيك يا
مردمي تقسيم مي شد. ادبيات كلاسيك نيز، ادبياتي عامه پسند ومردمي نيست.
اين ادبيات مختص طبقات بالاي جامعه و قشر تحصيل كرده وخاص مدارس به منظور
آموزش است. از نظر نويسندگان كلاسيك يك اثر ادبي يا هنري با رعايت كامل و
دقيق اصول وقواعد كلاسيك مي تواند به درجه «كمال » و «زيبايي» مطلوب برسد.
به همين دليل شعرا و نويسندگاني مانند مونتني ، رونسار ، كرني چون اين
اصول را رعايت نمي كردند و بيشتر به زبان مردم وعامه مي نوشتند يا مي
سرودند، آنها را جزو نويسندگان كلاسيك محسوب نمي كنند.
عقايد كلاسيكها
«انسان
شريف » : به عقيده كلاسيكها انسان بايد از نظر اخلاقي و اجتماعي درسطح
ايده آل و مطلوب وداراي «هنر زندگي كردن» باشد. يعني اعتدال، دانش بدون
فخرفروشي ، رعايت ادب و نزاكت بدون حقيرشمردن خود، رعايت احترام وادب در
برابر خانمها، ايمان بدون تعصب را در زندگي رعايت كند، كه روي هم رفته
براي چنين انسان ايده آلي، كلاسيكها عبارت «انسان شريف» را به كار مي
برند. .
تقليد از طبيعت كلاسيكها طبيعت را درآثار خود نه با تمام
واقعيت بلكه تنها با جنبه هاي خوب و ايده آل آن ارائه مي دهند يعني طبيعت
را نه آنطور كه هست بلكه آنچنان كه مي خواهند باشد، همراه با آرزوها و
آرمانهاي خود نمايش مي دهند. آنان با درنظرگرفتن عقل ومنطق وبدون دخالت
احساسات خود طبيعت را به تصوير مي كشند.
آموزنده وخوشايند بودن:
نويسندگان كلاسيك معتقدند كه آثارشان بايد علاوه براينكه موردقبول و توجه
خواننده قرار مي گيرد بايد براي او آموزنده نيز باشد ويكي بدون ديگري
فايده ندارد واين مسأله هدف نويسنده كلاسيك است.
بياني واضح و روشن: زبان نويسنده كلاسيك بايد زباني واضح و صريح همراه با ايجاز و كلمات درست دقيق و مناسب باشد.
آرمانگرايي : كلاسيكها آيده آليست و آرمانگرايند . يعني درهنر فقط به دنبال زيبايي كمال و خوبي اند.
خردگرايي
: كلاسيكها با موضوعات مختلف بطور عقلاني و منطقي برخورد مي كنند. آنان
معتقدند احساسات انسان بايد با كنترل عقل بيان و تجزيه و تحليل شود.
رعايت
مسائل اخلاقي ومذهبي كلاسيسيسم «مكتب اخلاقيون» است . از نظر آنان اثر
هنري و ادبي علاوه برآموزنده بودن بايد درخدمت «اخلاق ومذهب» نيز باشد.
درجست
وجوي اعتدال و كمال: كلاسيكها به دنبال تعادل بين عشق وعقل غم و شادي ،
اضطراب و آرامش و … هستند و از نظر آنان با رسيدن به اين تعادلها مي توان
كمال مطلوب وموردنظر خود را به دست آورد.
قالبهاي ادبي
تئاتر
كمدي وتراژدي ، قالب مناسبي براي بيان عقايد و اصول كلاسيكها است. به اين
وسيله آنان مي توانند ايده آل هاي خود را القا كنند. آنان در تئاتر، اصل
«حقيقت نمايي و نزاكت» را رعايت مي كنند. يعني همه چيز بايد نزديك به
واقعيت باشد و درصحنه تئاتر كلمات زشت و بي ادبانه را به كار نمي برند و
تماشاچي را با صحنه اي از تئاتر يا گفته اي ، شوكه و متعجب نمي كنند. (به
عنوان مثال، هرگز صحنه مرگ درتئاتر كلاسيك ديده نمي شود). علاوه براين ،
آنان «قانون سه گانه وحدت» را كه ارسطو، فيلسوف يوناني ، وضع كرده بود،
نيز كاملاً رعايت مي كنند. اين قانون شامل وحدت موضوع، وحدت زمان و وحدت
مكان است. يعني كل صحنه ها و پرده هاي يك نمايشنامه بايد يك موضوع را در
زماني واحد و مشخص و درمكاني واحد ارائه دهند.
موضوع ومضمون ادبيات كلاسيك
معمولاً
درآثار كلاسيك، نويسندگان به توضيح و توصيف خصوصيات روحي و اخلاقي وتجزيه
و تحليل روانشناسانه انسان مطلوب و آرماني خود مي پردازند. «طبيعت» نيز
ازجمله اين موضوعات است. البته منظور از «طبيعت درآثار كلاسيك، طبيعت
انساني و سرشت دروني انسان است. كلاسيكها توصيف طبيعت خارجي (مانند رودها
، كوهها، جنگلها و…) را درآثار و نوشته هاي خود كاري بي ارزش مي دانند
درحالي كه معتقدند بيان طبيعت انساني (مانند اميال ، گرايشها، احساسات ،
محبتها و…) چون صحبت از روح و درون انسان است برروح خواننده نيز اثر مي كند
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 11:34|
سمبوليسم
سمبل(symbol) در اصل يك واژهی يوناني(sum ball)و به معناي وابستگي و چسباندن دو نقطه مجزا است. اين واژه در حالت اسمي به معناي "رمز، علامت و نشانه" به كار ميرود.[1] در زبان فارسي براي آن معادلهايي نظير "نماد، نمود و رمز" پيشنهاد شده است.
در حوزهی ادبيات، سمبل يا نماد به چيزي گفته ميشود كه هم خودش باشد و هم مظهر مفاهيمي ديگر؛ مثلا درخت زيتون علاوه بر مفهوم واقعياش، نماد صلح و دوستي نيز هست. نمادها با توجه به زمينههاي فكري، فرهنگي و شرايط به وجود آمدنشان به دو گروه بومي يا عمومي تقسيم ميشوند.[2]
نمادهاي بومي مربوط به مردم منطقهاي خاص است؛ اما نماد عمومي را تقريبا همه مردم جهان به يك صورت درك ميكنند. در آثار ادبي، نيز نماد، دو گونه كاربرد دارد. گاهي هنرمند اثري كاملا سمبوليك و نمادين ميآفريند مثل منطق الطير عطار و گاه در اثر خود از برخي عناصر به عنوان نماد بهره ميگيرد.
اكنون ببينيم مكتب سبوليسم چيست؟ سمبوليسم يا نمادگرايي مكتبي ادبي – هنري است؛ كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا و آمريكا رواج يافت. اين مكتب در حدود سال 1855م. در "فرانسه" پايه ريزي شد و در سالهاي 1880 تا 1890 به اوج فعاليت خود رسيد.
مكتب سمبوليسم پيش از آنكه به شكل مكتبي مستقل درآيد. در بين گروهي از جوانان آن دوران پايهگذاري شد. اين افراد كه به تمامي قواعد و قوانين اجتماعي، سياسي و حتي اخلاقي معترض بودند، تلاش ميكردند تا هر آنچه با سنت گذشته ارتباط داشت را نابود نمايند. آنها با درآميختن احساسات و عواطف شاعرانه با هرزگي و بيبندوباري، ادبيات تازهاي را پديد آورند. همين روح عصيانگر آنها، در نهايت منجر به ايجاد تغييرات اساسي در ادبيات گرديد. برجستهترين فرد اين گروه، "ورلن"(Verlaine) بود كه كتاب "شاعران نفرين شده" او زمينههاي ظهور سمبوليسم را فراهم كرد. اين گروه به خاطر رفتارهاي افراطيشان به گروه "منحط" شهرت يافتند.[3]
از سوي ديگر نويسندهی ديگري به نام "ادگار آلنپو"(Edgar Allan Poe) در آمريكا موفق به خلق آثاري شد كه ترجمهی آنها تأثير بسزايي در شكلگيري مكتب سمبوليسم داشت. اين آثار كه غالبا به وسيلهی "بودلر"(Bolder) به زبان فرانسوي ترجمه ميشد، به همراه كتابي از بودلر به نام "گلهاي بدي" دنياي ادبيات را تكان داد. سپس شاعراني مانند "استفان مالارمه" (Mallarme) و "آرتور رمبو"(Rimbaud) پايههاي اين مكتب را استوار كردند.[4]
اين شاعران كه اندكي متعادلتر از شاعران منحط بودند، ميكوشيدند با مطالعات عميقتر جايگاه هنري خود را تثبيت نمايند. آنها كه به نظريهی "هنر براي هنر" معتقد بودند، با استفاده آموزشي و تعليمي هنر و ادبيات مخالفت ميورزيدند.
به عقيدهی آنها جهان سراسر رمز و راز است و مردم عادي از درك اين دنياي مرموز عاجزند و تنها شاعران ميتوانند اين اسرار را درك نمايند. از نظر آنها شاعر پيامبري است؛ كه ميتواند درون يا وراي دنياي واقعي ببيند و از آنجا كه اين عوالم توصيف ناپذيرند، شاعر سمبوليست ميكوشد با استفاده از زباني نمادين دنياي ناشناخته را به مخاطب بشناساند.[5]
مخالفت آنها با قيد و بندهاي ادبيات سنتي رفته رفته سبب ايجاد تغييراتي در اوزان شعري گرديد."رمبو" و "ورلن" نخستين كساني بودند كه شعر آزاد را در "ادبيات فرانسه" مطرح نمودند.
بارزترين ويژگي سمبوليستها، درونگرايي شديد و قطع ارتباط آنها با جهان بيرون بود. به باور آنها عرصهی شعر از آنجا شروع ميشود كه با واقعيت قطع رابطه شود.
درون گرايي و اعتقاد آنها به جهان ماوراء و تأكيد بر تخيل و كشف و شهود سبب شد كه شعر سمبوليستها از پيچيدگيهاي خاصي برخوردار شود و گاهي درك معناي آن به راحتي امكان پذير نباشد. توجه به همين ويژگيها، فضاي آثار سمبوليستي غالبا مه آلود و وهمانگيز بود.
سمبوليستها شعر را وسيلهاي براي بيان عواطف و احساسات شاعر ميدانستند و ميكوشيدند به جاي ارائهی يك پيام فكري يا اخلاقي، يك وضعيت عاطفي خلق كنند كه در آن از نمادهاي ظاهري براي بیان اين عواطف استفاده شود.[7]
از ديگر ويژگيهاي فكري سمبوليستها بدبيني و نگاه تيره و تار آنها به جهان بود. ريشهی اين بدبيني را بايد در تأثيرپذيري آنها از افكار "شوپنهاور" (Schopen Hauer)، فيلسوف آلماني قرن نوزدهم ميلادي جستجو كرد. او كه با ديدي منفي به زندگي انسان نظر داشت و آن را سراسر بدي و شر ميدانست، مرگ را تنها راه رهايي انسان از اين زندگي رنجبار تلقي ميكرد. اين افكار به شدت بر هنرمندان سمبوليست مؤثر افتاد، به طوري كه هالهاي از يأس و انبوه آثار آنها را فرا گرفت.[8]
يكي از چيزهايي كه به شدت توجه سمبوليستها را به خود جلب كرد، موسيقي بود. آنها ميكوشيدند شعر را به موسيقي نزديك نمايند؛ زيرا موسيقي هم زباني غيرمستقيم داشت و هم بيواسطه با عواطف انساني در ارتباط بود، بدون آنكه پيام خاصي را به مخاطب القاء كند. به همين سبب، سمبوليستها توجه به آهنگ و موسيقي دروني شعر را دستور كار خود قرار دادند؛ به طوري كه "مالارمه" معتقد بود: شعر پيش از آنكه كلماتي با معنا باشد، همراهي و هماهنگي صداهاست و عبارتي زيبا و بيمعني از عبارتي كه معنا دارد، ولي زيبا نيست، ارزشمندتر است.[9]
اين جنبش سرانجام در دهه اول قرن بيستم به وسيله "آندره برتون"(Andre Breton) به مكتب سوررئاليسم تغيير شكل يافت.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 11:33|
اکسپرسیونیسم
کلمۀ اکسپرسیون از دو قسمت ex که پیشوند و به معنای خارج است و pression به معنای فشار و فشردگی تشکیل شده است. این کلمه در زبان های اروپایی معانی متعدد دارد: بیان، عبارت، حالت قیافه؛ و نیز به معنای ابراز حالات درون و بالاخره به معنا ی فشردن می باشد، از آن جهت که میوه ای را بفشارند تا آبش دربیاید.
اصطلاح اکسپرسیونیسم در واقع ناظر به دو معنای اخیر است.
در ادبیات، اکسپرسیونیسم روشی است که جهان را بیش تر از طریق عواطف و احساسات می نگرد، به عبارت دیگر کوشش هنرمند مصروف نمایش دادن و بیان حقایقی است که بر حسب احساسات و تأثیرات شخصی خود درک کرده است.
اکسپرسیونیسم را می توان عکس العمل و نشانۀ تمایلات رمانتیک هنرمندانی دانست که در جامعه صنعتی رو به رشد اوایل قرن بیستم می زیستند و بی اعتنایی آن جامعه نسبت به ارزش های هنری آنان را به یافتن شیوه های جدید و به کار گیری شکل های متفاوت بیان هنری بر می انگیخت، به خصوص که در آن سال ها عقاید فروید - روانشناس اتریشی - که اعماق ذهن بشر را می کاوید، هنرمندان را به گزارش دقیق زوایای درون انسان وامی داشت.
اکسپرسیونیسم یا تعبیر گرایی مکتبی است در ادبیات، نقاشی، پیکر تراشی و سینما. این مکتب در سال 1905 در نقاشی آلمان به وجود آمد و در طول دهه بعد از جنگ جهانی اول (1918-1941) ادامه یافت. این نظریه تأثیر قابل توجهی در آلمان و کشورهای اسکاندیناوی داشته است. ظاهراً اولین بار اصطلاح اکسپرسیونیسم برای نقاشی ژولیان آگوست هروه - نقاش فرانسوی - به کار رفت. ونسان ونگوگ، (1890-1853) نقاش هلندی و هودلی نقاش سوئیسی را می توان از جمله کسانی دانست که در پیدایش این مکتب مؤثر بوده اند.
اکسپرسیونیسم مکتبی است شدیداً ضد واقع گرایی؛ و مکتب ناتورالیسم که تقلید و تکرار و دوباره سازی واقعیت و طبیعت است و نیز اصل حقیقت مانندی کلاسیسم را رد می کند و هدف آن القای تأثر ها و حالت های هنرمند یا شخصیت های ساخته ذهن او از طریق تعبیری است که هنرمند از آن ها می کند، هنرمند این مکتب به حد افراطی ذهن گراست.
هنرمندان اکسپرسیونیست سعی دارند درون اشیاء را نشان دهند بی آنکه به نشان دادن بیرون آن بپردازند. اکسپرسیونیسم در شعر به صورت توجّه به اصوات و رنگ، و کوشش هایی برای حس آمیزی که گاه به خاطر آنها مفهوم فدا می شود، ظهور می کند. تحریف موضوع های جهان خارج و جا به جا کردن توالی زمان و به کار گیری کوشش دقیق برای نشان دادن دنیا آنگونه که در ذهن نا آرام مشوش می تواند آشکار شود از خصایص شعر اکسپرسیونیستی محسوب می شوند.
دوران نهضت ادبی اکسپرسیونیسم بسیار کوتاه بود و در فاصلۀ بین 1925-1915 را در بر می گرفت. در آلمان شعر اکسپرسیونیستی از 1910 تا اواسط 1920 که سوررئالیسم جایگزین آن شده، ادامه یافت و در مقوله های ادبی بیشترین تأثیر را در نمایش به جا گذاشته است. از نمایش نامه نویسان اکسپرسیونیست در آلمان می توان ارنست تولرو و برتولد برشت را نام برد. از آنجا که اغلب تأثیرات اولیه از هنرهای تجسمی مایه می گیرد، مثلاً وان گوگ، مونش ورودن و سپس پیکاسو؛ نقاشی در درجۀ اول قرار دارد و پس از آن نوبت شعر می رسد. در جایگاه سوم تئاتر قرار دارد و به دنبال آن است که مسأله صحنه سازی و کورئو گرافی مطرح می شود. پس از اینها رمان، موسیقی و سینما وارد عمل می شود و انتهای صف، معماری و هنر تزئینی قرار می گیرند در این میان هنر تبلیغات را هم نباید فراموش کرد. در واقع در برابر پوسترها و ویترین مغازه ها بود که بعدها قسمت اعظم مردم با روحیه و سبک اکسپرسیونیسم آشنا شدند و به آن گرویدند.
اکسپرسیونیسم قالب های سنتی را نفی می کند و از ادبیاتی دفاع می کند که تنها ادبیات باقی نمی ماند. اعتراض بر ضد قرار دادهای موجود قالب هنری، در عین حال انکار چهرۀ جامعه بوژوائی است و قیامی بر ضد نظم موجود. مکتب اکسپرسیونیسم در سال 1921 از میان رفت؛ اما تأثیر این انقلاب ادبی که هنرمندان آن تنها در یک نسل ظهور کرد، و بیش از 10 سال دوام نیافت، هم در آلمان وهم به طور کلی در ادبیات هنر جهان باقی خواهد ماند و امروزه اکسپرسیونیسم بیش تر مجموعه ای از تکنیک ها و گرایش هاست تا نهضتی منسجم و سازمان یافته.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 11:32|
رئاليسم
رئاليسم از ريشهي لاتين «Real» به معناي واقعيت گرفته شده است. رئاليسم در معناي لغوي، معادل واقعگرايي يا واقعيتگرايي است. به لحاظ مابعدالطبيعي و در فلسفهي يونان باستان، واقعيت عبارت است از امر بيروني خارج از ما. در حكمت عرفان اسلامي، «واقعيت»، امري ذومراتب است و در نظام هستي، «واقعيت مثالي» قرار دارد و باطنٍ واقعيت ملكوتي يا مثالي نيز، واقعيت جبروتي است كه البته در زبان حكما و عرفا، از اين مراحل بيشتر با تعبير «حقيقت» نام ميبرند و معمولاً واژهي «real» يا «واقعيت» در خصوص مرتبهي محسوس عالم و واقعيت حسي به كار برده ميشود.
مرحوم علامه طباطبايي، در مقابل سوفسطائيان و آن دسته از فيلسوفان موسوم به «ايدهآليست» كه به نحوي منكر وجود عالم عيني بيرون از ماده بودند، اساس انديشهي فلسفي خود را «رئاليسم» ناميدند. در يك احصاء مختصر، ميتوان از 3 منظر، به مفهوم «رئاليسم» (واقعگرايي) و مفهوم مقابل آن «ايدآليسم» نگريست:
الف) هستيشناختي
از نظر اين دادگاه، «واقعيت»، عبارت از آن مرتبه از واقعيت است كه ظهور عيني و محسوس دارد و ظاهرِ وجود است و «حقيقت» همانا مرتبهي باطني و عينياي است كه اصيلتر و واقعيتر از مرتبهي آن را تشكيل ميدهد كه در نظام هستيشناسي حِكْمي - عرفاني آن را «واقعيت ملكوتي» يا «عالم مثال» مينامند.
ب) معرفتشناختي
در اين منظر - كه برگرفته از تعريف افلاطوني - ارسطويي از حقيقت است، «واقعيت» عبارت است از عالم عيني مستقل از وجود ما و «حقيقت» عبارت است از انطباق تصوير ذهنيِ فاعلِ شناسا با واقعيت خارجي. اگر تصوير ذهني شناسنده، مبتني بر «واقعيت» باشد، قضيهاي صادق و معادل «حقيقت» است و اگر تصوير يا قضيه ذهنِ شناسنده انطباق با واقعيت خارجي نداشته باشد، قضيهاي «كاذب» است.
ج) اخلاقي و ارزشي
از منظر اخلاقي و ارزشي، «واقعيت» يا رئاليته عبارت از آن امري است كه وجود دارد و غالباً زشت و غيراخلاقي و ناپسند است و «حقيقت» همانا وضعيتِ آرماني و موعودي است كه بايد جانشين واقعيت موجود گردد. از اين منظر، رئاليسم به معناي پذيرش زشتي و بيعدالتي واقعيت موجود، بدون تلاش جدي يا بنيادين براي تغيير آن است. از اين منظر، فرد «رئاليست» يا «واقعگرا» كسي است كه دعوت به پذيرش وضع موجود عالم و نحوي تسليم انفعالانه در برابر آن دارد و تلاش انقلابيون آرمانگرا را نحوي «ايدآليسم» و «پندارباقي» ميداند.
در بررسي اصطلاح «رئاليسم» و «رئاليته» بايد به اين مهم توجه كرد كه «واقعيت» در فلسفهي مدرن غربي، محدود به عالم محسوس و قابل كشف، از طريق تجربهي حسي و روشهاي «ساينتيفيك» (به اصطلاح علمي) است و در نسبت با بشر مدرن خودبينانه - به عنون سوبژه يا سوژهي تصرفگرِ شناساي دكارتي- معادلي صِرف «اُبژه» مطرح ميشود. در اين تلقي، رئاليسم از منظر خودبنيادانگاري نفساني (سوبژكتيويسم) بشر مدرن تعريف شده و «واقعيت» به صرف واقعيت حسي - تجربي قابل تصرف توسط ارادهي معطوف به قدرت بشر بورژوا، تقليل مرتبه و معنا داده است. رويكردِ رئاليستي در هنر قرون هيجده و نوزده غربي نيز، تا حدود زيادي ملهم از چنين تعريفي از رئاليته است
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 11:32|
الأساطیر.. رموزها دلالاتها
لم
یتفق حتی الآن علماء المیثولوجیا علی تعریف دقیق للأسطورة بل بقی تعریفها
ناقصاً عند الباحثین والفلاسفة المتخصصین ، وقد فسّرها بعضهم بأنها من
الخیال اللامبرمج أو ربما تکون مجرد وهم أو نزقاً صبیانیاً . فی حین یری بعض آخر ان الأسطورة إلهام روحی محض ویفسّرها فریق ثالث أنها خرافة لتفسیر الکون " بینما یری رابع فی الأساطیر القدیمة ذخائر من دوافع ذات طابع اولی بدائی تکشف وتنیر العقل الباطن الجماعی للأنسان "
وربما تکون الأسطورة " نوعاً من اللغة الشعریة " یعتمد علیها الشعراء فی تأویل حدث ما او یتخذونها قناعاً یتسترون خلفهُ لعدم الأستطاعة بالبوح بما یخزنون فی عقولهم من أفکار لا تناسب الأعراف والتقالید .
وقد " تکشف عن حقیقة مهمة ندعوها حقیقة میتافیزیقیة "
ولقد عدّها الأقدمون " مزیجاً من السحر والدین والتأریخ والتأمل والعلم "
ولقد استلهم الأدباء الغربیون والشرقیون علی حد سواء الأسطورة واستطاعوا توظیفها لخدمة أغراضهم وأفکارهم وتوصیل معانیهم وأخیلتهم الی المتلقی ، فکانت الأسطورة عندهم بمثابة الفکرة المفضلة وقد تطور هذا الأسلوب علی ید رواد مدرسة شعراء التفعیلة نذکر منهم علی سبیل المثال - نازک الملائکة ، بدر شاکر السیاب ، عبد الوهاب البیاتی ، بلند الحیدری ، کاظم السماوی وغیرهم .
"کان الشعراء والفلاسفة الرومانطیقیون فی الغرب أول من اغترف من بحر الأسطورة وشرب من کأسها السحریة ، فشعروا بالتجدید والأنتعاش وتغیرت نظرتهم الی الأشیاء منذ ذلک الحین فغدت جمیع الأشیاء فی صورة جدیدة منحولة ولم یعد باستطاعة اولئک الرجوع الی عالم الواقع"
ان سبب لجوء الشاعر المعاصر للأسطورة علی ما یبدو یحمل بین طیاته أهدافاً وغایاتٍ کثیرة إذ أنه یطمح الی تحقیق افکاره المکبوتة فی اللاوعی خوفاً من رقیب أو تجنباً لمسؤولیة هو فی غنی عنها أو یرفض - ربما - أعراف وتقالید المجتمع الذی یعیش فیه أو خوفاً من ان یتجمع حوله أعداء وحاقدون یوشون به ویحاول الشاعر - مثلاً - تجنب مهاترات جانبیة قد تؤدی به الی استعداء السلطة علیه أو محاربته فی حیاته الشخصیة ، ولهذه الأسباب وغیرها یستعین الشاعر بهذه الرموز التی تقیه غضب المجتمع وسلطة القهر والقانون ، ولقد غامر الأنسان من اجل البحث عن تفسیرات لفهم ظواهر کانت تحدث فی الطبیعة لیجد لها قوانین ثابتة من مدة لأخری طمعاً فی الحصول علی نتائج تؤدی الی زیادة معلوماته اولاً والأستفادة من ابحاثه فی علوم الفیزیاء والکیمیاء ثانیاً .
وقد استطاع الانسان ان یفسر کل ما حوله من ظواهر الطبیعة بواسطة الأسطورة وقد درسها بتطرف واکتشف انها الوعاء الذی ینمّی عنده عالم الخیال وسعة المعرفة .
من الشعراء الذین استطاعوا توظیف الأسطورة بطریقة ذکیة أیحائیة بدر شاکر السیاب فقد استفاد کثیراً من أسطورة (تموز) مثلا وکذلک أسطورة عشتار وادونیس فی قصائد کثیرة منها علی سبیل المثال لا الحصر (الأسلحة والأطفال) و (رؤیا فوکای) و (المومس العمیاء) واقتدی به آخرون مجددون دهشوا لتوظیف الاسطورة عند السیاب ووجدوا فیها ضالتهم لأنها عبارة عن انزیاح أحزان الشاعر وفی الوقت نفسه التعبیر بجرأة وصدق عما یختزنونه فی أعماقهم من أفکار لیس باستطاعتهم البوح بها إما لأسباب سیاسیة قد تحرض السلطة علیهم بالقمع والنفی والتشرید او لاسباب اجتماعیة.
بعض الفلاسفة یعرف الأسطورة علی انها (محاولة لفهم الکون بظواهره المتعددة او هی تفسیر له ، انها نتاج ولید الخیال من منطق معین ومن فلسفة اولیة تطور عنها العلم والفلسفة فیما بعد).
ولقد عرف العرب الأسطورة منذ عصور سحیقة وأعطوها دلائل ورموزاً فی عباداتهم وطقوسهم الدینیة ، فالعُزّی هی عشتار واللات هی اللاتو ، ومَناة هی مناة وود هو تموز أو هو ودن ومعناها السید.
الأسطورة نوع من (الحکی) الذی له دلالة ورمز أقرب للخیال منه الی الحقیقة ، وقد اعتمد الأنسان القدیم علی معتقدات تراثیة ابتدعها محاولاً بواسطتها تفسیر الظواهر الطبیعیة وجعل لها رموزاً مختلفة کالنور والماء وهذه تجلب له الخیر کما جعل للأسطورة رموزاً اخری مثل الرعد والبرق وهذه تسبب له القلق والرعب والتشتت النفسی .
من هنا صار للأسطورة معنی فلسفی تراجیدی فهی الوسیلة الوحیدة التی اعتمد علیها الأنسان لحل مشاکله الأنسانیة .
ویری بعض الدارسین ان الأنسان القدیم کان یتصرف من خلال ما یراه من ظواهر طبیعیة تحدث کل یوم کظاهرة المطر مثلاً فیفسر تلک الظاهرة علی انها آتیة من قوی خارقة واضعاً لها نوامیس وتفاسیر خاصة متصوراً انها من فعل الجن ولا بد ان یحذر منها أو یتکیف لها . والشاعر بدر السیاب استخدم هذه الأساطیر فی اغلب قصائده وبث فیها الحرکة وجعلها تؤدی وظائف عدة : ففی قصیدته " شبّاک وفیقة " یستفید السیاب من أسطورة " عولیس " بطل الأودیسة حیث نقرأ :
یا صخرةَ معراج القلبِ
یا صورَ الألفةِ والحبِّ
یا درباً یصعدُ للربِّ
لولاک لما ضحکت للأنسام القریة
فی الریح عبیر
من طوق النهر یهدهدنا ویغنّینا
(عولیس) من الأمواج یسیرهُ
والریحُ تذکّرُهُ بجزائرَ منسّیه
" شبْنا یا ریحُ فخلّینا
کما نقرأ فی قصیدة " ام البروم " فی الصفحة " 25 " هذه المقاطع :
یقول رفیقی السکرانُ : (دعها تأکل الموتی
مدینتنا لتکبرَ تحضن الأحیاءَ تسْقینا
شراباً من حدائق برسفون تعلُّنا حتی
تدور جماجمُ الأموات من سکْرٍ مشی فینا)
والأسطورة هی أعلی مراحل الرمز وهی ایحاء بشیء لایخطر علی بال الشاعر وقد تبنی العرب هذه الرموز خاصة فی العصر الجاهلی ومن الأساطیر ما هی بابلیة او کنعانیة أو آشوریة أو فینیقیة أو فرعونیة أو عربیة قدیمة .
إن توظیف الأسطورة هو معادل رمزی ذو دلالة اجتماعیة یهدف الی تعویض الشاعر عن شیء لایستطیع تحقیقه فی الیقظة فیحاول تجسیده فی الخیال ویستفید منه فی التعبیر عن ذاته ربما خوفاً من رقیب او تجنباً لملامة عذول .
والحقیقة ان الشاعر بدر شاکر السیاب یستخدم الأساطیر غیر المألوفة بغیة انعاش قصیدته محاولاً جعلها رکناً أساسیاً فی شعره وهو توظیف دقیق یدل علی اصالة وابداع .
عیناه فی الظلام تسربان کالسّفین
بأی حقلٍ تحلمانِ ؟ أیما نَهَرْ ؟...
بعودة الأب الکسیح من قرارة الضریح ؟
(أمیّتُ فیهتف المسیحُ ..
من بعد أن یزحزحَ الحَجَرْ
هلم یا عازرُ)
ومن الأساطیر التی استخدمها الشاعر السیاب والتی تعد من المعتقدات الشعبیة اسطورة " میدوزا " وهی الجنیة الأغریقیة القادرة علی تحویل عینی من ینظر الیها الی حجر کذلک استغل اسطورة تموز فی احدی قصائده اذ رمز فیها الی الخصب والنماء :
تموزُ یموتُ علی الأُفُقِ
وتغورُ دماهُ مع الشفَقِ
باختصار کان للأساطیر دور خطیر فی اغلب قصائد الشاعر السیاب ومن هذه الأساطیر :
1- أسطورة تموز : هو أله الخصب عند البابلیین وزوجته عشتار یقابله ادونیس کرمز للخصب والنماء عند قدماء الیونانیین وحبیبته عشتروت أو فینوس آلهة الحب وقد کان یقضی نصفاً من الشتاء فی العالم السفلی مع برسفون والصیف والربیع علی الأرض مع فینوس .
وتموز عرفته الیمن بأسم (تعز) وما زالت احدی مدنها تسمی باسمه حتی الیوم.
وتموز بابلی الأسم عالمی الرمز یموت من أجل أن یحیا ویشکل موته موتاً للخصب وعودته تشکل عودة للحیاة فهو واهب الحیاة للبشر ومجدد الخیر وباعث العطاء.
2- افرودیت : هی آلهة الحب عند الأغریق یقابلها فینوس عند الرومان .
3- اوزیریس : یعد إله الخصب عند المصریین القدماء وتقول الأسطورة الکنعانیة والمصریة ایضاً ان اوزیریس ارتبط بـ (إیزیس) لتجسید معنی الخصب فی الطبیعة کما ارتبط (بعل) بـ (أنات) السومریة .
4- ادونیس : هو اله الخصب والنماء عند الفینیقیین والأغریق وهو فی الأصل کلمة سامیة معناها (السید) وکان تموز البابلی یرتبط بحبیبته الآلهة عشتار بینما ارتبط ادونیس بافرودیت کونه اغریقیاً وبفینوس مرة اخری کونه رومانیاً .
ان تموز تقابله عشتار رمز الخصوبة والحیاة والحب عند سکان وادی الرافدین ، اما ادونیس فتقابله افرودیت او فینوس وکان ادونیس یمثل إله الخصب عند الفینیق والأغریق وهی تسمیة یونانیة .
5- أتیس : هو إله الخصب عند سکان آسیا الصغری حیث یجرح عابدوه أنفسهم بالسیوف والمدی وهم یرقصون حول تمثاله حتی تسیل دماؤهم قرباناً ودلالة علی الخصب .
6- لاة : هی ام تموز فی الأسطورة البابلیة. 7- أنات : هی أنانا السومریة وفی البابلیة تعنی (عشتارا) وفی الفینیقیة تسمی (عشتروت)
8- میدوزا : وهی رمز لآلهة الشر وقد مسخت حجراً وکانت کلما وقعت عیناها علی أی کائن حولته الی حجر .
وهناک اساطیر کثیرة تختص کل أسطورة بطقوس خاصة بها من هذه الأساطیر (ایکاروس ، واورفیوس ،ونرسیس وتنتالوس) .
9- أسطورة سیزیف : وهی فی الأصل یونانیة وسیزیف هذا محکوم علیه من الآلهة بالشقاء والعذاب الأبدیین فقد حکم علیه بان یرفع صخرة من اسفل غیاهب الارض الی اعلی قمة فی جبل المدینة وکان کلما وصل بها الی منتصف الجبل سقطت منه الصخرة الی القعر ، ویعود سیزیف یحملها مرة ثانیة وثالثة ورابعة وتسقط منه الی الأسفل وهکذا وهو کما یری القارئ عبث مستدیم وعذاب لا ینتهی منه الأنسان ولعل الأنسان العراقی الیوم خاصة یشبه سیزیف فی عذابه ومحنته .
وکذلک هناک اساطیر حدیثة الجذور کأسطورة (أناهید) وأسطورة (عبقر) التی تعد ملهمة الشعراء علی حد زعم شعراء قدماء .
ویعتقد ان هناک اساطیر صینیة وهندیة وکل من هذه الأساطیر وظفها الشعراء الکبار فی قصائدهم وجعلوا منها مواضیع اجتماعیة وانسانیة وحاولوا إلباسها لباساً عصریاً یخدم فنون اغراضهم الشعریة واشهر من استعمل الأساطیر الشاعر الأنکلیزی (ت. س. الیوت) والشاعر المبدع بدر شاکر السیاب .
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:14|
حافظ الشیرازی والتراث العربی
أسرار الإبداع فی شاعریته
شمس الدین محمد المعروف حافظ الشیرازی والملقب بلسان الغیب وترجمان الأسرار من أعظم شعراء الغزل فی الأدب الفارسی بل الأدب العالمی.
تاریخ ولادته على أفضل تقدیر عام 726ه/1325م وتاریخ وفاته على أفضل تقدیر أیضاً عام 791ه/1388 أو 1389 وعلى هذا یكون قد عاش نحواً من خمس وستین سنة. وتزیّن حیاته زهاء ثلاثة أرباع القرن الثامن الهجری والقرن الرابع عشر المیلادی.
وإذا كانت المدن ترسخ وجودها على الأرض بالاتساع والعمران واستمرار البقاء فإن بعضها یؤكد خلوده فی غمار الزمان بأبنائه العظام. ولاشك أن شیراز تدین بشهرتها الواسعة الآبدة لعلمائها الكبار وعارفیها الفضلاء ولكنها تدین بشهرتها خاصة لولدیها العالمیّین العظیمین سعدی فی القرن السابع الهجری وحافظ فی القرن الثامن.
ولد حافظ فی هذه المدینة من أب كان یشتغل بالتجارة. وكان أصغر أولاده الثلاثة. وتوفی الوالد وتفرق الأخوة. وبقی الابن الصغیر شمس الدین محمد مع والدته فی شیراز. وتذكر الموسوعة الإسلامیة نقلاً أنه كان له أخت أیضاً.
اشتغل حافظ فیما یروى حین كان صغیراً أجیر خباز: فكان یفیق فی غلس اللیل لیقوم بعمله حتى الفجر. فإذا فرغ اشتغل بالعبادة. ثم انصرف إلى حلقات بعض العلماء الأعلام فی مدینته یأخذ عنهم علوم عصره شأن الفتیان الذین تفتحت قلوبهم وبصائرهم على محبة العلم والتفقه فیه.
وأقبل خاصة على دراسة علوم الدین واللغة العربیة والفارسیة وبرع فی ذلك كله، وحفظ القرآن الكریم وهو فتى فوصف بالحافظ، حتى غدا هذا الوصف لقباً له شُهِر به وتمسك هو به حتى جعله اسماً له یزهى به. بل كان یعزو الفضل فی لطف شعره وسحر بیانه إلى ما یرمز إلیه هذا اللقب.
وله بیت من الشعر الفارسی یفید هذا المعنى:
ما رأیت ألطف من شعرك یا حافظ بالقرآن الذی یكنّه صدرك
وقد أجاد اللغة العربیة إجادة تامة واطلع على التآلیف العربیة التی كانت متیسرة ورائجة فی بلده شیراز.
درس "الكشاف عن حقائق التنزیل" لأبی القاسم جار الله الزمخشری (متوفى 538) و "المصباح" فی النحو للإمام ناصر بن عبد السید المطرزی، (متوفى 610) و "طوالع الأنوار من مطالع العلوم" فی البلاغة وفی بقیة العلوم للعلامة سراج الدین یوسف أبی یعقوب السكاكی (متوفى عام 626).
ونلاحظ أن هؤلاء المؤلفین جمیعهم من إیران وخوارزم. وأحدهم وهو البیضاوی أبو الخیر ناصر الدین عبد الله بن عمر نسبته إلى البیضاء وهی مدینة بإقلیم فارس قریبة من شیراز تدعى الیوم تل بیضا، اسمها عربی مفرد فی فارس، دعاها بهذا الاسم الجنود العرب الذین عسكروا فیها بعد إذ حصنوها حین حاصروا اصطخر زمن الفتح الإسلامی. وكانت قلعتها تستبین من بعد ویرى بیاضها وهی تقع فی شرق الوادی الجمیل شعب بوان.
وإنما توافرت كتب أولئك المؤلفین بفضل انتشار الوراقة ولقرب العهد بها ولتدریسها جیلاً بعد جیل. هذا وتسلسل التعلیم والروایة عن العلماء والإجازات التی تخرج الطلاب النبهاء متواصلة فی تلك الحضارة الواسعة لشرف العلم والعلماء فیها.
وقد نشأ حافظ وشهر بعلمه واطلاعه على العلوم العربیة والآداب العربیة والفارسیة وسمی معلماً فی مدرسة شیراز. وهو قد أحب مدینته حب سلفه سعدی لها، ولكنه لم یقم على خلاف سعدی بأسفار طویلة ما عدا سفراً قصیراً إلى بندر هرمز وسفراً آخر إلى مدینة یزد وزیارة لقبر علی الرضا فی مشهد. وقضى سائر عمره فی شیراز التی تَمَلَّى أرضها وسماءها وكان طوال حیاته هزارها الذی تغذى جناها وسلسالها وغنى جمالها أجمل غناء. وقد دفن فیها وغدا ضریحه مزار الناس ومرتاد المعجبین بشعره وغزله.
شیراز مدینة بنیت أو جددت فی أثناء خلافة عبد الملك بن مروان وأثناء حكم الحجاج بن یوسف الثقفی للعراق. ویروى أن أول من بناها محمد بن یوسف أخو الحجاج ولاّه أخوه على إقلیم فارس فبنى هذه المدینة كما یروى أن محمد بن القاسم ابن أبی عقیل وهو ابن الحجاج وفاتح الهند هو الذی بناها.
كانت معسكراً للمسلمین لما حاصروا مدینة اصطخر ثم جدد حكامها عمارتها وغدت مدینة عربیة إسلامیة كالدرة فی إقلیم فارس وورثت مجد العاصمة القدیمة اصطخر. وقد ازدهرت فی القرن الرابع الهجری حین اتخذها البویهیون مستقراً لهم وقاعدة لملكهم فی فارس. وبلغت فی زمن عضد الدولة فناخسرو ابن ركن الدولة شأواً عظیماً من العمران. وقد قصدها أبو الطیب المتنبی حین أرسل إلیه بعد وفادته على ابن العمید عضد الدولة یستزیره فحظی عنده وفاز ببعض أمانیه ومدحه بمدائح خالدة منها قصیدته التی یصف بها شعب بوان وقد مر به فی طریقه إلیه.
ثم أهملت شیراز وفقدت مكانتها حین انتقلت السلطة السیاسیة إلى البقاع الشمالیة من إیران. ولكنها مع ذلك بقیت وما زالت حتى الآن كالحدیقة الغناء الحافلة بالریاض والورود ولاسیما الورد الجوری هو صنو الورد البلدی أی الورد الدمشقی الذی سارت شهرته فی العالم أجمع. والنعت الجوری نسبة إلى مدینة جور القریبة من شیراز وهی التی بدّل اسمها عضد الدولة فجعله فیروزا باد وقد نسب إلى شیراز جماعة كثیرة من العلماء فی كل فن وكذلك جماعة من الزهاد والصوفیة أشهرهم أبو عبد الله محمد بن خفیف الشیرازی شیخ الصوفیة إذ ذاك. ولكثرة الصوفیة والزهاد فیها دعیت "برج الأولیاء". كما أنه نبغ فیها بعد حین من الزمان وفی بدایة العهد الصفوی فلاسفة مشهورون من أبرزهم صدر الدین الشیرازی الملقب "ملاّ صدرا" الذی انتهى إلیه العرفان.
تغنى بشیراز سعدی فی القرن السابع الهجری، ثم تغنى بها حافظ فی القرن الثامن الهجری. وقد بلغ تغنیه بها غایة الرقة والعذوبة وهی عنده فی التشبیه كالخال على خد الأقالیم السبعة.
وربما كان من الطرف ومن المفید أن نستجلی بعض محاسن شیراز فی زمن حافظ نفسه. فلقد عاصره ابن بطوطة (703/1304-779/1377) وزار فی ثنایا رحلته الواسعة الطویلة شیراز. وقد دخلها فی سنة 727 (كان حافظ یحبو أو طفق یمشی فی العام الأول من عمره) ویقول فیها: "وهی مدینة أصیلة البناء، فسیحة الأرجاء، شهیرة الذكر، منیفة القدر، لها البساتین المونقة والأنهار المتدفقة والأسواق البدیعة والشوارع الرفیعة. وهی كثیرة العمارة متقنة المبانی عجیبة الترتیب. وأهل كل صناعة فی سوقها لا یخالطهم غیرهم. وأهلها حسان الصور، نظاف الملابس، ولیس فی الشرق بلدة تدانی مدینة دمشق فی حسن أسواقها وبساتینها وأنهارها وحسن صور ساكنیها إلا شیراز. وهی فی بسیط من ارض تحف بها البساتین من جمیع الجهات وتشقها خمسة أنهار أحدها المعروف بركن آباد (تغنى به حافظ) وهو عذب الماء، شدید البرودة فی الصیف سخن فی الشتاء، فینبعث من عین فی سفح جبل هنالك یسمى القُلَیْعة. ومسجدها الأعظم یسمى بالمسجد العتیق وهو من أكبر المساجد ساحة وأحسنها بناء. وصحنه متسع مفروش بالمرمر. ویغسل فی أوان الحر كل لیلة. ویجتمع فیه كبار أهل المدینة كل عشیة، ویصلون به المغرب والعشاء. وبشماله باب یعرف بباب حسن یفضی إلى سوق الفاكهة. وهی من أبدع الأسواق. وأنا أقول بتفضیلها على سوق باب البرید من دمشق.
وأهل شیراز أهل صلاح ودین وعفاف وخصوصاً نساءها. وهن یلبسن الخفاف ویخرجن ملتحفات متبرقعات فلا یظهر منهن شیء. ولهن الصدقات والإیثار. ومن غریب حالهن أنهن یجتمعن لسماع الواعظ فی كل یوم اثنین وخمیس وجمعة بالجامع الأعظم. فربما اجتمع منهن الألف والألفان بأیدیهن المراوح یروحّن بها عن أنفسهن من شدة الحرّ. ولم أر النساء فی مثل عددهن فی بلدة من البلاد".
ویشید الرحالة ببعض المشاهد التی رآها فی شیراز كمشهد أحمد بن موسى أخی علی الرضا بن موسى بن جعفر الصادق ومشهد الإمام الولی أبی عبد الله بن خفیف كما یشیر إلى ضریح الشاعر الكبیر سعدی فیها. لقد قابل ابن بطوطة بین شیراز عاصمة ولایة فارس إذ ذاك ودمشق عاصمة بلاد الشام فی حسن الأسواق والبساتین والأنهار، ولاسیما بین سوق الفاكهة فی الأولى وسوق باب البرید فی الثانیة. وتلك مظاهر تتبدل مع الزمان فی التنظیم وشكل العمران. ولكنه أغفل منظراً طبیعیاً مشتركاً یضم الاثنتین وهو دائم وسافر للعیان وهو أن كلتیهما مستلقیة على سفح جبل. أما شیراز فعلى سفح جبل "الله أكبر" وأما دمشق فعلى سفح جبل قاسیون. ویروى أن تسمیة جبل شیراز كذلك أن طائفة من الأولیاء والصوفیة لما قدموا إلیها وأطلوا من أحد شعاب الجبل راعهم المنظر فهتفوا جمیعاً: الله أكبر.
على أن محاسن شیراز تعرضت فی القرن الثامن الهجری لعواصف سیاسیة وحروب داخلیة دامیة.
ذلك أنه لما انقرض مغول إیران أو الایلخانیون عمد بعض القادة والولاة إلى إعلان استقلالهم فی ولایات إیران. فنشأت فیها دویلات محلیة مستبدة تقیم حكمها على أساس روابط السرة فكانت تتنافس وتتطاحن وبقیت كذلك حتى فاجأها تیمورلنك فی نهایة القرن الثامن بغزواته وفتوحاته المدمرة.
حوصرت هذه المدینة فی زمن حافظ نحو خمس مرات وتداول حكمها الأمراء والملوك من تلك الأسر فكانت الحیاة الاجتماعیة فیها بین مدّ وجزر وشدة ویسر تتعرض حیناً لوابل من الدماء وتزخر تارة بالمحافل والأعیاد، تتراخى العادات والأعراف فیها طوراً، ویسودها التقشف والزهادة طوراً آخر، وتتلاطم فیها السلطات تلاطم الأمواج فی البحر المزبد ولم یكن هذا البحر سوى صحراء إیران وهضابها وسهولها وواحاتها.
أما حافظ فشق طریقه فی قرض الشعر ولمع فیه عَلَماً مجلیاً، وكان یراقب صروف الحیاة دون أن یتورط فی تیاراتها ولا فی صروفها المفاجئة. فلا نجد فی شعره إلا إشارات خاطفة تزید فی بیان براعته وجمال قریضه. ویجهد شراح دیوانه فی تعیین من تشیر إلیه من ملوك وما تلمح من حوادث أو وقائع.
وقد شهد وهو فی ریعان شبابه كیف استولى أبو إسحاق اینجو(1) على شیراز مرة ثانیة سنة 743 ولبث حاكماً لها عشر سنوات حتى سنة 754 ویروى أن هذا السلطان كان شاعراً وكان محباً للعلم، وكان كریماً فتح أبوابه للناس جمیعاً من شریف ووضیع وفقیر ورفیع، وكان یمیل إلى اللهو والسلم والحیاة الرخیة.
وقد تمكن مبارز الدین محمد مؤسس دولة المظفریین أن یهزم أبا إسحاق حین داهمه على أبواب شیراز ففر إلى أصفهان واحتمى بها حتى سنة 758 حین وقع أسیراً فی أیدی آل المظفر فسیق إلى شیراز التی حكمها من قبل فأعدم فی میدانها وأدرج مبارز الدین شیراز وأصفهان فی عداد مملكته.
واتسم حكم مبارز الدین فی شیراز بالقسوة وشدة التمسك بالدین والزهد والورع وقد ائتمر علیه أبناؤه فقبضوا علیه سنة 759 وسملوا عینیه وتوزعوا مملكته بینهم فكان إقلیم فارس الذی عاصمته شیراز من نصیب ابنه الشاه شجاع وقد أشار حافظ فی مقطوعة له إلى هذه الحادثة. فهو یحذر المرء من الركون إلى الدنیا وصروفها وینوه بالملك الغازی القوی مبارز الدین ثم یقول ما معناه: سمل عینیه من كان ینیر له الدنیا إذا وقعت عیناه علیه.
والمشهور أن الشاه شجاعاً على خلاف أبیه رفع الحظر على الحانات وأباح للناس سبل اللهو. وقد خلفه على شیراز ابنه زین العابدین. لكن أبناء الشاه شجاع تطاحنوا وما زالوا یتطاحنون حتى غشیهم صلیل السیوف فی جیش تیمور فأبادهم جمیعاً.
شهر حافظ بدیوانه الذی ترجم إلى سبع وعشرین لغة. فیه نحو سبعمائة قطعة من الشعر منها ما یقرب من خمسمائة مصوغة فی هذا الضرب من الشعر الفارسی الذی یدعى بالغزل. وقد طارت شهرة غزله فی الآفاق داخل إیران وخارجها حتى أن الشاعر الألمانی الشهیر غوتی قد عدّه أحد الأعمدة التی قام علیها صرح الآداب العالمیة. هذا وقسم من أشعاره ملمّع أی ورد بعض أبیاته بالعربیة. وقد نسب إلیه شعر بالعربیة ولكنه لا یرتفع إلى مستوى شعره بالفارسیة. والذی نظنه أن الشعر الذی نظمه بالعربیة ینبغی أن یكون أكثر من الذی وصل إلینا نظراً لتضلع حافظ من هذه اللغة ومعرفة آدابها معرفة عمیقة. وربما ضاع فی المحن وفی غبار الزمن. وقد أطلق الشاعر عبد الرحمن جامی (817/1414-898/1492) فی كتابه "نفحات الأنس" على حافظ لقب لسان الغیب وترجمان الأسرار وفسره بأن صاحب هذا اللقب كشف عن كثیر من الأسرار الغیبیة والمعانی الحقیقیة التی التفّت بألبسة المجاز. وهی مع ذلك خالیة من التكلف والاضطراب. وهذا كله یدل على أن أشعار حافظ كانت تهز الناس وتطربهم أیما طرب وتبعث فی نفوسهم نشوة عمیقة.
إن التمكن من الثقافتین العربیة والفارسیة أفاد حافظاً فی قریضه وبلاغته. وقد أشار فی غزلیته رقم 28 إلى استفادته من البلاغة العربیة. فهو یقول ما معناه: "لیس من الأدب التمدح وإظهار الفضل أمام الحبیب. ولهذا فلسانی صامت ولكن فمی حافل ببلاغة العرب".
هذا وربما كان القارئ یود أن یطلع على بعض ما وصل إلینا من شعره العربی. فنحن نثبت له هذه القطعة:
ألم یأنِ للأحباب أن یترحموا وللناقضین العهد أن یتندموا
ألم یأتهم أنباء من بات بعدهم وفی قلبه نار الأسى تتضرم
فیا لیت قومی یعلمون بما جرى على مرتجٍ منهم فیعفوا ویرحموا
حكى الدمع عنی والجوانح أضمرت فیا عجباً من صامت یتكلم
أتى موسم النیروز واخضرت الربا ورقق خمر والندامى ترنموا
بنی عمنا جودوا علینا بجرعة وللفضل أسباب بها یتوسم
شهور بها الأوطار تقضی من الصبا وفی شأننا عیش الربیع محرم
أیا من علا كل السلاطین سطوة ترحم جزاك الله فالخیر مغنم
لكل من الخلان ذخر ونعمة وللحافظ المسكین فقر ومغرم
وها أنذا أختار بعض الأبیات العربیة التی وردت فی قصیدة له ملمعة:
سلیمى منذ حلت بالعراق ألاقی من نواها ما ألاقی
ربیع العمر فی مرعى حماكم حماك الله یا عهد التلاقی
مضت فرص الوصال وما شعرنا وإنی الآن فی عین الفراق
نهانی الشیب عن وصل العذارى سوى تقبیل وجه واعتناق
دموعی بعدكم لا تحقروها فكم بحر تجمَّع من سواقی
على أن العصر الثامن الهجری مع ما خامره من فتن واضطراب فی مختلف أرجاء العالم الإسلامی الواسع لم ینفك عن متابعة الازدهار اللغوی والأدبی والعلمی وعن التقدم فی أكثر مظاهر المدینة. ذلكم أن عناصر المدینة من سیاسة وإدارة واقتصاد وعلوم وفنون لا تجری فی تطورها على نسق واحد. وإذا شئنا أن نستعمل تعبیراً اجتماعیاً حدیثاً قلنا إن المتغیرات الحضاریة والاجتماعیة لا تتبع فی تغیرها المستمر خطاً بیانیاً واحداً. بل لكل منها خط بیانی فی تطوره وإن كانت جمیعاً تلفها حضارة واحدة. وهكذا نجد فی هذا العصر مع اضطرابه وفتنه وقلاقله من قل أشباههم وندر أمثالهم. وحسبنا هنا أن نشیر إلى ثلاثة من معاصری حافظ ومواطنیه ممن بلغوا القمة فی علومهم.
ولد عبد الرحمن عضد الدین الایجی (860؟/1281؟-756/1355) بایج من نواحی شیراز. ولی القضاء وغدا إماماً فی المعقولات وفی أصول الفقه وفی المعانی والبیان والنحو وأنجب تلامیذ عظاماً. من كتبه المشهورة "المواقف فی علم الكلام".
وولد مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الشیرازی الفیروزأبادی (729/1329-816/1413) فی بلدة كارزین القریبة من فیروزآباد التی أشرنا إلیها آنفاً. وقد درس فی شیراز، ثم بغداد، ورحل إلى دمشق وبیت المقدس ثم زار القاهرة ومكة والهند ثم رجع إلى مكة وبقی فیها مدة ثم زار تیمور فی شیراز حین دخلها فاتحاً. وقد عرف تیمور مكانته فأكرمه غایة الإكرام، ثم خرج إلى الیمن. ولما دخل زبید سنة 796 تلقاه الملك الأشرف إسماعیل من الدولة الرسولیة وبالغ فی إكرامه وبقی فیها حتى وفاته نحو عشرین سنة وتولى قضاء الیمن كله. وقد تزوج الملك الأشرف ابنته وكانت رائعة فی الجمال فنال بذلك منه زیادة البر والرفعة وألّف فی زبید قاموسه المحیط المشهور الذی هو ركن من أركان اللغة العربیة. ومن المعلوم أن الشعوب الإسلامیة كان یتزوج بعضها من بعض. وأعلى الكفاءات فی الزواج هی العلم. ومجد الدین قد ولد فی فارس ولكنه كان ینتسب إلى أبی بكر الصدیق ویصف نفسه بالصدیقی.
وولد السید الشریف علی بن محمد الجرجانی (740/1340-813/1413) فی بلیدة من نواحی جرجان فی شمالی إیران. ولكنه التحق فی سنة 779 بخدمة الشاه شجاع الذی جعله أستاذاً فی مدرسة "دار الشفاء" فی شیراز. وربما كان زمیلاً لحافظ لبعض الوقت. أخذه تیمور فی سنة 789 حین دخل شیراز للمرة الأولى إلى سمرقند. ولكنه استطاع الرجوع إلى شیراز بعد وفاة تیمور عام 807 وتوفی السید الشریف فی السنة التی توفی فیها الفیروزأبادی. من أشهر كتبه "التعریفات" وله أیضاً كتاب "شرح المواقف" أی مواقف الایجی.
على أن بلاد العرب وبلاد الإسلام كلها كانت تتألق بالعلماء والشعراء والمؤلفین فی هذا العصر كما فی العصور الأخرى. ونحن نرغب فی إیراد أسماء بعض الأعلام إشارة إلى هذه الكثرة الزاخرة إذ ذاك نذكرهم حسب تواریخ وفیاتهم الهجریة. وكأننا نتغنى بهم:
الإمام ابن تیمیة (728) والسلطان المؤرخ أبو الفداء (732)، وشهاب الدین النویری صاحب "نهایة الأرب فی فنون الأدب" (733) وابن فضل الله العمری صاحب كتاب "مسالك الأبصار فی ممالك الأمصار" (748) وشمس الدین الذهبی الحافظ المؤرخ (748) والشاعر عمر بن الوردی (749) والشاعر الكبیر صفی الدین الحلی (750) وابن قیّم الجوزیة (751) وابن هشام النحوی (761) وصلاح الدین الصفدی (764) وابن شاكر الكتبی (764) وابن كثیر المحدث والمؤرخ صاحب كتاب "البدایة والنهایة" (774) ولسان الدین الخطیب الغرناطی الأندلسی (776) ومسعود بن عمر التفتازانی (793) أبعده تیمورلنك إلى سمرقند كما أبعد الشریف الجرجانی إلیها، وعبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة والتاریخ المشهورین الذی رحل إلى مصر فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق ثم قدم دمشق عند محاصرة تیمورلنك لها وقابل الطاغیة على أبوابها(808).
وقد قدمنا هذا العرض لبیان اشتباك الصروف السیاسیة والحربیة وتقدم العلوم والآداب الدائب فی ظلال تلك الصروف وفی دیاجیها. ویصعب على الباحث حین یتناول علماً من الأعلام ولاسیما مثل حافظ ألاّ ینوّه بذلك التقدم الدائب وذلك الاشتباك المؤسف.
لقد مضى على وفاة حافظ ستمائة عام. وتخلیداً لذكراه أقیم مهرجان تكریم له فی دمشق لإلقاء أضواء جدیدة على أدبه وثقافته وشعره ألقى كاتب هذه السطور فیه بحثاً حول أسرار الإبداع فی شاعریة حافظ وهو البحث الآتی.
* * *
من الصعب على الباحث أن یُمْسِك بأسرار كشفٍ علمی یدرسه أو إلهام شعری یتأمله. ولكنه یستطیع أن یوضح تلك الأسرار ما تسنّى له الإیضاح. ومن الصعب أیضاً أن یتلمس الباحث عبقریة الشاعر إذا كان غیر مختص بلغة الشاعر وآداب قومه، ولكن هاتین الصعوبتین قد یجدهما الدانی القریب كما یجدهما القاصی البعید. وقدیماً قیل: "شدة القرب حجاب"، وقد یرى البعید ما لا یراه القریب. ولكنّا نقول أیضاً: "شدة البعد غیاب"، وقد یرى القریب ما لا یراه البعید. وفرق كبیر بین أن تسمع خفقات قلب الحبیب وهو فی یدیك وعلى وسادتك وأن تتصور تلك الخفقات مجرد تصور، وكذلك فرق كبیر بین أن تقرأ الشاعر فی لغته فتسمع هجسات نفسه وأن تقرأه فی ترجماته فتغیب عنك تلك الهجسات الخفیة. ومع ذلك فربما یتاح لنا مع قربنا من حافظ فی ترجماته وبعدنا عنه فی لغته الأصلیة أن نحاكیه لماماً ولیس دائماً ولو فی شأن من الشؤون. أولیس هو الملقب بلسان الغیب وترجمان الأسرار؟! فلا یعوزنا بحافز حبّه وعاصف الإعجاب بعبقریته أن نتكلم على إبداعه وأن نترجم أسرار هذا الإبداع إلى العربیة، حتى للمختصین بدراسة هذا الشاعر العظیم...
إن الشعر كبقیة الفنون یتألف من عناصر عدة متباینة وعناصره هی الألفاظ والإیقاع والوزن والقافیة والنغم الذی ینساب بین ذلك كله والمعانی المختلفة حقیقیة ومجازیة ورمزیة، والإیحاءات التی تواكب المعانی وتحفّ بها والتی تطلق الفكر فی آفاق شتى ثم یأتی فوق ذلك كله ائتلاف تلك العناصر المتعددة والتحامها فی صیغة مُثْلى علیا متقنة الأداء رائعة التأثیر لا یمكن تصور صیغة أعلى منها فی موضوعها المفرد الذی یضم تلك العناصر ضمّ الأم لولدها الوحید..
والباحثون فی شعر حافظ متفقون جمیعاً على عذوبة ألفاظه وبعده عن الكلمات النابیة والعبارات الواهیة ومجمعون على ما فی هذا الشعر من إیقاع مؤثر ینجذب إلیه القلب ویطرب له السمع وتهش له النفس، إذ یصور نزعاتها الحسیة والعلویة معاً، وتبتهج به الروح إذ یحلق بها فی جو من الأحلام والآمال والحریة والصفاء والإبداع، هذا كله ینوّه به علماء اللغة الفارسیة وزعماء الأدب الفارسی...
أما نحن فنرید أن نعالج بعضاً من معانیه التی نزعم أن التفنن فی سبكها وفی تلوینها من أسرار إبداعه. هذه الأسرار قد لا یدركها الحساد الشانئون فیلخصونها فی جملة من الأغراض المتكررة المتباینة، وذلك على مثال ما یروى من أن سلطان شیراز الشاه شجاعاً كان ینظم الشعر ویرید أن تبلغ أشعاره ما بلغته أشعار حافظ من الشهرة وبعد الصیت وكمال الصنعة وإحسان الأداء، فاستدعاه یوماً وانتقد غزلیاته قائلاً: "إن واحدة من غزلیاتك لا تجری على نهج واحد من أولها إلى آخرها بل إننا نجد فی الغزل الواحد بعض الأبیات فی وصف الخمرة وبعضها فی التصوف والباقی فی التغزل بالحبیب، وهذا التلون والتنوع فی أغراض الغزل لا یجیزها البلغاء والفصحاء". وقد صعب على حافظ أن یشرح له أسرار صناعته، ومن المعلوم أن الشعراء یقولون أشیاء جمیلة دون أن یدركوا كیف یقولونها كما قرر قدیماً سقراط زعیم فلاسفة الیونان، فلم یجد حافظ ما یرد به على الشاه شجاع خیراً من أن یوافقه على ما ذهب إلیه وأن یختم عبارته بلون من الثقة بالنفس والسخریة اللاذعة فقال: "إن ما قاله مولای هو عین الصدق ومحض الصواب، ومع ذلك فإن أشعار حافظ یتردد إنشادها فی الآفاق على حین لا تتجاوز أقوال غیره من الشعراء أبواب شیراز"...
وعندنا أن هذا التفنن فی مختلف الأغراض فی غزلیة واحدة یحكی صیاغة جوهرة من الماس فریدة، فهو یعرض ألواناً من العواطف الجمیلة كما یعرض الموشور البلوری ألوان الطیف السبعة حین یجتازه النور الأبیض، ألوان الطیف هذه تبهج البصر كما تبهج تلك الأغراض الفنیة المصوغة صوغاً متقناً وملهماً حاسة السمع العقلیة الفنیة، فتطرب الفكر بإحكامها وإتقانها على مثال الموسیقى البولیفونیة الجمیلة الممتعة.
ثم إن هناك أموراً أخرى لابد من جلائها لبیان ذلك الإبداع.
ذلك أن شعر حافظ یختلف دارسوه وشراحه فی حقیقة مقاصده أكان یرید بالخمرة بنت الكرم وبالأحباء بنات شیراز الشهیرات بالجمال والإغراء ذوات العیون السود السابیة والثغور النقیة والقدود المائسة وضفائر الشعر المسبلة على الكتفین والحدیث الناعم والشذا الفاغم أم یرید معانی روحانیة ومجالی ربانیة یحار فی تأملها الدرویش الصوفی ویغرق فی لآلائها فكر الشاعر الحكیم. أوكان حافظ یلازم حقاً خمارات المجوس وأدیرتهم أم كان یرمز بها إلى الظواهر المادیة التی كان یتجاوز أشكالها وسقاتها وراحها إلى ما وراء ذلك من لُبانات مثالیة عالیة؟... إن ذلك الإبهام یسبغ على أشعار حافظ صفة الرمز. وللرمز الشاعری الملائم للطبع مزایا كثیرة... منها أن الرموز متصلة بالحالات النفسیة التی یرید الشاعر أن یصورها أو یوحی بها ویشیر إلیها. ذلك أن معانی الألفاظ الحقیقیة تحیط بالفكرة وتحصرها وتحدها، ولكن المعانی الرمزیة تطلق الفكر فی جو من التأمل وتحمله على بُراقها فی رحلات بعیدة، وتتیح له أن یكشف عن رؤى بدیعة تتنوع حسب الطبع والمیول والثقافة والسریرة... وهذا یجعل السامع أو القارئ یشعر بجذل لذیذ خفی حین یتوهم أنه یشارك الشاعر فی تحری تلك الرؤى الطریفة وفی تبصرها. إن الوضوح التام یحرم الفكر من غبطة الحزر التدریجی. أما الإیحاء والغموض فهما الغایة المنشودة وهما السر المخامر للرمز. الوضوح التام یجعل الفكر یقف عند رؤیة المرء سطح البحر ولكن الرمز یحفزه على الغوص فی أعماق اللجج لالتقاط اللآلئ. الوضوح التام ینظر أیضاً إلى صفحة القبة الزرقاء فی النهار فیراها جمیلة حقاً بلونها السماوی اللازوردی، ولكن الرمز ینظر إلیها فی لیلة صافیة فیجعل الفكر یُشْدَهُ بتأمل نجومها وكواكبها وبروحها ویحاول السفر بعیداً فی أجوائها الساحرة الشاسعة..
إن هذا الذی قدمناه لا یكفی. بل نزید أن الحب والوجد والكأس والشراب والحبیب والربیع والخضرة والریاحین كلها أمور یمیل إلیها الطبع ویأنس بها القلب وتستلذها الفطرة الإنسانیة، ولهذا قرنها الشعراء منذ القدیم بأشیاء مستحبة وملذوذة أو شبهوها بها، فالوجد یشبه النشوة والحب یشبه السكر والشراب بحسب ألوانه یذكر بالورد أو الیاقوت ورائحة التفاح أحیاناً وغیرها... كما أنهم شبهوا وجه الحبیب بالقمر أو الشمس وثغره بالدر وقوامه بالغصن وشذاه بالعبیر، وما إلى ذلك من صور شعریة فاتنة، ثم إن الربیع یحكی شباب العمر، وتكاد الخضرة والبساتین والریاحین تمثل الجنان. وقد نستعمل فی علم البیان المشبه به مكان المشبه فتلك هی الاستعارة والمجاز ویضاف إلى ذلك الكنایة والتلمیح وما إلى ذلك من وسائل التعبیر التی تضفی ستاراً على المقصود الحقیقی ولكنها تلمح به أو تشف عنه، وذلك هو جوهر الرمز الشعری. ولكن هذا رمز ندعوه من الدرجة الأولى. فإذا صعدنا درجة أعلى واعتمدنا تلك الاستعارات لا لأجل ما تدل علیه فی عالم الواقع من حبیب إنسانی وخمر مادیة وكأس بلوریة ولا ما تحاكیه فی عالم الشعر من شمس أو قمر أو ورود أو عقیق أو لازورد بل لتشیر إلى معالم علویة كالحب الإلهی والنشوة بهذا الحب، وكحنین النفس إلى القیم العلیا مشابهاً لعشق الفراشة للنور ثم التغنّی بالضیاع وخلع العذار فی هذا العشق السامی، فإن ذلك رمز ندعوه من الدرجة الثانیة وهو أكثر عمقاً وأشد شفوفاً عن أبعاد متعددة وعن عوالم متفاوتة الصور كالعالم المادی والعالم الشاعر والعالم الروحانی منظمةً ومرتبةً على مستویات ثلاثة وما إلى ذلك من آفاق واسعة حرة مستجیبة للتأویل وغنیة بالصور والأحلام...
ربما یعمد الشاعر إلى مثل هذا الرمز المتعدد الدرجات ولكنه لا یأتی بالشعر العجاب. ذلك أن المهم لا حشد المعانی ولا لطافة الألفاظ ولا حساب الوزن والإیقاع، ولا غیرها من العناصر.
وإنما المهم تألیف ذلك كله تألیفاً معجزاً مبتكراً بدیعاً لا یعلو علیه تألیف فی موضوعه ولا تستطیع أن تناله بالتغیر والتبدیل وهذا هو سر الإلهام وحقیقة الإبداع، وهذا ما نظن أن حافظاً قد بلغ الأوج فیه والاحتفاظ به. لم یكن أحد یدرك إذ ذاك أن ذلك الصبیّ الخباز سوف یصنع بشعره أطیب أصناف الحلوى الحسیة والروحیة لیقدمها إلى العالم أجمع. یضاف إلى ذلك أن لسان الغیب كما أصبح یدعى لم یقبع فی برج عاجی ولا كان بعیداً عما یجری فی مجتمعه ویقع بمدینته من ضغوط اجتماعیة ومن عنف ومحن وطوارئ محزنة، فكان فی شعره یعمد إلى التلمیح فی الحین بعد الحین ویشیر ولو من بعید إلى تلك الظروف الاجتماعیة، حتى إن شراحه یجهدون فی إرجاع كل تلمیح إلى حادث مسمى. ولا غرو فی ذلك فقد كان ذا قلب إنسانی بكل ما فی لفظ الإنسانی من معنى شریف وخلق سام، فهو یكره التزلف ویبغض النفاق والریاء ویندد بالاستبداد وینوه بالحریة والنقاء. قلبه عامر بحب بلده شیراز برج الأولیاء وبحب غیدها، طافح بحب أمته، بل بحب الإنسانیة كلها. وهو إذا ظهر فی شعره بمظهر الماجن المستخف بالعرف فلكی ینكر التعصب وینادی بالحریة الفكریة والمعاشیة، ویجذب الأنظار نحو الفقراء والدراویش، ویتمشى مع عواطفهم. أولیس ینكر على الشعراء انسیاقهم فی مظاهر الترف بلا طائل ولا فائدة حین لا یبالون فقر الفقراء ولا حاجة المحتاجین؟! من المعلوم أنه كان متمكناً من العلوم العربیة ومن العلوم الدینیة كما سلف حتى إنه كان یدرّس تفسیر الكشاف فی مدرسة شیراز ویُحَشّی علیه إلى جانب حفظه القرآن. وهو یدرك تماماً جمال بیتی أبی نواس فی قطعته الفنیة الجمیلة المشهورة:
تدار علینا الراح فی عسجدیة حبتها بأنواع التصاویر فارس
قراراتها كسرى وفی جنباتها مها تدریها بالقسیّ الفوارس
فهو لا یمر بها دون تعلیق، لا نجده ینكر على الماجن شرابه ولكنه یندد بهذه الكأس العسجدیة التی لا لزوم لها فی السكر إذ یستطیع الماجن أن یحتسی الراح فی كوب بسیط وأن یوزع الذهب فی تلك الكأس العسجدیة على الفقراء:
أیها المحتسی بكأس ابن هانی بنت كرم كمثل لَعلٍ مذاب
أفلا جدت بالنضار على من ألصق الدهر أنفه بالتراب
على حد ترجمة الشاعر السوری محمد الفراتی لهذین البیتین.
وهو أیضاً یندد بأصحاب القصور الذین أعماهم الغنى المادی عن الغنى الروحی. فإذا هم عاشوا فی قصور مشیدة فالدراویش أغنى منهم روحیاً إذ یبیتون فی قصر الكون یتملكون ما فیه تملكاً روحیاً حین یعون ما فیه من جمال ومحاسن ومجالی لا تنفد، ذلك أن التملك المادی وَهْم إذ لا نملك على وجه البسیطة شیئاً عند التحقیق، وهذا حین تغنى الشعراء الدراویش أمثال حافظ بجمال الحبیب وسحره یشعرون بغناهم الروحی إذ یتملكون الأشیاء تملكاً ممتعاً آخر غیر التملك المادی، فهو إذ یتغنون بجمال الحبیب یستطیعون أن یقدموا له هدایا سنیة مما یتملكون من الكون فیهبون له أشهر البلاد وأوسعها مثل سمرقند وبخارى بل یستطیعون أن یهبوا له أكثر من ذلك، وهنا لابد من الوقوف عند هذه النادرة:
عاش حافظ الشیرازی لیرى تیمورلنك یدخل مدینة شیراز سنة تسع وثمانین وسبعمائة ویروى أن تیمورلنك لما دخل المدینة وكان قد قرأ شعر حافظ وأعجب به استدعاه إلیه ولامه على بیت فی غزلیته ذات الرقم (3) وكانوا یتغزلون بالجمال الهجین التركی الشیرازی ومعنى البیت "لو أن ذلك التركی الشیرازی یأخذ قلوبنا بإشارة من یده لوهبت له كُرْمى خاله الأسود سمرقند وبخارى".
قال له تیمور: "إنی سخَّرت أكثر الربع المسكون بحد السیف وأنت الیوم تهب سمرقند وبخارى وهما موطنای الألیفین لخال أسود على وجنة تركی شیرازی".
ولكن الشاعر أراد أن یحوّل نظر الفاتح الشكس عن غناه الروحی الذی یعتدّ به إلى حالته المادیة المزریة فی الفقر والدروشة فأجابه: "بسبب هباتی الخاطئة هذه تجدنی یا مولای أقضی حیاته فیما أنا فیه من عدم ومسكنة"...
هذا وقد قالت العرب قدیماً: "من ألف فقد استَهْدَف" أی من ألف كتاباً أو شعراً أو غیرهما فقد عرض تألیفه للنقد.
وقد انتُقد حافظ حین بدأ غزلیة له مُلَمَّعَة هی الأولى فی دیوانه بأحد بیتَیْ شعر متواریین فی سواد الكتب العربیة ولا یكاد یعرفهما إلا المختصون بالأدب العربی منسوبین إلى یزید بن معاویة وهذان البیتان هما:
أنا المسموم ما عندیَ تریاق ولا راقی
أدر كأساً وناولها ألا یا أیها الساقی
ویدافع الشاعر الفارسی أهلی شیراز عن حافظ فی هذا الاستهلال فیقول ما معناه: "رأیت حافظاً فی المنام ذات لیلة فقلت له: یا فریداً فی فضلك وعلمك كیف استحللت شعر یزید بن معاویة وأبحت لنفسك استخدامه مع ما لك من فضل وكمال، لا حد لهما. قال حافظ: ألم تعرف السر بعدُ؟ ألیس مال الكافر حلالاً للمسلم".
ومع ذلك فإن أدیباً وشاعراً آخر هو الكاتبی النیشابوری لم یقبل هذا العذر ورآه واهیاً فكتب ما معناه: "إنی لأعجب كثیراً من تصرف خواجه حافظ ویعجز عقلی عن فهمه إذ ما هی الحكمة التی رآها فی شعر یزید فأوردها فی دیوانه الأول؟ حتى لو فرضنا أن مال الكافر حلال للمسلم ولم نعارض فی هذا الشأن لعددنا عیباً كبیراً فی اللیث أن یخطف اللقمة من فم الكلب".
إن هذه اللقمة من فم الكلب تحولت بكیمیاء الفن إلى حلیة ذهبیة ساحرة حین تناولها ترجمان الأسرار واستهل بها غزلیته الفاخرة الملمعة. وهذا شأن الصوفیة یأخذون كل ما یجدونه فی عالم الواقع ویقلبون معدنه الخسیس إلى معدن شریف؟ أولسنا نذكر كیف كان ینادی البقال: یا سعتر بری فقلبه الصوفی إلى اسعَ تَرَ برّی. وشاعت تلك الغزلیة بذلك الاستهلال العربی البسیط القوی الإیقاع عند جمیع من شدا شیئاً من اللغة الفارسیة والتركیة والعربیة والأوردیة وغیرها. أذكر مصادفتی لكاتب تركی حدیث فی استانبول منذ ثلاث سنین لا یعرف العربیة، فما أن رأیته حتى ابتدرنی بهذا الاستهلال وهو یعرف أنی عربی. وكذلك شاعت هذه الغزلیة فی طاجكستان وأفغانستان وغیرهما من البلدان. ولقد هزنی إیقاع هذا البیت لما سمعته فی أرض غیر عربیة وبقی یعتمل فی نفسی حتى هذه المناسبة فی إحیاء ذكرى حافظ. فدفعنی هذا الإیقاع الیوم إلى أن أجاری مؤلف الغزلیة الرائعة بروحه وأفكاره لعلی أجلو صوراً من براعته وأغراضه لا تبدو على حقیقتها فی الترجمات العربیة. وقد خرجت عن شروط الغزل الفارسی فتجاوزت عدد الأبیات التی ینبغی أن تراوح عادة بین الثمانیة والخمسة والعشرین. ولعل روح حافظ الفنیة التی ترفرف بیننا الآن ترضى عن هذه الصناعة:
"ألا یا أیها الساقی أدر كأساً وناولها"
وأغرق مشكلات العیش فی الصهبا وأبطلها
إذا ضاقت بك الدنیا بورد الكأس جَمِّلها
ودعنی أنا والحسنا مع الصهبا أغازلها
وإن ناءت بك الأوزا ر للرحمن أوكلها
فؤادك بالهوى مُضْنى وروحك بالطلا وَلْهى
ویا ربی على الفقرا ء سحب العفو أسبلها
ملأت قلوبهم عشقاً حیارى فی الهوى بُلْها
* * *
دجا الدهر ومازلنا على فلْك الهوى نسری
ونحمل رایة العشا ق من عصر إلى عصر
ومن قطب إلى قطب ومن قطر إلى قطر
دعاة الحب فی الدنیا وفی الأخرى وفی الحشر
سكارى منذ أن كنا بلا كأس ولا خمر
أتتنا نشوة الصهبا ء قبل القطف والعصر
سرى تأثیرها فی الرو ح مثل النور فی الفجر
فَجَدِّدْ نشوة سلفت ونفسك لا تحمّلها
* * *
ألا أیها الدرویش حسبك كوبك الملآن
وزهدك فی حطام العیش والرحمة والرضوان
فلا تحفل بما قالوا وما یجری ولا ما كان
فكم حلّ على شیرا زمن بَغْی ومن طغیان
وزال البغی والباغی وغاب الملك والسلطان
ولكن بقی النسری ن والنرجس والریحان
ألیست هذه دار ك برج العلم والعرفان
صلاتك حینما لیلى تجیء إلیك أجّلْها
* * *
تؤاخذنی على عاری ومجدی هو فی عاری
وما عاری حبی وصهبائی وقیثاری
وتهیامی بذات الشفة الحمراء كالنار
وما داری زوایا النسك بل حانة خمار
أنا السكران لكنّی أرجی رحمة الباری
یدارون الملوك وأنت ربات البها داری
لباسهم الریاء وأنت من ثوب الریا عاری
ذنوبك أیها العاصی بماء التوبة اغسلها
* * *
عجیب أمر هذا الشع ر طفلٌ عمرهُ لیله
یطوف العالم المعمو ر یقطع وعره سهله
ویمضی خالداً فی كل قلب ملهباً شعله
وكم من علة یأسو وكم ینقع من غلّه
كأن الله قد ألقى على تكوینه ظله
فیا وجدی إلى ثغر ال حبیب كأنه فِلَّه
ویا ظمئی إلى الصهبا ء تمسح لاعجی كلّه
فهیّا یا شقیق الرو ح نحو الحان ندخلها
* * *
خلاف الأهل أضنانی وإبلیس هو الجانی
وما شان بهاء العب ش إلا الحاسد الشانی
وما أحلى تلاقی الأه ل فی حب وإحسان
فیا للشمل ضموّه لندفع كل عدوان
ألیس المسجد الأقصى أسیر قطیع ذؤبان
ألا إن سلام الأر ض نیروزی وبستانی
فیا رحمن كن معنا وبارك صلح إخوانی
ویا رباه رحماك عقود الصلح أكملها
* * *
أدر كأساً وناولها ألا یا أیها الساقی
حمیّا الكأس والمحبو ب زادا نار أشواقی
رعاكِ الله یا شیرا ز أنت ضیاء آماقی
زكوتِ ربیع آفاق وفُزْتِ نعیم عشاق
أنا المجنون یا لیلى أنا المسقیّ والساقی
أنا كأسی وصهبائی أنا سمی وتریاقی
شرابی ما به صحوٌ جنونی ما له راقی
جذوری فی الثرى غرقى وجذعی سامق راقی
وتلك الشمس میقاتی وهذی الأرض أوراقی
وأكتب بالشعاع الحلو ألحانی وأذواقی
إذا أفنتنی الأیّا م شعری خالد باقی
* * *
تحیاتك یا یافی إلى شیراز أرسلها
هنالك بیت أسرا رك للعشاق فَصِّلْها
مزایاك التی فی القلب ویحك لا تبدلها
"متى ما تلق من تهوى دع الدنیا وأهملها"
* * *
بعض المراجع:
(1)معجم البلدان: یاقوت الحموی.
(2)رحلة ابن بطوطة: المسماة تحفة النظار فی غرائب الأمصار وعجائب الأسفار –المكتبة التجاریة مصر 1938-1357,
(3)مهذب رحلة ابن بطوطة: وقف على تهذیبه وضبط غریبه وأعلامه، أحمد العوامری بك ومحمد أحمد جاد المولى بك القاهرة 1937.
(4)الموسوعة الإسلامیة.
(5)Encyclopedia
(6)الموسوعة البریطانیة.
(7)تاریخ الأدب الفارسی: ج1 تألیف إدوارد براون وترجمة د.أحمد كمال الدین حلمی –جامعة الكویت 1984.
(8)حافظ الشیرازی: تألیف إبراهیم أمین الشواربی –مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر 1944.
(9)الأدب الفارسی فی أهم أدواره وأشهر أعلامه: د.محمد محمدی –منشورات قسم اللغة الفارسیة وآدابها 1967 فی الجامعة اللبنانیة بیروت.
(10)من روائع الأدب الفارسی: د.بدیع محمد جمعة –طبعة ثانیة- دار النهضة العربیة بیروت 1983.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:13|
الحنین إلى
الأوطان فی شعر المهجریی
إذا كان لمصر فضل السبق فی
تجدید أدبنا العربی وبعثه فی حلة قشیبة، موفور الصحة، تام العافیة، فقد
كانت أرض الكنانة منذ عصر الفاطمیین قبلة العالم العربی الثقافیة والدینیة،
ففیها وجد أدباء الشام الحریة والمناخ الملائم للإبداع والنشاط الخصب
ونذكر على سبیل المثال-لا الحصر- جرجی زیدان ویعقوب صروف ومی زیادة وغیرهم
ولمطبعة بولاق فضل لا ینكر ومزیة لا تجحد فی نشر الأدب والثقافة وتعمیم
نورهما على العالم العربی الخارج لتوه من ظلمات العصور الوسطى، المستفیق من
سبات عمیق حجب عنه نور العلم وثمرة الفكر وإشعاع الحریة، وكیف یجحد فضل
مصر وثلاثة من كبار شعرائها هم الذین أحیوا الشعر العربی؟ ونقصد البارودی
وشوقی وحافظ، وثلاثة من كبار كتابها هم الذین بینوا الطریق الصحیح للأدب
ووجهوا الناشئة إلى دروب الإبداع حسب المقاییس الفنیة؟ ونقصد العقاد وطه
حسین وإبرهیم عبد القادر المازنی. على أن مصر لم تكن فی المضمار فریدة
فالشام ردیفتها وصنوها فی التجدید والإحیاء ورسم معالم النهضة الأدبیة
الحدیثة ولعل هذا ماعناه شاعر النیل- حافظ إبرهیم- حین قال:
لمصر أم لربوع الشام تنتسـب
هنا العلا وهناك المجد والحسب
ركنان للشرق لازالت ربوعهما
قلب الهلال علیهما خافق یجب
خدران للضاد لم تهتك ستورهما
ولا تحول عن مغناهـما الأدب
أیرغبان عن الحسنى وبینهـما
فی رائعات المعالی ذلك النسب؟
فأدباء الشام- سوریة ولبنان- لهم فی التجدید الید الطولى وتحدیدا أولئك الذین قست علیهم الحیاة فی وطنهم وشظف عیشهم بعد أن جف الضرع واستعصت سبل الرزق، وتأسن الوضع السیاسی بفعل البطش العثمانی، فلم یكن أمامهم من باب یطرقونه غیر باب الهجرة، ولامن سبیل یلوذون بها غیر سبیل الفراق أملا فی عیش رغید وحریة یتعشقونها ومناخ ریاحه لواقح وتربته بلیلة تستنبت بذور الفكر والأدب. وإنها لمنة نحمدها للأقدار ورب ضارة نافعة، فقد كانت تلك الهجرة فأل خیر وبشرى بأدب حی وفكر صحیح وضمیر صاح، ولسنا فی حاجة إلى أن نذكر بقول شاعرنا أبی تمام:
وطول مقام المرء بالحی مخلق
لـدیباجتیه فـاغتـرب تتجـدد
فإنی رأیت الشمس زیدت محبة
إلى الناس أن لیست علیهم بسرمد
فهذان البیتان من محفوظاتنا المدرسیة أتینا على ذكرهما لمجرد الذكرى – والذكرى تنفع المؤمنین-. وإذا ذكر أدب المهجر تبادر إلى الذهن جماعة الرابطة القلمیة فی المهجر الشمالی- أمریكا- والعصبة الأندلسیة فی المهجر الجنوبی- البرازیل والأرجنتین-. وأهل الشام -أحفاد الفنیقیین- معرفون بارتیاد البحار واصطیاد الشمس والكمون للقمر تجری المغامرة فی عروقهم مجرى الدم أو كما قال شاعر النیل عنهم:
بأرض "كولمب" أبطال غطارفـة
أسد جیاع إذا مـاووثبوا وثبوا
رادوا المناهل فی الدنیا ولووجدوا
إلى المجرة ركبا صاعدا صعدوا
أو قیل فی الشمس للراجین منتجع
مدوا لها سببا فی الجو وانتدبوا
سعوا إلى الكسب محمودا وما فتئت
أم اللغات بذاك السعی تـكتسب
ولقد اغتنت أم اللغات بتلك الهجرة المیمونة بالشعر الصافی السلس المنبجس من الوجدان ومن الفكر الحی الصحیح الملقح بالتجارب الغربیة حیث الصناعة والعلم والدیموقراطیة والحریة ودور المرأة الحی الفاعل فی المجتمع، وهذا مانجد صداه فی أدب جبران خلیل جبران ومیخائیل نعیمة وآل المعلوف وجورج صیدح وأمین مشرق ومیشال مغربی وعبد المسیح حداد وجورج صوایا وغیرهم ممن یضیق هذا المقال عن حصرهم. إنما الذی یعنینا فی هذا المقال كیف كان الحنین إلى الوطن وإلى الأم وإلى الحبیبة وإلى الشلة وإلى ذكریات العید، ومرابع زحلة وشواهق صنین ونواعیر حماة وخریر بردى سببا فی هذا الإبداع الخالد المستل من الوجدان، المكتوب بدم الفؤاد، الممهور بشهقة الروح الفاعلة الخلاقة. إن الانسان حین یهاجر یصاب بالفصام كل حسب استعداداته النفسیة وطاقاته الروحیة فقد تكونت شخصیة المهاجر فی وطنه، وتلونت روحه بأطیاف الوطن من دین ولغة وعادات وطرائق معیشة بل ومناخ وتضاریس، فجاء فكره انعكاسا لمحیطه، ثم ترك وطنه للأسباب التی ذكرناها آنفا فإذا به فسیلة أو شجرة تزرع فی تربة غیر تربتها الأولى، إنها عادات جدیدة وطرائق حیاة مستحدثة وفلسفة فی الحیاة غیر الأولى، والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لینجح فی حیاته-المادیة على الأقل- ولكنه فی الواقع وفی غیاهب اللاوعی تكمن عادات ولغة وأسلوب معیشته الأول فی الوطن الأم هنا تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة، وتتشظى الروح فنجد أشلاءها فیما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه وإكسیر البهاء والنقاء لأدبنا الذی غفا فی كهف السجع والتوریة وشعر المناسبات، وأدب الرسائل الإخوانیة المتسمة بالریاء المتسربل بالوقار والكذب المتشح بوشاح الوفاء بالعهد إنها معاناة روحیة وجودیة وضعت صاحبها بین مطرقة الضرورة وسندان الحبیب الأول(الوطن). على حد قول شاعرنا:
كم من منزل فی الأرض یألفه الفتى
وحنینـه أبدا لأول مـنزل
ونحن فی هذا المقال راصدون أشتاتا من تلك المعاناة المتجلیة فی الحنین إلى مراتع الصبا وحضن الأم وسماء الوطن فیما أنتجة أدباء المهجرین- الشمالی والجنوبی- لنرى كیف كان التجدید فی الشكل حین ذابت الأصباغ وتلاشت المساحیق وفی المضمون حین قبر الریاء الماكر والتقلید الأعجم، والإنصراف عن الحیاة وهموم الناس، وتطلیق المسؤولیة الأخلاقیة للأدیب فی مغالبة الفساد ومصارعة الاستبداد وقهر الرجعیة وقهر نرعة الردة إلى عصر المغارة. إن حب الوطن والحنین إلیه والوفاء له هو المطهر من الإثم الذی یشعر به الأدیب إن أصاب حظا من النجاح المادی والمكانة المرموقة فی مجتمعه الجدید، إنه اللاوعی یتخلص من عقدة الذنب التی تسللت إلى نفس الأدیب لرهافة حسه ونبل ضمیره وصفاء فكره. وهاهو زكی قنصل الأدیب السوری الذی ولد بیبرود عام 1917م وهاجرإلى الأرجنتین فهو من جماعة العصبة الأندلسیة یحن إلى مراتع الصبا ومرابع اللهو فی نضارة الطفولة إقرأ هذا المقطع وتذوق جماله الفنی واستشعر شیئا من الأسى وقدر هذا الحنین من الشاعر إلى وطنه: أیها الـعائدون للشام هلا
نفحة من شمـیم أرض النبوه
علم الله كم صـبونا إلیها
واشتهینا تحت الـعریشة غفوه
وتحسس ألم الضلوع، وانظر عبرة الشوق تتحدر من المآقی، وقدر مافی هذا القلب من شوق ومن حنین: یـاعائدین إلـى الـربوع
قـلبی تحـرق للـرجوع
نهنهتـه فـازداد تـحنانا
وعـربـد فی الضـلوع
یـاعائدین إلـى الـحمى
قلـبی به عـطش وجوع
بـالله هـل فی الـمركب
متسـع لملـهوف ولـوع
وحـزمت أمـتعتی فـیا
قلب ارتقب یوم الرجـوع
وهو یحسن وصف أوجاع الغربة وألم البعاد ومكابدة السهاد واسمعه یقول:
ویح الغریب على الأشواك مضجعه
وخبزه من عجین الهم والتعب
یعیش عن ربعه بالجسم مغتربا
وقلبه وهواه غیر مغترب
یستقبل اللیل لا تغفو هواجسـه
ویوقظ الفجر فی لیل من الكرب
یعلل النفس بالرجعى ویخدعها
فهل تحقق بالرجعى أمانیه؟
أما نعمة قازان المولود فی لبنان عام 1908م والذی استقر فی البرازیل وكان من جماعة " العصبة الأندلسیة فهو كصاحبه یذكر التحنان ویقاسی وجع الغربة ویتعشق عهد الطفولة ویتمنى لو تطأ قدمه أرض وطنه لبنان: بـلادی أأستـطیـع نـكراها
إذن فاقلعوا الحب من بزرتی
ولـبـنان أمـی بـه حفنـة
سقـتك السـموات یـاحفنتی
وأهلـی ومـا أقـول بـأهلی
ومـاذا أقـول بمـحبوبـتی؟
أقـول بـقاع الـدنیا حـلوة
وأحـلى بـقاع الـدنیا بقعتی
وكـنت مـع الله فـی قریتی
فصـرت بـلا الله فی غربتی
وكـنت غـنیا مـع الـقـلة
فصرت فقیـرا مـع الكـثرة
ولولا الحبیب وعودی الرطیب
رمانی اللهیب إلـى الشـهوة
ولـولا الـرجاء بعـود الرجا
قـذفت بنفسی إلـى الـهوة
وفی شعر هذا الشاعر بعض الركاكة اللغویة والفقر الفنی كقوله<وماذا أقول بأهلی، وماذا أقول بمحبوبتی؟>. وفی شعر المهجریین وأدبهم بعض الإسفاف والكثیر من ركاكة التعبیر والخروج عن قواعد اللغة-على غیر علم وبصیرة- وهو ما أخذه عمید الأدب العربی الدكتور -طه حسین- على كبیرهم الذی علمهم السحر إیلیا أبی ماضی، ولكن یشفع لهم أنهم لم یتخرجوا من جامعة ولاترددوا على حلقات اللغة والأدب، وزد على ذلك حیاتهم خارج أوطانهم یتكلمون بغیر لغتهم وحسب المرء أن ینتج شیئا من هذا الشعر السلس الراقی ولسانه تعود على الكلام بغیر لغته الشعریة. إنما هی الموهبة والسلیقة والكد الشخصی والعصامیة والتعلق باللغة العربیة والقدرة على قرض الشعر والاسترسال فی النثر كانت العوامل الداخلیة زد علیها هم الغربة ونكدها وحال الشرق وسباته هی التی حدت بهؤلاء إلى البروز فی فن القول شعرا ونثرا. وهاهو الشاعر حسنی غراب الحمصی المولود عام 1899م یتحدث عن وطنه أجمل حدیث كأنه كلام منتزع من سویداء القلب ومن بؤبؤ العین:
أبعد حمص لنا دمع یراق على
منازل أم بنا من حادثات هلع؟
دار نـحن إلیـها كلـما ذكرت
كـأنما هـی من أكبادنا قطع
وملـعب للصبا نـأسى لـفرقته
كـأنه من سواد العین منتزع
وهذا شاعر آخر من فتوح كسروان اللبنانیة شكر الله الجر والمقیم بالبرازیل والعضو فی العصبة الأندلسیة لایخفی تحنانه ولله ما أحلى ذكره لكلمتی الشیح والعرار وهما موحیتان بخصائص الریف الشامی وبلاد العرب عامة اقرأ معی قوله:
ذكـر الأرز بعـد شط مزاره
أی جـرح یسیل من تذكاره
لیس أشهى علـى القلوب وأندى
مـن شذا شیحه ونفح عراره
واقرأ معی هذا البیت الذی یذیب القلب ویقطع الكبد تحسرا فلئن یئس الشاعر من الأوبة إلى بلده فرجاؤه الوحید أن یدفن فی أرضه: إن حـرمنا من نعمة العیش فیه
ما حرمنا من مرقد فی جواره
أما قصة هجرته ومالاقى فی سبیلها من لجاج النفس وشك الضمیر وتردد العقل فقد وصفها أبدع وصف نكتفی منها بهذا المقطع:
ركـبنا من الیم طودایقل الـ
عـباد فـكل إلـى رغبـته
فـیاله مـن مشـهد للـوداع
یـذیب الـحدید على قسوته
فـأم تـضم إلـى قـلـبـها
وحـیدا یـسیر لأمـنیتـه
وأخ یكـفكف دمـع أخـتـه
وزوج یـرفه عن زوجتـه
فیالیت شعری أیحظى المهاجر
فیما یـرجیه مـن هـجرته
ویالیت شـعری أیلقىالمسافر
یـوما سبیـلا إلـى أوبته؟
أم أن اللـیالـی تـزری بـه
فتذرو الفتى الحر فی تربته؟
فـلا أم تبـكی علـى قـبره
ولا أخت تسقی ثرى حفرته؟
وأما نعمة الحاج من غرزوز بلبنان والمقیم بالولایات المتحدة فیزید على أصحابه السابقین فی ذكر الحنین والوفاء للأهل والوطن هم الصحوة والبعث والتجدید فی الحیاة العربیة أدبا وفكرا وأسلوب معاش:
مـا نـسـینا ویشـهد الله أنـا
نـحن بـالروح حیث كـنا
إن بـعدنـا وإن قـربنا فلبنـا
ن سنـاه یشع فینـا ومـنا
نـحن فی الأرض أنجم ونسور
حلت الـعالیات برجاووكنا
هـذه الـنهضة الـحدیثة منكم
قربت منذ نحن بالأمس بنا
قـد نـفحنا ببوقـها وأثـرنـا
نارها والعیون إذ ذاك وسنى
أیـقظتكم مـن الـكرى فهبتم
وأجـدتم تجدیدها فهی أسنى
وازدهـى العمران والعلم والفن
تـراه الـعیون أكمل حسنا
أما شفیق المعلوف شقیق فوزی المعلوف الزحلاوی والمولود عام 1905م والمستقر فی البرازیل ففی قصیدته "بین شاطئین" استهلال لموضوع الحنین بالحدیث عن الوداع والعبرات وخفق الفؤاد:
ذراع مـلاق إثر كـف مودع
تلوحان لی كلتاهما خلف مدمعی
منادیل من ودعت یخفقن فوقهم
فـلا ترهقیهم یـاسفین واقلـعی
بـعدن فـغشاهن مـعی كأننی
أراهن من خلف الزجاج المصدع
ویزید فی هذه القصیدة وصفه لانبهاره بالعمران فی أمریكا وبحضارتها:
خـلیلی بدت جبارة المدن تزدهی
بأعظم ماازدانت به الأرض فاخشع
أدارت علـى الآفاق مشعل عزها
ومدت إلـى الشمس كـف یـوشع
وأعلت بروجا فی الغمام رؤوسها
فما تظفر الحدثـان منـها بـمطمع
مـدینة جن جـود الإنـس نحتها
بـإزمیـل جـبار وحكـمة مـبدع
ثم اسمعه یقول صادقا عن التحنان والوفاء:
أطـل علیكم والمنى تزحم المنى
بصدری وأنتم ملء قلبی ومسمعـی
لـئن تسألوا مافی الجنوب فإننی
حـملت إلـیكم قـلبه خافقا مـعی
ویختم ذلك كله بالمهمة الموكلة إلى أصحابه فی بعث الأدب العربی وإحیاء لغته:
وإن لـواء نـحن قـمـنا نـهزه
خـفوقا على حصن البیان الممنع
لـواء ظـفرتم أنـتم بـاكتسابه ونـحن ركزنـاه بـأرفع موضع
ولا شك أنه یعنی بقوله "ظفرتم أنتم" أدباء مصر وهو ما أشرنا إلیه فی بدایة المقال.
وأما مسعود سماحة المولود فی لبنان عام 1882م والمستقر فی أمریكا فإن حنینه لوطنه ووفاءه له أنطقه بهذین البیتین وهما دعوة إلى الثورة ومقاومة الاستبداد اسمعه یخاطب أهل لبنان:
مشت القرون وكل شعب قد مشى
مـعها وقومك واقفون ونـوم
لـم تـرتفع كف لـصفعة غاشم
فـیهم ولـم یـنطق بتهدید فم
وأما رشید أیوب المعروف بالدرویش والمولود فی نفس قریة میخائیل نعیمة "بسكنتا" بلبنان عام 1872م والذی استقر فی الولایات المتحدة ففی قصیدته المسافر یذكر المخاطرة والهجرة والآمال: دعتـه الأمـانی فخلى الربوع
وصار وفـی الـنفس شیـئ كثیـر
وفی الصدر بین حنایا الضلوع
لـنیـل الأمـانـی فـؤاد كـبیـر
فـحث المطایا وخاض البحار
ومـرت لـیـال وكـرت سـنون
ولم یرجع
ویعد الشاعر القروی رشید سلیم الخوری المولود ببربارة بلبنان عام 1887م والذی عاش فی البرازیل أمتن شعراء الجنوب لغة وأقدرهم على التصرف فی القریض وأجودهم فی تخیر اللفظ الموحی بمرارة الغربة ووحشة الأمل وأمل العودة واقرأ معی هذا المقطع من قصیدة عند الرحیل: نـصحتك یـانفس لا تـطمعی
وقلت حذار فلم تسمعـی
فـإن كـنت تستسهلین الـوداع
كمـا تدعین إذا ودعـی!
خـرجت أجرك جـر الكسیـح
تئنین فی صدری الموجع
ولـما غدونـا بنصف الطریق
رجعت ولیتك لم ترجعی
كفاك اضـطرابا كصدر المحیط
قفی حیث أنت ولاتجزعی
سأقضی بنفسی حقـوق العـلى
وأرجع فانتظری مرجعی
وما أجمله من إیحاء حین یذكر تركه لروحه فی وطنه الأم وحمل جثته إلى المهجر. ویأتی بعد القروی فی متانة اللغة وجودة السبك والتصرف فی القول إلیاس فرحات من كفرشیما فی لبنان والمولود عام 1893م والذی أقام فی البرازیل ولعل هذا المقطع هو من أشهر أشعاره تغنى بها المشرق والمغرب عن وحدة العرب:
إنـا وإن تـكن الشآم دیـارنا
فقـلوبـنا للـعرب بـالإجمال
نهوى العراق ورافدیه وماعلى
أرض الجزیرة من حصا ورمال
وإذا ذكرت لنا الكـنانة خلتنا
نـروى بسـائغ نیلـها السلسال
بـنا ومـازلنا نشاطر أهـلها
مـر الأسـى وحـلاوة الآمال
أما جورج صیدح الدمشقی والذی أقام فی الأرجنتین فلله ما أحلى حدیثه عن حنینه إلى دمشق ووفائه لها وألم البعاد عنها:
أنـا ولیدك یـا أماه كـم مـلكت
ذكراك نفسی وكم ناجاك وجدان
منذ افترقنا نعیم الـعیش فـارقنی
والـهم والـغم أشكـال وألوان
عهد الشباب وعهد الشام إن مضیا
فكل ما أعطت الأیـام حرمـان
وفی قصیدته "المهاجر" وصف للمعاناة النفسیة وتباریح الجوى:
كـیف یرتـاح وتذكار الحمى
كـلما أقعده الـجهد أقامه؟
بـرجه الـعاجی مـن یقطنه
إنـه یقطن بالروح خیامـه
ویبـعث الـمال سلاما للحمى
فالحمى بلا مال یأبى السلامه
قـل لـمن یحمیه فـی غربته
إن مـن أعدائه اللد غـرامه
أما مایلاقیه الفذ من ازدراء فی وطنه وتقدیر فی غیره فقد عبر عنه أجمل تعبیر:
رب أحجار بها الشرق ازدرى
أصبحت فی حائط الغرب دعامه
أما الشاعر المصری الكبیر أحمد زكی أبو شادی (1892-1955م) والذی استقر فی أمریكا وكان من مؤسسی جماعة أبولو التی جددت فی الأدب خاصة الشعر منه وعرفت هذه المدرسة برومنطیقیتها فقد خاطب أمریكا –وطن الحریة-قائلا:
لـجأت إلـیك یـاوطنا تغنى
بـه الأحـرار واعتز الـنشید
فـإنك منبری الحـر المرجى
وبدء نهاری بل عـمر جـدید
وقد كان نزوح أحمد زكی أبی شادی إلى أمریكا هروبا من استشراء الفساد وتعفن الوضع السیاسی وانعدام الحریة ولكنه فی غربته فی العالم الجدید یحن إلى وطنه فاسمعه یقول:
بكى الربیع طروب فی مباهجـه
وقد بكیت أنا حبـی وأوطانـی
أنا الغریب وروحی شاركت بدنی
هذا العذاب بأشواقی وأحزانـی
لی فی ثرى مصر دمع نائح ودم
أذیب من مهجتی اللهفى ونیرانی
تركته مثل غرس الحب ما ذبلت
أزهاره أو أغـاثت روح لهفان
أشمها فی اغترابی حین تلذعنی
ذكرى الشباب وذكرى عمری الفانی
واسمع معی میشال مغربی المغترب فی ساوباولو یتأسف على عمره الضائع هدرا فی بلاد الغربة وینصح شباب العرب بالبقاء فی أوطانهم:
وأناالذی باع الشبیبـة خاسرا
بجلاده وجهاده المتوالـی
أثر النضال على الجبین ترونه
ما الاغتراب سوى حیاة نضال
شطر المهاجر لاتولوا أوجها
كالخاسرین ربوعهم أمثالـی
أوطانكم أولى بكم و بسعیكم
وبما ملكتم من كریم خصال
ولأنتمو أولى بطیب هوائها
وجمالها المزری بكل جمال
ویأتی إیلیا أبو ماضی المولود بقریة "المحیدثة" بلبنان عام 1889م والذی استقر بأمریكا وكان من الأعضاء المؤسسین للرابطة القلمیة فی طلیعة الشعراء الذین تغنوا بالأوطان ووصفوا الحنین إلیها ولوعة البعد عن الخلان، واستذكروا عهد الصبا واقرأ معی هذا المقطع یخاطب لبنان ویناجیه:
وطـن النجوم أنا هنـا
حـدق أتذكر من أنا ؟
أنـا ذلك الـولد الـذی
دنیـاه كـانت هـاهنا
أنا مـن مـیاهك قطرة
فاضت جداول من سنا
كم عانقت روحی رباك
وصـفقت فی المنحنى
وما أجمل قوله لوطنه لبنان یعتذر له فیه عن البعد عنه ویتعلل لذلك بركوب الأخطار والطموح إلى المعالی والنزوع إلى الأمجاد:
لبنان لا تعدل بنیك إذا هم
ركبوا إلى العلیاء كل سفین
لم یهجروك ملالة لكنهم
خلقوا لصید اللؤلؤ المكنون
لما ولدتهم نسورا حلقوا
لا یقنعون من العلا بالدون
إذا فقد كانت الغربة وتباریحها مهمازا للقریحة وجناحا للتحلیق فی سماء الخلق الفنی وقد استفاد أدبنا العربی من هذه الغربة فتجدد وجهه وازدان بهاء ورونقا، وأصبح الشعر على ید هذا اللفیف من الشعراء تعبیرا عن الوجدان، ووصفا لخلجات النفس وخفقات الفؤاد، بلغة صافیة رقراقة متخلصة من أصباغ التكلف وطلاء التصنع، متعالیة عن الحذلقة البیانیة والبهلوانیة الانشائیة، وفی هذا الأدب كثیر من السقطات وسفاسف القول ولكنها لا تلغی أهمیة هذا الأدب بل تجعل أدباءه فی الطلیعة، مع أدباء المشرق الذین تعاونوا یدا بید ویراعا بیراع وتزاوجت خفقات قلب بقلب، وخلجات نفس بنفس، وطموح روح بروح على إخراج أدبنا من سبات الكهوف ونفض غبار القرون الوسطى عن حروفه حتى یصیر كآداب الدنیا، أدب الحیاة بما فیها من صخب ونشاط وهم وترح وفرح وماشئت من أطیاف الحیاة.
لمصر أم لربوع الشام تنتسـب
هنا العلا وهناك المجد والحسب
ركنان للشرق لازالت ربوعهما
قلب الهلال علیهما خافق یجب
خدران للضاد لم تهتك ستورهما
ولا تحول عن مغناهـما الأدب
أیرغبان عن الحسنى وبینهـما
فی رائعات المعالی ذلك النسب؟
فأدباء الشام- سوریة ولبنان- لهم فی التجدید الید الطولى وتحدیدا أولئك الذین قست علیهم الحیاة فی وطنهم وشظف عیشهم بعد أن جف الضرع واستعصت سبل الرزق، وتأسن الوضع السیاسی بفعل البطش العثمانی، فلم یكن أمامهم من باب یطرقونه غیر باب الهجرة، ولامن سبیل یلوذون بها غیر سبیل الفراق أملا فی عیش رغید وحریة یتعشقونها ومناخ ریاحه لواقح وتربته بلیلة تستنبت بذور الفكر والأدب. وإنها لمنة نحمدها للأقدار ورب ضارة نافعة، فقد كانت تلك الهجرة فأل خیر وبشرى بأدب حی وفكر صحیح وضمیر صاح، ولسنا فی حاجة إلى أن نذكر بقول شاعرنا أبی تمام:
وطول مقام المرء بالحی مخلق
لـدیباجتیه فـاغتـرب تتجـدد
فإنی رأیت الشمس زیدت محبة
إلى الناس أن لیست علیهم بسرمد
فهذان البیتان من محفوظاتنا المدرسیة أتینا على ذكرهما لمجرد الذكرى – والذكرى تنفع المؤمنین-. وإذا ذكر أدب المهجر تبادر إلى الذهن جماعة الرابطة القلمیة فی المهجر الشمالی- أمریكا- والعصبة الأندلسیة فی المهجر الجنوبی- البرازیل والأرجنتین-. وأهل الشام -أحفاد الفنیقیین- معرفون بارتیاد البحار واصطیاد الشمس والكمون للقمر تجری المغامرة فی عروقهم مجرى الدم أو كما قال شاعر النیل عنهم:
بأرض "كولمب" أبطال غطارفـة
أسد جیاع إذا مـاووثبوا وثبوا
رادوا المناهل فی الدنیا ولووجدوا
إلى المجرة ركبا صاعدا صعدوا
أو قیل فی الشمس للراجین منتجع
مدوا لها سببا فی الجو وانتدبوا
سعوا إلى الكسب محمودا وما فتئت
أم اللغات بذاك السعی تـكتسب
ولقد اغتنت أم اللغات بتلك الهجرة المیمونة بالشعر الصافی السلس المنبجس من الوجدان ومن الفكر الحی الصحیح الملقح بالتجارب الغربیة حیث الصناعة والعلم والدیموقراطیة والحریة ودور المرأة الحی الفاعل فی المجتمع، وهذا مانجد صداه فی أدب جبران خلیل جبران ومیخائیل نعیمة وآل المعلوف وجورج صیدح وأمین مشرق ومیشال مغربی وعبد المسیح حداد وجورج صوایا وغیرهم ممن یضیق هذا المقال عن حصرهم. إنما الذی یعنینا فی هذا المقال كیف كان الحنین إلى الوطن وإلى الأم وإلى الحبیبة وإلى الشلة وإلى ذكریات العید، ومرابع زحلة وشواهق صنین ونواعیر حماة وخریر بردى سببا فی هذا الإبداع الخالد المستل من الوجدان، المكتوب بدم الفؤاد، الممهور بشهقة الروح الفاعلة الخلاقة. إن الانسان حین یهاجر یصاب بالفصام كل حسب استعداداته النفسیة وطاقاته الروحیة فقد تكونت شخصیة المهاجر فی وطنه، وتلونت روحه بأطیاف الوطن من دین ولغة وعادات وطرائق معیشة بل ومناخ وتضاریس، فجاء فكره انعكاسا لمحیطه، ثم ترك وطنه للأسباب التی ذكرناها آنفا فإذا به فسیلة أو شجرة تزرع فی تربة غیر تربتها الأولى، إنها عادات جدیدة وطرائق حیاة مستحدثة وفلسفة فی الحیاة غیر الأولى، والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لینجح فی حیاته-المادیة على الأقل- ولكنه فی الواقع وفی غیاهب اللاوعی تكمن عادات ولغة وأسلوب معیشته الأول فی الوطن الأم هنا تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة، وتتشظى الروح فنجد أشلاءها فیما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه وإكسیر البهاء والنقاء لأدبنا الذی غفا فی كهف السجع والتوریة وشعر المناسبات، وأدب الرسائل الإخوانیة المتسمة بالریاء المتسربل بالوقار والكذب المتشح بوشاح الوفاء بالعهد إنها معاناة روحیة وجودیة وضعت صاحبها بین مطرقة الضرورة وسندان الحبیب الأول(الوطن). على حد قول شاعرنا:
كم من منزل فی الأرض یألفه الفتى
وحنینـه أبدا لأول مـنزل
ونحن فی هذا المقال راصدون أشتاتا من تلك المعاناة المتجلیة فی الحنین إلى مراتع الصبا وحضن الأم وسماء الوطن فیما أنتجة أدباء المهجرین- الشمالی والجنوبی- لنرى كیف كان التجدید فی الشكل حین ذابت الأصباغ وتلاشت المساحیق وفی المضمون حین قبر الریاء الماكر والتقلید الأعجم، والإنصراف عن الحیاة وهموم الناس، وتطلیق المسؤولیة الأخلاقیة للأدیب فی مغالبة الفساد ومصارعة الاستبداد وقهر الرجعیة وقهر نرعة الردة إلى عصر المغارة. إن حب الوطن والحنین إلیه والوفاء له هو المطهر من الإثم الذی یشعر به الأدیب إن أصاب حظا من النجاح المادی والمكانة المرموقة فی مجتمعه الجدید، إنه اللاوعی یتخلص من عقدة الذنب التی تسللت إلى نفس الأدیب لرهافة حسه ونبل ضمیره وصفاء فكره. وهاهو زكی قنصل الأدیب السوری الذی ولد بیبرود عام 1917م وهاجرإلى الأرجنتین فهو من جماعة العصبة الأندلسیة یحن إلى مراتع الصبا ومرابع اللهو فی نضارة الطفولة إقرأ هذا المقطع وتذوق جماله الفنی واستشعر شیئا من الأسى وقدر هذا الحنین من الشاعر إلى وطنه: أیها الـعائدون للشام هلا
نفحة من شمـیم أرض النبوه
علم الله كم صـبونا إلیها
واشتهینا تحت الـعریشة غفوه
وتحسس ألم الضلوع، وانظر عبرة الشوق تتحدر من المآقی، وقدر مافی هذا القلب من شوق ومن حنین: یـاعائدین إلـى الـربوع
قـلبی تحـرق للـرجوع
نهنهتـه فـازداد تـحنانا
وعـربـد فی الضـلوع
یـاعائدین إلـى الـحمى
قلـبی به عـطش وجوع
بـالله هـل فی الـمركب
متسـع لملـهوف ولـوع
وحـزمت أمـتعتی فـیا
قلب ارتقب یوم الرجـوع
وهو یحسن وصف أوجاع الغربة وألم البعاد ومكابدة السهاد واسمعه یقول:
ویح الغریب على الأشواك مضجعه
وخبزه من عجین الهم والتعب
یعیش عن ربعه بالجسم مغتربا
وقلبه وهواه غیر مغترب
یستقبل اللیل لا تغفو هواجسـه
ویوقظ الفجر فی لیل من الكرب
یعلل النفس بالرجعى ویخدعها
فهل تحقق بالرجعى أمانیه؟
أما نعمة قازان المولود فی لبنان عام 1908م والذی استقر فی البرازیل وكان من جماعة " العصبة الأندلسیة فهو كصاحبه یذكر التحنان ویقاسی وجع الغربة ویتعشق عهد الطفولة ویتمنى لو تطأ قدمه أرض وطنه لبنان: بـلادی أأستـطیـع نـكراها
إذن فاقلعوا الحب من بزرتی
ولـبـنان أمـی بـه حفنـة
سقـتك السـموات یـاحفنتی
وأهلـی ومـا أقـول بـأهلی
ومـاذا أقـول بمـحبوبـتی؟
أقـول بـقاع الـدنیا حـلوة
وأحـلى بـقاع الـدنیا بقعتی
وكـنت مـع الله فـی قریتی
فصـرت بـلا الله فی غربتی
وكـنت غـنیا مـع الـقـلة
فصرت فقیـرا مـع الكـثرة
ولولا الحبیب وعودی الرطیب
رمانی اللهیب إلـى الشـهوة
ولـولا الـرجاء بعـود الرجا
قـذفت بنفسی إلـى الـهوة
وفی شعر هذا الشاعر بعض الركاكة اللغویة والفقر الفنی كقوله<وماذا أقول بأهلی، وماذا أقول بمحبوبتی؟>. وفی شعر المهجریین وأدبهم بعض الإسفاف والكثیر من ركاكة التعبیر والخروج عن قواعد اللغة-على غیر علم وبصیرة- وهو ما أخذه عمید الأدب العربی الدكتور -طه حسین- على كبیرهم الذی علمهم السحر إیلیا أبی ماضی، ولكن یشفع لهم أنهم لم یتخرجوا من جامعة ولاترددوا على حلقات اللغة والأدب، وزد على ذلك حیاتهم خارج أوطانهم یتكلمون بغیر لغتهم وحسب المرء أن ینتج شیئا من هذا الشعر السلس الراقی ولسانه تعود على الكلام بغیر لغته الشعریة. إنما هی الموهبة والسلیقة والكد الشخصی والعصامیة والتعلق باللغة العربیة والقدرة على قرض الشعر والاسترسال فی النثر كانت العوامل الداخلیة زد علیها هم الغربة ونكدها وحال الشرق وسباته هی التی حدت بهؤلاء إلى البروز فی فن القول شعرا ونثرا. وهاهو الشاعر حسنی غراب الحمصی المولود عام 1899م یتحدث عن وطنه أجمل حدیث كأنه كلام منتزع من سویداء القلب ومن بؤبؤ العین:
أبعد حمص لنا دمع یراق على
منازل أم بنا من حادثات هلع؟
دار نـحن إلیـها كلـما ذكرت
كـأنما هـی من أكبادنا قطع
وملـعب للصبا نـأسى لـفرقته
كـأنه من سواد العین منتزع
وهذا شاعر آخر من فتوح كسروان اللبنانیة شكر الله الجر والمقیم بالبرازیل والعضو فی العصبة الأندلسیة لایخفی تحنانه ولله ما أحلى ذكره لكلمتی الشیح والعرار وهما موحیتان بخصائص الریف الشامی وبلاد العرب عامة اقرأ معی قوله:
ذكـر الأرز بعـد شط مزاره
أی جـرح یسیل من تذكاره
لیس أشهى علـى القلوب وأندى
مـن شذا شیحه ونفح عراره
واقرأ معی هذا البیت الذی یذیب القلب ویقطع الكبد تحسرا فلئن یئس الشاعر من الأوبة إلى بلده فرجاؤه الوحید أن یدفن فی أرضه: إن حـرمنا من نعمة العیش فیه
ما حرمنا من مرقد فی جواره
أما قصة هجرته ومالاقى فی سبیلها من لجاج النفس وشك الضمیر وتردد العقل فقد وصفها أبدع وصف نكتفی منها بهذا المقطع:
ركـبنا من الیم طودایقل الـ
عـباد فـكل إلـى رغبـته
فـیاله مـن مشـهد للـوداع
یـذیب الـحدید على قسوته
فـأم تـضم إلـى قـلـبـها
وحـیدا یـسیر لأمـنیتـه
وأخ یكـفكف دمـع أخـتـه
وزوج یـرفه عن زوجتـه
فیالیت شعری أیحظى المهاجر
فیما یـرجیه مـن هـجرته
ویالیت شـعری أیلقىالمسافر
یـوما سبیـلا إلـى أوبته؟
أم أن اللـیالـی تـزری بـه
فتذرو الفتى الحر فی تربته؟
فـلا أم تبـكی علـى قـبره
ولا أخت تسقی ثرى حفرته؟
وأما نعمة الحاج من غرزوز بلبنان والمقیم بالولایات المتحدة فیزید على أصحابه السابقین فی ذكر الحنین والوفاء للأهل والوطن هم الصحوة والبعث والتجدید فی الحیاة العربیة أدبا وفكرا وأسلوب معاش:
مـا نـسـینا ویشـهد الله أنـا
نـحن بـالروح حیث كـنا
إن بـعدنـا وإن قـربنا فلبنـا
ن سنـاه یشع فینـا ومـنا
نـحن فی الأرض أنجم ونسور
حلت الـعالیات برجاووكنا
هـذه الـنهضة الـحدیثة منكم
قربت منذ نحن بالأمس بنا
قـد نـفحنا ببوقـها وأثـرنـا
نارها والعیون إذ ذاك وسنى
أیـقظتكم مـن الـكرى فهبتم
وأجـدتم تجدیدها فهی أسنى
وازدهـى العمران والعلم والفن
تـراه الـعیون أكمل حسنا
أما شفیق المعلوف شقیق فوزی المعلوف الزحلاوی والمولود عام 1905م والمستقر فی البرازیل ففی قصیدته "بین شاطئین" استهلال لموضوع الحنین بالحدیث عن الوداع والعبرات وخفق الفؤاد:
ذراع مـلاق إثر كـف مودع
تلوحان لی كلتاهما خلف مدمعی
منادیل من ودعت یخفقن فوقهم
فـلا ترهقیهم یـاسفین واقلـعی
بـعدن فـغشاهن مـعی كأننی
أراهن من خلف الزجاج المصدع
ویزید فی هذه القصیدة وصفه لانبهاره بالعمران فی أمریكا وبحضارتها:
خـلیلی بدت جبارة المدن تزدهی
بأعظم ماازدانت به الأرض فاخشع
أدارت علـى الآفاق مشعل عزها
ومدت إلـى الشمس كـف یـوشع
وأعلت بروجا فی الغمام رؤوسها
فما تظفر الحدثـان منـها بـمطمع
مـدینة جن جـود الإنـس نحتها
بـإزمیـل جـبار وحكـمة مـبدع
ثم اسمعه یقول صادقا عن التحنان والوفاء:
أطـل علیكم والمنى تزحم المنى
بصدری وأنتم ملء قلبی ومسمعـی
لـئن تسألوا مافی الجنوب فإننی
حـملت إلـیكم قـلبه خافقا مـعی
ویختم ذلك كله بالمهمة الموكلة إلى أصحابه فی بعث الأدب العربی وإحیاء لغته:
وإن لـواء نـحن قـمـنا نـهزه
خـفوقا على حصن البیان الممنع
لـواء ظـفرتم أنـتم بـاكتسابه ونـحن ركزنـاه بـأرفع موضع
ولا شك أنه یعنی بقوله "ظفرتم أنتم" أدباء مصر وهو ما أشرنا إلیه فی بدایة المقال.
وأما مسعود سماحة المولود فی لبنان عام 1882م والمستقر فی أمریكا فإن حنینه لوطنه ووفاءه له أنطقه بهذین البیتین وهما دعوة إلى الثورة ومقاومة الاستبداد اسمعه یخاطب أهل لبنان:
مشت القرون وكل شعب قد مشى
مـعها وقومك واقفون ونـوم
لـم تـرتفع كف لـصفعة غاشم
فـیهم ولـم یـنطق بتهدید فم
وأما رشید أیوب المعروف بالدرویش والمولود فی نفس قریة میخائیل نعیمة "بسكنتا" بلبنان عام 1872م والذی استقر فی الولایات المتحدة ففی قصیدته المسافر یذكر المخاطرة والهجرة والآمال: دعتـه الأمـانی فخلى الربوع
وصار وفـی الـنفس شیـئ كثیـر
وفی الصدر بین حنایا الضلوع
لـنیـل الأمـانـی فـؤاد كـبیـر
فـحث المطایا وخاض البحار
ومـرت لـیـال وكـرت سـنون
ولم یرجع
ویعد الشاعر القروی رشید سلیم الخوری المولود ببربارة بلبنان عام 1887م والذی عاش فی البرازیل أمتن شعراء الجنوب لغة وأقدرهم على التصرف فی القریض وأجودهم فی تخیر اللفظ الموحی بمرارة الغربة ووحشة الأمل وأمل العودة واقرأ معی هذا المقطع من قصیدة عند الرحیل: نـصحتك یـانفس لا تـطمعی
وقلت حذار فلم تسمعـی
فـإن كـنت تستسهلین الـوداع
كمـا تدعین إذا ودعـی!
خـرجت أجرك جـر الكسیـح
تئنین فی صدری الموجع
ولـما غدونـا بنصف الطریق
رجعت ولیتك لم ترجعی
كفاك اضـطرابا كصدر المحیط
قفی حیث أنت ولاتجزعی
سأقضی بنفسی حقـوق العـلى
وأرجع فانتظری مرجعی
وما أجمله من إیحاء حین یذكر تركه لروحه فی وطنه الأم وحمل جثته إلى المهجر. ویأتی بعد القروی فی متانة اللغة وجودة السبك والتصرف فی القول إلیاس فرحات من كفرشیما فی لبنان والمولود عام 1893م والذی أقام فی البرازیل ولعل هذا المقطع هو من أشهر أشعاره تغنى بها المشرق والمغرب عن وحدة العرب:
إنـا وإن تـكن الشآم دیـارنا
فقـلوبـنا للـعرب بـالإجمال
نهوى العراق ورافدیه وماعلى
أرض الجزیرة من حصا ورمال
وإذا ذكرت لنا الكـنانة خلتنا
نـروى بسـائغ نیلـها السلسال
بـنا ومـازلنا نشاطر أهـلها
مـر الأسـى وحـلاوة الآمال
أما جورج صیدح الدمشقی والذی أقام فی الأرجنتین فلله ما أحلى حدیثه عن حنینه إلى دمشق ووفائه لها وألم البعاد عنها:
أنـا ولیدك یـا أماه كـم مـلكت
ذكراك نفسی وكم ناجاك وجدان
منذ افترقنا نعیم الـعیش فـارقنی
والـهم والـغم أشكـال وألوان
عهد الشباب وعهد الشام إن مضیا
فكل ما أعطت الأیـام حرمـان
وفی قصیدته "المهاجر" وصف للمعاناة النفسیة وتباریح الجوى:
كـیف یرتـاح وتذكار الحمى
كـلما أقعده الـجهد أقامه؟
بـرجه الـعاجی مـن یقطنه
إنـه یقطن بالروح خیامـه
ویبـعث الـمال سلاما للحمى
فالحمى بلا مال یأبى السلامه
قـل لـمن یحمیه فـی غربته
إن مـن أعدائه اللد غـرامه
أما مایلاقیه الفذ من ازدراء فی وطنه وتقدیر فی غیره فقد عبر عنه أجمل تعبیر:
رب أحجار بها الشرق ازدرى
أصبحت فی حائط الغرب دعامه
أما الشاعر المصری الكبیر أحمد زكی أبو شادی (1892-1955م) والذی استقر فی أمریكا وكان من مؤسسی جماعة أبولو التی جددت فی الأدب خاصة الشعر منه وعرفت هذه المدرسة برومنطیقیتها فقد خاطب أمریكا –وطن الحریة-قائلا:
لـجأت إلـیك یـاوطنا تغنى
بـه الأحـرار واعتز الـنشید
فـإنك منبری الحـر المرجى
وبدء نهاری بل عـمر جـدید
وقد كان نزوح أحمد زكی أبی شادی إلى أمریكا هروبا من استشراء الفساد وتعفن الوضع السیاسی وانعدام الحریة ولكنه فی غربته فی العالم الجدید یحن إلى وطنه فاسمعه یقول:
بكى الربیع طروب فی مباهجـه
وقد بكیت أنا حبـی وأوطانـی
أنا الغریب وروحی شاركت بدنی
هذا العذاب بأشواقی وأحزانـی
لی فی ثرى مصر دمع نائح ودم
أذیب من مهجتی اللهفى ونیرانی
تركته مثل غرس الحب ما ذبلت
أزهاره أو أغـاثت روح لهفان
أشمها فی اغترابی حین تلذعنی
ذكرى الشباب وذكرى عمری الفانی
واسمع معی میشال مغربی المغترب فی ساوباولو یتأسف على عمره الضائع هدرا فی بلاد الغربة وینصح شباب العرب بالبقاء فی أوطانهم:
وأناالذی باع الشبیبـة خاسرا
بجلاده وجهاده المتوالـی
أثر النضال على الجبین ترونه
ما الاغتراب سوى حیاة نضال
شطر المهاجر لاتولوا أوجها
كالخاسرین ربوعهم أمثالـی
أوطانكم أولى بكم و بسعیكم
وبما ملكتم من كریم خصال
ولأنتمو أولى بطیب هوائها
وجمالها المزری بكل جمال
ویأتی إیلیا أبو ماضی المولود بقریة "المحیدثة" بلبنان عام 1889م والذی استقر بأمریكا وكان من الأعضاء المؤسسین للرابطة القلمیة فی طلیعة الشعراء الذین تغنوا بالأوطان ووصفوا الحنین إلیها ولوعة البعد عن الخلان، واستذكروا عهد الصبا واقرأ معی هذا المقطع یخاطب لبنان ویناجیه:
وطـن النجوم أنا هنـا
حـدق أتذكر من أنا ؟
أنـا ذلك الـولد الـذی
دنیـاه كـانت هـاهنا
أنا مـن مـیاهك قطرة
فاضت جداول من سنا
كم عانقت روحی رباك
وصـفقت فی المنحنى
وما أجمل قوله لوطنه لبنان یعتذر له فیه عن البعد عنه ویتعلل لذلك بركوب الأخطار والطموح إلى المعالی والنزوع إلى الأمجاد:
لبنان لا تعدل بنیك إذا هم
ركبوا إلى العلیاء كل سفین
لم یهجروك ملالة لكنهم
خلقوا لصید اللؤلؤ المكنون
لما ولدتهم نسورا حلقوا
لا یقنعون من العلا بالدون
إذا فقد كانت الغربة وتباریحها مهمازا للقریحة وجناحا للتحلیق فی سماء الخلق الفنی وقد استفاد أدبنا العربی من هذه الغربة فتجدد وجهه وازدان بهاء ورونقا، وأصبح الشعر على ید هذا اللفیف من الشعراء تعبیرا عن الوجدان، ووصفا لخلجات النفس وخفقات الفؤاد، بلغة صافیة رقراقة متخلصة من أصباغ التكلف وطلاء التصنع، متعالیة عن الحذلقة البیانیة والبهلوانیة الانشائیة، وفی هذا الأدب كثیر من السقطات وسفاسف القول ولكنها لا تلغی أهمیة هذا الأدب بل تجعل أدباءه فی الطلیعة، مع أدباء المشرق الذین تعاونوا یدا بید ویراعا بیراع وتزاوجت خفقات قلب بقلب، وخلجات نفس بنفس، وطموح روح بروح على إخراج أدبنا من سبات الكهوف ونفض غبار القرون الوسطى عن حروفه حتى یصیر كآداب الدنیا، أدب الحیاة بما فیها من صخب ونشاط وهم وترح وفرح وماشئت من أطیاف الحیاة.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:12|
الیوتوبیا أو الفردوس الإنسانی فی الشعر العربی المعاصر
توطئة:تفنن الخیال البشری فی تمثّل شكل الفردوس الموعود وتقریبه إلى المخیلة الإنسانیة التی تمیل إلى الحسی والمباشر، ولم یكن الفردوس الموعود حكرا على الأنبیاء ، والقصاص، والكهنة بل صار موضوعا دسما فی نقاشات الفلاسفة وكتاباتهم وأضفوا علیها بصمة خاصة حین خلعوا عنه متعلقاته اللاهوتیة، وجعلوه مشروعا إنسانیا قابلا للتحقق على أرض الواقع، أطلقوا علیه مصطلح المدینة الفاضلة تارة والیوتوبیا تارة أخرى، وهذا ما خلق إشكالا نقدیا وقسم النقاد إلى فئتین؛ فئة توحّد بین الیوتوبیا وعدن، وفئة تجعلها تصورین مختلفین، وقبل أن أعرض حجج الطرفین سأعرّف من البدایة بمصطلح الیوتوبیا، وألقی نظرة على نتائج هذا المفهوم.
كلمة یوتوبیا "Utopie" هی كلمة لاتینیة "تحیل على مجتمع سیاسی ذی نظام مثالی، أو على أرض أو وطن خیالی، ویكون هذا التصور مثالیا ونهائیا، وأقدم النصوص الیوتوبیة هی جمهوریة أفلاطون، وكلمة یوتوبیا هی عنوان عمل لاتینی كتبه توماس مورT.More فی القرن السادس عشر، حیث یصل رحالة إلى أرض مثالیة، وفی هذا السیاق أیضا یمكن أن نذكر أطلنطس الجدیدة لفرانسیس بیكون، و"الآن من اللامكان""Now from Nowhere" لویلیام موریس William Morris، والأفق المفقود Lost Horizon لجیمس هیلتونJ.Hilton"(1)تعبّر الیوتوبیا عن حماس الإنسان كی یصنع جنته بیده دون أیة وصایة ماورائیة أو إعانة من السماء.
مع تطور التكنولوجیا ظهرت یوتوبیات جدیدة جعلت الآلة هی وسیلة الإنسان لتحقیق فردوسه المنشود بما تتیحه من رفاهیة و رخاء و راحة. و تجاوزت یوتوبیات القرن العشرین – الیوتوبیات السابقة- خصوصا حین حلت الآلة محل العبید و السخرة وكانت هذه نقطة تشكل نقدا لاذعا للیوتوبیات الكلاسیكیة، لكن سرعان ما ظهر للعیان خطر هذه الآلة، إذ تحولت إلى قوة مسیطرة على الإنسان. أو هی بمثابة المخلوق الذی استعصى على خالقها" فقد فاقت الآلات الشیطانیة كل قوة مبدعة لدى الإنسان، وازدادت فتاكا بالقیم و العلاقات الإنسانیة. وسیطرت على كل من یعارضها حتى على خالقها"(2).
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:11|
المخلص:
تهدف هذه المقاله الی دراسه «الملحمه» فی الادب العربی و اسباب خلو الادب العربی منها، بدءاً بالمعنی اللغوی لهذه الكلمه ثم بیان معناها فی الادب و بیان انواعها و میزاتها فی الادب العالمی، و ذكر ما هو یعد من قبیل الملاحم فی الادب العربی القدیم و الحدیث و دراسه ظهورها فی الادب العربی أو خلو الادب العربی منها، و الا شاره إلی اسباب قلّه الملاحم فی الادب العربی، و منها الخیال البسیط و الفردیه و قلّه خطر الدین لشاعر الجاهلی و قلّه الاساطیر الخصبه و وجود القیود الوزن و القافیه فی الشعر العربی و ضعف فن القصه فیه و ضیق نطاق الاحداث الجاهلی و قصر النفس الشعری و التمسك بالمنهج التقلیدی و …
الكلمات الرئیسه: الاجناس الادبیه، الملحمه، الشعر القصصی، الشعر الحماسی
مقدمه::
الملحمه هی من اهم الاجناس الادبیه، و لدراستنا حول الملاحم أهمیه خاصه، لأنها ترجع تأریخیاً إلی العهود الفطریه للشعوب، العهود التی كان الناس یخلطون بین الخیال و الحقیقه و بین الحكایه و التأریخ، و هی التی تعرفنا القیمه الحقیقیه و الفنیه لحضارات القدیمه كالاغریق و الایران و بین النهرین و الهند و …
و هی التی تروی لنا قصه التأریخ و قصه السابقین الاولین من هذا الرکب البشری و نحن نكون من الذین یرون من خلالها الظروف الاجتماعیه و الاقتصادیه و السیاسیه التی سادت علی المجتمع الانسانی فی تلك العهود القدیمه الماضیه، و لولاها لبقی التأریخ الحضاری أوهاماً یحفر فی اذهان الاجیال اسئله یستعصی حلّها أو تتأخّر الاجابه علیها و هی التی حافله بالمعلومات الخطیره و الهامه و هی التی تحمل الماثرالبشریه التی تحاكی فی افعالها البطوله و النبل و الخوارق و نجد فیها ایضاً ماثر اخری و موضوعات فنیه أخری منها الشعر و منها النثر، منها الغناء و الموسیقی، و منها التصویر و الرسم، حتی النحت و الخط و ماشابه ذلك…
فضلاً عن اتخاذ الملاحم الیوم ماده للرموز فی الاداب من جانب الشعراء، و اتخاذ مضامینها فی القصص و المسریحات و الروایات و… و الذین یقرأون هذه القصص و الروایات یحسون بلذهٍ كثیرهٍ و یرون انفسهم فی بینه حافله بالهدوء و السذاجه و البساطه، «و لن تخلوا الدنیا من هؤلاء القراء الذین یسرون للانتقال من الحیاه الخاطره المعقده الشاقه الی العصور الماضیه البسیطه حیث یظفرون براحه النفس و مطالعه الطبیعه البشریه فی درجتها الفطریه الجمیله»
و نتناول خلال دراستنا الی الظروف الاجتماعیه و الاقتصادیه و النفسیه التی یعیشها الشاعر الجاهلی لأننا نعتقد بأن بعضاً من هذه الاسباب -اسباب الخلو الادب العربی من الملحمه- یرجع الی البیئه التی یعیش فیها الشاعر و بعضها یرجع إلی نفسیه الشاعر و بعضها یرجع الی العوامل السیاسیه التی ساعدت علی المجتمع العربی فی تلك العهود، و ركّزنا دائره بحثنا علی العصر الجاهلی اكثر من العصور المتأخره الأخری، لأننا نعتقد بأن الملاحم –خاصه الملاحم المجموعه أو الأصلیه- تنشأ فی العهود الفطریه للشعوب «و المدینه الحاضره و تقدم العقل البشری، و النظم الدیمقراطیه فی العصور المتأخره، لن تسمح بقیام الملاحم، حتی أن محاوله خلقها تعد بمثابه محاوله بعث الموتی، و وجود خصائص الملاحم فی عمل ادبی معاصر یعد مرضاً یجب استئصاله»
الملحمه لغه::
الملحمه فی اللغه بمعنی الحرب و إنما سمیت بذلك لأمرین: أحدهما تلاحم الناس، أل تداخلهم بعضهم فی بعض و الاخر أن القتلی كاللحم الملقی…
و بعباره اخری «الملحمه: الوقعه العظیمه القتل، و قیل موضع القتال و ألحمت القوم؛ اذا قتلتهم حتی صاروا لحماً.و الحم الرجل الحاماً و استحلم استلحاماً: إذا نشب فی الحرب فلم یجد مخلصاً…
و الجمع الملاحم، مأخوذ من اشتباك الناس و اختلاطهم فیها كاشتباك لحمه الثوب بالسدی، و قیل هو من اللحم لكثره لحوم القتلی فیها…
و الملحمه: الحرب ذات القتل الشدید… و الوقعه العظیمه فی الفتنه…»
و كلمه ملحمه یونانیه الاصل و تلفظ Epikos أو Epos و معناها «كلام» أو «حكایه» و فی الفرنسیه Epique و فی الانجیلزیه تلفظ Epic.
«و قد وردت الملحمه» و مشتقاتها فی الشعر كثیراً، من ذلك قول الأخطل:
حتی یكون لهم بالطف ملحمه و بالثویه، لم ینبض بهاوتر
و قول عجیر السلولی:
و مستلحم قد صکه القوم صکه بعید الموالی، نیل ما كان یجمع
و ایضا وردت الكلمه فی حدیث جعفر الطیار(رض)یوم مؤته: «أنه أخذ الرایه بعد قتل زید فقاتل بها حتی ألحمه القتال فنزل و عقر فرسه»
اما الملحمه فی المصطلح الادبی فهی::
جنس أو نوع خاص من الشعر القصصی البطولی، الذی لم تعرف العربیه شبیهاً له، من حیث البناء القصصی المتكامل، و من حیث الحجم العددی للأبیات الشعریه التی تبلغ الالاف، و من حیث الشخصیات التی تسمو فوق المستوی العادی للناس الأسویاء، و تتصف بما هو من سمات الابطال الأسطوریین، و من سمات الالهه، أو أنصاف الالهه، فی المعتقدات الوثنیه البدائیه، و من حیث الاحداث و الوقائع الخارقه ، و من حیث أن الوقائع الحربیه التی یخوض الابطال الملحمیون غمارها، و الماثر الخارقه التی یحققونها، تدخل فی صمیم الصراع الوطنی و القدمی، دفاعاً عن حق مغتصب، و فی سبیل أن تحیا الامه التی یمثلونها بحریه و كرامه و هناء.
و من هذا المنطلق، تدور الملاحم حول محور بطل وطنی أو حول شخصیه مصطفاه من العقیده الدینیه و هی أنا شید وطنیه یتغنی الشعب بها، لأنها الصوره المثلی التی یطمح الشعب إلیها… و هی تحتوی علی افعال عجیبه، و حوادث خارق العاده و العنصر الاساسی فیها هی الحكایه و الروایه و إزدهرت فی عهود الشعوب الفطریه، حین كان الناس یهتمون بالخیال اكثر مما یهتمون بالواقع.
و الشاعر فی هذا الضرب القصصی لایتطرق الی عواطفه و لا یتحدث عنها «فهو شاعر موضوعی یذكر نفسه، و یتحدث فی قصته عن بطل معتمداً علی خیاله، و مستمداً فی أثناء ذلك من تأریخ قومه، و كل ماله أنه یخلق القصه و یرتب لها الاشخاص و الأشیاء و یجمع لها المعلومات، و یكون من ذلك قصیدته، و عاده ینظمها من وزن واحد لا یخرج عنه»
و تختلف الملاحم البطولیه اختلافاً بیناً عن المدائح التقلیدیه التی تعج بها دواوین الشعراء، لأن الملاحم هی تسجیل فنی لبطوله شخص تأریخی أو أمه عریقه المجد، یملیها علی الناظم إیمان شدید بتلك البطوله و شغف عمیق بتصویرها و نصبها امام الحالمین، و هكذا تصبح البطوله الشخصیه أو القومیه موضوعاً عاماً یوحد أجزاء الملحمه و یوجهها نحو هدف خاص. و شتان ما بینها و بین قصیده المدح التی إنما یراد بها تبجیل الممدوح أو التذلف الیه فتأتی دون هدف فكری موحد.
میزات الملحمه
- البطل الاصلی فی الملحمه هو بطل أو صنف (شبه) إله، الذی یضع مصیره قومه علی الخیر و الصواب و یجب أن تكون فیه قوه بالغه فوق القدره البشریه كه «رستم» فی «شاهنامه» و «آشیل» فی «الیاذه».
- أحداث الملحمه وقعت فی ماض الحیوه البشریه، بحیث افضل الملاحم قیمه، أقدمها زمناً.
- البعد المكانی فی الملحمه و سیع جداً، بحیث ستشمل العالم برمته فی بعض الاحیان، مثلاً فی «اودیسه» ستشمل هذه الملحمه كل اقطاع المعهوده فی ذلك الزمن، أو فی «الجنه المفقوده» -بصفتها ملحمه دینیه- نحن نواجه كل العالم بصوره كامله و شامله.
- احداث الملحمه تدور حول الحروب العظیمه و ما فوق القدره البشریه
- تداخل الموجودات العجیبه أو أصناف الالهه فی الحوادث الموجوده فی الملحمه، ك «سیمرغ» (عنقاء) فی «شاهنامه» ورب «المب» فی الالیاذه و الاودیسه.
- اصل الملاحم یرجع الی الجذور التأریخیه، أو الدینیه، أو الخیالیه.
- الملاحم –فی بدایه امرها- وضعت لأن تقرأ بالصوت العالیه، لأجل ذلك نری فیها لغه ضخمه و غلیظه و هی تختلف عن اللغه التی یتکلم بها العوام.
- تنشر الملاحم فی اكثر الاحیان علی بحر واحد.
- تنشأ الملاحم بفواصل زمینه كثیره بالنسبه إلی الأحداث نفسها.
- لا تعبر الملاحم عن الحروب و القتل و الدم فقط… بل هی تمثل الصفات الخلقیه و الفتوه و البطوله و… ایضا، و الابطال هم الممثلون لعصرهم و ابناء عصرهم.[7]
و كلمه «ملحمه» قدیمه كلفظه فی اللغه العربیه و هی تعنی موقعه حربیه التحم فیها جیشان و تنائر فیها لحم المحاربین، و كلها لم تكن تعنی قبل عصرنا الحالی علی أنها نوع ادبی بذاته أو أنها جنس من أجناس الادبیه المعهوده عند العرب. «و قد تكون شعراً كالیاذه عند الاغریق، و الشاهنامه عند الفرس، و قد تكون نثراً كسیره عنتره»
[u]انواع الملاحم[/
 ]
]1- الملاحم الطبیعیه: هی التی تظهر فی المراحل البدائیه من حیاه الامم و تاریخ الشعوب، وتصاغ بصوره تلقائیه و عضویه، و یكون ناظموها و رواتها و الذین یتداولونها، مؤمنین بما تتضمنه من ذكر الخوارق، و تدخل الالهه فی حیاه البشر، ایماناً مطلقاً لا تشوبه شائبه من الریبه و الشك، و الشعب فی الحقیقه هو مؤلف هذه الملاحم علی مرّ العصور… و بعباره أخری: «الملاحم الطبیعیه أو المجموعه هی الاصیل و ترتقی إلی زمن من تأریخ القوم و بما سبق عهد التدوین عندهم، فاعتمد فی تناقلها علی الروایه، لكنها بداعی تواتر الروایه تعرضت لكثیر من الحذف و الاضافه و التغییر و التبدیل، إلی أن اضطلع بروایتها علم من اعلام الشعر و الانشاء، فاستقام محتواها و سیاقها علی الصوره التی بلغتنا فیها مدونه –مضافه إلی جامعها و راویها و غالب الظن أنها فی الاصل قصائد عامره، نظمها شعراء أفذاذ، فی عهود متعاقبه، و مناسبات مختلفه- عقدكبار روایتها بین فرائدها، فنسبت إلی أشهرهم و ابرزهم، كماجری ذلك فی ملحمه الیونان الشهیره المضافه إلی هو میروس، و المعروفه به «الیاذه»
2- الملاحم الاصطناعیه: هی التی یصفها الشعراء فی الأزمنه المتأخره، و ینظمونها علی نهج الملاحم الطبیعیه، و محاكاه لمضامینها و اسلوبها من غیرأن یكونوا بالضروره مؤمنین بما یصفون من حوادث، و ینسجون من خوارق، و یصورون من بطولات «و هذه الملاحم –الملاحم الاصطناعیه أو الموضوعه- قد نظمها شاعر معروف فی زمن محدد، و نسج أنا شیدها حول احداث معینه، و جری فی سرد وقائعها، و وصف مشاهدها، علی مثال الملاحم المجموعه، بمقدار ما سمح موضوعه، و ألهمته قریحته، فأحاطها بهاله من البطوله، و اغناها بالمشاعر القومیه، و التقالید الاجتماعیه، و الاساطیر الموروثه التی تمت إلی موضوعه بصله قریبه أو بعیده. و مثالها «الانیاذه» التی نظمها «فرچیل» فی قیام الامبراطوریه الرومانیه و اتساع امجادها»
و من النقاد من قسم الملحمه قسمین: ملحمه ادبیه و ملحمه شعبیه
ففی الاول –الادبیه- یعلن الشاعر فی مستهل ملحمته عن موضوعها، ثم یذكر القصه و احداثها الخارقه للعاده و تدخل اصناف الالهه فی شؤون البشر، مستخدماً التصویرات الفنیه و التشبیهات الطویله و البعیده، و أسماء الابطال و الحروب و الاماكن و الاشیاء الهامه لحیاه الابطال كالأسلحه و…
اما الثانیه –الشعبیه- فیتضح فیها النقل مشافهه و التكرار، و تجرؤالسرد، الامر الذی یدل علی أنهالم تكن نتاج زمن واحد أو قریحه واحده.
و هناك ایضاً تقسیمات أخری ك:
-الملاحم الشعریه -الملاحم النثریه
و ایضاً
-الملاحم الاسطوریه - الملاحم التأریخیه - الملاحم الدینیه
أشهر الملاحم المجموعه (الطبیعیه)
1- ملحمه البابلین «جلجامش» (Gilgames)
2- ملحمه الهنود «مهابهاراتا» (Mahabharata)
3- ملحمه الهنود «رامایانا» (Ramayana)
4- ملحمه الفرس «شاهنامه» (Shahnameh)
5- ملحمه الیونان «الیاذه» (Iliade)
6- ملحمه الیونان «اودیسه» (Odysse)
أشهر الملاحم الموضوعه (الاصطناعیه)
1- ملحمه الرومانیین «انیاذه» (Aeneise)
الملحمه فی الادب العربی القدیم:
بالرغم من انتشار ادب الملحمه بین مختلف الشعوب و الامم فاننالانجد لهذا الفن اثراً فی الشعر العربی سوی مقطوعات قصیره و قلیله و قصائد محدوده ذات نفس ملحمی. و لكن لانستطیع أن نضمها الی الملاحم العالمیه الشهیره كالتی عند الیونان و الفرس، و حقاً لقد عرف العرب الشعر الحماسی، ذلك الذی كان الشاعر یتغنی فیه بمفاخر قومه، و یهجو خصومهم، و یدخل الحروب شجاعاً و یخرج منها ناجحاً و واصفاً تلك البطولیه التی خاضنتها أو كانت تخوضها قبیلته. لكن القصیده العربیه لم تكن قصصیه. بل كانت ذات طابع غنائی، كما أنها لم تكن تمتد لأكثر من مائه و خمسین بیتاً اللهم إلا فی القلیل النادر، و لكن هذا لایعنی أن الشاعر العربی لم یتطرق الی تلك المعانی التی تطرق الیها اصحاب الملاحم و خاصه المعانی التی تتعلق بذكر البطوله و الشجاعه، و الفخر و الحماسه، و منها المعلقات السبع و دواوین الحماسه و اراجیز و اناشید الجهاد و بعض الملاحم التی تتصف بالشعبیه و البطولیه الخارقه ك «سیره الزیز السالم» و «قصه عنتره» و …
نعم، المعلقات التی ترجع الی العهود الفطریه للشعب العربی، فی حین كانوا یخلطون بین الحكایه و التأریخ، هی ملحمه متعدد الناظمین، وحماد الراویه، فهو بمقام راوی هذه الماحم، أو الشاعر الذی جمع هذه الملاحم، فأضیفت إلیه كما أضیفت الایاذه إلی هومیروس، و الشاهنامه الی فردوسی، و كما كانت الملاحم الیونانیه و الهندیه و... تعبر عن صفات شعبها الخلقیه و عاداتهم و سننهم و… هذه المعلقات ایضاً تعبر عن عادات العرب و سننهم فی تلك العهود، و الحروب الطویله التی جرت بینهم كحرب البسوس و حرب داحس و الغبراء تذكر الحروب التی جرت –علی سبیل المثال- بین ایران و توران، فعنتره مثلاً یشبه فی كثیر من الاحیان «رستم» فی بطولته و شاعته و هیبته، و عفته و حیائه، و شخصیته الشعبیه.
و ایضاً فی العصر الاسلامی، نحن نری فی اشعار هذا العصر النفس الملحمی و البطوله و الاقدام و الحروب العظیمه و الكثیره، التی نری شبهها فی الملاحم العالمیه الاخری، كقصائد فرزدق و احظل و طرماح و…
و فی العصور المتأخره ایضاً نری كثیراً من الاشعار و الدواوین التی نری فیها نفس الملحمی و الحماسی، كدواوین الحماسه لأبی تمام و بحتری و …
و یقول فی هذا المجال الدكتور كمال الیازجی: «إذا جاز لنا أن نحمل الشعر العربی شیئاً من قبیل الملاحم، فالذی یبدو لی أن هذه القصائد التالیه ربما كن اقرب الی الملاحم؛
- ارجوزه ابن المعتز فی مدح المعتضد (418 بیت) التی تصف قیام بیت العباسی و استقلاله بالخلافه، و ازدهار الخلافه العباسیه.
- ارجوزه ابن عبد ربه فی مدح عبدالرحمن الناصر (442 بیت) التی تصف تحول الاماره الامویه فی الاندلس الی الخلافه علی ید عبدالرحمن الناصر و بلوغها فی عهده اوج ازدهارها.
- تائیه ابن الفارض الكبری (761 بیت) التی نستطیع أن نحسبها ملحمه صوفیه، تروی حكایه جهاد النفس ضد اباطیل الدنیا، و تحررها من مغریات الحیاه، و تسامیها الی الله من اجل الاتصال به و الفناء فیه».
و یعتقد فی هذا المجال الدكتور محمد التونجی بأن: «سیفیات المتنبی، التی تصف بطوله الفارس العربی سیف الدوله، تجاه البیزنطیین بالامتداد داخل بلاد الشام، و رومیات ابی فراس، تلك التی و صفت قتال هذا الشاعر العربی ضد البیزنطیین، و وصفت حاله ایام اسره، و قصائد شعراء «ادب الجهاد» فی مرحله الهجمه الصلیبیه الغربیه علی ارض العرب، با سم الحرب المقدسه، كشعر شاعر اسامه بن منقذ، و شعر طلائع بن رزیك، و لا سیما تلك القصائد التی اشادت ببطوله صلاح الدین ربما كان اقرب الی الملاحم.»
فضلاً عن هذا كله، لدنیا ملاحم تتصف بالشعبیه و البطوله الخارقه، امثال «سیره الزیز السالم» و هی تحكی بطوله مهلهل بین ربیعه فی حرب البسوس، و ملحمه «الظاهر بیبرس» صاحب الفتوحات و الانتصارات علی المغول و الصلیبین، و ملحمه «بنی هلال» و بنو هلال قبیله عربیه من فروع معدو عن بطولاتهم وضعت سیره «بنی هلال» مع وقایع تأریخیه و أسطوریه، و هی سیرتان، السیره الشامیه و السیره الحجازیه، و قصه «عنتره بن شداد» ملحمه حماسیه و بطولیه و غرامیه، برزت احداثها فی الجاهلیه، و بطلها شخصیه عربیه واقعیه، وضعت لهدف سیاسی هو الهاء الشعب عن السیاسه فی العهد العثمانی.
علی أن المیزه الطاغیه علی هذه الملاحم الركاکه الاسلوبیه، و الهلهله الشعریه أو النثریه، و تكرار بعض الاحداث، و إذا لم یكن للاعراب ملاحم تنطبق تماماً علی ملاحم الاغریق فإن بوادر هذه الملحمه برزت فی الشعر الحماسی و الفروسی، و فی سیر الشعبیه التی لو قیض لها شاعر ینمیها لغدت من صمیم هذا الفن العریق.»[13]
الملاحم فی الادب العربی الحدیث
استمرت محاولات الشعراء فی طرق الشعر الملحمی حتی مستهل القرن العشرین حیث ظهرت الملحمه ظهوراً ملتفا للنظر و بثوب جدید و بمواضیع قومیه و عقائدیه و تأریخیه قلما تطرق إلیها الشعراء فی العصور السابقه. و قد ردّ بعض الادباء هذه الظاهره إلی یقظه العرب القومیه منذ بدء هذا القرن و التفاتهم إلی أمجادهم السالفه، و تطلعهم الی الاداب الاجنبیه، و حرصهم علی الغرف من منابعها العذبه الغزیره، و كان السابق الی الاهتمام بالملاحم اهتماماً فعلیاً سلیمان البستانی.
و من الملاحم الدینیه التی ظهرت فی هذا العصر هی ملحمه الشاعر الشیخ كاظم الارزی المعروفه بـ «الازریه» التی مدح الشاعر فیها الرسول (ص) و ذكر معجزاته و مناقبه و … و تبلغ عدد ابیاتها إلی ألف بیت و لكن مابقیت منها الا ابیات قلیله، و من الملاحم المهمه الاخری التی ظهرت فی مستهل القرن العشرین هی القصیده المباركه لعبد المسیح الانطاكی التی تعرف «بالملحمه» و قد بلغ عدد ابیات هذه القصیده 5595 بیتاً و من الملاحم الدینیه الاخری هی ملحمه «مجد الاسلام» أو «إلیاذه اسلامیه» لاحمد محرم، و اختار الشاعر موضوع دیوانه «مجد الاسلام» من التأریخ الاسلامی و عصر صدر الاسلام، حیث تناول غزوات الرسول (ص) و اصحابه(رض)، و قسم عمله الی فصول، و قدم لكل فصل لمقدمه نثریه یشرح فیها موضوعه، و اسم «دیوان الاسلام» اقرب إلی طبیعه هذا العمل من وصفه بالملحمه، لأن الشاعر لجأ إلی حقائق التأریخ و لم یلجأ الی عنصر الخیال و لم یذكر الحوادث الخارقه للعاده و … كما انه یمیل إلی الغنائیه، و شارك فی هذ، الاتجاه، احمد شوقی فی كتابیه «كبار الحوادث فی وادی النیل» و «دول العرب و عظماء الاسلام» و عمر ابو ریشه فی كتاب «الملاحم البطولیه فی التأریخ الاسلامی» و خالد الفرج فی كتاب «احسن القصص» و منها ایضاً بولس سلامه فی «عید الغدیر» و حافظ ابراهیم فی «عمریه» و عبدالحلیم المصری فی «بكریه» و عمر ابو ریشه فی «خالدیه» و … و ممن حاولوا أن یملأوا فراغ الشعر العربی من الملاحم –فضلاً عما سبق-
- شفیق معلوف فی «عبقر» - سعید عقل فی «قدموس» حلیم دموس فی «ملحمه العرب»
- محمد عبدالمطلب فی «علویه» - عبدالمنعم الفرطوسی من «ملحمه اهل البیت»
و الملاحم بهذا المعنی كثیره جداً، و هذا كله –بسبب خلوه من اكثر میزات الملحمه و عناصرها- من قبیل الملاحم و من قبیل شبه الملاحم، و لیست اكثر الملاحم البطولیه و الدینیه التی ظهرت حتی الان فی الادب العربی إلا محاولات لم تستكمل نضجها بالنسبه إلی ما عند الاغریق و الفرس و الهنود و …
اسباب خلو الادب العربی من الملاحم:
قد اشتغل الباحثون فی تعلیل هذا الامر و اوردوا اسباباً عده منها: قول من زعم «أن العرب نظموا فیه كثیراً و ضاع مانطموه» فلم یبق لعهد التدوین و الروایه إلا القلیل هما ذكرت فیه اخبار العرب، و هو قول ترده الشواهد و الدلائل التاریخیه. و منها «أن خیال الجاهلیین لم یتسع للملاحم و القصص الطویله لانحصاره فی بادیه متشابهه الصور، محدوده المناظر ثم لمادیتهم و كثافه روحانیتهم، ثم لفردیتهم و ضعف الروح القومیه و الاجتماعیه فیهم، ثم لقله خطر الدین فی قلوبهم و قصر نظرهم عما بعدالطبیعه، فلم یلتفتوا الی ابعد من ذاتهم، و لا الی عالم غیر العالم المنظور، و لاتولدت عندهم الاساطیر الخصبه، و لم یكن لأصنامهم من الفن و الجمال ما یبعث الوحی فی النفوس شأن اصنام الیونان و الرومان: فقل من ذكر منهم اوثانه و استوحاها فی شعره. و لم یساعدهم مجتمعهم علی التأمل الطویل و ربط الافكار و فسح آفاق الخیال، لاضطراب حیاتهم برحیل مستمر، فجاء نفسهم قصیراً كإقامتهم، و خیالهم متقطعاً كحیاتهم، صافیاً واضحاً كسمائهم، دانی التصور محدودا لألوان كطبیعتهم. و كانت ثقافتهم الادبیه فطریه خالصه یتغذی بعضهم من بعض، و لایقبلون لقاح الاداب الاجنبیه الراقیه لجهالتهم و اعتزال بادیتهم و تمردها و كذلك كانت علومهم ساذجه لا تفتح نوافذ النور للنظر، فیالنفس و ما بعد العالم الهیولی.»
و یقول فی هذا المجال الدكتور شفیق البقاعی: «اما السبب العائد لخو الادب العربی من بعض الاجناس الادبیه –و منها الملحمه- التی نحن نری مثالها عند الیونان و الرومان و السومریین، فهو عائد لظروف كونت طبائع اسلافنا و ركبت فیهم المیزاجیه التی صنعوا من خلالها ادبهم»
و یقول الدكتور عبدالمنهم الخفاجی: «1- أن مزاوله هذین اللونین –القصص و التمثیلی- من الشعر تقتضی الرویه و الفكره، و العرب اهل بدیهه و ارتجال. 2- و انهما یتطلبان الإلمام بطبائع الناس، و قد شغل العرب بأنفسهم عن دراسه النفوس و التفرغ لتحلیل طبائع الناس. 3- و انهما یفتقران إلی التحلیل و التطویل؛ و العرب اشد الناس اختصاراً للقول، و اقلهم استقصاداً فی البحث. 4- و انهما یحتاجان إلی كثره الاساطیر، و لم تتوفر هذه الكثره للعرب. 5- علی أن قیود الوزن و القافیه فی الشعر العربی لا تساعد علی الاطاله و الانشاء الملاحم الطویله. 6- و علی أن الشعر القصصی و التمثیلی یحتاجان إلی تدوین و كتابه لانهما لونان من الوان التدوین و الحضاره، و العربی فی الجاهلیه لم یكن یعرف هذه الوسائل، و كان بعد العصر الجاهلی محتذیاً للقدامی فی مناهجهم الادبیه و ألوان شعرهم الفنیه»[16]
و ثمه تعلیلات أخری فسرت انعدام الفن الملحمی فی الشعر العربی، منها أن القصه فی الشعر الجاهلی ضعیفه الفن لاقتصادها علی الخبر البسیط و السرد السریع… و لا جرم أن الا یجاز الذی درج علیه الجاهلی كان یحول بینه و بین الاسهاب فی اخباره… فلم یتوفر له عمل الملاحم و القصص الطویله.
و نحن نری بأن القصیده العربیه منذ نشأتها موحده القافیه، و الفتوحات الاسلامیه لم تتمخض عن ظهور شعر ملحمی، لأننا نری فی هذه الفتوحات طابعاً دینیاً و كان الهدف الاول منها هو نشر الاسلام و المضامین الدینیه.
و یقول الدكتور كمال الیازجی فی تحلیل هذه الظاهره –احجام العرب عن نظم الملاحم- عن لسان سلیمان البستانی، و یقول «1- ضیق نظاق الاحداث الجاهلیه 2- قصر النفس الشعری 3- التمسك بالمنهج التقلیدی و 4- ضعف تراث الاسطوری و … هی من الاسباب الرئیسیه لخلو الادب العربی من الملحمه.»
و ربما من الاسباب الرئیسیه الهامه فی هذا المجال هی عدم ترجمه الاعراب الادب الیونانی، لعدم رغبتهم أو أنهم لایعجبون بشعر غیر شعرهم، فیقولون أن الشعر هو شعر العرب فحسب.
و منها أن الوثنیه العربیه فی الجاهلیه لم تكن تلك الوثنیه المكتمله المعقده و المركبه: بل كانت و ثنیه فی ابسط اشكالها و كانت تتعایش مع مذاهب توحیدیه، كالیهودیه و النصرانیه و …
و منها أن التقلید الشعری الاصولی السائد، و المتمثل بسلطه القصیده الغنائیه ذات القافیه الواحده و الوزن الواحد لم یكن یسمح بنظم المطولات القصصیه الملحمیه…
و یقول الدكتور احمد الشایب: «إن ماده القصص توافرت للأقدمیین من عرب الجاهلیه لكثره ایامهم الداخلیه و الخارجیه، و توالی أسفارهم و شیوع الاساطیر و الخرافات بینهم، و لكن الشاعر او هو میر العرب لم یوجد، بدلیل أن هذه الماده الجاهلیه نفسها أو جدت القصص بعد الاسلام و كان خلیطاً من النظم و النثر»[18]
الخاتمه:
بالرغم من انتشار ادب الملحمه بین مختلف الشعوب و الامم فإننا لانجد لهذا الفن و هذا الجنس الادبی اثراً فی الشعر العربی سوی مقطوعات قصیره و قلیله و قصائد محدوده ذات نفس ملحمی، التی لانستطیع أن نضمها الی الملاحم العالیمه الشهیره كالتی عند الیونان و الفرس و الهنود، و لقدا تفق اكثرالباحثین تقریباً علی خلو الادب العربی من هذا الجنس الادبی و لكن تفرقت آراؤهم فی تفسیر هذه الظاهره، منهم من یردها الی خیال الجاهلین البسیط لانحصاره فی بادیه متشابهه الصور و الی فردیتهم و ضعف الروح القدسیه بینهم كبطرس البستانی، كما یردها البعض الاخر إلی قلّه الاساطیر و وجود قیود الوزن و القافیه كعبد المنعم الخفاجی، أو الی ضیق نظاق الاحداث الجاهلیه و قصر النفس الشعری، و التمسك بالمنهج التقلیدی كسلیمان البستانی.
و من الباحثین من یعتقد بأن هناك توجد قصائد ذات نفس ملحمی و حماسی، التی تستطیع أن تسمی شبه الملاحم و إن لم تصل إلی ما عند الیونان و الفرس و منهم الدكتور كمال الیازجی، الذی یعتقد بأن أرجوزه ابن معتز و ارجوزه ابن عبد ربه و تائیه ابن الفارض الكبری –بصفتها ملحمه صوفیه و دینیه- ربما كانت اقرب الی الملاحم، كما یعتقد الدكتور التونجی بأن سیفیات المتنبی و رومیات آبی فراس و قصائد شعراء «ادب الجهاد» ربما كانت أشبه بالملاحم.
و منها المعلقات السبعه التی نستطیع أن نحسبها ملحمه متعدد الناظمین فضلاً عن دواوین الحماسه و …
و فی الادب العربی الحدیث ایضاً، استمرت محاولات الشعراء فی هذا المجال و نری ظهور الآثار التی تشبه الملاحم فی بعض –الاحیان كـ «الیاذه الاسلامیه» لاحمد محرم و «الازریه» لشیخ الكاظم الازری و «عید الغدیر» لبولس سلامه و…
و لكن نری الشعراء فی هذه الاثار یلجؤون الی الحقائق التأریخی و یمیلون الی الغنائیه و لم یلجؤوا الی عناصر الملاحم كعنصر الخیال و الحوادث الخارقه للعاده
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:10|
أدب العقاد والاتجاه الفلسفی
غیر مجد فی یقینی واعتقادی تجاهل البعد الفلسفی حین الحدیث عن عباس العقاد.صحیح أنه یعد بالدرجة الأولی أدیبا,ولكن هل نستطیع الفصل بین مجال الأدب ومجال الفلسفة؟ كلا ثم كلا ان اسهامات العقاد فی مجال التألیف الفلسفی ـ وبصرف النظر عن اتفاقنا معه تارة واختلافنا معه تارة أخری ـ لایمكن التقلیل من أهمیتها خاصة فی الوقت الذی ألف فیه العقاد ما ألف.فقد كتب الرجل عشرات الكتب ومئات المقالات والتی تتصل من حیث الموضوع ومن حیث المنهج أیضا بالفكر الفلسفی بصورة مباشرة تارة وغیر مباشرة تارة أخری وتتصل من قریب ومن بعید بالجوانب الفلسفیة بصورتها العامة وبصورتها الخاصة.
ومن بین مؤلفاته ومقالاته والتی لاتخلو من دلالات فلسفیة ماكتبه عن فرنسیس بیكون الفیلسوف الإنجلیزی حین خصص له كتابا مستقلا, وماكتبه عن ابن رشد سواء فی كتابه عن ابن رشد أو فی عرض لبعض آرائه بمجلة الكتاب وغیرها من مجلات تصدر بمصر, وكتابه عن عقائد المفكرین فی القرن العشرین, والفلسفة القرآنیة وإبلیس, ومحمد عبده, والإسلام فی القرن العشرین,
واثر العرب فی الحضارة الأوروبیة ومقالاته وأحادیثه فی الإذاعة التی نشرت فی كتب عدیدة له, ویضاف إلی ذلك أیضا تحلیلاته الفلسفیة حین یتصدی للكتابة عن شخصیة أو أكثر من الشخصیات التی تمزج فی أقوالها أو فی شعرها بین الجانب الفلسفی والجانب الأدبی, كابن الرومی وغیره من أدباء العرب, بل أدباء الغرب أیضا كشكسبیر وقد خصص له كتاب مستقلا هو التعریف بشكسبیر وبرنارد شو وعشرات الأدباء الغربیین.
وكتابات العقاد فی المجال الفلسفی وصلته بالمجال الأدبی والمجال الدینی رغم ماقد یوجه إلیه من نقد, لاتخلو من أهمیة خاصة إذا وضعنا فی الاعتبار أنها تكشف عن إطلاع واسع وبغیر حدود. وتكشف عن روح نقدیة ولیس روحا تقلیدیة لقد بذل الرجل أقصی مایمكنه فی مجال البحث والدراسة والتمحیص.
قلنا إن العقاد كانت لدیه اهتمامات فلسفیة, لقد كتب الرجل الكثیرفی مجال الفلسفة سواء فی حد ذاتها أو من خلال علاقتها بمجالاتت أخری دینا كانت أو أدبا أوعلما وإذا كنا نقول انه لیس بوسع مقالة ان تعرض لكل اهتماماته الفلسفیة وما أكثرها, فإنه من الضروری إذن ان نقف عند مجرد مجموعة من النماذج والجوانب. ویؤكد العقاد وجود فلسفة فی مصر حین یقول: نعم فی مصر فلسفة نعم وفیها عنایة بالكتب الفلسفیة وآیة ذلك اننا تلقینا فی عام واحد نحو عشرین رسالة فی المباحث الفلسفیة وما إلیها, وعلمنا أنها تقرأ فی بیئة المتعلمین الذین یعدون الامتحان المدرسی وتقرأ فی بیئة المطلعین الذی یقنعون بالإطلاع.
ویؤكد العقاد أهمیة السعی لترجمة أعمال الفلاسفة الكبار أمثال أفلاطون وأرسطو.ولم یكن اهتمام العقاد بالفكر الفلسفی مقتصرا علی دراسة آراء القدامی فحسب, بل نراه مهتما بدراسة العدید من الآراء المعاصرة ودراسة الكثیر من الشخصیات التی عاشت فی عصرنا الحدیث, إن هذا یتضح من خلال العدید من الكتب التی تركها لنا هذا المفكر الشامخ, انه یخصص كتابا لدراسة آراء الشیخ محمد عبده والذی توفی عام1905 م.
ویتحدث فی هذا الكتاب عن حیاته الفكریة وعلاقته بجمال الدین الأفغانی وعن آرائه الإصلاحیة, وهذا الكتاب, كتاب العقاد عن الشیخ محمد عبده, یعد من الكتب المهمة فی مجال الفكر الفلسفی العربی المعاصر. صحیح أن محمد عبده لا یعد فیلسوفا ولكن هل وجدنا فلاسفة فی عالمنا العربی منذ ثمانیة قرون, أی منذ وفاة العملاق ابن رشد؟.
أما فی كتابه مراجعات فی الأدب والفنون فإننا نجد حدیثا من جانب العقاد عن معنی الجمال ورأی شوبنهور فی معنی الجمال, واصل الجمال فی نظر العلم, هذا بالاضافة إلی العدید من المقالات والتی لاتخلو من دلالات فلسفیة, ومن حیث موضوعها علی الأقل كحدیثه عن علم الأخلاق وصورة السعادة.. الخ
ومن الكتب المهمة التی تركها لنا العقاد, كتاب ساعات بین الكتب والذی نجد فیه العدید من المقالات الفلسفیة, إنه یتحدث عن الآراء والمعتقدات والعقل والعاطفة والإیمان العلمی, والجمال والشر فی الفنون, وغیر ذلك من مقالات تكشف عن إطلاع واسع من جانب العقاد, وإن كنا لانجد لبعضها فائدة علمیة إلا إذا وضعنا فی اعتبارنا الزمن الذی ألف فیه العقاد هذا الكتاب بمقالاته العدیدة المتنوعة. وواجب علینا الاهتمام بدراسة الأبعاد الفلسفیة عند العقاد وذلك حتی نستطیع الاقتراب من الصواب حین دراسة آرائه الأدبیة.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:9|
التجدید العروضی الغنائی فی شعر الموشحات الأندلسیة
احتاجت الدولة العربیة فی الأندلس إلى قرنین أو ثلاثة قرون من تأسیسها حتى تستقر أركانها وتثبت دعائمها. وعندئذ مال الناس إلى الترف واللهو فی حیاتهم، وكان من آثار ذلك انتشار الغناء ودواعی الطرب، وزیادة الاهتمام بالألحان، والموسیقا وآلاتها.
ولاشك أن لهذه الحال الاجتماعیة أثراً كبیراً فی نشأة الموشحات وشیوعها، لأن الموشحات عامة تدخل فی إطار الاتجاه الشعبی الذی هیأ له نمو الشخصیة الأندلسیة وإسهام الأندلسیین فی إنشاد الشعر والإصغاء إلى ألحانه فی مجالسهم وأسمارهم.
وهذه الصلة الوثیقة بین الموشحات والغناء تبدو فی اعتماد لغة الموشحات على الألفاظ الرقیقة الغزلة الهزازة والمعانی الطریفة، على ما فیها من سطحیة، وبموضوعاتها التی تناسب جو الغناء والمرح من غزل ووصف خمر وطبیعة ساحرة عرفت بها بلاد الأندلس ومرابعها العامرة.
وعلى الرغم من قوة الصلة بین الموشحات وبین الموسیقا وطریقة الغناء، فإننا لا نعلم شیئاً عن النظریة الإیقاعیة التی قامت علیها الموشحات، ولا عن كیفیة أدائها وتلحینها وإنشادها، ولكن الراجح أنها كانت تصاغ على نهج معین لتتسق مع النغم المنشود، وأنها كانت تغنى بطریقة فردیة، لا بطریقة "الكورس"، وأن الوشاح هو الملحن غالباً، وقد یكون غیره. أما المغنی فهو شخص آخر. وأغلب الظن أن بواكیر الموشحات عاشت زمناً بین الناس مسموعة لا مقروءة. ولم یعمد أحد إلى تدوینها فی بادئ الأمر. ولیس معنى ذلك أن الموشحات جمیعاً كانت تغنى، إذ لا شك أن كثیراً منها نظم لغیر غرض الغناء والتلحین، ولاسیما تلك التی لا تتصل مناسبتها ولا موضوعها بهذا الجانب: كالهجاء والرثاء والزهد.
وهذا كله یعنی أن الموشح فن أندلسی أصیل ابتدعه العرب فی ظل ظروف اجتماعیة خاصة، وهذا ما أكده المؤلفون العرب من أندلسیین ومشارقة، كابن خلدون فی مقدمته، وابن بسام فی ذخیرته، وابن دحیة فی "المطرب"، والمقری فی نفح الطیب، وابن سناء الملك فی "دار الطراز"، وغیرهم، وإن كانت هناك أقوال یسیرة تنسب ظهور بدایات هذا الفن إلى المشارقة.
أما الأثر المتبادل بین فن الموشحات وشعر التروبادور Troubaours، فما زال یفتقر إلى مزید من المناقشة والتثبت والتمحیص، وإلى القول الفصل فی مدى التأثیر والتأثر بینهما(2). فالموشحات إذن هی عربیة الأرومة، وفن جدید فی الشعر الأندلسی، لأن البیئة فی الأندلس كانت مواتیة للتجدید أكثر من المشرق، ویمكن أن نحدد الموشح بأنه قالب شعری عربی وشكل مستحدث للقصیدة شذ فیه الأندلسیون عن مأثور نظامها الموسیقی الموروث فی الوزن الواحد، والقافیة الواحدة، إلى نظام آخر یحمل خصائص معینة.
وأهم هذه الخصائص –مما یدخل فی نطاق بحثنا هذا- خروج الموشح على نظام القافیة الواحدة فی القصیدة، واللجوء إلى التنویع فی القوافی والتوزیع الإیقاعی وفق نسق معین یجعل الموشح حقاً أشبه بالوشاح المزین المزركش الذی رصعته الجواهر المتلألئة، وزینته الزخارف والنمنمات الملونة، فضلاً عن "الخرجة" التی تأتی فی خاتمة الموشح زینة أخرى متمیزة، عندهم، بخصائص ینبغی للوشاح مراعاتها.
ومن هذا المنطلق، منطلق التجدید العروضی الإیقاعی، والموسیقی الغنائی، نشیر إلى أن الوشاحین الأندلسیین –على كثرتهم- لم یبینوا لنا بصورة واضحة قواعد الموشح وأسس بنائه ومصطلحاته، وإن كنا نجد هنا وهناك بعض الإشارات إلى أصول هذا الفن. وربما كان ابن سناء الملك، المصری، (608ه/1212م) أول من حاول أن یحدد قواعد هذا الفن الشعری وأوزانه، ویبیّن لنا خصائصه وطرق نظمه، وذلك فی كتابه القیّم "دار الطراز فی عمل الموشحات". وتكونت نتیجة لذلك كله جملة من التقسیمات والتصنیفات التی حملت مصطلحات مختلفة، ومتضاربة فی دلالاتها أحیاناً. إلا أننا سنقتصر على أیسرها وأقربها منالاً، مما لا یتعب القارئ فی استیعابه وتفهمه:
إن أهم أقسام الموشح وعناصره هی: القفل، والبیت، والغصن، والخَرْجة. وهذا ما نوضحه فی بعض مقاطع الموشح التالی لابن زُهر الأندلسی (595ه/1199م):
حَیِّ الوجوه المِلاحا
وحیِّ نُجلَ العیونْ
هل فی الهوى من جُناحِ
أم فی ندیمٍ وراحِ؟
رام النصیحُ صلاحی
وكیف أرجو صَلاحا
بین الهوى والمجون؟
أبكی العیونَ البواكی
تذكارَ أختِ السِّماكِ
حتى حَمامُ الأراكِ
بكى شجونی وناحا
على فروعِ الغصونْ(3)
افتتح هذا الموشح بالبیت الأول وهو المطلع، ویسمى قفلاً. وهو على البحر المجتث (مستفعلن فاعلاتن) بضرب مقصور (فاعلاتن). وعلى وزنه هذا، وقافیتی صدره وعجزه توالت بعده الأقفال كلها، ویضم هذا الموشح ستة أقفال، یبدأ بقفل وینتهی بقفل، ویسمى عندئذ "التام".
والأقفال أساسیة فی الموشح، وبدونها لا تكون المنظومة موشحاً، وهی الوحدة الأولى فیه. ویسمى كل شطر من شطری القفل: غصناً.
أما الوحدة الثانیة فی الموشح فهی التی تلی القفل، وتتألف هنا فی موشح ابن زهر من ثلاثة أشطر أو أغصان وزن كل منها (مستفعلن فاعلاتن) أیضاً، تسمى بمجموعها "بیتاً". وعددها خمسة "أبیات". وهی جمیعاً تتفق فیما بینها فی الوزن ولكنها تختلف فی القوافی. وهذا النظام هو الغالب فی الموشح عامة، وهو المسمى "بالتام" ویكون مؤلفاً –كما نرى- من ستة أقفال، وخمسة "أبیات". وكلها ذات وزن عروضی واحد. فإذا لم یبدأ بقفل، بل ب "بیت"- وهذا قلیل- سمی الموشح "أقرع".
ولا یقتصر القفل فی الموشح على بیت شعری واحد ذی شطرین أو غصنین، بل قد یكون أكثر من ذلك، وكذا "البیت" بین القفلین یمكن أن یكون مؤلفاً من عدة أغصان، تكتب على نسق شاقولی (عمودی)، أو أفقی فی سطر واحد.
أما "الخَرْجة" فهی القفل الأخیر من الموشح –كما قال ابن سناء الملك فی كتابه "دار الطراز"- وإذا كان القفل الأول فی الموشح لیس عنصراً رئیسیاً، فإنه فی غایة الأهمیة عندما یكون فی خاتمة الموشح، وهو الذی یعرف بالخَرْجة، وهی ركن أساسی یولیه الوشاحون عنایة خاصة، ولها شروط تنسجم مع جو الطرب والغناء المواتی للموشحات.
والموشح، بعد هذا، بأقفاله و"أبیاته" وأغصانه وخرجته یؤلف وحدة كاملة مترابطة فیما بینها فی المعنى، كما الأبیات كلها فی القصیدة العربیة الموروثة، وهذا التقسیم الاصطلاحی الإیقاعی لأجزاء الموشح لا یعنی أنها منفصلة فیما بینها من حیث الأفكار والمعانی.
وبعد هذه الوقفة عند أجزاء الموشح وعناصره التی تؤلف بنیته ووحدته، یحسن بنا أن نتحدث عن وزنه العروضی أو التفعیلی، ومدى ما فیه من تجدید أو تقلید فی هذا الجانب. وفی هذا السیاق الغنائی القائم على التلحین والوزن یمكن أن نقسم الموشحات إلى خمسة أقسام:
1-قسم یلتزم بالبحور الشعریة الستة عشر الموروثة، التزاماً تاماً، من حیث أوزانها المعروفة، أما فیما عدا ذلك فإنها تختلف فی شكلها الفنی وتوزیعها الإیقاعی عن شكل القصیدة، وقلیل من الوشاحین من یلتزمون بنظام الشطرین وحده فی الموشح –على طریقة القصیدة العربیة –لكنهم حتى فی هذه الحالة یحافظون على طریقة الأقفال و "الأبیات" دون مراعاة الخرجة.
ومن هذا القبیل موشحة ابن سهل الإشبیلی (649ه/1251م) التی بدأها بقفل مؤلف من أربعة أشطر، على بحر الرمل:
هل درى ظبیُ الحِمى أنْ قد حمَى
قلبَ صَبِّ حلّه عن مكنسِ؟
فهو فی حَرٍّ وخفْقٍ مثلما
لعبتْ ریحُ الصَّبا بالقَبس
وختمها بهذا القفل الأخیر:
قلتُ، لمّا أن تبدّى مُعْلَما
وهو من ألحاظِهِ فی حَرس
أیُّها الآخِذُ قلبی مَغْنَما
اجعلِ الوصلَ مكانَ الخُمُس
وما بین القفلین، الأول والأخیر، تأتی "الأبیات" وعددها خمسة، على وزن الرمل أیضاً، ولكن قوافیها تختلف من "بیت إلى آخر" وكل بیت مؤلف من ستة أشطر، وأوّلها بعد المطلع (القفل الأول) وقافیته راء ساكنة:
یا بدوراً أشرقتْ یومَ النوى
غرراً تَسلكُ بی نهجَ الغرَرْ
ما لنفسی فی الهوى ذنبٌ سوى
منكم الحسنُ، ومن عینی النظَرْ
أجتنی اللذّاتِ مكلومَ الجَوى
والتذاذی مِن حبیبی بالفِكَرْ(4)
ثم تتوالى "الأبیات" بین الأقفال على هذا النسق.
وأما النوع الآخر من الموشحات الجاریة على الأوزان الموروثة فإن الوشّاح لا یلتزم نظام الشطرین المتقابلین، بل ینوع فی بناء الموشح من حیث الالتزام بالشطرین معاً فی الأقفال، وبشطر واحد أو أكثر فی "الأبیات".
ومثال ذلك موشح ابن زُهر الأندلسی (595ه/1199م) وهو موشح تام على بحر الرمل، ذو ستة أقفال وخمسة "أبیات"، وكل بیت مؤلف من ثلاثة أشطار، والقفلان الأولان یأتیان على النمط التالی، مع القفل الواقع بینهما، وتتبعهما بقیة الأقفال والأبیات على النمط نفسه، مع اتفاق فی قافیة الأقفال، واختلاف فی قوافی "الأبیات":
أیها الساقی إلیك المشتكى
قد دعوناكَ وإن لم تسمعِ
وندیمٍ هِمتُ فی غُرّتهِ
وبشربِ الراح من راحتِه
كلما استیقظَ من سكرتهِ
جذبَ الزقّ إلیه واتّكا
وسقانی أربعاً فی أربعِ(5)
2-قسم یظهر فیه التجدید على استحیاء، وهو ما یفعله بعض أصحاب الموشحات من ابتعاد موشحاتهم قلیلاً عن البحر التقلیدی، وذلك بتعدیل بعض تفعیلاته، أو إدخال شیء من الزیادة أو النقصان فی حركاته وكلماته، أو فی تقفیة حشو الأبیات فی موضع معین للتزیین والزخرفة، ومثال ذلك الموشح التام –الذی سبق- لابن زهر وأوله:
حَیّ الوجوهَ المِلاحا
وحَیِّ نُجل العیونْ
هل فی الهوى من جُناحِ
أو فی ندیمٍ وراح؟
رام النصیحُ صلاحی
وكیف أرجو صَلاحا
بین الهوى والمجونْ؟
فهذا الموشح یقوم فی أصله على وزن البحر المجتث (مستفعلن فاعلاتن)، ولكن ابن زُهر لم یبق الضرب فی الأقفال كلها على فاعلاتن بل جعله "مقصوراً" بحذف ساكن السبب الخفیف فی آخره وتسكین ما قبله فصار (فاعلاتْ = فاعلانْ). وهذا التغییر لا وجود له فی وزن المجتث الموروث.
ومن هذا القبیل موشح أبی بكر بن بقی (540ه/1145م) وأوله:(6)
یا ویحَ صبٍّ إلى البرق
له نظَرُ
وفی البكاء معَ الوُرْقِ له وطرُ
من أجل بُعدٍ عن صَحْبی
بكیتُ دمَا
كم لی هنالكَ من سِرْبِ
ووصْلِ دُمى
وعسكرُ اللیلِ فی الغربِ
قد انهزَما
والصبحُ قد فاضَ فی الشرقِ
له نهَرُ
وسال من أنجُمِ الأُفْقِ دمٌ كدِرُ
فهذا الموشح من وزن البسیط التام، ولكن الوشّاح التزم قافاً مكسورة فی وسط الحشو من شطری الأقفال جمیعاً، وبذلك بناها على أربع قوافٍ یُتوقّف عندها فی القراءة أو الإنشاد بما یجعل القفل خارج البحر البسیط من حیث الظاهر.
أما "الأبیات" فقد جعل أغصانها شطراً من البحر البسیط، ولكنه جعل لكل غصن قافیتین (ب +ما) بحسب الظاهر مع أن تفعیلات الغصن كلها متتابعة فی الوزن (مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن) ثم نوّع هذه القوافی فی سائر أغصان "الأبیات" ضمن الموشح كله.
3-ونوع ثالث من الموشحات الموزونة، وهو ما اشترك فیه أكثر من وزن واحد، ویكون ذلك بإحدى طریقتین:
آ- استخدام بحر واحد فی موشح واحد كامل، وذلك بتوظیف حالاته المختلفة من زحافات وعلل، وأعاریض وأضرب، وتام ومجزوء، ومشطور ومنهوك ضمن الموشح نفسه، لا یخرج فی ذلك كله عن بحر واحد داخل الموشح المنشود، كأن تأتی أشطار على الرمل التام، وأخرى على مجزوء الرمل.. أی یتفاوت عدد التفعیلات وأشكالها.
ب- أن یجمع صاحب الموشح بحرین اثنین فی موشح واحد بحیث یأتی بأشطرٍ على بحر ما، تام، أو مجزوء، أو منهوك، ثم یعدل عنه فی أشطر تالیة إلى بحر آخر مختلف التفعیلات، وذلك فی حال تنقله من القفل إلى البیت. أما الأقفال أو الأبیات فیبقى كل منها ملتزماً وحدة البحر مع نظائره فی الموشح نفسه، من أقفال و"أبیات"، إضافة إلى وحدة القافیة بین الأقفال، أو فی حشو الأقفال و "الأبیات" المقفّاة" فی حشوها. ومثال ذلك موشح للأعمى التُّطیلی (القرن 3ه = 9م) یقول فیه(7):
المطلع (القفل الأول)
ضاحكٌ عن جُمانْ
سافرٌ عن بَدرِ
ضاق عنه الزمانْ
وحواهُ صَدری
* *
البیت الأول
آهِ مما أجِدْ
شفّنی ما أجِدْ
قام بی وقَعدْ
باطشٌ مُتَّئدْ
كلّما قلتُ قدْ
قال لی: أینَ قد؟
* *
القفل الثانی
وانثنى خوطَ بانْ
ذا مَهَزٍّ نَضْرِ
عابثَتْهُ یَدانْ
للصَّبا والقَطْرِ
وهكذا دوالیك..
وقد جاءت التفعیلات فی هذا الموشح على الوجه التالی:
المطلع (القفل الأول)
فاعلن فاعلانْ
فاعلن مفعولنْ
فاعلن فاعلانْ
فعلن مفعولنْ
البیت الأول:
فاعلن فاعلن
فاعلن فاعلن
فاعلن فعِلن
فاعلن فاعلن
فاعلن فاعلن
فاعلن فاعلن
القفل الثانی:
فاعلن فاعلانْ
فاعلن مفعولنْ
فاعلن فاعلانْ
فاعلن مفعولنْ
4-وقسم من الموشحات له أوزان وتفعیلات خاصة یدركها السامع عند القراءة أو السماع، ویستعذبها الذوق ولكنها لا تنطبق على شیء من أوزان الشعر العربی الموروثة.
وقد حاول بعضهم حصر الأوزان والتفعیلات التی بُنی علیها هذا النوع من الموشحات وجهدوا فی أن یردّوها إلى نظام الأوزان العروضیة التی حصرها الخلیل الفراهیدی ومَن بَعدهُ فی البحور الستة عشر، وفروعها، حتى أوصلوها إلى نحو 150 وزناً أو بحراً مخترعاً، لا عهد للشعر العربی بها، ولكن محاولاتهم هذه اتسمت بشیء كبیر من التكلف والافتعال، فضلاً عن أنها لم تستقص أوزان الموشحات كافة، فما زالت هناك موشحات خارج تلك الأوزان ولكن الإیقاع فیها –على كل حال- هو عربی خالص، وتفعیلاتها متناسقة مع اختلاف تنویعاتها، وإن كانت لا یمكن أن تنتمی إلى بحر معین كالبسیط أو مجزوء الكامل.. الخ فالوزن العربی لم یُقفل بابه على مر العصور، ولیس هناك ما یحول بین الشاعر المجدّد وبین استخراجه ما یریده من أوزان، إذا جرى فی الاستخراج على قاعدة سلیمة فی التقفیة والإیقاع.
ومثال هذا النوع قول ابن اللَّبانة (507ه/1113م):
القفل الأول
كم ذا یؤرّقنی ذُو حَدقِ
مَرضَى صِحاحِ
لا بُلینَ بالأرَقِ(8)
البیت الأول
قد باح دمعی بما أكتمُه
وحنَّ قلبی لِمنْ یَظلِمُهُ
رشَا تمرَّن فی "لا" فَمُهُ
كم بالمُنى أبداً ألثِمُه
القفل الثانی
یفترُّ عن لؤلؤٍ فی نَسقِ
منَ الأقاحی
بنَسیمهِ العَبِقِ
وجاء الوزن فیه على الوجه التالی:
القفل (1)
مستفعلن فعِلن مفتعلن
مستفعلن متفْعلن مفاعلَتن
البیت (1)
مستفعلن فاعلن مفتعلن
متفْعلن فاعلن مفتعلن
متفعلن فعلن مفْتعلن
مستفعلن فعلن مفتعلن
القفل (2)
مستفعلن فاعلن مفتعلن
متفْعلن مفتعلن مفاعلتن
5-والقسم الخامس والأخیر من الموشحات ما لیس له وزن یدركه السمع عند قراءته أو إنشاده، ولا یوزن إلا بالتلحین وذلك بمد حرف، وقصر آخر أو خطف حركته، وإدغام حرف فی حرف، وغیر ذلك من فنون التلحین.
وهذا النوع –كما قال ابن سناء الملك –لا یدخل شیء منه فی أوزان العرب، وهو النمط الذی یسود أكثر نماذج الوشاحین فی الأندلس، وعدده لا یقع تحت حصر، ولا یستقصیه إحصاء، لأنه قائم على التلحین فقط، ولا میزان له إلا الضرب على العود أو النفخ فی الأرغن، ولا ضابط له سوى النغم والإیقاع عن طریق مد الصوت بالإنشاد والغناء، أو قصره وحبسه، حتى ینسجم مع اللحن العام الذی یسود الموشح المغنّى.
وهذا یؤكد التلازم والتواشج الوثیق بین التوشیح والغناء، وما كان من هذا النمط فإنه لا یعلم صالحه من مختله إلا بمیزان الغناء والتلحین الذی یجبر كسره، ویقوّم معوجّه، ویردّه صحیحاً. ولكن هذا لا یمنع من ورود بعض الكلمات أو التراكیب فیه موزونة أحیاناً على بعض التفعیلات.
ومثال هذا النوع قول ابن القزاز فی مطلع موشح له(9):
رُحْ للراح وباكِرْ
بالمُعْلَمِِ المَشُوفْ
غَبوقا وصَبوحْ
على الوتَرِ الفصیحْ
لیس اسمُ الخمرِ عندی
مأخوذاً فاعلَمْ
إلاّ مِن خاءِ الخَدِّ
ومیمِ المَبْسِمْ
وَراءِ ریقِ الشَّهْدِ
العاطِرِ الفَمْ
فكُنْ للهم هاجِرْ
وصِلْ هذی الحُروفْ
كی تَغدو وتَروحْ
بجسمٍ فیه رُوحْ
* * *
أخیراً، إن الموشحات فن شعری أندلسی، وهو فن جدید مستقل بمفرده، ونماذجُه المختلفة لا تتفق مع القصیدة الشعریة الموروثة فی جوانب كثیرة، أبرزها الشكل، واللغة، والقافیة، والوزن، كما أنها تتصل اتصالاً قویاً بفن الموسیقا وطرائق الغناء فی الأندلس.
ولاشك أن هذا الفن اكتسب على مدى الأیام قیمة كبیرة، ومكانة سامیة فی میدان الغناء والطرب، حتى إنه استهوى المشارقة، فراح عدد منهم ینظم الموشحات كابن سناء الملك، وابن نُباتة المصری، وصفی الدین الحلی، وتابعهم آخرون حتى العصر الحدیث كالشاعر أحمد شوقی الذی نظم موشحته "صقر قریش" على طریقته الخاصة، وقبله سلیمان البستانی فی ترجمته لإلیاذة هومیروس، فبرهنا بذلك على مطاوعة هذا الفن لنظم الملاحم.
وبذلك تكون الموشحات الأندلسیة منعطفاً بارزاً فی مسیرة الشعر العربی، لأنها أول محاولة تجدیدیة فی الشعر العربی على الإطلاق، والذی عرف بتقالیده الفنیة الراسخة، وعراقة تلك التقالید وقوتها، لذلك لو لم یكن للموشحات إلا أنها كسرت هذا الطوق، وانطلقت منه إلى نظام شعری جدید، لكفى أن تلتفت إلیها الأنظار، ویُبحث عن دواعیها ونتائجها، وإن كان هذا النظام الجدید مرتبطاً بإطار التقفیة والتنویع فی الوزن والإیقاع الموسیقی، وتنوع الأجواء الفنیة الخارجیة دون أن یتعداها إلى المضمون المرتبط برؤیا الشاعر إلى الوجود، والمتصل بمنابع الثقافة الفكریة، وآرائه فی الحیاة الاجتماعیة، وسبر أغوار النفس.
ولاشك أن فن التوشیح كان نقطة انطلاق حثیث إلى السیر فی طریق التجدید العروضی والإیقاعی النغمی فی الشعر العربی الحدیث الذی بدأ یتحرر من رتوب القافیة، ویخرج على توازن الأشطار فی القصیدة العربیة، ویبتعد عن التكلف والتصنع فی اللغة والأسلوب، مما ساعد على ولوج الشعراء مجالات أخرى فی فنون القول: كالقصص الشعریة، والملاحم، والأدب التمثیلی، وكذلك كان فن التوشیح مرتكزاً للتجدید فی الشعر التفعیلی المعاصر، وأنماطه الإیقاعیة المختلفة عند الشعراء فی المشرق وفی المهجر، من أمثال خیر الدین الزركلی، وخلیل مردم والأخطل الصغیر، وعمر أبو ریشة، ونازك الملائكة، وفدوى طوقان، وصلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطی حجازی، وعبد الوهاب البیاتی، والیاس فرحات، والشاعر القروی، وفوزی المعلوف وشفیق المعلوف وغیرهم.
المصادر والمراجع
1-أبو نواس الأندلس، ابن سهل الإسرائیلی: محروس منشاوی الجالی- القاهرة 1986م.
2-الأدب الأندلسی: مصطفى الشكعة –بیروت 1983م.
3-أدباء العرب: بطرس البستانی –بیروت 1937م
4-تاریخ الأدب الأندلسی "عصر الطوائف والمرابطین": إحسان عباس –بیروت 1962م,
5-تاریخ الأدب العربی (الجزء الخامس): عمر فروخ –بیروت 1982م.
6-دار الطراز فی عمل الموشحات: ابن سناء الملك –تح. جودة الركابی- دمشق 1977م.
7-دراسات أدبیة فی الشعر الأندلسی: سعد إسماعیل شلبی –القاهرة 1972م.
8-دیوان ابن سهل الأندلسی: جمعه وشرحه: أحمد حسنین القرنی –القاهرة 1926م.
9- دیوان الأعمى التُّطیلی: تح. إحسان عباس- بیروت 1963م
10-الشعر فی عهد المرابطین والموحّدین بالأندلس، محمد مجید السعید –بیروت 1985م.
11-الشعر والبیئة فی الأندلس: میشال عاصی- بیروت 1970م.
12-فی الأدب الأندلسی: جودة الركابی –دمشق 1955م.
13-مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون- طبعة دار الشعب –القاهرة
14-ملامح الشعر الأندلسی: عمر الدقاق –بیروت 1972م.
15-موسیقا الشعر العربی: محمود فاخوری –حلب 1981م.
16-الموشحات والأزجال: مصطفى عوض الكریّم –القاهرة 1965م.
________________________________________
* مدرّس فی كلیة الآداب بجامعة حلب.
(2) ممّن تناول هذا الموضوع بالبحث: میشال عاصی فی كتابه "الشعر والبیئة فی الأندلس" ص112-114 وسعد إسماعیل شلبی فی كتابه "دراسات أ دبیة فی الشعر الأندلسی" ص90-95.
(3) ملامح الشعر الأندلسی، د.عمر الدقاق، ص 355.
(4) دیوان ابن سهل الأندلسی: جمعه أحمد حسنین القرنی –القاهرة 1344ه، 1926م، ص 53-55.
(5) أدباء العرب: بطرس البستانی 3/77، وتاریخ الأدب العربی: د.عمر فروخ 5/540.
(6) ملامح الشعر الأندلسی: د.عمر الدقاق، ص341.
(7) دیوان الأعمى التطیلی: تحقیق د.إحسان عباس –بیروت 1963م. ص253.
(8) الموشحات والأزجال: مصطفى عوض الكریّم –ص55.
(9) الموشحات والأزجال، مصطفى عوض الكریّم، ص54.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:8|
القواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي
حدود وأبعاد ومنهج:
لم يعرف التاريخ الإنساني التقاء أكثر غنىً وشمولاً من التقاء العرب والإيرانيين على مستويات عديدة سياسية واجتماعية؛ وفكرية وثقافية؛ فلسفية ودينية؛ أدبية وفنية, لغوية وبلاغية...
وترجع علاقة التفاعل الوطيدة إلى عصور تاريخية عريقة تجسدت في الحياة والفن والأدب... إذ تجلى في الأدبين العربي والفارسي مفاهيم التصور الديني والفلسفي الممزوجة ببحر العزة والعظمة الإلهية؛ والموشاة بكل المودة والمحبة على الصعيد الاجتماعي. فقد برزت أشكال التمازج الحضاري منذ البعثة المحمدية لتؤكد مفهوم الوصول "إلى المساواة بين الشعوب على السلطة القائمة, وعلى الثقافة العربية الإسلامية"(1) من خلال علاقة الرحمة والتقوى والعدل، لا من خلال العرق والجنس واللون.
وليس هذا غريباً ولا بدعاً من القول فقد تأسس ذلك في النفوس كما لدى البحتري إذ قال في مدح عبيد الله بن خرداذبة(2):
إِنْ كان من فارسٍ في بيتِ سُؤْدَدِها *** وكنتُ من طيِّئٍ في البيت ذي الحَسَبِ
فلم يَضْرِنا تنائي المَنْصِبَيْن وقد *** رُحْنا نَسيبين في خُلْق وفي أَدبِ
فالقواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي إنما انبثقت من التمازج المشترك بين الشعبين العربي والإيراني منذ العصور التاريخية ثمَّ ازدادت إحكاماً وارتقاء حضارياً بعد الإسلام, إذ دخل أبناء إيران فيه طوعاً وإرادة ورغبة؛ وانصهروا في بوتقة تعاليمه ومبادئه... وعملوا على نشرها...
ولما كانت العربية لغة القرآن والدين الجديد الذي اعتنقوه أقبلوا على تعلّمها وإتقانها كأهلها. وقد تضافر إلى هذا رغبة علمية جامحة وملحة في خدمة الحضارة الإسلامية... صار كثير منهم يتقن اللسانين حديثاً وكتابة. ومن ثمَّ أخذوا ينقلون بوساطة اللغة العربية كثيراً من معارفهم القديمة المكتوبة بلغاتها الأصلية؛ في التاريخ والفن والطب والكيمياء والفلك واللغة والحساب والأدب... وقد شاركهم في هذا عدد من علماء العرب والبلدان المفتوحة الأخرى...
وحينما كانت القواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي تزداد اتساعاً وتنوعاً كانت تتخذ لنفسها أنماطاً عدة عبّرت عنها المصادر التي استندت إليها؛ بمثل ما تركزت في الترجمة والتأليف الأدبي والبلاغي... ومن ثمَّ وجدت بأشكال وموضوعات محددة في كليهما...
وبناء على ذلك كله كان لزاماً علينا أن نلجأ إلى مبدأ الاختيار والإيجاز والتكثيف في معالجة القواسم المشتركة التي يقوم عليها البحث... لأنَّ الحديث عنها كلها يحتاج إلى مجلدات كثيرة, علماً أن بعض الدارسين قبلنا سبقنا إلى ذكر نتف منها كما نلمسه عند محمد غنيمي هلال الذي اتكأ عليه كل من جاء بعده.
ولما كان القرآن الكريم هو أهم المصادر آثرنا أن نتوقف عند قصةٍ واحدة من قصصه؛ مع إيماننا اليقيني بأن هناك مصادر أخرى لتلك القواسم كالسُنَّة المطهرة, والأحداث التاريخية والاجتماعية, والكتب الدينية والفلسفية والتاريخية, مثل كتاب الشاهنامه للفردوسي الطوسي, وتاريخ الطبري, وتاريخ ابن الأثير؛ وكتب أدب الرحلات, وأدب التصوف الذي تصدره من الإيرانيين الغزالي وجلال الدين الرومي.
ولعل هذا ينقلنا إلى حركة الترجمة وأثرها في إطلاق تفاعل أدبي بين العرب والإيرانيين لا يضاهيه في عناصر الالتقاء ما نجده عند غيرهم, كما وقع في كتاب (كليلة ودمنة) ورباعيات الخيام والمقامات, ممَّا اخترناه. ولهذا عقد ابن خلدون في مقدمته فصلاً عن "حملة العلم في الإسلام" فوجد أكثرهم من الإيرانيين(3).
ومن هنا نتوقف عند القواسم المشتركة اللغوية والفنية في الأدبين كالألفاظ والمصطلحات والأساليب والاقتباس الحرفي والأوزان والقافية والقصة... فكلها مثلت ملامح مشتركة في الأدب العربي والإيراني. وهي الملامح التي تحققت في موضوعات تعاور عليها الأديان, وكيف تغيّرت وظائفها في بعض الاتجاهات الأدبية, كما نجده في قصص الحب العذري؛ ولا سيما حكاية ليلى والمجنون, وموضوع وصف الأطلال والممالك الزائلة.
فعظمة المادة وتنوعها لم يترك لنا المجال إلا أن نتبنى المنهج الذي أشرنا إليه... وسنتوقف عند القرآن الكريم؛ باعتباره أعظم مصدر التقى عليه المسلمون, وعند واحدة من قصصه؛ وهي قصة المعراج.
1 القرآن الكريم؛ قصة المعراج النبوي:
أكدت مبادئ الدين الحنيف العودة الأصيلة والنبيلة إلى الهويّة الإنسانية دون تشويه للذات الفردية وللانتماء الاجتماعي والبيئي والوطني... وهذا حمل الناس قديماً وحديثاً على اعتناق الإسلام؛ لأنه يتفق مع الفطرة والعقل معاً... ثمَّ ارتبطوا بحبل الله المتين, وطفقوا يبنون الحضارة الإسلامية التي تنشد التقدم والحق والعدل...
وقد جسَّد القرآن الكريم شكلاً ومضموناً قواسم مشتركة عظمى بين المسلمين، ليس من جهة العقيدة والعبادة والتبرك فقط، بل من جهة أنه كتاب معجز في أساليبه وأفكاره وأخباره وقصصه... وهذا ما جعلهم ينصهرون في آياته ولغته، يقتبسون منها ما وسعهم الجهد؛ أو يضمّنون أفكارهم العديد من أفكارها؛ أو ينتهجون طرائقه في التأليف والكتابة والإبداع...
ولما كان مقام الاحتذاء بالنص القرآني عظيم الحجم وكثير التنوع رغبنا في الوقوف عند قصة المعراج النبوي التي احتفل بها الأدب العربي والفارسي, وجعلها "منطلقاً إلى فضاء الفكر الأرحب؛ حيث تعالج مسائل فلسفية أو صوفية أو أدبية أو وطنية"(4)؛ فكانت توظف توظيفاً مجازياً يؤدي الغرض الذي يرمون إليه. وهذا لا يعني أن الأدب العربي والفارسي لم يحفل بغيرها, ولا سيما قصة يوسف () وزليخا التي شاع أمرها في الأدب الفارسي(5).
وتتلخص قصة المعراج بأن النبي الكريم عرج إلى السموات السبع يصحبه جبريل () هادياً ومرشداً... وقد رأى () في السماء الأولى (آدم) وفي الثانية (يحيى وعيسى) وفي الثالثة (يوسف) وفي الر ابعة (إدريس) وفي الخامسة (هارون) وفي السادسة (موسى) وفي السابعة (إبراهيم) عليهم صلوات الله أجمعين. وكان () قد رأى في كل سماء أشياء تأسس في ضوئها جملة من الأوامر والنواهي...
ومن ثمَّ انتهت رحلة المعراج إلى سِدْرة المنتهى على وفق قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى (النجم 53/18).
فالوقوف بين يدي الحضرة الإلهية كان المرحلة الأخيرة في قصة المعراج ثمَّ العودة إلى الأرض...
ولسنا الآن في صدد الحديث عن أول من تأثر بقصة المعراج وعمن تناولها وإنما في صدد إثبات أنها غدت مدار التقاء أدبي وفكري وفلسفي بين الأدبين العربي والفارسي...فالأديب الإيراني فريد الدين العطار (545 627ه) ترجم في كتابه (تذكرة الأولياء) أول معراج صوفي لأبي يزيد البسطامي طيفور بن عيسى؛ الملقب بسلطان العارفين؛ (ت 261ه). وقد كتبه البسطامي بالعربية في إطار رؤية منامية يتخيل فيها الطريق إلى الله. أمَّا الشيخ الرئيس أبو علي حسين بن عبد الله بن سينا (338 428ه) فقد ألف (رسالة الطير) ورأى أنه "يطير مع الطيور وأن الطريق مليء بالصيادين الذين تمكنوا من الإيقاع بالطيور فطارت الطيور وعبرت الكثير من الصعاب ومنها ثمانية جبال وكان هدفها الوصول إلى المليك الذي يخلصها من الشباك"(6).
وتحظى الطيور بلقاء الملك ويخلصها من الشباك وتعود أدراجها...
وبهذا يلتقي ابن سينا مع البسطامي في الحديث عمَّا يستوجب على السالك الصوفي أن يفعله في حياته ليصل إلى مقام المشاهدة والالتقاء بالحضرة الإلهية.
ومن هنا نشير إلى رسالة (التوابع والزوابع) لابن شُهَيد الأندلسي أبي عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان (382 426/992 1034م)...
وفيها عقد رحلته إلى العالم الآخر وهو يرمي إلى مفاضلة أنداده ومنافسيه من الأدباء والوزراء وأهل السياسية والانتقاص منهم ونقدهم وإظهار مناقبه... وفيها عرض لعدد من الشعراء وتوابعهم في وادي عبقر, فضلاً عن بعض الأدباء والنقاد كعبد الحميد الكاتب والجاحظ وبديع الزمان...(7) وبهذا فهي رحلة إلى العالم الآخر, صاحب فيها أبو عامر هادياً له يتمتع بصفات خارقة.
وتتوافق رسالة التوابع والزوابع مع قصص المعراج ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري (363 449ه) بأنها رحلة معراجية إلى العالم الآخر, بعد أن اجتمع فيها اثنان يرشد أحدهما الآخر ويبين له سبيل الحق... وبعد الوصول إلى مقام الشهود في قصص المعراج وإلى الجنة أو النار في رسالتي الغفران والتوابع والزوابع تنتهي الرحلة بالعودة إلى عالم الوجود.
فرسالة الغفران تجعل من ابن القارح قائداً للرحلة, وإن كانت شخصية السارد (أبي العلاء) لا تغيب في كثير من الأحيان عنها. ويزور فيها الجنة والنار ويقابل الشعراء والأدباء والقرّاء والنحويين وغيرهم فيسأل أحدهم عن سبب دخوله النار أو دخوله الجنة, وبمَ غُفر له؟. ويشبهها في هذا البناء رحلة الموبد الزرادشتي (أرده ويراف) إلى الجحيم والأعراف والجنة, ولعل المعري تأثر بها(8) إنْ كان يعرف الفارسية, وهو مستبعد. ويبقى الفرق بين رسالتي المعري وابن شهيد وقصص المعراج في الأدب العربي والفارسي أنهما تعبير عن الذات بخلاف الأخرى التي تحقق للصوفي ما يصبو إليه من مشاهدة أو اتحاد.
وإن كانت قصص المعراج في الأدب الفارسي عديدة مثل (سير العباد إلى المعاد) لسنائي الغزنوي (ت 545ه) و(رسالة الطير) لحجة الإسلام زين العابدين أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (450 505ه) فإننا سنتوقف عند منظومة (منطق الطير) لكبير مشايخ التصوف الفارسي فريد الدين العطار (545 627ه)؛ إذ عُدّ ثالث ثلاثة فيه بعد جلال الدين الرومي وسنائي الغزنوي...
ومنظومة (منطق الطير) المبنية على المزدوج/المثنوي في قالب شعري قصصي؛ تعد من أعظم ما نظم في الأدب الصوفي خاصة؛ إذ بلغت (4650 بيتاً) وكان قد نظمها سنة (583ه)(9). ولعل فيما يدل عليه مصطلح المثنوي أنه بني على المقابلة الثنائية شكلاً ومعنى؛ في الإيمان والاعتقاد بالجنة والنار, والليل والنهار...
وليست مهمة البحث عرض طبيعتها وماهيتها فقد انعقدت فُصول في كتب شتّى لهذا الغرض؛ ولكن مهمته الأصلية إثبات أن فريد الدين العطار تأثر على نحو كبير برسالة الطير لكل من ابن سينا والغزالي, في الوقت الذي اتفق فيه مع رسالتي الغفران والتوابع والزوابع في منطلق الرحلة, وهو المنطلق الذي قامت عليه قصة المعراج النبوي في استصحاب هادٍ ومرشد.
وإذا كان ابن سينا قد عبَر جبالاً ثمانية لمقابلة الملك فإن الأودية والطرق عند الغزالي وسنائي والعطار سبعة, وهي ترمز إلى المقامات السبعة في التصوف, وطرقها...
وإذا كان سنائي الغزنوي قد اتفق مع ابن سينا والغزالي والعطار في تجاوز الطيور للوديان والجبال فإنه اتفق مع رسالة الغفران ورحلة الموبد الزرادشتي في كونه رافق مرشده وهاديه في رحلته إلى الجنة والأعراف والنار...
وكان العطار قد نظم الرحلة على ألسنة طيور حقيقية كالهدهد والنَّهْس والصقر وغيرها؛ ولم يختر إلا طيراً خرافياً واحداً هو (السِّيْمُرغ) ورمز فيه إلى ملك قوي... وتعني (سي) ثلاثين (مُرغ) الطائر, أي الثلاثين طيراً. وهو عند الإيرانيين بمنزلة العنقاء عند العرب. وهنا نثبت أن الغزالي استخدم العنقاء في (رسالة الطير) على حين استعمل مصطلح (الطيور) لأنواعها كلها...
وما يعنينا هنا أن الأودية السبعة: وادي الطلب والعشق والمعرفة والاستغناء والتوحيد والحَيْرة وأخيراً وادي الفقر والغناء كناية عن السموات السبع في قصة المعراج النبوي, على حين ترمز إلى المقامات السبعة عند أهل التصوف كمراحل لتصفية أرواحهم ليحظوا في نهاية المطاف بعد اجتياز الوادي السابع (الفقر والغناء) بالحَضْرة الإلهية.. علماً أن الهدهد يرمز إلى جبريل, والسيمرغ يرمز إلى ملك قوي صابر يتجلى في المرآة عن توحده مع الله. فهو يمثل الطيور الثلاثين التي سلكت الأودية السبعة ووصلت إلى جبل (قاف) وحظيت بلقاء الحضرة الإلهية.
وهذا يعني أن السالك من المتصوفة الطيور قد صمم على قطع الأودية؛ مهما كانت صعوباتها ووعورتها لأنَّ اليأس لا يتسرب إلى نفوس المؤمنين(10) لينتهي به المطاف في مقام الشهود إلى التجلي والاتحاد...
أمَّا منظومة (جاويد نامه) أي (رسالة الخلود) للمفكر الإسلامي الكبير محمد إقبال (1873 1938م) التي كتبها بالفارسية عام (1932م) فقد ترجمها إلى العربية محمد السعيد جمال الدين، وفيها نرى جلال الدين الرومي هادياً ومرشداً لمحمد إقبال الذي تاقت نفسه للعروج والاتجاه إلى الله وحده بعد اجتياز الزمان والمكان من خلال أفلاك سبعة ليصل إلى جنة الفردوس... ويشكو إقبال "تشتت العالم الإسلامي لضعف في نفوس المسلمين, وبسبب مصائب الاستعمار والشيوعية" ثمَّ يرى أن العالم الإسلامي أصيب بحالة موت ولن ينقذه منها إلا عالم القرآن الكريم(11).
وقد وقع التجلي الإلهي في معراج إقبال بعد انتهاء الرحلة إلى مقام الشهود عن طريق العشق الإلهي...
ومن بين القواسم المشتركة بين رسالة الخلود ورسالة الغفرانِ محاكمةُ الزنادقة؛ فإذا كان المعري قد حاكم بشاراً وأمثاله فإن محمد إقبال حاكم ثلاثة من الزنادقة حين وصل إلى فلك المشتري وهم المنصور الحلاج, والشاعر الهندي أسد الله غالب وشاعرة المذهب البابي في إيران قُرّة العين الطاهرة التي أُعدمت سنة (1852م) لاعتناقها هذا المذهب... أمَّا التقاؤهما بالمعراج النبوي فتجسد بعدم الرضا بهذا العالم ولا بد من التوجه أبداً إلى الذات الإلهية... وهي الفكرة التي يلتقي فيها الصوفي الكبير محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي (560 638ه), ولا سيما في كتابه المخطوط (الإسرا إلى المقام الأسرى). ويعد أحد الكتب في تزكية النفس, وفيه أفاد من قصة المعراج النبوي, بمثل ما أفاد منها عدد من أدباء الغرب كما نراه في (الكوميديا الإلهية) للشاعر الإيطالي دانتي (1265 1331م), و(الفردوس المفقود) للشاعر الإنكليزي ملتون (1608 1674م)(12).
وفي ضوء ذلك كله ثبت لنا أن قصة المعراج النبوي أحدثت حركة أدبية عظيمة, وأثرت الخيال الخصب للشعراء والأدباء في الأدبين العربي والفارسي فكانت قاسماً مشتركاً عظيماً بينهما...
وهذا يجعلنا ننتقل إلى مظهر آخر من مظاهر العلاقة الوطيدة بين الأدبين ويتمثل في الترجمة والتأليف.
2 الترجمة والتأليف:
ليس المقصود في هذا المقام أن نتحدث عن الترجمة باعتبارها تعني نقل الكلام من لغة إلى أخرى؛ أو أن اللغة الأقوى تؤثر في الأضعف... وإنما المقصود ما أنتجته الترجمة من تكوين قواسم مشتركة عديدة بين العرب والإيرانيين على الصعيد الاجتماعي والسياسي والثقافي والأدبي... وقد حمل أعباء ذلك كل من أبناء الشعبين على السواء, فأكدوا عظمة التفاعل المتبادل بينهم وأتاحوا للأدباء والباحثين والشعراء الاطلاع على ثقافة الشعبين؛ فازدادت إبداعاتهم غنىً وارتقاء... وربَّما أحدثت بعض الكتب المترجمة حركة أدبية عظيمة الأشكال والأفكار والموضوعات والمؤلفات, علماً أن كثيراً من الأدباء والمؤرخين والفقهاء واللغوين صاروا من أصحاب اللسانين العربي والفارسي, ألفوا فيهما ونظموا الأشعار بمثل ما ترجموا منهما... فابن سينا مثلاً ألّف كتباً بالعربية منها (الشفاء والقانون والإشارات) وكتباً بالفارسية منها (دانشنامه علائي) وله شعر عربي كقصيدة (النفس) وثنتان وعشرون قطعة من الشعر الفارسي... وأبو الريحان البيروني كتب نسختين من كتابه (التفهيم لأوائل صناعة التنجيم) واحدة بالعربية والأخرى بالفارسية... أمَّا الشاعر الصوفي الشهير سعدي الشيرازي (ت 691ه) فله أشعار بالفارسية, وقصائد بالعربية منها قصيدته في رثاء بغداد على إثر تخريبها بيد المغول سنة (656ه)(13).
وإذا كنا سنأتي على ذكر عدد آخر في الأشكال الأدبية المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي فإننا سنشير بإيجاز إلى كتابين أحدثا حركة التقاء كبرى بينهما وهما كتاب (كليلة ودمنة) لعبد الله بن المقفع (106 142ه) ورباعيات الخيّام؛ لعمر الخيام, وكلاهما إيرانيان من أصحاب اللسانين.
أمَّا (كليلة ودمنة) فهو أشهر الكتب التي ترجمها ابن المقفع سنة (133ه) وكان رأس المترجمين العشرة؛ فضلاً عن أنه ألف في العربية عدداً من الكتب مثل (الأدب الصغير, والأدب الكبير, واليتيمة في الرسائل) كما ترجم من الفارسية عدداً آخر لم يصل إلينا منها شيء حتَّى الآن, ومنها (خُداي نامه في السِّيَر, وآيين نامه: القواعد والرسوم, والتاج في سيرة أنو شروان)(14).
ويعد كتاب (كليلة ودمنة) أحد الكتب التي قرّبت بين الأدبين العربي والفارسي في الوقت الذي أحدث فيهما حركة فنية وفكرية... وكان ابن المقفع قد ترجمه عن الفارسية القديمة (الفهلوية) التي نُقل إليها من اللغة الهندية؛ ولما ضاع الأصل الفارسي والهندي صارت الترجمة العربية أصلاً ولا سيما أن ابن المقفع أضاف إليها بعض الأبواب..., وأشهر من ترجمها بعد ذلك إلى الفارسية أبو المعالي نصر الله (سنة 539ه) ثمَّ ترجمت غير مرّة إلى الفارسية وغيرها من اللغات العالمية(15).
وإذا كانت قصص مشهد الحيوان معروفة في الشعر الجاهلي فإن السرد القصصي لكليلة ودمنة يختلف كل الاختلاف عمَّا هو في مشاهد الحيوان تلك, فضلاً عن أن ابن المقفع تصرّف في أسلوب السرد ومعانيه بما يتوافق والذوق العربي...
ومن ثمَّ فإن كثيراً من الأدباء واللغويين أخذوا ينقلون منها حكايات وأمثالاً كما نجده في (عيون الأخبار) لابن قتيبة, أو يؤلفون على منوالها كما حُكي عن كتاب (القائف) للمعري الذي ما زال مفقوداً, وكتاب ابن الهبّارية في الشعر (الصادح والباغم) الذي طُبع مرات عدة, وغيرهما(16).
وإذا كان الدكتور طه حسين قد أعجب بجودة عبارات كليلة ودمنة؛ فإن كثيراً من الأدباء احتذوا ابن المقفع في الكتابة والأساليب وغزارة المعاني, واقتباس الأمثال والحكم من أ فواه البهائم والطير ومن ثمَّ نسجها في أشكال شعرية ونثرية... فأبان بن عبد الحميد اللاحقي نظم كليلة ودمنة شعراً ولكن منظومته ضاعت ونظمها عدد آخر مثل سهل بن نوبخت عام (165ه)(17).
ولم تقتصر العلاقة بين الأدبين العربي والفارسي على الأدب القديم وإنما امتدت إلى الأدب الحديث. وكان أنوار سهيلي قد ترجم (كليلة ودمنة) إلى الفارسية, ومن ثمَّ ترجمت إلى الفرنسية فتأثر بها لافونتين (1621 1695م) وحاكاها, ثمَّ تأثر الأدب العربي الحديث بها, إذ ترجمها من العرب المحدثين محمد عثمان جلال (ت 1898م)؛ فقد ضمّ كتابه (العيون اليواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ) كثيراً من حكاياتها وأفكارها..., واتسمت حكاياته بالإيجاز واستخدام بعض الألفاظ العامية فضلاً عن تأثره بحكايات لافونتين... ومن أبرز التقاطع بين حكايات محمد عثمان جلال والشعر الفارسي أنه نظمها على فن المزدوج/المثنوي عند الإيرانيين؛ في وحدة القافية بين البيتين دون التزامها في القصيدة كلها كما في قصة (الثعلب مقطوع الذنب)(18).
وفي هذا المقام لا ننسى أن نشير إلى أمير الشعراء أحمد شوقي الذي كتب خمسين قطعة على لسان الحيوان تؤكد تأثره بحكايات (كليلة ودمنة) وأفكارها كقصيدته (الثعلب والديك), ومنها تظاهرُ الثعلب بالتقوى والصلاح, وتخلّيه عن كل مكائده وفتكه بالطيور...(19). وإذا كانت الخرافات والأساطير إحدى نقاط الالتقاء بين العرب والإيرانيين فإن كليلة ودمنة جمعت هذا إلى جوانب أخرى.
وليس هناك كتاب يتفوق على (كليلة ودمنة) إلا رباعيات الخيام لأبي الفتح غياث الدين عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري (430 526ه) التي نظمها بالفارسية, فضلاً عمَّا قيل: إنَّ له أشعاراً حسنة بالعربية والفارسية؛ وكذلك كتب بالعربية (مقالة في الجبر والمقابلة) و(رسالة في الوجود) وغيرها(20)؛ فهو أحد أصحاب اللسانين...
ولعل مقام البحث ومنهجه يتأبّى عن الإفاضة برباعيات الخيام وترجماتها؛ وما قيل في شأنها وشأن صاحبها, فقد تكفلت فيه دراسات شتى شرقاً وغرباً... ولكننا نتوقف عند قيمة الرباعيات باعتبار ما انتهت إليه من بناء علاقة كبرى بين الأدب الفارسي والأدب العربي ولا سيما الحديث.
وإذا كان كتاب (جَهار مقاله) للعروضي السمرقندي أقدم وثيقة تاريخية عُنيت بالخيام وفلسفته وطبه وفلكه فإن صاحب حواشي ذلك الكتاب قد أثبت رباعية للخيّام, كما أثبت كتاب (فردوس التواريخ) رباعية لا بأس بها...(21).
ثمَّ وثّق المحققون له رباعيات تراوحت بين (16 و56) وربَّما زاد عددها, فاشتهرت به كما اشتهر بها فأضيفت إليه (رباعيات الخيام) علماً أن فن الرباعيات معروف منذ أواخر القرن الثالث الهجري لدى الشعراء الإيرانيين, ونظم عليه مثلاً شهيد البلخي (ت 325ه) والرودكي السمرقند (ت 329ه) والدقيق الطوسي (ت 368ه) وغيرهم(22).
ولعل التقاء الرباعيات بفنون عربية كالمشطرات والمربعات والمخمسات لم يكن عرضاً علماً أنها نظمت على وزن الهزج وغيره... وإن تفردت عنها بتكرار المعاني وتفتيق الأفكار... أمَّا التقاؤها بالأدب العربي الحديث فقد كان معنياً؛ إذ أحدثت الرباعيات نشاطاً أدبياً وفكرياً ونفسياً عظيماً, في الوقت الذي دلت على نزوع عقلي امتزج بحس مرهف, وبعاطفة شفافة في معالجتها للبحث عن سر الوجود: الحياة/الموت.
ولهذا فإن ترجماتها العربية زادت على خمس عشرة ترجمة منذ ترجمة وديع البستاني لها سنة (1912م) عن الترجمة الإنكليزية التي قام بها فيتز جيرالد عن الفارسية؛ سواء كانت ترجمة شعرية أم نثرية؛ فضلاً عن دراسات كثيرة وأبحاث أكثر عدداً. وإذا كان البستاني قد أحال الرباعية إلى سباعية فإن ترجمته دفعت من يتقن الفارسية إلى ترجمتها عنها مباشرة كما دفعت الناس إلى تعلم الفارسية لينقلوا الرباعيات عنها كما حدث مع الشاعر أحمد رامي...
ولا مراء في أن ترجمة أحمد الصافي النّجفي تتميز بشفافية عالية سكب فيها روحه ورؤاه؛ فقرَّب الرباعيات إلى الذوق العربي, وما سبقه في هذا إلا أحمد رامي الذي كان يقع تحت تأثير أحزانٍ وهموم لفقده أحد ذويه حين ترجمها سنة (1924م).... دون أن ننسى صوت أم كلثوم الذي أشاع بين العامة عدداً من الرباعيات من ترجمة أحمد رامي(23).
ولا نرتاب لحظة واحدة في أن فلسفة الخيام في الرباعيات تتقاطع في بعض ملامح منها بما نجده عند الشاعر المعري؛ ولا سيما ما يدور حول مفهوم الوجود ودورة الحياة؛ فالإنسان من تراب وسيعود إليه(24), أو حول مبدأ الشك واليقين(25)... ويبدو أن هذا كله امتد إلى شعر إيليا أبي ماضي ولا سيما قصيدته (الطلاسم) التي أنشدها بعد أن اطلع على ترجمة فيتز جيرالد للرباعيات, ومنها(26):
جئت لا أعلم من أين؛ ولكني أتيت
ولقد أبصرت قدّامي طريقاً فمشيت
وسأبقى ماشياً إنْ شئت هذا أم أبيت
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟
لست أدري.
ولما انطلق الخيام من المبدأ المادي باعتباره شرطاً لوجود العالم وهو بخلاف الموجود الأزلي القديم رأينا إيليا أبا ماضي يحذو حذوه في غير ما مكان من قصيدته السابقة(27).
ولم يقتصر الأمر على المعري وأبي ماضي بل امتد أيضاً إلى جماعة الديوان كعباس محمود العقاد (1889 1984م) الذي بدأ أولى مقالاته عن الرباعيات سنة (1908م) وأتبعها بدراسات أخرى فضلاً عن معارضته إياه برباعيات أخرى؛ وعبد الرحمن شكري (1886 1958م) الذي ترجم ثلاث رباعيات وكتب عنها؛ وإبراهيم عبد القادر المازني (1890 1949م) الذي كان أكثر تأثراً بالرباعيات من صاحبيه, وردَّ عن الخيام تهمة النزعة الأبيقورية ونزعة التصوف(28).
ولعل ما أرسته رباعيات الخيّام من قواسم مشتركة بين الأدبين العربي والفارسي فناً وأسلوباً, فكراً ونقداً يدفع بنا إلى إحياء مؤسسات مشتركة بين العرب والإيرانيين لترجمة آدابهما وتراثهما ومؤلفاتهما المختلفة في كل اتجاه... فلماذا لا نجدّد روح (بيت الحكمة) الذي أنشئ في العصر العباسي في بغداد؟!!
ونكتفي بما أشرنا إليه دون أن ننسى عوامل الالتقاء الأخرى التي أدت ازدياد التقارب بين العرب والإيرانيين, وتمازجهما في الحياة والفكر... ويعد الجاحظ (ت 255ه) أحد الأدباء الذين مارسوا ذلك قولاً وفعلاً... فلما أهدى كتابه (الحيوان) إلى الوزير ابن الزيات أهدى (البيان والتبيين) إلى قاضي القضاة ابن أبي دؤاد, وكتاب (الزرع والنخيل) إلى إبراهيم بن العباس الصولي...
ومن يقرأ كتابه (البخلاء) الذي قدمه إلى أحد الأعيان يجد تمازجاً حضارياً فكرياً واجتماعياً مدهشاً سيق بأسلوب أدبي طريف لكل من بخلاء العرب والفرس(29).
وفي نهاية هذا الاتجاه من الترجمة والتأليف لا يمكننا أن نغفل التنويه بفضل المقامات الأدبية التي نشأت عند العرب وأبدعها بديع الزمان الهمذاني (ت 398ه) وأبي محمد القاسم بن علي الحريري (446 516ه) ثمَّ انتقلت إلى الأدب الفارسي على يد القاضي أبي بكر حميد الدين عمر بن محمود البلخي (ت 559ه). وقلَّد في مقاماته المقامات العربية أسلوباً ومادة؛ وإن ظهر فيها تأثير الروح الفارسية كالتفنن في الأساليب, وسميت بأسماء بعض مناطق فارس كالمقامة البلخية, والسجستانية, والأذربيجانية والجرجانية والأصفهانية وغيرها... دون أن ننسى أن مقامات الحريري تقاسمت الروح الفارسية في الموضوعات والأساليب مع المقامات الفارسية؛ علماً أن حميد الدين كان أكثر تأثراً بها... وقد عرض لذلك عدد من الدارسين والباحثين(30).
ولعل أهم ما فعلته المقامات من تقاسم مشترك بين الأدبين العربي والفارسي, ومن ثمَّ في الحياة, أن استخدام الألفاظ العربية قد كثر على الألسنة, وشاع استعمال أنماط من التراكيب العربية الكاملة في سياق ما يستدعيه موضوع ما...
ونكتفي بما ذكرناه لننتقل منه إلى القواسم المشتركة في اللغة والأشكال الفنية وفي بعض الموضوعات الأدبية...
3 القواسم اللغوية والفنية
يعدُّ الالتقاء الحضاري اللغوي والبلاغي والأسلوبي والفني من أبرز وجوه التفاعل بين الأدبين العربي والفارسي منذ القديم؛ وذلك لعظمة التمازج التاريخي والاجتماعي بين الشعبين العربي والإيراني.
فمن منا ينسى استنجاد ملك اليمن سيف بن ذي يزن (ت 50 ق.ه) بكسرى أنوشروان (ت سنة 1 ق. ه) لطرد الأحباش, فأسرع إلى تلبية رغبته؟ وظل لهذه الحادثة التاريخية أصداؤها في الحياة والأدب؛ وممن أشار إليه البحتري (ت 284ه) في قوله(31):
أَيّدوا مُلكنا وشدُّوا قواه *** بكُمَاة تحت السَّنَوَّر حُمْسِ
وأعانوا على كتائب أَرْيا *** طٍ بطَعْن على النحور ودَعْسِ
ومن ثمَّ ما جمعت حادثة تاريخية بين الشعبين كتلك التي جرت أحداثها بعد الإسلام بمقتل سبط رسول الله () الحسين بن علي () في كربلاء, فألهبت عواطف الأدباء والشعراء فكانت مصدراً ثراً للأدبين.
ونكتفي بهذين المثالين لنثبت القواسم المشتركة في اللغة ألفاظاً ومصطلحات وتراكيب وصوراً... فكان أبناء العربية يتداولون الألفاظ الفارسية ويتعلمون لغتها, بمثل ما كان أبناء إيران يسعون منذ القديم إلى تقليد الحياة العربية؛ ويتعلمون لغتها ويقرضون أشعارها... وكلّنا يذكر أن الملك الساساني بَهْرام كَور (جور) أرسله أبوه إلى الحِيْرة, ليقوم النعمان بن المنذر على تربيته وتعليمه العربية... وقد تمَّ له ذلك؛ وقيل: إنه تجاوز تعلم اللغة وقرض الشعر... وكذلك كان الشاعر عدي بن زيد وابنه زيد مترجمين لكسرى أنوشروان, وظهرت كثير من الألفاظ الفارسية في شعره وشعر غيره كطرفة بن العبد وأعشى بني قيس...(32)
وكان عدد من العرب قد سمَّوا أبناءهم وبناتهم بأسماء فارسية مثل (قابوس) بن النعمان بن المنذر, ودختنوس بنت لقيط بن زُرَارة, فضلاً عن تسمية بعض بطون قبائلهم بتلك الأسماء, كالأَسْبذيين الذين ينتسبون إلى (أَسْبذ). وهو لفظ مأخوذ من كلمة فارسية (أسب) وتعني (الفَرس) وذكر ذلك طرفة في قوله(33):
خذوا حِذْركم أهل المُشَقَّر والصَّفا *** عبيدَ اسْبَذٍ والقرضُ يُجْزى من القرضِ
وفي ضوء ذلك يمكننا أن نستدعي شاهداً واحداً من شعر الأعشى ليؤكد عظمة دوران الألفاظ الفارسية على ألسنة الأدباء والناس في العصر الجاهلي؛ وهو قوله(34):
لنا جَلَّسان عندها وبَنفسجٌ *** وسيْسَنْبرٌ والمَرْزجوشُ مُنَمْنَما
وآسٌ وخِيريٌّ ومَرْوٌ وسوسن *** إذا كان هِنْزَ مَنْ ورحت مُخَشَّما
وشاهَسْفِرم والياسمين ونرجسٌ *** يُصبّحنا في كل دَجْن تَغَيَّما
ومُسْتقُ سينين ووَنٌّ وبَرْبَط *** يجاوبه صَنْج إذا ما ترنَّما
فأصل (جَلّسان) في الفلاسية: (كَلشن) و(بنفسج: بنفشه) و(سيسَنْبر: سيسنمر) و(مرزجوش: مرزن كَوشَ) و(شاهسفرم: شاه سبرغم) و(ياسمين: ياسمن) و(وَنّ: وَنَكَث) و(بربط: بربت) و(صنج: جَنكث) على حين اتفقت العربية والفارسية بالألفاظ الأخرى (آس, خيري, سوسن؛ مستق).
ويبدو لي أن لفظ (ناهد) ومعناه الفتاة التي برز ثدياها انتقلت إلى الفارسية بالمعنى ذاته, وورد استعمالها في كتاب (الأَفستا)؛ أما أستاذ اللغات القديمة في جامعة طهران (بَهرام فره وش) فذهب إلى العكس(35).
ثمَّ جاء الإسلام؛ فاستعمل القرآن الكريم عدداً من الألفاظ الفارسية المعربة مثل (سُنْدس واستبرق, ومَرْجان ومسك؛ وزنجبيل, وسِجِلّ وسُرَادق...).
ولما انتشرت اللغة العربية بانتشار الدين الجديد ازداد دوران الألفاظ العربية على الألسنة وصارت لغة الآداب الفارسية في كثير من العلوم والفنون وتغلغلت في كل مجال؛ ثمَّ في كل كتاب فارسي... وهذا أكثر شهرة من أن يقف الباحث عنده؛ فلو تصفح أحدنا أي كتاب في الشعر أو غيره لتأكد له ذلك... فضلاً عن أسماء الكتب؛ والعنوانات العربية, وعن وضع المعاجم اللغوية الفارسية على غرار المعاجم العربية. ولعل أقدم معجم فارسي هو (لغة الفرس) لعلي بن أحد الأسدي الطوسي (ت 465ه).
وامتد الأمر إلى المصطلحات اللغوية في الأدب والفن والعمارة والفقه والحديث وعلوم القرآن والفلسفة والتصوف... وهذا ميدان عريض لا يحدُّ, وهو ما يجعلنا ننتقل إلى استمرار استعارة العرب للألفاظ الفارسية من العامة والخاصة ولا سيما في العصر العباسي... وشاعت في الحياة والأدب كأسماء الأعياد والنرد وغيرها, كما نراه في شعر البحتري, ومنه قوله(36):
يرمي فما يشوي ويقتل من رمَى *** بسِهامِ لا هَدَفٍ ولا بُرْجاسِ
ويتردد في شعر البحتري مثلاً ألفاظ فارسية لأعلام وأماكن وجماعات وغير ذلك...، ولم يقتصر الأمر على ذلك فهناك من أدخل في شعره ألفاظاً فارسية على سبيل التملّح كقول العُمَانيّ للرشيد يمدحه(37):
لمّا هوى بين غياض الأُسْدِ *** وصار في كفِّ الهِزَبْر الوَرْدِ
آلى يذوق الدَّهْرَ آبِ سَرْدِ
والتملح في لفظ (آب سَرْد) وآب: يعني (الماء) وسَرْد: يعني (البارد).
ومن هنا ننتقل إلى بعض الأساليب اللغوية والبلاغية التي تبادلها الأدبان العربي والفارسي... فقد كثر اقتباس القوالب اللغوية والأسماء بعينها؛ سواء كان ذلك من لغة القرآن والحديث أم لغة الأدب وعلوم اللغة وغيرها, فضلاً عن استبدال بعض المصطلحات بما يوازيها معنى ولفظاً, فالمزدوج هو المثنوي عند الفرس, والتجنيس المطلق يطلق عليه لدى البلاغيين الفرس (المتشابه)(38) وعلوم البلاغة ومصطلحاتها وشواهدها عند العرب نجدها بدقائقها في كتاب (حدائق السحر في دقائق الشعر) لرشيد الدين البلخي.... أمَّا كتاب (أنوار البلاغة) لمحمد هادي بن محمد صالح المازندراني أحد علماء المسلمين في القرن الحادي عشر فقد تأثر كثيراً بكتابي (المطول) و(المختصر) للتفتازاني(39).
وأساليب البلاغة ومصطلحاتها التي تبادلها الأدباء والبلاغيون والنقاد كانت تشكل قاسماً مشتركاً كبيراً بين الأدبين؛ علماً أن الأدب الفارسي أفاد في هذا الشأن من الأدب العربي... فلن يبلغ الأديب شأواً بعيداً إذا لم يكن على دراية بها... ولم يقع الاختلاف إلا في أساليب قليلة؛ فلما فضّل الشعراء العرب صنعة (التصريع, والترصيع, والإيجاز والتكثيف) فضّل الشعراء الفرس صنعة (السؤال والجواب؛ وتفريع الأفكار) كما رآه الوطواط(40).
وهذا يفرض علينا الإشارة السريعة إلى الأساليب الفنية الأدبية التي غدت قاسماً مشتركاً بين الأدبين... فلما شاع إنشاد الأشعار باللغتين العربية والفارسية أخذ الشعراء ينظمون الشعر مزاوجين بينهما؛ فإما أن يكون شطر لكل منهما وإما أن يكون بيت وأطلق على هذا الصنيع (المُلَمَّعات) وهذا ما نجده عند الشاعر حافظ الشيرازي (ت 791ه)؛ إذ يستهلّ أشهر مُلمَّعة عند العرب والفرس بقوله من الهزج(41):
ألا يا أيها الساقي *** أَدر كأساً وناولها
كه عشق آسان نمود *** أوّل ولى افتاد مشكلها
وترجمة البيت الفارسي: إنَّ الحب سهل وممتنع في أوله ولكن متاعبه تكمن فيما بعد... ومن يتأمل البيت الأول يستشف أنه متأثر فيه بأبيات ليزيد بن معاوية... فالاستشهاد بنصٍّ كامل لم يعد مقتصراً على القرآن والحديث بل انتقل إلى الشعر العربي, وهو ما عرف بالاقتباس اللفظي ويعرف اليوم في النقد الحديث بالتناص اللفظي... وهذه الظواهر من الاشتراك الأدبي "أشهر وأرحب من أن نمثل لها ببضعة أمثلة. ونكتفي بأن نقرر أنها تكثر في الأجناس" الأدبية الفارسية والعربية المستحدثة(42). فالكتابات الديوانية والرسائل الديوانية والعلمية, والتوقيعات والتعليقات كلها انتقلت من بلاد فارس إلى العربية, وأفادت من أساليبهم الفنية فيها, ولا سيما العناية بالمقدمات والإطناب, والشرح في أنواع من الرسائل... وغدا ذلك كله قاسماً عاماً في الأدبين العربي والفارسي ابتداءً من عهد عبد الملك بن مروان, وخلفائه. وكان عبد الحميد الكاتب الفارسي الأصل تلميذاً بارعاً لسالم مولى هشام بن عبد الملك؛ فقدّم للأشكال الفنية والكتابية في الأدب العربي خدمات جُلَّى(43).
أمَّا ما يتعلق بوصف الخمر التي أولع بها أبو نواس وأمثاله في العصر العباسي فقد تطور كثيراً نتيجة التأثر بطبيعة حياة اللهو والأدب الفارسي(44)؛ على الرغم من أن العرب منذ القديم كانوا يتفنّنون في أوصافها كالأعشى.
ومن ثمَّ فقد أخذت الخمر اتجاهاً جديداً دخل في باب التصوف الذي اشتهر به العرب والفرس على السواء... ودخلت ألفاظ الخمر في باب الرموز الصوفية ودرجاتها عند عدد من شعراء الطرفين, بل إنَّ أبا نواس ارتقى في درجات عشقها ارتقاء المتصوفة في مقاماتهم.
ولعل فيما أشرنا إليه كفاية عن هذه الأنماط الفنية الأدبية لدى العرب والإيرانيين شكلت عظمة الالتقاء فيما بينهم... بيد أن المرء لا يمكنه أن يهمل ما يتعلق بالأوزان والقافية, وهو حديثنا الأخير في القواسم الفنية المشتركة لننتقل بعدها إلى الموضوعات لنوجز القول فيها.
وقد تناول باحثون عديدون ما يتصل بالأوزان والقافية في الشعر؛ فرأوا أن الأدب الفارسي القديم لم يعرف إلا الملاحم التي نظمت على بحر المتقارب المزدودج/المثنوي (وقد ظهر أول ما ظهر في الفارسية الحديثة بعد الفتح في شعر دقيق المتوفى عام (230ه/940م) الذي بدأ نظم (الشاهنامه) وفي شعره كثرت الرباعيات والمنظومات المثنوية من بحر الرمل والخفيف؛ كما بدأ نظم (كليلة ودمنة) أيضاً في مثنوي بحر الرمل"(45).
ومن ثمَّ نتبين أن الوزن لم يأخذ طريقه إلى الأدب الفارسي قبل القرن الثالث الهجري, ولا عرف القافية الواحدة, وإن وقعت في الشعر الفارسي الإسلامي في المزدوج والرباعيات, والقصيدة العادية... والملمعات... وهذا يعني أن الأوزان والقافية انتقلت من الأدب العربي إلى الأدب الفارسي؛ وغدت قاسماً مشتركاً بينهما. ويقع (المتقارب) في الدرجة الأولى عند الشعراء الإيرانيين؛ ويليه الهزج والرمل والخفيف, على حين ندر استعمال بقية الأوزان؛ علماً أن الطويل والكامل والبسيط ثمَّ الوافر والسريع والمتقارب أكثر شيوعاً في الأدب العربي من البحور السابقة...
ويظن الدكتور محمد غنيمي هلال أن الإيرانيين ربَّما عرفوا في العصور القديمة قبل الإسلام أوزاناً شعبية قريبة من الهزج أو من الرجز(46)؛ وهما بحران مستعملان بكثرة في الشعر العربي منذ القديم...
وليس هناك مراء في أن الأدب الفارسي أنتج فن (المثنوي) ذي القافية الواحدة بين مصراعي البيت الواحد دون باقي القصيدة؛ كما أبدع فن (الرباعي) المكون من أربع شطرات ذات قافية موحدة, وكل رباعية مستقلة بذاتها عمَّا قبلها وبعدها... وإن كان العرب قد عرفوا المشطرات والمربعات والمُخَمّسات, ثمَّ أبدعوا الموشحات ذات النهج الجديد في البناء والقافية, وهي التي أثرت في نشأة شعر التروبادور الأوربي. وما يشبه الموشحات إلا فن الزجل, وكلاهما فن شعبي(47) يعالج موضوعات مختلفة كالمدح والغزل, على حين تحاول الأناشيد الدينية المشتركة أنْ تعالج موضوعات صوفية.
هكذا يسلمنا الحديث إلى سمة عالمية مشتركة بين آداب الأمم المختلفة بما فيها الأدب العربي والفارسي وهي سمة القصة والسرد؛ وإذا كان أول ظهور لها في النثر اليوناني القصصي, علماً أن هناك عناصر قصصية في ملاحم اليونان وبعض أشعار العرب القدماء وسير ملوك فارس وحكمائها فإن أول ظهور لها في النثر العربي والفارسي كان في العصر الحديث وقبلها ظهرت المسرحية والمقالة باعتبارهما فنين جديدين.... اللهم إذا استثنينا من ذلك قصص الفروسية والعشق, والسِّيَر الشعبية كسيرة عنترة وسيرة كسرى أنو شروان وأمثالهما؛ وقصة ألف ليلة وليلة, وحي بن يقظان...(48)
وبناء على ما تقدم كله يتضح لدينا بعض القواسم المشتركة اللغوية والفنية الأدبية والأسلوبية بين الأدب العربي والفارسي... وهي تلزمنا بتكثيف الكلام على الموضوعات من جهة المضمون أو الفكرة...
4 الموضوعات المشتركة
هناك موضوعات أدبية عدة تبادلها الأدبان العربي أو الفارسي, أو انتقلت من أحدهما إلى الآخر, ثمَّ رجعت إليه بصورتها الفكرية الجديدة؛ لتغدو قاسماً مشتركاً بينهما؛ وكانت في كل مرة تتخذ وظائف جديدة على نحو كبير.
ولعل موضوع وصف الطبيعة الجامدة والمتحركة, ووصف الممالك الزائلة والأطلال الدارسة من الموضوعات المشتركة والمهمة بين الأدبين العربي والفارسي... وتطور موضوع الأطلال كما هو في العصر الجاهلي إلى وصف الآطام والحصون والقصور الخربة؛ كإيوان كسرى, والصروح الرومانية القديمة أو الآثار الإسلامية التي تهدمت... وغدت موضوعات الوصف في هذا الاتجاه تحمل بُعداً عاطفياً ذاتياً, ووطنياً في بعض الأحيان...(49)
وإذا كان البحتري قد بكى إيوان كسرى ووصفه وصفاً رائعاً, وكأنه ببكائه يبكي خراب هذه المباني العظيمة؛ كما نجده في سينيته المشهورة؛ ومطلعها(50):
صنْتُ نفسي عمّا يُدنِّسُ نفسي *** وترفَّعْتُ عن جَدا كلِّ جِبْسِ
ثمَّ عارضه فيها أحمد شوقي في العصر الحديث ورثى آثار العرب في الأندلس, ثمَّ بكى أمجاد العرب الغابرة في قصيدته, ومطلعها(51):
اختلاف النهار والليل يُنْسي *** اذكرا لي الصِّبا وأَيَّامَ أُنسي
ومن قبلُ حذا حذوه الشاعر الإيراني منو جهري أحد شعراء القرن الخامس الهجري فوقف على الأطلال حين مدح عظيماً من العظماء, وكذلك فعل الشاعر الإيراني الآخر خاقاني وهو أفضل الدين إبراهيم بن علي الشيرواني المتوفى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي, ووصف إيوان كسرى(52).
وأخيراً نتوقف عند موضوع الحب العذري, وبخاصة قصة عشق قيس بن الملوح؛ مجنون بني عامر؛ لليلى العامرية... فهي من أعظم القصص في الأدبين العربي والفارسي في موضوع الحب والتدله والحرمان... وإذا كانت قصة المجنون عند العرب تجسد أخباراً مثيرة تناقلها الناس؛ فإنها لقيت لدى أدباء إيران رواجاً لا نظير له؛ ثمَّ اتّخذت شكل العمل الأدبي المتكامل بعد أن كانت مجرد أخبار متفرقة تعبر عن الحرمان والعذاب والمعاناة والعشق. وكان فضل الريادة في هذا للشاعر الإيراني (نظامي الكنجوي 530 595ه). وقد نظم قصة (ليلى والمجنون) في (4700) بيت عام (584ه) في أربعة أشهر(53).
ومن ثمَّ كان الحب العذري منطلقاً إلى الحب الصوفي في الأدب الفارسي؛ وهذا ما ظهر في صنيع (نظامي) ثمَّ نسج أحمد شوقي مسرحيته (مجنون ليلى) على منوال ما حيك عن المجنون في الأدب الفارسي الذي نقل إلى التركية؛ التي كان شوقي يجيدها(54).
وهذا لا ينسينا أن الأدب الصوفي نفسه "نشأ في الأدب العربي وعني به الكتاب عناية فائقة, ثمَّ نقل بعد ذلك إلى الأدب الفارسي, فعُني به الكتاب؛ ثمَّ انتقلت تلك العناية إلى الشعراء. وهكذا دخل عليه تطور في الأدب الفارسي حتَّى جاء وقت غلبت فيه التأليفات الصوفية الشعرية على النثرية في الأدب الفارسي؛ على حين كان العكس في الأدب العربي؛ إذ ظلت الغلبة للمؤلفات الصوفية النثرية على المؤلفات الشعرية الصوفية"(55).
ويعد الشاعر الإيراني جلال الدين الرومي: محمد بن محمد البلخي (604 672ه) من أعظم شعراء التصوف الإسلامي. وقد حدثنا عن طريق السالكين المملوءة بالمصاعب والدم, وهو يقص علينا عشق المجنون... وينتهي إلى ذكر عدد من مقامات الصوفية في قصيدته (شكوى الناي). فالناي لديه رمز للروح التي كانت في عالم الذر, فلمّا تجلى الله للروح سكنت الجسد(56). وهي في ثمانية عشر بيتاً افتتحها بالمثنوي, فقال:(57)
بشنو أين نى جون شكايت في كند *** ازجدا بى ها حكايت في كند
والمعنى: استمع للناي كيف يقص حكايته. إنه يشكو آلام الفراق. وترجمها محمد الفراتي شعراً فقال:
اسمع النايَ مُعْرِباً عن شكاتِهْ *** بعد أن بات نائياً عن لِداتِهْ
ووظّف الشاعر الكبير محمد إقبال حكاية المجنون في الأدب الصوفي الحديث في قوله(58):
ما زال قيسٌ والغرام كعهده *** وربوعُ ليلى في ربيع جمالها
وهضاب نجدٍ في مراعيها المها *** وظباؤها الخفرات ملءُ جبالها
والعشق فيّاض وأُمَّة أحمد *** يتحفّز التاريخُ لاستقبالها
هكذا أدّى العشق العذري والحرمان فيه إلى إثارة خيال المتصوفة, وأوقد ذاكرتهم فأبدعت أفكاراً شتى دخلت العرفان الفارسي من الباب الواسع, ومن ثمَّ أخذت تنتقل إلى الأدب العربيّ فنتج عنها قواسم مشتركة فناً وفكراً.
وهذا ما ينطبق على موضوعات أخرى كأغراض المدح والغزل وغيرهما. إذ يضيق المجال بهذه الموضوعات لو تتبعناها؛ وحسبنا ما وقفنا عنده ممَّا يؤكد عظمة الالتقاء بين الأدبين العربي والفارسي؛,,, ولعل هذا يطرد من نفوسنا أي استشعار بالفرقة والعداوة؛ لأنَّ المودة والمحبة كانت وراء ذلك التمازج قبل أن تكون الأحداث التاريخية والاجتماعية وراء عملية التقارب والتمازج لنعيد إلى ذاتنا جوهرها الأصيل الذي أسسه قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس فنحن شعبان في أمة واحدة...
المصادر والمراجع
(1) إبداع ونقد قراءة جديدة للإبداع في العصر العباسي د. حسين جمعة دار النمير دمشق 2003م.
(2) الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال دار العودة بيروت ط5 د/ت.
(3) الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت ط7 1986م.
(4) إيليا أبو ماضي: شاعر المهجر الأكبر زهير ميرزا نشر دار اليقظة العربية ومطبوعات المطبعة التعاونية اللبنانية بيروت ط2 1963م.
(5) تاريخ الأدب في إيران إدوارد براون ترجمة إبراهيم أمين الشواربي دار السعادة مصر 1954م.
(6) تاريخ الترسل النثري عند العرب في العصر الأموي د. محمد المقداد مكتبة الفرسان الكويت 1997م.
(7) تأثر جماعة الديوان برباعيات الخيام د. يوسف بكار أبحاث ندوة (العلاقات الأدبية واللغوية العربية الإيرانية) اتحاد الكتاب العرب دمشق 1999م.
(8) ترجمان البلاغة بالفارسية لمحمد بن عمر الرادوياني به تصحيح واهتمام أحمد آتش جاب دوم, شركت انتشارات أساطير تهران 1362 ه. ش.
(9) حدائق السحر في دقائق الشعر رشيد الدين محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري البلخي المعروف بالوطواط ترجمة د. إبراهيم الشواربي 1945م.
(10) دراسات في الأدب المقارن د. بديع محمد جمعة دار النهضة العربية بيروت ط2 1980.
(11) ديوان الأعشى تحقيق د. محمد محمد حسين المكتب الشرقي بيروت 1968م.
(12) ديوان البحتري شرح د. محمد التونجي دار الكتاب العرب بيروت ط2 1999م.
(13) ديوان حافظ الشيرازي تصحيح د. حسين إلهي خط غلام حسين أمير خاني انتشارات سروس تهران 1374 ه. ش.
(14) ديوان طرفة بن العبد دار صادر بيروت, والبيت المستشهد به لا يوجد إلا في هذه الطبعة من طبعات الديوان.
(15) ديوان أبي نواس تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي دار الكاتب العربي بيروت د/ت.
(16) رباعيات الخيام بين الأصل الفارسي والترجمة العربية د. عبد الحفيظ محمد حسن كلية العلوم جامعة القاهرة ط1 1989م.
(17) رباعيات عمر الخيام ترجمة أحمد الصافي النجفي دار طلاس دمشق ط5 1998م.
(18) رباعيات عمر الخيام ترجمة الشاعر الأردني عَرار: مصطفى وهبي التل تحقيق د. يوسف بكار مكتبة الرائد العلمية عمّان الأردن ط2 1999م.
(19) رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي تحقيق بطرس البستاني دار صادر بيروت 1967م.
(20) رسالة الغفران لأبي العلاء المصري تحقيق د. بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن دار المعارف بمصر ص 8 1990م.
(21) الشاهنامه لأبي القاسم الفردوسي ترجمة سمير مالطي دار العلم للملايين بيروت ط2 1979م.
(22) شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية بيروت 1979م.
(23) شروح سقط الزند تحقيق مصطفى السقا ورفاقه الهيئة المصرية العامة للكتاب نسخة عن طبعة دار الكتب المصرية 1945م.
(24) شكوى الشكوى: تأملات في قصيدة (شكوى الناي) د. عيسى علي العاكوب ضمن أبحاث ندوة العلاقات الأدبية انظر رقم 7.
(25) الشوقيات أحمد شوقي المكتبة التجارية الكبرى بمصر 1970م.
(26) الظواهر المسرحية عند العرب علي عقلة عرسان اتحاد الكتاب العرب دمشق ط3 1985م.
(27) العلاقات العربية الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل مجموعة من الباحثين مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ط1 1996م.
(28) فرهنك وازهاي فارسي عربي إي بهرام فره وش تهران 1968م.
(29) قصة الأدب الفارسي حامد عبد القادر مكتبة نهضة مصر القاهرة 1951م.
(30) القيان والغناء د. ناصر الدين الأَسد دار المعارف بمصر القاهرة ط2 1968م.
(31) كشف اللثام عن رباعيات الخيام لأبي النصر مبشر الطرازي الحسيني دار الكاتب العربي ط1 القاهرة.
(32) لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت 1955 1956م.
(33) ليلى والمجنون للشاعر الفارسي نظامي الكنجوي ترجمة عائشة عفة زكريا دار المنهل للطباعة والنشر دمشق 2001م.
(34) مختارات من الشعر الفارسي د. محمد غنيمي هلال الدار القومية للطباعة القاهرة 1965م.
(35) مروج الذهب للمسعودي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المطبعة التجارية الكبرى بمصر ط 4 1964م.
(36) المعجم في معايير أشعار العجم بتصحيح محمد قزويني ومدرس رضوي جاب سوم كتابفروشي تهران 1360ه. ش.
(37) المقامات الأدبية لأبي محمد الحريري مطبعة مصطفى البابي الحليب مصر ط5 1950م.
(38) مقدمة ابن خلدون دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط4 د/تا.
(39) ابن المقفع بين حضارتين د. حسين جمعة منشورات المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق 2003م.
(40) يوسف وزليخا لعبد الرحمن الجامي ترجمة عائشة عفة زكريا دار المنهل للطباعة والنشر دمشق 2003م.
________________________________________
(*)باحث وأستاذ في كلية الآداب في جامعة دمشق.
(1) العلاقات العربية الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل 113.
(2) ديوان البحتري 1/146.
(3) انظر مقدمة ابن خلدون 451 453.
(4) دراسات في الأدب المقارن 99 وانظر الظواهر المسرحية عند العرب 491 588.
(5) انظر مثلاً (يوسف وزليخا) لعبد الرحمن الجامي.
(6) انظر دراسات في الأدب المقارن100 والظواهر المسرحية عند العرب 523.
(7) انظر رسالة التوابع والزوابع 72 74 والظواهر المسرحية 276 وما بعدها.
(8) انظر رسالة الغفران 129 و132و139 141 والأدب المقارن 230 والظواهر المسرحية عند العرب 518 520 و525 وإبداع ونقد 135 136.
(9) انظر دراسات في الأدب المقارن 115 117.
(10) انظر دراسات في الأدب المقارن 143 150.
(11) انظر المرجع السابق 105 ومختارات من الشعر الفارسي 445.
(12) انظر الأدب المقارن 149 158 والأعلام 6/281 والظواهر المسرحية عند العرب 519 521 و525.
(13) انظر دراسات في الأدب المقارن 84 86.
(14) انظر ابن المقفع بين حضارتين 65 165 والظواهر المسرحية عند العرب 391 وما بعدها.
(15) انظر دراسات في الأدب المقارن 172 وما بعدها و194 وما بعدها والأدب المقارن 183 187.
(16) انظر دراسات في الأدب المقارن 186 192.
(17) انظر المرجع السابق 178 و187.
(18) انظر المرجع السابق 205 207 والأدب المقارن 189 193.
(19) انظر الشوقيات 4/150 والأدب المقارن 193 195.
(20) انظر كشف اللثام عن رباعيات الخيام 9 11 و27 و64 65.
(21) انظر المرجع السابق 70 87.
(22) انظر رباعيات الخيام بين الأصل الفارسي والترجمة العربية 38 و41 و68 و124.
(23) انظر كل ما ورد أعلاه في المرجع السابق 67 68 وما بعدهما و124 و295 وما بعدها.
(24) انظر المرجع السابق 143 144 وشروح سقط الزند 974 975.
(25) انظر مثلاً رباعيات الخيام بين الأصل الفارسي والترجمة العربية 318 ورباعيات عمل الخيام ترجمة النجفي 43 و77.
(26) إيليا أبو ماضي 193.
(27) انظر المرجع السابق 193 ورباعيات عمر الخيام ترجمة عرار 65.
(28) تأثر جماعة الديوان برباعيات الخيام 67 وما بعدها.
(29) انظر مقدمات كتب الجاحظ المذكور ة في المتن؛ وفي مواضعها.
(30) انظر دراسات في الأدب المقارن 223 وما بعدها و247 وما بعدها, وتاريخ الأدب في إيران 2/439 وما بعدها والأدب المقارن 200 و261 والظواهر المسرحية عند العرب 437 وما بعدها وعُد إلى المقامات الأدبية للحريري؛ وشرح مقامات بديع الزمان الهمداني, وتأمل فيهما.
(31) ديوان البحتري 2/635.
(32) انظر القيان والغناء 45 والشاهنامه 151 و153 و161 ومروج الذهب 1/161.
(33) ديوان طرفة بن العبد 66 وانظر لسان العرب (أسبذ دخدنس قبس).
(34) ديوان الأعشى 329.
(35) انظر فرهنك وازهاي فارسي عربي إي ص 3.
(36) ديوان البحتري 2/638 والبُرْجاس: غرض في الهواء يُرْمى به.
(37) انظر المعجم في معايير أشعار العجم 418 وترجمان البلاغة 11.
(38) انظر المرجعين السابقين والصفحات نفسها, ثمَّ انظر حدائق السحر 18 وما بعدها.
(39) انظر الأدب المقارن 284 285.
(40) انظر حدائق السحر 18.
(41) ديوان حافظ الشيرازي 33.
(42) انظر الأدب المقارن 284.
(43) انظر تاريخ الترسل النثري 434 و438 441 و445.
(44) انظر ديوان أبي نواس (ف) وما بعدها, وانظر فيه باب الخمريات الفهرس 731 746.
(45) انظر الأدب المقارن 269 270 وراجع فيه 265 268 ودراسات في الأدب المقارن 73.
(46) انظر الأدب المقارن 267 268.
(47) انظر الأدب المقارن 270 273.
(48) انظر المرجع نفسه 201 203 و220 223 و240 246.
(49) انظر الأدب المقارن 195 197 وقصة الأدب الفارسي 1/193.
(50) ديوان البحتري 2/631 وانظر الأدب المقارن 198.
(51) الشوقيات 2/45 وانظر الأدب المقارن 199.
(52) انظر الأدب المقارن 199.
(53) انظر ليلى والمجنون نظام الكنجوي 3 14 ودراسات في الأدب المقارن 291 293 و307.
(54) انظر دراسات في الأدب المقارن 333 وما بعدها و342 وما بعدها.
(55) دراسات في الأدب المقارن 25 26.
(56) شكوى الشكوى: تأملات في قصيدة شكوى الناي 50 51.
(57) المرجع نفسه والصفحة ذاتها.
(58) المرجع نفسه 60.
مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 97 - السنة الرابعة والعشرون - آذار 2005 - آذار 1425
لم يعرف التاريخ الإنساني التقاء أكثر غنىً وشمولاً من التقاء العرب والإيرانيين على مستويات عديدة سياسية واجتماعية؛ وفكرية وثقافية؛ فلسفية ودينية؛ أدبية وفنية, لغوية وبلاغية...
وترجع علاقة التفاعل الوطيدة إلى عصور تاريخية عريقة تجسدت في الحياة والفن والأدب... إذ تجلى في الأدبين العربي والفارسي مفاهيم التصور الديني والفلسفي الممزوجة ببحر العزة والعظمة الإلهية؛ والموشاة بكل المودة والمحبة على الصعيد الاجتماعي. فقد برزت أشكال التمازج الحضاري منذ البعثة المحمدية لتؤكد مفهوم الوصول "إلى المساواة بين الشعوب على السلطة القائمة, وعلى الثقافة العربية الإسلامية"(1) من خلال علاقة الرحمة والتقوى والعدل، لا من خلال العرق والجنس واللون.
وليس هذا غريباً ولا بدعاً من القول فقد تأسس ذلك في النفوس كما لدى البحتري إذ قال في مدح عبيد الله بن خرداذبة(2):
إِنْ كان من فارسٍ في بيتِ سُؤْدَدِها *** وكنتُ من طيِّئٍ في البيت ذي الحَسَبِ
فلم يَضْرِنا تنائي المَنْصِبَيْن وقد *** رُحْنا نَسيبين في خُلْق وفي أَدبِ
فالقواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي إنما انبثقت من التمازج المشترك بين الشعبين العربي والإيراني منذ العصور التاريخية ثمَّ ازدادت إحكاماً وارتقاء حضارياً بعد الإسلام, إذ دخل أبناء إيران فيه طوعاً وإرادة ورغبة؛ وانصهروا في بوتقة تعاليمه ومبادئه... وعملوا على نشرها...
ولما كانت العربية لغة القرآن والدين الجديد الذي اعتنقوه أقبلوا على تعلّمها وإتقانها كأهلها. وقد تضافر إلى هذا رغبة علمية جامحة وملحة في خدمة الحضارة الإسلامية... صار كثير منهم يتقن اللسانين حديثاً وكتابة. ومن ثمَّ أخذوا ينقلون بوساطة اللغة العربية كثيراً من معارفهم القديمة المكتوبة بلغاتها الأصلية؛ في التاريخ والفن والطب والكيمياء والفلك واللغة والحساب والأدب... وقد شاركهم في هذا عدد من علماء العرب والبلدان المفتوحة الأخرى...
وحينما كانت القواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي تزداد اتساعاً وتنوعاً كانت تتخذ لنفسها أنماطاً عدة عبّرت عنها المصادر التي استندت إليها؛ بمثل ما تركزت في الترجمة والتأليف الأدبي والبلاغي... ومن ثمَّ وجدت بأشكال وموضوعات محددة في كليهما...
وبناء على ذلك كله كان لزاماً علينا أن نلجأ إلى مبدأ الاختيار والإيجاز والتكثيف في معالجة القواسم المشتركة التي يقوم عليها البحث... لأنَّ الحديث عنها كلها يحتاج إلى مجلدات كثيرة, علماً أن بعض الدارسين قبلنا سبقنا إلى ذكر نتف منها كما نلمسه عند محمد غنيمي هلال الذي اتكأ عليه كل من جاء بعده.
ولما كان القرآن الكريم هو أهم المصادر آثرنا أن نتوقف عند قصةٍ واحدة من قصصه؛ مع إيماننا اليقيني بأن هناك مصادر أخرى لتلك القواسم كالسُنَّة المطهرة, والأحداث التاريخية والاجتماعية, والكتب الدينية والفلسفية والتاريخية, مثل كتاب الشاهنامه للفردوسي الطوسي, وتاريخ الطبري, وتاريخ ابن الأثير؛ وكتب أدب الرحلات, وأدب التصوف الذي تصدره من الإيرانيين الغزالي وجلال الدين الرومي.
ولعل هذا ينقلنا إلى حركة الترجمة وأثرها في إطلاق تفاعل أدبي بين العرب والإيرانيين لا يضاهيه في عناصر الالتقاء ما نجده عند غيرهم, كما وقع في كتاب (كليلة ودمنة) ورباعيات الخيام والمقامات, ممَّا اخترناه. ولهذا عقد ابن خلدون في مقدمته فصلاً عن "حملة العلم في الإسلام" فوجد أكثرهم من الإيرانيين(3).
ومن هنا نتوقف عند القواسم المشتركة اللغوية والفنية في الأدبين كالألفاظ والمصطلحات والأساليب والاقتباس الحرفي والأوزان والقافية والقصة... فكلها مثلت ملامح مشتركة في الأدب العربي والإيراني. وهي الملامح التي تحققت في موضوعات تعاور عليها الأديان, وكيف تغيّرت وظائفها في بعض الاتجاهات الأدبية, كما نجده في قصص الحب العذري؛ ولا سيما حكاية ليلى والمجنون, وموضوع وصف الأطلال والممالك الزائلة.
فعظمة المادة وتنوعها لم يترك لنا المجال إلا أن نتبنى المنهج الذي أشرنا إليه... وسنتوقف عند القرآن الكريم؛ باعتباره أعظم مصدر التقى عليه المسلمون, وعند واحدة من قصصه؛ وهي قصة المعراج.
1 القرآن الكريم؛ قصة المعراج النبوي:
أكدت مبادئ الدين الحنيف العودة الأصيلة والنبيلة إلى الهويّة الإنسانية دون تشويه للذات الفردية وللانتماء الاجتماعي والبيئي والوطني... وهذا حمل الناس قديماً وحديثاً على اعتناق الإسلام؛ لأنه يتفق مع الفطرة والعقل معاً... ثمَّ ارتبطوا بحبل الله المتين, وطفقوا يبنون الحضارة الإسلامية التي تنشد التقدم والحق والعدل...
وقد جسَّد القرآن الكريم شكلاً ومضموناً قواسم مشتركة عظمى بين المسلمين، ليس من جهة العقيدة والعبادة والتبرك فقط، بل من جهة أنه كتاب معجز في أساليبه وأفكاره وأخباره وقصصه... وهذا ما جعلهم ينصهرون في آياته ولغته، يقتبسون منها ما وسعهم الجهد؛ أو يضمّنون أفكارهم العديد من أفكارها؛ أو ينتهجون طرائقه في التأليف والكتابة والإبداع...
ولما كان مقام الاحتذاء بالنص القرآني عظيم الحجم وكثير التنوع رغبنا في الوقوف عند قصة المعراج النبوي التي احتفل بها الأدب العربي والفارسي, وجعلها "منطلقاً إلى فضاء الفكر الأرحب؛ حيث تعالج مسائل فلسفية أو صوفية أو أدبية أو وطنية"(4)؛ فكانت توظف توظيفاً مجازياً يؤدي الغرض الذي يرمون إليه. وهذا لا يعني أن الأدب العربي والفارسي لم يحفل بغيرها, ولا سيما قصة يوسف () وزليخا التي شاع أمرها في الأدب الفارسي(5).
وتتلخص قصة المعراج بأن النبي الكريم عرج إلى السموات السبع يصحبه جبريل () هادياً ومرشداً... وقد رأى () في السماء الأولى (آدم) وفي الثانية (يحيى وعيسى) وفي الثالثة (يوسف) وفي الر ابعة (إدريس) وفي الخامسة (هارون) وفي السادسة (موسى) وفي السابعة (إبراهيم) عليهم صلوات الله أجمعين. وكان () قد رأى في كل سماء أشياء تأسس في ضوئها جملة من الأوامر والنواهي...
ومن ثمَّ انتهت رحلة المعراج إلى سِدْرة المنتهى على وفق قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى (النجم 53/18).
فالوقوف بين يدي الحضرة الإلهية كان المرحلة الأخيرة في قصة المعراج ثمَّ العودة إلى الأرض...
ولسنا الآن في صدد الحديث عن أول من تأثر بقصة المعراج وعمن تناولها وإنما في صدد إثبات أنها غدت مدار التقاء أدبي وفكري وفلسفي بين الأدبين العربي والفارسي...فالأديب الإيراني فريد الدين العطار (545 627ه) ترجم في كتابه (تذكرة الأولياء) أول معراج صوفي لأبي يزيد البسطامي طيفور بن عيسى؛ الملقب بسلطان العارفين؛ (ت 261ه). وقد كتبه البسطامي بالعربية في إطار رؤية منامية يتخيل فيها الطريق إلى الله. أمَّا الشيخ الرئيس أبو علي حسين بن عبد الله بن سينا (338 428ه) فقد ألف (رسالة الطير) ورأى أنه "يطير مع الطيور وأن الطريق مليء بالصيادين الذين تمكنوا من الإيقاع بالطيور فطارت الطيور وعبرت الكثير من الصعاب ومنها ثمانية جبال وكان هدفها الوصول إلى المليك الذي يخلصها من الشباك"(6).
وتحظى الطيور بلقاء الملك ويخلصها من الشباك وتعود أدراجها...
وبهذا يلتقي ابن سينا مع البسطامي في الحديث عمَّا يستوجب على السالك الصوفي أن يفعله في حياته ليصل إلى مقام المشاهدة والالتقاء بالحضرة الإلهية.
ومن هنا نشير إلى رسالة (التوابع والزوابع) لابن شُهَيد الأندلسي أبي عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان (382 426/992 1034م)...
وفيها عقد رحلته إلى العالم الآخر وهو يرمي إلى مفاضلة أنداده ومنافسيه من الأدباء والوزراء وأهل السياسية والانتقاص منهم ونقدهم وإظهار مناقبه... وفيها عرض لعدد من الشعراء وتوابعهم في وادي عبقر, فضلاً عن بعض الأدباء والنقاد كعبد الحميد الكاتب والجاحظ وبديع الزمان...(7) وبهذا فهي رحلة إلى العالم الآخر, صاحب فيها أبو عامر هادياً له يتمتع بصفات خارقة.
وتتوافق رسالة التوابع والزوابع مع قصص المعراج ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري (363 449ه) بأنها رحلة معراجية إلى العالم الآخر, بعد أن اجتمع فيها اثنان يرشد أحدهما الآخر ويبين له سبيل الحق... وبعد الوصول إلى مقام الشهود في قصص المعراج وإلى الجنة أو النار في رسالتي الغفران والتوابع والزوابع تنتهي الرحلة بالعودة إلى عالم الوجود.
فرسالة الغفران تجعل من ابن القارح قائداً للرحلة, وإن كانت شخصية السارد (أبي العلاء) لا تغيب في كثير من الأحيان عنها. ويزور فيها الجنة والنار ويقابل الشعراء والأدباء والقرّاء والنحويين وغيرهم فيسأل أحدهم عن سبب دخوله النار أو دخوله الجنة, وبمَ غُفر له؟. ويشبهها في هذا البناء رحلة الموبد الزرادشتي (أرده ويراف) إلى الجحيم والأعراف والجنة, ولعل المعري تأثر بها(8) إنْ كان يعرف الفارسية, وهو مستبعد. ويبقى الفرق بين رسالتي المعري وابن شهيد وقصص المعراج في الأدب العربي والفارسي أنهما تعبير عن الذات بخلاف الأخرى التي تحقق للصوفي ما يصبو إليه من مشاهدة أو اتحاد.
وإن كانت قصص المعراج في الأدب الفارسي عديدة مثل (سير العباد إلى المعاد) لسنائي الغزنوي (ت 545ه) و(رسالة الطير) لحجة الإسلام زين العابدين أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (450 505ه) فإننا سنتوقف عند منظومة (منطق الطير) لكبير مشايخ التصوف الفارسي فريد الدين العطار (545 627ه)؛ إذ عُدّ ثالث ثلاثة فيه بعد جلال الدين الرومي وسنائي الغزنوي...
ومنظومة (منطق الطير) المبنية على المزدوج/المثنوي في قالب شعري قصصي؛ تعد من أعظم ما نظم في الأدب الصوفي خاصة؛ إذ بلغت (4650 بيتاً) وكان قد نظمها سنة (583ه)(9). ولعل فيما يدل عليه مصطلح المثنوي أنه بني على المقابلة الثنائية شكلاً ومعنى؛ في الإيمان والاعتقاد بالجنة والنار, والليل والنهار...
وليست مهمة البحث عرض طبيعتها وماهيتها فقد انعقدت فُصول في كتب شتّى لهذا الغرض؛ ولكن مهمته الأصلية إثبات أن فريد الدين العطار تأثر على نحو كبير برسالة الطير لكل من ابن سينا والغزالي, في الوقت الذي اتفق فيه مع رسالتي الغفران والتوابع والزوابع في منطلق الرحلة, وهو المنطلق الذي قامت عليه قصة المعراج النبوي في استصحاب هادٍ ومرشد.
وإذا كان ابن سينا قد عبَر جبالاً ثمانية لمقابلة الملك فإن الأودية والطرق عند الغزالي وسنائي والعطار سبعة, وهي ترمز إلى المقامات السبعة في التصوف, وطرقها...
وإذا كان سنائي الغزنوي قد اتفق مع ابن سينا والغزالي والعطار في تجاوز الطيور للوديان والجبال فإنه اتفق مع رسالة الغفران ورحلة الموبد الزرادشتي في كونه رافق مرشده وهاديه في رحلته إلى الجنة والأعراف والنار...
وكان العطار قد نظم الرحلة على ألسنة طيور حقيقية كالهدهد والنَّهْس والصقر وغيرها؛ ولم يختر إلا طيراً خرافياً واحداً هو (السِّيْمُرغ) ورمز فيه إلى ملك قوي... وتعني (سي) ثلاثين (مُرغ) الطائر, أي الثلاثين طيراً. وهو عند الإيرانيين بمنزلة العنقاء عند العرب. وهنا نثبت أن الغزالي استخدم العنقاء في (رسالة الطير) على حين استعمل مصطلح (الطيور) لأنواعها كلها...
وما يعنينا هنا أن الأودية السبعة: وادي الطلب والعشق والمعرفة والاستغناء والتوحيد والحَيْرة وأخيراً وادي الفقر والغناء كناية عن السموات السبع في قصة المعراج النبوي, على حين ترمز إلى المقامات السبعة عند أهل التصوف كمراحل لتصفية أرواحهم ليحظوا في نهاية المطاف بعد اجتياز الوادي السابع (الفقر والغناء) بالحَضْرة الإلهية.. علماً أن الهدهد يرمز إلى جبريل, والسيمرغ يرمز إلى ملك قوي صابر يتجلى في المرآة عن توحده مع الله. فهو يمثل الطيور الثلاثين التي سلكت الأودية السبعة ووصلت إلى جبل (قاف) وحظيت بلقاء الحضرة الإلهية.
وهذا يعني أن السالك من المتصوفة الطيور قد صمم على قطع الأودية؛ مهما كانت صعوباتها ووعورتها لأنَّ اليأس لا يتسرب إلى نفوس المؤمنين(10) لينتهي به المطاف في مقام الشهود إلى التجلي والاتحاد...
أمَّا منظومة (جاويد نامه) أي (رسالة الخلود) للمفكر الإسلامي الكبير محمد إقبال (1873 1938م) التي كتبها بالفارسية عام (1932م) فقد ترجمها إلى العربية محمد السعيد جمال الدين، وفيها نرى جلال الدين الرومي هادياً ومرشداً لمحمد إقبال الذي تاقت نفسه للعروج والاتجاه إلى الله وحده بعد اجتياز الزمان والمكان من خلال أفلاك سبعة ليصل إلى جنة الفردوس... ويشكو إقبال "تشتت العالم الإسلامي لضعف في نفوس المسلمين, وبسبب مصائب الاستعمار والشيوعية" ثمَّ يرى أن العالم الإسلامي أصيب بحالة موت ولن ينقذه منها إلا عالم القرآن الكريم(11).
وقد وقع التجلي الإلهي في معراج إقبال بعد انتهاء الرحلة إلى مقام الشهود عن طريق العشق الإلهي...
ومن بين القواسم المشتركة بين رسالة الخلود ورسالة الغفرانِ محاكمةُ الزنادقة؛ فإذا كان المعري قد حاكم بشاراً وأمثاله فإن محمد إقبال حاكم ثلاثة من الزنادقة حين وصل إلى فلك المشتري وهم المنصور الحلاج, والشاعر الهندي أسد الله غالب وشاعرة المذهب البابي في إيران قُرّة العين الطاهرة التي أُعدمت سنة (1852م) لاعتناقها هذا المذهب... أمَّا التقاؤهما بالمعراج النبوي فتجسد بعدم الرضا بهذا العالم ولا بد من التوجه أبداً إلى الذات الإلهية... وهي الفكرة التي يلتقي فيها الصوفي الكبير محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي (560 638ه), ولا سيما في كتابه المخطوط (الإسرا إلى المقام الأسرى). ويعد أحد الكتب في تزكية النفس, وفيه أفاد من قصة المعراج النبوي, بمثل ما أفاد منها عدد من أدباء الغرب كما نراه في (الكوميديا الإلهية) للشاعر الإيطالي دانتي (1265 1331م), و(الفردوس المفقود) للشاعر الإنكليزي ملتون (1608 1674م)(12).
وفي ضوء ذلك كله ثبت لنا أن قصة المعراج النبوي أحدثت حركة أدبية عظيمة, وأثرت الخيال الخصب للشعراء والأدباء في الأدبين العربي والفارسي فكانت قاسماً مشتركاً عظيماً بينهما...
وهذا يجعلنا ننتقل إلى مظهر آخر من مظاهر العلاقة الوطيدة بين الأدبين ويتمثل في الترجمة والتأليف.
2 الترجمة والتأليف:
ليس المقصود في هذا المقام أن نتحدث عن الترجمة باعتبارها تعني نقل الكلام من لغة إلى أخرى؛ أو أن اللغة الأقوى تؤثر في الأضعف... وإنما المقصود ما أنتجته الترجمة من تكوين قواسم مشتركة عديدة بين العرب والإيرانيين على الصعيد الاجتماعي والسياسي والثقافي والأدبي... وقد حمل أعباء ذلك كل من أبناء الشعبين على السواء, فأكدوا عظمة التفاعل المتبادل بينهم وأتاحوا للأدباء والباحثين والشعراء الاطلاع على ثقافة الشعبين؛ فازدادت إبداعاتهم غنىً وارتقاء... وربَّما أحدثت بعض الكتب المترجمة حركة أدبية عظيمة الأشكال والأفكار والموضوعات والمؤلفات, علماً أن كثيراً من الأدباء والمؤرخين والفقهاء واللغوين صاروا من أصحاب اللسانين العربي والفارسي, ألفوا فيهما ونظموا الأشعار بمثل ما ترجموا منهما... فابن سينا مثلاً ألّف كتباً بالعربية منها (الشفاء والقانون والإشارات) وكتباً بالفارسية منها (دانشنامه علائي) وله شعر عربي كقصيدة (النفس) وثنتان وعشرون قطعة من الشعر الفارسي... وأبو الريحان البيروني كتب نسختين من كتابه (التفهيم لأوائل صناعة التنجيم) واحدة بالعربية والأخرى بالفارسية... أمَّا الشاعر الصوفي الشهير سعدي الشيرازي (ت 691ه) فله أشعار بالفارسية, وقصائد بالعربية منها قصيدته في رثاء بغداد على إثر تخريبها بيد المغول سنة (656ه)(13).
وإذا كنا سنأتي على ذكر عدد آخر في الأشكال الأدبية المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي فإننا سنشير بإيجاز إلى كتابين أحدثا حركة التقاء كبرى بينهما وهما كتاب (كليلة ودمنة) لعبد الله بن المقفع (106 142ه) ورباعيات الخيّام؛ لعمر الخيام, وكلاهما إيرانيان من أصحاب اللسانين.
أمَّا (كليلة ودمنة) فهو أشهر الكتب التي ترجمها ابن المقفع سنة (133ه) وكان رأس المترجمين العشرة؛ فضلاً عن أنه ألف في العربية عدداً من الكتب مثل (الأدب الصغير, والأدب الكبير, واليتيمة في الرسائل) كما ترجم من الفارسية عدداً آخر لم يصل إلينا منها شيء حتَّى الآن, ومنها (خُداي نامه في السِّيَر, وآيين نامه: القواعد والرسوم, والتاج في سيرة أنو شروان)(14).
ويعد كتاب (كليلة ودمنة) أحد الكتب التي قرّبت بين الأدبين العربي والفارسي في الوقت الذي أحدث فيهما حركة فنية وفكرية... وكان ابن المقفع قد ترجمه عن الفارسية القديمة (الفهلوية) التي نُقل إليها من اللغة الهندية؛ ولما ضاع الأصل الفارسي والهندي صارت الترجمة العربية أصلاً ولا سيما أن ابن المقفع أضاف إليها بعض الأبواب..., وأشهر من ترجمها بعد ذلك إلى الفارسية أبو المعالي نصر الله (سنة 539ه) ثمَّ ترجمت غير مرّة إلى الفارسية وغيرها من اللغات العالمية(15).
وإذا كانت قصص مشهد الحيوان معروفة في الشعر الجاهلي فإن السرد القصصي لكليلة ودمنة يختلف كل الاختلاف عمَّا هو في مشاهد الحيوان تلك, فضلاً عن أن ابن المقفع تصرّف في أسلوب السرد ومعانيه بما يتوافق والذوق العربي...
ومن ثمَّ فإن كثيراً من الأدباء واللغويين أخذوا ينقلون منها حكايات وأمثالاً كما نجده في (عيون الأخبار) لابن قتيبة, أو يؤلفون على منوالها كما حُكي عن كتاب (القائف) للمعري الذي ما زال مفقوداً, وكتاب ابن الهبّارية في الشعر (الصادح والباغم) الذي طُبع مرات عدة, وغيرهما(16).
وإذا كان الدكتور طه حسين قد أعجب بجودة عبارات كليلة ودمنة؛ فإن كثيراً من الأدباء احتذوا ابن المقفع في الكتابة والأساليب وغزارة المعاني, واقتباس الأمثال والحكم من أ فواه البهائم والطير ومن ثمَّ نسجها في أشكال شعرية ونثرية... فأبان بن عبد الحميد اللاحقي نظم كليلة ودمنة شعراً ولكن منظومته ضاعت ونظمها عدد آخر مثل سهل بن نوبخت عام (165ه)(17).
ولم تقتصر العلاقة بين الأدبين العربي والفارسي على الأدب القديم وإنما امتدت إلى الأدب الحديث. وكان أنوار سهيلي قد ترجم (كليلة ودمنة) إلى الفارسية, ومن ثمَّ ترجمت إلى الفرنسية فتأثر بها لافونتين (1621 1695م) وحاكاها, ثمَّ تأثر الأدب العربي الحديث بها, إذ ترجمها من العرب المحدثين محمد عثمان جلال (ت 1898م)؛ فقد ضمّ كتابه (العيون اليواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ) كثيراً من حكاياتها وأفكارها..., واتسمت حكاياته بالإيجاز واستخدام بعض الألفاظ العامية فضلاً عن تأثره بحكايات لافونتين... ومن أبرز التقاطع بين حكايات محمد عثمان جلال والشعر الفارسي أنه نظمها على فن المزدوج/المثنوي عند الإيرانيين؛ في وحدة القافية بين البيتين دون التزامها في القصيدة كلها كما في قصة (الثعلب مقطوع الذنب)(18).
وفي هذا المقام لا ننسى أن نشير إلى أمير الشعراء أحمد شوقي الذي كتب خمسين قطعة على لسان الحيوان تؤكد تأثره بحكايات (كليلة ودمنة) وأفكارها كقصيدته (الثعلب والديك), ومنها تظاهرُ الثعلب بالتقوى والصلاح, وتخلّيه عن كل مكائده وفتكه بالطيور...(19). وإذا كانت الخرافات والأساطير إحدى نقاط الالتقاء بين العرب والإيرانيين فإن كليلة ودمنة جمعت هذا إلى جوانب أخرى.
وليس هناك كتاب يتفوق على (كليلة ودمنة) إلا رباعيات الخيام لأبي الفتح غياث الدين عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري (430 526ه) التي نظمها بالفارسية, فضلاً عمَّا قيل: إنَّ له أشعاراً حسنة بالعربية والفارسية؛ وكذلك كتب بالعربية (مقالة في الجبر والمقابلة) و(رسالة في الوجود) وغيرها(20)؛ فهو أحد أصحاب اللسانين...
ولعل مقام البحث ومنهجه يتأبّى عن الإفاضة برباعيات الخيام وترجماتها؛ وما قيل في شأنها وشأن صاحبها, فقد تكفلت فيه دراسات شتى شرقاً وغرباً... ولكننا نتوقف عند قيمة الرباعيات باعتبار ما انتهت إليه من بناء علاقة كبرى بين الأدب الفارسي والأدب العربي ولا سيما الحديث.
وإذا كان كتاب (جَهار مقاله) للعروضي السمرقندي أقدم وثيقة تاريخية عُنيت بالخيام وفلسفته وطبه وفلكه فإن صاحب حواشي ذلك الكتاب قد أثبت رباعية للخيّام, كما أثبت كتاب (فردوس التواريخ) رباعية لا بأس بها...(21).
ثمَّ وثّق المحققون له رباعيات تراوحت بين (16 و56) وربَّما زاد عددها, فاشتهرت به كما اشتهر بها فأضيفت إليه (رباعيات الخيام) علماً أن فن الرباعيات معروف منذ أواخر القرن الثالث الهجري لدى الشعراء الإيرانيين, ونظم عليه مثلاً شهيد البلخي (ت 325ه) والرودكي السمرقند (ت 329ه) والدقيق الطوسي (ت 368ه) وغيرهم(22).
ولعل التقاء الرباعيات بفنون عربية كالمشطرات والمربعات والمخمسات لم يكن عرضاً علماً أنها نظمت على وزن الهزج وغيره... وإن تفردت عنها بتكرار المعاني وتفتيق الأفكار... أمَّا التقاؤها بالأدب العربي الحديث فقد كان معنياً؛ إذ أحدثت الرباعيات نشاطاً أدبياً وفكرياً ونفسياً عظيماً, في الوقت الذي دلت على نزوع عقلي امتزج بحس مرهف, وبعاطفة شفافة في معالجتها للبحث عن سر الوجود: الحياة/الموت.
ولهذا فإن ترجماتها العربية زادت على خمس عشرة ترجمة منذ ترجمة وديع البستاني لها سنة (1912م) عن الترجمة الإنكليزية التي قام بها فيتز جيرالد عن الفارسية؛ سواء كانت ترجمة شعرية أم نثرية؛ فضلاً عن دراسات كثيرة وأبحاث أكثر عدداً. وإذا كان البستاني قد أحال الرباعية إلى سباعية فإن ترجمته دفعت من يتقن الفارسية إلى ترجمتها عنها مباشرة كما دفعت الناس إلى تعلم الفارسية لينقلوا الرباعيات عنها كما حدث مع الشاعر أحمد رامي...
ولا مراء في أن ترجمة أحمد الصافي النّجفي تتميز بشفافية عالية سكب فيها روحه ورؤاه؛ فقرَّب الرباعيات إلى الذوق العربي, وما سبقه في هذا إلا أحمد رامي الذي كان يقع تحت تأثير أحزانٍ وهموم لفقده أحد ذويه حين ترجمها سنة (1924م).... دون أن ننسى صوت أم كلثوم الذي أشاع بين العامة عدداً من الرباعيات من ترجمة أحمد رامي(23).
ولا نرتاب لحظة واحدة في أن فلسفة الخيام في الرباعيات تتقاطع في بعض ملامح منها بما نجده عند الشاعر المعري؛ ولا سيما ما يدور حول مفهوم الوجود ودورة الحياة؛ فالإنسان من تراب وسيعود إليه(24), أو حول مبدأ الشك واليقين(25)... ويبدو أن هذا كله امتد إلى شعر إيليا أبي ماضي ولا سيما قصيدته (الطلاسم) التي أنشدها بعد أن اطلع على ترجمة فيتز جيرالد للرباعيات, ومنها(26):
جئت لا أعلم من أين؛ ولكني أتيت
ولقد أبصرت قدّامي طريقاً فمشيت
وسأبقى ماشياً إنْ شئت هذا أم أبيت
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟
لست أدري.
ولما انطلق الخيام من المبدأ المادي باعتباره شرطاً لوجود العالم وهو بخلاف الموجود الأزلي القديم رأينا إيليا أبا ماضي يحذو حذوه في غير ما مكان من قصيدته السابقة(27).
ولم يقتصر الأمر على المعري وأبي ماضي بل امتد أيضاً إلى جماعة الديوان كعباس محمود العقاد (1889 1984م) الذي بدأ أولى مقالاته عن الرباعيات سنة (1908م) وأتبعها بدراسات أخرى فضلاً عن معارضته إياه برباعيات أخرى؛ وعبد الرحمن شكري (1886 1958م) الذي ترجم ثلاث رباعيات وكتب عنها؛ وإبراهيم عبد القادر المازني (1890 1949م) الذي كان أكثر تأثراً بالرباعيات من صاحبيه, وردَّ عن الخيام تهمة النزعة الأبيقورية ونزعة التصوف(28).
ولعل ما أرسته رباعيات الخيّام من قواسم مشتركة بين الأدبين العربي والفارسي فناً وأسلوباً, فكراً ونقداً يدفع بنا إلى إحياء مؤسسات مشتركة بين العرب والإيرانيين لترجمة آدابهما وتراثهما ومؤلفاتهما المختلفة في كل اتجاه... فلماذا لا نجدّد روح (بيت الحكمة) الذي أنشئ في العصر العباسي في بغداد؟!!
ونكتفي بما أشرنا إليه دون أن ننسى عوامل الالتقاء الأخرى التي أدت ازدياد التقارب بين العرب والإيرانيين, وتمازجهما في الحياة والفكر... ويعد الجاحظ (ت 255ه) أحد الأدباء الذين مارسوا ذلك قولاً وفعلاً... فلما أهدى كتابه (الحيوان) إلى الوزير ابن الزيات أهدى (البيان والتبيين) إلى قاضي القضاة ابن أبي دؤاد, وكتاب (الزرع والنخيل) إلى إبراهيم بن العباس الصولي...
ومن يقرأ كتابه (البخلاء) الذي قدمه إلى أحد الأعيان يجد تمازجاً حضارياً فكرياً واجتماعياً مدهشاً سيق بأسلوب أدبي طريف لكل من بخلاء العرب والفرس(29).
وفي نهاية هذا الاتجاه من الترجمة والتأليف لا يمكننا أن نغفل التنويه بفضل المقامات الأدبية التي نشأت عند العرب وأبدعها بديع الزمان الهمذاني (ت 398ه) وأبي محمد القاسم بن علي الحريري (446 516ه) ثمَّ انتقلت إلى الأدب الفارسي على يد القاضي أبي بكر حميد الدين عمر بن محمود البلخي (ت 559ه). وقلَّد في مقاماته المقامات العربية أسلوباً ومادة؛ وإن ظهر فيها تأثير الروح الفارسية كالتفنن في الأساليب, وسميت بأسماء بعض مناطق فارس كالمقامة البلخية, والسجستانية, والأذربيجانية والجرجانية والأصفهانية وغيرها... دون أن ننسى أن مقامات الحريري تقاسمت الروح الفارسية في الموضوعات والأساليب مع المقامات الفارسية؛ علماً أن حميد الدين كان أكثر تأثراً بها... وقد عرض لذلك عدد من الدارسين والباحثين(30).
ولعل أهم ما فعلته المقامات من تقاسم مشترك بين الأدبين العربي والفارسي, ومن ثمَّ في الحياة, أن استخدام الألفاظ العربية قد كثر على الألسنة, وشاع استعمال أنماط من التراكيب العربية الكاملة في سياق ما يستدعيه موضوع ما...
ونكتفي بما ذكرناه لننتقل منه إلى القواسم المشتركة في اللغة والأشكال الفنية وفي بعض الموضوعات الأدبية...
3 القواسم اللغوية والفنية
يعدُّ الالتقاء الحضاري اللغوي والبلاغي والأسلوبي والفني من أبرز وجوه التفاعل بين الأدبين العربي والفارسي منذ القديم؛ وذلك لعظمة التمازج التاريخي والاجتماعي بين الشعبين العربي والإيراني.
فمن منا ينسى استنجاد ملك اليمن سيف بن ذي يزن (ت 50 ق.ه) بكسرى أنوشروان (ت سنة 1 ق. ه) لطرد الأحباش, فأسرع إلى تلبية رغبته؟ وظل لهذه الحادثة التاريخية أصداؤها في الحياة والأدب؛ وممن أشار إليه البحتري (ت 284ه) في قوله(31):
أَيّدوا مُلكنا وشدُّوا قواه *** بكُمَاة تحت السَّنَوَّر حُمْسِ
وأعانوا على كتائب أَرْيا *** طٍ بطَعْن على النحور ودَعْسِ
ومن ثمَّ ما جمعت حادثة تاريخية بين الشعبين كتلك التي جرت أحداثها بعد الإسلام بمقتل سبط رسول الله () الحسين بن علي () في كربلاء, فألهبت عواطف الأدباء والشعراء فكانت مصدراً ثراً للأدبين.
ونكتفي بهذين المثالين لنثبت القواسم المشتركة في اللغة ألفاظاً ومصطلحات وتراكيب وصوراً... فكان أبناء العربية يتداولون الألفاظ الفارسية ويتعلمون لغتها, بمثل ما كان أبناء إيران يسعون منذ القديم إلى تقليد الحياة العربية؛ ويتعلمون لغتها ويقرضون أشعارها... وكلّنا يذكر أن الملك الساساني بَهْرام كَور (جور) أرسله أبوه إلى الحِيْرة, ليقوم النعمان بن المنذر على تربيته وتعليمه العربية... وقد تمَّ له ذلك؛ وقيل: إنه تجاوز تعلم اللغة وقرض الشعر... وكذلك كان الشاعر عدي بن زيد وابنه زيد مترجمين لكسرى أنوشروان, وظهرت كثير من الألفاظ الفارسية في شعره وشعر غيره كطرفة بن العبد وأعشى بني قيس...(32)
وكان عدد من العرب قد سمَّوا أبناءهم وبناتهم بأسماء فارسية مثل (قابوس) بن النعمان بن المنذر, ودختنوس بنت لقيط بن زُرَارة, فضلاً عن تسمية بعض بطون قبائلهم بتلك الأسماء, كالأَسْبذيين الذين ينتسبون إلى (أَسْبذ). وهو لفظ مأخوذ من كلمة فارسية (أسب) وتعني (الفَرس) وذكر ذلك طرفة في قوله(33):
خذوا حِذْركم أهل المُشَقَّر والصَّفا *** عبيدَ اسْبَذٍ والقرضُ يُجْزى من القرضِ
وفي ضوء ذلك يمكننا أن نستدعي شاهداً واحداً من شعر الأعشى ليؤكد عظمة دوران الألفاظ الفارسية على ألسنة الأدباء والناس في العصر الجاهلي؛ وهو قوله(34):
لنا جَلَّسان عندها وبَنفسجٌ *** وسيْسَنْبرٌ والمَرْزجوشُ مُنَمْنَما
وآسٌ وخِيريٌّ ومَرْوٌ وسوسن *** إذا كان هِنْزَ مَنْ ورحت مُخَشَّما
وشاهَسْفِرم والياسمين ونرجسٌ *** يُصبّحنا في كل دَجْن تَغَيَّما
ومُسْتقُ سينين ووَنٌّ وبَرْبَط *** يجاوبه صَنْج إذا ما ترنَّما
فأصل (جَلّسان) في الفلاسية: (كَلشن) و(بنفسج: بنفشه) و(سيسَنْبر: سيسنمر) و(مرزجوش: مرزن كَوشَ) و(شاهسفرم: شاه سبرغم) و(ياسمين: ياسمن) و(وَنّ: وَنَكَث) و(بربط: بربت) و(صنج: جَنكث) على حين اتفقت العربية والفارسية بالألفاظ الأخرى (آس, خيري, سوسن؛ مستق).
ويبدو لي أن لفظ (ناهد) ومعناه الفتاة التي برز ثدياها انتقلت إلى الفارسية بالمعنى ذاته, وورد استعمالها في كتاب (الأَفستا)؛ أما أستاذ اللغات القديمة في جامعة طهران (بَهرام فره وش) فذهب إلى العكس(35).
ثمَّ جاء الإسلام؛ فاستعمل القرآن الكريم عدداً من الألفاظ الفارسية المعربة مثل (سُنْدس واستبرق, ومَرْجان ومسك؛ وزنجبيل, وسِجِلّ وسُرَادق...).
ولما انتشرت اللغة العربية بانتشار الدين الجديد ازداد دوران الألفاظ العربية على الألسنة وصارت لغة الآداب الفارسية في كثير من العلوم والفنون وتغلغلت في كل مجال؛ ثمَّ في كل كتاب فارسي... وهذا أكثر شهرة من أن يقف الباحث عنده؛ فلو تصفح أحدنا أي كتاب في الشعر أو غيره لتأكد له ذلك... فضلاً عن أسماء الكتب؛ والعنوانات العربية, وعن وضع المعاجم اللغوية الفارسية على غرار المعاجم العربية. ولعل أقدم معجم فارسي هو (لغة الفرس) لعلي بن أحد الأسدي الطوسي (ت 465ه).
وامتد الأمر إلى المصطلحات اللغوية في الأدب والفن والعمارة والفقه والحديث وعلوم القرآن والفلسفة والتصوف... وهذا ميدان عريض لا يحدُّ, وهو ما يجعلنا ننتقل إلى استمرار استعارة العرب للألفاظ الفارسية من العامة والخاصة ولا سيما في العصر العباسي... وشاعت في الحياة والأدب كأسماء الأعياد والنرد وغيرها, كما نراه في شعر البحتري, ومنه قوله(36):
يرمي فما يشوي ويقتل من رمَى *** بسِهامِ لا هَدَفٍ ولا بُرْجاسِ
ويتردد في شعر البحتري مثلاً ألفاظ فارسية لأعلام وأماكن وجماعات وغير ذلك...، ولم يقتصر الأمر على ذلك فهناك من أدخل في شعره ألفاظاً فارسية على سبيل التملّح كقول العُمَانيّ للرشيد يمدحه(37):
لمّا هوى بين غياض الأُسْدِ *** وصار في كفِّ الهِزَبْر الوَرْدِ
آلى يذوق الدَّهْرَ آبِ سَرْدِ
والتملح في لفظ (آب سَرْد) وآب: يعني (الماء) وسَرْد: يعني (البارد).
ومن هنا ننتقل إلى بعض الأساليب اللغوية والبلاغية التي تبادلها الأدبان العربي والفارسي... فقد كثر اقتباس القوالب اللغوية والأسماء بعينها؛ سواء كان ذلك من لغة القرآن والحديث أم لغة الأدب وعلوم اللغة وغيرها, فضلاً عن استبدال بعض المصطلحات بما يوازيها معنى ولفظاً, فالمزدوج هو المثنوي عند الفرس, والتجنيس المطلق يطلق عليه لدى البلاغيين الفرس (المتشابه)(38) وعلوم البلاغة ومصطلحاتها وشواهدها عند العرب نجدها بدقائقها في كتاب (حدائق السحر في دقائق الشعر) لرشيد الدين البلخي.... أمَّا كتاب (أنوار البلاغة) لمحمد هادي بن محمد صالح المازندراني أحد علماء المسلمين في القرن الحادي عشر فقد تأثر كثيراً بكتابي (المطول) و(المختصر) للتفتازاني(39).
وأساليب البلاغة ومصطلحاتها التي تبادلها الأدباء والبلاغيون والنقاد كانت تشكل قاسماً مشتركاً كبيراً بين الأدبين؛ علماً أن الأدب الفارسي أفاد في هذا الشأن من الأدب العربي... فلن يبلغ الأديب شأواً بعيداً إذا لم يكن على دراية بها... ولم يقع الاختلاف إلا في أساليب قليلة؛ فلما فضّل الشعراء العرب صنعة (التصريع, والترصيع, والإيجاز والتكثيف) فضّل الشعراء الفرس صنعة (السؤال والجواب؛ وتفريع الأفكار) كما رآه الوطواط(40).
وهذا يفرض علينا الإشارة السريعة إلى الأساليب الفنية الأدبية التي غدت قاسماً مشتركاً بين الأدبين... فلما شاع إنشاد الأشعار باللغتين العربية والفارسية أخذ الشعراء ينظمون الشعر مزاوجين بينهما؛ فإما أن يكون شطر لكل منهما وإما أن يكون بيت وأطلق على هذا الصنيع (المُلَمَّعات) وهذا ما نجده عند الشاعر حافظ الشيرازي (ت 791ه)؛ إذ يستهلّ أشهر مُلمَّعة عند العرب والفرس بقوله من الهزج(41):
ألا يا أيها الساقي *** أَدر كأساً وناولها
كه عشق آسان نمود *** أوّل ولى افتاد مشكلها
وترجمة البيت الفارسي: إنَّ الحب سهل وممتنع في أوله ولكن متاعبه تكمن فيما بعد... ومن يتأمل البيت الأول يستشف أنه متأثر فيه بأبيات ليزيد بن معاوية... فالاستشهاد بنصٍّ كامل لم يعد مقتصراً على القرآن والحديث بل انتقل إلى الشعر العربي, وهو ما عرف بالاقتباس اللفظي ويعرف اليوم في النقد الحديث بالتناص اللفظي... وهذه الظواهر من الاشتراك الأدبي "أشهر وأرحب من أن نمثل لها ببضعة أمثلة. ونكتفي بأن نقرر أنها تكثر في الأجناس" الأدبية الفارسية والعربية المستحدثة(42). فالكتابات الديوانية والرسائل الديوانية والعلمية, والتوقيعات والتعليقات كلها انتقلت من بلاد فارس إلى العربية, وأفادت من أساليبهم الفنية فيها, ولا سيما العناية بالمقدمات والإطناب, والشرح في أنواع من الرسائل... وغدا ذلك كله قاسماً عاماً في الأدبين العربي والفارسي ابتداءً من عهد عبد الملك بن مروان, وخلفائه. وكان عبد الحميد الكاتب الفارسي الأصل تلميذاً بارعاً لسالم مولى هشام بن عبد الملك؛ فقدّم للأشكال الفنية والكتابية في الأدب العربي خدمات جُلَّى(43).
أمَّا ما يتعلق بوصف الخمر التي أولع بها أبو نواس وأمثاله في العصر العباسي فقد تطور كثيراً نتيجة التأثر بطبيعة حياة اللهو والأدب الفارسي(44)؛ على الرغم من أن العرب منذ القديم كانوا يتفنّنون في أوصافها كالأعشى.
ومن ثمَّ فقد أخذت الخمر اتجاهاً جديداً دخل في باب التصوف الذي اشتهر به العرب والفرس على السواء... ودخلت ألفاظ الخمر في باب الرموز الصوفية ودرجاتها عند عدد من شعراء الطرفين, بل إنَّ أبا نواس ارتقى في درجات عشقها ارتقاء المتصوفة في مقاماتهم.
ولعل فيما أشرنا إليه كفاية عن هذه الأنماط الفنية الأدبية لدى العرب والإيرانيين شكلت عظمة الالتقاء فيما بينهم... بيد أن المرء لا يمكنه أن يهمل ما يتعلق بالأوزان والقافية, وهو حديثنا الأخير في القواسم الفنية المشتركة لننتقل بعدها إلى الموضوعات لنوجز القول فيها.
وقد تناول باحثون عديدون ما يتصل بالأوزان والقافية في الشعر؛ فرأوا أن الأدب الفارسي القديم لم يعرف إلا الملاحم التي نظمت على بحر المتقارب المزدودج/المثنوي (وقد ظهر أول ما ظهر في الفارسية الحديثة بعد الفتح في شعر دقيق المتوفى عام (230ه/940م) الذي بدأ نظم (الشاهنامه) وفي شعره كثرت الرباعيات والمنظومات المثنوية من بحر الرمل والخفيف؛ كما بدأ نظم (كليلة ودمنة) أيضاً في مثنوي بحر الرمل"(45).
ومن ثمَّ نتبين أن الوزن لم يأخذ طريقه إلى الأدب الفارسي قبل القرن الثالث الهجري, ولا عرف القافية الواحدة, وإن وقعت في الشعر الفارسي الإسلامي في المزدوج والرباعيات, والقصيدة العادية... والملمعات... وهذا يعني أن الأوزان والقافية انتقلت من الأدب العربي إلى الأدب الفارسي؛ وغدت قاسماً مشتركاً بينهما. ويقع (المتقارب) في الدرجة الأولى عند الشعراء الإيرانيين؛ ويليه الهزج والرمل والخفيف, على حين ندر استعمال بقية الأوزان؛ علماً أن الطويل والكامل والبسيط ثمَّ الوافر والسريع والمتقارب أكثر شيوعاً في الأدب العربي من البحور السابقة...
ويظن الدكتور محمد غنيمي هلال أن الإيرانيين ربَّما عرفوا في العصور القديمة قبل الإسلام أوزاناً شعبية قريبة من الهزج أو من الرجز(46)؛ وهما بحران مستعملان بكثرة في الشعر العربي منذ القديم...
وليس هناك مراء في أن الأدب الفارسي أنتج فن (المثنوي) ذي القافية الواحدة بين مصراعي البيت الواحد دون باقي القصيدة؛ كما أبدع فن (الرباعي) المكون من أربع شطرات ذات قافية موحدة, وكل رباعية مستقلة بذاتها عمَّا قبلها وبعدها... وإن كان العرب قد عرفوا المشطرات والمربعات والمُخَمّسات, ثمَّ أبدعوا الموشحات ذات النهج الجديد في البناء والقافية, وهي التي أثرت في نشأة شعر التروبادور الأوربي. وما يشبه الموشحات إلا فن الزجل, وكلاهما فن شعبي(47) يعالج موضوعات مختلفة كالمدح والغزل, على حين تحاول الأناشيد الدينية المشتركة أنْ تعالج موضوعات صوفية.
هكذا يسلمنا الحديث إلى سمة عالمية مشتركة بين آداب الأمم المختلفة بما فيها الأدب العربي والفارسي وهي سمة القصة والسرد؛ وإذا كان أول ظهور لها في النثر اليوناني القصصي, علماً أن هناك عناصر قصصية في ملاحم اليونان وبعض أشعار العرب القدماء وسير ملوك فارس وحكمائها فإن أول ظهور لها في النثر العربي والفارسي كان في العصر الحديث وقبلها ظهرت المسرحية والمقالة باعتبارهما فنين جديدين.... اللهم إذا استثنينا من ذلك قصص الفروسية والعشق, والسِّيَر الشعبية كسيرة عنترة وسيرة كسرى أنو شروان وأمثالهما؛ وقصة ألف ليلة وليلة, وحي بن يقظان...(48)
وبناء على ما تقدم كله يتضح لدينا بعض القواسم المشتركة اللغوية والفنية الأدبية والأسلوبية بين الأدب العربي والفارسي... وهي تلزمنا بتكثيف الكلام على الموضوعات من جهة المضمون أو الفكرة...
4 الموضوعات المشتركة
هناك موضوعات أدبية عدة تبادلها الأدبان العربي أو الفارسي, أو انتقلت من أحدهما إلى الآخر, ثمَّ رجعت إليه بصورتها الفكرية الجديدة؛ لتغدو قاسماً مشتركاً بينهما؛ وكانت في كل مرة تتخذ وظائف جديدة على نحو كبير.
ولعل موضوع وصف الطبيعة الجامدة والمتحركة, ووصف الممالك الزائلة والأطلال الدارسة من الموضوعات المشتركة والمهمة بين الأدبين العربي والفارسي... وتطور موضوع الأطلال كما هو في العصر الجاهلي إلى وصف الآطام والحصون والقصور الخربة؛ كإيوان كسرى, والصروح الرومانية القديمة أو الآثار الإسلامية التي تهدمت... وغدت موضوعات الوصف في هذا الاتجاه تحمل بُعداً عاطفياً ذاتياً, ووطنياً في بعض الأحيان...(49)
وإذا كان البحتري قد بكى إيوان كسرى ووصفه وصفاً رائعاً, وكأنه ببكائه يبكي خراب هذه المباني العظيمة؛ كما نجده في سينيته المشهورة؛ ومطلعها(50):
صنْتُ نفسي عمّا يُدنِّسُ نفسي *** وترفَّعْتُ عن جَدا كلِّ جِبْسِ
ثمَّ عارضه فيها أحمد شوقي في العصر الحديث ورثى آثار العرب في الأندلس, ثمَّ بكى أمجاد العرب الغابرة في قصيدته, ومطلعها(51):
اختلاف النهار والليل يُنْسي *** اذكرا لي الصِّبا وأَيَّامَ أُنسي
ومن قبلُ حذا حذوه الشاعر الإيراني منو جهري أحد شعراء القرن الخامس الهجري فوقف على الأطلال حين مدح عظيماً من العظماء, وكذلك فعل الشاعر الإيراني الآخر خاقاني وهو أفضل الدين إبراهيم بن علي الشيرواني المتوفى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي, ووصف إيوان كسرى(52).
وأخيراً نتوقف عند موضوع الحب العذري, وبخاصة قصة عشق قيس بن الملوح؛ مجنون بني عامر؛ لليلى العامرية... فهي من أعظم القصص في الأدبين العربي والفارسي في موضوع الحب والتدله والحرمان... وإذا كانت قصة المجنون عند العرب تجسد أخباراً مثيرة تناقلها الناس؛ فإنها لقيت لدى أدباء إيران رواجاً لا نظير له؛ ثمَّ اتّخذت شكل العمل الأدبي المتكامل بعد أن كانت مجرد أخبار متفرقة تعبر عن الحرمان والعذاب والمعاناة والعشق. وكان فضل الريادة في هذا للشاعر الإيراني (نظامي الكنجوي 530 595ه). وقد نظم قصة (ليلى والمجنون) في (4700) بيت عام (584ه) في أربعة أشهر(53).
ومن ثمَّ كان الحب العذري منطلقاً إلى الحب الصوفي في الأدب الفارسي؛ وهذا ما ظهر في صنيع (نظامي) ثمَّ نسج أحمد شوقي مسرحيته (مجنون ليلى) على منوال ما حيك عن المجنون في الأدب الفارسي الذي نقل إلى التركية؛ التي كان شوقي يجيدها(54).
وهذا لا ينسينا أن الأدب الصوفي نفسه "نشأ في الأدب العربي وعني به الكتاب عناية فائقة, ثمَّ نقل بعد ذلك إلى الأدب الفارسي, فعُني به الكتاب؛ ثمَّ انتقلت تلك العناية إلى الشعراء. وهكذا دخل عليه تطور في الأدب الفارسي حتَّى جاء وقت غلبت فيه التأليفات الصوفية الشعرية على النثرية في الأدب الفارسي؛ على حين كان العكس في الأدب العربي؛ إذ ظلت الغلبة للمؤلفات الصوفية النثرية على المؤلفات الشعرية الصوفية"(55).
ويعد الشاعر الإيراني جلال الدين الرومي: محمد بن محمد البلخي (604 672ه) من أعظم شعراء التصوف الإسلامي. وقد حدثنا عن طريق السالكين المملوءة بالمصاعب والدم, وهو يقص علينا عشق المجنون... وينتهي إلى ذكر عدد من مقامات الصوفية في قصيدته (شكوى الناي). فالناي لديه رمز للروح التي كانت في عالم الذر, فلمّا تجلى الله للروح سكنت الجسد(56). وهي في ثمانية عشر بيتاً افتتحها بالمثنوي, فقال:(57)
بشنو أين نى جون شكايت في كند *** ازجدا بى ها حكايت في كند
والمعنى: استمع للناي كيف يقص حكايته. إنه يشكو آلام الفراق. وترجمها محمد الفراتي شعراً فقال:
اسمع النايَ مُعْرِباً عن شكاتِهْ *** بعد أن بات نائياً عن لِداتِهْ
ووظّف الشاعر الكبير محمد إقبال حكاية المجنون في الأدب الصوفي الحديث في قوله(58):
ما زال قيسٌ والغرام كعهده *** وربوعُ ليلى في ربيع جمالها
وهضاب نجدٍ في مراعيها المها *** وظباؤها الخفرات ملءُ جبالها
والعشق فيّاض وأُمَّة أحمد *** يتحفّز التاريخُ لاستقبالها
هكذا أدّى العشق العذري والحرمان فيه إلى إثارة خيال المتصوفة, وأوقد ذاكرتهم فأبدعت أفكاراً شتى دخلت العرفان الفارسي من الباب الواسع, ومن ثمَّ أخذت تنتقل إلى الأدب العربيّ فنتج عنها قواسم مشتركة فناً وفكراً.
وهذا ما ينطبق على موضوعات أخرى كأغراض المدح والغزل وغيرهما. إذ يضيق المجال بهذه الموضوعات لو تتبعناها؛ وحسبنا ما وقفنا عنده ممَّا يؤكد عظمة الالتقاء بين الأدبين العربي والفارسي؛,,, ولعل هذا يطرد من نفوسنا أي استشعار بالفرقة والعداوة؛ لأنَّ المودة والمحبة كانت وراء ذلك التمازج قبل أن تكون الأحداث التاريخية والاجتماعية وراء عملية التقارب والتمازج لنعيد إلى ذاتنا جوهرها الأصيل الذي أسسه قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس فنحن شعبان في أمة واحدة...
المصادر والمراجع
(1) إبداع ونقد قراءة جديدة للإبداع في العصر العباسي د. حسين جمعة دار النمير دمشق 2003م.
(2) الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال دار العودة بيروت ط5 د/ت.
(3) الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت ط7 1986م.
(4) إيليا أبو ماضي: شاعر المهجر الأكبر زهير ميرزا نشر دار اليقظة العربية ومطبوعات المطبعة التعاونية اللبنانية بيروت ط2 1963م.
(5) تاريخ الأدب في إيران إدوارد براون ترجمة إبراهيم أمين الشواربي دار السعادة مصر 1954م.
(6) تاريخ الترسل النثري عند العرب في العصر الأموي د. محمد المقداد مكتبة الفرسان الكويت 1997م.
(7) تأثر جماعة الديوان برباعيات الخيام د. يوسف بكار أبحاث ندوة (العلاقات الأدبية واللغوية العربية الإيرانية) اتحاد الكتاب العرب دمشق 1999م.
(8) ترجمان البلاغة بالفارسية لمحمد بن عمر الرادوياني به تصحيح واهتمام أحمد آتش جاب دوم, شركت انتشارات أساطير تهران 1362 ه. ش.
(9) حدائق السحر في دقائق الشعر رشيد الدين محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري البلخي المعروف بالوطواط ترجمة د. إبراهيم الشواربي 1945م.
(10) دراسات في الأدب المقارن د. بديع محمد جمعة دار النهضة العربية بيروت ط2 1980.
(11) ديوان الأعشى تحقيق د. محمد محمد حسين المكتب الشرقي بيروت 1968م.
(12) ديوان البحتري شرح د. محمد التونجي دار الكتاب العرب بيروت ط2 1999م.
(13) ديوان حافظ الشيرازي تصحيح د. حسين إلهي خط غلام حسين أمير خاني انتشارات سروس تهران 1374 ه. ش.
(14) ديوان طرفة بن العبد دار صادر بيروت, والبيت المستشهد به لا يوجد إلا في هذه الطبعة من طبعات الديوان.
(15) ديوان أبي نواس تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي دار الكاتب العربي بيروت د/ت.
(16) رباعيات الخيام بين الأصل الفارسي والترجمة العربية د. عبد الحفيظ محمد حسن كلية العلوم جامعة القاهرة ط1 1989م.
(17) رباعيات عمر الخيام ترجمة أحمد الصافي النجفي دار طلاس دمشق ط5 1998م.
(18) رباعيات عمر الخيام ترجمة الشاعر الأردني عَرار: مصطفى وهبي التل تحقيق د. يوسف بكار مكتبة الرائد العلمية عمّان الأردن ط2 1999م.
(19) رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي تحقيق بطرس البستاني دار صادر بيروت 1967م.
(20) رسالة الغفران لأبي العلاء المصري تحقيق د. بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن دار المعارف بمصر ص 8 1990م.
(21) الشاهنامه لأبي القاسم الفردوسي ترجمة سمير مالطي دار العلم للملايين بيروت ط2 1979م.
(22) شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية بيروت 1979م.
(23) شروح سقط الزند تحقيق مصطفى السقا ورفاقه الهيئة المصرية العامة للكتاب نسخة عن طبعة دار الكتب المصرية 1945م.
(24) شكوى الشكوى: تأملات في قصيدة (شكوى الناي) د. عيسى علي العاكوب ضمن أبحاث ندوة العلاقات الأدبية انظر رقم 7.
(25) الشوقيات أحمد شوقي المكتبة التجارية الكبرى بمصر 1970م.
(26) الظواهر المسرحية عند العرب علي عقلة عرسان اتحاد الكتاب العرب دمشق ط3 1985م.
(27) العلاقات العربية الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل مجموعة من الباحثين مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ط1 1996م.
(28) فرهنك وازهاي فارسي عربي إي بهرام فره وش تهران 1968م.
(29) قصة الأدب الفارسي حامد عبد القادر مكتبة نهضة مصر القاهرة 1951م.
(30) القيان والغناء د. ناصر الدين الأَسد دار المعارف بمصر القاهرة ط2 1968م.
(31) كشف اللثام عن رباعيات الخيام لأبي النصر مبشر الطرازي الحسيني دار الكاتب العربي ط1 القاهرة.
(32) لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت 1955 1956م.
(33) ليلى والمجنون للشاعر الفارسي نظامي الكنجوي ترجمة عائشة عفة زكريا دار المنهل للطباعة والنشر دمشق 2001م.
(34) مختارات من الشعر الفارسي د. محمد غنيمي هلال الدار القومية للطباعة القاهرة 1965م.
(35) مروج الذهب للمسعودي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المطبعة التجارية الكبرى بمصر ط 4 1964م.
(36) المعجم في معايير أشعار العجم بتصحيح محمد قزويني ومدرس رضوي جاب سوم كتابفروشي تهران 1360ه. ش.
(37) المقامات الأدبية لأبي محمد الحريري مطبعة مصطفى البابي الحليب مصر ط5 1950م.
(38) مقدمة ابن خلدون دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط4 د/تا.
(39) ابن المقفع بين حضارتين د. حسين جمعة منشورات المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق 2003م.
(40) يوسف وزليخا لعبد الرحمن الجامي ترجمة عائشة عفة زكريا دار المنهل للطباعة والنشر دمشق 2003م.
________________________________________
(*)باحث وأستاذ في كلية الآداب في جامعة دمشق.
(1) العلاقات العربية الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل 113.
(2) ديوان البحتري 1/146.
(3) انظر مقدمة ابن خلدون 451 453.
(4) دراسات في الأدب المقارن 99 وانظر الظواهر المسرحية عند العرب 491 588.
(5) انظر مثلاً (يوسف وزليخا) لعبد الرحمن الجامي.
(6) انظر دراسات في الأدب المقارن100 والظواهر المسرحية عند العرب 523.
(7) انظر رسالة التوابع والزوابع 72 74 والظواهر المسرحية 276 وما بعدها.
(8) انظر رسالة الغفران 129 و132و139 141 والأدب المقارن 230 والظواهر المسرحية عند العرب 518 520 و525 وإبداع ونقد 135 136.
(9) انظر دراسات في الأدب المقارن 115 117.
(10) انظر دراسات في الأدب المقارن 143 150.
(11) انظر المرجع السابق 105 ومختارات من الشعر الفارسي 445.
(12) انظر الأدب المقارن 149 158 والأعلام 6/281 والظواهر المسرحية عند العرب 519 521 و525.
(13) انظر دراسات في الأدب المقارن 84 86.
(14) انظر ابن المقفع بين حضارتين 65 165 والظواهر المسرحية عند العرب 391 وما بعدها.
(15) انظر دراسات في الأدب المقارن 172 وما بعدها و194 وما بعدها والأدب المقارن 183 187.
(16) انظر دراسات في الأدب المقارن 186 192.
(17) انظر المرجع السابق 178 و187.
(18) انظر المرجع السابق 205 207 والأدب المقارن 189 193.
(19) انظر الشوقيات 4/150 والأدب المقارن 193 195.
(20) انظر كشف اللثام عن رباعيات الخيام 9 11 و27 و64 65.
(21) انظر المرجع السابق 70 87.
(22) انظر رباعيات الخيام بين الأصل الفارسي والترجمة العربية 38 و41 و68 و124.
(23) انظر كل ما ورد أعلاه في المرجع السابق 67 68 وما بعدهما و124 و295 وما بعدها.
(24) انظر المرجع السابق 143 144 وشروح سقط الزند 974 975.
(25) انظر مثلاً رباعيات الخيام بين الأصل الفارسي والترجمة العربية 318 ورباعيات عمل الخيام ترجمة النجفي 43 و77.
(26) إيليا أبو ماضي 193.
(27) انظر المرجع السابق 193 ورباعيات عمر الخيام ترجمة عرار 65.
(28) تأثر جماعة الديوان برباعيات الخيام 67 وما بعدها.
(29) انظر مقدمات كتب الجاحظ المذكور ة في المتن؛ وفي مواضعها.
(30) انظر دراسات في الأدب المقارن 223 وما بعدها و247 وما بعدها, وتاريخ الأدب في إيران 2/439 وما بعدها والأدب المقارن 200 و261 والظواهر المسرحية عند العرب 437 وما بعدها وعُد إلى المقامات الأدبية للحريري؛ وشرح مقامات بديع الزمان الهمداني, وتأمل فيهما.
(31) ديوان البحتري 2/635.
(32) انظر القيان والغناء 45 والشاهنامه 151 و153 و161 ومروج الذهب 1/161.
(33) ديوان طرفة بن العبد 66 وانظر لسان العرب (أسبذ دخدنس قبس).
(34) ديوان الأعشى 329.
(35) انظر فرهنك وازهاي فارسي عربي إي ص 3.
(36) ديوان البحتري 2/638 والبُرْجاس: غرض في الهواء يُرْمى به.
(37) انظر المعجم في معايير أشعار العجم 418 وترجمان البلاغة 11.
(38) انظر المرجعين السابقين والصفحات نفسها, ثمَّ انظر حدائق السحر 18 وما بعدها.
(39) انظر الأدب المقارن 284 285.
(40) انظر حدائق السحر 18.
(41) ديوان حافظ الشيرازي 33.
(42) انظر الأدب المقارن 284.
(43) انظر تاريخ الترسل النثري 434 و438 441 و445.
(44) انظر ديوان أبي نواس (ف) وما بعدها, وانظر فيه باب الخمريات الفهرس 731 746.
(45) انظر الأدب المقارن 269 270 وراجع فيه 265 268 ودراسات في الأدب المقارن 73.
(46) انظر الأدب المقارن 267 268.
(47) انظر الأدب المقارن 270 273.
(48) انظر المرجع نفسه 201 203 و220 223 و240 246.
(49) انظر الأدب المقارن 195 197 وقصة الأدب الفارسي 1/193.
(50) ديوان البحتري 2/631 وانظر الأدب المقارن 198.
(51) الشوقيات 2/45 وانظر الأدب المقارن 199.
(52) انظر الأدب المقارن 199.
(53) انظر ليلى والمجنون نظام الكنجوي 3 14 ودراسات في الأدب المقارن 291 293 و307.
(54) انظر دراسات في الأدب المقارن 333 وما بعدها و342 وما بعدها.
(55) دراسات في الأدب المقارن 25 26.
(56) شكوى الشكوى: تأملات في قصيدة شكوى الناي 50 51.
(57) المرجع نفسه والصفحة ذاتها.
(58) المرجع نفسه 60.
مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 97 - السنة الرابعة والعشرون - آذار 2005 - آذار 1425
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:7|
أَبو تَمّام
أبو تَمّامٍ حَبِیْبُ بنُ أَوْسٍ الطّائیّ، مِنْ أَساطِیْن الأَدَبِ وأُمرائِه، وعَلَمٌ فی الشِّعْر أَغَرُّ أَبْلَجُ، حَفّاظَةٌ له، ذوّاقَةٌ فی تَخَیُّرِ أَشْعار العرب وانْتِخابِها، آیَةٌ فی تَصَیُّدِ الجِیاد الحِسان مِنْها، ومَأْثَرَةٌ جَلِیْلةٌ مِنْ مَآثِرِ طَیِّئ، الّتی یَتَحَدَّرُ مِنْ أَصْلابِها، علا شانِئیْه بالشِّعْرِ والأَدَب، فغَمَزُوْهُ فی الحَسَبِ والنَّسَبِ، وزاد على ذلك غُلاتُهم فجَعلوه رُوْمِیَّ الأَرُومَةِ والمَحْتِد، نَصْرانِیَّ المِلَّةِ، وسَمَّوا أَباه «تدوس» أو «تیودوس»، وقد أَعانَهم حَبِیْبٌ على نَفْسِهِ برِقَّةِ دِیْنِه وتَخَفُّفِهِ فیه، عِلاوةً على سَدِّهِ أَبوابَ الرِّزْقِ علیهم حَیاتَه، واحْتِسائِهِ الصَّهْباء، وإِتْیانِه اللَّهْوَ فی الجَهْر والخَفاء، ومَیْلِه إلى ظاهرِ الطَّرَبِ واللَّعِب، حتّى شَكَّ فیه مُحِبُّوْه، وخَالَطَ أَفْئِدَتَهم رَیْبٌ لم تَنْقَشِعْ عنها سَحائِبُه.
وُلِدَ فی قریة جاسِم، مِنْ أَعْمال حَوْرانَ بسوریَة، وشَبَّ بها، لیس تَمِیْزُهُ مِنْ أَتْرابِه خِلالٌ ظاهرةٌ إِلاّ أنّه «كان أَسْمَرَ طُوالاً فیه حُبْسَةٌ وتَمْتَمَةٌ یسیرةٌ، حُلْوَ الكَلامِ فَصِیْحاً، كَأَنّ لَفْظَهُ لَفْظُ الأَعْراب»، وهو مع ذلك قَبِیْحُ الإِنْشادِ للشِّعْر، غَیْرُ مُحْسِنٍ فیه، ممّا أَحْوَجَه ـ بعد أنْ صَعِد نَجْمُه ـ إلى اتِّخاذِ غُلامٍ له، حَسَنِ الإِنْشاد للشِّعر، كان یُفَرِّقُ ما جَمَّعَ حَبِیْبٌ مِنْ قَوافیه، على ذَوِی الحُظْوَة والجَاه، المُصْغِیَةِ أَفْئِدَتُهم إلیه، حتّى قَطَعَتْ صِلاتُهُم لِسانَه، ومَلأَتْ هِباتُهُم وعَطایاهم فاه.
أَمّا بعد أَنْ خَرَجَ إلى النّاس ببِضاعَتِهِ، وعَظِیماتِ سَجایاه، فقد آمَنَ الخَلْقُ بمَواهِبَ فَذّةٍ رُزِقَها، وخِصالٍ عالیةٍ وُهِبَها، أَنْبَهَتْه بینهم نَباهَةً لَم یَخْمُل بعدها ذِكْرُه أَو یَسْقُطْ صِیْتُه، مِنْها: غَزارَةُ عِلْمِهِ، وسَعَةُ معرفتِه، وحُسْنُ اختیاراته ومُنْتَخَباته، مع حِدَّةِ ذكاءٍ، وحُضُورِ بَدِیْهةٍ، وسُرْعَةِ جَوابٍ، حتّى إنّه كان یُبادرُ المُتَكَلِّمَ بالجواب قبل انْقِضاء كلامِه، كأَنَّما اطَّلَعَ على سِرِّه، فعَلِمَ ما سیقول؛ مِنْ ذلك أَنَّه مَدَحَ الأَمیرَ أَحْمدَ بنَ المُعْتَصِم بقصیدتِه السِّیْنِیَّةِ، الّتی یقول فیها:
أَبْلَیْتَ هذا المَجْدَ أَبْعَدَ غایَةٍ
فِیْهِ، وأَكْرَمَ شِیْمَةٍ ونِحاسِ
إِقْدامَ عَمْرٍو، فی سَماحَةِ حاتِمٍ
فی حِلْمِ أَحْنَفَ، فی ذَكاءِ إِیاسِ
وكان أبو یُوسُفَ یَعْقُوبُ بنُ الصباح الكِنْدِیّ الفیلسوفُ حاضرًا؛ فقال ـ مُخاطبًا أبا تَمّام ـ: «الأَمیرُ فوقَ مَنْ وَصَفْتَ». فأَطْرَقَ أبو تَمّام هُنَیْهَةً، ثمّ ارْتَجَل قائلاً:
لا تُنْكِرُوا ضَرْبِیْ لَهُ مَنْ دُوْنَهُ
مَثَلاً شَرُوداً فی النَّدَى والبَاسِ
فاللهُ قَدْ ضَرَبَ الأَقَلَّ لِنُوْرِهِ
مَثَلاً مِنَ المِشْكاةِ والنِّبْراسِ
ولمّا تَلَقَّفوا القصیدةَ مِنْ یَدِه لم یُصِیْبوا فیها هذین البیتین، فعَجِبوا من سرعة فِطْنَتِه، واتِّقادِ قَرِیْحَتِه، وقولِه الشِّعر على السَّجِیّة، كأَنّما یُمْسِكُ بیَدَیْهِ أَزِمَّةَ القَوافی أَجْمَعِینَ.
أوّل ما نَشَرَ فضائلَ أبی تَمّام المَطْوِیَّة فی صدره، طَیَّ السِّجِل، سُبابٌ وتَهارشٌ نَهَضَا بینه وبین الشَّاعرِ المِصْریّ یُوسُفَ السَّرّاجِ، إِبَّانَ رحلته إلى مِصْر، شَهَراهُ وأَشْخصا ذِكْرَهُ عند الأُمَراءِ والوُلاة فی كلّ صُقْعٍ، ثمّ عَلِق قلبُه التَّسْفارَ والتَّطْواف فأَنْضى مَطِیّتَه فیهما، فوَفَدَ على المَأْمون بالعراق مادِحًا، ثمّ اسْتَقْدَمَه المُعْتَصِمُ بعده إجلالاً لقَدْرِه، وإِعظامًا لشأْنه، وقَدِم خُراسان فمَدَح بها عبدَ الله بنَ طاهر بن الحُسین، ووَصَل إلى إِرْمِیْنِیَة فمَدَح خالدَ بنَ یزید، فما زال هذا دَأْبُهُ، یُشَرِّقُ تارةً ویُغَرِّبُ أُخْرى، ولِسانُ حالِه یقول:
بالشّامِ أَهْلِیْ، وبَغْدادُ الهَوَى، وأَنَا
بِالرَّقْمَتَیْنِ، وبِالفُسْطاطِ إِخْوانِی
وكان فی حَلِّهِ وتَرْحالِه یجودُ بقوافٍ عَظُمَتْ صُدورُها بحُبٍّ جَمٍّ للعُرُوبَةِ وأَعْلامِها، وناءتْ أَعْجازُها بمَعانٍ إسلامیَّة جلیلةٍ، أظْهرُها وأَعْلاها ـ وكلّها ظاهرٌ عالٍ ـ ما جاء فی كلمته البائِیَّة فی فَتْحِ عَمُّورِیَّة.
انْمازَ شعرُ أبی تَمّام من غیره بغَلَبَة المعانی المُخْتَرعة علیه، وظهورِ نَفَسِ التّجدید فیه، فضلاً عن بُرُوزِ الصَّنْعة غیرِ المُتَكَلَّفَة، والتَّفَنُّنِ فی تطویعها دون مَشَقَّةٍ أَو إِنْعام نَظَر؛ أَعانَ حَبِیْبًا على ذلك حِسٌّ مُرْهَفٌ، ونَفْسٌ شاعرةٌ تَوّاقَةٌ إلى اخْتِراع المعانی، تَتَعَشَّق الجدیدَ وتَهْفُو إلیه؛ قال البُحْتُری عن سَعْی مُعَلِّمِه إلى تولید المعانی: «أبو تَمّام أَغْوَصُ على المعانی، وأنا أَقْوَمُ بعمود الشِّعر». وقال ابن الرُّومیّ: «أبو تمّام یطلب المعنى ولا یُبالی باللّفظ». ومن المعانی المُبْتكرة الّتی لم یُسْبَق إلیها حَبِیْبٌ، بل وَرَدَها صَفْواً لا كَدَر فیه، ثمَ ألْبَسها حُلىً قَشِیْبةً زاهِیَةً، تَسُرّ النّاظرین، قوله:
وإِذا أَرادَ اللهُ نَشْرَ فضِیْلَةٍ
طُوِیَتْ أَتاحَ لَهَا لِسانَ حَسُوْدِ
لَوْلا اشْتِعالُ النَّارِ فِیْمَا جَاوَرَتْ
مَا كانَ یُعْرَفُ طِیْبُ عَرْفِ العُوْدِ
وقوله:
لا تُنْكِرِیْ عَطَلَ الكَرِیْمِ مِنَ الغِنَى
فَالسَّیْلُ حَرْبٌ للمَكانِ العَالِی
وقوله:
یا أَیُّها المَلِكُ النَّائی بِرُؤْیَتِهِ
وجُوْدُهُ لِمَراعِی جُوْدِهِ كُثُبُ
لَیْسَ الحِجَابُ بِمُقْصٍ عَنْكَ لِی أَمَلاً
إِنَّ السَّماءَ تُرَجَّى حِیْنَ تُحْتَجَبُ
وآثارُ الصَّنْعَةِ فی شعر أبی تمّام ظاهرةٌ ظُهورًا لافِتًا، تُرَى فی بَدْو القصائد، وتَرِدُ فی تَضاعِیفِها، فمِنْ أَظْهَرِ ما یَفْجَؤُ النّاظرَ فی شعره خُرُوجُهُ على إِلْف العرب، مِنَ الابْتِداء بالوقوف على الأطلال والدِّمَن، ومُخاطَبَة صُواها، والبُكاء على رَحِیل ظَعائِنِها، إِذ كان یَهْجُم على المعنى المَنْشود فیُمُسكه بَتلابِیْبِه مِنْ دون أَنْ یَتَحَوَّجَ إلى تُكَأَةٍ لُغَوِیّة یَسْتَنِد إلیها، أو شَفاعةٍ مَنْ إِلْفِ الشّعراء قبله یَلُوْذُ بها، فهذه كلمته فی فَتْح عمُّورِیَّة بدأها بقوله:
السَّیْفُ أَصْدَقُ إِنْباءً مِنَ الكُتُبِ
فی حَدِّهِ الحَدُّ بَیْنَ الجِدَّ واللَّعِبِ
وقَصَد فیها ما یُوائِمُ المُقام مِنْ دون أنْ تُلْهِیَهِ المُقَدّمة، أو تَصرفَه عن غرضه، فأصابه، وذهب یَنْشُدُ الجناس (بین الحَدَّین) والطّباق (بین الجِدّ واللَّعِب) فاقْتادهما، وعَزَّزهما بقوله:
بِیْضُ الصَّفَائِحِ لا سُودُ الصَّحائِفِ فی
مُتُوْنِهِنَّ جَلاءُ الشَّكِ والرِّیَبِ
ومِنْ أَمْلَح ما وَرَد فی كلامه مِنَ التَّدْبِیْج، قوله فی رثاء مُحمّد بن حَمِیْد الطُّوسِیّ:
تَرَدَّى ثِیابَ المَوْتِ حُمْراً فَما دَجا
لَهَا اللَّیْلُ إِلاَّ وهْیَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرُ
فجَمَعَ بین الحُمْرة الّتی عنى بها القَتْل، والخُضْرَةِ الّتی عَنى بها ثِیاب الشّهداء؛ أی إِنّه لم یَنْقضِ یومُه حتّى أُبْدِلَ بثیابِه المُلَطّخَةِ بالدّمِ ثیابَ أهل الجنّة. وهذا ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ تَصَرُّف حَبِیْبٍ فی ثقافته، وسَعة اطّلاعه، غَیرَ أنّه إذا اعْتاصَ علیه معنًى مِنَ المعانی، أو حار فی تَطْوِیعه، فإنّه یلُوذُ بالكلام غَیْرِ المفهوم، ویَحْتَمِی بالغُمُوضِ وعُسْرِ التَّأویلِ، فإِذا سأله سائلٌ: لِمَ لا تَقول ما یُفْهَم؟ أجابه بقوله: وأنْتَ، لماذا لا تَفْهم ما یُقال؟!
تَصَدَّرَ أبو تَمّام مَجالسَ الشِّعْرِ، فلم یُصِبْ شاعرٌ مِنْ شعراء عصره فُسْحَةً فیها إلاّ بقَدْرِ ما یُصِیْبُ مِنْ رِضاهُ عنه، ولاسیّما مجالسِ الفَخْرِ والحَماسَة والأَمادِیْح ـ فإِنْ ذَهِل حَبِیْبٌ أَو تَغافَل عمَّنْ زاحَمَه، فلیس فی غیرِ الغَزَلِ والتَّشْبِیْب لَهُ نَصِیْب ـ واحْتَلَّ المَحَلّ الأَوّل بین شعراء عصره وأُدبائه، أهَّلَته لذلك قَرِیْحَتُه المُتَّقِدَة، وغَزارَة محفوظاته؛ إِذْ نَخَلَ أشعار العرب فی الجاهلیّة والإسلام، واسْتَظْهَرَ نُخالَتَها، فحفظ منها أربعةَ عشرَ أَلْف أُرْجُوزَةٍ مِنْ أراجِیْزِهم غیرَ القصائد والمَقاطِیْع، وتَلَقَّف أسالیبَ التّجدید ـ فوق ما رُزِق منها وأَصاب ـ مِنْ دیوانَی المُفْلِقَین المَطْبُوعَیْن، أبی نُواسٍ ومسلم بن الولید، وكان مُدِیْمًا للنَّظر فیهما، وحین سأله بعضُهم فی ذلك، قال: هما اللاَّتُ والعُزَّى.
وازَنَ النّقاد بین شعر حَبِیْبٍ وأشعارِ طَبَقَتِه، فذهب فریقٌ من الفُرَقاء إلى تفضیله على سائر الشّعراء، فهذا الصّولیّ یقول: «مَنْ تَبَحّرَ شعرَ أبی تمّام وَجَدَ كلَّ محسنٍ بعده لائذًا به». وقال المُبَرِّد: «ما یَهْضِمُ شعرَ هذا الرّجل إلاّ أحدُ رجلین: إمّا جاهلٌ بعِلْمِ الشّعر ومعرفة الكلام، وإمّا عالمٌ لم یَتَبَحَّرْ شعرَه، ولم یسمعه». وذهب آخرون، فیهم دِعبل الخُزاعِیّ، إلى غَمْطِ أبی تمّام مكانته، وازْدِراءِ عبقریّتِه، وكان دِعْبِلٌ، إذا سُئِلَ عنه، قال: «ثلثُ شعره سَرِقَة، وثلثه غَثٌّ، وثلثه صالح». أمّا ابن الأعرابی فقد أَنَكَرَ على حَبِیْب قَوافِیْه جَمْعاء، فقال:«إن كان هذا شعراً فما قالته العرب باطلٌ».
وفی المُوازَنة بین أبی تمّام والبُحْتُری والمُتَنَبّی نُصِیْبُ آراءً مُتباینةً یَنْظِمها قولُ الشَّرِیْف الرّضیّ: «أمّا أبو تمّام فخطیبُ مِنْبَر، وأمّا البُحْتُرِی فواصِفُ جُؤْذُر، وأمّا المُتَنَبِّی فقائدُ عَسْكر».
قضى أبو تمّام وهو والٍ على برید المَوْصِل، حیث ولاّه علیه مَمْدُوحُهُ الحَسَنُ بنُ وَهْب ـ وكان وَجِیْهًا مُقَدّمًا، وكاتِبًا شاعرًا ـ ودُفِن بها، فرثاه الشّعراء والكتّاب والوزراء، وأعاد له الحَسَنُ بن وَهْب مَدائِحَه مَراثیَ، فقال مِنْ كلمةٍ له:
سَقَى بِالمَوصِلِ القَبْرَ الغَرِیْبَا
سَحائِبُ یَنْتَحِبْنَ لَهُ نَحِیْبَا
فَإِنَّ تُرابَ ذاكَ القَبْرِ یَحْوِیْ
حَبِیْبًا كان یُدْعَى حَبِیْبَا
خَلّف أبو تمّام ابنًا له شاعراً، هو تمّام الّذی یُكْنَى به، أَوْرَثَه ظُرْفَه كلَّه، وبعضَ شعره، فكانوا یستضْعفون شعره، ویسْتَمْلِحون حدیثَه إذا تَكَلَّم، ویقولون: «یا بُعْدَ ما بینَه وبین أبیه، إِنْ لم یكنْ معه شِعْرُ أبیه، فمعه ظُرْفُه».
ترك أبو تَمّام تَصانِیْفَ جلیلةً أَثْرَتِ المكتبة العربیّة وأَغْنَتها، أَجَلُّها مُنْتخباته، الّتی بدا فیها أَشْعرَ منه فی شعره ـ على قوّة شعره وجَزالتِه، وعُلُوِّ صَنْعَته ـ فمِنْ رائقِ ما انْتَخَبَ: «دیوانُ الحَماسَة»، الّذی كَسَرَه على عشرةِ أبوابٍ: الحَماسة، والمَراثِی، والأَدَب، والنّسِیْب، والهجاء، والأَضْیاف والمَدِیْح، ثمّ ذَیَّله بالصّفات وما اختاره منه، والسَّیْر والنُّعاس، والمُلَح، ومَذَمَّة النِّساء، غَیرَ أَنّه حَبا باب الحَماسةَ ما یُربی على ثُلُثِ مُخْتاراتِهِ مِنْ أَشْعارِ العرب، ثمّ بالَغَ فی حِبـائِهِ فصَدَّرَ به كتابَه وجعله عُنْوانًا له، تَغْلیْبًا له على سائر أغراض الشّعر. و«كتاب الوَحْشِیَّات» ـ الحَماسة الصُّغْرَى ـ وهو مَقاطِیْعُ لا تُعْرف، أَغلبُها للمُقِلِّیْن مِنَ الشّعراء أو المَغْمورین منهم، وهو دون صِنْوِه الحَماسة فی حُسْنِ الاختیار وجَوْدَة الانْتِقاء. و«مختار أشعار القبائل»، وقف علیه البَغدادی صاحب الخزانة، ثمّ حُجِب فیما حُجِبَ من نفائسَ وقلائد، وهو أَصْغَرُ من دیوان الحماسة. و»نقائض جریر والأَخْطل»، ولیس له البَتَّة؛ قال المَیْمَنی عن نِسْبَته: «إنّ بعض المُتأَخّرین فی زَمَنِ الأَتْراك لمّا رأى عنوانه غُفْلاً عن ذِكْر المُؤلِّف، زاد بخطِّه الفارسی تألیف الإمام الشّاعر الأدیب الماهِر أبی تمّام»، وهو اختلاقٌ منه قبیح». ثمّ رَجّح ـ وَفْقًا لِمَا جاء فی فهرست النّدیم ـ أن یكون للأصْمعیّ، فضلاً عن ورود كنیته أبی سعید غیر ما مَرَّة فی مَتْنِه. و«دیوان شعره» وكلُّ تَصانِیْفِهِ السّالفة مطبوعٌ.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:6|
صورة
الدكتور محمد إقبال فی الأدبیات العربیة
یحتاج الحدیث عن الدكتور محمد
إقبال إلى اختصاصیین فی اللغات الأوردیة والفارسیة والإنكلیزیة، وفی
الفلسفة والشعر والسیاسة والعقیدة، لیتمكنوا من الإحاطة بجوانب عبقریته.
ولست واحداً من هؤلاء الاختصاصیین، ولا أعتقد أنه یحق لی خداع أحد بذكر بعض
ما هو معروف متداول عن هذا الفیلسوف الشاعر العظیم. وسأعترف، بادئ ذی بدء،
بأننی غیر راض عن بعض ما قرأته فی اللغة العربیة عن إقبال. ولعل عدم الرضا
هو الشیء الوحید الذی یحق لی امتلاكه دون أن ینازعنی فیه الآخرون. لكنه،
دون شك، لیس المسوغ الرئیس لما أقدمه هنا. ولأعترف أن سبب عدم الرضا هو
المسوغ المقبول عندی. وهذا السبب كامن فی أننی جمعت ما كتب عن الدكتور محمد
إقبال فی الأدبیات العربیة، مجلات كانت أم كتباً أم محاضرات أم كلمات فی
ندوات تكریم هذا الرجل الفذ. جمعت ما ضمته الأدبیات العربیة لأتعرّف الصورة
التی رسمتها هذه الأدبیات لرجل ذاع صیته فی الشرق والغرب. وما إن فرغت من
القراءة حتى اكتشفت التباین بین الصورة التی كان علیها الرجل فی الواقع
والصورة التی رأیتها مجسدة فی الأدبیات العربیة. وكنت مؤمناً أن هذا
الفیلسوف الشاعر أكبر بكثیر من الملامح التی رسمتها له الأدبیات العربیة.
فرحت أحاول التنبیه على ما تضمه هذه الأدبیات من جوانب الصورة الإقبالیة،
سواء أكانت هذه الجوانب تتعلق بحیاته أم كانت تتعلق بمؤلفاته وفلسفته
وشعره، انطلاقاً من صلته بالعرب وسعیه إلى معالجة مشكلاتهم.
أول ملامح الصورة الإقبالیة فی الأدبیات العربیة ما یتعلق بحیاة إقبال ومؤلفاته. فقد لاحظت أن المقالات(1) التی نشرت عنه طوال خمسین سنة من عام 1935 حتى عام 1985 انصرفت كلها تقریباً إلى ترجمة حیاته وسرد مؤلفاته، وخصصت بعض خواتیمها أو جانباً منها لحدیث عام عن فلسفته أو شعره. وكنت أتساءل دوماً: أما تكفینا مقالة واحدة للإلمام بحیاة هذا الرجل؟ غیر أن الإجابة عن هذا السؤال لم تكن هینة. إذ إن مقالة واحدة تكفی فی العادة للإلمام بحیاة الدكتور محمد إقبال إذا كانت دقیقة. وما قرأته لم یكن كذلك على الرغم من سعی الكاتبین إلى الدقة وإیمانی بصدق نیاتهم.
فقد قرأت أنه ولد عام 1876(2)، كما قرأت أنه ولد فی عام 1873(3). فقلت، وأنا أعلم أنه ولد عام 1877، لعل ذلك من قبیل الشائع فی كتب التراجم. فالناس یهتمون بالأعلام بعد نبوغهم، ویفوتهم فی هذه الحال زمن ولادتهم، وقلما فاتهم زمن وفاتهم(4). وربما كان الاختلاف عائداً إلى أن زمن ولادة إقبال لم یكن یعرف تسجیل الموالید بدقة، أو أن هناك تصحیفاً فی المراجع التی عاد إلیها الكتاب العرب. وربما كان هناك سبب آخر، إلا أن الاختلاف فی زمن الولادة یبقى أمراً بسیطاً. وما هو أكثر أهمیة أن حیاة محمد إقبال شهدت تطورات عدة، أبرزها الفترة التی تلت عام 1908. لكن المرء یقرأ فی الأدبیات العربیة شیئاً كثیراً عن إقبال دون أن یرافق ذلك توضیح لهذه التطورات. ومسوغ الإشارة إلى هذا الأمر كامن فی أن العرب معنیون بما آل إلیه تفكیر إقبال فی أمرهم. فقد آلمه خضوعهم للمستعمر الغربی، وتخلفهم، وفرقتهم، ومن ثم راح یدعوهم إلى الثورة. أو قل: راح یدعوهم إلى جوهر فلسفته الثوریة. لكن الأدبیات العربیة سكتت عن هذا الأمر(5) وكأنه لم یكن الشغل الشاغل لمحمد إقبال طوال ثلاثین سنة فی المرحلة الثالثة من حیاته (بین 1908-1938).
كذلك الأمر فی مؤلفات محمد إقبال. فقد توزعتها ثلاث لغات، هی: الأوردیة والفارسیة والإنكلیزیة. إلا أن الأدبیات العربیة ترجَّحت فی نسبة هذا الكتاب أو ذاك إلى الأوردیة أو الفارسیة، والشعر خاصة. كما ترجحت فی توثیق طباعة بعض الكتب، إضافة إلى تباین بسیط فی ترجمة عنواناتها إلى اللغة العربیة. فمن قائل أن "رموز بیخودی" مقالة فلسفیة، إلى قائل أنها دیوان شعری. ومن قائل أن "أسرار خودی" صدر عام 1915، إلى قائل أنه صدر عام 1916(6). ومن قائل أن "أسرار خودی" تعنی بالعربیة "أسرار الذات"، إلى قائل أنها تعنی "الأسرار الذاتیة"، وبین الترجمتین فرق فی المعنى. ویكاد التباین فی الترجمة یشمل غالبیة مؤلفات إقبال(7).
أخلص من ذلك إلى أن تقدیرنا محمد إقبال یفرض علینا التدقیق فی ترجمة حیاته وسرد مؤلفاته، بغیة مساعدة القارئ العربی على تعرف حیاة هذا الفیلسوف ومؤلفاته، ومنعاً للخلل فی الصورة التی نرسمها له. ومن ثم أعتقد أن المقالات التی كررت الحدیث عن سیرة حیاة إقبال وسردت مؤلفاته، كلها أو بعضها، كانت تشعر دائماً أن ما سبقها لم یف هذه الحیاة حقها ولم یسرد المؤلفات بدقة. لذلك راحت غالبیة هذه المقالات تخصص جانباً منها لهذه الحیاة وتلك المؤلفات. وهذا یقود إلى ما بدأت به من أن مقالة واحدة تكفی للإلمام بحیاة إقبال ومؤلفاته إذا كانت دقیقة. وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون العرب.
الأمر الثانی اللافت للنظر فی الأدبیات العربیة هو إهمال مزج جانبین هامین فی شخصیة محمد إقبال، هما اهتمامه بالوطن العربی وفلسفته الثوریة. وأذكّر هنا أننی لست مؤهلاً لتحلیل فلسفة إقبال. غیر أن المرء ما یفتأ یلاحظ أن الاختصاصیین نصوا على أن فلسفته تستند إلى ثلاث رواجب هـــی(8): جهاد النفس –الإنسان مسؤول- العشق. ولهذه الرواجب الثلاث صلة وثیقة بما كان العالم الإسلامی عامة، والوطن العربی خاصة، یعانیان منه فی النصف الأول من القرن العشرین. فهما محتلان متخلفان مجزآن تعتمل فیهما الأدواء والمفاسد، فما السبیل إلى خلاصهما من ذلك وعودتهما إلى الحضارة والرقی ورفعة الشأن؟.
إن السبیل، بإیجاز، هو محاربة الإنسان ما یعتمل فی دخیلته من ذاتیة مفرطة، وتحطیمه أغلاله التی زیّنها له وهم الحریة، وإیمانه أنه مسؤول، وأن واجبه یدفعه إلى أن یندمج بالشعب ویشاركه كفاحه من أجل إزالة التخلف والأوضاع الطبقیة الفاسدة والظلم والتسلط، كی یتمكن المسلمون عامة، والعرب خاصة، من تحریر وطنهم المغتصب، وجعل الإنسان فیه عزیزاً حراً كریماً. "فإقبال وجیله من المجددین جابهوا بجرأة مشكلة الحضارة الحدیثة، وضعوا الفرد المسلم والعربی وجهاً لوجه أمام مسؤولیته"(9).
أجل، كان الشرق متخلفاً والغرب متقدماً. لكن هذا الغرب فی رؤیة إقبال "زاخر بالحركة مجرد من المبادئ الخلقیة الأصلیة، فقیر بالحب والإیمان. سخر الطبیعة لأغراضه، ولكنه أخفق فی محو البؤس الإنسانی"(10). لذلك رغب إقبال فی أن یجمع الشرق بین الحب والعقل. ولكن، هل هذا ممكن دون تهیئة فكریة لمواجهة حدید الغرب ورصاصه ولؤمه ودخانه(11)؟ لابد من العشق إذن. ما العشق؟ إنه الطاقة التی تحطم القیود. فإذا عشقت مقصداً تمنیته فإن غیره لا یرضیك ولا یقنعك(12). علیك أن تعد العدة من أجل تحقیق هذا المقصد. لكن حرب العدو الخارجی لا یقل شأناً عن حرب العدو الكامن فی نفس كل إنسان. بل إن حرب التشتت والهوى والنزعات الفاسدة فی نفس الفرد ینتج عنها توحد النفوس وسیادة النظام، مما یجعل التغلب على العدو الخارجی سهلاً. ویحق للمرء هنا القول إن جوهر فلسفة إقبال الثورة كان قادراً على خدمة الوطن العربی لو التفتت الأدبیات العربیة إلى هذا المزج بین اهتمامات العرب وحالهم وطبیعة الفلسفة الثوریة لإقبال. لو وضحت الأدبیات العربیة أن العرب مطالبون بالتخلی عن الحسد والتشتت والتفرقة، والعودة إلى أساس حضارتهم الأخلاقی، لجعلهم ذلك وحده قلباً واحداً قادراً على مقارعة المستعمر الذی احتل بلادهم وجعل عزیز قومهم ذلیلاً.
خاطب إقبال العرب خاصة، والمسلمین عامة قائلاً لهم: "إنكم الآن تجتازون أدق مرحلة، وتمرون بأصعب دور فی حیاتكم السیاسیة. فعلیكم أن تحتفظوا بالارتباط الشامل والاتحاد القویم فی العزائم والجهود، وفی الوسائل والغایات. إننی لا أستطیع أن أخفی عنكم شعوری بأنكم فی سبیل تدارك هذه الحال الخطرة لابد من أن تناضلوا فی كفاح الحریة. ولا سبیل إلى محاولة أخیرة لكسب سیاسی إلا حیث تكون العزائم عزماً واحداً، والقلوب المتباعدة قلباً واحداً. وأن تتركز مشاعركم حول مطلب لا تختلفون علیه. إنكم تستطیعون ذلك، وبالقوة إن شاء الله، یوم تتحررون من القیود النفسیة، وحین تضعون أعمالكم الفردیة والاجتماعیة فی میزان ما تنشدونه من الأهداف العالیة والمثل الرفیعة"(13). هذا الخطاب الواضح المحدد الذی یشیر إلى جهاد النفس ومسؤولیة الإنسان وعشقه حریة شعبه وأمته لم یترجم إلى اللغة العربیة فی أثناء خضوع الوطن العربی للاستعمار الغربی، وإنما ترجم فی أخریات عام 1985. وكأن الأدبیات العربیة فی أیام الاستعمار غافلة عن هذا التفكیر الإقبالی فی حال الأمة العربیة، وارتباطه الوثیق بما عانى منه العرب أفراداً وجماعات على المستویات النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة. ویخیّل إلیّ أن إقبالاً لمس عزوف العرب عما خاطبهم به، فقال عام 1925، أو نحو ذلك: "ولكن العرب لا یعرفون شیئاً عن نغماتی الشجیة". یرید من ذلك صدى المعرفة الحقیقیة لشعره عند العرب كما نص صدیقة الوفی أبو النصر أحمد الحسینی الهندی(14).
أما شعر محمد إقبال فكان المعبر عن فلسفته. غیر أن الأدبیات العربیة لم تشر إلى شیء یتعلق بالمراحل التی قطعها شعره، وهی مراحل تتفاوت قوة وضعفاً. وقارئ هذه الأبیات یخیل إلیه أن شعر الدكتور إقبال واحد ما دام الكتاب یستشهدون به دون تفریق وتوضیح. وقد نص السید أبو النصر أحمد الحسینی الهندی قبل ثلاث سنوات من وفاة إقبال على أن الشعر الذی كتبه صدیقه إقبال مرّ بثلاث مراحل:
أ-مرحلة الطلبة وتنتهی هذه المرحلة عام 1905. یمتاز شعره فیها بسعة الخیال وابتكار المعانی، لكنه مجرد من دقة الفكر والتعمق. یجد القارئ فیه روح الحب ونشدان الجمال والترحیب بالعشق، لكنه فی النهایة تعبیر عن مرحلة الأمل بشیء غیر معلوم. فإقبال فی هذه المرحلة یتوق إلى المجهول الذی لم یتضح فی فكره بعد.
ب-المرحلة الثانیة هی مرحلة الزمن الذی عاش فیه فی أوربة بین 1905-1908 وهذه المرحلة أقل إنتاجاً، وأكثر إبرازاً لأثر مشاهداته فی أوربة. غیر أن روح الحب وطلب الجمال والترحیب بالعشق تبقى متجلیة فی شعر هذه المرحلة. وقد أضیف إلیها بدء علو أفكاره واتساعها، حتى أن اللغة الأردیة التی كان ینظم بها شعره- وهی لغة حدیثة آنذاك- ضاقت عنه فمال إلى النظم بالفارسیة.
ج-المرحلة الثالثة هی المرحلة التی تلت عودته من أوربة، أی بعد عام 1908 ففی هذه المرحلة حلّت السكینة والطمأنینة فی روح الشاعر محل التوقان والاضطراب، كما خف سلطان المحبة والجمال وحل محله توق إلى الحكمة والكمال، وقد جادت قریحة الشاعر فی هذه المرحلة فأصدر سبعة دواوین شعریة. كما تمكن من إبراز معالم فلسفته فی شعره وإیصالها إلى العالم أجمع. وكانت الأدبیات العربیة مطالبة بإبراز هذه المرحلة وتوضیحها لأنها أكثر التصاقاً بهموم العرب وتوجهاً إلیهم. ذلك أن شعر إقبال فی هذه المرحلة عبّر عن روح المسلم الشرقی الثائر ذی الحماسة الواضحة، فی حین تساجلت فی عشره روح المحبة والجمال والعشق فی المرحلتین الأولى والثانیة. إنه القائل فی هذه المرحلة یخاطب العرب: كل شعب قام یبنی نهضة وأرى بنیانكم منقسما فی قدیم الدهر كنتم أمة لهف نفسی كیف صرتم أمما
وقد نصت سمر العطار على أن إقبالاً "نصیر الحریة فی كل مكان، ینشد البعث لأمم الأرض قاطبة. وشعره سجل حافل بالأحداث التاریخیة والسیاسیة. فلقد واجه موسولینی برأیه فی قوة وحزم، وبسط له مغزى الحكم الدیكتاتوری. وحذر العالم من مكائد الیهود وأحابیلهم، ودحض مزاعمهم حینما كانوا یدّعون ملكیة فلسطین"(15) إلا أن الأدبیات العربیة عزفت عن تقدیم شعره إلى القارئ العربی على هذا النحو من التطور، وآثرت الحدیث العام عن هذا الشعر.
وقبل ذلك كله آثرت غالبیة الأدبیات العربیة تقدیم شعر إقبال منثوراً. وما كان نثر الشعر محل اهتمام القارئ العربی. إذ جرت العادة لدى غالبیة المترجمین على تقدیم الشعر الأجنبی منثوراً بعد خلعه من ثوبه الفنی(16). والشعر –كما هو معروف- عصی على الترجمة، یؤثر فی القارئ بلغته، فإذا نقل إلى لغة أخرى فقد معظم أثره. وقد لاحظ المرء فی أثناء قراءة شعر إقبال أن هناك من سرد معنى الأبیات الشعریة، وأن هناك آخرین غامروا بنظمها حسب وزن من الأوزان العربیة. ولعل أقدم المغامرین هو الدكتور عبد الوهاب عزام الذی ترجم كثیراً من شعر إقبال ونشره فی مجلة الرسالة(17)، كما نشر ثلاثة من دواوینه(18). حتى أن صادق آئینه وند عدّ إقبالاً واحداً "من كبار شعراء الفارسیة المعدودین". وأضاف أنه "نجم من نجوم سماء العرفان اللامعة الذین نادوا بالمعرفة والحریة والنضال والجهاد، وحددوا أهداف الأمة الإسلامیة ودفعوا الشعوب للحركة، مثل مولوی وحافظ وعراقی والحلاج وسعدنی، ممن قوّموا النفس الإنسانیة عن طریق وتحدید ذاتها وإمكاناتها وأهدافها الوجودیة وحدائها إلى مقامها المحمود فی الدنیا والآخـــرة"(19). أما أوزان الشعر التی نظم فیها إقبال مثل "مثنوی" و "قصیدة" و "رباعی" و "قطعة" و "مسدس" فلم تتح للقارئ العربی فرصة الاطلاع علیها، مما حرمه من أداة التعبیر التی استخدمها إقبال وبزّ فیها أقرانه.
ولا تنتهی القضیة هنا، ذلك أن إغفال التطور الشعری المواكب للتطور الفكری عند إقبال جرّ معه إغفال عرض الشعر المعبر عن الفلسفة الثوریة للرجل، والاهتمام بالشعر المعبر عن العشق وروح المحبة وطلب الجمال(20). أی أن المترجمین العرب اهتموا بترجمة شعر المرحلتین الأولى والثانیة بأكثر من اهتمامهم بشعر المرحلة الثالثة المواكبة لرسالة إقبال وضوحاً وعمقاً. فقصیدة "فلسطین" التی دعا فیها العرب إلى "الوقوف صفاً واحداً من أجل إحباط مؤامرات الصهیونیة العالمیة، ودحض الافتراءات الیهودیة وتفنید عزائم الصهیونیین وأفكارهم الإجرامیة"(21) صدرت فی دیوانه "بال جبریل" الصادر عام 1935. وقد ترجم الدكتور عزام الدیوان إلى اللغة العربیة بعد عامین(1937)، ولكن أحداً من العرب لم ینبه علیها فلم یكتب لها الذیوع والانتشار. كما عرض عبد المعین الملوحی ما یعتقد المرء أنه آخر التطورات الفكریة عند إقبال.
أقصد قصیدته "لینین أمام الله"(22). وهذه القصیدة –كما یقول الملوحی- "لم تكن تبدلاً فی اتجاه تفكیره كما قالت مجلة الثورة الأفریقیة، ولكنها على الأكثر كانت تعمیقاً لهذا التفكیر. بل إن هذه القصیدة لم تكن القطعة الأولى والأخیرة التی یفضح فیها مساوئ الرأسمالیة، ویدل على مواضع الشر فی الحضارة الغربیة، ولكنها كانت أكثر دلالة على إدراكه لهذه المساوئ، وأكثر إلحاحاً على ضرورة هدم الوضع الاجتماعی المتعفن لبناء مجتمع إنسانی شریف وحدیث"(23). لقد فرح أستاذنا الملوحی بهذه القصیدة حین قرأها فی مجلة الثورة الأفریقیة وترجمها ونشرها غیر كاملة، وأعلن آسفاً أنها لم تصله كاملة(24)، على الرغم من أنها إحدى قصائد دیوان "بال جبریل" أیضاً، وقد ترجمها الدكتور عبد الوهاب عزام كاملة إلى اللغة العربیة عام 1937 حین ترجم الدیوان المذكور. وهذا هو المقطع الأخیر من القصیدة:
هلموا فأیقظوا فی العالم الفقراء
هزوا أركان قصور الأغنیاء
أدفئوا دماء العبید بنار الثقة والإیمان
هبوا للعصفور قوة یصارع بها الشاهین
یوم سیادة الشعوب یقترب
فی خطوات حثیثة
لتتهدم صروح الماضی أینما كانت
لتحترق كل سنبلة فی الحقل
لا تكونوا طعاماً للفلاح
الحضارة الحدیثة
مصنع ینفخون فیه الزجاج
املؤوا صدر شاعر الشرق بغضب نبیل
یسحق به هذا المصنع سحقاً.
هذه القصیدة تعزز الرأی الصائب الذی ذكره عبد الكریم الیافی. فإقبال "لم یتخل عن مضامین التراث التی وعاها، ولا رفض قیم الحضارة الحدیثة التی اطلع علیها، وإنما كان وفیاً لمطالب الحیاة المستجدة، أمیناً على خزائن التراث الرفیعة. وإذا لهج بعض الفلسفات الفنیة الحدیثة بفكرة الالتزام فإنَّا لنجد فنه من أوله إلى آخره ملتزماً بحب الإنسان والسعی لإسعاده أیان كان. ینوه برفعته، ویشید بسموه، ویوجهه إلى أنبل الغایات وأعلى المقاصد. وهو فی أسالیب تعبیره عن ذلك لا یقطع الصلة بین تشوف الحاضر وصور الماضی"(25) تلك هی الأصالة عند إقبال. إنها النسغ الذی جعله یواكب الحضارة الحدیثة، فلا ینعزل عن الأفكار الثوریة التی سادت العالم فی العشرینیات والثلاثینیات، ولا یركن إلى المجد الذی حققه شعره، ولا إلى المكانة الفكریة والاجتماعیة التی احتلها بدأبه وإخلاصه وفلسفته.
یخلص المرء من الحدیث السابق إلى أن الأدبیات العربیة عُنیت بحیاة إقبال وشعره وفلسفته، إلا أنها قدمت فی أحایین كثیرة ملامح عامة عن هذه الأمور الثلاثة، وعنیت فی أحایین قلیلة بجانب من هذه الجوانب. ولم تصل فی الحالات كلها إلى تقدیم صورة شاملة لحیاته وشعره وفلسفته. ویجب أن یستثنی المرء من هذا الحكم شریحة من المثقفین العرب، درست حیاة إقبال وشعره وفلسفته بشیء غیر قلیل من الدقة، وألّفت عدداً من الكتب حوله، وترجمت بعض دواوینه. أذكر من هذه الشریحة الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله. فقد ألف كتاباً عنوانه "محمد إقبال سیرته وفلسفته وشعره"، وترجم ثلاثة دواوین، ونشر عدداً من المقالات فی مجلة الرسالة. وأذكر أیضاً حمید مجید هدو والصاوی علی شعلان ومحمد حسن الأعظمی ونجیب الكیلانی وعلی حسون وعباس محمود الذی ترجم كتاب إقبال "تجدید التفكیر الدینی فی الإسلام".
غیر أن جهود هذه الشریحة تبقى فردیة فی النهایة، وتبقى الفئة القارئة العربیة بعیدة نسبیاً عن هذه الجهود التی توزعتها السنون الخمسون الماضیة، دون أن یرفدها تخطیط لترجمة أعماله الكاملة النثریة والشعریة، وتعریف الأجیال العربیة الجدیدة بصاحبها. ولا عجب، بعد ذلك، أن تتكرر فی مقالات الكتّاب العرب وكتبهم أغلاط فی ترجمة حیاة إقبال. وبعدٌ عن توثیق المراجع العربیة التی تحدثت عنه، وأحكام عامة حول شعره، وعزوف عن تحلیل طبیعة ارتباطه بالعرب وطبیعة ارتباط العرب به. ولا نقلل من أهمیة الجهود العربیة حین نقول إن الغرب قدّر إقبالاً أكثر من تقدیر العرب له. فقد ترجم حسین دانش شعره إلى اللغة التركیة، وكتب مقالات كثیرة عن دیوانه بیام مشرق(26). كما تُرجم إلى الروسیة دیوان "أسرار خودی". وترجم دایشو روسو إلى الألمانیة مقدمة بیام مشرق، وكتب فیشر فی مجلة إسلامیكا مقالات كثیرة عن هذا الدیوان الذی ترجمه بعد ذلك هانسی مائنیكه. وأنشئت فی ألمانیة جمعیة لنشر مبادئ إقبال والتعریف بشعره. كذلك الأمر فی إیطالیا وإنكلترة. فقد نشر الدكتور اسكاریا الإیطالی كثیراً من المقالات عن إقبال، وترجم نكلسون دیوان "أسرار خودی" وجزءاً من بیام مشرق إلى الإنكلیزیة، وكتب المستشرق براون عن أسرار خودی مقالات فی مجلة الجمعیة الآسیویة. كما ألف العالم الأمریكی میكنزی كتاب "یقظة الهند" كان لإقبال فیه حیز كبیر.
وإذا كان اهتمام الغرب بهذا الفیلسوف الشاعر ینم عن مكانته، فإن العرب مطالبون بتقدیره أكثر من الغربیین لمكانته ولاهتمامه الخاص بهم. بل لأنه رأى نفسه واحداً منهم لجامع العقیدة بینهما. إن صورة الدكتور محمد إقبال فی الأدبیات العربیة ترضی الذین یملكون معرفة عامة بمكانة هذا الرائد فی الشعر والفلسفة والثورة. لكن هذه الصورة لا ترضی أولئك الذین غاصوا فی بحر علومه ورأوا لآلئه. ولعلنا نرضی هؤلاء الاختصاصیین بترجمة الأعمال الكاملة لإقبال، ونضع بین یدی الباحثین ثبتاً بما كتب عنه فی اللغة العربیة، تمهیداً لدراسته وتقدیم مواهبه وعبقریته وعظمته إلى القارئ العربی بموضوعیة.
الهوامش: (1)من أجل الابتعاد عن التعمیم أقول أن المراد هنا هو المقالات التی عثرت علیها فی المجلات التالیة: الرسالة (القاهرة) –الثقافة (دمشق)- التراث العربی (دمشق). وفی الكتب التی ضمت محاضرات الاحتفال بذكراه، كذكرى محمد إقبال (دمشق 1964)، ونداء إقبال (دمشق 1985).
(2)انظر ص1415 من: الهندی، السید أبو النصر أحمد الحسینی –الدكتور محمد إقبال –مجلة الرسالة- س3- العدد 113-2 أیلول 1935.
(3)انظر ص11 من: هدو، حمید مجید –إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان- مطبعة الفرى- النجف 1963. وص 9 من: مقدمة ذكرى محمد إقبال (مقالات الاحتفاء بإقباء فی دمشق 1964)، وفی هذه الصفحة أنه ولد فی 22 شباط، وورد فی أدبیات أخرى أنه ولد فی التاسع من تشرین الثانی. وانظر أیضاً ص45 من: العطار، سمر –إقبال الشاعر (محاضرات الاحتفال بذكرى محمد إقبال)- دار الفكر 1964 (4)اتفق الذین ترجموا حیاة الدكتور محمد إقبال على أنه توفی عام 1938.
(5)یستثنى من هذا الحكم الدكتوران یوسف عز الدین وعبد الكریم الیافی. فقد أشاروا إلى حال الأمة العربیة فی أثناء حدیثهما عن إقبال، من غیر أن یلوما الأدبیات العربیة على إهمالها ربط دعوة إقبال بما كانت علیه الأمة العربیة من تخلف وتجزئة وخضوع للمستعمر الغربی انظر ص10 من: الیافی، د.عبد الكریم –محمد إقبال فیلسوف الذات وشاعر العشق- مجلة التراث العربی- دمشق- العدد 23- نیسان 1986. وص6 من المقدمة التی كتبها الدكتور یوسف عز الدین لكتاب: إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان لحمید مجید هدو- مطبعة الفرى- النجف 1963. والملاحظ أن مقدمة المحاضرات التی احتفلت بذكرى إقبال فی دمشق عام 1964 أشارت إلى هذا الأمر أیضاً. والملاحظ أن مقدمة المحاضرات التی احتفلت بذكرى إقبال فی دمشق عام 1964 أشارت إلى هذا الأمر أیضاً. انظر ص7 من: ذكرى محمد إقبال- دار الفكر- دمشق 1964.
(6)كذلك الأمر فی دیوان "مسافر". فقد ذكرت الأدبیات العربیة تاریخین هما 1933 و 1934. ودیوان "رموز بیخودی" الذی ذكرت له تاریخین هما 1918 و1923.
(7)لاحظ أن "بیام مشرق" ترجم رسالة المشرق ورسالة الشرق. وأن "رموز بیخودی" ترجم أسرار نفی الذات والرموز الذاتیة. وأن "جاوید نامة" ترجم رسالة الخلود والرسالة الخالدة. (8)اعتمدت، هنا، على رسالة الدكتور عبد الكریم الیافی –محمد إقبال فیلسوف الذات وشاعر العشق –المرجع السابق نفسه. (9)انظر ص44 من: طعمة، د.جورج –فلسفة إقبال (محاضرات الاحتفال بذكرى إقبال فی دمشق)- دار الفكر- دمشق 1964.
(10)انظر ص11 من: الیافی، د.عبد الكریم- محمد إقبال فیلسوف الذات وشاعر العشق. (11)المرجع السابق نفسه- ص10.
(12)المرجع السابق نفسه- ص14. وانظر أیضاً ص1623 من: الهندی، السید أبو النصر أحمد الحسینی- الدكتور محمد إقبال- مجلة الرسالة-
س3- العدد 18-7 تشرین الأول 1935. انظر خاصة قوله: "أن الشیء الذی یقوی الأنانیة هو العشق فی مفهومه المطلق، ومعناه جذبك الشیء أو طلبك إیاه لتجعله جزءاً من نفسك. وأسمى صورة له هو ما یمكن صاحبه من خلق القیم والغایات، ویدفعه إلى السعی فی تحقیقها وبلوغها". (13)من خطبة إقبال فی الحفل السنوی للرابطة الإسلامیة مدینة "الله آباد" عام 1930. وقد اخترنا عبارات من هذه الخطبة بتصرف. (انظر نص الخطبة فی ص37 وما بعد من: الكتاب الوثائقی الذی أعده محمد برویز عبد الرحیم بمناسبة ذكرى میلاد إقبال، وأصدرته السفارة الباكستانیة فی دمشق 1985.
(14)انظر ص1415 من: الهندی، السید أبو النصر أحمد الحسینی –الدكتور محمد إقبال- مجلة الرسالة- س3- العدد 113-2 أیلول 1935 (15)انظر ص57 من: العطار، سمر-إقبال الشاعر (محاضرات الاحتفال بذكرى إقبال فی دمشق) –دار الفكر- دمشق 1964.
(16)أشار حمید مجید هدو إلى هذا الأمر الهام. انظر ص183 من: إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان. (17)ترجم الدكتور عزام مقطوعات من دیوان رسالة الشرق فی مجلة الرسالة –س3- العدد 80-14 كانون الثانی 1935. ومقطوعات من دیوان رموز بیخودی فی المجلة نفسها –العدد 85-18 شباط 1935. ومقطوعات من رباعیاته شقائق الطور فی المجلة نفسها –العددان 87 و 88- 4 آذار و 11 آذار 1935.
(18)الدواوین التی ترجمها الدكتور عزام هی: بیام مشرق (رسالة الشرق) 1951 –ضرب كلیم (شریعة موسى) 1937- أسرار خودی (أسرار الذات)؟ (19)انظر ص22 من: وند، صادق آئینه- الیقظة الإسلامیة فی فارسیات إقبال- مجلة التراث العربی- دمشق –س6- العدد 23- نیسان 1986.
(20)انظر نموذجاً لذلك فی مقالة "عود إلى محمد إقبال" للدكتور عبد الوهاب عزام –مجلة الرسالة- س2- العدد 53-9 تموز 1934. ومقالة "محمد إقبال" للدكتور عزام نفسه –مجلة الرسالة –س2- العدد 56-30 تموز 1934. والمقالتان تضمان ترجمة بعض شعر إقبال المنشور فی دیوانیه "أسرار خودی" و "رموز بیخودی". وكان الدكتور عزام –رحمه الله- ترجم فی مجلة الرسالة نفسها عام 1933 نبذاً من دیوان بیام مشرق. (21)انظر ص190 من: هدو، حمید مجید- إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان. (22)عرض الأستاذ عبد المعین الملوحی قصیدة إقبال إلى لینین فی كلمته التی ألقاها فی مناسبة مرور مائة عام على ولادة الشاعر، وألقاها فی المؤتمر العالمی الذی عقد فی لاهور عام 1977، بین 2-8 كانون الأول. وقد نشر نص الكلمة مع القصیدة فی مجلة الثقافة –دمشق-تموز 1980. ثم ذكر نصها فی محاضراته: "محمد إقبال شاعر الإسلام وفیلسوف الثورة". انظر ص43 وما بعدها من: نداء إقبال- دار الفكر- دمشق 1986. (23)انظر ص16 من: الملوحی، عبد المعین- محمد إقبال شاعر الإسلام وفیلسوف الثورة- المرجع السابق نفسه. (24)انظر ص56 من: الملوحی، عبد المعین –محاضرات نداء إقبال (الاحتفال بذكرى إقبال فی دمشق) دار الفكر –دمشق 1986.
(25)انظر ص18 من: الیافی، د.عبد الكریم –محمد إقبال فیلسوف الذات وشاعر العشق- المرجع السابق نفسه. (26)استمدت الأفكار الخاصة بصدى إقبال فی العالم من مقالة السید أبو النصر أحمد الحسینی الهندی، فی مجلة الرسالة –العدد 117-30 أیلول 1935. ملحق(1)
محطات فی حیاة الدكتور محمد إقبال
- ولد فی مدینة سیالكوت (الباكستان) فی التاسع من تشرین الثانی عام 1877، وتوفی فی الحادی عشر من نیسان عام 1938، الموافق 20 صفر 1357هـ.
- درس فی كلیة سیالكوت، وتتلمذ فیها على مولانا میرحسن أحد كبار علماء الدین واللغتین الفارسیة والعربیة.
- التحق بكلیة الحكومة فی لاهور عام 1895، ونال منها الإجازة فی الفلسفة B.A ثم شهادة الماجستیر M.A. عام 1897 فی الفلسفة الإسلامیة. وتتلمذ فی هذه الكلیة على المستشرق توماس أرنولد.
- درس فی جامعة كامبردج فی إنكلترة، ونال منها إجازة فی الفلسفة عن موضوع: ازدهار علم ما وراء الطبیعة فی بلاد فارس.
- درس فی جامعة میونیخ فی ألمانیة، ونال منها شهادة الدكتوراه فی الفلسفة عن الموضوع السابق نفسه.
- درس فی جامعة لندن فی إنكلترة، ونال منها شهادة المحاماة.
- أجاد الإنكلیزیة والفرنسیة والألمانیة والفارسیة والأوردیة، وعرف العربیة والسنسكریتیة.
- نظم الشعر بالأوردیة والفارسیة.
- عمل أستاذاً للفلسفة والسیاسة المدنیة فی الكلیة الشرقیة فی لاهور، وأستاذاً للفلسفة واللغة الإنكلیزیة فی كلیة الحكومة فی لاهور. ورفض بعد أن رجع من أوربة عام 1908 مناصب الحكومة، واختار الحیاة الحرة، ومارس مهنة الإرشاد القانونی.
ملحق(2)
مؤلفات الدكتور محمد إقبال
الشعر: أ- الدواوین المنظومة باللغة الأوردیة:
- بانك درا (جلجلة الجرس) 1924.
- مسافر 1934.
- بال جبریل (جناح جبریل) 1935.
- ضرب كلیم (شریعة موسى) 1937.
الدواوین المنظومة باللغة الفارسیة:
- أسرار خودی (أسرار الذات) 1915 (على القافیة المزدوجة- المثنوی)
- رموز بیخودی (أسرار نفی الذات) 1918. (على القافیة المزدوجة- المثنوی)
- بیام مشرق (رسالة الشرق) 1923.
- زبور عجم (أناشید فارسیة) 1929
- جاوید نامه (رسالة الخلود) 1932.
- بس جه باید كردای أقوام مشرق. (ماذا یجب أن نعمل یا أمم الشرق) 1936.
- سرود رفته (أنشودة الماضی) 1959.
الدواوین المنظومة باللغة الأوردیة والفارسیة:
- أرمغان حجاز (تحفة الحجاز) 1938 (طبع بعد وفاته) ترتیب كتابة الدواوین: بانك درا- أسرار خودی- رموز بیخودی- بیام مشرق- زبور عجم- جاوید نامه- مسافر- بال جبریل ضرب كلیم- بس جه باید كردای أقوام مشرق- أرمغان حجاز- سرود رفته- "طُبع الدیوان بعد وفاته وضم الشعر الذی لم تضمه الدواوین السابقة).
النثر:
- علم الاقتصاد (باللغة الأوردیة) 1903.
- ازدهار علم ما وراء الطبیعة فی فارس (رسالة الدكتوراه) 1908.
- تجدید التفكیر الدینی فی الإسلام 1930.
- رسائل إقبال إلى محمد علی جناح 1944 (طبع بعد وفاته)
- خطب إقبال وبیاناته 1944 (طبع بعد وفاته)
- رسائل إقبال 1944 (طبع بعد وفاته)
ملحق (3)
الكتب التی ألفت عن إقبال باللغة العربیة
1. محمد إقبال، سیرته وفلسفته وشعره عبد الوهاب عزام آخر طبعات الكتاب: دار القلم 1960.
2. فلسفة إقبال والثقافة الإسلامیة فی الهند وباكستان الصاوی علی شعلان –محمد حسن الأعظمی دار إحیاء الكتب العربیة 1950
3. إقبال الشاعر الثائر نجیب الكیلانی الشركة العربیة للطباعة والنشر 1959.
4. روائع إقبال أبو الحسن علی الحسنی الندوی دار الفكر –دمشق 1960.
5. إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان حمید مجید هدو مطبعة الفرى- النجف 1963.
6. فلسفة إقبال علی حسون دار السؤال –دمشق 1985.
ملحق (4)
الكتب والدواوین التی ترجمت إلى اللغة العربیة
1. أسرار الذاتیة ترجمة عبد الوهاب عزام دار المعارف –مصر
2. رسالة الشرق ترجمة عبد الوهاب عزام 1951 مجلس إقبال- الباكستان
3. ضرب كلیم ترجمة عبد الوهاب عزام 1937 جماعة الأزهر –مصر
4. درر من شعر محمد إقبال أمیرة نور الدین
5. تجدید التفكیر الدینی فی الإسلام ترجمة عباس محمود
ملحق (5)
كتب عن إقبال تضم محاضرات الاحتفال بذكراه
1. محمد إقبال- مجموعة مقالات لكبار الكتاب والأدباء العرب- القاهرة 1956.
2. شاعر الإسلام محمد إقبال- مجموعة مقالات لأدباء سعودیین- السعودیة 1957.
3. ذكرى محمد إقبال- مجموعة المقالات فی الاحتفال بإقبال فی دمشق 1964 (دار الفكر- دمشق 1964).
4. نداء إقبال- مجموعة المحاضرات والقصائد فی مؤتمر إقبال فی دمشق 1985. (دار الفكر- دمشق 1986).
أول ملامح الصورة الإقبالیة فی الأدبیات العربیة ما یتعلق بحیاة إقبال ومؤلفاته. فقد لاحظت أن المقالات(1) التی نشرت عنه طوال خمسین سنة من عام 1935 حتى عام 1985 انصرفت كلها تقریباً إلى ترجمة حیاته وسرد مؤلفاته، وخصصت بعض خواتیمها أو جانباً منها لحدیث عام عن فلسفته أو شعره. وكنت أتساءل دوماً: أما تكفینا مقالة واحدة للإلمام بحیاة هذا الرجل؟ غیر أن الإجابة عن هذا السؤال لم تكن هینة. إذ إن مقالة واحدة تكفی فی العادة للإلمام بحیاة الدكتور محمد إقبال إذا كانت دقیقة. وما قرأته لم یكن كذلك على الرغم من سعی الكاتبین إلى الدقة وإیمانی بصدق نیاتهم.
فقد قرأت أنه ولد عام 1876(2)، كما قرأت أنه ولد فی عام 1873(3). فقلت، وأنا أعلم أنه ولد عام 1877، لعل ذلك من قبیل الشائع فی كتب التراجم. فالناس یهتمون بالأعلام بعد نبوغهم، ویفوتهم فی هذه الحال زمن ولادتهم، وقلما فاتهم زمن وفاتهم(4). وربما كان الاختلاف عائداً إلى أن زمن ولادة إقبال لم یكن یعرف تسجیل الموالید بدقة، أو أن هناك تصحیفاً فی المراجع التی عاد إلیها الكتاب العرب. وربما كان هناك سبب آخر، إلا أن الاختلاف فی زمن الولادة یبقى أمراً بسیطاً. وما هو أكثر أهمیة أن حیاة محمد إقبال شهدت تطورات عدة، أبرزها الفترة التی تلت عام 1908. لكن المرء یقرأ فی الأدبیات العربیة شیئاً كثیراً عن إقبال دون أن یرافق ذلك توضیح لهذه التطورات. ومسوغ الإشارة إلى هذا الأمر كامن فی أن العرب معنیون بما آل إلیه تفكیر إقبال فی أمرهم. فقد آلمه خضوعهم للمستعمر الغربی، وتخلفهم، وفرقتهم، ومن ثم راح یدعوهم إلى الثورة. أو قل: راح یدعوهم إلى جوهر فلسفته الثوریة. لكن الأدبیات العربیة سكتت عن هذا الأمر(5) وكأنه لم یكن الشغل الشاغل لمحمد إقبال طوال ثلاثین سنة فی المرحلة الثالثة من حیاته (بین 1908-1938).
كذلك الأمر فی مؤلفات محمد إقبال. فقد توزعتها ثلاث لغات، هی: الأوردیة والفارسیة والإنكلیزیة. إلا أن الأدبیات العربیة ترجَّحت فی نسبة هذا الكتاب أو ذاك إلى الأوردیة أو الفارسیة، والشعر خاصة. كما ترجحت فی توثیق طباعة بعض الكتب، إضافة إلى تباین بسیط فی ترجمة عنواناتها إلى اللغة العربیة. فمن قائل أن "رموز بیخودی" مقالة فلسفیة، إلى قائل أنها دیوان شعری. ومن قائل أن "أسرار خودی" صدر عام 1915، إلى قائل أنه صدر عام 1916(6). ومن قائل أن "أسرار خودی" تعنی بالعربیة "أسرار الذات"، إلى قائل أنها تعنی "الأسرار الذاتیة"، وبین الترجمتین فرق فی المعنى. ویكاد التباین فی الترجمة یشمل غالبیة مؤلفات إقبال(7).
أخلص من ذلك إلى أن تقدیرنا محمد إقبال یفرض علینا التدقیق فی ترجمة حیاته وسرد مؤلفاته، بغیة مساعدة القارئ العربی على تعرف حیاة هذا الفیلسوف ومؤلفاته، ومنعاً للخلل فی الصورة التی نرسمها له. ومن ثم أعتقد أن المقالات التی كررت الحدیث عن سیرة حیاة إقبال وسردت مؤلفاته، كلها أو بعضها، كانت تشعر دائماً أن ما سبقها لم یف هذه الحیاة حقها ولم یسرد المؤلفات بدقة. لذلك راحت غالبیة هذه المقالات تخصص جانباً منها لهذه الحیاة وتلك المؤلفات. وهذا یقود إلى ما بدأت به من أن مقالة واحدة تكفی للإلمام بحیاة إقبال ومؤلفاته إذا كانت دقیقة. وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون العرب.
الأمر الثانی اللافت للنظر فی الأدبیات العربیة هو إهمال مزج جانبین هامین فی شخصیة محمد إقبال، هما اهتمامه بالوطن العربی وفلسفته الثوریة. وأذكّر هنا أننی لست مؤهلاً لتحلیل فلسفة إقبال. غیر أن المرء ما یفتأ یلاحظ أن الاختصاصیین نصوا على أن فلسفته تستند إلى ثلاث رواجب هـــی(8): جهاد النفس –الإنسان مسؤول- العشق. ولهذه الرواجب الثلاث صلة وثیقة بما كان العالم الإسلامی عامة، والوطن العربی خاصة، یعانیان منه فی النصف الأول من القرن العشرین. فهما محتلان متخلفان مجزآن تعتمل فیهما الأدواء والمفاسد، فما السبیل إلى خلاصهما من ذلك وعودتهما إلى الحضارة والرقی ورفعة الشأن؟.
إن السبیل، بإیجاز، هو محاربة الإنسان ما یعتمل فی دخیلته من ذاتیة مفرطة، وتحطیمه أغلاله التی زیّنها له وهم الحریة، وإیمانه أنه مسؤول، وأن واجبه یدفعه إلى أن یندمج بالشعب ویشاركه كفاحه من أجل إزالة التخلف والأوضاع الطبقیة الفاسدة والظلم والتسلط، كی یتمكن المسلمون عامة، والعرب خاصة، من تحریر وطنهم المغتصب، وجعل الإنسان فیه عزیزاً حراً كریماً. "فإقبال وجیله من المجددین جابهوا بجرأة مشكلة الحضارة الحدیثة، وضعوا الفرد المسلم والعربی وجهاً لوجه أمام مسؤولیته"(9).
أجل، كان الشرق متخلفاً والغرب متقدماً. لكن هذا الغرب فی رؤیة إقبال "زاخر بالحركة مجرد من المبادئ الخلقیة الأصلیة، فقیر بالحب والإیمان. سخر الطبیعة لأغراضه، ولكنه أخفق فی محو البؤس الإنسانی"(10). لذلك رغب إقبال فی أن یجمع الشرق بین الحب والعقل. ولكن، هل هذا ممكن دون تهیئة فكریة لمواجهة حدید الغرب ورصاصه ولؤمه ودخانه(11)؟ لابد من العشق إذن. ما العشق؟ إنه الطاقة التی تحطم القیود. فإذا عشقت مقصداً تمنیته فإن غیره لا یرضیك ولا یقنعك(12). علیك أن تعد العدة من أجل تحقیق هذا المقصد. لكن حرب العدو الخارجی لا یقل شأناً عن حرب العدو الكامن فی نفس كل إنسان. بل إن حرب التشتت والهوى والنزعات الفاسدة فی نفس الفرد ینتج عنها توحد النفوس وسیادة النظام، مما یجعل التغلب على العدو الخارجی سهلاً. ویحق للمرء هنا القول إن جوهر فلسفة إقبال الثورة كان قادراً على خدمة الوطن العربی لو التفتت الأدبیات العربیة إلى هذا المزج بین اهتمامات العرب وحالهم وطبیعة الفلسفة الثوریة لإقبال. لو وضحت الأدبیات العربیة أن العرب مطالبون بالتخلی عن الحسد والتشتت والتفرقة، والعودة إلى أساس حضارتهم الأخلاقی، لجعلهم ذلك وحده قلباً واحداً قادراً على مقارعة المستعمر الذی احتل بلادهم وجعل عزیز قومهم ذلیلاً.
خاطب إقبال العرب خاصة، والمسلمین عامة قائلاً لهم: "إنكم الآن تجتازون أدق مرحلة، وتمرون بأصعب دور فی حیاتكم السیاسیة. فعلیكم أن تحتفظوا بالارتباط الشامل والاتحاد القویم فی العزائم والجهود، وفی الوسائل والغایات. إننی لا أستطیع أن أخفی عنكم شعوری بأنكم فی سبیل تدارك هذه الحال الخطرة لابد من أن تناضلوا فی كفاح الحریة. ولا سبیل إلى محاولة أخیرة لكسب سیاسی إلا حیث تكون العزائم عزماً واحداً، والقلوب المتباعدة قلباً واحداً. وأن تتركز مشاعركم حول مطلب لا تختلفون علیه. إنكم تستطیعون ذلك، وبالقوة إن شاء الله، یوم تتحررون من القیود النفسیة، وحین تضعون أعمالكم الفردیة والاجتماعیة فی میزان ما تنشدونه من الأهداف العالیة والمثل الرفیعة"(13). هذا الخطاب الواضح المحدد الذی یشیر إلى جهاد النفس ومسؤولیة الإنسان وعشقه حریة شعبه وأمته لم یترجم إلى اللغة العربیة فی أثناء خضوع الوطن العربی للاستعمار الغربی، وإنما ترجم فی أخریات عام 1985. وكأن الأدبیات العربیة فی أیام الاستعمار غافلة عن هذا التفكیر الإقبالی فی حال الأمة العربیة، وارتباطه الوثیق بما عانى منه العرب أفراداً وجماعات على المستویات النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة. ویخیّل إلیّ أن إقبالاً لمس عزوف العرب عما خاطبهم به، فقال عام 1925، أو نحو ذلك: "ولكن العرب لا یعرفون شیئاً عن نغماتی الشجیة". یرید من ذلك صدى المعرفة الحقیقیة لشعره عند العرب كما نص صدیقة الوفی أبو النصر أحمد الحسینی الهندی(14).
أما شعر محمد إقبال فكان المعبر عن فلسفته. غیر أن الأدبیات العربیة لم تشر إلى شیء یتعلق بالمراحل التی قطعها شعره، وهی مراحل تتفاوت قوة وضعفاً. وقارئ هذه الأبیات یخیل إلیه أن شعر الدكتور إقبال واحد ما دام الكتاب یستشهدون به دون تفریق وتوضیح. وقد نص السید أبو النصر أحمد الحسینی الهندی قبل ثلاث سنوات من وفاة إقبال على أن الشعر الذی كتبه صدیقه إقبال مرّ بثلاث مراحل:
أ-مرحلة الطلبة وتنتهی هذه المرحلة عام 1905. یمتاز شعره فیها بسعة الخیال وابتكار المعانی، لكنه مجرد من دقة الفكر والتعمق. یجد القارئ فیه روح الحب ونشدان الجمال والترحیب بالعشق، لكنه فی النهایة تعبیر عن مرحلة الأمل بشیء غیر معلوم. فإقبال فی هذه المرحلة یتوق إلى المجهول الذی لم یتضح فی فكره بعد.
ب-المرحلة الثانیة هی مرحلة الزمن الذی عاش فیه فی أوربة بین 1905-1908 وهذه المرحلة أقل إنتاجاً، وأكثر إبرازاً لأثر مشاهداته فی أوربة. غیر أن روح الحب وطلب الجمال والترحیب بالعشق تبقى متجلیة فی شعر هذه المرحلة. وقد أضیف إلیها بدء علو أفكاره واتساعها، حتى أن اللغة الأردیة التی كان ینظم بها شعره- وهی لغة حدیثة آنذاك- ضاقت عنه فمال إلى النظم بالفارسیة.
ج-المرحلة الثالثة هی المرحلة التی تلت عودته من أوربة، أی بعد عام 1908 ففی هذه المرحلة حلّت السكینة والطمأنینة فی روح الشاعر محل التوقان والاضطراب، كما خف سلطان المحبة والجمال وحل محله توق إلى الحكمة والكمال، وقد جادت قریحة الشاعر فی هذه المرحلة فأصدر سبعة دواوین شعریة. كما تمكن من إبراز معالم فلسفته فی شعره وإیصالها إلى العالم أجمع. وكانت الأدبیات العربیة مطالبة بإبراز هذه المرحلة وتوضیحها لأنها أكثر التصاقاً بهموم العرب وتوجهاً إلیهم. ذلك أن شعر إقبال فی هذه المرحلة عبّر عن روح المسلم الشرقی الثائر ذی الحماسة الواضحة، فی حین تساجلت فی عشره روح المحبة والجمال والعشق فی المرحلتین الأولى والثانیة. إنه القائل فی هذه المرحلة یخاطب العرب: كل شعب قام یبنی نهضة وأرى بنیانكم منقسما فی قدیم الدهر كنتم أمة لهف نفسی كیف صرتم أمما
وقد نصت سمر العطار على أن إقبالاً "نصیر الحریة فی كل مكان، ینشد البعث لأمم الأرض قاطبة. وشعره سجل حافل بالأحداث التاریخیة والسیاسیة. فلقد واجه موسولینی برأیه فی قوة وحزم، وبسط له مغزى الحكم الدیكتاتوری. وحذر العالم من مكائد الیهود وأحابیلهم، ودحض مزاعمهم حینما كانوا یدّعون ملكیة فلسطین"(15) إلا أن الأدبیات العربیة عزفت عن تقدیم شعره إلى القارئ العربی على هذا النحو من التطور، وآثرت الحدیث العام عن هذا الشعر.
وقبل ذلك كله آثرت غالبیة الأدبیات العربیة تقدیم شعر إقبال منثوراً. وما كان نثر الشعر محل اهتمام القارئ العربی. إذ جرت العادة لدى غالبیة المترجمین على تقدیم الشعر الأجنبی منثوراً بعد خلعه من ثوبه الفنی(16). والشعر –كما هو معروف- عصی على الترجمة، یؤثر فی القارئ بلغته، فإذا نقل إلى لغة أخرى فقد معظم أثره. وقد لاحظ المرء فی أثناء قراءة شعر إقبال أن هناك من سرد معنى الأبیات الشعریة، وأن هناك آخرین غامروا بنظمها حسب وزن من الأوزان العربیة. ولعل أقدم المغامرین هو الدكتور عبد الوهاب عزام الذی ترجم كثیراً من شعر إقبال ونشره فی مجلة الرسالة(17)، كما نشر ثلاثة من دواوینه(18). حتى أن صادق آئینه وند عدّ إقبالاً واحداً "من كبار شعراء الفارسیة المعدودین". وأضاف أنه "نجم من نجوم سماء العرفان اللامعة الذین نادوا بالمعرفة والحریة والنضال والجهاد، وحددوا أهداف الأمة الإسلامیة ودفعوا الشعوب للحركة، مثل مولوی وحافظ وعراقی والحلاج وسعدنی، ممن قوّموا النفس الإنسانیة عن طریق وتحدید ذاتها وإمكاناتها وأهدافها الوجودیة وحدائها إلى مقامها المحمود فی الدنیا والآخـــرة"(19). أما أوزان الشعر التی نظم فیها إقبال مثل "مثنوی" و "قصیدة" و "رباعی" و "قطعة" و "مسدس" فلم تتح للقارئ العربی فرصة الاطلاع علیها، مما حرمه من أداة التعبیر التی استخدمها إقبال وبزّ فیها أقرانه.
ولا تنتهی القضیة هنا، ذلك أن إغفال التطور الشعری المواكب للتطور الفكری عند إقبال جرّ معه إغفال عرض الشعر المعبر عن الفلسفة الثوریة للرجل، والاهتمام بالشعر المعبر عن العشق وروح المحبة وطلب الجمال(20). أی أن المترجمین العرب اهتموا بترجمة شعر المرحلتین الأولى والثانیة بأكثر من اهتمامهم بشعر المرحلة الثالثة المواكبة لرسالة إقبال وضوحاً وعمقاً. فقصیدة "فلسطین" التی دعا فیها العرب إلى "الوقوف صفاً واحداً من أجل إحباط مؤامرات الصهیونیة العالمیة، ودحض الافتراءات الیهودیة وتفنید عزائم الصهیونیین وأفكارهم الإجرامیة"(21) صدرت فی دیوانه "بال جبریل" الصادر عام 1935. وقد ترجم الدكتور عزام الدیوان إلى اللغة العربیة بعد عامین(1937)، ولكن أحداً من العرب لم ینبه علیها فلم یكتب لها الذیوع والانتشار. كما عرض عبد المعین الملوحی ما یعتقد المرء أنه آخر التطورات الفكریة عند إقبال.
أقصد قصیدته "لینین أمام الله"(22). وهذه القصیدة –كما یقول الملوحی- "لم تكن تبدلاً فی اتجاه تفكیره كما قالت مجلة الثورة الأفریقیة، ولكنها على الأكثر كانت تعمیقاً لهذا التفكیر. بل إن هذه القصیدة لم تكن القطعة الأولى والأخیرة التی یفضح فیها مساوئ الرأسمالیة، ویدل على مواضع الشر فی الحضارة الغربیة، ولكنها كانت أكثر دلالة على إدراكه لهذه المساوئ، وأكثر إلحاحاً على ضرورة هدم الوضع الاجتماعی المتعفن لبناء مجتمع إنسانی شریف وحدیث"(23). لقد فرح أستاذنا الملوحی بهذه القصیدة حین قرأها فی مجلة الثورة الأفریقیة وترجمها ونشرها غیر كاملة، وأعلن آسفاً أنها لم تصله كاملة(24)، على الرغم من أنها إحدى قصائد دیوان "بال جبریل" أیضاً، وقد ترجمها الدكتور عبد الوهاب عزام كاملة إلى اللغة العربیة عام 1937 حین ترجم الدیوان المذكور. وهذا هو المقطع الأخیر من القصیدة:
هلموا فأیقظوا فی العالم الفقراء
هزوا أركان قصور الأغنیاء
أدفئوا دماء العبید بنار الثقة والإیمان
هبوا للعصفور قوة یصارع بها الشاهین
یوم سیادة الشعوب یقترب
فی خطوات حثیثة
لتتهدم صروح الماضی أینما كانت
لتحترق كل سنبلة فی الحقل
لا تكونوا طعاماً للفلاح
الحضارة الحدیثة
مصنع ینفخون فیه الزجاج
املؤوا صدر شاعر الشرق بغضب نبیل
یسحق به هذا المصنع سحقاً.
هذه القصیدة تعزز الرأی الصائب الذی ذكره عبد الكریم الیافی. فإقبال "لم یتخل عن مضامین التراث التی وعاها، ولا رفض قیم الحضارة الحدیثة التی اطلع علیها، وإنما كان وفیاً لمطالب الحیاة المستجدة، أمیناً على خزائن التراث الرفیعة. وإذا لهج بعض الفلسفات الفنیة الحدیثة بفكرة الالتزام فإنَّا لنجد فنه من أوله إلى آخره ملتزماً بحب الإنسان والسعی لإسعاده أیان كان. ینوه برفعته، ویشید بسموه، ویوجهه إلى أنبل الغایات وأعلى المقاصد. وهو فی أسالیب تعبیره عن ذلك لا یقطع الصلة بین تشوف الحاضر وصور الماضی"(25) تلك هی الأصالة عند إقبال. إنها النسغ الذی جعله یواكب الحضارة الحدیثة، فلا ینعزل عن الأفكار الثوریة التی سادت العالم فی العشرینیات والثلاثینیات، ولا یركن إلى المجد الذی حققه شعره، ولا إلى المكانة الفكریة والاجتماعیة التی احتلها بدأبه وإخلاصه وفلسفته.
یخلص المرء من الحدیث السابق إلى أن الأدبیات العربیة عُنیت بحیاة إقبال وشعره وفلسفته، إلا أنها قدمت فی أحایین كثیرة ملامح عامة عن هذه الأمور الثلاثة، وعنیت فی أحایین قلیلة بجانب من هذه الجوانب. ولم تصل فی الحالات كلها إلى تقدیم صورة شاملة لحیاته وشعره وفلسفته. ویجب أن یستثنی المرء من هذا الحكم شریحة من المثقفین العرب، درست حیاة إقبال وشعره وفلسفته بشیء غیر قلیل من الدقة، وألّفت عدداً من الكتب حوله، وترجمت بعض دواوینه. أذكر من هذه الشریحة الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله. فقد ألف كتاباً عنوانه "محمد إقبال سیرته وفلسفته وشعره"، وترجم ثلاثة دواوین، ونشر عدداً من المقالات فی مجلة الرسالة. وأذكر أیضاً حمید مجید هدو والصاوی علی شعلان ومحمد حسن الأعظمی ونجیب الكیلانی وعلی حسون وعباس محمود الذی ترجم كتاب إقبال "تجدید التفكیر الدینی فی الإسلام".
غیر أن جهود هذه الشریحة تبقى فردیة فی النهایة، وتبقى الفئة القارئة العربیة بعیدة نسبیاً عن هذه الجهود التی توزعتها السنون الخمسون الماضیة، دون أن یرفدها تخطیط لترجمة أعماله الكاملة النثریة والشعریة، وتعریف الأجیال العربیة الجدیدة بصاحبها. ولا عجب، بعد ذلك، أن تتكرر فی مقالات الكتّاب العرب وكتبهم أغلاط فی ترجمة حیاة إقبال. وبعدٌ عن توثیق المراجع العربیة التی تحدثت عنه، وأحكام عامة حول شعره، وعزوف عن تحلیل طبیعة ارتباطه بالعرب وطبیعة ارتباط العرب به. ولا نقلل من أهمیة الجهود العربیة حین نقول إن الغرب قدّر إقبالاً أكثر من تقدیر العرب له. فقد ترجم حسین دانش شعره إلى اللغة التركیة، وكتب مقالات كثیرة عن دیوانه بیام مشرق(26). كما تُرجم إلى الروسیة دیوان "أسرار خودی". وترجم دایشو روسو إلى الألمانیة مقدمة بیام مشرق، وكتب فیشر فی مجلة إسلامیكا مقالات كثیرة عن هذا الدیوان الذی ترجمه بعد ذلك هانسی مائنیكه. وأنشئت فی ألمانیة جمعیة لنشر مبادئ إقبال والتعریف بشعره. كذلك الأمر فی إیطالیا وإنكلترة. فقد نشر الدكتور اسكاریا الإیطالی كثیراً من المقالات عن إقبال، وترجم نكلسون دیوان "أسرار خودی" وجزءاً من بیام مشرق إلى الإنكلیزیة، وكتب المستشرق براون عن أسرار خودی مقالات فی مجلة الجمعیة الآسیویة. كما ألف العالم الأمریكی میكنزی كتاب "یقظة الهند" كان لإقبال فیه حیز كبیر.
وإذا كان اهتمام الغرب بهذا الفیلسوف الشاعر ینم عن مكانته، فإن العرب مطالبون بتقدیره أكثر من الغربیین لمكانته ولاهتمامه الخاص بهم. بل لأنه رأى نفسه واحداً منهم لجامع العقیدة بینهما. إن صورة الدكتور محمد إقبال فی الأدبیات العربیة ترضی الذین یملكون معرفة عامة بمكانة هذا الرائد فی الشعر والفلسفة والثورة. لكن هذه الصورة لا ترضی أولئك الذین غاصوا فی بحر علومه ورأوا لآلئه. ولعلنا نرضی هؤلاء الاختصاصیین بترجمة الأعمال الكاملة لإقبال، ونضع بین یدی الباحثین ثبتاً بما كتب عنه فی اللغة العربیة، تمهیداً لدراسته وتقدیم مواهبه وعبقریته وعظمته إلى القارئ العربی بموضوعیة.
الهوامش: (1)من أجل الابتعاد عن التعمیم أقول أن المراد هنا هو المقالات التی عثرت علیها فی المجلات التالیة: الرسالة (القاهرة) –الثقافة (دمشق)- التراث العربی (دمشق). وفی الكتب التی ضمت محاضرات الاحتفال بذكراه، كذكرى محمد إقبال (دمشق 1964)، ونداء إقبال (دمشق 1985).
(2)انظر ص1415 من: الهندی، السید أبو النصر أحمد الحسینی –الدكتور محمد إقبال –مجلة الرسالة- س3- العدد 113-2 أیلول 1935.
(3)انظر ص11 من: هدو، حمید مجید –إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان- مطبعة الفرى- النجف 1963. وص 9 من: مقدمة ذكرى محمد إقبال (مقالات الاحتفاء بإقباء فی دمشق 1964)، وفی هذه الصفحة أنه ولد فی 22 شباط، وورد فی أدبیات أخرى أنه ولد فی التاسع من تشرین الثانی. وانظر أیضاً ص45 من: العطار، سمر –إقبال الشاعر (محاضرات الاحتفال بذكرى محمد إقبال)- دار الفكر 1964 (4)اتفق الذین ترجموا حیاة الدكتور محمد إقبال على أنه توفی عام 1938.
(5)یستثنى من هذا الحكم الدكتوران یوسف عز الدین وعبد الكریم الیافی. فقد أشاروا إلى حال الأمة العربیة فی أثناء حدیثهما عن إقبال، من غیر أن یلوما الأدبیات العربیة على إهمالها ربط دعوة إقبال بما كانت علیه الأمة العربیة من تخلف وتجزئة وخضوع للمستعمر الغربی انظر ص10 من: الیافی، د.عبد الكریم –محمد إقبال فیلسوف الذات وشاعر العشق- مجلة التراث العربی- دمشق- العدد 23- نیسان 1986. وص6 من المقدمة التی كتبها الدكتور یوسف عز الدین لكتاب: إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان لحمید مجید هدو- مطبعة الفرى- النجف 1963. والملاحظ أن مقدمة المحاضرات التی احتفلت بذكرى إقبال فی دمشق عام 1964 أشارت إلى هذا الأمر أیضاً. والملاحظ أن مقدمة المحاضرات التی احتفلت بذكرى إقبال فی دمشق عام 1964 أشارت إلى هذا الأمر أیضاً. انظر ص7 من: ذكرى محمد إقبال- دار الفكر- دمشق 1964.
(6)كذلك الأمر فی دیوان "مسافر". فقد ذكرت الأدبیات العربیة تاریخین هما 1933 و 1934. ودیوان "رموز بیخودی" الذی ذكرت له تاریخین هما 1918 و1923.
(7)لاحظ أن "بیام مشرق" ترجم رسالة المشرق ورسالة الشرق. وأن "رموز بیخودی" ترجم أسرار نفی الذات والرموز الذاتیة. وأن "جاوید نامة" ترجم رسالة الخلود والرسالة الخالدة. (8)اعتمدت، هنا، على رسالة الدكتور عبد الكریم الیافی –محمد إقبال فیلسوف الذات وشاعر العشق –المرجع السابق نفسه. (9)انظر ص44 من: طعمة، د.جورج –فلسفة إقبال (محاضرات الاحتفال بذكرى إقبال فی دمشق)- دار الفكر- دمشق 1964.
(10)انظر ص11 من: الیافی، د.عبد الكریم- محمد إقبال فیلسوف الذات وشاعر العشق. (11)المرجع السابق نفسه- ص10.
(12)المرجع السابق نفسه- ص14. وانظر أیضاً ص1623 من: الهندی، السید أبو النصر أحمد الحسینی- الدكتور محمد إقبال- مجلة الرسالة-
س3- العدد 18-7 تشرین الأول 1935. انظر خاصة قوله: "أن الشیء الذی یقوی الأنانیة هو العشق فی مفهومه المطلق، ومعناه جذبك الشیء أو طلبك إیاه لتجعله جزءاً من نفسك. وأسمى صورة له هو ما یمكن صاحبه من خلق القیم والغایات، ویدفعه إلى السعی فی تحقیقها وبلوغها". (13)من خطبة إقبال فی الحفل السنوی للرابطة الإسلامیة مدینة "الله آباد" عام 1930. وقد اخترنا عبارات من هذه الخطبة بتصرف. (انظر نص الخطبة فی ص37 وما بعد من: الكتاب الوثائقی الذی أعده محمد برویز عبد الرحیم بمناسبة ذكرى میلاد إقبال، وأصدرته السفارة الباكستانیة فی دمشق 1985.
(14)انظر ص1415 من: الهندی، السید أبو النصر أحمد الحسینی –الدكتور محمد إقبال- مجلة الرسالة- س3- العدد 113-2 أیلول 1935 (15)انظر ص57 من: العطار، سمر-إقبال الشاعر (محاضرات الاحتفال بذكرى إقبال فی دمشق) –دار الفكر- دمشق 1964.
(16)أشار حمید مجید هدو إلى هذا الأمر الهام. انظر ص183 من: إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان. (17)ترجم الدكتور عزام مقطوعات من دیوان رسالة الشرق فی مجلة الرسالة –س3- العدد 80-14 كانون الثانی 1935. ومقطوعات من دیوان رموز بیخودی فی المجلة نفسها –العدد 85-18 شباط 1935. ومقطوعات من رباعیاته شقائق الطور فی المجلة نفسها –العددان 87 و 88- 4 آذار و 11 آذار 1935.
(18)الدواوین التی ترجمها الدكتور عزام هی: بیام مشرق (رسالة الشرق) 1951 –ضرب كلیم (شریعة موسى) 1937- أسرار خودی (أسرار الذات)؟ (19)انظر ص22 من: وند، صادق آئینه- الیقظة الإسلامیة فی فارسیات إقبال- مجلة التراث العربی- دمشق –س6- العدد 23- نیسان 1986.
(20)انظر نموذجاً لذلك فی مقالة "عود إلى محمد إقبال" للدكتور عبد الوهاب عزام –مجلة الرسالة- س2- العدد 53-9 تموز 1934. ومقالة "محمد إقبال" للدكتور عزام نفسه –مجلة الرسالة –س2- العدد 56-30 تموز 1934. والمقالتان تضمان ترجمة بعض شعر إقبال المنشور فی دیوانیه "أسرار خودی" و "رموز بیخودی". وكان الدكتور عزام –رحمه الله- ترجم فی مجلة الرسالة نفسها عام 1933 نبذاً من دیوان بیام مشرق. (21)انظر ص190 من: هدو، حمید مجید- إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان. (22)عرض الأستاذ عبد المعین الملوحی قصیدة إقبال إلى لینین فی كلمته التی ألقاها فی مناسبة مرور مائة عام على ولادة الشاعر، وألقاها فی المؤتمر العالمی الذی عقد فی لاهور عام 1977، بین 2-8 كانون الأول. وقد نشر نص الكلمة مع القصیدة فی مجلة الثقافة –دمشق-تموز 1980. ثم ذكر نصها فی محاضراته: "محمد إقبال شاعر الإسلام وفیلسوف الثورة". انظر ص43 وما بعدها من: نداء إقبال- دار الفكر- دمشق 1986. (23)انظر ص16 من: الملوحی، عبد المعین- محمد إقبال شاعر الإسلام وفیلسوف الثورة- المرجع السابق نفسه. (24)انظر ص56 من: الملوحی، عبد المعین –محاضرات نداء إقبال (الاحتفال بذكرى إقبال فی دمشق) دار الفكر –دمشق 1986.
(25)انظر ص18 من: الیافی، د.عبد الكریم –محمد إقبال فیلسوف الذات وشاعر العشق- المرجع السابق نفسه. (26)استمدت الأفكار الخاصة بصدى إقبال فی العالم من مقالة السید أبو النصر أحمد الحسینی الهندی، فی مجلة الرسالة –العدد 117-30 أیلول 1935. ملحق(1)
محطات فی حیاة الدكتور محمد إقبال
- ولد فی مدینة سیالكوت (الباكستان) فی التاسع من تشرین الثانی عام 1877، وتوفی فی الحادی عشر من نیسان عام 1938، الموافق 20 صفر 1357هـ.
- درس فی كلیة سیالكوت، وتتلمذ فیها على مولانا میرحسن أحد كبار علماء الدین واللغتین الفارسیة والعربیة.
- التحق بكلیة الحكومة فی لاهور عام 1895، ونال منها الإجازة فی الفلسفة B.A ثم شهادة الماجستیر M.A. عام 1897 فی الفلسفة الإسلامیة. وتتلمذ فی هذه الكلیة على المستشرق توماس أرنولد.
- درس فی جامعة كامبردج فی إنكلترة، ونال منها إجازة فی الفلسفة عن موضوع: ازدهار علم ما وراء الطبیعة فی بلاد فارس.
- درس فی جامعة میونیخ فی ألمانیة، ونال منها شهادة الدكتوراه فی الفلسفة عن الموضوع السابق نفسه.
- درس فی جامعة لندن فی إنكلترة، ونال منها شهادة المحاماة.
- أجاد الإنكلیزیة والفرنسیة والألمانیة والفارسیة والأوردیة، وعرف العربیة والسنسكریتیة.
- نظم الشعر بالأوردیة والفارسیة.
- عمل أستاذاً للفلسفة والسیاسة المدنیة فی الكلیة الشرقیة فی لاهور، وأستاذاً للفلسفة واللغة الإنكلیزیة فی كلیة الحكومة فی لاهور. ورفض بعد أن رجع من أوربة عام 1908 مناصب الحكومة، واختار الحیاة الحرة، ومارس مهنة الإرشاد القانونی.
ملحق(2)
مؤلفات الدكتور محمد إقبال
الشعر: أ- الدواوین المنظومة باللغة الأوردیة:
- بانك درا (جلجلة الجرس) 1924.
- مسافر 1934.
- بال جبریل (جناح جبریل) 1935.
- ضرب كلیم (شریعة موسى) 1937.
الدواوین المنظومة باللغة الفارسیة:
- أسرار خودی (أسرار الذات) 1915 (على القافیة المزدوجة- المثنوی)
- رموز بیخودی (أسرار نفی الذات) 1918. (على القافیة المزدوجة- المثنوی)
- بیام مشرق (رسالة الشرق) 1923.
- زبور عجم (أناشید فارسیة) 1929
- جاوید نامه (رسالة الخلود) 1932.
- بس جه باید كردای أقوام مشرق. (ماذا یجب أن نعمل یا أمم الشرق) 1936.
- سرود رفته (أنشودة الماضی) 1959.
الدواوین المنظومة باللغة الأوردیة والفارسیة:
- أرمغان حجاز (تحفة الحجاز) 1938 (طبع بعد وفاته) ترتیب كتابة الدواوین: بانك درا- أسرار خودی- رموز بیخودی- بیام مشرق- زبور عجم- جاوید نامه- مسافر- بال جبریل ضرب كلیم- بس جه باید كردای أقوام مشرق- أرمغان حجاز- سرود رفته- "طُبع الدیوان بعد وفاته وضم الشعر الذی لم تضمه الدواوین السابقة).
النثر:
- علم الاقتصاد (باللغة الأوردیة) 1903.
- ازدهار علم ما وراء الطبیعة فی فارس (رسالة الدكتوراه) 1908.
- تجدید التفكیر الدینی فی الإسلام 1930.
- رسائل إقبال إلى محمد علی جناح 1944 (طبع بعد وفاته)
- خطب إقبال وبیاناته 1944 (طبع بعد وفاته)
- رسائل إقبال 1944 (طبع بعد وفاته)
ملحق (3)
الكتب التی ألفت عن إقبال باللغة العربیة
1. محمد إقبال، سیرته وفلسفته وشعره عبد الوهاب عزام آخر طبعات الكتاب: دار القلم 1960.
2. فلسفة إقبال والثقافة الإسلامیة فی الهند وباكستان الصاوی علی شعلان –محمد حسن الأعظمی دار إحیاء الكتب العربیة 1950
3. إقبال الشاعر الثائر نجیب الكیلانی الشركة العربیة للطباعة والنشر 1959.
4. روائع إقبال أبو الحسن علی الحسنی الندوی دار الفكر –دمشق 1960.
5. إقبال الشاعر والفیلسوف والإنسان حمید مجید هدو مطبعة الفرى- النجف 1963.
6. فلسفة إقبال علی حسون دار السؤال –دمشق 1985.
ملحق (4)
الكتب والدواوین التی ترجمت إلى اللغة العربیة
1. أسرار الذاتیة ترجمة عبد الوهاب عزام دار المعارف –مصر
2. رسالة الشرق ترجمة عبد الوهاب عزام 1951 مجلس إقبال- الباكستان
3. ضرب كلیم ترجمة عبد الوهاب عزام 1937 جماعة الأزهر –مصر
4. درر من شعر محمد إقبال أمیرة نور الدین
5. تجدید التفكیر الدینی فی الإسلام ترجمة عباس محمود
ملحق (5)
كتب عن إقبال تضم محاضرات الاحتفال بذكراه
1. محمد إقبال- مجموعة مقالات لكبار الكتاب والأدباء العرب- القاهرة 1956.
2. شاعر الإسلام محمد إقبال- مجموعة مقالات لأدباء سعودیین- السعودیة 1957.
3. ذكرى محمد إقبال- مجموعة المقالات فی الاحتفال بإقبال فی دمشق 1964 (دار الفكر- دمشق 1964).
4. نداء إقبال- مجموعة المحاضرات والقصائد فی مؤتمر إقبال فی دمشق 1985. (دار الفكر- دمشق 1986).
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:5|
سعدی الشیرازی شاعر الانسانیة
صادق خورشا
صادق خورشا
اشارة:
وهو من رعیل الخریجین الأوائل فی كلیة الآداب بجامعة فؤاد الأول , حینما كانت الفارسیة تدرس فی ) معهد اللغات الشرقیة ) التابع لكلیة الآداب . وقد دَرَّس فی البدایة بكلیته التی تخرج منها , وما لبث أن أنتقل للعمل فی ( كلیة دار العلوم ) بالقاهرة , وفی جامعة الكویت وكانت هذه أول مرة تُدرس فیها اللغة الفارسیة وآدابها هناك , واستمر فی العمل بجامعة الكویت حتى آخر لحظة فی حیاته .
وقد خلف لنا الدكتور هنداوی العدید من الأبحاث والمؤلفات القیمة الممتعة فی الأدب الفارسی وكانت باكورة أعماله هی كتابه سعدی الشیرازی ( شاعر الإنسانیة ) عصره ودیوانه البوستان . وقد تناول هذا الكتاب تاریخاً حافلاً بالحوادث فی القرن السابع الهجری . وهو العصر الذی عاش فیه الشاعر ( سعدی ) , فتناول أحداثه السیاسیة العامة والخاصة –فی الأقلیم والدولة – وكذلك فصل الحدیث عن الحركة العلمیة والمواكبة لهذا العصر , وأوضح مدى انعكاس كل هذا على تكییف حیاة الشاعر ,وأثره فی إنتاجه ثم انتقل بعد ذلك للحدیث عن شخصیة (سعدی ) ومذهبها فی الحیاة , وحقق وقارن الآراء والخلافات التی تدور حولها .
ثم عدد إنتاجه محاولاً استخلاص بعض أفكار الشاعر) سعدی ( وآراؤه ومذهبه . وأخیراًَ فی الباب الثالث أفرد الحدیث عن دیوان (البوستان ) .
وقد أختار الدكتور ( الهنداوی ) البوستان من إنتاج الشاعرجمیعه لأنه أهم كتاب یعرض للدراسة الأخلاقیة , ویوضح كثیراً من مذاهب الشاعر , وآرائه .
والحقیقة ، أن قراءة هذا الكتاب تعد متعة , فعلى سبیل المثال نجد فی الباب الثانی دراسة واقعیة وتحقیق علمی حول شخصیة , سعدی الشیرازی ، فقد تتبع هنداوی أطراف حیاته من البدایة حتى النهایة , وفصل فی كثیر من الخلافات حول مسائل هامة تعد موضوع جدل ومناقشة مثل النسب والتاریخ المیلاد وغیر ذالك .
أما فصل الحضارة ، فقد أكد فیه الدكتور ( الهنداوی ) على حقیقة - وربما لأول مرة تتناول لهذا المنظور- وهی أن المغول كانوا أهل حضارة ولم یعادوها بالمعنى الذی عرف عنهم ، ووصف بعض المظاهر الحضاریة المدللة على نظریته .
أما دراسته التحلیلیة لدیوانه كانت عوضا عن الترجمة الصامتة وهو یرى من منطلق إیمانه بالدكتور طه حسین ونظریته فی هذا الموضوع ، أن الترجمة وحدها ترضى حاسة الأدیب قبل أن تسد حاجة الباحث العلمی , فالترجمة , هنا هی عمل تكمیلی لا أساسی
وقد شملت هذه الدراسة التحلیلیة تحلیل المقامات وما تحتویها من أفكار ‘ ثم تحلیل القصة التی تدور حول شخوص تاریخیة أو على السنة الحیوان ... ولأنه قرر تعیین حدود القصة قبل الولوج إلى أفكارها ومواضیعها فقد وضع الجداول , وأتبع تحلیل القصة بالإشارة الی الأفكار العامة التی نادى بها الشاعر فی مختلف قصص الباب كله
وهو یؤكد أنه اختار أقوى القصص – بلا منازع – وعرضها للتحلیل فی معرض إثباته للشاعر وآرائه . ونثبت هنا إحدى القطع التی تتعرض لوصفه تعالى , فیجتمع فیها وصفه بالقدم , والقدرة , والخلق ثم فی بیان عجز الإنسان عن إدراك كنهه .
ان العالم متفق على إلهیته
لكنه عاجز عن كنه ماهیته
لم یعرف البشر شیئاً وراء جلاله
لم یدرك البصر منتهى جماله
ولن یبلغ طائر الوهم أوج ذاته
ولن تترك ید الفهم , أطراف صفاته .
ومما یناسب باب العشق الصوفی :
تأمل فی مرآة قلبك
تحصل تدریجیاً – على صفاء نفسك
لعل رائحة من ا لعشق تسكرك
فتصیر طالباً لعهد (الست).
ومن القطع الجمیلة ، القطعة الخامسة من نسخة (سودی ) وعنوانها (فی معنى أهل المحبة ) وتتردد فی هذه القطعة عقیدة الفناء فی الله وقد وردت فی ترجمة هنداوی فی ص 402 :
لا تنتظر أن یكون لی صبر بدونه !
ولا یمكن أن یكون لی قربى بغیره !
لیس عندی محل الصفاء , ولا قدرة على الصبر
ولا مكان للبقاء , ولا قدم للفرار .
لا تقل لی ولّ وجهك عن هذا الباب !
ولو وضعوا رأسی - كالوتد- فی الأطناب
ومنذ ذلك الوقت , الذی طلبنی فیه حبیبی
لم تبق لی معرفة مع أحد غیره
ولأقسمن بحقه ! حین ظهر لی ما فیه من جمال
فكل ماسوا ه , بدا لی ! كأنه خیال .
وان كنت حبیباً , فلا تتحدث عن نفسك
فأنه شرك أن تجمع بین الحبیب , وبین نفسك .
والحقیقة ان صلة الدكتور ( هنداوی ) بشاعر الإنسانیة لم تنتهی عند هذا الحد , لانه كان قد ترجم فی بدایة رحلته مع (سعدی) أشعار كثیرة , وقد تحدث معه الدكتور طه حسین بهذا الصدد واتفقا على أن تؤجل عملیة نشر هذه الترجمة فی مرحلة أخرى وعلیه فقد انتقى الأشعار الخاصة ببحثه وضمنها عمله الأول ، وقد قام بدراسة وافیة مستفیضة عن ( البوستان) وعن موضوعا ته ونسخه والشروح الفارسیة والتركیة التی تمت علیه , وكذلك أبوابه وحكایاته ثم ترجم كتاب البوستان كاملاً فی مجلدین واستطاع أن ینقل لنا الأشعار الخالدة محافظاً على المعانی و الفكرة وبأسلوب سلس دقیق .
وبعد هذه الرحلة مع ( شاعر الإنسانیة) وجد ( هنداوی) ان هناك من الروائع الخالدة التی كتبها الشاعر , لابد وأن یطلع علیها القارئ العربی فقام بترجمة ( الكلستان) وذلك تحت عنوان ( الروضة ) وقد صدر ضمن سلسلة روائع الأدب الفارسی –مكتبة الأنجلو المصریة – القاهرة عام 1955 م . وقد قام بتحقیق النص الفارسی وقدمه للقارئ العربی واضعاً تحت یدیه الأصل الفارسی المحقق المصحح مع الترجمة العربیة ، وجدیر بالذكر أن وزارة المعارف الإیرانیة منحت الدكتور ( هنداوی) وسام المعارف عام 1953 م وذلك تقدیراً له على جهوده وأبحاثه القیمة فی مجال الأدب والثقافة الإیرانیة .
وقد صدر الدكتور ( هنداوی) نسخة البوستان – الطبعة الأولى – صورة هذا الوسام , وكذلك صورة لتهنئة الجامعة له بحصوله علیه .
ومن أعماله القیمة كذلك ( المعجم فی اللغة الفارسیة ) وهو یحتوی قرابة 20ألف كلمة واستعمال وتركیب مع مقابلة دقیقة على أوثق المعاجم الحدیثة وسوف نترك ( الدكتور عبد الوهاب عزام ) , یحدثنا عن هذا المعجم :
( عنى التلمیذ الصدیق الدكتور محمد الهنداوی , بوضع معجم مختصر , اعتمد فیه على أوثق المعاجم الفارسیة والإنكلیزیة . وهو معجم صغیر یمد الطالب بحاجته ویسعفه بطلبه ... وقد عكف على العمل فیه سنین ولقی فیه من المشقة ما یلقى من یعانی مثل هذا العمل، وهو عمل لم یسبق إلیه فی اللغة العربیة ) .
وقد استعان فی تدوین معجمه أولاً بالدكتور ( عبد الوهاب عزام ) عندما كان مدیراً لمعهد للغات الشرقیة بجامعة فؤاد الأولى وقد طلب منه ان یقابل معجمه على معجم فارسی بحت و تخیر له معجم (نوبهار) أو معجم (برهان قاطع ) . ولكن هذا التعاون والمشاركة العلمیة توقفت بعد فترة إذ انشغل الدكتور عزام بمنصب عمادة فی كلیة الآداب . فاستعان الدكتور هنداوی بالسید ( كاظم آزرمی) الملحق بالسفارة الإیرانیة آنذاك وكان قد أسند إلیه العمل فی تدریس اللغة الفارسیة وآدابها بمعهد اللغات الشرقیة . اقترح علیه السید كاظم الآزرمی مقابلة معجمه على قاموس( فرهنك نفیسی) وقد تم ذلك بالإضافة إلى مقابلته مع معجم ( steingass) كما استعان الدكتور هنداوی بعد أن ثقلت أعباء السید كاظم الآزرمی , بالأستاذ الدكتور (أحمد ترجانی زادة) الأستاذ بجامعة تبریز و الموفد إلى مصر وقد انتدبته كلیة الآداب بجامعة فؤاد الأول للتدریس بمعهد اللغات الشرقیة
وقد قام الدكتور محمد موسى (الهنداوی ) كذلك بترجمة كتاب عن تاریخ الأدب فی إیران تحت عنوان (تاریخ الأدب الفارسی ) والكتاب من تألیف الدكتور( رضا زاده شفق ) وعنوانه بالفارسیة (تاریخ أدبیات در إیران ) وهو بهذه الترجمة یعّرف العدید من أدباء وشعراء الفارسیة عبر العصور المختلفة بعد الإسلام . والكتاب یعد تكملة لما قام به الدكتور الشواربی من ترجمته لكتاب ( تاریخ الأدب فی إیران من الفردوسی إلى السعدی ) والتی ترجمها عنه ( ادوارد براون ) .
و من أعماله الجلیلة بالاشتراك مع الدكتور فؤاد الصیاد والأستاذ صادق نشأت ، ترجمته الجزء الأول من المجلد الثانی من كتاب (جامع التواریخ ) وكان ذلك بتكلیف من وزارة الثقافة والإرشاد القومی ( الإدارة العامة للثقافة ) ویحتوی هذا الجزء على فترة من أهم فترات تاریخ المغول وهی فترة حكم (هولاكو) وكذلك مقدمة المؤلف ( رشید الدین فضل الله ) وكذلك مقدمة ( كارتر یر ) المستشرق الفرنسی الكبیر الذی قام بنشر الكتاب وقد ترجم كذلك (یوسف وزلیخا) المنسوب للشاعر الكبیر ( الفردوسی ) و( نصائح الملوك ) للغزالی وأیضاً ( نصائح الملوك ) لسعدی .
ونختم حدیثنا عن الدكتور ( محمد موسى هنداوی ) بمقطوعة لشاعر الإنسانیة ، قام بترجمتها (هنداوی) وهی رقم ( 815) وتحتل الصفحة ( 251) والترجمة :
سواء أكان المرء عبداً ... یحمل الأحمال على أم ناصیته
أویسامی الفلك فی علوه ... وتدنو منه رأسه
ففی اللحظة التی تنتهی فیها حیاته
یغدر الصفاء ... والشقاء ... رأسه ...
إن الغم والسرور ... لیس لهما الدوام
ولكن یبقى ثواب العمل الطیب ... والاسم العظیم
إن الكرم هو الدائم ... ولیس الدوام للتاج والتخت
فأعط !! فإن العطاء بقاء !! یا سعید البخت !!
وأخیرا نذكر فهرساً لمؤلفاته وهی :
---------------------------------------------------------------------------
1 – تاریخ الأدب الفارسی .
2 – سعدی الشیرازی ( شاعر الإنسانیة ) .
3 – المعجم فی اللغة الفارسیة .
4 – بوستان ( الجزء الأول ).
5 – كلستا ن أو الروضة ( الجزء الأول ) .
6 – جامع التواریخ لرشید الدین فضل الله .
7 – بوستان ( الجزء الثانی ) .
6 – السامی فی الاسامی للمیدانی صاحب الأمثال . بالاشتراك .
9 – كلستا ن أو الروضة ( الجزء الثانی ) .
10 – بوستان (الأجزاء الأخیرة ) .
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 22:4|
الرفض فی الشعر الحدیث
إذا كان لا بد من كلمة تقال
فی شعر التفعیلة أو الشعر الحدیث كما یحلو للبعض تسمیته تكون مفتاحه أو
تلخص مساره أو مضمونه فلن تكون تلك الكلمة غیر كلمة الرفض، إنه شعر استهل
مشواره الإبداعی بالتمرد على عمود الشعر الكلاسیكی، ولئن حاول بعض الشعراء
المحدثین التجدید فی الشعر باطراح التقلید والتكلف اللغوی بانتقاء اللفظ
البراق والحرص على الصدق الفنی والتأكید على التجربة الوجدانیة شأن الرابطة
القلمیة وجماعة الدیوان وجماعة أبولو فإن رواد الشعر الحدیث رفضوا هذا
الموقف مصرین على الثورة حریصین على سلوك مسلك فی الشعر فرید من نوعه لا
یكتفی من التجدید بما سلف ذكره، بل یرفض عمود الشعر ویتمرد على القافیة
لأنها تخنق روح الإبداع وتؤكد تبعیة الشاعر للغة فضلا على الإصرار على روح
التقلید و رتابة الماضی.
تكبیر النصتصغیر النصنص فقط
وهكذا فالشعر الحدیث استهل رفضه بالثورة على القالب الشعری زاعما أن القالب التقلیدی لا ینسجم مع روح العصر و لا یلبی الاحتیاجات الفكریة و الجمالیة المستجدة خاصة و عصرنا هو عصر العلم والدیموقراطیة والحریة الإنسانیة – حریة الفكر و المعتقد – وعصر حصلت فیه المرأة على حقوقها ناهیك عن تأثیر الإحتكاك بالثقافة الأوروبیة التی تدمر روح الجمود لحساب روح الإبتكار وتؤكد على المضمون الإنسانی و تحرص على احترام فردیة الإنسان وتمیز كیانه الفكری و الإیدیولوجی والتی هی فی النهایة خلاصة التجربة الدیموقراطیة المنبثقة عن الثورة الفرنسیة و إعلان حقوق الإنسان هذه القیم التی تمثلها شعراؤنا المحدثون وتبنوها كقناعات فكریة ومن ثمة تبلور الرفض وتحتمت الثورة كصرخة عمیقة تزلزل الروح موقظة إیاها من سبات عمیق وخدر فكری زین للإنسان العربی أوهام الماضی على أنها حقائق وفی مقدمتها فكرة تاریخیة عمیقة تداولتها الأجیال على أنها مسلمة لا یأتیها الباطل من بین یدیها ولا من خلفها وهی فكرة المركزیة ونعنی بها اعتقاد العربی أنه مركز التاریخ ودرة الوجود وحامل لواء الحقیقة وما عداه فذیل أو هو على الهامش، لا هو فی العیر و لا هو فی النفیر وقد انتهت تلك الأفكار بالعربی إلى إدانة العقل و تبنی التقلید وانتشار الثقافة الفقهیة على حساب الثقافة العلمیة ووئدت الحریة و أجهز على الروح الإنسانیة فی المرأة وهمشت أحقابا طویلة كما استبد الحاكم وعبث بالإنسان وبالمال العام فعمت الجهالة وانتشرت الفوضى وترسخت الطبقیة و أصبحت الحیاة العربیة إلى تاریخ الحملة الفرنسیة على مصر عام 1798 حیاة عبثیة مجردة من القصدیة انتهت بالعالم العربی إلى الوقوع فریسة سهلة بین مخالب القوى الاستعماریة الفرنسیة و الإنجلیزیة خاصة كنتیجة حتمیة لتراكمات العصور السابقة بظلالها القاتمة.
فهذه الأفكار شكلت القناعة الراسخة لدى شعراء الرفض فی شعرنا الحدیث وحركت فی نفوسهم وضمائرهم مشاعر السخط والتمرد بحثا عن حریة افتقدوها فی رحاب مجتمع غارق فی دیاجیر الجهالة والعماء، وكانت أولى بوادر هذا الرفض و إرهاصاته هی رفض القالب الشعری القدیم لأنه اهتم بالقشور على حساب اللباب و بالزیف على حساب الحقیقة و بالمصلحة الفردیة على حساب المصلحة الجماعیة والتی تنأى بالشاعرعن دروب الحریة و تلقی به فی قرار العبودیة حارمة خلایاه من التجدد فی رحاب الطبیعة والزمان فرواد الشعر الحدیث إذا أخرجوا الشعر من القمقم الذی وضعه فیه الخلیل منذ القرن الثانی الهجری واضعا عنه أغلال القافیة هادما حیطان البیت ذی الشطرین المتساویین واضعا هندسة جدیدة وتصمیما آخر هو صنو الحریة و ابن التلقائیة لا ابن التكلف یتمشى وحدة الانفعال و زخم الأفكار و فردانیة الـتأمل، إنه شعر هو الذی یضبط الموسیقى و یتحكم فیها و لیست هی بالمتحكمة فیه فالسطر یطول أو یقصر حسب حدةالشعور و أهمیة اللحظة وموقف الشاعر منها وفی الصمیم یحتفی هذا الشعر بالموسیقى الداخلیة لا بالموسیقى الخارجیة و یكون النص الشعری فی النهایة رؤیا وموقفا فردانیا للشاعر من الوجود فی تداخل مظاهره وتفاعل عناصره وذلك ما یجعل من الشعر موقفا من العالم و إعادة صیاغة له تتجاوز واقعه الموضوعی إلى علاقته الجدلیة بالذات الشاعرة و اندغام تلك الذات فی هذا الواقع وفق صیغة إنسانیة ولیست میكانیكیة و فی المحصلة أنسنة الوجود لا وصفه خارجیا وهذا هو الإنجاز الأول الذی حققه الشعر الحدیث فی رفضه لكل ما غدا دوغمائیا جاهزا أثر الماضی فیه أطغى من أثر الحاضر ولا عجب أن یبدأ الرفض من القالب الشعری ذاته وفی رفض النموذج الخلیلی باعتباره مرحلة من مراحل التاریخ الثقافی والجمالی للأمة العربیة.
ولعل أكبر الرافضین فی الشعر الحدیث " أدونیس" ورفضه إنسانی یشمل قیم الوجود وواقع الأمة فی ماضیها و حاضرها وتجلیات هذا الواقع فی السیاسة والفكر والدین والعلاقات الاجتماعیة یقول الشاعر
أفتت العالم كی أمنحه الوجود
ضاربا بعصای الصخر حیث ینبجس الرفض
یغسل جسد البسیطة
معلنا طوفان الرفض
معلنا سفر تكوینه
وللطوفان دلالة خاصة ذلك أنه مصطلح دینی تداولته الكتب السماویة وهو یعنی اجتثاث الواقع و سحقه إیذانا بمیلاد عالم جدید لأن ذلك الواقع انتهى إلى العقم و إلى الجدب والتصالح معه لا یجدی ثم یأتی المصطلح التوراتی الثانی " سفر التكوین " الذی یعنی البدایة الأولى والخلق من جدید، وكأنه الواقع الذی تدنس أخلاقیا بدلیل كلمة " یغسل " فی السطر الثالث والتی تعنی عقم الواقع وعطالته وتجرده من القیم الإنسانیة والحریة حجر الزاویة فیها والتی ابتذلتها المؤسسات الرسمیة السیاسیة والدینیة والثقافیة، فغدا الإنسان رقما فی العالم لا حزمة من المشاعر والرؤى والمواقف الفردیة التی تتأكد بها إنیته میزته عن باقی الموجودات و أدونیس ( علی أحمد سعید ) الشاعر السوری المعاصر أكثر الشعراء إثارة للجدل و الاهتمام فی ذات الوقت ذلك أنه شاعر ملغز حلزونی الفكر لا یعطی سره للمراودة الأولى بل یظل محتفظا بسحره وبضبابیته فی ذات الوقت مع الاحتفاظ بقیمته كشاعر صاحب رؤیا وموقف ذاتی من العالم یلخص الأزمة الوجودیة لكل واحد منا إذا ضرب بعصا ه الصخر حیث ینبجس الرفض وقرر أن یتمرد على الدوغمائیات الدینیة و السیاسیة بالمعاییر الأخلاقیة بحثا عن عالم إنسانی لا یكون الواحد منا فیه رقما بل ینطوی فیه العالم الأكبر.
من أنت ؟
من تختار یا مهیار ؟
أنى اتجهت
الله أو هاویة الشیطان
هاویة تذهب أو هاویة تجئ
والعالم اختیار
لا الله أختار و لا الشیطان
كلاهما یغلق عینی
هل أبدل الجدار بالجدار ؟ فإذا قیل: إن العالم اختیار فالشاعر یثور على هذه الكلمة لأنها تعنی الاختیار ا لقسری الذی هو اضطرار مادام الإختیار یقود إلى مسلكین عالم الله وعالم الشیطان و فی النهایة یتقلص حجم الحریة الإنسانیة و یصیب الإنسان مسخ فیصبح كأنه فأر تجارب لا یمكنه أن یسلك إلا أحد المسلكین مسلك الإیمان و التسلیم والقول بأنه لیس فی الإمكان أبدع مما كان ومسلك التمرد و العصیان الذی غدا رتیبا تقلیدیا لأنه مسلك مرسم ومنظر له سیاجاته وحدوده فی الفكر و الشعور و كلا المسلكین یرفضهما الشاعر لأنهما یحدان من نظرته الإنسانیة وطابعه الفردانی وتأملاته فی آفاق بكر وعوالم لم تطأها قدم انسان من قبل وترى الشاعر فی نظرته إلى الوجود یصر على المسلك الإنسانی فهو یرفض المیتافیزیقا لأنها ارتبطت فی اللاوعی بالقهر والرهاب وربما القمع المترسبة عواقبه فی الوجدان من مغبة العصیان وارتكاب الخطیئة بالأكل من الشجرة المحرمة والخوف من فواجع القدر والباحث عن دروب الحریة وآفاق الإنسانیة لابد له أن یرفض كرفض الشاعر البعد الرأسی ویصر على البعد الأفقی لیتأله الناسوت ویتأنسن اللاهوت وهو ما توحی به كلمة " انحناء" فی هذا المقطع:
مات إله كان من هناك
یهبط من جمجمة السماء
لربما فی الذعر والهلاك
فی الیأس والمتاه
یصعد من أعماق الإله
فالأرض لی سریر وزوجة
والعالم انحناء
وإذا كان الرفض فی المقطع الأول هو رفض وجودی وفی الثانی میتافیزیقی فهو فی المقطع الثالث سیاسی، والسیاسة لها سیاجها الدوغمائی و أطرها القهریة ومؤسساتها القمعیة و آصارها اللانسانیة فتختصر الإنسان إلى حزمة من الغرائز أو تجعله ككلب" بافلوف" رهین المنعكسات الشرطیة بین مؤثر و استجابة ولعل المثقف العربی أكثر المثقفین تحملا لأعباء السیاسة وقهرها ولا انسانیتها فهی هرم كبیر یجثم على الصدر و یكتم الأنفاس حجارتها ازدادت صلادة مع كر الدهور منذ الأمویین وإلى الآن ومؤسساتها أطر للتضلیل و التدجین ولذا یرفضها الشاعر ویرفض دوغمائیتها مؤثرا دور المنبت الذی لا أرضا قطع و لا ظهرا أبقى
ولكن هذا المنبت وبحكم انسانیته و بطبعه الاجتماعی وروابطه الإنسانیة أقوى من أن یظل من الأوابد فالإنفصال عن المجموع ما هو إلا جری وراء السراب فی الحقیقة، والإنسان یستمد بقاءه من الجماعة فهو یحیا فیها و بها وهی التی تلهمه الثورة والتمرد وتعزز فیه ذاتیته وتشحذ ذهنه للبحث عن اللباب والمضمون الإنسانی فی العلاقات الاجتماعیة وفی أشكال الإنتاج و الرافض یظل یترنح بین قطبی الاتصال و الانفصال أی هو المتصل المنفصل و المنفصل المتصل
ترید وننی أن أكون مثلكم
تطبخوننی فی قدر صلواتكم
تمزجوننی بحساء العساكر وفلفل الطاغیة
ثم تنصبوننی خیمة للوالی
و ترفعون جمجمتی بیرقا
آه یا موتى ؟ تعیشون كالبلاط
یفصلنی عنكم بعد بحجم السراب
لا أستطیع أن أحیا معكم
لا أستطیع أن أحیا إلا معكم
و یأتی كذلك فی طلیعة الشعراء المحدثین الرافضین الشاعر اللبنانی خلیل حاوی ولعل موته منتحرا بعد غزو إسرائیل للبنان و اجتیاح بیروت عام 1982 تعبیر عن رفضه السیاسی ذلك الرفض الذی كان صرخة فی وجه الأنظمة العربیة القابلة للواقع المملى علیها الراضیة بالتدجین القانعة من الصراع بالتطبیع إنه رفض للهزیمة وعد م اعتراف بشرعیة الواقع الذی صارت إسرائیل طرفا فاعلا فیه ورفض للأنظمة العربیة الفاقدة للشرف وللعذریة والتی أسلمت فلسطین لمصیرها التراجیدی وتهاونت فی قضیة لبنان و سكتت عن احتلال الجولان و انتهت مصر لقمة سائغة بعد اتفاقیات كامب دیفید كل هذه الجروح لم تندمل فی روح الشاعر و ضمیره الذی اقتنع بأن كل شىء فی العالم العربی قد أجدب و أصیب بخصاء فكری و أخلاقی ووجدانی بما فیه الحیاة الثقافیة ورأى أن المعادل الموضوعی لهذا المأزق الوجودی هو الموت فرحل بإرادته تعبیرا عن حالة رفض كلا نی للواقع وعدم اعتراف بشرعیته و فی شعر خلیل حاوی نقع على هذا الرفض بغیر عناء كبیر ففی قصیدته " ضباب و بروق " نقع على حالة یأس تام استسلم لها الشاعر وحالة عطالة انتهى إلیها و لا أدل على ذلك من استخدام كلمة "المقهى" الموحیة بالعطالة وأما حالة الجدب والخصاء والیأس فتعبر عنها فی هدا المقطع كلمة " البوم و أما لفظة" النسر" فدلالتها هی الشموخ و الكبریاء إنها كلمات مشبعة بالرفض ومضمخة بالیأس:
ضجة المقهى ضباب التبغ
مصباح و أشباح یغشیها الضباب
ویغشى رعشة فی شفتی السفلی
یغشى صمت وجهی ووجومه
أفرخ البوم
ومات النسر
فی قلبی الذی اعتاد الهزیمة
والشاعر لا ینسى أن یذكرنا بأحلامه الماضیة ولعلها الشبابیة حین كان طالبا فی جامعة كمبردج، وكیف كان الحلم ناصعا بغد عربی مشرق ووحدة عربیة ونهضة فكریة و علمیة و أدبیة و اندحار للفكر الصهیونی المتطرف فی بلادنا و تلاشی لكل التیارات العمیاء المتطرفة الدینیة و السیاسیة فی عالمنا العربی وقد جد الشاعر و اجتهد باحثا عن المعرفة التی سیوظفها فی خدمة هذا الحلم و عن النور الذی سینیر به حلكات الطریق مضحیا بمصلحته الشخصیة لحساب مصلحة المجموع:
طالما جعت افترست الجمر
أتلفت الیالی
أتقی ماأشتهیه وأهاب
وأطیل الجوع حتى ینطوی الجوع
على موت الرغاب
ثم جاءت ساعة الحقیقة وانجلى الواقع على قبض الریح وحصاد الهشیم فلا الوطن تحرر ولا العدو انحدر ولا المجتمع تقدم وانتهى الشاعر نازفا بالدماء كأنه أحد أبطال التراجیدیا الإغریقیة كأنه برومیثیوس بعدأن بدأ مشواره كأحد أبطال السیر الشعبیة وكأنه أبو زید الهلالی، وهو فی الأخیر رفض لایصنع شیئا ولا یغیر واقعا غیر حفظ الكرامة الإنسانیة وصیانتها عن الإبتذال لقاء أی عرض من أعراض السیاسة أو الرفاه وإذا كان الأمر كذلك فلا جرم أن تدمر الذات إنقاذا لها من مزید من المعاناة الصامتة:
فی جبال من كوابیس التخلی والسهاد
حیث حطت بومة سوداء تجتر السواد
الصدى والظل والدمع جماد !
وأما الشاعر الكبیر عبد الوهاب البیاتی ذلك الشاعر الذی طوف فی الدنیا منفیا ومشردا من موسكو إلى مدرید وإلى دمشق فقد جسد فی شعره وفی حیاته حالة الرفض للقهر السیاسی واستبداد الحكام وحالة الرفض لكل السلطات الدنیویة والدینیة كالإكلیروس الدینی والمؤسسات السیاسیة والثقافیة الرسمیة لأنها تمارس الإكراه على الحریة الإنسانیة وتعتدی على الكرامة البشریة وقد امتد رفض البیاتی هذا إلى الإعجاب برافضین من تاریخنا العربی ومن العالم الغربی، فمحی الدین بن عربی الشاعر الأندلسی صاحب فلسفة وحدة الوجود والفتوحات الملكیة كان فی تصوفه وفی حبه رافضا للثقافة السائدة والتدین الساری متبنیا موقفا إنسانیا فریدا لا علاقة له بما هو جاری العمل به فی الواقع،وقد نال هذا الشاعر احترام وحب البیاتی إلى درجة أنه أوصى أن یدفن إلى جواره فی دمشق.
ویمتد إعجاب البیاتی إلى شاعر كبیر من إسبانیا هو فریدیریكو غارسیا لوركا وهو فی الشعر الإسبانی شاعر رافض ورفضه أدى إلى موته مقتولا على أیدی قوات فرانكو دیكتاتور إسبانیا.
لقد رفض لوركا الثقافة الرسمیة التی تنص على مركزیة أوربا وهامشیة العالم الآخر كما رفض النظریة التی تربط التفوق بلون البشرة والدم، وترجع تقهقر إسبانیا الصناعی والعلمی قیاسا إلى فرنسا وألمانیا إلى الوجود العربی أیام الأندلس، فقد رفض هذا الشاعر البدیع أن یعتبر الوجود العربی الإسلامی فی إسبانیا احتلالا حال دون تقدم شبه الجزیرة الإیبیریة، بل اعتبره وجودا حضاریا أفاد اسبانیا عمرانیا وعلمیا وفكریا وفنیا لم یحسن الإسبان فیما بعد احتضانه وتمثله فكانت همجیة فرناند وإیزابیلا وجنودها التی صنعت فضائح وفضائع یندى لها جبین الإنسانیة وقد عبر لوركا عن مواقفه هذه شعرا وفی لقاءاته الصحفیة إلى درجة إقلاق النظام الحاكم فأعدمته قوات فرانكو تخلصا منه ومن مواقفه.
إذا وجد البیاتی فی هذا الشاعر صدیقا كما وجد ذلك فی شاعر المتصوفة وصوفی الشعراء محی الدین بن عربی والبیاتی یرفض تخاذل المثقف فی السكوت على ظلم الحاكم والتعلل لذلك بقوة السلطان وجبروته وحاجات النفس والتمادی فی هذا الموقف المتخاذل إلى درجة التحول من سیف یناضل ضد القهر والعماء إلى مروحة تجلب للحاكم النسیم العلیل لقاء اتقاء شره والظفر بمغانم الدنیا !
ولقد كان الشاعر مؤمنا أن الثقافة الحقة یجب أن یتحلى الموصوف بها بصفة النضال ضد الطبقیة والرجعیة والتخلف والقهر لحساب النهضة والحریة والكرامة خاصة والمجتمع العربی فی المنعطف لم یخرج إلى آفاق العلم والحریة والإبداع الرحبة كغیره من شعوب العالم المتمدن.
إنه یرفض المثقف المتحول إلى حزمة من الغرائز تنشد الإشباع فی البلاط ساكتة عن جرائم السلطان مؤثرة المصلحة الفردیة على حساب مصلحة الجماعة فهو یقول عن المثقف:
یداعب الأوتار
یمشی فوق حد السیف والدخان
یرقص فوق الحبل
یأكل الزجاج
ینثنی مغنیا سكران
یقلد السعدان
یركب فوق متنه الأطفال فی البستان
یخرج للشمس إذا مدت إلیه یدها اللسان
یكلم النجوم والأموات
ینام فی الساحات !
فهذا المثقف الذی كان یفترض فیه أن یكون طلیعیا تحول إلى بهلوان یجید الریاء والتلاعب بمشاعر الأمة وخداعهم والتمویه علیهم، لقد صار كالدرویش رمزا للسذاجة والغفلة وقد غدا الأمر هزأة فهو ینام فی الساحات ویكلم الأموات ویتعامل بغباء مع قیم الثورة والحریة والعطاء فیخرج للشمس إذا مدت إلیه یدها اللسان ! ونأتی فی خاتمة المقال إلى شاعر مثیر للجدل لاتكف الألسن عن تداول اسمه وتردید شعره فهو فی المحدثین كأبی الطیب فی القدماء إنه الشاعر السوری نزار قبانی فقد كانت حیاته هو الآخر تجسیدا لمبدأ الرفض وكان شعره بلورة له وذهابا به إلى أقصى المعمورة صراخا وتشهیرا به، وأما رفضه فیتجلى فی موقفه من المرأة ومن الحب حین رفض روایة المؤسسة الرسمیة الملیئة بالنفاق والتحایل والقهر والكذب والسادیة واحتقار الكرامة الإنسانیة المتجلیة فی الأنوثة وفی الحط من قدرها وتلخیصها فی میزاتها الجنسیة لأنه مجتمع الكوالیس، یبطن غیرما یظهر ویرى الحب جریرة والحدیث عنه دعارة ولا یرى مانعا من ممارسته فی الخفاء ألا إنه مجتمع منحط حین یأتی الرجل والمرأة كلاهما فعلا واحد فیرى الرجل بطلا والمرأة مومسا، وقد جسد هذا الرفض فی انتقامه للأخت المنتحرة التی رفضت هی الأخرى زواجا قسریا مفضلة الموت علیه بالتشهیر بالحب وبنعیمه وبالتغنی بمواطن الفتنة فی المرأة وفی الإعلاء من شأن الأنوثة منذ صدور دیوانه الأول" طفولة نهد" الذی تحول تحت ضغط المؤسسات الرسمیة الوصیة إلى " طفولة نهر"
وأما الرفض السیاسی فللشاعر فیه صولات وجولات منذ صدور" هوامش على دفتر النكسة"، وقد كان الشاعر فضاحا للمواقف المتخاذلة مشهرا بها لا یهادن ولا یسالم معتبرا جبن الساسة وتخاذلهم بل ونفاقهم هو الذی أسلم فلسطین إلى أعدائها ورهن مستقبل كامل البلاد العربیة وفی قصیدته المشهورة التی بعث بها إلى جامعة الدول العربیة بتونس والتی عنوانها" أنا متعب بعروبتی" یتجلى هذا الرفض فی حالة من الثورة العارمة والإنفعالات الحادة المعبرة عن عمق الجرح ونزیفه ولقد كتبها الشاعر على الطریقة العمودیة لیرد على مؤسسة رسمیة بقالب شعری رسمی نظر له الخلیل لایعوزه التحكم فیه والسیطرة علیه وقد كان تأثیر هذه القصیدة مدویا لأنها صادفت هوى جمیع العرب وعبرت عن مكنون ضمائرهم فمن رفض طغیان الساسة:
من أین یأتی الشعر یا قرطاجة
والله مات وعادت الأنصاب؟
من أین یأتی الشعر حین نهارها
قمع وحین مساؤنا إرهاب؟
سرقوا أصابعنا وعطر حـروفنا
فبأی شىء یكتب الكتاب ؟
والــــحكم شرطی یسیر وراءنا
فنـكهة خــــبزنا استجواب
إلى رفض استبداد المؤسسات الثقافیة وممثلیها من الشعراء خاصة:
من أین أدخل فی القصیدة یاترى
وحدائق الشعر الجمیل خراب؟
لـــــم یبق فی دار الــبلابل بــلبل
لا الــبحتری هنــا ولا زریــاب
شعراء هذا الیوم جـــنس ثـــالث
الـــــقول فوضى والكلام ضباب
اللاهثون على هـــوامش عمرنا
سیان إن حضروا وإن هم غابوا
إذا لقد كان الشعر الحدیث بتمثله لمبدأ الرفض شعرا تقدمیا وإنسانیا وكان هؤلاء الشعراء الأعلام فرسان الكلمة ورجال الموقف نأوا بالشعر عن قصور الحكام ونزهوا الشعر عن تضمنه العربدة المحببة إلى قلوب الجماهیر، لقد طوحوا به فی آفاق الإنسانیة الرحبة، والتزموا حقا- كما یلح جون بول سارتر على فكرة الإلتزام فی الأدب وعلى ضرورة تأمیمه- بقضایا الوطن وتاریخه العریق وحاضره التعس ومستقبله المرهون بلا خطابیة فجة أو إیدیولوجیة مقیتة فحافظ شعرهم على طراوته ونكهته الوجدانیة ومضامینه الفكریة والإنسانیة، وقد ساعدهم على ذلك نفس شعری قوی لا یخمد وروح تجدیدیة عنیدة لا تقهر ولا تخبو نارها، ووعی بالواقع فی علاقاته المتشابكة خاصة مع الغرب سیاسة وثقافة بل وقوتا، فجاء هذا الشعر فی صیغته الحدیثة شعرا انسانیا – على الرغم من عثراته ونقائصه-وقد أثبت قوته وشبابه وحصانته وأنه قادر على اكتساح المنابر الثقافیة وضم المریدین والأشیاع رغم تمرده على الذاكرة والخطابیة ورنة الترنم، وهو رد حاسم على كل المشككین فی جدوى الشعر الحدیث.
تكبیر النصتصغیر النصنص فقط
وهكذا فالشعر الحدیث استهل رفضه بالثورة على القالب الشعری زاعما أن القالب التقلیدی لا ینسجم مع روح العصر و لا یلبی الاحتیاجات الفكریة و الجمالیة المستجدة خاصة و عصرنا هو عصر العلم والدیموقراطیة والحریة الإنسانیة – حریة الفكر و المعتقد – وعصر حصلت فیه المرأة على حقوقها ناهیك عن تأثیر الإحتكاك بالثقافة الأوروبیة التی تدمر روح الجمود لحساب روح الإبتكار وتؤكد على المضمون الإنسانی و تحرص على احترام فردیة الإنسان وتمیز كیانه الفكری و الإیدیولوجی والتی هی فی النهایة خلاصة التجربة الدیموقراطیة المنبثقة عن الثورة الفرنسیة و إعلان حقوق الإنسان هذه القیم التی تمثلها شعراؤنا المحدثون وتبنوها كقناعات فكریة ومن ثمة تبلور الرفض وتحتمت الثورة كصرخة عمیقة تزلزل الروح موقظة إیاها من سبات عمیق وخدر فكری زین للإنسان العربی أوهام الماضی على أنها حقائق وفی مقدمتها فكرة تاریخیة عمیقة تداولتها الأجیال على أنها مسلمة لا یأتیها الباطل من بین یدیها ولا من خلفها وهی فكرة المركزیة ونعنی بها اعتقاد العربی أنه مركز التاریخ ودرة الوجود وحامل لواء الحقیقة وما عداه فذیل أو هو على الهامش، لا هو فی العیر و لا هو فی النفیر وقد انتهت تلك الأفكار بالعربی إلى إدانة العقل و تبنی التقلید وانتشار الثقافة الفقهیة على حساب الثقافة العلمیة ووئدت الحریة و أجهز على الروح الإنسانیة فی المرأة وهمشت أحقابا طویلة كما استبد الحاكم وعبث بالإنسان وبالمال العام فعمت الجهالة وانتشرت الفوضى وترسخت الطبقیة و أصبحت الحیاة العربیة إلى تاریخ الحملة الفرنسیة على مصر عام 1798 حیاة عبثیة مجردة من القصدیة انتهت بالعالم العربی إلى الوقوع فریسة سهلة بین مخالب القوى الاستعماریة الفرنسیة و الإنجلیزیة خاصة كنتیجة حتمیة لتراكمات العصور السابقة بظلالها القاتمة.
فهذه الأفكار شكلت القناعة الراسخة لدى شعراء الرفض فی شعرنا الحدیث وحركت فی نفوسهم وضمائرهم مشاعر السخط والتمرد بحثا عن حریة افتقدوها فی رحاب مجتمع غارق فی دیاجیر الجهالة والعماء، وكانت أولى بوادر هذا الرفض و إرهاصاته هی رفض القالب الشعری القدیم لأنه اهتم بالقشور على حساب اللباب و بالزیف على حساب الحقیقة و بالمصلحة الفردیة على حساب المصلحة الجماعیة والتی تنأى بالشاعرعن دروب الحریة و تلقی به فی قرار العبودیة حارمة خلایاه من التجدد فی رحاب الطبیعة والزمان فرواد الشعر الحدیث إذا أخرجوا الشعر من القمقم الذی وضعه فیه الخلیل منذ القرن الثانی الهجری واضعا عنه أغلال القافیة هادما حیطان البیت ذی الشطرین المتساویین واضعا هندسة جدیدة وتصمیما آخر هو صنو الحریة و ابن التلقائیة لا ابن التكلف یتمشى وحدة الانفعال و زخم الأفكار و فردانیة الـتأمل، إنه شعر هو الذی یضبط الموسیقى و یتحكم فیها و لیست هی بالمتحكمة فیه فالسطر یطول أو یقصر حسب حدةالشعور و أهمیة اللحظة وموقف الشاعر منها وفی الصمیم یحتفی هذا الشعر بالموسیقى الداخلیة لا بالموسیقى الخارجیة و یكون النص الشعری فی النهایة رؤیا وموقفا فردانیا للشاعر من الوجود فی تداخل مظاهره وتفاعل عناصره وذلك ما یجعل من الشعر موقفا من العالم و إعادة صیاغة له تتجاوز واقعه الموضوعی إلى علاقته الجدلیة بالذات الشاعرة و اندغام تلك الذات فی هذا الواقع وفق صیغة إنسانیة ولیست میكانیكیة و فی المحصلة أنسنة الوجود لا وصفه خارجیا وهذا هو الإنجاز الأول الذی حققه الشعر الحدیث فی رفضه لكل ما غدا دوغمائیا جاهزا أثر الماضی فیه أطغى من أثر الحاضر ولا عجب أن یبدأ الرفض من القالب الشعری ذاته وفی رفض النموذج الخلیلی باعتباره مرحلة من مراحل التاریخ الثقافی والجمالی للأمة العربیة.
ولعل أكبر الرافضین فی الشعر الحدیث " أدونیس" ورفضه إنسانی یشمل قیم الوجود وواقع الأمة فی ماضیها و حاضرها وتجلیات هذا الواقع فی السیاسة والفكر والدین والعلاقات الاجتماعیة یقول الشاعر
أفتت العالم كی أمنحه الوجود
ضاربا بعصای الصخر حیث ینبجس الرفض
یغسل جسد البسیطة
معلنا طوفان الرفض
معلنا سفر تكوینه
وللطوفان دلالة خاصة ذلك أنه مصطلح دینی تداولته الكتب السماویة وهو یعنی اجتثاث الواقع و سحقه إیذانا بمیلاد عالم جدید لأن ذلك الواقع انتهى إلى العقم و إلى الجدب والتصالح معه لا یجدی ثم یأتی المصطلح التوراتی الثانی " سفر التكوین " الذی یعنی البدایة الأولى والخلق من جدید، وكأنه الواقع الذی تدنس أخلاقیا بدلیل كلمة " یغسل " فی السطر الثالث والتی تعنی عقم الواقع وعطالته وتجرده من القیم الإنسانیة والحریة حجر الزاویة فیها والتی ابتذلتها المؤسسات الرسمیة السیاسیة والدینیة والثقافیة، فغدا الإنسان رقما فی العالم لا حزمة من المشاعر والرؤى والمواقف الفردیة التی تتأكد بها إنیته میزته عن باقی الموجودات و أدونیس ( علی أحمد سعید ) الشاعر السوری المعاصر أكثر الشعراء إثارة للجدل و الاهتمام فی ذات الوقت ذلك أنه شاعر ملغز حلزونی الفكر لا یعطی سره للمراودة الأولى بل یظل محتفظا بسحره وبضبابیته فی ذات الوقت مع الاحتفاظ بقیمته كشاعر صاحب رؤیا وموقف ذاتی من العالم یلخص الأزمة الوجودیة لكل واحد منا إذا ضرب بعصا ه الصخر حیث ینبجس الرفض وقرر أن یتمرد على الدوغمائیات الدینیة و السیاسیة بالمعاییر الأخلاقیة بحثا عن عالم إنسانی لا یكون الواحد منا فیه رقما بل ینطوی فیه العالم الأكبر.
من أنت ؟
من تختار یا مهیار ؟
أنى اتجهت
الله أو هاویة الشیطان
هاویة تذهب أو هاویة تجئ
والعالم اختیار
لا الله أختار و لا الشیطان
كلاهما یغلق عینی
هل أبدل الجدار بالجدار ؟ فإذا قیل: إن العالم اختیار فالشاعر یثور على هذه الكلمة لأنها تعنی الاختیار ا لقسری الذی هو اضطرار مادام الإختیار یقود إلى مسلكین عالم الله وعالم الشیطان و فی النهایة یتقلص حجم الحریة الإنسانیة و یصیب الإنسان مسخ فیصبح كأنه فأر تجارب لا یمكنه أن یسلك إلا أحد المسلكین مسلك الإیمان و التسلیم والقول بأنه لیس فی الإمكان أبدع مما كان ومسلك التمرد و العصیان الذی غدا رتیبا تقلیدیا لأنه مسلك مرسم ومنظر له سیاجاته وحدوده فی الفكر و الشعور و كلا المسلكین یرفضهما الشاعر لأنهما یحدان من نظرته الإنسانیة وطابعه الفردانی وتأملاته فی آفاق بكر وعوالم لم تطأها قدم انسان من قبل وترى الشاعر فی نظرته إلى الوجود یصر على المسلك الإنسانی فهو یرفض المیتافیزیقا لأنها ارتبطت فی اللاوعی بالقهر والرهاب وربما القمع المترسبة عواقبه فی الوجدان من مغبة العصیان وارتكاب الخطیئة بالأكل من الشجرة المحرمة والخوف من فواجع القدر والباحث عن دروب الحریة وآفاق الإنسانیة لابد له أن یرفض كرفض الشاعر البعد الرأسی ویصر على البعد الأفقی لیتأله الناسوت ویتأنسن اللاهوت وهو ما توحی به كلمة " انحناء" فی هذا المقطع:
مات إله كان من هناك
یهبط من جمجمة السماء
لربما فی الذعر والهلاك
فی الیأس والمتاه
یصعد من أعماق الإله
فالأرض لی سریر وزوجة
والعالم انحناء
وإذا كان الرفض فی المقطع الأول هو رفض وجودی وفی الثانی میتافیزیقی فهو فی المقطع الثالث سیاسی، والسیاسة لها سیاجها الدوغمائی و أطرها القهریة ومؤسساتها القمعیة و آصارها اللانسانیة فتختصر الإنسان إلى حزمة من الغرائز أو تجعله ككلب" بافلوف" رهین المنعكسات الشرطیة بین مؤثر و استجابة ولعل المثقف العربی أكثر المثقفین تحملا لأعباء السیاسة وقهرها ولا انسانیتها فهی هرم كبیر یجثم على الصدر و یكتم الأنفاس حجارتها ازدادت صلادة مع كر الدهور منذ الأمویین وإلى الآن ومؤسساتها أطر للتضلیل و التدجین ولذا یرفضها الشاعر ویرفض دوغمائیتها مؤثرا دور المنبت الذی لا أرضا قطع و لا ظهرا أبقى
ولكن هذا المنبت وبحكم انسانیته و بطبعه الاجتماعی وروابطه الإنسانیة أقوى من أن یظل من الأوابد فالإنفصال عن المجموع ما هو إلا جری وراء السراب فی الحقیقة، والإنسان یستمد بقاءه من الجماعة فهو یحیا فیها و بها وهی التی تلهمه الثورة والتمرد وتعزز فیه ذاتیته وتشحذ ذهنه للبحث عن اللباب والمضمون الإنسانی فی العلاقات الاجتماعیة وفی أشكال الإنتاج و الرافض یظل یترنح بین قطبی الاتصال و الانفصال أی هو المتصل المنفصل و المنفصل المتصل
ترید وننی أن أكون مثلكم
تطبخوننی فی قدر صلواتكم
تمزجوننی بحساء العساكر وفلفل الطاغیة
ثم تنصبوننی خیمة للوالی
و ترفعون جمجمتی بیرقا
آه یا موتى ؟ تعیشون كالبلاط
یفصلنی عنكم بعد بحجم السراب
لا أستطیع أن أحیا معكم
لا أستطیع أن أحیا إلا معكم
و یأتی كذلك فی طلیعة الشعراء المحدثین الرافضین الشاعر اللبنانی خلیل حاوی ولعل موته منتحرا بعد غزو إسرائیل للبنان و اجتیاح بیروت عام 1982 تعبیر عن رفضه السیاسی ذلك الرفض الذی كان صرخة فی وجه الأنظمة العربیة القابلة للواقع المملى علیها الراضیة بالتدجین القانعة من الصراع بالتطبیع إنه رفض للهزیمة وعد م اعتراف بشرعیة الواقع الذی صارت إسرائیل طرفا فاعلا فیه ورفض للأنظمة العربیة الفاقدة للشرف وللعذریة والتی أسلمت فلسطین لمصیرها التراجیدی وتهاونت فی قضیة لبنان و سكتت عن احتلال الجولان و انتهت مصر لقمة سائغة بعد اتفاقیات كامب دیفید كل هذه الجروح لم تندمل فی روح الشاعر و ضمیره الذی اقتنع بأن كل شىء فی العالم العربی قد أجدب و أصیب بخصاء فكری و أخلاقی ووجدانی بما فیه الحیاة الثقافیة ورأى أن المعادل الموضوعی لهذا المأزق الوجودی هو الموت فرحل بإرادته تعبیرا عن حالة رفض كلا نی للواقع وعدم اعتراف بشرعیته و فی شعر خلیل حاوی نقع على هذا الرفض بغیر عناء كبیر ففی قصیدته " ضباب و بروق " نقع على حالة یأس تام استسلم لها الشاعر وحالة عطالة انتهى إلیها و لا أدل على ذلك من استخدام كلمة "المقهى" الموحیة بالعطالة وأما حالة الجدب والخصاء والیأس فتعبر عنها فی هدا المقطع كلمة " البوم و أما لفظة" النسر" فدلالتها هی الشموخ و الكبریاء إنها كلمات مشبعة بالرفض ومضمخة بالیأس:
ضجة المقهى ضباب التبغ
مصباح و أشباح یغشیها الضباب
ویغشى رعشة فی شفتی السفلی
یغشى صمت وجهی ووجومه
أفرخ البوم
ومات النسر
فی قلبی الذی اعتاد الهزیمة
والشاعر لا ینسى أن یذكرنا بأحلامه الماضیة ولعلها الشبابیة حین كان طالبا فی جامعة كمبردج، وكیف كان الحلم ناصعا بغد عربی مشرق ووحدة عربیة ونهضة فكریة و علمیة و أدبیة و اندحار للفكر الصهیونی المتطرف فی بلادنا و تلاشی لكل التیارات العمیاء المتطرفة الدینیة و السیاسیة فی عالمنا العربی وقد جد الشاعر و اجتهد باحثا عن المعرفة التی سیوظفها فی خدمة هذا الحلم و عن النور الذی سینیر به حلكات الطریق مضحیا بمصلحته الشخصیة لحساب مصلحة المجموع:
طالما جعت افترست الجمر
أتلفت الیالی
أتقی ماأشتهیه وأهاب
وأطیل الجوع حتى ینطوی الجوع
على موت الرغاب
ثم جاءت ساعة الحقیقة وانجلى الواقع على قبض الریح وحصاد الهشیم فلا الوطن تحرر ولا العدو انحدر ولا المجتمع تقدم وانتهى الشاعر نازفا بالدماء كأنه أحد أبطال التراجیدیا الإغریقیة كأنه برومیثیوس بعدأن بدأ مشواره كأحد أبطال السیر الشعبیة وكأنه أبو زید الهلالی، وهو فی الأخیر رفض لایصنع شیئا ولا یغیر واقعا غیر حفظ الكرامة الإنسانیة وصیانتها عن الإبتذال لقاء أی عرض من أعراض السیاسة أو الرفاه وإذا كان الأمر كذلك فلا جرم أن تدمر الذات إنقاذا لها من مزید من المعاناة الصامتة:
فی جبال من كوابیس التخلی والسهاد
حیث حطت بومة سوداء تجتر السواد
الصدى والظل والدمع جماد !
وأما الشاعر الكبیر عبد الوهاب البیاتی ذلك الشاعر الذی طوف فی الدنیا منفیا ومشردا من موسكو إلى مدرید وإلى دمشق فقد جسد فی شعره وفی حیاته حالة الرفض للقهر السیاسی واستبداد الحكام وحالة الرفض لكل السلطات الدنیویة والدینیة كالإكلیروس الدینی والمؤسسات السیاسیة والثقافیة الرسمیة لأنها تمارس الإكراه على الحریة الإنسانیة وتعتدی على الكرامة البشریة وقد امتد رفض البیاتی هذا إلى الإعجاب برافضین من تاریخنا العربی ومن العالم الغربی، فمحی الدین بن عربی الشاعر الأندلسی صاحب فلسفة وحدة الوجود والفتوحات الملكیة كان فی تصوفه وفی حبه رافضا للثقافة السائدة والتدین الساری متبنیا موقفا إنسانیا فریدا لا علاقة له بما هو جاری العمل به فی الواقع،وقد نال هذا الشاعر احترام وحب البیاتی إلى درجة أنه أوصى أن یدفن إلى جواره فی دمشق.
ویمتد إعجاب البیاتی إلى شاعر كبیر من إسبانیا هو فریدیریكو غارسیا لوركا وهو فی الشعر الإسبانی شاعر رافض ورفضه أدى إلى موته مقتولا على أیدی قوات فرانكو دیكتاتور إسبانیا.
لقد رفض لوركا الثقافة الرسمیة التی تنص على مركزیة أوربا وهامشیة العالم الآخر كما رفض النظریة التی تربط التفوق بلون البشرة والدم، وترجع تقهقر إسبانیا الصناعی والعلمی قیاسا إلى فرنسا وألمانیا إلى الوجود العربی أیام الأندلس، فقد رفض هذا الشاعر البدیع أن یعتبر الوجود العربی الإسلامی فی إسبانیا احتلالا حال دون تقدم شبه الجزیرة الإیبیریة، بل اعتبره وجودا حضاریا أفاد اسبانیا عمرانیا وعلمیا وفكریا وفنیا لم یحسن الإسبان فیما بعد احتضانه وتمثله فكانت همجیة فرناند وإیزابیلا وجنودها التی صنعت فضائح وفضائع یندى لها جبین الإنسانیة وقد عبر لوركا عن مواقفه هذه شعرا وفی لقاءاته الصحفیة إلى درجة إقلاق النظام الحاكم فأعدمته قوات فرانكو تخلصا منه ومن مواقفه.
إذا وجد البیاتی فی هذا الشاعر صدیقا كما وجد ذلك فی شاعر المتصوفة وصوفی الشعراء محی الدین بن عربی والبیاتی یرفض تخاذل المثقف فی السكوت على ظلم الحاكم والتعلل لذلك بقوة السلطان وجبروته وحاجات النفس والتمادی فی هذا الموقف المتخاذل إلى درجة التحول من سیف یناضل ضد القهر والعماء إلى مروحة تجلب للحاكم النسیم العلیل لقاء اتقاء شره والظفر بمغانم الدنیا !
ولقد كان الشاعر مؤمنا أن الثقافة الحقة یجب أن یتحلى الموصوف بها بصفة النضال ضد الطبقیة والرجعیة والتخلف والقهر لحساب النهضة والحریة والكرامة خاصة والمجتمع العربی فی المنعطف لم یخرج إلى آفاق العلم والحریة والإبداع الرحبة كغیره من شعوب العالم المتمدن.
إنه یرفض المثقف المتحول إلى حزمة من الغرائز تنشد الإشباع فی البلاط ساكتة عن جرائم السلطان مؤثرة المصلحة الفردیة على حساب مصلحة الجماعة فهو یقول عن المثقف:
یداعب الأوتار
یمشی فوق حد السیف والدخان
یرقص فوق الحبل
یأكل الزجاج
ینثنی مغنیا سكران
یقلد السعدان
یركب فوق متنه الأطفال فی البستان
یخرج للشمس إذا مدت إلیه یدها اللسان
یكلم النجوم والأموات
ینام فی الساحات !
فهذا المثقف الذی كان یفترض فیه أن یكون طلیعیا تحول إلى بهلوان یجید الریاء والتلاعب بمشاعر الأمة وخداعهم والتمویه علیهم، لقد صار كالدرویش رمزا للسذاجة والغفلة وقد غدا الأمر هزأة فهو ینام فی الساحات ویكلم الأموات ویتعامل بغباء مع قیم الثورة والحریة والعطاء فیخرج للشمس إذا مدت إلیه یدها اللسان ! ونأتی فی خاتمة المقال إلى شاعر مثیر للجدل لاتكف الألسن عن تداول اسمه وتردید شعره فهو فی المحدثین كأبی الطیب فی القدماء إنه الشاعر السوری نزار قبانی فقد كانت حیاته هو الآخر تجسیدا لمبدأ الرفض وكان شعره بلورة له وذهابا به إلى أقصى المعمورة صراخا وتشهیرا به، وأما رفضه فیتجلى فی موقفه من المرأة ومن الحب حین رفض روایة المؤسسة الرسمیة الملیئة بالنفاق والتحایل والقهر والكذب والسادیة واحتقار الكرامة الإنسانیة المتجلیة فی الأنوثة وفی الحط من قدرها وتلخیصها فی میزاتها الجنسیة لأنه مجتمع الكوالیس، یبطن غیرما یظهر ویرى الحب جریرة والحدیث عنه دعارة ولا یرى مانعا من ممارسته فی الخفاء ألا إنه مجتمع منحط حین یأتی الرجل والمرأة كلاهما فعلا واحد فیرى الرجل بطلا والمرأة مومسا، وقد جسد هذا الرفض فی انتقامه للأخت المنتحرة التی رفضت هی الأخرى زواجا قسریا مفضلة الموت علیه بالتشهیر بالحب وبنعیمه وبالتغنی بمواطن الفتنة فی المرأة وفی الإعلاء من شأن الأنوثة منذ صدور دیوانه الأول" طفولة نهد" الذی تحول تحت ضغط المؤسسات الرسمیة الوصیة إلى " طفولة نهر"
وأما الرفض السیاسی فللشاعر فیه صولات وجولات منذ صدور" هوامش على دفتر النكسة"، وقد كان الشاعر فضاحا للمواقف المتخاذلة مشهرا بها لا یهادن ولا یسالم معتبرا جبن الساسة وتخاذلهم بل ونفاقهم هو الذی أسلم فلسطین إلى أعدائها ورهن مستقبل كامل البلاد العربیة وفی قصیدته المشهورة التی بعث بها إلى جامعة الدول العربیة بتونس والتی عنوانها" أنا متعب بعروبتی" یتجلى هذا الرفض فی حالة من الثورة العارمة والإنفعالات الحادة المعبرة عن عمق الجرح ونزیفه ولقد كتبها الشاعر على الطریقة العمودیة لیرد على مؤسسة رسمیة بقالب شعری رسمی نظر له الخلیل لایعوزه التحكم فیه والسیطرة علیه وقد كان تأثیر هذه القصیدة مدویا لأنها صادفت هوى جمیع العرب وعبرت عن مكنون ضمائرهم فمن رفض طغیان الساسة:
من أین یأتی الشعر یا قرطاجة
والله مات وعادت الأنصاب؟
من أین یأتی الشعر حین نهارها
قمع وحین مساؤنا إرهاب؟
سرقوا أصابعنا وعطر حـروفنا
فبأی شىء یكتب الكتاب ؟
والــــحكم شرطی یسیر وراءنا
فنـكهة خــــبزنا استجواب
إلى رفض استبداد المؤسسات الثقافیة وممثلیها من الشعراء خاصة:
من أین أدخل فی القصیدة یاترى
وحدائق الشعر الجمیل خراب؟
لـــــم یبق فی دار الــبلابل بــلبل
لا الــبحتری هنــا ولا زریــاب
شعراء هذا الیوم جـــنس ثـــالث
الـــــقول فوضى والكلام ضباب
اللاهثون على هـــوامش عمرنا
سیان إن حضروا وإن هم غابوا
إذا لقد كان الشعر الحدیث بتمثله لمبدأ الرفض شعرا تقدمیا وإنسانیا وكان هؤلاء الشعراء الأعلام فرسان الكلمة ورجال الموقف نأوا بالشعر عن قصور الحكام ونزهوا الشعر عن تضمنه العربدة المحببة إلى قلوب الجماهیر، لقد طوحوا به فی آفاق الإنسانیة الرحبة، والتزموا حقا- كما یلح جون بول سارتر على فكرة الإلتزام فی الأدب وعلى ضرورة تأمیمه- بقضایا الوطن وتاریخه العریق وحاضره التعس ومستقبله المرهون بلا خطابیة فجة أو إیدیولوجیة مقیتة فحافظ شعرهم على طراوته ونكهته الوجدانیة ومضامینه الفكریة والإنسانیة، وقد ساعدهم على ذلك نفس شعری قوی لا یخمد وروح تجدیدیة عنیدة لا تقهر ولا تخبو نارها، ووعی بالواقع فی علاقاته المتشابكة خاصة مع الغرب سیاسة وثقافة بل وقوتا، فجاء هذا الشعر فی صیغته الحدیثة شعرا انسانیا – على الرغم من عثراته ونقائصه-وقد أثبت قوته وشبابه وحصانته وأنه قادر على اكتساح المنابر الثقافیة وضم المریدین والأشیاع رغم تمرده على الذاكرة والخطابیة ورنة الترنم، وهو رد حاسم على كل المشككین فی جدوى الشعر الحدیث.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:58|
بین
العربیة و الفارسیة - مقارنة لغویة
لا بد لنا من الذكر بدایة أن التواصل بین الشعوب القاطنة فی فارس و الجریرة العربیة وبلاد الرافدین لم ینقطع أبدا منذ بدایة التاریخ بل أن التكامل بین جمیع القبائل القاطنة فیها كان كبیرا ، و انه قد اشتد و توثق بعد رسالة محمد ( ص) – أو ما یسمیه المؤرخین الحضارة الإسلامیة.
لقد نظر العدید من الباحثین إلى هذا التقارب من وجهتی نظر متطابقتین فی المضمون ، مختلفتین فی المبنى و التسمیة - فجاءت أبحاثهم تحوی العدید من الأدلة التی تدل على التقارب ، القسم الأول القدیم منها اعتبر أن اللغة العربیة اقترضت من الفارسیة ألكثیر و أن الفارسیة اقترضت من العربیة أكثر حتى بات من الصعب الحكم على مبتدأ الكلمات هل كان فارسی قدیم أم عربی قدیم ، و القسم الثانی الحدیث الذی یعتبر أن جمیع اللغات من سامیة وهندیة أوروبیة و حامیة هی فی الأصل لغة واحدة .
تكبیر النصتصغیر النصنص فقط
بین العربیة و الفارسیة
لا بد لنا من الذكر بدایة أن التواصل بین الشعوب القاطنة فی فارس و الجریرة العربیة وبلاد الرافدین لم ینقطع أبدا منذ بدایة التاریخ بل أن التكامل بین جمیع القبائل القاطنة فیها كان كبیرا ، و انه قد اشتد و توثق بعد رسالة محمد ( ص) – أو ما یسمیه المؤرخین الحضارة الإسلامیة.
لقد نظر العدید من الباحثین إلى هذا التقارب من وجهتی نظر متطابقتین فی المضمون ، مختلفتین فی المبنى و التسمیة - فجاءت أبحاثهم تحوی العدید من الأدلة التی تدل على التقارب ، القسم الأول القدیم منها اعتبر أن اللغة العربیة اقترضت من الفارسیة ألكثیر و أن الفارسیة اقترضت من العربیة أكثر حتى بات من الصعب الحكم على مبتدأ الكلمات هل كان فارسی قدیم أم عربی قدیم ، و القسم الثانی الحدیث الذی یعتبر أن جمیع اللغات من سامیة وهندیة أوروبیة و حامیة هی فی الأصل لغة واحدة .
لذلك جاء تسمیة المباحث فی هذا المقال تبعا لهذا التقییم قدیم و حدیث.
قبل أن نبدأ بعرض مقارن لحیثیات التقارب بین العربیة و الفارسیة لا بد لنا من أن نبحث فی معنى اسم فارس – ما هو أصله من أین أتى لنقیم على ذلك البناء المتین لمعنى الوجود الفارسی فی الاسم و اللغة.
مقارنة بین المباحث القدیمة و الحدیثة فی كلمة فارس :
من موسوعة وایكیبیدیا نقتطع : فارس هو الاسم التاریخی للمنطقة التی قامت علیها الإمبراطوریات والدول الفارسیة والتی تشكل الیوم إیران. تقع الإمبراطوریة الفارسیة شرق شبه الجزیرة العربیة. تأسست الإمبراطوریة الفارسیة عام 559 ق.م. بواسطة قورش.
التاریخ الإیرانی قبل الآریین
سكنت المنطقة عدة شعوب قبل مجیء الفرس الآریین إلیها. أهم تلك الشعوب:
حضارة عیلام هی واحدة من أول الحضارات فی المنطقة، ولا ینتمی شعبها إلى الشعوب الهندو-أوربیة، بل البعض یعتقد بأن أصولهم عربیة. وتتواجد فی إقلیم عربستان ومحافظة إیلام. استمرت الحضارة بین عامی 2700 قبل المیلاد و 539 قبل المیلاد. والعیلامیون شعب سامی اندمج لاحقاً مع بعض القبائل العربیة التی سكنت الاحواز.
المانیون أحد الشعوب القدیمة التی استوطنت الأراضی التی تعرف حالیا بأذربیجان الإیرانیة فی الفترة مابین القرن العاشر قبل المیلاد و القرن السابع قبل المیلاد. لم یكونوا من الشعوب الهندو-أوربیة. ویعتقد البعض أنهم یشكلون نواة شعب الأكراد.
من المباحث الحدیثة :
اسم فارس من الفرز و الفرق:
فارس – الفرز ، و الفرس – الفرسیین هم الفرزیین فی التاریخ ( مبحث حدیث )
بالمقارنة بین مشرق جزیرة العرب و مغربها نرى منطقتین أفریقیا تقع فی الفرق الغربی من جزیرة العرب ( الموطن الذی انطلق منه البشر و انتشروا فی الأرض ) أما فارس فإنها تقع فی الفرق الشرقی منها – و إذا كنا قد حللنا فی مقال سابق ( الجغرافیا و اللغة العربیة )
اسم أفریقیا من مصدر عربی وهو كلمة فرق ، فإن تسمیة الفرق الغربی لا بد وأن ینطبق علیها المثل عینه .
ونعود إلى عمق تاریخ البشر فنرى فی التوراة ، شعب ذكرته التوراة بأنه یشترك فی السكن مع الكنعانیین ( قنعان – یقطان ) و الحثیین ( حشیین – عدنان ) و الاموریین ( حمیر ) و الیبوسیین ( قحطان و یبوس – اثیوبیا ) - وهذا الشعب هو الفرزیین.
و نجد فی التوراة ، بالنص المعتمد من الیهود و المترجم إلى العربیة الآتی :
1. و قال الله أیضا لموسى هكذا تقول لبنی إسرائیل یهوه اله آبائكم اله إبراهیم و اله اسحق و اله یعقوب أرسلنی إلیكم هذا اسمی إلى الأبد و هذا ذكری إلى دور فدور
2. اذهب و اجمع شیوخ إسرائیل و قل لهم الرب اله آبائكم اله إبراهیم و اسحق و یعقوب ظهر لی قائلا إنی قد افتقدتكم و ما صنع بكم فی مصر
3. فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى ارض الكنعانیین و الحثیین و الاموریین و الفرزیین و الحویین و الیبوسیین إلى ارض تفیض لبنا و عسلا
4. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت و شیوخ بنی إسرائیل إلى ملك مصر و تقولون له الرب اله العبرانیین إلتقانا فالآن نمضی سفر ثلاثة أیام فی البریة و نذبح للرب إلهنا
و لقد حققت ذلك فی كتاب رحلات الأنبیاء فی جزیرة العرب مبینا أن موسى ذهب ببنی إسرائیل من مصر إلى جزیرة العرب عبر البحر الأحمر لیقیموا العید و یحجوا إلى بكة- مكة ، من هنا فإن الفرزیین الذین ورد ذكرهم فی التوراة هم ( الفارسین – الفرس ) الذین كغیرهم من سكان البلاد المجاورة للجزیرة العربیة كانوا یحجون إلیها فی المواسم ، فیستقر قسم منهم فیها ( لأسباب عدة )
ونستطیع أن نؤكد انطلاقا من هذا التحلیل أن كلمة فارس– من مصدر فرز حیث أن حرف الزین یقلب و یلطف إلى سین شأنه شأن كل الكلمات المنهیة بحرف السین فی العربیة وهناك عدد غیر قلیل من الكلمات العربیة – فردوس – سندس – قدموس – طوروس و عدد كبیر من المدن ، نابلس طرابلس طرسوس ترسیس ، وجمیعها منتهیة بحرف السین الذی هو فی الأصل لاحقة التعریف العربیة المخففة من (ذی) إلى س .
من هذا المنطلق یمكننا ان نقول ان اللغة الفرسیة القدیمة ( التی تعود الى عیلام و ربما ابعد من ذلك فی التاریخ ) هی عربیة فی منشأها و تطورها فی جمیع مراحلها ، مما یجعل الفارسیة أیضا نموذج عن تطور معین للعربیة فی اتجاه الشرق كله. إن هذا التحلیل الحدیث للعلاقة بین العربیة و فارس من حیث الجغرافیا و التسمیة ، یقابله التحلیل التقلیدی القدیم الذی لا بد من عرضه لكی ندخله فی المقارنة فی النهایة وأترك للقارئ الحكم .
نبذة عن اللغة الفارسیة :اللغة الفارسیة هی لغة هندو اوروبیة، یتحدث بها فی إیران وطاجكستان وافغانستان وفی بعض المناطق فی الهند و باكستان . تكتب بالخط العربی بإضافة 4 حروف: گ، پ، ژ، چ . و یسمیها بعض متكلمی اللغة الفارسیة بالفارسیة الدریة ( فارسى درى ) فی أفغانستان كما تسمى بالتاجیكیة (فی تاجكستان)، أثرت اللغة الفارسیة على بعض اللغات مثل: التركیة العثمانیة والأوردو، و اللغة العربیة كما تأثرت بشكل كبیر باللغة العربیة .
اللغات الإیرانیة القدیمة
وهی اللغات التی سادت فی المرحلة الأولى من تاریخ اللغة الفارسیة و ذلك منذ بدایة نشأتها حتى القرنین الرابع و الثالث قبل المیلاد و من بینها اللغة الفارسیة القدیمة وهی اللغة المحكیة و الرسمیة فی عهد الملوك الاخمینیین و قد كتبت بالخط المسماری حفظت بعض النقوش المسطرة بهذه اللغة فی كتابات داریوش الكبیر على صخور ( بیستون) و فی غیرها من الاثار المعروفة و جمیعها نقشت بالخط المسماری السومری…اضافة لهذه اللغة فقد ساد فی هذه المرحلة ما یسمى باللغة الابستاقیة و هی اللغة التی كتب بها الابستاق (اوستا) كتاب زردشت المقدس لدى الزردشتیین وهو الأثر الوحید الذی بقی مكتوبا بهذه اللغة.
یقول الباحث الإیرانی یوسف عزیزی: "ازدهرت اللغة الفارسیة وترعرعت فی أحضان الأبجدیة العربیة بعد الفتح الإسلامی لإیران. وقدمت شعراء ومتصوفین ومفكرین عظاماً، خلافاً لما قبل الاسلام حیث لم تقدم اللغة البهلویة ـوهی لغة البلاط عند الأكاسرةـ أی اسم بارز فی مختلف مجالات المعروفة وخاصة والأدب. و یبدو ان اللغة الفارسیة استعارت من اللغة العربیة الكثیر من تراكیبها و مفراداتها و لاحقا استفادت من اللغة المغولیة عند سیطرة الإمبراطوریة المغولیة و من ثم التركیة .
بالمقابل دخلت العربیة العدید من المفردات العربیة خاصة تلك المتعلقة بالتنظیمات الإداریة التی اقتبست عن الفرس. ویضیف الباحث الإیرانی یوسف عزیزی: "لقد أثرت الثقافة العربیة فی الثقافة الفارسیة، عبر العصور. وكان للأدب العربی تحدیدا، تأثیر مهم فی الادب الفارسی كما وكان للغة العربیة أیضا، دور فی إغناء اللغة الفارسیة بالمفردات المتعددة. فهناك نحو 60% من اللغة الفارسیة مفردات عربیة، أو عربیة الجذور. و یمكن القول أن تأثیر اللغة العربیة فی اللغة الفارسیة، یشبه تأثیر اللغة الرومانیة فی اللغة اللاتینیة. و كونی باحثا فی الادب الفارسی، وفی الادب العربی، باستطاعتی القول ان الادب الفارسی لم یكن له وجود بارز قبل الاسلام، وقد أصبح له هذا الوجود، وهذا البروز بعد الاسلام، فنتیجة لتمازج الثقافتین الفارسیة و العربیة، الذی انتج عندنا شعراء و مفكرین وأدباء كبارا، مثل حافظ الشیرازی و سعدی الشیرازی و ناصر خسرو البلخی وفی مجال الفلسفة الملا صدرا و ابن سینا و الفارابی و الغزالی.
و یبدی ادی شیر (رئیس اساقفه الكنائس الكلدانیه) فی كتابه «الالفاظ الفارسیه المعربه» دهشته لنفوذ الفارسیه الی هذ الحد فی اللغه العربیه، رغم ان الفارسیه من فصیله اللغات الآریه، فی حین لم تؤثر فی العربیه لغات سامیه من فصیله العربیه نفسها كالسریانیه و الرومیه و القبطیه و الحبشیه. و الارتباط اللغوی كما نعرف بین اللغات ذات الاصل الواحد اسهل من اللغات ذات الاصول البعیده [1].
و لیس هناك من سبب مقنع لتفسیر هذه الظاهره سوی ان الاسلام قد قارب بین اللغتین و عمل علی احداث هذ التأثیر المتبادل العجیب. [2]
ونستنبط من دراسه الكتب العربیه و الفارسیه ان بعض المفردات الفارسیه قد دخل العربیه قبل الاسلام بمئات السنین، لكن یصعب تشخیص هذه المفردات و ذلك للتغییرات الكبیره التی طرأت علی الفارسیه. و كمثال علی صعوبه ذلك التشخیص یضرب بهرام فره وشی استاذ اللغات القدیمه فی جامعه طهران مثالاً علی ذلك (14) فیقول ان كلمه «ناهد» التی تعنی الیوم بالعربیه الفتاه الكاعب، نجدها تعطی المعنی نفسه فی كتاب الایرانیین القدماء ای «الافستا»،
فهل یعنی هذا ان العرب قد اخذوها عن الفارسیه، ام الفرس اخذوها عن العربیه؟
على هذا المنوال درج الباحثون فی الخوض بالعلاقة بین اللغة العربیة و الفارسیة عبر العصور ، متحیرین فی العدید من الكلمات هل اخذها العرب عن الفرس أم ان الفرس اخذوها عن العرب.
حتى وصلنا الى العصر الحدیث حین بدأ ت فی البحث عن الحقیقة بالنظر الى هذا الموضوع و غیره من التداخل بین اللغات من زاویة حادة و بافق اوسع .
فبعد الدراسات المستفیضة التی اثبتت أن اللغات الهندیة الاوروبیة – و السامیة و الحامیة و غیرها هی فی الاصل تنتمی الى لغة واحدة تظهر جلیة فی مفردات كل تلك اللغات من تمازج و تماثل حتى فی الضمائر
ولو علمنا أن ( I , Ieo , Ya , Je ) هی فی الاصل ضمیر عربی هو إیای و أن رفض – ( تلفظ رفظ ) لتبین لنا أن Refuse ایضا تنتمی إلى لغة واحدة قدیمة فی الاصل مشتركة بین جمیع هذه اللغات .
و إن كان ما یبرره الباحثون من دخول الكلمات العربیة الى عدد كبیر من اللغات ، منها الفارسیة ، بإنتشار الإسلام بینها ، إلآ أن بعض المفردات تجعلنا نقف مشدوهین أمامها – لا نستطیع أن نجزم الى أی لغة تنتمی هذه المفردة فی الأصل.
من هذه المفردات كلمة ، سراط – صراط التی هی كلمات Strade Straight, Street , Strada فی لغات أخرى ، و كلمة ستان التی شرحتها فی مقال سابق و التی هی اختصار لكلمة إستیطان ، و التی اصبحت Estate , State الت تعنی الوطن و المقاطعة
ومنها كلمة قسطاس ( قسطا ذی ) – ذی القسط التی نراها فی Justice , Just واصل كل هذه الكلمات بعد ان بینا تكوینها هو العربیة القدیمة.
من هذا المنطلق سوف احاول ان اسرد بعض المفردات المشتركة بین الفارسیة و العربیة بالرغم من أن 60 % من الفارسیة الحدیثة ( عربیة واضحة ) فإن الـ 40 % الباقیة منها یمكن إرجاعها الى العربیة بعد شرح و تصرف ، معزیا ذلك الى لغة مشتركة بینها فی عمق التاریخ – هذه اللغة على التحقیق هی العربیة القدیمة ، نظرا لأننا إن تمحصنا فی تاریخ كل من اللغتین الفارسیة و العربیة لتبین لنا أن الفارسیة قد تبدلت كثیرا ( وهی تنتقی من العربیة القدیمة ما یلائمها ) بینما العربیة حافظت على مبناها الذی یعود الى 1900 ق. م. على اقل تقدیر ( كما بین ذلك انیس فریحة فی كتابة اساطیر اوغاریت ، والذی اعتمد على النصوص الموجودة فی مكتشفات أوغاریت من الالواح الحجریة).
المبحث الأخیر: هل صحیح ؟ ما یقوله اللغویون فی تحدید فارسیة الألفاظ العربیة تبعا لترتیب الحروف ؟ و سوف أصحح بین القوسین
وابین بطلان هذه المقولة التی یقولون فیها :
تمتاز المفردات العربیة عاده ببعض الخصائص التی یمكن من خلالها تشخیص المفردات الفارسیة المعربة إلی حد ما، ومنها:
فی مفرده عربیه واحده:
- لا یأتی حرف الـ (ج) و حرف الـ (ق) معاً. ( وحرف الجیم هو حرف متبدل فی جمیع العائلات اللغویة إما إلى ی و إما إلى ق – و لا تصح هذه المقولة على اللهجات العربیة )
- لا یأتی حرف الـ (ص) مع حرف الـ (ج). ( راجع سابقا)
- لا یأتی حرف الـ (ط) و حرف الـ (ج) الا اذا كانت المفرده اسماً لشخص او موضع. ( راجع سابقا)
- لا یأتی حرف الـ (ن) بعد حرف الـ (ز). ( مزن و مازن - أأنتم أنزلتموه من المزن )
- لا یأتی حرف الـ (ز) بعد حرف الـ (د) او الـ (ب) او الـ (س) او الـ (ت). ( و المقصود بها مهندز – و مهندس و فردس و قابس و سندس )
- لا یرد حرفان متشابهان بینهما الف. ( باب - دجاج – شاش – زقاق – زجاج – مداد – مساس – إمام -)
مما سبق نفهم ان المفرده العربیه اذا وجدت فیها احدی الخصائص اعلاه، فهی معربه و لیست اصیله
فهل احد یستطیع أن یجزم بالأدلة القاطعة أن الكلمات التی وضعت ضمن الأقواس لیست عربیة ؟
والأمر الثانی الذی لا بد من اللفت إلیه وهو ان الحروف إنما هی رسم الألفاظ ، و اللفظ متغیر من قریة إلى أخرى حتى فی اللغة الواحدة ، فاعتمادنا على مقولة ترتیب الحروف لا معنى له إطلاقا فی علم اللغات المقارن لأن المقارنات أصلها فی اللفظ .
و بخلاصة هذا البحث استخلص ان اللغة الفارسیة القدیمة و الحدیثة لا تختلف عن غیرها من لغات العالم ، و أنها تطور متعدد المراحل للغة العربیة القدیمة و الكلمات الموجودة فیها هی إما عربیة على التحقیق و إما عربیة بعد تدقیق.
لقد وضعت جدولا فی ملف وورد لبعض الكلمات لتسلیط الضوء على الطریقة التی إعتمدها الباحثون للاستدلال على فارسیة الكلمات - بعد تفكیك رموزها و اعادتها الى أكثر من كلمة فارسة - هذا الملقف یوجد ربطا.
المراجع :
التأثیر المتبادل بین الفارسیة و العربیة – عبد الرحمن العلوی
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:58|
إشارات ورموز عربیـــة فی شعر السیــــاب
لقد
صرح السیاب مرة أنه ینتظر المؤلف الحدیث الذی یجمع الرموز العربیة فی شعره
من مظانها المتفرقة كیما یمكن الإفادة منها. ( 1 )
والحدیث عن دور الأسطورة والرمز فی الشعر الحدیث قد یطول بنا إذا تقصیناه ، یقول السیاب فی هذا السیاق :
" هناك مظهر مهم من مظاهر الشعر الحدیث هو اللجوء إلى الخرافة والأسطورة ، وإلى الرموز ، ولم تكن الحاجة إلى الرمز وإلى الأسطورة أمسّ مما هی علیه الیوم ، فنحن نعیش فی عالم لا شعر فیه - أعنی أن القیم التی تسوده قیم لاشعریة ، والكلمة العلیا فیه للمادة لا للروح ، وراحت الأشیاء التی كان فی وسع الشاعر أن یقولها أن یحولها إلى جزء من نفسه تتحطم واحدًا فواحدًا ، أو تنسحب إلى هامش الحیاة .
إذن فالتعبیر المباشر عن اللاشعر لن یكون شعرًا ، فماذا یفعل الشاعر إذا عاد إلى الأساطیر إلى الخرافات التی ما تزال تحتفظ بحرارتها ، لأنها لیست جزءًا من هذا العالم . عاد إلیها لیستعملها رموزًا ولیبنی منها عوالم یتحدى بها منطق الذهب والحدید " ( 2 ) .
وهو یعترف فی مكان آخر أن الرموز والأساطیر تخلص الشاعر من إلقاء كلماته بصورة نثریة وبلا واسطة ، وتضیف تداعیات لشعره . (3 )
ویرى ب . موریه أن هذه الرموز تساعد على خلق موسیقا جدیدة – موسیقا الفكرة – بالإضافة إلى إیقاع الوزن ، وهذا النوع من الموسیقا یشبه التنویعات السمفونیة – إنها عودة لنفس الفكرة التی تؤكد الموضوع الرئیسی للقصیدة ، وبالإضافة إلى التداعیات التی تثیرها هذه الرموز من التاریخ والمیثولوجیا فهی تساعد فی تجسید التشبیهات بصورة حیة ودقیقة أكثر، وتساعد الشاعر أن یكون مراقبًا حیادیًا أقل عاطفة ،وقادرًا على كبح مشاعره ( 4 ) .
ومن خلال ملاحظتنا لرموز السیاب نرى أنه یطعم قصائد بعناصر موحیة ، وهی عنده كالكنوز یلجأ إلیها مقارنًا بین ما كان وبین ما هو كائن ، وهو بها یعمق المعنى وینقل التجربة إلى جو إنسانی یستمد الجذور من التاریخ الفاعل والمحرك . وسنحاول هنا أن نصنفها ونحدد ماهیتها :
1- رموز من السیرة النبویة :
یقول السیاب :
محمد الیتیم أحرقوه فالمساء یضیء من حریقه ، وفارت الدماء ( ص 467 من المجموعة الكاملة 1 للسیاب ) ویقول :
" محمد النبی فی حراء قیدوه ……… ستأكل الكلاب من دم البراق " ( ص 468 )
فهو بهذه الأبیـــات لا ینقل إلینا الجو الدینی كما كان ، بل یقدم لنا صورة العذاب الذی عاناه محمد أكثر مما یجسم صورة النصر . ومحمد فی التاریخ لم یكن شهیدًا – حسب الاصطلاح المتولد فی بعد ، بل كان رمزًا للموقف والنضال . وهو یقول فی ضوء السیرة :
ولا ملأت حراء وصبحه الآیات والسور ( ص 184 )
وحراء هو الغار الذی نزل فیه الوحی على النبی ، بید أن السیاب یخلط بینه وبین غار (ثور ) - وثور فی الطریق إلى المدینة :
هذا حرائی حاكت العنكبوت
خیطًا على بابه ( ص 425 )
والعنكبوت حسب السیرة حاكت خیوطها على غار ثور (5) . وفی قول الشاعر :
وهبّ محمد وإلهه العربی والأنصار إن إلهنا فینا ( ص 402) استعادة لمواقف النصر فی تضامنه مع المغرب العربی ، وهو یشدد على كلمة ( العربی ) وصفـًا للإله حتى یؤكد عروبة المغرب ، أو لیظهر عروبته هو بصورة حادة بعد أن مر بتجربة الشیوعیة . 2- وإشارات التراث العربی القبلی نجد أصداءها عند الشاعر ، ففی قوله :
كما أكلوه إذ جاعوا إلههم……. ( ص400)
إشارة إلى بعض قبائل العرب ( روی أنهم بنو حنیفة ) ، إذ كانوا یصنعون آلهتهم من التمور ، فاذا جاعت القبیلة أكلت ما صنعته .
ویقول الشاعر :
أشم فیه عفن الزمان والعوالم العجیبة
من إرمٍ وعاد ( ص 605 )
وشاعرنا یتعامل مع ( إرم وعاد ) الواردتین فی القرآن الكریم كأنهما دلالة للعفن ، بید أن السیاب یختار فی قصیدة ( إرم ذات العماد – ص 602 ) روایة لقصة إرم - عن صیاد من الجنوب ( جد أبیه ) الذی تحدث عن أیام صباه ، وأنه رأى جنة عاد الضائعة ، ثم اختفت عنه ، وظل یبحث عنها ….وقد حاول السیاب هنا من خلال هذه الأسطورة التعبیر عن حنینه للماضی ، فمن قصص الحب المأثورة یضمّن الشاعر أبیـــاته :
وهی المفلـّیة العجوز وما توشوش عن حزام
وكیف شق القبر عنه أمام عفراء الجمیلة ( ص 318 )
ویعلق السیاب فی حاشیة القصیدة :
" هكذا أصبح اسم الشاعر العاشق عروة بن الحزام عند العامة الذین یروون قصة حبه لعفراء وموته ، ویرددون معانی قصیدته بشعر عامی " .
وتأخذ القصة مسارًا حزینًا وهو غریب على الخلیج ، وإذا كان قد استذكر قصة عروة وحزام فلا بدع أن تجد قصة عنترة وعبلة أصداءها كذلك :
……ذاك عنترٌ یجوب
دجى الصحاری إن حی عبلة المزار ( 604 )
ویعلق عز الدین إسماعیل فی مقاله " الشعر المعاصر والتراث العربی " :
" یستغل السیاب قصة الحب البدوی التی تردد فی التاریخ العربی ، وهی قصة عنتر وعبلة ، وذلك فی قصیدته - إرم ذات العماد - ولست فی حاجة أن أعید هنا ما قلته فی هذا التلاحم بین المأثور والواقع النفسی للشاعر ، فقد وجد الشاعر فی هذه القصة القبلیة توجیهًا نفسیًا كافیًا یجدد لنا المسار النفسی لشعوره الراهن ." ( 6 )
وأبو زید الهلالی - رمز البطولة العربیة الملحمیة له مكان أسطوری فی ثنایا قصائده ، حتى یتوافق مع اندفاعه وحماسه للعروبة :
والأمل الخالق من توثب الصغیر
الف أبی زید تفور الرغوة
من خیله الحمراء ( ص221 )
3- رمو ز من التاریخ العربی :
فی قصیدة ( مرثیة جیكور ) نجد حشدًا من الإشارات التاریخیة ساقها الشاعر فی معرض استهتار ، فهو یرمز للتاریخ بعصر ( تعبان بن عیسى ) ، وربما كان الاسم الأول لیسقط تعبه هو :
لا علیك السلام یا عصر تعبان بن عیسى وهنت بین العهود
ها هو الآن فحمة تنخر الدیدان فیها فتلتظی من جدید
ذلك الكائن الخرافی فی جیكور هومیر شعبه المكدود
جالس القرفصاء فی شمس آذار وعیناه فی بلاط الرشید
یمضغ التبغ والتواریخ والأحلام بالشدق والخیال الوئید
ما تزال البسوس محمومة الخیل لدیه وما خبا من یزید
نار عینین ألقتاها على الشمر ظلالا مذبحات الورید
كلما لز شمره الخیل أو عرى أبو زیده التحام الجنود
شد راحًا وأطلق المغزل الدوار یدحوه للمدار الجدید ( ص 407 )
فالشاعر مل حالة الخواء التی خلص إلیها أخیرًا من جراء مضغ التبغ والتواریخ والأحلام ، وقد لاحظنا حشدًا من الأسماء : الرشید – رمز البذخ ، والبسوس – معركة بكر وتغلب ، ویزید هو الذی أمر الشمر بقتل الحسین ، وكان مرتدیًا ثیابًا حمرًا ، وأبو زید اشتهر بملاحمه….. وفی هذه الإشارات جمیعًا رمز للحرب التی نجتر تفاصیلها بلا جدوى ، وهو یؤكد ثانیة فیقول :
لا علیك السلام یا عصر تعبان بن عیسى وهنت بین العهود !
4 – ومن الصوفیة رأینا الشاعر یستعمل ( ابن حلاج ) ، وهو تحریف للحلاج ( 858م – 932 م ) ، إذ یقول : ویا عهد كنا كابن حلاج واحد
مع الله إن ضاع الورى فهو ضائع (ص 354 ) ویرى د . إحسان عباس أنه استخف بفكرة التألیه ( 7 ) ، وهو هنا لا یدل على عمق إیمانه ، فیقول السیاب : الحسن ال بصری جاب أرض واق الواق ولندنَ الح دید والصخر فما رأى أحسن عیشًا منه العراق (ص301)
فهو یتخیل نفسه الحسن البصری الذی یمكن أن یكون أحد الاثنین أو كلیهما معًا :
1- الحسن البصری الصوفی (ولد فی البصرة 642م – 728 ).
2- الحسن البصری الرحالة الوارد فی قصص ألف لیلة ولیلة ، والباحث عن الكنوز، ویبدو لی من خلال معاینة أن الاحتمال الأول أكثر إقناعًا ، بسبب ارتباط الشاعر بالبصرة ، وبسبب الشعور الدینی الذی لازم السیاب ساعة مرضه . ونحن مع ذلك لا ننكر هنا أن ذكر ( واق الواق ) یدفعنا إلى التفكیر فی الاتجاه الثانی .
* * *
5- فیما وراء التاریخ من أساطیر وقصص دینیة – وأبرز رمز یستعمله الشاعر هو السندباد- صاحب الرحلات السبع ، وفی حیاة السیاب ضیاع ، والسندباد قالب أو قناع یصب فیه الشاعر معاناته واقتحامه وجوَبانه ، فیقول عن نفسه : ……. مثل سندباد یسیر حول بیضة الرخ ولا یكاد ( ص604) ویخاطب زوجته المنتظرة :
وجلست تنتظرین عودة سندباد من السفار ( ص 229 )
وبینما هو :
فلك سندباد ضل فی البحر
حتى أتى جزیرة تهمس فی شطآنها المحار ( ص654) وقصة قابیل وهابیل الواردة فی الكتب المقدسة یستعملها الشاعر رمزًا للشر فی قابیل ، ورمزًا لضیاع الحق لدى هابیل ، وهو یصرخ : قابیل فینا ما تهاوى أخوه ( ص383 ) والشاعر لا یرید أن یكون وریثا لقابیل خوفًا من أن یُسال السؤال الوارد فی التوراة بصورة إنكاریة :
ولا أكون وریث قابیل اللعین سیسألون
لمن القتیل فلا أقول
أأنا الموكل ویحكم بأخی ؟!
……….. إن قابیل المكبل بالحدید
فی نفسی الظلماء ….. ( ص552 ) یرمز هنا إلى قافلة الضیاع ، وهی اللجوء . لكن الفیتوری فی نقده لقصیدة ( قافلة الضیاع ) یذكر أن الأسطورة التی تعتمد علیها القصیدة تختلف اختلافًا جذریًا عن مأساة اللاجئین فی ارتكازها على التجربة .( 8 ) ویرد ذكر قوم یأجوج ومأجوج فی القرآن الكریم على أنهم مفسدون فی الأرض ( سورة الكهف 94 )، لكن الشاعر یستعمل الأسطورة وقد شرحها فی حاشیة ( ص 529 ) أن یأجوج ومأجوج یلحسان السور بلسانیهما كل یوم حتى تصبح فی رقة قشرة البصل ویدركما التعب ، فیقولان " غدًا سنتم العمل " وفی الغد یجدان السور على عهده من القوة والمتانة …..وهكذا حتى یولد لهما طفل یسمیانه ( إن شاء الله ) – فیحطم السور :
یأجوج یغرز فیه من حنق أظافره الطویله
ویعض جندله الأصم وكف مأجوج الثقیله
والسور باق لا یثل وسوف یبقى ألف عام
لكن ( إن شاء الإله )
طفلاً كذلك سمیاه
سیهب ذات ضحى و یقلع ذلك السور الكبیر ( ص529 )
وبعد ، فقد عرضت بعض هذه الرموز والإشارات فی سیاقها ، وأبنت مدى تداخلها فی نسیج السیاب الشعری . ولا شك أن هناك رموزًا أخرى فثقافة الشاعر وقراءاته قد لا تكون مسبورة الغور دائمًا ولدى مختلف القراء المختلفة ثقافاتهم .
إذن ، لتكن هذه جولة استكشافیة فی شعر السیاب وتصادیه مع التراث العربی فی الرموز والأساطیر .
ولمن یهمه الأمر أشیر إلى أننی كنت قد أصدرت كتابًا حول الأصداء القدیمة فی شعر السیاب - كما یتمثل ذلك فی لغة القرآن ، وأسالیب الشعر القدیم ، وقد صدرت الطبعة الثانیة عن مطبعة الحكیم ، الناصرة - ( 2006 ) .
الهوامش
1) عبد الجبار البصری : " دراسة جدیدة فی الشعر العربی المعاصر" ، الآداب ، نوفمبر 1964 ص 4 .
2) " أخبار وقضایا " ، مجلة شعر ، العدد الثالث السنة الأولى ص 111- 113 .
3) ن.م - ص 112
4) همزراح هحداش ( بالعبریة ) ، العددان 1-2 /1968 ، ص 33 .
5) ابن هشام : السیرة النبویة ، ج2 ص 13 .
6) الآداب شهر آب 1956 ص 64 .
7) إحسان عباس : بدر شاكر السیاب ،دار الثقافة ، بیروت – 1969 ، ص267 .
8) الآداب شهر آب 1956 ، ص 64 .
والحدیث عن دور الأسطورة والرمز فی الشعر الحدیث قد یطول بنا إذا تقصیناه ، یقول السیاب فی هذا السیاق :
" هناك مظهر مهم من مظاهر الشعر الحدیث هو اللجوء إلى الخرافة والأسطورة ، وإلى الرموز ، ولم تكن الحاجة إلى الرمز وإلى الأسطورة أمسّ مما هی علیه الیوم ، فنحن نعیش فی عالم لا شعر فیه - أعنی أن القیم التی تسوده قیم لاشعریة ، والكلمة العلیا فیه للمادة لا للروح ، وراحت الأشیاء التی كان فی وسع الشاعر أن یقولها أن یحولها إلى جزء من نفسه تتحطم واحدًا فواحدًا ، أو تنسحب إلى هامش الحیاة .
إذن فالتعبیر المباشر عن اللاشعر لن یكون شعرًا ، فماذا یفعل الشاعر إذا عاد إلى الأساطیر إلى الخرافات التی ما تزال تحتفظ بحرارتها ، لأنها لیست جزءًا من هذا العالم . عاد إلیها لیستعملها رموزًا ولیبنی منها عوالم یتحدى بها منطق الذهب والحدید " ( 2 ) .
وهو یعترف فی مكان آخر أن الرموز والأساطیر تخلص الشاعر من إلقاء كلماته بصورة نثریة وبلا واسطة ، وتضیف تداعیات لشعره . (3 )
ویرى ب . موریه أن هذه الرموز تساعد على خلق موسیقا جدیدة – موسیقا الفكرة – بالإضافة إلى إیقاع الوزن ، وهذا النوع من الموسیقا یشبه التنویعات السمفونیة – إنها عودة لنفس الفكرة التی تؤكد الموضوع الرئیسی للقصیدة ، وبالإضافة إلى التداعیات التی تثیرها هذه الرموز من التاریخ والمیثولوجیا فهی تساعد فی تجسید التشبیهات بصورة حیة ودقیقة أكثر، وتساعد الشاعر أن یكون مراقبًا حیادیًا أقل عاطفة ،وقادرًا على كبح مشاعره ( 4 ) .
ومن خلال ملاحظتنا لرموز السیاب نرى أنه یطعم قصائد بعناصر موحیة ، وهی عنده كالكنوز یلجأ إلیها مقارنًا بین ما كان وبین ما هو كائن ، وهو بها یعمق المعنى وینقل التجربة إلى جو إنسانی یستمد الجذور من التاریخ الفاعل والمحرك . وسنحاول هنا أن نصنفها ونحدد ماهیتها :
1- رموز من السیرة النبویة :
یقول السیاب :
محمد الیتیم أحرقوه فالمساء یضیء من حریقه ، وفارت الدماء ( ص 467 من المجموعة الكاملة 1 للسیاب ) ویقول :
" محمد النبی فی حراء قیدوه ……… ستأكل الكلاب من دم البراق " ( ص 468 )
فهو بهذه الأبیـــات لا ینقل إلینا الجو الدینی كما كان ، بل یقدم لنا صورة العذاب الذی عاناه محمد أكثر مما یجسم صورة النصر . ومحمد فی التاریخ لم یكن شهیدًا – حسب الاصطلاح المتولد فی بعد ، بل كان رمزًا للموقف والنضال . وهو یقول فی ضوء السیرة :
ولا ملأت حراء وصبحه الآیات والسور ( ص 184 )
وحراء هو الغار الذی نزل فیه الوحی على النبی ، بید أن السیاب یخلط بینه وبین غار (ثور ) - وثور فی الطریق إلى المدینة :
هذا حرائی حاكت العنكبوت
خیطًا على بابه ( ص 425 )
والعنكبوت حسب السیرة حاكت خیوطها على غار ثور (5) . وفی قول الشاعر :
وهبّ محمد وإلهه العربی والأنصار إن إلهنا فینا ( ص 402) استعادة لمواقف النصر فی تضامنه مع المغرب العربی ، وهو یشدد على كلمة ( العربی ) وصفـًا للإله حتى یؤكد عروبة المغرب ، أو لیظهر عروبته هو بصورة حادة بعد أن مر بتجربة الشیوعیة . 2- وإشارات التراث العربی القبلی نجد أصداءها عند الشاعر ، ففی قوله :
كما أكلوه إذ جاعوا إلههم……. ( ص400)
إشارة إلى بعض قبائل العرب ( روی أنهم بنو حنیفة ) ، إذ كانوا یصنعون آلهتهم من التمور ، فاذا جاعت القبیلة أكلت ما صنعته .
ویقول الشاعر :
أشم فیه عفن الزمان والعوالم العجیبة
من إرمٍ وعاد ( ص 605 )
وشاعرنا یتعامل مع ( إرم وعاد ) الواردتین فی القرآن الكریم كأنهما دلالة للعفن ، بید أن السیاب یختار فی قصیدة ( إرم ذات العماد – ص 602 ) روایة لقصة إرم - عن صیاد من الجنوب ( جد أبیه ) الذی تحدث عن أیام صباه ، وأنه رأى جنة عاد الضائعة ، ثم اختفت عنه ، وظل یبحث عنها ….وقد حاول السیاب هنا من خلال هذه الأسطورة التعبیر عن حنینه للماضی ، فمن قصص الحب المأثورة یضمّن الشاعر أبیـــاته :
وهی المفلـّیة العجوز وما توشوش عن حزام
وكیف شق القبر عنه أمام عفراء الجمیلة ( ص 318 )
ویعلق السیاب فی حاشیة القصیدة :
" هكذا أصبح اسم الشاعر العاشق عروة بن الحزام عند العامة الذین یروون قصة حبه لعفراء وموته ، ویرددون معانی قصیدته بشعر عامی " .
وتأخذ القصة مسارًا حزینًا وهو غریب على الخلیج ، وإذا كان قد استذكر قصة عروة وحزام فلا بدع أن تجد قصة عنترة وعبلة أصداءها كذلك :
……ذاك عنترٌ یجوب
دجى الصحاری إن حی عبلة المزار ( 604 )
ویعلق عز الدین إسماعیل فی مقاله " الشعر المعاصر والتراث العربی " :
" یستغل السیاب قصة الحب البدوی التی تردد فی التاریخ العربی ، وهی قصة عنتر وعبلة ، وذلك فی قصیدته - إرم ذات العماد - ولست فی حاجة أن أعید هنا ما قلته فی هذا التلاحم بین المأثور والواقع النفسی للشاعر ، فقد وجد الشاعر فی هذه القصة القبلیة توجیهًا نفسیًا كافیًا یجدد لنا المسار النفسی لشعوره الراهن ." ( 6 )
وأبو زید الهلالی - رمز البطولة العربیة الملحمیة له مكان أسطوری فی ثنایا قصائده ، حتى یتوافق مع اندفاعه وحماسه للعروبة :
والأمل الخالق من توثب الصغیر
الف أبی زید تفور الرغوة
من خیله الحمراء ( ص221 )
3- رمو ز من التاریخ العربی :
فی قصیدة ( مرثیة جیكور ) نجد حشدًا من الإشارات التاریخیة ساقها الشاعر فی معرض استهتار ، فهو یرمز للتاریخ بعصر ( تعبان بن عیسى ) ، وربما كان الاسم الأول لیسقط تعبه هو :
لا علیك السلام یا عصر تعبان بن عیسى وهنت بین العهود
ها هو الآن فحمة تنخر الدیدان فیها فتلتظی من جدید
ذلك الكائن الخرافی فی جیكور هومیر شعبه المكدود
جالس القرفصاء فی شمس آذار وعیناه فی بلاط الرشید
یمضغ التبغ والتواریخ والأحلام بالشدق والخیال الوئید
ما تزال البسوس محمومة الخیل لدیه وما خبا من یزید
نار عینین ألقتاها على الشمر ظلالا مذبحات الورید
كلما لز شمره الخیل أو عرى أبو زیده التحام الجنود
شد راحًا وأطلق المغزل الدوار یدحوه للمدار الجدید ( ص 407 )
فالشاعر مل حالة الخواء التی خلص إلیها أخیرًا من جراء مضغ التبغ والتواریخ والأحلام ، وقد لاحظنا حشدًا من الأسماء : الرشید – رمز البذخ ، والبسوس – معركة بكر وتغلب ، ویزید هو الذی أمر الشمر بقتل الحسین ، وكان مرتدیًا ثیابًا حمرًا ، وأبو زید اشتهر بملاحمه….. وفی هذه الإشارات جمیعًا رمز للحرب التی نجتر تفاصیلها بلا جدوى ، وهو یؤكد ثانیة فیقول :
لا علیك السلام یا عصر تعبان بن عیسى وهنت بین العهود !
4 – ومن الصوفیة رأینا الشاعر یستعمل ( ابن حلاج ) ، وهو تحریف للحلاج ( 858م – 932 م ) ، إذ یقول : ویا عهد كنا كابن حلاج واحد
مع الله إن ضاع الورى فهو ضائع (ص 354 ) ویرى د . إحسان عباس أنه استخف بفكرة التألیه ( 7 ) ، وهو هنا لا یدل على عمق إیمانه ، فیقول السیاب : الحسن ال بصری جاب أرض واق الواق ولندنَ الح دید والصخر فما رأى أحسن عیشًا منه العراق (ص301)
فهو یتخیل نفسه الحسن البصری الذی یمكن أن یكون أحد الاثنین أو كلیهما معًا :
1- الحسن البصری الصوفی (ولد فی البصرة 642م – 728 ).
2- الحسن البصری الرحالة الوارد فی قصص ألف لیلة ولیلة ، والباحث عن الكنوز، ویبدو لی من خلال معاینة أن الاحتمال الأول أكثر إقناعًا ، بسبب ارتباط الشاعر بالبصرة ، وبسبب الشعور الدینی الذی لازم السیاب ساعة مرضه . ونحن مع ذلك لا ننكر هنا أن ذكر ( واق الواق ) یدفعنا إلى التفكیر فی الاتجاه الثانی .
* * *
5- فیما وراء التاریخ من أساطیر وقصص دینیة – وأبرز رمز یستعمله الشاعر هو السندباد- صاحب الرحلات السبع ، وفی حیاة السیاب ضیاع ، والسندباد قالب أو قناع یصب فیه الشاعر معاناته واقتحامه وجوَبانه ، فیقول عن نفسه : ……. مثل سندباد یسیر حول بیضة الرخ ولا یكاد ( ص604) ویخاطب زوجته المنتظرة :
وجلست تنتظرین عودة سندباد من السفار ( ص 229 )
وبینما هو :
فلك سندباد ضل فی البحر
حتى أتى جزیرة تهمس فی شطآنها المحار ( ص654) وقصة قابیل وهابیل الواردة فی الكتب المقدسة یستعملها الشاعر رمزًا للشر فی قابیل ، ورمزًا لضیاع الحق لدى هابیل ، وهو یصرخ : قابیل فینا ما تهاوى أخوه ( ص383 ) والشاعر لا یرید أن یكون وریثا لقابیل خوفًا من أن یُسال السؤال الوارد فی التوراة بصورة إنكاریة :
ولا أكون وریث قابیل اللعین سیسألون
لمن القتیل فلا أقول
أأنا الموكل ویحكم بأخی ؟!
……….. إن قابیل المكبل بالحدید
فی نفسی الظلماء ….. ( ص552 ) یرمز هنا إلى قافلة الضیاع ، وهی اللجوء . لكن الفیتوری فی نقده لقصیدة ( قافلة الضیاع ) یذكر أن الأسطورة التی تعتمد علیها القصیدة تختلف اختلافًا جذریًا عن مأساة اللاجئین فی ارتكازها على التجربة .( 8 ) ویرد ذكر قوم یأجوج ومأجوج فی القرآن الكریم على أنهم مفسدون فی الأرض ( سورة الكهف 94 )، لكن الشاعر یستعمل الأسطورة وقد شرحها فی حاشیة ( ص 529 ) أن یأجوج ومأجوج یلحسان السور بلسانیهما كل یوم حتى تصبح فی رقة قشرة البصل ویدركما التعب ، فیقولان " غدًا سنتم العمل " وفی الغد یجدان السور على عهده من القوة والمتانة …..وهكذا حتى یولد لهما طفل یسمیانه ( إن شاء الله ) – فیحطم السور :
یأجوج یغرز فیه من حنق أظافره الطویله
ویعض جندله الأصم وكف مأجوج الثقیله
والسور باق لا یثل وسوف یبقى ألف عام
لكن ( إن شاء الإله )
طفلاً كذلك سمیاه
سیهب ذات ضحى و یقلع ذلك السور الكبیر ( ص529 )
وبعد ، فقد عرضت بعض هذه الرموز والإشارات فی سیاقها ، وأبنت مدى تداخلها فی نسیج السیاب الشعری . ولا شك أن هناك رموزًا أخرى فثقافة الشاعر وقراءاته قد لا تكون مسبورة الغور دائمًا ولدى مختلف القراء المختلفة ثقافاتهم .
إذن ، لتكن هذه جولة استكشافیة فی شعر السیاب وتصادیه مع التراث العربی فی الرموز والأساطیر .
ولمن یهمه الأمر أشیر إلى أننی كنت قد أصدرت كتابًا حول الأصداء القدیمة فی شعر السیاب - كما یتمثل ذلك فی لغة القرآن ، وأسالیب الشعر القدیم ، وقد صدرت الطبعة الثانیة عن مطبعة الحكیم ، الناصرة - ( 2006 ) .
الهوامش
1) عبد الجبار البصری : " دراسة جدیدة فی الشعر العربی المعاصر" ، الآداب ، نوفمبر 1964 ص 4 .
2) " أخبار وقضایا " ، مجلة شعر ، العدد الثالث السنة الأولى ص 111- 113 .
3) ن.م - ص 112
4) همزراح هحداش ( بالعبریة ) ، العددان 1-2 /1968 ، ص 33 .
5) ابن هشام : السیرة النبویة ، ج2 ص 13 .
6) الآداب شهر آب 1956 ص 64 .
7) إحسان عباس : بدر شاكر السیاب ،دار الثقافة ، بیروت – 1969 ، ص267 .
8) الآداب شهر آب 1956 ، ص 64 .
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:57|
مختارات شعریة فی وصف
طبیعة حماة
وعاصیها و نواعیرها :
یقول الشیخ عبد الغنی النابلسی :والناس یدعونه العاصی هناك وقد أطاع قهرا على حكم المقادیر
عصى فلم یسق أرضا من حدائقهم إلا بحیلة وسواس النواعیر
وفیما یلی بعض ما قاله الشعراء القدامى والمحدثون فی حماة وعاصیها ونواعیرها.
یقول مجیر الدین بن تمیم :
أیا حسنها روضة ضاع نشرها فنادت علیه فی الریاض طیور
ودولابها كادت تعد ضلوعه لكثرة ما یبكی علیها یدور
وناعورة قد ألبست لحیائها من الشمس ثوبا فوق أثوابها الخضر
كطاووس بستان تدور وتنجلی وتنفض عن اریاشها بلل القطر
ودولاب روض كان من قبل أغصنا تمیس فلما غیرتها ید الدهر
تذكر عهدا بالریاض فكله عیون على أیام الصبا تجری
وناطقة كلما حركت ولیست بناطقة فی السكون
تـئن إذا دار دولابها فتطرب سامعها بالأنین
وتبكی ولیست بمجزومة بكاء المحب الكئیب الحزین
فتنطق بالصوت لا من فم وتقذف بالدمع لا من جفون
كأن لها میتا فی الثرى فأدمعها همع فی كل حین
إذا زمرت أطربت نفسها فغنت بمختلف اللحون
غناء یرقص كیزانها فیظهر فیهن وثب المجون
تأمل إلى الدولاب والنهر إذ جرى ودمعهما بین الریاض غزیر
كأن نسیم الروض قد ضاع منهما فأصبح ذا یجرى وذاك یدور
ناعورة مذ ضاع منها قلبها ناحت علیه بأنة وبكاء
و تعللت بلقائه فلأجل ذا جعلت تدیر عیونها فی الماء
ویقول ابن نباتة المصری :
أحسن بها ناعورة فی روضة عن جعفر یروی الهناء ربیعها
هذا ولیس یعد موج دموعها وتعد من فرط السقام ضلوعها
وناعورة قالت وقد ضاع قلبها وأضلعها كادت تعد من السقم
أدور على قلبی لأنی فقدته وأما دموعی فهی تجرى على جسمی
وناعورة قسمت حسنها على واصف وعلى سامع
وقد ضاع نشر الربى فغدت تدور وتبكی على الضائع
ویقول أبو تمام الحجام الأندلسی :
وذات شدو ومالها كلم كل فتى بالكؤوس حیاها
وطار لوح لها فأوقفها كلمحة العین ثم أجراها
كأنها قینة وقد قوطعت تسمع من قال دونها واها
ویقول سلیمان بن حسان النصیبی :
كم نعرت بالحمى ناعورة حنینها كالربط الناعر
فتارة تحسبها قینة تردد الزمر مع الزامر
وتارة ثكلى جرى دمعها فی مستهل والف ماطر
كأنما كیزانها أنجم دائرة فی فلك دائر
ویقول أبو الفرج الموفقی :
ناعورة تحسب فی صوتها متیما یشكو إلى زائر
كأنما كیزابها عصبة أصیبوا بریب الزمن الواتر
قد منعوا أن یلتقوا فغدا أولهم یبكی على الآخر
ویقول بدر الدین بن لؤلؤ الذهبی : وروضة دولابها إلى الغصون قد شكا
من حین ضاع نشرها دار علیها وبكى
ویقول عبد السلام المصری :
وروضة دولابها دائر موله من فرط أشجانه
فكله من وجده أعین تبكی على فرقة أغصانه
وقال ابن عبد السلام الدمشقی :
ودولاب روض قد شجانا أنینه وحرك منا لوعه ضمنها حب
ولكنه فی بحر عشق جهالة یدور على قلب ولیس له قلب
ویقول محمد كمال السراج :
وما من ناعورة وتئن دوما لتشبه مهجتی بالحزن یوما
سقم أضلاعها بالعد تحكی ضلوعی من فراق الإلف سقما
ولكن الأنین وبث شكوى یخفف ما بها وأذوب كتما
وأبكی من لظى نار بقلبی على ألمی وذی تبكی من ألما
وإن مدامعی من ذوب جسمی یجمدها الهوى فتجود نظما
وإن دموعها ماء قراح به تحیا وإن نثرته جما
ویقول ابن القضامی :
وذات شجو أسالت مدامعا لم تصنها
تبكی بفرط دموع ویضحك الروض منها
و یقول محمد بن الحسین الطاوی :
لحنینها حن الفؤاد التائق وبكى الكئیب المستهام الوامق
أنت أنین مغرب عن إلفه ودموعها مثل الجمان سوابق
تبكی ویضحك تحت سیل دموعها زهر تبسم نوره وشقائق
ویقول أبو المعالی سعد بن علی الوراق :
رب ناعورة كأن حبیبا فارقته فقد غدت تحكینی
أبدا هكذا تدور وتبكی بدموع تجری وفرط حنین
ویقول ابن حجة الحموی :
هوای بسفح القاسمیة والجسر إذا هب ذاك الریح فهو الهوى العذری
وفقری إلى رشف الرضاب الذی حلى من النهر حلى سائل الدمع فی النحر
یروق امتداد الجسر والقصر فوقه فیحلو طباق العیش بالمد والقصر
وقد أصبحت تلك الجزیرة جنة أ لم تنظروا الأنهار من تحتها تحری
تفوق عیون الزهر فوق شطوطها عیون المها بین الرصافة والجسر
وعاص رحیب الصدر قد خر طائعا ودولابه كالقلب یخفق بالصدر
وقد أشبه الخنساء نوحا وأنة وها دمعه قد جاء یبكی على صغر
فیا جیرة العاصی إذا ذقت ماءكم أهیم كأنی قد ثملت من السكر
ولولا بقایا طعمه فی مذاقی لما ظهرت هذی الحلاوة فی شعری
ویقول الشیخ عبد الغنی النابلسی :
ألا أیها الساری بعزم وهمة لنحو حماة زرت فی غایة الأجر
فلیست حماة فی الورى غیر جنة ألم تنظر الأنهار من تحتها تجری
بتنا على النهر فی قمر المسرات وللنواعیر أنات برنات
فوق المطیع لنا العاصی الذی انبسطت میاهه باضطرابات وموجات
سقى حماه وحیا الله جیرتها من بلدة أشبهت روضات جنات
والجسر بالقرب منا كالصراط بدا ونحن فی غرفة ذات ارتفاعات
وللشیخ عبد الغنی النابلسی فی حماة والعاصی شذرات شعریة أخرى منها:
إن حماة بلدة شریفة ریح الصبا طاب بها مهبه
من جاءها صادف فیها ما اشتهى و إنما حماته تحبه
عاصی حماة هو النهر الذی عذبت میاهه قد عصا فی حسن تقدیر
شرابه لم تدر أیدی السقاة به إلا على حسن أصوات النواعیر
لله نهر به حماة زهت فلذة العیش حسن وادیها
حماته لم تزل مطیعة بشربها منه وهو عاصبها
ویقول ابن سعید الأندلسی :
حمى الله من شطی حماة مناظرا وقفت علیها السمع والفكر والطرفا
تغنی حمام أو تمیل خمائل وتزهو میاه تمنح الواصف الوصفا
یلومون أن أعصی التصون والنهى بها وأطیع الكاس واللهو والقصفا
إذا كان فیها النهر عاص فكیف لا أحاكیه عصیانا وأشربها صرفا
وأشدو إلى تلك النواعیر شدوها وأغلبها رقصا وأشبهها عزفا
تئن وتذری دمعها فكأنما تهیم بمرآها وتسألها العطفا
ویقول الشیخ صباح
حماة التی ما مثلها بلد لكل دان من الأهلین أو قاصی
ترق قلبا لأحوال الغریب لها حتى نواعیرها تبكی على العاصی
ویقول صفی الدین الحلی:
أطعت داعی الهوى رغما عن العاصی لما نزلنا على ناعورة العاصی
والریح تجری رضاء فوق جدولها والطیر ما بین بناء وغواص
وقد تلاقت فروع الدوح واشتبكت كأنما الطیر فیها فوق أقفاص
ویقول الصافی النجفی :
هذی حماة مدینة سحریة وأنا امرؤ بجمالها مسحور
یا لیت شعری ما أقول بوصفها وحماة شعر كلها وشعور
یا لیت أنی كنت فیها طائرا وعلى المناظر كلهن أطیر
إن قصر الإنسان فی تعمیرها فمن الطبیعة كلها معمور
أنی مشیت فجنة وخمائل أو أین سرت فأنهر وجسور
حتى خرائبها تلوح كأنها لجلالها السامی البهی قصور
یا لیت أنی كنت فیها طائرا وعلى المناظر كلهن أطیر
لو كنت أبصر كلها للثمتها وودت كلی أعین وثغور
وكأن شهب الأفق جن بها الدجى نزلت بصاحبها الجمیل تدور
وإذا تموج ماؤه رقصت به شهب السماء فعمهن حبور
وترى النجوم تصادمت وتكسرت قطعا كما یتكسر البلور
وكأن نجما راح یلثم ثانیا حتى تمازح أوجه وغور
ویقول حسن الرزق عن طاحونة الغزالة وناعورة الجسریة :
ودولاب رأى حسن الغزالة فرام وصالها فأبت وصاله
ویقول علاء الدین بن غانم :
حماة فی بهجتها جنة وهی من الغم لنا جنة
لا تیأسوا من رحمة الله فقد أبصرتم العاصی فی الجنة
ویقول بدر الدین الحامد عن الناعورة والعاصی :
الدهر بین یدیك دان عجبا لشأنك أی شان
أفنى الجبال وما له بك یا ولیدته یدان
أترى أخذت على الزما ن وصرفه عهد الأمان
عاصیك یغسل مطرفیـ ــك وأنت فی ظل الجنان
عیناك من قبل المسیـ ـح وأمه نضاحتان
ما أنت یا لدة الخلو د تكلمنی فالوقت حان
وإذا الظلام بدا وألـ قى فوق وادیك الجران
مثلت عفریتا یزمــ ــجر محنقا ما بین جان
فالأشوس الصندید إن لقاك فی الأسحار هان
نــــاعورة دوارة عاصی حماة بها یزان
أمواه عاصیها تقلـ ــبها فهل هی خیزران
ولها قبیل الفجر تـر جیع یردده المكان
خلدت على مر العصو ر فلن تبید ولن تهان
ویقول مخاطبا أحمد شوقی عند زیارته بلاد الشام :
أرأیت مثل بلادنا جمالا ما بین مدن زرتها ونواح
وهناك عند أبی الفدا عاص بها یطفی أوام الظامئ الملتاح
ویقول عن العاصی :
تحدرت فی الأحقاب من عهد آدم أما یرعك الدهر تترى عجائبه
إذا ما انقضى جیل وودع آخر تولیت جیلا فی الحیاة تصاحبه
كأنك فی هذا الوجود مخلد رویدك فالتخلید أعیت مطالبه
أتذكركم حلت حماك فیالق تناوئ من یزری بها وتحاربه
إذا أنت رافقت العصور ولم تزل تصارع آذی الفنا وتغالبه
ألا أیها العاصی بحسبك ما جرى فذلك ماض ودعتنا مثالبه
ویقول منذر لطفی :
بلد طیب وشعب أصیل نهر ضاحك ودنیا بتول
ذاك وادی حماة نبع الجما لات تلفت فكل حسن دلیل
ریشة تبدع الرسوم العذارى ألق غامر وظل ظیل
ویقول ولید قنباز :
وحماة لؤلؤتی الجمیلة كلما قلبتها فی ناظری تتألق
أفقان هذا الكون أفق أخضر غرقت حماة به وأفق أزرق
فی جنة للعاشقین فمن رأى قلبا بأجمل جنة یتحرق
ویقول عدنان قیطاز عن الناعورة :
بنت الزمان وأنت آیة صنعه من ذا الذی أغراك بالدوران
من عهد آدم لم تزل هتانة عیناك ما فترت عن الهملان
و لم الأنین وأنت فی وادی حما محفوفة بالروح والریحان
ویقول میخائیل بطرس عن العاصی :
أمن السما العلیا هبطت إلى الثرى أم من هضاب الدیر ماؤك قد جرى
یا نیل سوریة وبهجة شعبها من أی عهد سلت فیها كوثرا
ویقول صلاح الدین الصفدی :
لقد نزلنا على العاصی بمنزلة زانت محاسن شطیه حدائقها
تبكی نواعیره العبرى بأدمعها لكونه بعد لقیاها یفارقها
ویقول أحد الأعراب :
باتت تحن وما بها و جدی وأحن من وجد إلى وجد
ودموعها تحیا الریاض بها ودموع عینی أحرقت خدی
ویقول أحدهم :
ناعورة فی النهر أبصرتها تشوق الدانی والقاصی
قد نبهتنا للهدى والتقى لأنها تبكی على العاصی
ویقول آخر :
أیها السائل عنی سلبوا العادة منی
كنت أسقى وأغنى صرت أسقی وأغنی
وأخر :
وإنی على نفسی لأجدر بالبكا إذا كانت الأخشاب تبكی على العاصی
وآخر :
وناعورة أنت فقلت لها اقصری أنینك هذا زاد للقلب فی الحزن
فقالت أنینی إذ ظننتك عاشقا ترق لحال الصب قلت لها إنی
وأخر :
ناعورة فی سیرها ولهانة وحائرة
الماء فوق ظهرها وهی علیه دائرة
وأخر :
أبدى لنا الدولاب قولا مع ندى لما رآنا قادمین إلیه
إنی من العجب العجاب كما ترى قلبی معی وأنا أدور علیه
وأخر :
ناعورة قالت لنا بأنینها قولا ولا تدری الجواب علیه
كم فیی من عجب یرى مع أننی أبدا أسیر ولا أفارق مضجعی
لا راس فی جسدی وقلبی ظاهر للناظرین وأعینی فی أضلعی
وآخر :
إنما الدولاب فی دوره یهیم من شوق وأشجان
ینوح حزنا ویرى باكیا بأعین تهمی على البان
وآخر :
لقد كنت غصنا فی الریاض منعما أمیس ونصبی أمان فی الخفض
فصیرنی صرف الزمان كما ترى فبعضی لما لاقیت یبكی على بعضی
وآخر :
لله دولاب یفیض بجدول فی روضة قد لأینعت أفنانا
فكأنه دنف یدور بمعهد یبكی ویسأل فیه عمن بانا
ضاقت مجاری جفنه عن دمعه فتفتحت أضلاعه أجفانا
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:56|
*تجدُّدُ
موسیقا الشِّعْرِ العربیِّ الحدیث
بین التفعیلة والإیقاع*
بین التفعیلة والإیقاع*
* "ولم یَقصرِ اللهُ العلمَ ، والشعرَ، والبلاغةَ على زمنٍ دون زمنٍ،
ولا خصَّ به قوماً دون قومٍ.بل جعل ذلك مشتركًا مقسومًا بین عباده فی كل دهْرٍ،
وجعل كل قدیم حدیثاً فی عصره ".
(ابن قتیبة: الشعر والشعراء)*
*
*
*تمهید:
فی بحثی هذا عن تجدد موسیقى الشعرالعربی الحدیث أهدف إلى أمرین:
أولهما : محاولة الوقوف على أثر هذه الموسیقا فی تطویر الشعر، وتجدد أشكاله
وتعدد صوره. ، إیجابا(بتحققها) ، كما فی :الموشحات والمخمسات والرباعیات ،
والمواویل، والمزدوجات ،وصولا إلى الشعر الحر(التفعیلة)، و سلبا (بغیابها)
كما فی قصیدة النثر(الإیقاع).
والثانی : الكشف عن فاعلیة هذه الموسیقا فی بناء القصیدة ، وتشكیلها تشكیلا
فنیا خاصا. بما یجعل من الموسیقا مدخلا للولوج إلى فهم البنیة والدلالة.
ولهذا حاولت ألا أكتفی برصد صور التجدید وظواهره ، بل كنت أعنى بالكشف عن
أسباب لجوء الشاعر إلى إیثار صورة ما للتعبیر عن تجربته ، كما رأیت فیما
أسمیته ظاهرة الالتفات العروضی . وهو أن یبدأ الشاعر بنمط من أنماط الشعر
أو بحر من البحور ، ثم یأخذ فی غیره لدلالة یقصدها.
ووصف شعرٍما بأنه حدیث وصف زمنی لا یوحی بحكم قیمة فرب حدیث أفضل من قدیم
ورب حدیث فی وقته یوصف بعد ذلك بالانحطاط ؛ فالشعر الذی كتب إبان عصور
الانحطاط الأدبیة كان فی وقته حدیثا !
لهذا صدرت البحث بكلمة ابن قتیبة المنصفة :
"ولم یَقصرِ اللهُ العلمَ ، والشعرَ، والبلاغةَ على زمنٍ دون زمن، ولا خصَّ بها قوماً
دون قومٍ. بل جعل ذلك مشترَكاً مقسوماً بین عباده فی كل دهر، وجعل كل قدیمٍ
حدیثاً فی عصره ". (ابن قتیبة: الشعر والشعراء)
أما المراد بالحدیث هنا وصفا للشعر فللدلالة على محاولات التجدید فی
الموسیقا الشعریة قبیل النصف الثانی من القرن العشرین المیلادی حیث بدأ
التجدید فی القصیدة الحدیثة یتجاوز المعانی والصور والأفكار إلى تجارب فنیة
تتصل بالتشیكل الموسیقی ، فبدأت محاولات الشعر المرسل و الشعر المنطلق
والشعر الحر والشعر المنثور ، وصولا إلى قصیدة النثر أو قصیدة الإیقاع .
أما أهم اتجاهات التجدید ومدارسه فی عصرنا الحدیث فهی: مدرسة الإحیاء،
وجماعة الدیوان، وجماعة أبولو ومدرسة المهجر، ثم جماعة مجلة شعر.
ثم عرفت موسیقا الشعر وبینت أهمیتها من حیث هی عنصر واحد من عناصر بناء
الشعریتضافر مع سائر العناصر فی بناء النص الشعری وتشكیله.
وهی عنصر مهم كاشف عن جانب من جوانب أسرار البناء الفنی .
وقد استعملت مصطلحات الموسیقا والوزن، والإیقاع وقد وصلت إلى معادلة یمكن
تصویرها على النحو التالی:
الموسیقا الشعریة = الوزن + الإیقاع
فالوزن وحده یعنی النظم ، وهو إذا خلا من الإیقاع یقع فی التنافر، والإیقاع
وحده لا یحقق الموسیقا الشعریة بل هو عنصر من عناصرها ، یحقق الانسجام الذی
یكون فی الشعر كما یكون فی النثر. هو خصیصة من خصائص الكلمة الفصیحة فی
النثر والشعر جمیعا، كما یقول ابن أبی الإصبع : " وهو أن یأتی الكلام
متحدرا كتحدر الماء المنسجم، سهولة سبك وعذوبة ألفاظ، حتى یكون للجملة من
المنثور والبیت من الموزون وقع فی النفوس وتأثیر فی القلوب ما لیس
لغیره"(تحریر التحبیر : 480)
أما مناقشتی لبدائل التفعیلة فی تصویر الوزن فقد كانت فی إطار علم العوض،
أعنی فی إطار تصویر أوزان القصیدة العربیة الأصیلة، ولم تكن على مستوى
الإبداع ، ولهذا صرحت بأن حواری فی هذا البحث لم یكن مع المبدعین فللمبدع
ما كان مبدعا أن یختار ما یناسب تجاربه ورؤاه ، ولكن كان نقاشی مع علماء
الموسیقا الشعریة من جهة ، ومع نقاد قصیدة النثر المنافحین عنها من جهة أخرى.
أما عن ترجیحی لاتخاذ التفعیلة أساسا لتصویر الوزن العروضی للقصیدة العربیة
فمبنی على إدراك اتساقها مع طبیعة اللغة العربیة ذاتها بصفتها لغة
اشتقاقیة. ثم لدقتها وموضوعیتها فی هذا التصویر ، فلا یختلف اثنان فی
التعبیر عن صورة الوزن إذا هما لجأا إلى التفعیلة بینما إذا لجأ نفر إلى
اتخاذ غیرها كالنبر أو المقاطع وجدت بینهم اختلافا كثیرا.
ولیس ترجیحی للتفعیلة نفیا لاستعمال غیرها من الوسائل الصوتیة معها ، بل
أرى أهمیة الاستئناس بتلك الوسائل على ألا تكون بدیلا للتفعیلة بل مساعدا
لها، للوقوف على أسرار موسیقا الشعر.
ولیس نقدی لبعض مقولات نقاد هذه القصیدة الجدیدة رفضا لها بل هو نقاش معهم
یهدف إلى محاولة تحریر المفاهیم النظریة حولها، ومنها مفهوم مبدأ التعویض.
الذی احتل مكانة كبیرة لدیهم.
وقد رأیت أن مفهوم التعویض لدى نقاد قصیدة النثر (الإیقاع)
وقد أفرزت هذه المدارس أنماطا عدة بقی منها فی المشهد الشعری ثلاثة أنماط
ما یزال لها مبدعوها ونقادها والمتذوقون لها وربما وصل الإعجاب بأحدها إلى
درجة التعصب ورفض ما عداها، وهی:
أولا: الشعر الأصیل: وهو المحافظ على الشكل الموسیقی للقصیدة العربیة
القدیمة مع التجدید فی إطارها من حیث ابتكارصور جدیدة ، والتنویع فی نظام
التقفیة .
ویطلق علیه كثیرون تسمیات غیر منهجیة مثل:
• الشعر التقلیدی: وهی تسمیة توحی الانتقاص إذ تنسبه إلى التقلید ، وسوف
ترى أن كل نمط یبدأ جدیدا وینتهی إلى التقلید فی الشكل. فمن الظلم ان یسمى
تقلیدیا .
• الشعر الخلیلی: وهی أیضا تسمیة خاطئة ، لأن هذا الشعر موجود من قبل
الخلیل كما عبر الشاعر:
قد كان شعر الورى صحیحا من قبل أن یخلق الخلیل
ومن المعروف أن العلماء زادوا على الخلیل بحرا مشهورا هو المتدارك ، كما
زادوا صورا عروضیة مبتكرة عما قرروا الخلیل كل هذا فی إطار هذا الشعر. فعلم
العروض من أكثر العلوم قابلیة للتجدید والتطویر منذ نشأته.
• الشعر العمودی أو (العامودی) : أطلقوا هذا الاسم ظانین أن العمود مرتبط
بالشكل العروضی وهو خطأ؛ لأن عمود الشعر مرتبط بالمعنى واللفظ والتحام
البناء فی الأساس .
• شعر الشطرین : وهی كذلك تسمیة غیر دقیقة لأن من هذا الشعر شعرا یُؤلف على
شطر واحد كالشعر الجاری على المشطور والمنهوك من البحور.
• شعر البیت: وأرى أنها تسمیة مقبولة من حیث الوزن ؛ لأنه من الممكن النظر
إلى البیت بصفته وحدة موسیقیة تمثل معظم الخصائص الموسیقیة للقصیدة، أما
إذا كان المراد بها أن البیت وحدة القصیدة بعامة فهی مرفوضة ، فالقصیدة
العربیة القدیمة وحدة واحدة كما یوضح عبد القاهر قائلا: "ولكن البیت إذا
قطع عن القطعة كان كالكعاب تفرد عن الأتراب، فیظهر فیها ذل الاغتراب".
(أسرار البلاغة : 206)
فبان من هذا وغیره من نصوص التراث خطأ أن یكون البیت وحدة القصیدة.
على أن لیس فی تسمیته بالأصیل انتقاص لغیره من الأنواع المبتكرة، فهذه
الأشكال إنما هی فروع عنه، دون أن یلغی احدهما الآخر.
ثانیا: الشعر الحر:
وقد شاع هذا المصطلح رغم عدم دقته ، بل برغم ظلمه له ولأصحابه حتى اتهمه
معادوه بأنه متحرر من الوزن والقافیة ، وسموه أیضا بأنه شعر سائب، مما جعل
شاعرا منهم كصلاح عبد الصبورأن یقسم لهم : "موزون والله العظیم".
ولكن أدرك الدرس العروضی والنقدی خطأ هذا المصطلح فی التعبیر عن المراد به،
فذهب إلى تسمیته بشعر التفعیلة.
وقد بان من البحث أن شعر التفعیلة وفق توفیقا واضحا فی تفجیر الطاقات
الموسیقیة التراثیة فی القصیدة مدركین قیمة التفعیلة والقافیة فی تشكیل
القصیدة تشكیلا موسیقیا موحیا .
ثالثا: قصیدة النثر: وقد وقف كثیر من الرافضین لها عند التناقض الظاهر فی
المصطلح وقد دعوت هنا إلى تجاوز الجدل حول هذا الأمر لأنه من الممكن النظر
إلیه على أنه تقیید للقصیدة بأنها نثر ، كما فی مصطلح (اسم الفعل) لدى
النحاة لقسم من أقسام الكلم فی العربیة ، وهو لیس متناقضا.
وحتى لو سلمنا بعدم دقة المصطلح فقد كان مصطلح الشعر الحر غیر دقیق وبالرغم
من هذا نجح هذا اللون من الشعر نجاحا كبیرا .
على أن من الدارسین من حاول إیجاد مصطلحات بدیلة ، أرى أقربها إلى الاشتقاق
والدلالة مصطلح (النثیرة) ویجمع على نثائر؛ فهو أفضل من تسمیات مقترحة مثل:
النسیقة، والعصیدة ، وكلها بعیدة عن الدلالة على هذا النمط ، ولا سیما
مصطلح : النثعیرة التی یأبها الاشتقاق . ویمجها الذوق.
ومن التسمیات تسمیة الشاعرعز الدین المناصرة لها بأنها القصیدة الخنثى .
وأنا أرفض مثل هذه التسمیات لأنها غیر موضوعیة.
وقد استعملت فی البحث مصطلح (قصیدة الإیقاع ) فی مقابل (قصیدة التفعیلة)
على فرض أن هذه القصیدة قد تخلت عن التفعیلة ولجأت إلى الإیقاع، وقد ناقشت
هذا الفرض.
والإیقاع یختلف عن الموسیقا فهو جزء من كل ، ولیس تحقق الإیقاع فی قصیدة
النثر تعویضا عن الموسیقا الغائبة فقد أكد كثیر من الباحثین أن الإیقاع
یكون فی النثر كما یكون فی الشعر.
وقد حاول نقاد هذه القصیدة البحث عن أسباب هذا الإیقاع ورصدها، والتقنین له
من خلال طرح التساؤل:
لقد وفق الخلیل فی رصد موسیقا الشعر العربی ، ونجح ابن سناء الملك فی كشف
القوانین الموسیقیة للموشحات ، واهتدت نازك الملائكة فلماذا لا یأتی مكتشف
لإیقاعات قصیدة النثر فیعمل لها ما عمله الخلیل وابن سناء ونازك.
وأرى أن مهمة هذا المكتشف المنتظر صعبة إن لم تكن مستحیلة؛ لأن الذی ساعد
هؤلاء السابقین أنهم تعاملوا مع أشكال لها موسیقاها رغم تنوعها. أما قصیدة
النثر فما تزال تبحث عن إیقاعها المرتجى . ومن یدری ربما وصلت إلیه یوما
فلا تضطر نقادها إلى تكلف القول فی بدائل غیر مجدیة.
لم یكن نقاشی هنا مع شعراء قصیدة النثر؛ لأن للمبدع - ما كان مبدعا - أن
یختار النمط الذی یناسب تجربته ورؤیاه ، وإنما كان حواری مع نفر من نقاد
هذه القصیدة یفتعلون خصومة بینها وبین الأنماط الأخرى ، كما لاحظت فی خطاب
الناقد الكبیر صلاح فضل الذی یتحدث عنها بلغة ثوریة حربیة، مع ان هذه
الخصومة لیست حاضرة فی أذهان كثیرین من مبدعی قصیدة النثر، مثل نزیه أبو
عفش الذی یبدع أیضا فی قصیدة التفعیلة ، ومثل الشاعر عماد الغزالی الذی عاد
إلى النبع فی دیوانه "لا تجرح الأبیض"
وبعد فأرجو أن تكون كلمتی تلك التی أثارتها شجون موسیقا الشعر وتجددها
وتجلیاتها حضورا وغیابا ، وأن تكون دعوة لنبذ التعصب، ومحاولة التعایش
الإیجابی بین الأنماط الثلاثة ولنذكر أن شعر التفعیلة لم یلغ الشعر الأصیل
بل تعایشا معا تعایشا أفاد كلیهما. وما زالا حاضرین فی المشهد الشعری ولن
یضیرهما أن تنجح قصیدة النثر فی اتخاذ مكان لها فی المشهد الشعری معهما، بل
لا ضیر للثلاثة فی أن یصدر شكل رابع جدید ؛ لأننا لا بد أن ندرك أن قصیدة
النثر لیست نهایة التاریخ الأدبی.*
**
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:55|
مناقشة نقاد قصیدة النثر:
أثار مصطلح قصیدة النثر منذ
مولده أو بالأحرى اجتلابه إلى البیئة العربیة
العدید من النقد أبرزه ملاحظة التناقض بین طرفی المصطلح ، ویرى الدكتور عبد
القادر أن هذا المصطلح یثیر مفارقة واضحة بین طرفی القصیدة والنثر فیقول :
" وقد أثارت المفارقة الواضحة بین طرفی المصطلح " القصیدة والنثر " - وما
زالت تثیر- كثیرا من الجدل ".(57)
وأرى أن على النقد تخطی ذلك الجدل ؛ لأن هذا اصطلاح، ولا مُشاحَّة فی الاصطلاح
كما علمنا علماؤنا الأوائل.
كما یجب ألا ننسى أن الشعر الحر أیضا قام على مصطلح غیر دقیق ، ولم ینته
الشعر الحر بسبب ذلك.
وقد نشأت مصطلحات أخرى مهدت فی العربیة لهذا النوع مثل :
"الشعر المنثور الذی یعرفه أمین الریحانی قائلا: : " یدعى هذا النوع من
الشعر الجدید.
بالإفرنسیة Vers Libres وبالإنكلیزیة Free Verse - أی الشعر الحر الطلیق-
وهو آخر ما اتصل إلیه الارتقاء الشعری عند الإفرنج وبالأخص عند الإنكلیز
والأمیركیین. فشكسبیر أطلق الشعر الإنكلیزی من قیود القافیة. وولت وتمن
Walt Waiman الأمیركی أطلقه من قیود العروض كالأوزان الاصطلاحیة والأبحر
العرفیة. على أن لهذا الشعر الطلیق وزنا جدیدا مخصوصا وقد تجیء القصیدة فیه
من أبحر عدیدة متنوعة..(61)
لاحظ أنه یتحدث عنه بصیغة الحدیث عن آخر صیحة!
ولتوفیق الحكیم تجربة یعبر عنها قائل:"ولقد أغرانی هذا الفن الجدید فی
السنوات العشرین من هذا القرن وأنا فی باریس بالشروع فی المحاولة فكتبت بضع
قصائد شعریة نثریة من هذا النوع ، وهو لا یتقید بنظم ولا بقالب معروف".(62)
أما حسین عفیف فقد عرفه بأنه :
"یجری وفق قوالب عفویة یصبها ویستنفدها أولا بأول, لا یتوخى موسیقى الوزن
ولكنه یستمد نغمته من ذات نفسه. لا یشرح ومع ذلك یوحی عبر ایجازه بمعان لم
یقلها, لیس كشعر القصید ولا كنثر المقال ولكنه أسلوب ثالث".
وفی تعریف آخر له یقول :" الشعر المنثور یتحرر من الأوزان الموضوعة ولكن
لا, لیجنح الى الفوضى, وانما لیسیر وفق أوزان مختلفة یضعها الشاعر عفو
الساعة ومن نسجه وحده, أوزان تتلاحق فی خاطره ولكن لا تطرد, غیر أنها برغم
تباین وحداتها, تتساوق فی مجموعها وتؤلف من نفسها فی النهایة هارمونیا
واحدة, تلك التی تكون مسیطرة علیه أثناء الكتابة.(63)
لكن أنسی الحاج یفرق بین المصطلحین فیقول:" لكن هذا لا یعنی أن الشعر
المنثور والنثر الشعری هما قصیدة نثر، إلا أنهما- والنثر الشعری الموقع على
وجه الحصر- عنصر أولی فی ما یسمى قصیدة النثر الغنائیة. ففی هذه لا غنى عن
النثر الموقع.(64)
أما البدایة الفعلیة فترجع إلى جماعة مجلة شعر التی تأسست فی بیروت 1957م
بریادة كل من یوسف الخال ، وخلیل حاوی، ونذیر العظمة، وأدونیس ، ثم انضم
إلیها : شوقی أبو شقرا وأنسی الحاج ، ودعمها من خارجها جبرا إبراهیم جبرا و
سلمى الجیوسی (65) ویصرح أنسی الحاج بأنه :
" صاحب أول وثیقة فی قصیدة النثر المكتوبة بالعربیة دیوان (لن) هو الكتاب
الأول المعرف نفسه بقصیدة النثر والمكتوب بهذه الصفة تحدیدا.. والمتبنی
لهذا النوع تبنیا مطلقا.(66)
فماذا قال فی مقدمته التاریخیة تلك ؟
قال: " هل یمكن أن نخرج من النثر قصیدة؟ أجل، فالنظم لیس هو الفرق الحقیقی
بین النثر والشعر. لقد قدمت جمیع التراثات الحیة شعرا عظیما فی النثر، ولا
تزال. وما دام الشعر لا یعرف بالوزن والقافیة، فلیس ما یمنع أن یتألف من
النثر شعر، ومن شعر النثر قصیدة نثر".(67)
تعریف قصیدة النثر:
أوردت الموسوعة العربیة العالمیة تعریفا منصفا لها ، یتضمن أغلب مقولات
أنصارها ، حیث عرفتها بأنها:
" جنس فنی یستكشف ما فی لغة النثر من قیم شعریة ، ویستغلها لخلق مناخ یعبر
عن تجربة ومعاناة، من خلال صور شعریة عریضة تتوافر فیها الشفافیة والكثافة
فی آن واحد ، وتعوض انعدام الوزن التقلیدی فیها بإیقاعات التوازن والاختلاف
والتماثل والتناظر معتمدة على الجملة وتموجاتها الصوتیة بموسیقا صیاغیة تحسُّ
ولا تُقاس".(68)
موقف من التراث:
وبینما كان رواد (الشعر الحر(التفعیلة) معنیین بصلتهم الوثقى بالتراث
الشعری والعروضی العربی فإن من رواد قصیدة النثر من لم یهتم بهذه الصلة ،
بل إن منهم من صرح بالاغتراب عن هذا التراث العربی یقول أنسی الحاج:
"أشعر بالغربة فی المقروء العربی... قراءة العربیة تصیبنی بملل لاحد له،
وما أبحث عنه أجده فی اللغة الفرنسیة؛ لأن الفرنسیة هی لغة (الانتهاك)
بینما العربیة لغة (مقدسات) ".(69)
وهذا تعمیم غیر علمی وشبهة مردودة فاللغة -أیة لغة- قادرة على أن تعبر عن
المقدس وغیرالمقدس .
ومنهم من عد الاهتمام بالبحث عن جذور أو أصل فی التراث خللا كالشاعر قاسم
حداد؛ إذ یقول " ثمة خلل فی الصدور عن إحساس بضرورة تأصیل كل ظاهرة فنیة
لمرجعیة محددة ، كأن تكون الكتابة ، خارج الوزن ، معطى منسوخا عن تجربة -
قصیدة النثر الغربیة ، أو أن یكون لهذه الكتابة أسلاف فی التراث العربی ".
(70)
وفی المقابل حاول نفر منهم تعویض النشأة الأجنبیة لقصیدة النثر اصطلاحا
وتعریفا وشروطا قائمة كلها على نماذج من الأدب الفرنسی، فلجؤوا إلى التراث
العربی القریب ناسبین قصیدة النثر إلى جبران ومصطفى صادق الرافعی، والبعید
مفتشین عن نماذج لابن حزم ، أبی حیان الأندلسی، وابن عربی.
أما على مستوى التنظیر فلجؤوا إلى بعض النصوص التراثیة للاستئناس بها
لقواعد سوزان برنار ، مثل النص الذی أورده عبد القاهر: "حین رجع عبد الرحمن
بن حسّان إلى أبیه حسَّان وهو صبیّ، یبكی ویقول لَسَعَنی طائر، فقال حسان: صِفْهُ یا
بُنیَّ، فقال: كأنه مُلْتَفٌّ فی بُرْدَىْ حِبرَة، وكان لسعَهُ زُنْبُور، فقال حسّان قال ابنِی
الشِّعر وربِّ الكعبة ، أفلا تراه جَعل هذا التشبیه مما یُستدَلُّ به على مقدار قُوّة
الطبعِ، ویُجْعَل عِیاراً فی الفَرْق بین الذهن المستعدّ للشعر وغیر المستعدّ له".(71)
ولیس فی نص الجرجانی دلیل على أن الشعر یكون بغیر وزن؛ لأن تسمیة حسان ما
قاله ابنه شعرًا تسمیة مجازیة توحی بقوة استعداد ابنه للشعر فیما بعد كما هو
واضح من تعلیق عبد القاهر.
ومنهم من تمسك بقول الفارابی إن "القول الشعری قد یكون غیر موزون ". ولم
ینتبهوا أن القول الشعری للفارابی مختلف عن الشعر فالمقصود به الحجة
الشعریة فی اصطلاح الفلاسفة.(72)
موقف من الموسیقا:
یعبر أدونیس عن موقف رواد قصیدة النثر من الموسیقا قائلا:
" الوزن/ القافیة ظاهرة إیقاعیة- تشكیلیة لیست خاصة بالشعر العربی وحده
وإنما هی ظاهرة عامة، فی الشعر الذی كتب ویكتب بلغات أخرى، لكن على تنویم
وتمایز. الزعم إذن، بان هذه الظاهرة خصوصیة نوعیة لا تقوم اللغة الشعریة
العربیة إلا بها، ولا تقوم إلا بدءا منها واستنادا إلیها، إنما هو زعم واهٍ
جدا وباطل".(73)
یبدأ أدونیس بمقدمة سلیمة ، هی أن الوزن والقافیة ظاهر إیقاعیة لیست خاصة
بالشعر العربی وحده ، وهذا صحیح وقد بینه الزمخشری من قبل ، لكنه یقفز إلى
نتیجة خاطئة هی رفض ألا تقوم اللغة الشعریة إلا بها.
فهل وجود الوزن والقافیة فی شعر لغات أخرى ، ینفی أن یكونا عنصرین من عناصر
بناء الشعر العربی.
وكذلك فإن عدم وجودهما فی شعر لغة من اللغات " لیس مما یسلب الشعر كله من
موسیقاه"(74) كما یقول الدكتور أنیس.
بدائل الموسیقا:
بعد أن اتفق أصحاب هذا الاتجاه إهدار عنصر الموسیقا راحوا یبحثون عن بدائل
للتعویض فتوصلوا إلى عمود لقصیدة النثر مستقى من تنظیر برنار ، قائم على
شروط ثلاثة بدون أحدها یستحیل الحدیث عن قصیدة نثر، وكل شرط من هذه الشروط
یستدعی ملازما له على هذا النحو:
1- الإیجاز : الكثافة .
2- التوهج : الإشراق .
3- المجانیة : اللازمنیة.
مبدأ تعویض الموسیقا الغائبة:
وقد أشار أنسی الحاج إلى هذا القانون فقال عن قصیدة النثر إنها :" تستعیض
عن التوقیع بالكیان الواحد المغلق، الرؤیا التی تحمل أو عمق التجربة الفذة،
أی بالإشعاع الذی یرسل من جوانب الدائرة أو المربع الذی تستوی القصیدة
ضمنه، لا من كل جملة على حدة وكل عبارة على حدة أو من التقاء الكلمات
الحلوة الساطعة ببعضها البعض الآخر فقط" . (75)
وهو یشیر هنا إلى مبدأ الاستعاضة او التعویض الذی نقله عن سوزان وتلقاه
نقاد قصیدة النثر.
وقد بلور الدكتور صلاح فضل هذا القانون فقال " إن قصیدة النثر تعتمد الجمع
بین الإجراءات المتناقضة ؟ أی إنها تعتمد أساسا على فكرة التضاد، وتقوم على
قانون التعویض الشعری".(76)
وأنا أرى أن قانون التعویض هذا ملازم لقصیدة النثر وأصحابها فی أكثر من
مستوى بدءًا من المصطلح (قصیدة ) ومرورا بكتابة كلمة شعر على نصوصهم
ودواوینهم ، وإلحاح بعضهم، لا سیما الماغوط ،على الإكثار من مفردات " شعر
وقصیدة" فی نصوصهم.
والذی یعنینی هنا مبدأ التعویض عن عنصر الموسیقا، وأرى أنه قائم على مفارقة
عجیبة .
فالتعویض إنما یكون عما یفقده الإنسان لا بإرادة منه ، فحینئذ یلجأ إلى
تعویض ما خسره ، أما فی حالة قصیدة النثر فإن إهدار الموسیقا متعمد فما
معنى التعویض؟
إن الموسیقا فی الشعر إما أن تكون مهمة ، فلا تستحق الإهدار، أو غیر مهمة ،
فلا تحتاج إلى تعویض.
فهل من المعقول المقبول أن یفقأ إنسان عینیه ثم یقول : سأعوض عن حاسة البصر
بتنشیط حواسی الأُخَر؟!
لكنهم انطلاقا من شعورهم بالحاجة إلى تعویض للموسیقا الغائبة ، راحوا
یبحثون، حتى توصلوا إلى تبنی البدائل التالیة:
أولا: بدیل كمال أبو دیب: "الفجوة: مسافة التوتر":
أما كمال أبو دیب فیعترض على اتخاذ الإیقاع عوضا عن الموسیقا فی قصیدة
النثر فلدیه:
"لا یكون ثمة من كبیر جدوى فی تحدید الشعریة على أساس الظاهرة المفردة
كالوزن أو القافیة أو الإیقاع الداخلی أو الصورة أو الرؤیا أو الانفعال ".(77)
ولذلك یقترح مفهوما جدیدا یسمیه:"الفجوة أو مسافة التوتر وهو مفهوم:" لا
تقتصر فاعلیته على الشعریة بل إنه لأساسی فی التجربة الإنسانیة بأكملها بید
أنه خصیصة ممیزة".
بید أن ما یمیز الشعر هو أن هذه الفجوة تجد تجسدها الطاغی فیه فی بنیة النص
اللغویة بالدرجة الأولى وتكون الممیز الرئیسی لهذه البنیة". ویحاول أن یطبق
هذا المفهوم الذی (لا یقتصر على الشعریة بید أنه خصیصة ممیزة )على نص"فارس
الكلمات الغریبة" لأدونیس" ، حیث:"تبرز مسافة التوتر فی العبارة الواحدة
منذ اللحظة الأولى للنص:
"یُقْبلُ أعزلَ كالْغابة "
ذلك أن یقبل أعزل الخالیة من التوتر نهائیا تخلق ما سأسمیه بنیة توقعات
بعشرات الإمكانیات لكن النص یقدم اختیاره من خارج بنیة التوقعات "كالغابة"
ویفعل بذلك شیئین: یخلق فجوة: مسافة توتر نابعة من ربط العزلة بالغابة،
وفجوة أخرى نابعة من حصر دلالات الغابة اللانهائیة نظریا ، فی دلالة واحدة
تقع هی أیضا خارج بنیة التوقعات المرتبطة بالغابة".(78)
فهل تصلح هذه (الفجوة:مسافة التوتر) أن تكون بدیل الموسیقا الشعریة فی
القصیدة ، وممیز الشعریة فیها ؟
ثانیا : الإیقاع:
تعریف الإیقاع:( RHYTHM)
"الإیقاع أقدم الأنواع الموسیقیة . وهو العنصر الذی ینظم حركة الموسیقا
وتدفقها خلال الزمن."(79)
فالإیقاع جزء من الموسیقا وعنصر من عناصرها.
یقول الدكتور غنیمی هلال:" ویقصد به وحدة النغمة التی تتكرر على نحو ما فی
الكلام أو فی البیت ، أی توالی الحركات والسكنات على نحو منتظم فی فقرتین
أو أكثر من فِقَرِ الكلام، أو فی أبیات القصیدة ، وقد یتوافر الإیقاع فی
النثر، وقد یبلغ درجة یقرب بها كلَّ القرب من الشعر، أما الإیقاع فی الشعر
فتمثله التفعیلة فی البحر العربی ".(80)
لكن أصحاب قصیدة النثر فهموا الإیقاع فهما یتلاءم مع قصیدتهم، یقول الدكتور
النجار:"وهو - توفیق صایغ- إذ یستغنی عن إیقاع الوزن فإنه لا بد یستغنی عنه
بعناصر إیقاعیة أخرى هی ما یطلق علیه الإیقاع الداخلی ، وهو یشیر إلى إیقاع
فی النص باستثناء الوزن والقافیة الرئیسة".(81)
فقسم الإیقاع إیقاعین داخلی ومعنوی:
1- الإیقاع الداخلی:
یقول:"فكان هذا الإیقاع أبرز ما یكون متمثلا فی الحرص على أحرف العلة ، ومن
2- الإیقاع المعنوی
أ ، یقول الدكتور مصلح النجار: ثمة إیقاع یستند أساسا إلى جانب معنوی هو
التضاد اللغوی والتقابلات التی تحتشد فی الأسطر السابقة
العشی – الصباح / جاهلیة – الیقین/ لتعطی – لتأخذی.
وهذا یصنع إیقاعا معنویا ، ینضاف إلى ما یسمى الإیقاع الداخلی أیضا." (82)
وأنت تدرك أن النثر العربی القدیم كان بتلك المحسنات البدیعیة حفیا !
وقد حاول كمال خیر بك أن یحلل قصیدة للماغوط تحلیلا إیقاعیا مكتشفا فیها
"كتلا" إیقاعیة متناسبة بدرجة أو بأخرى، حسب تعبیره ، وهو یرى أن الشاعر
یفكر بإرادة واعیة فی إعطاء نصه مسحة موسیقیة منتظمة . (83)
أما الدكتور صلح فضل فیبشر بشعر آخر یتیح لنا:" أن نكتشف إیقاعا آخر غیر
الذی یكاد یصم آذاننا لشدة ما تعودنا رنینه".(84)
وهو یجد ضالته فی مقطوعة بعنوان " وتراءى له" للشاعر محمد متولی فی مجموعته
الشعریة بعنوان" حدث ذات مرة أن" التی یراها "تمثل نموذجا ناجحا لهذه
الثورة الشعریة فی مصر" وتذكره بما كانت تحدثه الدواوین الانفجاریة الأولى
من تأثیر :
"فی القطار/سیدة حافیة تغنی الآریا الأخیرة لموسیقار مجهول
وفئران تطعم من بطانة مقعدها/ شعراء فی هیئة شحاذین/ یتبادلون الصحف القدیمة
ومهرول یعثر على قدم حبیبته تحت الحقائب/ بینما شخیر الراكب یعلو..
علیك أن تحشو فمه بحذاء ممزق".(85)
ولن یعجز ناقدنا عن أن یلم شتات هذه الأشیاء فی فكرة "التآكل وانتهاء
العالم القدیم" وینتهی إلى حكمة مهمة ،هی:"ضرورة الصمت " كما یبرزها المشهد
الأخیر.
ثم یسألنا الناقد : هل تبشر المقطوعة بانتهاء عصر الغناء الرث والعواطف
الفجة التی لا تستحق سوى السخریة والازدراء والبتر العنیف".
هكذا یرى الناقد ضرورة الصمت ولو بالحذاء، أما الشخیر فهو فی تفسیره "عصر
الغناء الرث" الذی ینبغی أن یضرب بالحذاء
فهل لنا أن نفهم أن المقصود بالحذاء حسب تفسیر الناقد هو البدیل . ألا یرى
فی هذا إهانة للبدیل الذی یبشر به.
لا أظن ، لأن الناقد یتحدث بلغة ثوریة ، بل یدخل إلى البحث عن "شعر آخر
إیقاع آخر" وكأنه یدخل معركة ، إذ یقول:" أثبت عدد مجلة (الناقد) المخصص
لقصیدة النثر أن المخزون الاستراتیجی للشعریة العربیة منها عندنا أوفر مما
یقدره النقاد.. ویبدو أن قصیدة النثر أصبحت رایة الشباب الثائر على الأعراف".
ثم یتحدث عن مشكلة " غیبة الإیقاع الخارجی الظاهر المریح، واختفاء أنساق
التفعیلات العروضیة من فوق سطح النص" ، لیلجأ إلى حل أكثر راحة ألا وهو:
" أن نتوسع فی مفهوم الإیقاع ، ولا نقصره على نوع واحد "، فإذا نحن صنعنا
ذلك : "استطعنا أن نتبین ما تبقیه قصیدة النثر وتنمیه من إیقاعات".
وإذا ناقشنا هذا النقد بموضوعیة – بصرف النظر عن مناقشة قصیدة النثر ذاتها-
اكتشفنا أنه غیر منهجی، إن مثله كمثل من یقول :" لماذا لا تتوسع فی مفهوم
الذهب لیشمل الحدید والنحاس ؟ ألیست جمیعها معادن؟!
ثم یحدثنا الناقد عن " الترجیع الإیقاعی " فلیس ثمة إیقاع بدون ترجیع ،
وإذا كانت القصیدة تنبنی من كِسَرٍ مرصوصة ، ونثار وردی من التفاعیل المبعثرة
، تخلق بنسیجها الصوتی مجالاتها وأصداءها الموسیقیة المبتكرة – تظل جملة
"الموسیقى: خلفیة لا أكثر هی الرباط الذی یشد هیكل البنیة الإیقاعیة للقصیدة".
فهل ینجح هذا النقد فی تعویض الموسیقا المهدرة سلفا؟
أما الشاعر حلمی سالم( فی ندوة عُقدت بحلقة الزیتون الإبداعیة بالقاهرة
لمناقشة دیوان (نقرة إصبع شارك فیها المؤلف) راجع موقع الشاعرة فاطمة ناعوت
على الإنترنت : فیقطع الطریق على هؤلاء الذین یتكلفون البحث عن الإیقاع فی
قصیدة النثر قائلا:
"لقد كنا فیما سبق نردد مثل هذا الكلام حول الإیقاع فی قصیدة النثر، ولكنی
أقول الیوم: وما الذی سیحدث لو لم یكن هناك إیقاع أصلا؟ دعونا من ذلك
ولنتأمل لغة كل شاعر وأبنیته وصوره" .
وبعدُ ، فقد حكى طه حسین( 86) عن جوردان السوقة فی مسرحیة من مسرحیات مولییر
قوله :"یا للعجب إذًا فأنا أتكلم النثر منذ أربعین سنة ، ولا أدری؟"
ویعلق أدیبنا قائلا: " أخشى أیها السادة أن نكون جمیعا كما كان جوردان هذا
نفهم النثر من أنه كل كلام لم یتقید بالنظم والوزن والقافیة"
وأقول : لو قرأ جوردان بعض نماذج قصیدة النثر لقال : "أنا أتكلم قصیدة
النثر منذ أربعین سنة ، ولا أدری!"
أما طه حسین فیقول مستدركا ، ومدركا قیمة النثر:" وأنا إذا قلت النثر فلا
أعنی ذلك النثر الذی یفهمه جوردان ، إنما أقصد النثر الذی یفهمه الأدیب" .
ولإیمان طه حسین جاء نثره بدیعا من غیر حاجة إلى تعویض.
مستقبل قصیدة النثر:
هل لقصیدة النثر مستقبل
من العسیر أن یتنبأ الباحث الدارس لتاریخ الأدب بموت تجربة أدبیة حتى لو
كانت لا تروق له لأسباب موضوعیة أوغیر موضوعیة ؛ فقد علمنا تاریخ الأدب أن
الرفض مهما تكن مبرراته لا یمنع شیوع الشكل الجدید.
وأنت تعرف ما حُكی أن ابن الأعرابی قال، وقد أنشد شعراً لأبی تمام:
إن كان هذا شعراً فما قالته العربُ باطلٌ!
وقد أنصف التاریخ أباتمام دون أن یكون شعر العرب باطلا.
ولنا درس فی موقف العقاد الذی حاول التصدی للشعر الحر(التفعیلة) ، وبقی
الشعر الحر.
ومن الإنصاف أن یتجرع الشاعر الكبیر عبد المعطی حجازی من الكأس ذاتها التی
سقاها للعقاد!
وهل سینصت التاریخ الدبی لصیحة الناقد الكبیر الدكتور القط" :"إذا كان هذا
هو الشعر فأنا منه براء".(87)
وهل سیستمع ناشئة قصیدة النثر إلى تحذیر أدونیس یحذر من " الزیف الذی ینتشر
باسم التجدید. خصوصا أن الكثیر من هذا المزعوم تجدیدا ، یخلو من أیة طاقة
خلاقة ، وتعوزه حتى معرفة أبسط أدوات الشاعر: الكلمة والإیقاع".(88)
أما أنا فأرى – والله أعلم – أن الأشكال الثلاثة (قصیدة البیت ، و قصیدة
التفعیلة ، وقصیدة النثر أوقصیدة الإیقاع) سوف تستمر، وأن الصراع بینها
أیضا سیحتدم لكنی أتمنى أن یكون صراعا إیجابیا ولیس إقصائیا، فها أنت ترى
أن كل محاولات إقصاء الشعر الأول أو الثانی قد باءت بالفشل ، واستمرا رغم
حدة الخلاف بین أنصاریهما فی فترات سابقة .
وأن الشعرالأصیل (ولا أقول القدیم ) (المسمَّى خطأ بالشعر التقلیدی ،
أوالعمودی، أو بشعر الشطرین) والذی وصل إلى آفاق عالیة على ید مبدعین
كالجواهری وأبی ریشة والبردونی ، بما حققوا له من توهج وحیویة ، ما یزال
یواصل تجدده رغم المحافظة على الشكل على أیدی شعراء أخلصوا له ، كالدكتور
عبد اللطیف عبد الحلیم ، والدكتور سعد مصلوح ، وأحمد بخیت، وسمیر فراج ،
والدكتور عبد الرحمن العشماوی، وغیرهم، وسیظل یزدهر على أیدی ناشئة سیدركون
افتقاد محبی الشعر له ، لكنهم سیستمرون فی التجدید مفیدین من إنجازات الشعر
الحر(التفعیلة)، وقصیدة النثر(الإیقاع) معا.
فلیست قصیدة النثر وحدها التی تمتلك المخزون الاستراتیجی (بحسب تعبیر
الدكتور صلاح فضل).
وكما یجب على شعراء البیت، والتفعیلة البعد عن التقلید ، فإننی أرى أن على
حاملی لواء قصیدة النثر الجدد أن یتخلوا عن الشروط التی أراد الشعراء
المؤسسون ونقادهم أن یفرضوها علیها وعلیهم ،() وبعضهم یحاول ذلك كعماد
الغزالی وفاطمة ناعوت ورضا العربی ، حتى لا یظلوا فی انعزال عن أمتهم
وقضایا أمتهم ، وأن یتخلصوا من فكرة القطیعة، لیقللوا من خسائرهم. وأن
یدركوا مدى الخسائر التی تكبدوها بإصرارهم على إهدار الموسیقا الشعریة ،
فخسروا بذلك مكاسب حققتها قصیدة الشعر على مر العصور، منها:
1- الغناء
فإن هذا النفر من الشعراء سیحرم من أن یتغنى بقصائدهم النثریة، بما یمثله
هذا الغناء من ذیوع وانتشار وكسب مساحة جدیدة من المتلقین غیر القراء. وذلك
بسبب افتقارها إلى عنصر الموسیقا رغم تشبثهم بالإیقاع؛ لأن الإیقاع بحسب
تصورهم سیجعل ألحان هذه (النثائر) – إن هی لُحِّنتْ - متشابهة ومكرورة وبعیدة
عن ذوق المستمع العربی، حیث یحتاج إلى مط بعض الحروف لیعوض غیاب الوزن الأصیل.
2- المسرح الشعری
بما یمثله من ثراء فی التعبیر ، وتنوع فی الأداء الموسیقی، والوصول إلى
جمهور خاص.
وأتساءل لو أراد مبدع قصیدة النثر أن یكتب مسرحیة شعریة ماذا سیسمیها ؟
3- الاستشهاد:
فقد اعتاد كثیر من المثقفین حتى غیر المعنیین بالشعر منهم الاستشهاد ببض
الأبیات المأثورة من الشعر الأصیل(البیت) والشعر الحر(التفعیلة) كالاستشهاد
بأبیات الحكمة أو الغزل أو السیاسة مثلا .
فهل یستطیع أصحاب قصیدة النثر أن یصلوا إلى هذا المرتقى؟
هل یتاح لهم أن یسهموا فی بناء الوعی كما أتیح للشعرالأصیل وشعر التفعیلة؟
4- الجمهور المتلقی :
حتى إذا جادل أصحاب اتجاه قصیدة النثر وقالوا لا یعنینا الغناء ولا المسرح
الشعری فإن خسارتَهم الكبرى خسارةُ محبی الشعر الذین انصرفوا عنه انصرافا.
وأحسب أن الخسائر أكثر من هذا وأفدح ، ولكننی أتوقع من كثیر من أصحاب قصیدة
النثر أن یردوا على ذلك بأنهم غیر آبهین لهذه الخسائر، وأنهم زاهدون فی
تحقیق تلك المكاسب، وسیكون شأنهم معها شأن الذی أراد و لم یستطع أن ینال
العنب، فقال:
" إنه حصرم!"
العدید من النقد أبرزه ملاحظة التناقض بین طرفی المصطلح ، ویرى الدكتور عبد
القادر أن هذا المصطلح یثیر مفارقة واضحة بین طرفی القصیدة والنثر فیقول :
" وقد أثارت المفارقة الواضحة بین طرفی المصطلح " القصیدة والنثر " - وما
زالت تثیر- كثیرا من الجدل ".(57)
وأرى أن على النقد تخطی ذلك الجدل ؛ لأن هذا اصطلاح، ولا مُشاحَّة فی الاصطلاح
كما علمنا علماؤنا الأوائل.
كما یجب ألا ننسى أن الشعر الحر أیضا قام على مصطلح غیر دقیق ، ولم ینته
الشعر الحر بسبب ذلك.
وقد نشأت مصطلحات أخرى مهدت فی العربیة لهذا النوع مثل :
"الشعر المنثور الذی یعرفه أمین الریحانی قائلا: : " یدعى هذا النوع من
الشعر الجدید.
بالإفرنسیة Vers Libres وبالإنكلیزیة Free Verse - أی الشعر الحر الطلیق-
وهو آخر ما اتصل إلیه الارتقاء الشعری عند الإفرنج وبالأخص عند الإنكلیز
والأمیركیین. فشكسبیر أطلق الشعر الإنكلیزی من قیود القافیة. وولت وتمن
Walt Waiman الأمیركی أطلقه من قیود العروض كالأوزان الاصطلاحیة والأبحر
العرفیة. على أن لهذا الشعر الطلیق وزنا جدیدا مخصوصا وقد تجیء القصیدة فیه
من أبحر عدیدة متنوعة..(61)
لاحظ أنه یتحدث عنه بصیغة الحدیث عن آخر صیحة!
ولتوفیق الحكیم تجربة یعبر عنها قائل:"ولقد أغرانی هذا الفن الجدید فی
السنوات العشرین من هذا القرن وأنا فی باریس بالشروع فی المحاولة فكتبت بضع
قصائد شعریة نثریة من هذا النوع ، وهو لا یتقید بنظم ولا بقالب معروف".(62)
أما حسین عفیف فقد عرفه بأنه :
"یجری وفق قوالب عفویة یصبها ویستنفدها أولا بأول, لا یتوخى موسیقى الوزن
ولكنه یستمد نغمته من ذات نفسه. لا یشرح ومع ذلك یوحی عبر ایجازه بمعان لم
یقلها, لیس كشعر القصید ولا كنثر المقال ولكنه أسلوب ثالث".
وفی تعریف آخر له یقول :" الشعر المنثور یتحرر من الأوزان الموضوعة ولكن
لا, لیجنح الى الفوضى, وانما لیسیر وفق أوزان مختلفة یضعها الشاعر عفو
الساعة ومن نسجه وحده, أوزان تتلاحق فی خاطره ولكن لا تطرد, غیر أنها برغم
تباین وحداتها, تتساوق فی مجموعها وتؤلف من نفسها فی النهایة هارمونیا
واحدة, تلك التی تكون مسیطرة علیه أثناء الكتابة.(63)
لكن أنسی الحاج یفرق بین المصطلحین فیقول:" لكن هذا لا یعنی أن الشعر
المنثور والنثر الشعری هما قصیدة نثر، إلا أنهما- والنثر الشعری الموقع على
وجه الحصر- عنصر أولی فی ما یسمى قصیدة النثر الغنائیة. ففی هذه لا غنى عن
النثر الموقع.(64)
أما البدایة الفعلیة فترجع إلى جماعة مجلة شعر التی تأسست فی بیروت 1957م
بریادة كل من یوسف الخال ، وخلیل حاوی، ونذیر العظمة، وأدونیس ، ثم انضم
إلیها : شوقی أبو شقرا وأنسی الحاج ، ودعمها من خارجها جبرا إبراهیم جبرا و
سلمى الجیوسی (65) ویصرح أنسی الحاج بأنه :
" صاحب أول وثیقة فی قصیدة النثر المكتوبة بالعربیة دیوان (لن) هو الكتاب
الأول المعرف نفسه بقصیدة النثر والمكتوب بهذه الصفة تحدیدا.. والمتبنی
لهذا النوع تبنیا مطلقا.(66)
فماذا قال فی مقدمته التاریخیة تلك ؟
قال: " هل یمكن أن نخرج من النثر قصیدة؟ أجل، فالنظم لیس هو الفرق الحقیقی
بین النثر والشعر. لقد قدمت جمیع التراثات الحیة شعرا عظیما فی النثر، ولا
تزال. وما دام الشعر لا یعرف بالوزن والقافیة، فلیس ما یمنع أن یتألف من
النثر شعر، ومن شعر النثر قصیدة نثر".(67)
تعریف قصیدة النثر:
أوردت الموسوعة العربیة العالمیة تعریفا منصفا لها ، یتضمن أغلب مقولات
أنصارها ، حیث عرفتها بأنها:
" جنس فنی یستكشف ما فی لغة النثر من قیم شعریة ، ویستغلها لخلق مناخ یعبر
عن تجربة ومعاناة، من خلال صور شعریة عریضة تتوافر فیها الشفافیة والكثافة
فی آن واحد ، وتعوض انعدام الوزن التقلیدی فیها بإیقاعات التوازن والاختلاف
والتماثل والتناظر معتمدة على الجملة وتموجاتها الصوتیة بموسیقا صیاغیة تحسُّ
ولا تُقاس".(68)
موقف من التراث:
وبینما كان رواد (الشعر الحر(التفعیلة) معنیین بصلتهم الوثقى بالتراث
الشعری والعروضی العربی فإن من رواد قصیدة النثر من لم یهتم بهذه الصلة ،
بل إن منهم من صرح بالاغتراب عن هذا التراث العربی یقول أنسی الحاج:
"أشعر بالغربة فی المقروء العربی... قراءة العربیة تصیبنی بملل لاحد له،
وما أبحث عنه أجده فی اللغة الفرنسیة؛ لأن الفرنسیة هی لغة (الانتهاك)
بینما العربیة لغة (مقدسات) ".(69)
وهذا تعمیم غیر علمی وشبهة مردودة فاللغة -أیة لغة- قادرة على أن تعبر عن
المقدس وغیرالمقدس .
ومنهم من عد الاهتمام بالبحث عن جذور أو أصل فی التراث خللا كالشاعر قاسم
حداد؛ إذ یقول " ثمة خلل فی الصدور عن إحساس بضرورة تأصیل كل ظاهرة فنیة
لمرجعیة محددة ، كأن تكون الكتابة ، خارج الوزن ، معطى منسوخا عن تجربة -
قصیدة النثر الغربیة ، أو أن یكون لهذه الكتابة أسلاف فی التراث العربی ".
(70)
وفی المقابل حاول نفر منهم تعویض النشأة الأجنبیة لقصیدة النثر اصطلاحا
وتعریفا وشروطا قائمة كلها على نماذج من الأدب الفرنسی، فلجؤوا إلى التراث
العربی القریب ناسبین قصیدة النثر إلى جبران ومصطفى صادق الرافعی، والبعید
مفتشین عن نماذج لابن حزم ، أبی حیان الأندلسی، وابن عربی.
أما على مستوى التنظیر فلجؤوا إلى بعض النصوص التراثیة للاستئناس بها
لقواعد سوزان برنار ، مثل النص الذی أورده عبد القاهر: "حین رجع عبد الرحمن
بن حسّان إلى أبیه حسَّان وهو صبیّ، یبكی ویقول لَسَعَنی طائر، فقال حسان: صِفْهُ یا
بُنیَّ، فقال: كأنه مُلْتَفٌّ فی بُرْدَىْ حِبرَة، وكان لسعَهُ زُنْبُور، فقال حسّان قال ابنِی
الشِّعر وربِّ الكعبة ، أفلا تراه جَعل هذا التشبیه مما یُستدَلُّ به على مقدار قُوّة
الطبعِ، ویُجْعَل عِیاراً فی الفَرْق بین الذهن المستعدّ للشعر وغیر المستعدّ له".(71)
ولیس فی نص الجرجانی دلیل على أن الشعر یكون بغیر وزن؛ لأن تسمیة حسان ما
قاله ابنه شعرًا تسمیة مجازیة توحی بقوة استعداد ابنه للشعر فیما بعد كما هو
واضح من تعلیق عبد القاهر.
ومنهم من تمسك بقول الفارابی إن "القول الشعری قد یكون غیر موزون ". ولم
ینتبهوا أن القول الشعری للفارابی مختلف عن الشعر فالمقصود به الحجة
الشعریة فی اصطلاح الفلاسفة.(72)
موقف من الموسیقا:
یعبر أدونیس عن موقف رواد قصیدة النثر من الموسیقا قائلا:
" الوزن/ القافیة ظاهرة إیقاعیة- تشكیلیة لیست خاصة بالشعر العربی وحده
وإنما هی ظاهرة عامة، فی الشعر الذی كتب ویكتب بلغات أخرى، لكن على تنویم
وتمایز. الزعم إذن، بان هذه الظاهرة خصوصیة نوعیة لا تقوم اللغة الشعریة
العربیة إلا بها، ولا تقوم إلا بدءا منها واستنادا إلیها، إنما هو زعم واهٍ
جدا وباطل".(73)
یبدأ أدونیس بمقدمة سلیمة ، هی أن الوزن والقافیة ظاهر إیقاعیة لیست خاصة
بالشعر العربی وحده ، وهذا صحیح وقد بینه الزمخشری من قبل ، لكنه یقفز إلى
نتیجة خاطئة هی رفض ألا تقوم اللغة الشعریة إلا بها.
فهل وجود الوزن والقافیة فی شعر لغات أخرى ، ینفی أن یكونا عنصرین من عناصر
بناء الشعر العربی.
وكذلك فإن عدم وجودهما فی شعر لغة من اللغات " لیس مما یسلب الشعر كله من
موسیقاه"(74) كما یقول الدكتور أنیس.
بدائل الموسیقا:
بعد أن اتفق أصحاب هذا الاتجاه إهدار عنصر الموسیقا راحوا یبحثون عن بدائل
للتعویض فتوصلوا إلى عمود لقصیدة النثر مستقى من تنظیر برنار ، قائم على
شروط ثلاثة بدون أحدها یستحیل الحدیث عن قصیدة نثر، وكل شرط من هذه الشروط
یستدعی ملازما له على هذا النحو:
1- الإیجاز : الكثافة .
2- التوهج : الإشراق .
3- المجانیة : اللازمنیة.
مبدأ تعویض الموسیقا الغائبة:
وقد أشار أنسی الحاج إلى هذا القانون فقال عن قصیدة النثر إنها :" تستعیض
عن التوقیع بالكیان الواحد المغلق، الرؤیا التی تحمل أو عمق التجربة الفذة،
أی بالإشعاع الذی یرسل من جوانب الدائرة أو المربع الذی تستوی القصیدة
ضمنه، لا من كل جملة على حدة وكل عبارة على حدة أو من التقاء الكلمات
الحلوة الساطعة ببعضها البعض الآخر فقط" . (75)
وهو یشیر هنا إلى مبدأ الاستعاضة او التعویض الذی نقله عن سوزان وتلقاه
نقاد قصیدة النثر.
وقد بلور الدكتور صلاح فضل هذا القانون فقال " إن قصیدة النثر تعتمد الجمع
بین الإجراءات المتناقضة ؟ أی إنها تعتمد أساسا على فكرة التضاد، وتقوم على
قانون التعویض الشعری".(76)
وأنا أرى أن قانون التعویض هذا ملازم لقصیدة النثر وأصحابها فی أكثر من
مستوى بدءًا من المصطلح (قصیدة ) ومرورا بكتابة كلمة شعر على نصوصهم
ودواوینهم ، وإلحاح بعضهم، لا سیما الماغوط ،على الإكثار من مفردات " شعر
وقصیدة" فی نصوصهم.
والذی یعنینی هنا مبدأ التعویض عن عنصر الموسیقا، وأرى أنه قائم على مفارقة
عجیبة .
فالتعویض إنما یكون عما یفقده الإنسان لا بإرادة منه ، فحینئذ یلجأ إلى
تعویض ما خسره ، أما فی حالة قصیدة النثر فإن إهدار الموسیقا متعمد فما
معنى التعویض؟
إن الموسیقا فی الشعر إما أن تكون مهمة ، فلا تستحق الإهدار، أو غیر مهمة ،
فلا تحتاج إلى تعویض.
فهل من المعقول المقبول أن یفقأ إنسان عینیه ثم یقول : سأعوض عن حاسة البصر
بتنشیط حواسی الأُخَر؟!
لكنهم انطلاقا من شعورهم بالحاجة إلى تعویض للموسیقا الغائبة ، راحوا
یبحثون، حتى توصلوا إلى تبنی البدائل التالیة:
أولا: بدیل كمال أبو دیب: "الفجوة: مسافة التوتر":
أما كمال أبو دیب فیعترض على اتخاذ الإیقاع عوضا عن الموسیقا فی قصیدة
النثر فلدیه:
"لا یكون ثمة من كبیر جدوى فی تحدید الشعریة على أساس الظاهرة المفردة
كالوزن أو القافیة أو الإیقاع الداخلی أو الصورة أو الرؤیا أو الانفعال ".(77)
ولذلك یقترح مفهوما جدیدا یسمیه:"الفجوة أو مسافة التوتر وهو مفهوم:" لا
تقتصر فاعلیته على الشعریة بل إنه لأساسی فی التجربة الإنسانیة بأكملها بید
أنه خصیصة ممیزة".
بید أن ما یمیز الشعر هو أن هذه الفجوة تجد تجسدها الطاغی فیه فی بنیة النص
اللغویة بالدرجة الأولى وتكون الممیز الرئیسی لهذه البنیة". ویحاول أن یطبق
هذا المفهوم الذی (لا یقتصر على الشعریة بید أنه خصیصة ممیزة )على نص"فارس
الكلمات الغریبة" لأدونیس" ، حیث:"تبرز مسافة التوتر فی العبارة الواحدة
منذ اللحظة الأولى للنص:
"یُقْبلُ أعزلَ كالْغابة "
ذلك أن یقبل أعزل الخالیة من التوتر نهائیا تخلق ما سأسمیه بنیة توقعات
بعشرات الإمكانیات لكن النص یقدم اختیاره من خارج بنیة التوقعات "كالغابة"
ویفعل بذلك شیئین: یخلق فجوة: مسافة توتر نابعة من ربط العزلة بالغابة،
وفجوة أخرى نابعة من حصر دلالات الغابة اللانهائیة نظریا ، فی دلالة واحدة
تقع هی أیضا خارج بنیة التوقعات المرتبطة بالغابة".(78)
فهل تصلح هذه (الفجوة:مسافة التوتر) أن تكون بدیل الموسیقا الشعریة فی
القصیدة ، وممیز الشعریة فیها ؟
ثانیا : الإیقاع:
تعریف الإیقاع:( RHYTHM)
"الإیقاع أقدم الأنواع الموسیقیة . وهو العنصر الذی ینظم حركة الموسیقا
وتدفقها خلال الزمن."(79)
فالإیقاع جزء من الموسیقا وعنصر من عناصرها.
یقول الدكتور غنیمی هلال:" ویقصد به وحدة النغمة التی تتكرر على نحو ما فی
الكلام أو فی البیت ، أی توالی الحركات والسكنات على نحو منتظم فی فقرتین
أو أكثر من فِقَرِ الكلام، أو فی أبیات القصیدة ، وقد یتوافر الإیقاع فی
النثر، وقد یبلغ درجة یقرب بها كلَّ القرب من الشعر، أما الإیقاع فی الشعر
فتمثله التفعیلة فی البحر العربی ".(80)
لكن أصحاب قصیدة النثر فهموا الإیقاع فهما یتلاءم مع قصیدتهم، یقول الدكتور
النجار:"وهو - توفیق صایغ- إذ یستغنی عن إیقاع الوزن فإنه لا بد یستغنی عنه
بعناصر إیقاعیة أخرى هی ما یطلق علیه الإیقاع الداخلی ، وهو یشیر إلى إیقاع
فی النص باستثناء الوزن والقافیة الرئیسة".(81)
فقسم الإیقاع إیقاعین داخلی ومعنوی:
1- الإیقاع الداخلی:
یقول:"فكان هذا الإیقاع أبرز ما یكون متمثلا فی الحرص على أحرف العلة ، ومن
2- الإیقاع المعنوی
أ ، یقول الدكتور مصلح النجار: ثمة إیقاع یستند أساسا إلى جانب معنوی هو
التضاد اللغوی والتقابلات التی تحتشد فی الأسطر السابقة
العشی – الصباح / جاهلیة – الیقین/ لتعطی – لتأخذی.
وهذا یصنع إیقاعا معنویا ، ینضاف إلى ما یسمى الإیقاع الداخلی أیضا." (82)
وأنت تدرك أن النثر العربی القدیم كان بتلك المحسنات البدیعیة حفیا !
وقد حاول كمال خیر بك أن یحلل قصیدة للماغوط تحلیلا إیقاعیا مكتشفا فیها
"كتلا" إیقاعیة متناسبة بدرجة أو بأخرى، حسب تعبیره ، وهو یرى أن الشاعر
یفكر بإرادة واعیة فی إعطاء نصه مسحة موسیقیة منتظمة . (83)
أما الدكتور صلح فضل فیبشر بشعر آخر یتیح لنا:" أن نكتشف إیقاعا آخر غیر
الذی یكاد یصم آذاننا لشدة ما تعودنا رنینه".(84)
وهو یجد ضالته فی مقطوعة بعنوان " وتراءى له" للشاعر محمد متولی فی مجموعته
الشعریة بعنوان" حدث ذات مرة أن" التی یراها "تمثل نموذجا ناجحا لهذه
الثورة الشعریة فی مصر" وتذكره بما كانت تحدثه الدواوین الانفجاریة الأولى
من تأثیر :
"فی القطار/سیدة حافیة تغنی الآریا الأخیرة لموسیقار مجهول
وفئران تطعم من بطانة مقعدها/ شعراء فی هیئة شحاذین/ یتبادلون الصحف القدیمة
ومهرول یعثر على قدم حبیبته تحت الحقائب/ بینما شخیر الراكب یعلو..
علیك أن تحشو فمه بحذاء ممزق".(85)
ولن یعجز ناقدنا عن أن یلم شتات هذه الأشیاء فی فكرة "التآكل وانتهاء
العالم القدیم" وینتهی إلى حكمة مهمة ،هی:"ضرورة الصمت " كما یبرزها المشهد
الأخیر.
ثم یسألنا الناقد : هل تبشر المقطوعة بانتهاء عصر الغناء الرث والعواطف
الفجة التی لا تستحق سوى السخریة والازدراء والبتر العنیف".
هكذا یرى الناقد ضرورة الصمت ولو بالحذاء، أما الشخیر فهو فی تفسیره "عصر
الغناء الرث" الذی ینبغی أن یضرب بالحذاء
فهل لنا أن نفهم أن المقصود بالحذاء حسب تفسیر الناقد هو البدیل . ألا یرى
فی هذا إهانة للبدیل الذی یبشر به.
لا أظن ، لأن الناقد یتحدث بلغة ثوریة ، بل یدخل إلى البحث عن "شعر آخر
إیقاع آخر" وكأنه یدخل معركة ، إذ یقول:" أثبت عدد مجلة (الناقد) المخصص
لقصیدة النثر أن المخزون الاستراتیجی للشعریة العربیة منها عندنا أوفر مما
یقدره النقاد.. ویبدو أن قصیدة النثر أصبحت رایة الشباب الثائر على الأعراف".
ثم یتحدث عن مشكلة " غیبة الإیقاع الخارجی الظاهر المریح، واختفاء أنساق
التفعیلات العروضیة من فوق سطح النص" ، لیلجأ إلى حل أكثر راحة ألا وهو:
" أن نتوسع فی مفهوم الإیقاع ، ولا نقصره على نوع واحد "، فإذا نحن صنعنا
ذلك : "استطعنا أن نتبین ما تبقیه قصیدة النثر وتنمیه من إیقاعات".
وإذا ناقشنا هذا النقد بموضوعیة – بصرف النظر عن مناقشة قصیدة النثر ذاتها-
اكتشفنا أنه غیر منهجی، إن مثله كمثل من یقول :" لماذا لا تتوسع فی مفهوم
الذهب لیشمل الحدید والنحاس ؟ ألیست جمیعها معادن؟!
ثم یحدثنا الناقد عن " الترجیع الإیقاعی " فلیس ثمة إیقاع بدون ترجیع ،
وإذا كانت القصیدة تنبنی من كِسَرٍ مرصوصة ، ونثار وردی من التفاعیل المبعثرة
، تخلق بنسیجها الصوتی مجالاتها وأصداءها الموسیقیة المبتكرة – تظل جملة
"الموسیقى: خلفیة لا أكثر هی الرباط الذی یشد هیكل البنیة الإیقاعیة للقصیدة".
فهل ینجح هذا النقد فی تعویض الموسیقا المهدرة سلفا؟
أما الشاعر حلمی سالم( فی ندوة عُقدت بحلقة الزیتون الإبداعیة بالقاهرة
لمناقشة دیوان (نقرة إصبع شارك فیها المؤلف) راجع موقع الشاعرة فاطمة ناعوت
على الإنترنت : فیقطع الطریق على هؤلاء الذین یتكلفون البحث عن الإیقاع فی
قصیدة النثر قائلا:
"لقد كنا فیما سبق نردد مثل هذا الكلام حول الإیقاع فی قصیدة النثر، ولكنی
أقول الیوم: وما الذی سیحدث لو لم یكن هناك إیقاع أصلا؟ دعونا من ذلك
ولنتأمل لغة كل شاعر وأبنیته وصوره" .
وبعدُ ، فقد حكى طه حسین( 86) عن جوردان السوقة فی مسرحیة من مسرحیات مولییر
قوله :"یا للعجب إذًا فأنا أتكلم النثر منذ أربعین سنة ، ولا أدری؟"
ویعلق أدیبنا قائلا: " أخشى أیها السادة أن نكون جمیعا كما كان جوردان هذا
نفهم النثر من أنه كل كلام لم یتقید بالنظم والوزن والقافیة"
وأقول : لو قرأ جوردان بعض نماذج قصیدة النثر لقال : "أنا أتكلم قصیدة
النثر منذ أربعین سنة ، ولا أدری!"
أما طه حسین فیقول مستدركا ، ومدركا قیمة النثر:" وأنا إذا قلت النثر فلا
أعنی ذلك النثر الذی یفهمه جوردان ، إنما أقصد النثر الذی یفهمه الأدیب" .
ولإیمان طه حسین جاء نثره بدیعا من غیر حاجة إلى تعویض.
مستقبل قصیدة النثر:
هل لقصیدة النثر مستقبل
من العسیر أن یتنبأ الباحث الدارس لتاریخ الأدب بموت تجربة أدبیة حتى لو
كانت لا تروق له لأسباب موضوعیة أوغیر موضوعیة ؛ فقد علمنا تاریخ الأدب أن
الرفض مهما تكن مبرراته لا یمنع شیوع الشكل الجدید.
وأنت تعرف ما حُكی أن ابن الأعرابی قال، وقد أنشد شعراً لأبی تمام:
إن كان هذا شعراً فما قالته العربُ باطلٌ!
وقد أنصف التاریخ أباتمام دون أن یكون شعر العرب باطلا.
ولنا درس فی موقف العقاد الذی حاول التصدی للشعر الحر(التفعیلة) ، وبقی
الشعر الحر.
ومن الإنصاف أن یتجرع الشاعر الكبیر عبد المعطی حجازی من الكأس ذاتها التی
سقاها للعقاد!
وهل سینصت التاریخ الدبی لصیحة الناقد الكبیر الدكتور القط" :"إذا كان هذا
هو الشعر فأنا منه براء".(87)
وهل سیستمع ناشئة قصیدة النثر إلى تحذیر أدونیس یحذر من " الزیف الذی ینتشر
باسم التجدید. خصوصا أن الكثیر من هذا المزعوم تجدیدا ، یخلو من أیة طاقة
خلاقة ، وتعوزه حتى معرفة أبسط أدوات الشاعر: الكلمة والإیقاع".(88)
أما أنا فأرى – والله أعلم – أن الأشكال الثلاثة (قصیدة البیت ، و قصیدة
التفعیلة ، وقصیدة النثر أوقصیدة الإیقاع) سوف تستمر، وأن الصراع بینها
أیضا سیحتدم لكنی أتمنى أن یكون صراعا إیجابیا ولیس إقصائیا، فها أنت ترى
أن كل محاولات إقصاء الشعر الأول أو الثانی قد باءت بالفشل ، واستمرا رغم
حدة الخلاف بین أنصاریهما فی فترات سابقة .
وأن الشعرالأصیل (ولا أقول القدیم ) (المسمَّى خطأ بالشعر التقلیدی ،
أوالعمودی، أو بشعر الشطرین) والذی وصل إلى آفاق عالیة على ید مبدعین
كالجواهری وأبی ریشة والبردونی ، بما حققوا له من توهج وحیویة ، ما یزال
یواصل تجدده رغم المحافظة على الشكل على أیدی شعراء أخلصوا له ، كالدكتور
عبد اللطیف عبد الحلیم ، والدكتور سعد مصلوح ، وأحمد بخیت، وسمیر فراج ،
والدكتور عبد الرحمن العشماوی، وغیرهم، وسیظل یزدهر على أیدی ناشئة سیدركون
افتقاد محبی الشعر له ، لكنهم سیستمرون فی التجدید مفیدین من إنجازات الشعر
الحر(التفعیلة)، وقصیدة النثر(الإیقاع) معا.
فلیست قصیدة النثر وحدها التی تمتلك المخزون الاستراتیجی (بحسب تعبیر
الدكتور صلاح فضل).
وكما یجب على شعراء البیت، والتفعیلة البعد عن التقلید ، فإننی أرى أن على
حاملی لواء قصیدة النثر الجدد أن یتخلوا عن الشروط التی أراد الشعراء
المؤسسون ونقادهم أن یفرضوها علیها وعلیهم ،() وبعضهم یحاول ذلك كعماد
الغزالی وفاطمة ناعوت ورضا العربی ، حتى لا یظلوا فی انعزال عن أمتهم
وقضایا أمتهم ، وأن یتخلصوا من فكرة القطیعة، لیقللوا من خسائرهم. وأن
یدركوا مدى الخسائر التی تكبدوها بإصرارهم على إهدار الموسیقا الشعریة ،
فخسروا بذلك مكاسب حققتها قصیدة الشعر على مر العصور، منها:
1- الغناء
فإن هذا النفر من الشعراء سیحرم من أن یتغنى بقصائدهم النثریة، بما یمثله
هذا الغناء من ذیوع وانتشار وكسب مساحة جدیدة من المتلقین غیر القراء. وذلك
بسبب افتقارها إلى عنصر الموسیقا رغم تشبثهم بالإیقاع؛ لأن الإیقاع بحسب
تصورهم سیجعل ألحان هذه (النثائر) – إن هی لُحِّنتْ - متشابهة ومكرورة وبعیدة
عن ذوق المستمع العربی، حیث یحتاج إلى مط بعض الحروف لیعوض غیاب الوزن الأصیل.
2- المسرح الشعری
بما یمثله من ثراء فی التعبیر ، وتنوع فی الأداء الموسیقی، والوصول إلى
جمهور خاص.
وأتساءل لو أراد مبدع قصیدة النثر أن یكتب مسرحیة شعریة ماذا سیسمیها ؟
3- الاستشهاد:
فقد اعتاد كثیر من المثقفین حتى غیر المعنیین بالشعر منهم الاستشهاد ببض
الأبیات المأثورة من الشعر الأصیل(البیت) والشعر الحر(التفعیلة) كالاستشهاد
بأبیات الحكمة أو الغزل أو السیاسة مثلا .
فهل یستطیع أصحاب قصیدة النثر أن یصلوا إلى هذا المرتقى؟
هل یتاح لهم أن یسهموا فی بناء الوعی كما أتیح للشعرالأصیل وشعر التفعیلة؟
4- الجمهور المتلقی :
حتى إذا جادل أصحاب اتجاه قصیدة النثر وقالوا لا یعنینا الغناء ولا المسرح
الشعری فإن خسارتَهم الكبرى خسارةُ محبی الشعر الذین انصرفوا عنه انصرافا.
وأحسب أن الخسائر أكثر من هذا وأفدح ، ولكننی أتوقع من كثیر من أصحاب قصیدة
النثر أن یردوا على ذلك بأنهم غیر آبهین لهذه الخسائر، وأنهم زاهدون فی
تحقیق تلك المكاسب، وسیكون شأنهم معها شأن الذی أراد و لم یستطع أن ینال
العنب، فقال:
" إنه حصرم!"
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:54|
صنعةُ الكتابة عند العرب
الكتابة فی اللغة مصدر كتب یكتُبُ كتْباً وكتاباً وكِتابةً ومكْتَبة وكِتبة فهو كاتب ومعناها الجمع، ومنه قیل لجماعة الخَیل كتیبة، ومن ثَمَّ سمِّیَ الخط كتابة لجمع الحروف بعضها إلى بعض. قال ابن الأعرابی: وقد نطلق الكتابة على العلم ومنه قوله تعالى فی سورة الطور/ 41: {أم عنْدَهمُ الغَیْبُ فَهُمْ یكتبُون}. أی یعلمون. وعلى حدِّ ذلك قوله (صلى الله علیه وسلم) فی كتابه لأهل الیمن حین بعث إلیهم معاذاً وغیره "إنی بعثت إلیكم كاتباً". قال ابن الأثیر فی غریب الحدیث:"أراد عالماً سُمِّی بذلك لأنه الغالب على مَنْ كان یعلم الكتابة أن عنده علماً ومعرفة، وكان الكاتب عندهم قلیلاً وفیهم عزیزاً".(1).
*فضل الكتابة:
أعظم شاهد لجلیل قدْرها وأقوى دلیل على رفعة شأنها أن الله تعالى نسب تعلیمها إلى نفسه، واعتدَّه من وافر كرمه وإفضاله فقال فی سورة العلق/4: {إقْرأ وربُّكَ الأكْرَمْ الَّذی عَلَّمَ بالْقَلَمْ عَلَّمَ الإنْسَانَ ما لَمْ یَعْلَمْ}. مع ما یروى أن هذه الآیة والتی قبلها مفتتح الوحی فی قول معظم المفسرین، وأول التنزیل على أشرف نبیّ وأكرم مرسل (صلى الله علیه وسلم)، وفیه دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم. روى سعید عن قتادة قال: "القلم نعمة من الله تعالى عظیمة، لولا ذلك لم یقم دین، ولم یصلح عیش، فدلَّ على كمال كرمه سبحانه بأنه علَّم عباده مالم یعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبَّه على فضل علم الكتابة، لما فیه من المنافع العظیمة، التی لا یحیط بها إلا هو". (2). وفی ذلك من الاهتمام بشأنها ورفعة شأوها مالا خفاء فیه. ولذلك نقل صاحب البیان والتبیین: "القلم أحد اللسانین، كما قالوا: القلم أبقى أثراً واللسان أكثرُ هذراً".(3).
وقد بیَّن الله شرفها بأن وصف بها الحَفَظة الكرام من ملائكته فقال جلَّتْ قدرته فی سورة الانفطار/5: {وإِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِینَ كِرَاماً كاتِبِین}. ولا أعلى رتبةً وأبذخ شرفاً مما وصف الله تعالى به ملائكته ونعت به حَفَظَتَه، ثم زاد ذلك تأكیداً بأن أقسم بالقلم الذی هو آلة الكتابة وما یُسطَّرْ به فقال تقدَّست أسماؤه فی سورة القلم/1: {ن. والقَلَمِ وما یَسْطُرُون. وما أنْتِ بِنعْمَةِ ربِّكَ بِمَجْنُون}. والإقسام لا یقع منه سبحانه إلا بشریف ما أبدع، وكریم ما اخترع: كالشمس والقمر والنجوم ونحوها، إلى غیر ذلك من الآیات الدالة على شرفها ورفعة قدرها. قال سعید ابن العاص: "من لم یكتب فیمینه یُسْرى"، وقال معن بن زائدة: "إذا لم تكتب الید فهی رِجْل". وبالغ مكحول فقال: "لا دِیَّة لیدلا تكتب...". وقال ابن المقفع: "الملوك أحوج إلى الكتّاب من الكتَّاب إلى الملوك"(4).
وأورد القلقشندی(5) رسائل فی المفاخرة بین السیف والقلم، إشارة إلى أن بهما قِوام الملك وترتیب السلطنة، بل ربما فضل القلم على السیف ورجَحَ علیه بضروب من وجوه الترجیح. كما قال أبو الفتح البستی مفضلاً القلم بقسم الله تعالى به:
إن افتخر الأبطالُ یوماً بسیفهم *** وعدُّوه مما یكسِبُ المجدَ والكرم
كفى قلم الكتاب عِزاً ورِفْعةً *** مدى الدهر أنْ الله أقسم بالقلم
وكما قال النوبختی:
كذا قال اللهُ للأقلام مُذْ بُرِیَت *** أنَّ السیوفَ لها مُذْ أرهِفَتْ خدَمُ
وعلى النقیض الآخر أورد الحصری(6) ما قاله أیضاً بعض أنصار السیف: كقول أبی تمَّام:
السَّیفُ أصدقُ إنباءً من الكُتُبِ *** فی حَدِّهِ بَینَ الجِدِّ واللعبِ
والمتنبی:
حتى رَجَعْتُ وأقلامی قوائِلُ لی *** المجدُ للسَّیف لیسَ المجدُ للقَلَمِ
*ما قاله السَّلف عن أمیَّة الرسول:
قد یسأل سائل: إذا كان الأمر كذلك فَلِم كان الرسول الأعظم أمیَّاً؟.. وفی الجواب أشار الأقدمون إلى أن الكتابة حُرِّمت على النبی ردَّاً على الملحدین حیث نسبوه إلى الاقتباس من كتب المتقدمین، كما أخبر تعالى بقوله فی سورة الفرقان/5: {وقالُوا أَسَاطِیْرِ الأوَّلِیْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِیَ تُمْلَى عَلَیْهِ بُكْرَةً وأَصِیْلا}. وأكد ذلك بقوله فی سورة العنكبوت/48: {وما كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ولا تْخُطُّهُ بِیَمِینِكَ إذاً لارتابَ المُبْطِلون}. قال العتبیّ: "الأمِّیَّة فی رسول الله (صلى الله علیه وسلم) فضیلةٌ وفی غیره نقیصةٌ (7). وهی المعجزة الخالدة له لأن الله لم یعلِّمه الكتابة لتمكُّن الإنسان بها من الحیلة فی تألیف الكلام، واستنباط المعانی، فیتوسل الكفَّار إلى أن یقولوا اقتدر بها على ما جاء به. وفی الحدیث الشریف: "أوتیتُ جوامع الكَلِم واخْتُصِرَ لِیَ الكلام اختصاراً".(8).
*فضل العربیة:
قال العرب والمنصفون من الأعاجم أن العربیة تامة الحروف، كاملةُ الألفاظ، إذ لم ینقص عنها شیء من الحروف فیشینَها نُقصانُه، ولم یزد فیها شیء فیعیبها زیادته. وقد خُبِرْتُ هذا عن تجربة؛ فترى العرب قادرین على إخراج مختلف الأصوات والنبرات الأعجمیة، وما ذلك إلا بسبب احتواء العربیة على جمیع مخارج الحروف. ومن خصائصها أنه یوجد فیها من الإیجاز ما لا یوجد فی غیرها من اللغات؛ فمن الإیجاز الواقع فیها أنَّ للضَّرب كلمة واحدة فتوسعوا فیها؛ فقالوا للضرب فی الوجه لَطْم، وفی القفا صَفْع، وفی الرأس إذا أدْمى شَجّ، فكان قولُهم لُطِم أوجز من ضُرِب على وجهه، وكذلك اسم محمد بالعربیة مثلاً فإنه یتألف من أربعة حروف، بینما هو فی الإنكلیزیة وسائر اللغات المتفرعة عن اللاتینیة یتألف من ثمانیة أحرف MUHAMMAD، ذلك أن الحروف الصوتیة والمضاعفة فی العربیة مشكولة وهناك مكتوبة.
ونقل ابن قتیبة فی "عیون الأخبار"(9)، عن ابن شُبْرُمة قوله: "إذا سرَّك أن تعظم فی عین من كنت فی عینیه صغیراً، ویصغُر فی عینیك من كان فی عینیك عظیماً فتعلَّم العربیة، فإنها تجریك على المنطق، وتدنیك من السلطان".
*ذكر ما یحتاج الكاتب إلى معرفته من الأمور الكُلِّیَّة:
قال النویری(10) أن أول ما یبدأ به من ذلك حفظ كتاب الله تعالى، وملازمة درسه، وتدبر معانیه، ویتلو ذلك الاستكثار من حفظ الأحادیث النبویة، وخصوصاً فی السِیَر والمغازی والأحكام، ثم قراءة ما یتفق من كتب النحو، وما یتهیأ من مختصرات اللغة، ویتصل بذلك حفظ خطب البلغاء من الصحابة وغیرهم، ومخاطباتهم ومحاوراتهم ومراجعاتهم ومكاتباتهم. وأیضاً النظر فی أیام العرب ووقائعهم وحروبهم، ثم النظر فی التواریخ ومعرفة أخبار الدول، وحفظ أشعار العرب ومطالعة شروحها واستكشاف غوامضها، والتوفر على ما اختاره العلماء بها منها. وكذلك حفظ جانب جید من شعر المحدَثین، والنظر فی رسائل المتقدمین، وكتب الأمثال، والأحكام السلطانیة. وأما الأمور الخاصة التی تزید معرفتها قدره، ویزین العلم بها نظمَه ونثرَه فإنها من المكملات لهذا الفن. ومن ذلك علم المعانی والبیان والبدیع، ومنها ذَكَر الفصاحة والبلاغة والحقیقة والمجاز.
*ذكر ما یحتاج إلیه الكاتب من الأمور اللغویة:
لا مِریة فی أن اللغة هی "رأسُ مال الكاتب، وأسُّ كلامه، وكنز إنفاقه؛ من حیث أن الألفاظ قوالب للمعانی التی یقع التصرف فیها بالكتابة. وحینئذٍ یحتاج إلى طول الباع فیها، وسعة الخطو، ومعرفة بسائطها؛ من الأسماء والأفعال والحروف، والتصرف فی وجوه دلالتها الظاهرة والخفیة، لیقتدر بذلك على استعمالها فی محالَّها ووضعها فی مواضعها اللائقة بها، ویجد السبیل إلى التوسع فی العبارة عن الصور القائمة فی نفسه، فیتسع علیه نطاق النطق، وینفسح له المجال فی العبارة، وینفتح له باب الأوصاف فیما یحتاج إلى وصفه، وتدعو الضرورة إلى نعته؛ فیستظهر على ما ینشیه، ویحیط علماً بما یذره ویأتیه".(11).
ولا یخفى أن الكاتب یحتاج فی كماله إلى معرفة لغة الكتب التی یطالعها فی مجال تخصصه، وهذا قد یعنی الإلمام بلغة أو أكثر من اللغات الأعجمیة. وقد روى محمد بن عمر المدائنی فی "كتاب القلم والدواة"، بسنده إلى زید بن ثابت (رضی الله عنه)، قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وسلم): "إنه یرِدُ علیَّ أشیاء من كلام السریانیة لا أحسنُها فتعلَّمْ كلامَ السریانیة فتعلَّمتُها فی ستة عَشَرَ یوماً"(12). من هنا اهتم العرب بتعلم اللغات الأعجمیة، ووضعوا شرائط للترجمان كالتی أوردها الجاحظ: "وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضیق، والعلماءُ به أقلَّ، كان أشد على المترجم، وأجدرَ أن یخطئ فیه. ولن تجد البتة مترجماً یفی بواحد من هؤلاء العلماء". (13).
*ذكر ما یحتاج إلیه الكاتب من المعرفة بالنحو:
أجمع العرب على أن النحو هو قانونُ العربیة، ومیزانُ تقویمها، وهو لها ـ كما قیل ـ كالملح فی الطعام، ونقل القلقشندی عن صاحب "المثل السائر": "وهو أوَّلُ ما ینبغی إثبات معرفته؛ على أنه لیس مختصاً بهذا العلم خاصة بل بكل علم؛ لا بل ینبغی معرفته لكل أحد ینطق باللسان العربی لیأمن معرَّة اللحن. ومن كلام مالك بن أنس: "الأعراب حَلْیُ اللسان فلا تمنعوا ألسنَتَكُم حُلِیَّها". ولله درُّ أبی سعید البصری حیث یقول:
النَّحْوُ یبسُطُ من لِسانِ الألْكَنِ *** والمرْءُ تُكْرِمُهُ إذا لم یَلْحَنِ
وإذا طَلَبْتَ من العُلومِ أَجَلَّها *** فأجلُّها عندی مُقِیمُ الألْسُنِ
وقد رُوی أن أعرابیاً قرأ الآیة 28 من سورة فاطر هكذا: {إِنَّما یَخْشَى اللهُ من عِبادِهِ العُلماء}. برفع الأول ونصب الثانی، فوقع فی الكفر، بنقل فتحة إلى ضمَّة وضمَّة إلى فتحة، فقیل له: یا هذا إن الله تعالى لا یخشى أحداً! فتنبه لذلك وتفطن له"(14). ولذا قال مَسْلَمَةُ بن عبد الملك: "اللحن فی الكلام أَقْبَح من الجدری فی الوجه(15)، قال القلقشندی:"واعلم أن اللحن قد فَشَا فی الناس، والألسنة قد تغیرت حتى صار التكلم بالإعراب عیباً، والنطق بالكلام الفصیح عِیَّاً... ووقف بعض الخلفاء على كتاب لبعض عماله فیه لَحْنٌ، فی لفظه، فكتب إلى عامله: قَنِّعْ كاتبَك هذا سوطاً معاقبةً على لحنه، قال أحمد بن یحیى: كان هذا مقدار أهل العلم، وبحسبه كانت الرغبةُ فی طلبه والحِذْرِ من الزلل... فكیف لو أبصر بعضَ كُتَّابِ زماننا هذا؟ قد قال ذلك فی زمانِهِ هو وفی الناس بعض الرمق، والعلم ظاهر وأهلُهُ مكْرَمون، وإلا فلو عَمَرَ إلى زماننا نحن [بل فما بالك بزماننا نحن!">. لقال [تِلْكَ أُمَّةٌ قدْ خَلَتْ">"(16)، ولكان لسان حاله كما قال الشاعر:
تعس الزمان! فقد أتى بعُجابٍ *** ومَحا فُنُون الفضلِ والآدابِ
وأتى بِكُتَّابِ لو انبسطتْ یَدی *** فِیهم ردَدتُهُمْ إلى الكُتَّابِ
*ذكر ما یحتاج إلیه الكاتب من الأمور العلمیة:
لعل أحسن ما قیل فی هذا الباب ما أورده ابن قتیبة عن كتابه النفیس: "أدب الكاتب".(17)، من أنه لیس لمن لم یتعلق من الإنسانیة إلا بالجسم، ولا من الكتابة إلا بالاسم، ولم یتقدم من الأداة إلا بالقلم والدواة: ولكنه لمن شَدا شیئاً من الإعراب فعرف الصَّدْرَ والمصدر، والحال والظرف، وشیئاً من التصاریف والأبنیة، وانقلابَ الیاء عن الواو، والألف عن الیاء، وأشباه ذلك. ولابد له من النظر فی الأشكال لِمساحة الأرضین، حتى یعرفَ المثلث القائم الزاویة، والمثلث الحادّ، والمثلث المنفرج، ومساقط الأحجار، والمربعات المختلفات، والقِسیّ والمدوَّرات، والعمودَیْن، ویمتَحن معرفته بالعمل فی الأرضین لا فی الدفاتر، فإنَّ المُخبَر عنه لیس كالمُعاین". وكانت العجم تقول: من لم یكن عالماً بإجراء المیاه، وحفر فُرَضِ المشارب ورَدْمِ المَهاوی ومجاری الأیام فی الزیادة والنقص، ودوران الشمس، ومطالع النجوم، وحال القمر فی استهلاكه واتصاله، ووزن الموازین، وذَرْع المثلث والمربع والمختلف الزوایا، ونصْبِ القناطر، والجسور، والدَّوالی، والنواعیر على المیاه، وحال أدوات الصنَّاع، ودقائق الحساب، كان ناقصاً فی حال كتابته. ولابدَّ له من النظر فی جمل الفقه ومعرفة أصوله... والحدیث... ودراسة أخبار الناس، وتحفُّظ عیون الحدیث لیُدْخِلَها فی تضاعیف سطوره متمثلاً بها إذا كَتب ویصل بها كلامه إذا حاور". ثم خفَّفَ على الكتَّاب بعد ذلك قائلاً: "ومدار الأمر على القُطْب، وهو العقل وجودة القریحة، فإن القلیل معهما بإذن الله تعالى كافٍ، والكثیر مع غیرهما مقصِّر"، وختم ذلك بالقول: "ونستحبُّ له أن یُنَزِّلَ ألفاظَه فی كتُبِه فیجعلها على قَدْرِ الكاتب والمكتوب إلیه، وألا یعطی خسیسَ الناس ریعَ الكلام، ولا رفیع الناس خسیسَ الكلام".
وتابعه الوزیر ضیاء الدین بن الأثیر فی "المثل السائر"، وأبو هلال العسكری فی بعض ذلك. قال الأخیر فی بعض أبواب كتابه: "الصناعتین". (18). "ینبغی أن تعلم أن الكتابة تحتاج إلى آلاتٍ كثیرة، وأدوات جمَّة: من معرفة العربیة لتصحیح الألفاظ وإصابة المعنى؛ وإلى الحساب وعلم المساحة والمعرفة بالأزمنة والشهور والأهلَّة وغیر ذلك مما لیس هذا موضع ذكره وشرحه"، وخالف أبو جعفر النحاس فی كثیر من ذلك فذكر فی أول كتابه "صناعة الكتابة" فی المرتبة الثانیة منه بعدما یتعلق بالخط: أن من أدوات الكتابة البلاغة، ومعرفة الأضداد مما یقع فی الكسب والرسائل والعلم بترتیب مما یقع بترتیب أعمال الدواوین، والخبرة بمجاری العمال، والدُّرْبة بوجوه استخراج الأموال مما یجب ویمتنع. ثم قال فهذه الآلات لیس لواحد منها بذاته، ولا انفراد باسم یخصُّه، وإنما هو جزء من الكتابة وأصل من أركانها، أما الفقه والفرائض والعلم بالنحو واللغة وصناعة الحساب والمساحة والنجوم، والمعرفة بإجراء المیاه، والعلم بالأنساب فكل واحد منها منفرد على حدته، وإن كان الكاتب یحتاج إلى أشیاء منها نحو ما یُكْتبُ بالألف والیاء، وإلى شیء من المقصور والممدود". وزاد القلقشندی على ذلك: "والتحقیق أن ذلك یختلف باختلاف حال الكتابة بحسب تنوُّعها؛ فكل نوع من أنواعه یحتاج إلى معرفة فن أو فنون تختصُّ به.... فلیس احتیاجه إلى ذلك على حدٍّ واحد: بل منها ما یحتاج إلیه بطریق الذات، وهی مواد الإنشاء التی یستمد منها ویقتبس من مقاصدها... ومنها ما یحتاج إلیه بطریق العَرض كالطبِّ والهندسة والهیئة ونحوها من العلوم... لینظم ذلك فی خلال كلامه فیما یكتب به من متعلَّقات كل فن من هذه الفنون كالألفاظ الدائرة بین أهل الطب ومشاهیر أهله وكتبه فیما یكتب به لرئیس الطب، ونحو ذلك من الهیئة فیما یكتب به لمنجِّم، ونحوه من الهندسة فیما یكتب به لمهندس".(19).
*المنهج العلمی فی الكتابة عند العرب وما قالوه فی البلاغة والفصاحة والإیجاز:
تكلم رجل عند النبی (صلى الله علیه وسلم) فقال له النبی (صلى الله علیه وسلم): "كم دون لسانك من حِجاب؟". قال: شفتای وأسنانی. فقال له: "إن الله یكرهُ الانبِعاق فی الكلام [الاندفاع فیه بلا توقف">، فَنَضَّرَ اللهُ وجْهَ رجلٍ أوجز فی كلامِهِ، واقتصر على حاجتهِ"، وسُئِلَ النبیُّ (صلى الله علیه وسلم): فیم الجمال؟ فقال:"فی اللسان" یرید البیان. وقال أیضاً: "إنَّ من البیان لسحرا".(20).
قال العاملی فی "أسرار البلاغة"(21): "البلاغة تختص بالمعانی، والفصاحة تختص بالألفاظ، والإیجاز یختص بهما. قال عبد الحمید الكاتب، وكان وزیر مروان بن محمد آخر خلفاء بنی أمیة، وبه یضرب المثل فی الكتابة والبلاغة: البلاغة ما فَهِمَتْهُ العامة، ورضیته الخاصة... وقیل لابن المقفع: ما البلاغة؟.. فقال: التی إذا سمعها الجاهل ظن أنه یحسن مثلَها. وسُمِّیَت بلاغة لأن المتكلم یبلغ بها الكثیر من الغرض فی القلیل من المعانی. والفصاحة: حدُّها التخلُّصُ من التعقید والتنافر وضعف التألیف، لأنه یُقال: لفظ فصیح، ومعنى بلیغ، والإیجاز: هو تقلیل اللفظ، وتكثیر المعنى. وهو على قسمین: إیجاز قَصَر، وإیجاز حذف. فإیجاز القصر: هو التعبیر عن المعنى بأقل ما یمكن من الألفاظ، كقوله تعالى فی سورة الحجر/ 94 مخاطباً لنبیه محمد (صلى الله علیه وسلم) : {فاصْدَعْ بِما تُؤْمَرْ}. فهذه ثلاث كلمات اشتملت على جمیع معانی الرسالة... وإیجاز الحذف: هو الاستغناء بالمذكور عما لم یُذْكَر، مثل قوله تعالى فی سورة یوسف/ 82: {واسْألِ القَرْیَة الَّتی كُنَّا فِیها}. والمراد أهل القریة".
أقول ویصعب الإحاطة بما قاله العرب فی هذا الباب، وإنما أسوق فیما یلی غیضاً من فیض. قال صاحب "العقد الفرید".(22): "أشرفُ الكلام كلّه حسناً، وأرفعه قَدْراً، وأعظمه من القلوب موقعاً، وأقلُّه على اللسان عملاً، ما دلَّ بعضُهُ على كلِّه، وكفى قلیلُهُ عن كثیرِهِ، وشهد ظاهرهُ على باطنه، وذلك أن تقلَّ حروفُهُ، وتكثر معانیه، ومنه قولهم: ربَّ إشارة أبلغُ من لفظ". وقیل فی تعریف البلاغة أیضاً أن یبلغ الرجل بعبارته كَنْهَ ما فی نفسه. ولا یسمى البلیغ بلیغاً إلا إذا جمع المعنى الكثیر فی اللفظ القلیل، وهو المسمى إیجازاً... ولا یسمى الفصیح فصیحاً حتى تخلُص لغته عن اللكنة الأعجمیة". وقال الجاحظ فی "البیان والتبیین".(23): "وأحسن الكلام ماكان قلیله یغنیك عن كثیره، ومعناه فی ظاهر لفظه.... فإذا كان صحیح الطبع، بعیداً عن الاستكراه، ومنزّهَاً عن الاختلال مصوناً عن التكلُّف صنع فی القلوب صنیع الغیث فی التربة الكریمة". وزاد فی مكان آخر: "إیَّاكَ والتتبُّع لوحشیِّ الكلام طمعاً فی نیل البلاغة، فإن ذلك هو العیُّ الأكبر".
ونقل صاحب "العمدة" (24) عن ابن المقفع قوله فی البلاغة أیضاً أنها "اسم لمعانٍ تجری فی وجوه كثیرة؛ فمنها ما یكون فی السكوت، ومنها ما یكون فی الاستماع، ومنها ما یكون جواباً... فعامَّة هذه الأبواب الوحی فیها والإشارة إلى المعنى والإیجاز هو البلاغة. فانظر كیف جعل ابن المقفع من المسكوت بلاغة، رغبةً فی الإیجاز". ومثل ذلك ما قاله المبرِّد فی "الكامل"(25): خیر الكلام ما أغنى اختصاره عن إكثاره".
أما أصحاب "دائرة المعارف الإسلامیة"، فقالوا إن البلاغة هی "جودة الكلام... فنقول بلاغة الكلمة وبلاغة الكلام، كما نستطیع أن نقول بلاغة الألفاظ وبلاغة المعانی، أی جودة كل ذلك".(26).
*ذكر ما یحتاج إلیه الكاتب من التواضع:
استحب ابن قتیبة للكاتب "أن یؤدب نفسه قبل أن یؤدب لسانه، ویهذِّب أخلاقَه قبل أن یهذِّب ألفاظه، ویصون مروءته عن دناءة الغیبة وصناعته عن شَینِ الكذبِ".
كما استهجن العرب استخدام ضمائر المتكلم، وخاصة فی صیغة الجمع وما شابهها، ونوَّهوا بضرورة أن یخلو أسلوب الكاتب من مظاهر الفخر والمبالغة والاعتداد بالنفس، لأن "نحن لا یكتب بها عن نفسه إلا آمرٌ وناه، لأنها من كلام الملوك والعظماء. قال تعالى فی سورة الحجر/9: {إنَّا نحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ}. وقال أیضاً فی سورة القمر/49: {إنَّا كُلَّ شیءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ}. وعلى هذا الابتداء خوطبوا فی الجواب؛ فقال تعالى فی سورة المؤمنون/99 حكایة عمَّن حضره الموت: {ربِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحَاً}، ولم یقل: ربِّ ارجعنِ(27)". أقول ولا یدخل فی ذلك ضمیر المتكلم فی حالة المفرد، "إذا أراد الرجل أن یعرِّف بنفسه، أو أن یمدح نفسه بالحق إذا جُهل أمره، وكان فی ذلك فائدة".(28). كما فعل سیدنا یوسف (علیه السلام) أمام الملك كما أخبر القرآن فی سورة یوسف/55: {قال اجعلنی على خزائن الأرض إنی حفیظ علیم}. كما أن حقیقة قصور علم الإنسان وحواسه المحدودة تملی على الكاتب أن یتأدب كما قال تعالى فی سورة الإسراء/85: {وما أوتیتم من العِلْمِ إلاَّ قلیلا}، وأن یتواضع كما فی الحدیث الشریف: [من قال إنی عالم فهو جاهل">، وأَنْ یتحلى بمكارم الأخلاق كما قال الشاعر:
ملأى السنابل تنحنی بتواضعٍ *** والفارغاتُ رؤوسهنَّ شوامخُ
أو كما قال عبد الله بن المعتز: "متواضع العلماء أكثرهم علماً، كما أن المكان المنخفض أكثر الأماكن ماءً".(30)، لذا فقد تبع المؤلفون العرب فی كتاباتهم منذ القرن الثالث الهجری مبدأ الاعتذار، حتى غدا قاعدة یرتكز علیها الكتَّاب مهما عظم مقامهم، ورقیَت بحوثهم. فانظر إلى تواضع ابن الأثیر مثلاً وهو یقول فی مقدمة كتابه "المثل السائر": ولا أدعی فیما ألَّفْتَهُ من ذلك فضیلة الإحسان، ولا السلامة من سبق اللسان. فإن الفاضل من تعدُّ سقطاته، وتُحصى غلطاتُهُ". وهذا لعمری یدل على تواضع ذلك العالم النِّحریر أكثر مما یشیر إلى وجود أغالیط فی كتابه.
*خاتمة:
ونختم الحدیث بضرورة أن یقوم الكاتب بمراجعة ما خطَّه یراعه، من وقت إلى آخر، لتنقیح ما سوَّد، وتهذیب ما كتب، تأمَّل مقدار الدقة والحذر الذی وصله الجاحظ عندما قال: "وینبغی لمن كتب كتاباً ألاَّ یكتبه إلا على أن الناس كلهم له أعداء، وكلهم عالم بالأمور، وكلهم متفرِّغ له... فإذا سكنت الطبیعة، وهدأت الحركة، وتراجعت الأخلاط، وعادت النفس وافرة، أعاد النظر فیه. فیتوقف عند فصوله توقف من یكون طمعه فی السلامة أنقص من وزن خوفه من العیب".(31).
*الحواشی:
(1) ـ صبح الأعشى فی صناعة الإنشا للقلقشندی، أحمد (821 ـ 1418هـ)، نسخة مصورة عن الطبعة الأمیریة 1: 51.
(2) ـ الجامع لأحكام القرآن لأبی عبد الله القرطبی، دار الفكر، بیروت، لبنان 20 ـ 120.
(3) ـ البیان والتبیین للجاحظ، عمرو (150 ـ 255 هـ)، حققه عبد السلام محمد هارون، دار الجیل ودار الفكر، بیروت، لبنان 1: 79.
(4) ـ صبح الأعشى 1: 37ـ 43.
(5) ـ المرجع السابق: 1: 45.
(6) ـ زهر الآداب وثمر الألباب للحصری، إبراهیم (؟ ـ 453هـ)، حققه وشرحه د.زكی مبارك، دار الجیل، بیروت، لبنان: 2: 480 ـ 481.
(7) ـ صبح الأعشى: 1: 44.
(8) ـ أسرار البلاغة للعاملی، بهاء الدین (953 ـ 1031 هـ). مطبوع على هامش المخلاة. دار المعرفة. بیروت. لبنان: 316.
(9) ـ عیون الأخبار لابن قتیبة، عبد الله (213 ـ 276 هـ)، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 2: 157.
(10) ـ نهایة الإرب فی فنون الأدب للنویری، شهاب الدین أحمد (677 ـ 733). نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 7: 27 ـ 35.
(11) ـ صبح الأعشى: 1: 150.
(12) ـ المرجع السابق: 1: 165.
(13) ـ الحیوان للجاحظ. طبعة دار إحیاء التراث العربی المصورة عن الطبعة المصریة التی حققها عبد السلام محمد هارون 1: 77.
(14) ـ صبح الأعشى 1: 170 ـ 173.
(15) ـ عیون الأخبار 2 : 158.
(16) ـ صبح الأعشى: 1: 170.
(17) ـ أدب الكاتب لابن قتیبة. حققه محمد الدالی. مؤسسة الرسالة: 12 ـ 18.
(18) ـ الصناعتین لأبی هلال العسكری. طبع الأستانة : 7.
(19) ـ صبح الأعشى 1: 141 ـ 146.
(20) ـ العمدة لابن رشیق، 1: 417 . 429.
(21) ـ أسرار البلاغة: 316.
(22) ـ العقد الفرید للأندلسی، أحمد بن محمد بن عبد ربه 4: 155.
(23) ـ البیان والتبیین 1: 83.
(24) ـ العمدة لابن رشیق 1: 420.
(25) ـ الكامل للمبرد، محمد بن یزید. (210 ـ 285)، مؤسسة الرسالة. بیروت، لبنان 2: 884.
(26) ـ دائرة المعارف الإسلامیة، طبع كتاب الشعب 7: 529، مادة (بلاغة).
(27) ـ أدب الكاتب : 14.
(28) ـ كتاب التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزی، محمد بن أحمد (؟ ـ 292 هـ)، دار الفكر، بیروت، لبنان 1: 122.
(29) ـ التاج الجامع للأصول فی أحادیث الرسول لناصیف، منصور علی، دار الكتب العلمیة. بیروت، لبنان 1: 74.
(30) ـ نهایة الإرب 3: 245.
(31) ـ الحیوان 1: 88.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:53|
تطور النثر العربی
[*النثر لغة:*]
یقول صاحب اللسان: «النثر نَثرُكَ الشیءَ بیدك ترمی به متفرقا مثل نثر الجوز واللوز والسکر وکذلك نثر الحبّ إذا بُذر»1 فالمعنی اللغوی یعنی الشیء المبعثر (المتفرق) الذی لایقوم علی أساس فی تفرقه وبعثرته، أی: لا یقوم علی أساس من حیث الکیف والکم والاتساع.
[*النثر اصطلاحاً:*]
هو الکلام الذی لیس فیه الوزن ویعتمد علی الحقائق. بتعبیر آخر: النثر هو کلام المقفی بالأسجاع.
النثر أدب إنسانی، «وهو علی ضربین: أما الضرب الأول فهو النثر العادی الذی یقال فی لغة التخاطب، ولیست لهذا الضرب قیمة أدبیة إلا ما یجری فیه أحیانا من أمثال وحکم، وأما الضرب الثانی فهو النثر الذی یرتفع فیه أصحابه إلی لغة فیها فن ومهارة وبلاغة، وهذا الضرب هو الذی یعنی النقاد فی اللغات المختلفة ببحثه ودرسه وبیان ما مر به من أحداث وأطوار، ومایمتاز به فی کل طور من صفات وخصائص، وهو یتفرع إلی جدولین کبیرین، هما الخطابة والکتابة الفنیة ـ ویسمیها بعض الباحثین باسم النثر الفنی ـ وهی تشمل القصص المکتوب کما تشمل الرسائل الأدبیة المحبرة، وقد تتسع فتشمل الکتابة التاریخیة المنمقة».2
[*نشأة النثر الفنی:*]
یجد الباحث عنتا کبیرا حینما یحاول تحدید الوقت الذی نشأ فیه النثر الفنی فی اللغة العربیة. إذ أن الباحثین الذین تصدوا لدراسة الأدب الجاهلی قد اضطربوا فی تقدیر الوجود الأدبی لعرب الجاهلیة وبخاصة فیها یتعلق بالنثر، ولم یستطیعوا علی الرغم من جهودهم ودراساتهم أن یصلوا فی ذلك الموضوع إلی نتیجة ثابتة أو رأی موحد یمکن الاطمئنان إلیه.أما هذه الآثار النثریة المختلفة التی تنسب إلی الجاهلیین، فیکاد مؤرخو الأدب یتفقون علی عدم صحة شیء منها، والسبب فی عدم الثقة بهذه النصوص هو أن وسائل التدوین لم تکن میسرة فی العصر الجاهلی.
[*الآراء حول نشأة النثر الفنی فی العصر الجاهلی:*]
یؤکد الدکتور زکی مبارك أنه قد کان للعرب فی الجاهلیة نثر فنی له خصائصه وقیمته الأدبیة، وأن الجاهلیین لابد وأن یکونوا قد بلغوا فی ذلك المضمار شأوا بعیدا لایقل عما وصل إلیه الفرس والیونان فی ذلك الوقت، بل أنهم فی إنتاجهم الأدبی فی النثر لم یکونوا متأثرین تأثراً کبیرا بدولة أخری مجاورة أو غیر مجاورة، وإنما کانت لهم فی کثیر من الأحیان أصالتهم وذاتیتهم واستقلالهم الأدبی الذی تقتضیه بیئتهم المستقلة، وحیاتهم التی کانت أقرب إلی الانعزال. وإذا کانت الظروف المختلفة لم تساعد علی بقاء هذا التراث من النثر الجاهلی، فلیس معنی ذلك أن نهدره ونحکم بعدم وجوده، وإنما یجب أن نلتمسه فی مصادر أخری. ونحن إن فعلنا هذا فسوف نجد بین أیدینا حجة لاتنکر، ودلیلا لا یجحد علی أن ثمة نثرا جاهلیا، ألا وهو القرآن الکریم. فإذا کنا نؤمن بأن هذا القرآن قد نزل لهدایة هؤلاء الجاهلیین، وإرشادهم، وتنظیم حیاتهم فی نواحیها المختلفة من دینیة، وأخلاقیة، وسیاسیة، واجتماعیة، واقتصادیة، وأنه کان یخاطبهم وهم بطبیعة الحال لایخاطبون إلا بأسلوب الذی یفهمونه ویتذوقونه، وأنه کان یتحداهم فی محاکاته، والإتیان بسورة من مثله ولا یسوغ فی العقل أن یکون هذا التحدی إلا لقوم قد بلغوا درجة ما من بلاغة القول، وفصاحة اللسان تجعلهم أهلا لهذا التحدی حتی یصدق معناه، إذا کان هذا کله، وأن القرآن الکریم قد نزل بلغة العرب وعلی لسان واحد منهم ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم﴾ تأکد لنا أن العرب الجاهلیین قد عرفوا النثر الفنی، وأن القرآن یمکن أن یعطینا صورة ـ ولو تقریبیة ـ عن شکل هذا النثر، ومنهجه، وحالته التی کان علیها.3
[** وکذلك یعتقد الدکتور محمد عبدالمنعم خفاجی بوجود النثر الفنی فی الجاهلیة.4*]
ویری الدکتور طه حسین بأن النشر الفنی بمعنی أنه تعبیر جمیل رصین محکم یستدعی الرؤیة والتفکیر والإعداد، لایتصور أن یکون موجودا فی العصر الجاهلی؛ إذ أن هذا اللون من النثر إنما یلائم نوعا من الحیاة لم یکن قد تهیأ للعرب إذ ذاك. فهذه الحیاة الأولیة الفطریة السهلة التی کان یحیاها العرب قبل الإسلام لم تکن تسمح بقیام هذا اللون من الکتابة الفنیة التی تستدعی بطبیعتها الرؤیة، والتفکیر، ووجود جماعة إنسانیة منظمة تسودها أوضاع سیاسیة واجتماعیة معقدة. وهذا النثر المنسوب إلی الجاهلیین لیس إلا شیئا منحولا مدسوسا علیهم. حیث إنه علی هذا النحو الذی روی به لایکاد یمثل الحیاة الجاهلیة تمثیلا کاملا. فهذه الخطب، والوصایا، والسجع، والکلام الذی ینسب لقس بن ساعدة، وأکثم بن صیفی، وغیرهما یکفی أن ننظر إلیه نظرة واحدة لنرده بأجمعه إلی العصور الإسلامیة التی انتحلت فیها کل هذه الأشیاء؛ لنفس الأسباب التی انتحل الشعر من أجلها وأضیف إلی الجاهلیین.5
ویتحدث شوقی ضیف عن نشأة النثر الفنی فی الأدب العربی بقوله «نحن لانغلو هذا الغلو الذی جعل بعض المعاصرین یذهب إلی أن العرب عرفوا الکتابة الفنیة أو النثر الفنی منذ العصر الجاهلی، فما تحت أیدینا من وثائق ونصوص حسیة لا یؤید ذلك إلا إذا اعتمدنا علی الفرض والظن، والحق أن ما تحت أیدینا من النصوص الوثیقة یجعلنا نقف فی مرحلة وسطی بین الرأیین، فلا نتأخر بنشأة الکتابة الفنیة عند العرب إلی العصر الجاهلی، بل نضعها فی مکانها الصحیح الذی تؤیده المستندات والوثائق، وهو العصر الإسلامی».6
[*النثر فی العصر الإسلامی:*]
النثر الفنی فی عهد النبوة، لم یکد یختلف اختلافا جوهریا عن النثر الجاهلی. «دخل النثر العربی فی طور جدید بظهور الإسلام، بعد أن تعرضت الحیاة الأدبیة لانقلاب شامل وتطور بعید المدی. ولم یکن ثمة بد من أن یتأثر الأدب بالحیاة الجدیدة وأن یکون صدی لأحداثها واتجاهاتها. وکانت مظاهر التطور فی النثر أوضح منها فی الشعر، لأن الشعر فن تقلیدی یترسم فیه الشاعر خطا سابقیه، ویلتزم أصولا محددة، ولذلك یکون أبطأ من النثر استجابة لدواعی التطور».7
أما أغراض النثر ومعانیه، فإنها بلا شك قد تغیرت تغیرا محسوسا بظهور الإسلام، و «تلوّن النثر فی هذا العهد بجمیع ألوان الحیاة الجدیدة فکان خطابة، وکتابة، ورسائل وعهودا، وقصصا، ومناظرات، وتوقیعات، وکان علی کل حال أدبا مطبوعا. وامتاز النثر فی هذا العهد بالإیجاز علی سنة الطبیعة العربیة الأصیلة».8
[*النثر فی العصر الأموی:*]
کانت الکتابة ضرورة إداریة ملحة لا غنی عنها فی إدارة شؤون الدولة والمجتمع، فی المکاتبات والدواوین المختلفة. کما کانت ضرورة اجتماعیة لا غنی عنها فی المعاملات. وکانت کذلك ضرورة علمیة لا غنی عنها فی الحرکة العلمیة التی ازدهرت فی العصر الأموی وتعاظمت فی أواخره. ونتیجة لذلك کله توسع انتشار الخط واستعمال الکتابة، إبان ذلك العصر، توسعا عظیما، نظراً لإقبال الناس علی طلبه.
یقول الدکتور شوقی ضیف: «أن الکتابة نمت فی العصر الأموی نموا واسعا، فقد عرف العرب فکرة الکتاب وأنه صحف یجمع بعضها إلی بعض فی موضوع من الموضوعات، وقد ألفوا فعلا کتبا کثیرة».9
وقد کانت لمن یعرف الکتابة مکانة رفیعة عند الناس، إذ کانوا یعرفون له قدرة، وکان سعید بن العاص یردد دائماً قوله: «من لم یکتب فیمینه یسری».10
لعل من أهم الأسباب التی هیأت لرقی الکتابة الفنیة فی هذا العصر تعریب الدواوین فی البلاد المختلفة11، وتعقد الحیاة السیاسیة، وکثرة الأحزاب والمذاهب.12
«وقد تجلت بواکیر الکتابة فی أواخر العصر الأموی بفضل موهبة عبدالحمید بن یحیی الکاتب».13 ولقد أجمع النقاد والمؤرخون فی القدیم والحدیث علی أن عبدالحمید إمام طور جدید فی الکتابة العربیة، وأنه هو الذی وضع الأساس لهذا المنهج الکتابی الذی اقتفاه الکتاب من بعده، وهو «أبلغ کتاب الدواوین فی العصر الأموی وأشهرهم، وقد ضربت ببلاغته الأمثال»14، و«کان عبدالحمید أول من فتق أکمام البلاغة وسهل طرقها وفك رقاب الشعر».15
وقال ابن الندیم: «عنه أخذ المترسلون ولطریقته لزموا، وهو الذی سهل سبیل البلاغة فی الترسل».16
إذن لقد تواترت آراء المؤرخین والأدباء منذ القرن الثالث الهجری علی أن الرجل ذو مکانة ملحوظة فی تاریخ النثر العربی، وأنه ذو أثر عمیق فی تطور الکتابة الفنیة، وأنه قد سن طریقة جدیدة سار علی نهجها من جاء بعده من الکتاب.
[*النثر فی العصر العباسی:*]
زخر العصر العباسی بالأحداث التاریخیة، والتقلبات السیاسیة، کما زخر بالتطورات الاجتماعیة التی نقلت العرب من حال إلی حال، وقد کان لکل هذا، فضلا عن نضج العقول بالثقافة، أثر واضح فی تطویر الأدب بعامة، والکتابة بصفة خاصة. لقد تقدمت الکتابة الفنیة فی هذا العصر تقدما محسوسا؛ وسارت شوطا بعیدا فی سبیل القوة والعمق والاتساع.
و«أصبح النثر العربی فی العصر العباسی متعدد الفروع، فهناك النثر العلمی والنثر الفلسفی والنثر التاریخی، والنثر الأدبی الخالص، وکان فی بعض صوره امتدادا للقدیم؛ وکان فی بعضها الآخر مبتکرا لا عهد للعرب به».17
وکان تشجیع الخلفاء والوزراء والرؤساء للأدب وللکتاب باعثا علی النهوض بالکتابة، داعیا إلی ارتفاع شأنها، وسمو منزلتها، ثم کان التنافس القوی بین الأدباء وتسابقهم إلی خدمة الخلفاء والرؤساء حافزا علی تجویدها والتأنق فی أسالیبها.18
«إن الکتابة کانت جواز عبور إلی الوزارة وبعض الوظائف المرموقة فی مرافق الدولة لذلك کان علی الراغبین فی الوصول إلی هذه المناصب العلیا إتقان صناعة الکتابة حتی یحققوا أهدافهم التی کانوا یطمحون إلیها».19
والأغراض التی عبر عنها النثر الفنی فی هذا العصر قد اختلفت و«بعد أن کان النثر الأموی خطابته وکتابته منصرفا بوجه عام إلی أغراض سیاسیة وحزبیة، ولم یتجه إلی الأغراض الأخری إلا فی صورة ضئیلة، فانه فی العصر العباسی قد اتجه إلی کثیر من الأغراض والموضوعات الشخصیة والاجتماعیة والانسانیة؛ کالمدح والهجاء والرثاء والاعتذار والتهنئة والتعزیة والاستعطاف، والوصف والنسیب والفکاهة والنصح».20
ونستطیع القول بأن النثر خطا خطوة واسعة؛ فهو لم یتطور من حیث موضوعاته وأغراضه فقط؛ بل إن معانیه قد اتسعت وأفکاره قد عمقت، وأخیلته قد شحذت؛ لأن مشاهد الحیاة ومقوماتها العامة قد تغیرت.
[*مظاهر نهضة النثر فی العصر العباسی:*]
1ـ تنوع فنونه وأغراضه: فقد تناول کل مجالات الحیاة واستخدمته الدولة فی الشؤون السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة.
2ـ وصول الکتاب إلی المناصب الوزاریة.
3ـ أنه أصبح وعاء لثقافات جدیدة، کانت نتیجة لامتزاج الفکر العربی بأفکار الأمم الأخری.
4ـ رقی الأفکار وعمق المعانی.
5ـ التفنن فی أسالیبه وظهور مدارس متنوعة.21
[*أسباب نهضة النثر فی العصر العباسی:*]
1ـ استقرار الأمور فی الدولة واتساع العمران، وما یتبع ذلك من رخاء.
2ـ النضج العقلی وظهور آثار التقدم الفکری فی الدولة.
3ـ ظهور أجیال جدیدة من المثقفین من أبناء الأمم المستعربة الذین جمعوا إلی الثقافة العربیة الأصیلة فنونا جدیدة من ثقافات آبائهم الفرس، الهنود و الیونان.
4ـ تشجیع الخلفاء والأمراء للکتاب وإغداق الأموال علیهم.
5ـ وصول الکتاب إلی المناصب الکبیرة جعل الکتابة مطمح کل راغب فی الجاه والسلطان.
6ـ التنافس بین الکتاب فی سبیل الإجادة الفنیة.
7ـ کثرة المذاهب الکلامیة وحاجة کل مذهب إلی التأیید وشرح مبادئه.22
[*النثر الحدیث:*]
«فی النصف الأول من القرن التاسع عشر، کان النثر فی هذه الفترة رکیك الأسلوب یعتمد علی المحسنات البدیعیة، مسیطرا علیه طریقة القاضی الفاضل علی أسالیب کتاب عصره و نهج نهجه، فبدت علی أسالیب هؤلاء مظاهر التکلف فأسرفوا فی المحاکاة وأوغلوا فی الصنعة، وتعمد تصید الألفاظ والأسالیب ذات البریق واللمعان».23
فی بدایات النثر الأدبی الحدیث «کانت القرائح حبیسة الأغراض الضیقة والمعانی التافهة، وقلّما کانت تتجاوز الرسائل الاخوانیة، من تهنئة بمولود، أو تعزیة بفقید، أو معاتبة لصدیق، وقلّما تعدی موضوع النثر هذه الحدود الضیقة لیلامس اهتمام الناس ویعالج شؤون المجتمع».24
«انطلق الفکر الحدیث ناشطا و راح یرود آفاقا أرحب تتصل بالواقع وبالمجتمع، نتیجة انتشار أنوار النهضة فی أرجاء المشرق العربی. وبدأت الأسالیب تتحرر فی بعض جوانبها من قیود التصنع اللفظی. غیر أن فئة من الناثرین ظلت علی تعلقها بالعبارات المنمقة، وراحت تجد فیها نمطا أدبیا متمیزا لا یحسن التفریط به. ومن هذا المنطلق ساغ للشیخ ناصیف الیازجی خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر فن المقامات؛ فدأب علی إحیائه، وجهد فی النسج علی منواله... وفی الوقت نفسه کان ثمة ناثرون رواد ومؤلفون کبار أخذوا یراوحون بین النثر المقید والنثر المرسل، ترفدهم فی الحالین موهبة فذة، وفی مقدمة هؤلاء أحمد فارس الشدیاق، أحد أرکان النهضة الفکریة، ورائد الصحافة الأدبیة».25
ویمکن القول بأن اتصال الشرق العربی بالغرب ظل قاصرا فی أول الأمر علی النواحی العلمیة والفنیة التطبیقیة. أما النواحی الأدبیة فظل فیها الاتصال معدوما. وطبیعی ألا تنهض اللغة وتظل علی عهودها السابقة جامدة راکدة مثقلة بالسجع والمحسنات البدیعیة».26
واشتد احتکاك الشرق العربی بالغرب فی منتصف القرن التاسع عشر و «أرسلت طائفة من الشباب المصری إلی أوربا وعلی رأسها رفاعة الطهطاوی «الذی تعلم فی الأزهر وتخرج فیه، و رافق البعثة الکبری الأولی لمحمد علی إماما لها. ولم یکتف بعمله، بل أقبل علی تعلم اللغة الفرنسیة، حتی أتقنها. وفی أثناء إقامته بباریس أخذ یصف الحیاة الفرنسیة من جمیع نواحیها المادیة والاجتماعیة والسیاسیة فی کتابه «تخلیص الإبریز فی تلخیص باریز». وعاد إلی مصر فاشتغل بالترجمة وعیِّن مدیرا لمدرسة الألسن، وأخذ یترجم مع تلامیذه آثارا مختلفة من اللغة الفرنسیة. وکان ذلك بدء النهضة الأدبیة المصریة، ولکنه کان بدعا مضطربا، فإن رفاعة وتلامیذه لم یتحرروا من السجع والبدیع، بل ظلوا یکتبون بهما المعانی الأدبیة الأوربیة. ومن الغریب أنهم کانوا یقرءونها فی لغة سهلة یسیرة، ثم ینقلونها إلی هذه اللغة الصعبة العسیرة المملوءة بضروب التکلف الشدید، فتصبح شیئا مبهما لایکاد یفهم إلا بمشقة».27
«هناك ظاهرة جدیرة بالتسجیل تتعلق بالأدب فی تلك الحقبة، وهی الالتفات من بعض الکتاب إلی موضوع الوطن والوطنیة، بالمفهوم الحدیث تقریبا؛ فقد کان الوطن من قبل ذائبا فی جملة العالم الإسلامی أو دولة الخلافة، ولیس له دلالة خاصة، وبالتالی لیس هناك کتابات تدور حوله وتتغنی به. أما الآن ومع کتابات رفاعة الطهطاوی بصفة خاصة، فنحن نجد فکرة الوطن تبرز، والتغنی به یبدأ، حتی لیمکن أن یعتبر ما کان من ذلك حجر الأساس فی الأدب المصری القومی فی العصر الحدیث. وهکذا نری أن رفاعة الطهطاوی یعتبر واضع بذور التجدید فی الأدب المصری الحدیث، فأدبه یمثل دور الانتقال من النماذج المتحجرة التی تحمل غالباً عفن العصر الترکی إلی النماذج المجددة التی تحمل نسمات العصر الحدیث».28
«وکان لازدهار النثر الفنی عوامل کثیرة من بینها: العنایة بدراسة اللغة العربیة وآدابها فی الأزهر والمدارس والمعاهد والجامعات، وإحیاء مصادر الأدب العربی القدیم وطبع أحسن مؤلفات الأدباء المعاصرین، وظهور المجلات الأدبیة، وعنایة الصحف الیومیة بالأدب، وإنشاء دارالکتب المصریة، وکثرة ما ترجم من آداب الغرب إلی العربیة، وتعدد الثورات الشعبیة، التی احتاجت للخطابة، وقیام الصحف مما دعا إلی نهضة الکتابة».29
تطور النثر بعد الحرب العالمیة الأولی، وظهر الاتجاه الأدبی الذی یدعو أصحابه إلی الأسلوب الفصیح الرصین الجزل، حتی یکون لأدبهم موقع حسن فی الأسماع والقلوب، فهم یحرصون علی الإعراب وعلی الألفاظ الصحیحة. وکانوا فی إطار تجدید، لا یخرجون عن أصول العربیة، ویقوم هذا الاتجاه علی التحول والتطور فی اللغة العربیة علی نحوما تحولت وتطورت الآداب الأوربیة، دون قطع صلتها بالقدیم، ومن أصحابه فی مصر، طه حسین، هیکل والعقاد. وهذه النزعة المجددة کانت إحیاء للقدیم وبعثا وتنمیة فی صور جدیدة، ویعتمد علی عنصرین متکافئین وهما المحافظة علی إحیاء القدیم والإفادة من الآداب الغربیة.30
وقد ظهرت، فی أواخر القرن التاسع عشر، أربع طوائف فی النثر وهی: طائفة الأزهریین المحافظین، وطائفة المجددین المعتدلین الذین یریدون أن یعبرو بالعربیة دون استخدام سجع وبدیع، وطائفة المفرطین فی التجدید الذین یدعون إلی استخدام اللغة العامیة، ثم طائفة الشامیین، التی کانت فی صف الطائفة الثانیة، واشتدت المعارك بین الطائفة الأولی والطوائف الأخری، حتی انتصرت طائفة المجددین المعتدلین، فعدل الکتاب إلی التعبیر بعبارة عربیة صحیحة لا تعتمد علی زینة من سجع وبدیع، بل یعتمد علی المعانی ودقتها.31
وکان محمد عبده علی رأس طائفة المجددین المعتدلین. وهو الذی أخرج الکتابة الصحفیة من دائرة السجع والبدیع إلی دائرة الأسلوب الحر السلیم. وکوّن لنفسه أسلوبا قویا جزلا، ومرّنه علی تحمل المعانی السیاسیة والاجتماعیة الجدیدة والأفکار العالیة، ومعنی ذلك أنه طور النثر العربی من حیث الشکل والموضوع.32
ثم جاء تلمیذه لطفی المنفلوطی فقطع بهذا النثر شوطا کبیرا بکتبه ومقالاته، فأنشأ أسلوبا نقیا خالصا لیس فیه شیء من العامیة ولا من أسالیب السجع الملتویة إلا ما یأتی عفواً، ولم یقلد فی ذلك کاتبا قدیما مثل ابن المقفع والجاحظ بل حاول أن یکون له أسلوبه الخاص، فأصبح النثر متحررا من کل أشکال قیود السجع والبدیع، وبذا یعد المنفطوطی رائد النثر الحدیث.
وکانت الشهرة التی حظی بها المنفلوطی، تعزی إلی أسلوبه أکثر مما تعزی إلی مضمون مقالاته. وهو أدرك الحاجة إلی تغییر أسالیب اللغة العربیة، وکثیرا ما عبّر عن اعتقاده بأنّ سرّ الأسلوب کامن فی تصویر الکاتب تصویرا صادقا لما یدور فی عقله من أفکار.33
[*دور الصحافة والطباعة فی تطور النثر:*]
کانت للصحافة تأثیر کبیر فی حرکة التطور. ولئن کانت فی المرحلة الأولی وسیلة السلطة فحسب، فقد غدت، فیما بعد، محرضا وباعثا علی النهضة والتطور. وقد کانت تضم مقالات أدبیة أو اجتماعیة أو علمیة، یفید منها القراء. وأول من فکر فی إنشاء صحیفة، نابلیون، الذی أمر بإصدار ثلاث صحف، اثنتین بالفرنسیة وواحدة بالعربیة. ثم أنشأ محمد علی باشا جریدة رسمیة باسم السلطة.
وللسوریین واللبنانیین سهم کبیر فی إصدار عدد ضخم من الصحف والمجلات کالأهرام والمقتطف والمقطم والهلال.34
وکانت الصحافة هی التی عادت بالکتابة الأدبیة إلی أصالتها من حیث کونها خلصتها من التصنع والزخرف ورجعت بها إلی الوضوح ودقة التعبیر وطوعتها من جدید للتعبیر السمح عن خطرات التفکیر ومشاعر الوجدان.35
«ففی حقل الصحافة استطاعت الصحف الاسلامیة والوطنیة أن تصل إلی طبقات کاملة من القراء».36
وازدهار الصحافة کان نتیجة نمو الحرکات السیاسیة والاصلاحیة واستعلاء الوعی القومی من ناحیة والوعی الدینی من ناحیة أخری. فأصبحت الصحف منابر لتلك الحرکات والمنظمات التی تمثل مختلف الدعوات والمواقف الایدیولوجیة. وکان القصد عند هؤلاء وأولئك التأثیر فی الرأی العام والتعبیر عن قضایاه. وبذلك یکون ظهور فن المقالة نتیجة من نتائج هذه العوامل کلها، من ظهور الصحافة، وظهور الرأی العام، وظهور الحرکات السیاسیة والاصلاحیة. فعاد الأدب إلی الحیاة مرة أخری یعبر عن قضایاه ومنازعها.
«وقد کان لمحمد عبده أثر کبیر فی نهضة الصحافة فی أواخر القرن التاسع عشر، وهو الذی تولی العمل فی الوقائع المصریة».37
وکان للطباعة أیضاً أثر کبیر فی تطور النثر و «ما کان للنهضة أن تحدث لولا الطباعة، فهی وسیلة النشر الأولی، فی عصر یتسم بالتطور السریع، والحاجة إلی الکتاب والصحیفة والمجلة».38
«کان لازدیاد المطابع، والرغبة الأکیدة فی طلب المعرفة أن زادت حرکة إحیاء التراث العربی، فطبعت أمهات الکتب العربیة: الأغانی لأبی الفرج الاصبهانی، و العقد الفرید لابن عبد ربه الأندلسی ...».39
وفی البلاد العربیة کان السبق للبنان فی استعمال المطبعة.40
[*موضوعات النثر فی عصر النهضة:*]
کانت موضوعات النثر واسعة الأفق، و تناولت مشکلات الحیاة وما یهم الشعوب وما یبعث علی الیقظة والنهضة ممثلة فی:
1ـ الدفاع عن الشعوب المظلومة.
2ـ الدعوة إلی الأخذ بنظام الشوری فی الحکم.
3ـ محاربة الاستعمار، وإثارة الحمیة الوطنیة فی نفوس الشعوب المستذلة.
4ـ السعی فی إصلاح المفاسد الاجتماعیة.41
خصاص النثر فی عصر النهضة:
1ـ سلامة العبارة وسهولتها، مع المحافظة علی سلامة اللغة وخلوها من الوهن والضعف.
2ـ تجنب الألفاظ المهجورة والعبارات المسجوعة، إلا ما یأتی عفواً ولایثقل علی السمع.
3ـ تقصیر العبارة وتجریدها من التنمیق والحشو حتی یکون النثر علی قدر المعنی.
4ـ ترتیب الموضوع ترتیبا منطقیا فی حلقات متناسقة، وتقسیم المواضیع إلی فصول وأبواب وفقرات بحیث لایضیع القارئ، ویفهم تناسق الأجزاء ویتبع تسلسلها بسهولة.42
[*أغراض النثر فی عصر النهضة:*]
1ـ النثر الإجتماعی الذی یتطلب صحة العبارة، والبعد عن الزخرف والزینة، ووضوح الجمل، وترك المبالغات، وسلامة الحجج وإجراءها علی حکم المنطق الصحیح، لأن الغرض منه معالجة الأمر الواقع، فلا ینبغی استعمال الأقیسة الشعریة، ولا الخیال المجنح.
2ـ النثر السیاسی أو الصحفی، ویمتاز بالسهولة والوضوح بحیث یکون معناه فی ظاهر لفظه؛ لأن الصحف تخاطب الجماهیر، ویقرؤها الخاصة والعامة.
3ـ النثر الأدبی، وهو أشد أنواع النثر حاجة إلی تخیر اللفظ، والتأنق فی النظم، حتی یخرج الکلام مشرقا منیرا، لطیف الموقع فی النفوس، حلو النبرة فی الآذان، لأن للموسیقی اللفظیة أثرا کبیرا فی الأذهان. وهو أدنی أنواع النثر إلی الشعر.43
من مجموع ما مضی «یمکن أن نطلق علی الأدب العربی فی القرن التاسع عشر عصر الأدب الاتباعی الکلاسیکی، إلا أن الإتباعیة فیه کانت ذات ثلاثة مستویات معرفیة: الأول، یعتمد فی نثره الأسالیب الراقیة الفنیة فی العصور العربیة الزاهیة، والثانی، کان امتدادا لعصور الانحطاط التی بدأت قبل سقوط بغداد فیما یخص التطور النثری فاکتسب طابعها، اغراق فی المحسنات البدیعیة... وثالث مازج بینهما فکان فی نثره یجمع بین کلا الطابعین الأدبیین».44
[*خاتمة البحث:*]
تبین لنا من خلال هذا البحث أن نشأة النثر العربی فی العصر الجاهلی کانت غامضة؛ وکان حظ النثر من الحفظ أقل من حظ الشعر. وفی العصر الإسلامی کانت مظاهر التطور فی النثر أوضح منها فی الشعر ؛ وأغراض النثر ومعانیه قد تغیرت تغیرا محسوسا بظهور الإسلام. وکانت الکتابة ضرورة علمیة لا غنی عنها فی الحرکة العلمیة التی ازدهرت فی العصر الأموی وتعاظمت فی أواخره؛ ونتیجة لذلك توسع انتشار الخط واستعمال الکتابة، إبان ذلك العصر، توسعا عظیما، نظراً لإقبال الناس علی طلبه. وفی العصرالعباسی خطا النثر خطوة واسعة، فهو لم یتطور من حیث موضوعاته وأغراضه فقط؛ بل إن معانیه قد اتسعت وأفکاره قد عمقت، وأخیلته قد شحذت؛ لأن مشاهد الحیاة ومقوماتها العامة قد تغیرت. وفی العصر الحدیث خرج النثر من عهد الانحطاط، وبدأت الأسالیب تتحرر فی بعض جوانبها من قیود التصنع اللفظی؛ وکان للطباعة و الصحافة أثر کبیر فی تطور النثر.
یقول صاحب اللسان: «النثر نَثرُكَ الشیءَ بیدك ترمی به متفرقا مثل نثر الجوز واللوز والسکر وکذلك نثر الحبّ إذا بُذر»1 فالمعنی اللغوی یعنی الشیء المبعثر (المتفرق) الذی لایقوم علی أساس فی تفرقه وبعثرته، أی: لا یقوم علی أساس من حیث الکیف والکم والاتساع.
[*النثر اصطلاحاً:*]
هو الکلام الذی لیس فیه الوزن ویعتمد علی الحقائق. بتعبیر آخر: النثر هو کلام المقفی بالأسجاع.
النثر أدب إنسانی، «وهو علی ضربین: أما الضرب الأول فهو النثر العادی الذی یقال فی لغة التخاطب، ولیست لهذا الضرب قیمة أدبیة إلا ما یجری فیه أحیانا من أمثال وحکم، وأما الضرب الثانی فهو النثر الذی یرتفع فیه أصحابه إلی لغة فیها فن ومهارة وبلاغة، وهذا الضرب هو الذی یعنی النقاد فی اللغات المختلفة ببحثه ودرسه وبیان ما مر به من أحداث وأطوار، ومایمتاز به فی کل طور من صفات وخصائص، وهو یتفرع إلی جدولین کبیرین، هما الخطابة والکتابة الفنیة ـ ویسمیها بعض الباحثین باسم النثر الفنی ـ وهی تشمل القصص المکتوب کما تشمل الرسائل الأدبیة المحبرة، وقد تتسع فتشمل الکتابة التاریخیة المنمقة».2
[*نشأة النثر الفنی:*]
یجد الباحث عنتا کبیرا حینما یحاول تحدید الوقت الذی نشأ فیه النثر الفنی فی اللغة العربیة. إذ أن الباحثین الذین تصدوا لدراسة الأدب الجاهلی قد اضطربوا فی تقدیر الوجود الأدبی لعرب الجاهلیة وبخاصة فیها یتعلق بالنثر، ولم یستطیعوا علی الرغم من جهودهم ودراساتهم أن یصلوا فی ذلك الموضوع إلی نتیجة ثابتة أو رأی موحد یمکن الاطمئنان إلیه.أما هذه الآثار النثریة المختلفة التی تنسب إلی الجاهلیین، فیکاد مؤرخو الأدب یتفقون علی عدم صحة شیء منها، والسبب فی عدم الثقة بهذه النصوص هو أن وسائل التدوین لم تکن میسرة فی العصر الجاهلی.
[*الآراء حول نشأة النثر الفنی فی العصر الجاهلی:*]
یؤکد الدکتور زکی مبارك أنه قد کان للعرب فی الجاهلیة نثر فنی له خصائصه وقیمته الأدبیة، وأن الجاهلیین لابد وأن یکونوا قد بلغوا فی ذلك المضمار شأوا بعیدا لایقل عما وصل إلیه الفرس والیونان فی ذلك الوقت، بل أنهم فی إنتاجهم الأدبی فی النثر لم یکونوا متأثرین تأثراً کبیرا بدولة أخری مجاورة أو غیر مجاورة، وإنما کانت لهم فی کثیر من الأحیان أصالتهم وذاتیتهم واستقلالهم الأدبی الذی تقتضیه بیئتهم المستقلة، وحیاتهم التی کانت أقرب إلی الانعزال. وإذا کانت الظروف المختلفة لم تساعد علی بقاء هذا التراث من النثر الجاهلی، فلیس معنی ذلك أن نهدره ونحکم بعدم وجوده، وإنما یجب أن نلتمسه فی مصادر أخری. ونحن إن فعلنا هذا فسوف نجد بین أیدینا حجة لاتنکر، ودلیلا لا یجحد علی أن ثمة نثرا جاهلیا، ألا وهو القرآن الکریم. فإذا کنا نؤمن بأن هذا القرآن قد نزل لهدایة هؤلاء الجاهلیین، وإرشادهم، وتنظیم حیاتهم فی نواحیها المختلفة من دینیة، وأخلاقیة، وسیاسیة، واجتماعیة، واقتصادیة، وأنه کان یخاطبهم وهم بطبیعة الحال لایخاطبون إلا بأسلوب الذی یفهمونه ویتذوقونه، وأنه کان یتحداهم فی محاکاته، والإتیان بسورة من مثله ولا یسوغ فی العقل أن یکون هذا التحدی إلا لقوم قد بلغوا درجة ما من بلاغة القول، وفصاحة اللسان تجعلهم أهلا لهذا التحدی حتی یصدق معناه، إذا کان هذا کله، وأن القرآن الکریم قد نزل بلغة العرب وعلی لسان واحد منهم ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم﴾ تأکد لنا أن العرب الجاهلیین قد عرفوا النثر الفنی، وأن القرآن یمکن أن یعطینا صورة ـ ولو تقریبیة ـ عن شکل هذا النثر، ومنهجه، وحالته التی کان علیها.3
[** وکذلك یعتقد الدکتور محمد عبدالمنعم خفاجی بوجود النثر الفنی فی الجاهلیة.4*]
ویری الدکتور طه حسین بأن النشر الفنی بمعنی أنه تعبیر جمیل رصین محکم یستدعی الرؤیة والتفکیر والإعداد، لایتصور أن یکون موجودا فی العصر الجاهلی؛ إذ أن هذا اللون من النثر إنما یلائم نوعا من الحیاة لم یکن قد تهیأ للعرب إذ ذاك. فهذه الحیاة الأولیة الفطریة السهلة التی کان یحیاها العرب قبل الإسلام لم تکن تسمح بقیام هذا اللون من الکتابة الفنیة التی تستدعی بطبیعتها الرؤیة، والتفکیر، ووجود جماعة إنسانیة منظمة تسودها أوضاع سیاسیة واجتماعیة معقدة. وهذا النثر المنسوب إلی الجاهلیین لیس إلا شیئا منحولا مدسوسا علیهم. حیث إنه علی هذا النحو الذی روی به لایکاد یمثل الحیاة الجاهلیة تمثیلا کاملا. فهذه الخطب، والوصایا، والسجع، والکلام الذی ینسب لقس بن ساعدة، وأکثم بن صیفی، وغیرهما یکفی أن ننظر إلیه نظرة واحدة لنرده بأجمعه إلی العصور الإسلامیة التی انتحلت فیها کل هذه الأشیاء؛ لنفس الأسباب التی انتحل الشعر من أجلها وأضیف إلی الجاهلیین.5
ویتحدث شوقی ضیف عن نشأة النثر الفنی فی الأدب العربی بقوله «نحن لانغلو هذا الغلو الذی جعل بعض المعاصرین یذهب إلی أن العرب عرفوا الکتابة الفنیة أو النثر الفنی منذ العصر الجاهلی، فما تحت أیدینا من وثائق ونصوص حسیة لا یؤید ذلك إلا إذا اعتمدنا علی الفرض والظن، والحق أن ما تحت أیدینا من النصوص الوثیقة یجعلنا نقف فی مرحلة وسطی بین الرأیین، فلا نتأخر بنشأة الکتابة الفنیة عند العرب إلی العصر الجاهلی، بل نضعها فی مکانها الصحیح الذی تؤیده المستندات والوثائق، وهو العصر الإسلامی».6
[*النثر فی العصر الإسلامی:*]
النثر الفنی فی عهد النبوة، لم یکد یختلف اختلافا جوهریا عن النثر الجاهلی. «دخل النثر العربی فی طور جدید بظهور الإسلام، بعد أن تعرضت الحیاة الأدبیة لانقلاب شامل وتطور بعید المدی. ولم یکن ثمة بد من أن یتأثر الأدب بالحیاة الجدیدة وأن یکون صدی لأحداثها واتجاهاتها. وکانت مظاهر التطور فی النثر أوضح منها فی الشعر، لأن الشعر فن تقلیدی یترسم فیه الشاعر خطا سابقیه، ویلتزم أصولا محددة، ولذلك یکون أبطأ من النثر استجابة لدواعی التطور».7
أما أغراض النثر ومعانیه، فإنها بلا شك قد تغیرت تغیرا محسوسا بظهور الإسلام، و «تلوّن النثر فی هذا العهد بجمیع ألوان الحیاة الجدیدة فکان خطابة، وکتابة، ورسائل وعهودا، وقصصا، ومناظرات، وتوقیعات، وکان علی کل حال أدبا مطبوعا. وامتاز النثر فی هذا العهد بالإیجاز علی سنة الطبیعة العربیة الأصیلة».8
[*النثر فی العصر الأموی:*]
کانت الکتابة ضرورة إداریة ملحة لا غنی عنها فی إدارة شؤون الدولة والمجتمع، فی المکاتبات والدواوین المختلفة. کما کانت ضرورة اجتماعیة لا غنی عنها فی المعاملات. وکانت کذلك ضرورة علمیة لا غنی عنها فی الحرکة العلمیة التی ازدهرت فی العصر الأموی وتعاظمت فی أواخره. ونتیجة لذلك کله توسع انتشار الخط واستعمال الکتابة، إبان ذلك العصر، توسعا عظیما، نظراً لإقبال الناس علی طلبه.
یقول الدکتور شوقی ضیف: «أن الکتابة نمت فی العصر الأموی نموا واسعا، فقد عرف العرب فکرة الکتاب وأنه صحف یجمع بعضها إلی بعض فی موضوع من الموضوعات، وقد ألفوا فعلا کتبا کثیرة».9
وقد کانت لمن یعرف الکتابة مکانة رفیعة عند الناس، إذ کانوا یعرفون له قدرة، وکان سعید بن العاص یردد دائماً قوله: «من لم یکتب فیمینه یسری».10
لعل من أهم الأسباب التی هیأت لرقی الکتابة الفنیة فی هذا العصر تعریب الدواوین فی البلاد المختلفة11، وتعقد الحیاة السیاسیة، وکثرة الأحزاب والمذاهب.12
«وقد تجلت بواکیر الکتابة فی أواخر العصر الأموی بفضل موهبة عبدالحمید بن یحیی الکاتب».13 ولقد أجمع النقاد والمؤرخون فی القدیم والحدیث علی أن عبدالحمید إمام طور جدید فی الکتابة العربیة، وأنه هو الذی وضع الأساس لهذا المنهج الکتابی الذی اقتفاه الکتاب من بعده، وهو «أبلغ کتاب الدواوین فی العصر الأموی وأشهرهم، وقد ضربت ببلاغته الأمثال»14، و«کان عبدالحمید أول من فتق أکمام البلاغة وسهل طرقها وفك رقاب الشعر».15
وقال ابن الندیم: «عنه أخذ المترسلون ولطریقته لزموا، وهو الذی سهل سبیل البلاغة فی الترسل».16
إذن لقد تواترت آراء المؤرخین والأدباء منذ القرن الثالث الهجری علی أن الرجل ذو مکانة ملحوظة فی تاریخ النثر العربی، وأنه ذو أثر عمیق فی تطور الکتابة الفنیة، وأنه قد سن طریقة جدیدة سار علی نهجها من جاء بعده من الکتاب.
[*النثر فی العصر العباسی:*]
زخر العصر العباسی بالأحداث التاریخیة، والتقلبات السیاسیة، کما زخر بالتطورات الاجتماعیة التی نقلت العرب من حال إلی حال، وقد کان لکل هذا، فضلا عن نضج العقول بالثقافة، أثر واضح فی تطویر الأدب بعامة، والکتابة بصفة خاصة. لقد تقدمت الکتابة الفنیة فی هذا العصر تقدما محسوسا؛ وسارت شوطا بعیدا فی سبیل القوة والعمق والاتساع.
و«أصبح النثر العربی فی العصر العباسی متعدد الفروع، فهناك النثر العلمی والنثر الفلسفی والنثر التاریخی، والنثر الأدبی الخالص، وکان فی بعض صوره امتدادا للقدیم؛ وکان فی بعضها الآخر مبتکرا لا عهد للعرب به».17
وکان تشجیع الخلفاء والوزراء والرؤساء للأدب وللکتاب باعثا علی النهوض بالکتابة، داعیا إلی ارتفاع شأنها، وسمو منزلتها، ثم کان التنافس القوی بین الأدباء وتسابقهم إلی خدمة الخلفاء والرؤساء حافزا علی تجویدها والتأنق فی أسالیبها.18
«إن الکتابة کانت جواز عبور إلی الوزارة وبعض الوظائف المرموقة فی مرافق الدولة لذلك کان علی الراغبین فی الوصول إلی هذه المناصب العلیا إتقان صناعة الکتابة حتی یحققوا أهدافهم التی کانوا یطمحون إلیها».19
والأغراض التی عبر عنها النثر الفنی فی هذا العصر قد اختلفت و«بعد أن کان النثر الأموی خطابته وکتابته منصرفا بوجه عام إلی أغراض سیاسیة وحزبیة، ولم یتجه إلی الأغراض الأخری إلا فی صورة ضئیلة، فانه فی العصر العباسی قد اتجه إلی کثیر من الأغراض والموضوعات الشخصیة والاجتماعیة والانسانیة؛ کالمدح والهجاء والرثاء والاعتذار والتهنئة والتعزیة والاستعطاف، والوصف والنسیب والفکاهة والنصح».20
ونستطیع القول بأن النثر خطا خطوة واسعة؛ فهو لم یتطور من حیث موضوعاته وأغراضه فقط؛ بل إن معانیه قد اتسعت وأفکاره قد عمقت، وأخیلته قد شحذت؛ لأن مشاهد الحیاة ومقوماتها العامة قد تغیرت.
[*مظاهر نهضة النثر فی العصر العباسی:*]
1ـ تنوع فنونه وأغراضه: فقد تناول کل مجالات الحیاة واستخدمته الدولة فی الشؤون السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة.
2ـ وصول الکتاب إلی المناصب الوزاریة.
3ـ أنه أصبح وعاء لثقافات جدیدة، کانت نتیجة لامتزاج الفکر العربی بأفکار الأمم الأخری.
4ـ رقی الأفکار وعمق المعانی.
5ـ التفنن فی أسالیبه وظهور مدارس متنوعة.21
[*أسباب نهضة النثر فی العصر العباسی:*]
1ـ استقرار الأمور فی الدولة واتساع العمران، وما یتبع ذلك من رخاء.
2ـ النضج العقلی وظهور آثار التقدم الفکری فی الدولة.
3ـ ظهور أجیال جدیدة من المثقفین من أبناء الأمم المستعربة الذین جمعوا إلی الثقافة العربیة الأصیلة فنونا جدیدة من ثقافات آبائهم الفرس، الهنود و الیونان.
4ـ تشجیع الخلفاء والأمراء للکتاب وإغداق الأموال علیهم.
5ـ وصول الکتاب إلی المناصب الکبیرة جعل الکتابة مطمح کل راغب فی الجاه والسلطان.
6ـ التنافس بین الکتاب فی سبیل الإجادة الفنیة.
7ـ کثرة المذاهب الکلامیة وحاجة کل مذهب إلی التأیید وشرح مبادئه.22
[*النثر الحدیث:*]
«فی النصف الأول من القرن التاسع عشر، کان النثر فی هذه الفترة رکیك الأسلوب یعتمد علی المحسنات البدیعیة، مسیطرا علیه طریقة القاضی الفاضل علی أسالیب کتاب عصره و نهج نهجه، فبدت علی أسالیب هؤلاء مظاهر التکلف فأسرفوا فی المحاکاة وأوغلوا فی الصنعة، وتعمد تصید الألفاظ والأسالیب ذات البریق واللمعان».23
فی بدایات النثر الأدبی الحدیث «کانت القرائح حبیسة الأغراض الضیقة والمعانی التافهة، وقلّما کانت تتجاوز الرسائل الاخوانیة، من تهنئة بمولود، أو تعزیة بفقید، أو معاتبة لصدیق، وقلّما تعدی موضوع النثر هذه الحدود الضیقة لیلامس اهتمام الناس ویعالج شؤون المجتمع».24
«انطلق الفکر الحدیث ناشطا و راح یرود آفاقا أرحب تتصل بالواقع وبالمجتمع، نتیجة انتشار أنوار النهضة فی أرجاء المشرق العربی. وبدأت الأسالیب تتحرر فی بعض جوانبها من قیود التصنع اللفظی. غیر أن فئة من الناثرین ظلت علی تعلقها بالعبارات المنمقة، وراحت تجد فیها نمطا أدبیا متمیزا لا یحسن التفریط به. ومن هذا المنطلق ساغ للشیخ ناصیف الیازجی خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر فن المقامات؛ فدأب علی إحیائه، وجهد فی النسج علی منواله... وفی الوقت نفسه کان ثمة ناثرون رواد ومؤلفون کبار أخذوا یراوحون بین النثر المقید والنثر المرسل، ترفدهم فی الحالین موهبة فذة، وفی مقدمة هؤلاء أحمد فارس الشدیاق، أحد أرکان النهضة الفکریة، ورائد الصحافة الأدبیة».25
ویمکن القول بأن اتصال الشرق العربی بالغرب ظل قاصرا فی أول الأمر علی النواحی العلمیة والفنیة التطبیقیة. أما النواحی الأدبیة فظل فیها الاتصال معدوما. وطبیعی ألا تنهض اللغة وتظل علی عهودها السابقة جامدة راکدة مثقلة بالسجع والمحسنات البدیعیة».26
واشتد احتکاك الشرق العربی بالغرب فی منتصف القرن التاسع عشر و «أرسلت طائفة من الشباب المصری إلی أوربا وعلی رأسها رفاعة الطهطاوی «الذی تعلم فی الأزهر وتخرج فیه، و رافق البعثة الکبری الأولی لمحمد علی إماما لها. ولم یکتف بعمله، بل أقبل علی تعلم اللغة الفرنسیة، حتی أتقنها. وفی أثناء إقامته بباریس أخذ یصف الحیاة الفرنسیة من جمیع نواحیها المادیة والاجتماعیة والسیاسیة فی کتابه «تخلیص الإبریز فی تلخیص باریز». وعاد إلی مصر فاشتغل بالترجمة وعیِّن مدیرا لمدرسة الألسن، وأخذ یترجم مع تلامیذه آثارا مختلفة من اللغة الفرنسیة. وکان ذلك بدء النهضة الأدبیة المصریة، ولکنه کان بدعا مضطربا، فإن رفاعة وتلامیذه لم یتحرروا من السجع والبدیع، بل ظلوا یکتبون بهما المعانی الأدبیة الأوربیة. ومن الغریب أنهم کانوا یقرءونها فی لغة سهلة یسیرة، ثم ینقلونها إلی هذه اللغة الصعبة العسیرة المملوءة بضروب التکلف الشدید، فتصبح شیئا مبهما لایکاد یفهم إلا بمشقة».27
«هناك ظاهرة جدیرة بالتسجیل تتعلق بالأدب فی تلك الحقبة، وهی الالتفات من بعض الکتاب إلی موضوع الوطن والوطنیة، بالمفهوم الحدیث تقریبا؛ فقد کان الوطن من قبل ذائبا فی جملة العالم الإسلامی أو دولة الخلافة، ولیس له دلالة خاصة، وبالتالی لیس هناك کتابات تدور حوله وتتغنی به. أما الآن ومع کتابات رفاعة الطهطاوی بصفة خاصة، فنحن نجد فکرة الوطن تبرز، والتغنی به یبدأ، حتی لیمکن أن یعتبر ما کان من ذلك حجر الأساس فی الأدب المصری القومی فی العصر الحدیث. وهکذا نری أن رفاعة الطهطاوی یعتبر واضع بذور التجدید فی الأدب المصری الحدیث، فأدبه یمثل دور الانتقال من النماذج المتحجرة التی تحمل غالباً عفن العصر الترکی إلی النماذج المجددة التی تحمل نسمات العصر الحدیث».28
«وکان لازدهار النثر الفنی عوامل کثیرة من بینها: العنایة بدراسة اللغة العربیة وآدابها فی الأزهر والمدارس والمعاهد والجامعات، وإحیاء مصادر الأدب العربی القدیم وطبع أحسن مؤلفات الأدباء المعاصرین، وظهور المجلات الأدبیة، وعنایة الصحف الیومیة بالأدب، وإنشاء دارالکتب المصریة، وکثرة ما ترجم من آداب الغرب إلی العربیة، وتعدد الثورات الشعبیة، التی احتاجت للخطابة، وقیام الصحف مما دعا إلی نهضة الکتابة».29
تطور النثر بعد الحرب العالمیة الأولی، وظهر الاتجاه الأدبی الذی یدعو أصحابه إلی الأسلوب الفصیح الرصین الجزل، حتی یکون لأدبهم موقع حسن فی الأسماع والقلوب، فهم یحرصون علی الإعراب وعلی الألفاظ الصحیحة. وکانوا فی إطار تجدید، لا یخرجون عن أصول العربیة، ویقوم هذا الاتجاه علی التحول والتطور فی اللغة العربیة علی نحوما تحولت وتطورت الآداب الأوربیة، دون قطع صلتها بالقدیم، ومن أصحابه فی مصر، طه حسین، هیکل والعقاد. وهذه النزعة المجددة کانت إحیاء للقدیم وبعثا وتنمیة فی صور جدیدة، ویعتمد علی عنصرین متکافئین وهما المحافظة علی إحیاء القدیم والإفادة من الآداب الغربیة.30
وقد ظهرت، فی أواخر القرن التاسع عشر، أربع طوائف فی النثر وهی: طائفة الأزهریین المحافظین، وطائفة المجددین المعتدلین الذین یریدون أن یعبرو بالعربیة دون استخدام سجع وبدیع، وطائفة المفرطین فی التجدید الذین یدعون إلی استخدام اللغة العامیة، ثم طائفة الشامیین، التی کانت فی صف الطائفة الثانیة، واشتدت المعارك بین الطائفة الأولی والطوائف الأخری، حتی انتصرت طائفة المجددین المعتدلین، فعدل الکتاب إلی التعبیر بعبارة عربیة صحیحة لا تعتمد علی زینة من سجع وبدیع، بل یعتمد علی المعانی ودقتها.31
وکان محمد عبده علی رأس طائفة المجددین المعتدلین. وهو الذی أخرج الکتابة الصحفیة من دائرة السجع والبدیع إلی دائرة الأسلوب الحر السلیم. وکوّن لنفسه أسلوبا قویا جزلا، ومرّنه علی تحمل المعانی السیاسیة والاجتماعیة الجدیدة والأفکار العالیة، ومعنی ذلك أنه طور النثر العربی من حیث الشکل والموضوع.32
ثم جاء تلمیذه لطفی المنفلوطی فقطع بهذا النثر شوطا کبیرا بکتبه ومقالاته، فأنشأ أسلوبا نقیا خالصا لیس فیه شیء من العامیة ولا من أسالیب السجع الملتویة إلا ما یأتی عفواً، ولم یقلد فی ذلك کاتبا قدیما مثل ابن المقفع والجاحظ بل حاول أن یکون له أسلوبه الخاص، فأصبح النثر متحررا من کل أشکال قیود السجع والبدیع، وبذا یعد المنفطوطی رائد النثر الحدیث.
وکانت الشهرة التی حظی بها المنفلوطی، تعزی إلی أسلوبه أکثر مما تعزی إلی مضمون مقالاته. وهو أدرك الحاجة إلی تغییر أسالیب اللغة العربیة، وکثیرا ما عبّر عن اعتقاده بأنّ سرّ الأسلوب کامن فی تصویر الکاتب تصویرا صادقا لما یدور فی عقله من أفکار.33
[*دور الصحافة والطباعة فی تطور النثر:*]
کانت للصحافة تأثیر کبیر فی حرکة التطور. ولئن کانت فی المرحلة الأولی وسیلة السلطة فحسب، فقد غدت، فیما بعد، محرضا وباعثا علی النهضة والتطور. وقد کانت تضم مقالات أدبیة أو اجتماعیة أو علمیة، یفید منها القراء. وأول من فکر فی إنشاء صحیفة، نابلیون، الذی أمر بإصدار ثلاث صحف، اثنتین بالفرنسیة وواحدة بالعربیة. ثم أنشأ محمد علی باشا جریدة رسمیة باسم السلطة.
وللسوریین واللبنانیین سهم کبیر فی إصدار عدد ضخم من الصحف والمجلات کالأهرام والمقتطف والمقطم والهلال.34
وکانت الصحافة هی التی عادت بالکتابة الأدبیة إلی أصالتها من حیث کونها خلصتها من التصنع والزخرف ورجعت بها إلی الوضوح ودقة التعبیر وطوعتها من جدید للتعبیر السمح عن خطرات التفکیر ومشاعر الوجدان.35
«ففی حقل الصحافة استطاعت الصحف الاسلامیة والوطنیة أن تصل إلی طبقات کاملة من القراء».36
وازدهار الصحافة کان نتیجة نمو الحرکات السیاسیة والاصلاحیة واستعلاء الوعی القومی من ناحیة والوعی الدینی من ناحیة أخری. فأصبحت الصحف منابر لتلك الحرکات والمنظمات التی تمثل مختلف الدعوات والمواقف الایدیولوجیة. وکان القصد عند هؤلاء وأولئك التأثیر فی الرأی العام والتعبیر عن قضایاه. وبذلك یکون ظهور فن المقالة نتیجة من نتائج هذه العوامل کلها، من ظهور الصحافة، وظهور الرأی العام، وظهور الحرکات السیاسیة والاصلاحیة. فعاد الأدب إلی الحیاة مرة أخری یعبر عن قضایاه ومنازعها.
«وقد کان لمحمد عبده أثر کبیر فی نهضة الصحافة فی أواخر القرن التاسع عشر، وهو الذی تولی العمل فی الوقائع المصریة».37
وکان للطباعة أیضاً أثر کبیر فی تطور النثر و «ما کان للنهضة أن تحدث لولا الطباعة، فهی وسیلة النشر الأولی، فی عصر یتسم بالتطور السریع، والحاجة إلی الکتاب والصحیفة والمجلة».38
«کان لازدیاد المطابع، والرغبة الأکیدة فی طلب المعرفة أن زادت حرکة إحیاء التراث العربی، فطبعت أمهات الکتب العربیة: الأغانی لأبی الفرج الاصبهانی، و العقد الفرید لابن عبد ربه الأندلسی ...».39
وفی البلاد العربیة کان السبق للبنان فی استعمال المطبعة.40
[*موضوعات النثر فی عصر النهضة:*]
کانت موضوعات النثر واسعة الأفق، و تناولت مشکلات الحیاة وما یهم الشعوب وما یبعث علی الیقظة والنهضة ممثلة فی:
1ـ الدفاع عن الشعوب المظلومة.
2ـ الدعوة إلی الأخذ بنظام الشوری فی الحکم.
3ـ محاربة الاستعمار، وإثارة الحمیة الوطنیة فی نفوس الشعوب المستذلة.
4ـ السعی فی إصلاح المفاسد الاجتماعیة.41
خصاص النثر فی عصر النهضة:
1ـ سلامة العبارة وسهولتها، مع المحافظة علی سلامة اللغة وخلوها من الوهن والضعف.
2ـ تجنب الألفاظ المهجورة والعبارات المسجوعة، إلا ما یأتی عفواً ولایثقل علی السمع.
3ـ تقصیر العبارة وتجریدها من التنمیق والحشو حتی یکون النثر علی قدر المعنی.
4ـ ترتیب الموضوع ترتیبا منطقیا فی حلقات متناسقة، وتقسیم المواضیع إلی فصول وأبواب وفقرات بحیث لایضیع القارئ، ویفهم تناسق الأجزاء ویتبع تسلسلها بسهولة.42
[*أغراض النثر فی عصر النهضة:*]
1ـ النثر الإجتماعی الذی یتطلب صحة العبارة، والبعد عن الزخرف والزینة، ووضوح الجمل، وترك المبالغات، وسلامة الحجج وإجراءها علی حکم المنطق الصحیح، لأن الغرض منه معالجة الأمر الواقع، فلا ینبغی استعمال الأقیسة الشعریة، ولا الخیال المجنح.
2ـ النثر السیاسی أو الصحفی، ویمتاز بالسهولة والوضوح بحیث یکون معناه فی ظاهر لفظه؛ لأن الصحف تخاطب الجماهیر، ویقرؤها الخاصة والعامة.
3ـ النثر الأدبی، وهو أشد أنواع النثر حاجة إلی تخیر اللفظ، والتأنق فی النظم، حتی یخرج الکلام مشرقا منیرا، لطیف الموقع فی النفوس، حلو النبرة فی الآذان، لأن للموسیقی اللفظیة أثرا کبیرا فی الأذهان. وهو أدنی أنواع النثر إلی الشعر.43
من مجموع ما مضی «یمکن أن نطلق علی الأدب العربی فی القرن التاسع عشر عصر الأدب الاتباعی الکلاسیکی، إلا أن الإتباعیة فیه کانت ذات ثلاثة مستویات معرفیة: الأول، یعتمد فی نثره الأسالیب الراقیة الفنیة فی العصور العربیة الزاهیة، والثانی، کان امتدادا لعصور الانحطاط التی بدأت قبل سقوط بغداد فیما یخص التطور النثری فاکتسب طابعها، اغراق فی المحسنات البدیعیة... وثالث مازج بینهما فکان فی نثره یجمع بین کلا الطابعین الأدبیین».44
[*خاتمة البحث:*]
تبین لنا من خلال هذا البحث أن نشأة النثر العربی فی العصر الجاهلی کانت غامضة؛ وکان حظ النثر من الحفظ أقل من حظ الشعر. وفی العصر الإسلامی کانت مظاهر التطور فی النثر أوضح منها فی الشعر ؛ وأغراض النثر ومعانیه قد تغیرت تغیرا محسوسا بظهور الإسلام. وکانت الکتابة ضرورة علمیة لا غنی عنها فی الحرکة العلمیة التی ازدهرت فی العصر الأموی وتعاظمت فی أواخره؛ ونتیجة لذلك توسع انتشار الخط واستعمال الکتابة، إبان ذلك العصر، توسعا عظیما، نظراً لإقبال الناس علی طلبه. وفی العصرالعباسی خطا النثر خطوة واسعة، فهو لم یتطور من حیث موضوعاته وأغراضه فقط؛ بل إن معانیه قد اتسعت وأفکاره قد عمقت، وأخیلته قد شحذت؛ لأن مشاهد الحیاة ومقوماتها العامة قد تغیرت. وفی العصر الحدیث خرج النثر من عهد الانحطاط، وبدأت الأسالیب تتحرر فی بعض جوانبها من قیود التصنع اللفظی؛ وکان للطباعة و الصحافة أثر کبیر فی تطور النثر.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:53|
أدب الطفل ووظیفته التعلیمیة والذوقیة
أ ـ الوظیفة التعلیمیة:
من أفضل الوسائل التعلیمیة تلك التی تتم بواسطة السمع والبصر، وترفض الورق كوسیلة للتعلم والتذوق. فالأدب المكتوب من الوسائل التعلیمیة المحدودة الأثر، وحینما یصبح الأدب مسموعاً أو مشاهداً فإنه ـ حینئذ ـ یؤدی دوره كاملاً .. كما أن التراث الشفهی كان من أقوى الوسائل فی نقل المعارف، والحقائق، والنماذج الأدبیة الراقیة .. وذلك للأسباب التالیة:
1 ـ أن أسلوب الحكى والقص یحقق الألفة، والعلاقة الحمیمة، والمودة والثقة المتبادلة بین المتلقى، وهو هنا الطفل، ومَن فی مستوى مراحل الطفولة، و «القاص» أو «الحكواتی». وفی إطار هذا التبادل الدافئ فی العلاقة تتسلل المعلومات بخفة وسهولة ویسر .. ویقبل علیها الأطفال بشوق ولهفة.
2 ـ أن رفض «فن الكتابة» واعتماد فن القصة على التلقی سماعاً وتلقی المسرح مشاهدة بصریة حیث المبدع یلتقی فیه مباشرة ـ أمر یحقق عمقاً فی الذاكرة .. بحیث لا تنسى هذه الأعمال الفنیة، وتظل محفورة فی وجدان وعقل المتلقى، وتمده بالمعلومات فی حینها.
3 ـ فی المراحل المختلفة لنمو الأطفال، ینبغی بناء الأدب بعامة والقصص بخاصة على مواد تعلیمیة ترتبط بمیول التلامیذ والأطفال وخبراتهم، لأن مثل هذه المواد التعلیمیة تزید من شغف الأطفال والتلامیذ بالأعمال الفنیة، وتدفعهم إلى بذل المزید من حسن الاستعداد، ومن الجهد العقلی للاستفادة من هذه المواد. كما تزید من تهیئتهم للاستفادة الوجدانیة وقدراتهم على الحفظ والقراءة والأداء اللغوی والصوتی السلیم.
4 ـ الأدب فی إطاره القصصی مصدر للنمو اللغوی السلیم عند الأطفال والتلامیذ .. وبرغم ما فی أطوار نمو الأطفال من اختلاف وتباین حیث الاستعدادات للتنمیة اللغویة مختلفة .. فإن الأدب یساعد كل الأطفال، ابتداء من مرحلة الحضانة حتى عتبات الشباب على التحصیل اللغوی وتنمیته، ویتزاید المحصول اللغوی، وتثری دلالاته وتتنوع استخداماته، وذلك بأثر من تزاید عملیات النضج الداخلی لدى الطفل، والخبرات التی تزوده بها البیئة والتجارب التی یمارسها بحكم تقبله وتلقیه للإبداعات وفی مقدمتها القصص والمسرحیات .. ثم ألوان الأدب المختلفة من أناشید، وأشعار جمیلة، وأغانی ذات إیقاع جماعی، لكن بشرط أن تكون هذه «الآداب» متلاقیة مع حاجة من حاجات الأطفال.
5 ـ الأدب مصدر من مصادر المعرفة، فی مرحلة من مراحل الخصوصیات المعرفیة التی تصبح موضوع اهتمام المبدع مثل القصة أو المسرحیة أو قطعة الشعر، حینما تكون حاملة للغة الخطاب المعرفی، والطفل والتلمیذ والآباء والمدرسون یجدون فی هذه النماذج الأدبیة ما یجعل المتلقى من عالم الصغار قادراً على اكتساب ثقافات، وتتبع ما یجد من ألوانها ومن فنون المعرفة، ویكون عادات وجدانیة تسهل التقاط المعرفة والأدب باعتباره نشاطاً لغویاً یساعد على التربیة السلیمة .. حیث الخبرة والعمل، والإحساس السلیم والعاطفة الإیجابیة تساعد الأدب على تنمیتها، والأدب ـ فوق هذا ـ ینتقل بالمدرسة وبعملیتها التعلیمیة من مجرد تلقین التلمیذ مواد دراسیة إلى تزویده بالخبرات العقلیة والوجدانیة، وإعادة تنظیم خبراته السابقة، بصورة تضیف إلى معناها، وتزید من قدرته على توجیه مجرى خبراته التالیة نحو تحقیق أهداف التربیة فی خلق المواطن السلیم جسماً وعقلاً وروحاً ووجداناً وقلباً .. إلخ.
ب ـ الوظیفة الجمالیة التذوقیة:
الطفل یولد بمشاعر رقیقة، وشعور فیاض بالنیات الحسنة، والحب المتسامح النبیل .. وهو یولد مزوداً بخبرات فطریة جمیلة .. فالطفل قیمة تنطوی على الخیر والسعادة والرفاهیة حباً ومودة وتواصلاً كما أنه معروف بشمولیة ذوقه، ورهافة حسه وسعة خیاله، وحبه وشوقه للمجهول، وقیام عالمه الطفولی على المغامرة، والحل والتركیب. والسؤال أن الأدب یخلق فی عالم الطفل توجهات نحو الجمال، ویبرز القدرات المتذوقة ویكشف عن القدرة الإبداعیة.
كما یستطیع الطفل بكل مراحل نموه، أن یكتسب قدرات التذوق حسب كل مرحلة، وخصائصها، وقیمها، وطبیعة العمل الأدبی المناسب لها .. بذلك نستطیع تنشئة الطفل تنشئة تذوقیة حسب استعداده، وقدراته، وطبیعة مرحلته .. فرحلة الطفل خلال مراحل نموه برفقة الأدب، تخلق نوعاً من الصلة بین الجمال والإحساس به، ویمكن تلمس أثر هذا على الطفل الذی تعود الاستماع إلى الأدب أو مشاهدته، أو قراءته .. حیث الطفل یكون عادة فی اتم صحته النفسیة، وأكمل درجات نضجه، وأفضل حالاته الوجدانیة والذهنیة .. وهذا كله صدى للحس الذوقی الذی نما لدیه أثر إرتباطه الدائم بالتذوق الأدبی. ویمكن بلورة العوامل التی تنمی التذوق الأدبی لدى الأطفال وذلك بأثر من تعاملهم مع الأدب استماعاً أو قراءة أو مشاهدة، وذلك فیما یلی:
1 ـ یعمل الأدب على تنشئة الشخصیة، وتكاملها، ودعم القیم الاجتماعیة والدینیة، والثقافیة .. ومن ثم تتكون عادات التذوق السلیمة، والتوجهات نحو الجمال فی كل ما یتصل بالحیاة الیومیة والاجتماعیة، والحضاریة. ویصبح الطفل قادراً على مواصلة علاقاته الإیجابیة ببیئته، ویؤكد دائماً على مطالبه لتحقیق الجمال فی حیاته العامة والخاصة.
2 ـ تتكون لدیه قدرات وخبرات وتجارب وثقافة تعمل على التأكید على شخصیة الطفل المتذوقة للجمال، وإصدار أحكام إیجابیة لصالح النظام والنظافة، وذلك فی إطار الجمال العام. بالإضافة إلى دعم القیم الروحیة والقومیة والوطنیة لدى الأطفال، وذلك لخلق ثقة كاملة فی مستقبل أمة تنهض على أكتاف مسئولین تربوا وهم أطفال على التذوق، والتمسك بالجمال فی حیاتهم الخاصة والعامة.
3 ـ كما أن تذوقهم للغة، وجمالیاتها یساعد على تنشیط وجدانهم، وإكسابهم القدرة على تذوق اللغة واستعمالاتها وحسن توظیفها .. ومن ثم تتكون عادات عقلیة وفكریة، تكون قادرة على تهیئة أطفال الیوم، لیصبحوا قادة المستقبل، ومفكریه.
4- ان الاطفال الذین ینشأون نشاة تذوقیة ادبیة یحققون اكتساب المهارات التالیة :
- التعبیر باللغة والرسم عن افكارهم واحساساتهم لتنمیة قدراتهم على الاستفادة من الوان الثقافة وفنون المعرفة واعدادهم للمواقف الحیویة التی تتطلب القیادة والانتماء والتمسك بالجدیة والاستفادة فی الوقت نفسه من مباهج الحیاة .
- التذوق اللغوی والادبی یحقق للاطفال مجالات وافاقا اوسع فی تعاملهم واحتكاكهم الاجتماعی والانسانی ویعالج سلبیات الاطفال المتمثلة فی انطوائهم وعزلتهم وارتباك مواقفهم وتخرجهم هذه القدرات اللغویة وتذوق الادب من اطار عیوبهم الشخصیة والاجتماعیة الى اطار اوسع من النشاط والحیویة والتعاون والاقبال على الحیاة .
- القدرة على القراءة الواعیة وعلى تقدیر قیمة الكلمة المكتوبة فكریة ووجدانیة ومن ثم اعداد الاطفال لتولى اعمال اذاعیة ومسرحیة و…
- ان الادب یمكن الاطفال من معرفة الدلالات المعجمیة ویزودهم بالدلالات الثانویة الموحیة ویخلق لهم من خلال تذوقهم واستعمالاتهم ابعادا جدیدة عن طریق المجازات التی هی فی الحقیقة استعمالات لغویة تدل على الذكاء وحسن توظیف اللغة وضروریة لتنمیة التعبیر وامكاناته وتجدید طرائفه بل هنالك من یرى ان اللغة كلها مجازات .
- الادب فن والفن موطن الجمال وعلاقة الذوق بالفن قائمة على تنمیة الاحساس بالجمال لدى اطفالنا .فالادب قادر على تغذیة مخیلة الطفل بكل مایثیر ویمتع.
- ان الدب فی افقه الاوسع مجموعة من التجارب والخبرات وعندما نقدم شیئا منه لاطفالنا انما نقصد الى ان الاطفال لم یخوضوا ایة تجربة شخصیة مؤلمة ولم یستطیعوا التعرف على معنى وماهیة الخوف القابع فی اعماقهم ولهذا فانهم یجدون فی ادبهم تعویضا عن ذلك فی تلك الشخصیات والاحداث والمناسبات التی یتضمنها ادبهم .فكاتب ادب الاطفال العظیم هو القادر بحق على التعبیر عن مشاعر الخوف العمیقة لدى اطفالنا والقادر على ان یبتكر لهم مشاعرهم واحاسیس تربطهم بالحیاة بشكل اجمل
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:52|
النزعة الاجتماعیة فی شعر أبی القاسم
الشابی
أثر: سهاد جادری طالبة فی قسم الدکتوراه للادب العربی فی جامعة آزاد الاسلامیة فرع علوم تحقیقات طهران الاستاذ المشرف :الدکتور سید أمیر محمود أنوار الاستاذ المساعد:الدکتور محمود شکیب
المقدمة:
یدور موضوع المقال حول النزعة الاجتماعیة فی شعر الشابّی. تحدثنا ابتداءا ً و باختصار عن حیاة شاعرنا الأدیب المبدع. و مما لا شک فیه أنّه أدیب و شاعر ذو ثقافة واسعة و إحساس مرهف، تأثر فی شعره بوضوح بالمذهب الرومانطیقین لا سیمّا الفرنسی منه.
بعد ذلک أشرنا إلی النزعة الاجتماعیة فی شعره من خلال نماذج شعریة ظهر فیها هذا الاتجاه، مشتملة ً علی عناوین من هذا النّمط الشعری الحدیث فی الأدب العربی نحو: دور الأم و مشاعرها فی الحیاة، «و الطفل و الطفولة» و «المرأة» کما لم نغفل عن موهبته الدینیة و دور أسرته فی تکوین شخصیته و توسیع آفاقها. و فی الختام قـُمنا بدراسة وجیزة لقصیدته «إرادة الحیاة» منوّهین إلی «حب الوطن» فیها.
حیاته و ثقافته
ولد محمد الشابی والد الشاعر سنة 1879 وفی سنة 1900 ذهب إلی مصر وهو فی الثانیة و العشرین من عمره لیتلقی العلم فی الجامع الأزهر فی القاهرة و سکن فی مصر سبع سنوات عاد بعدها إلی تونس یحمل إجازة الأزهر ثـُمَّ أنّه التحق بعد عودته من الأزهربجامع الزیتونة بحیث درس عامین نال فی نهایتها إجازة التطویع و هی شهادة نهایة الدروس فی الزیتونة، و فی تلک السنة یبدو أن الشیخ محمد الشابی کان قد تزوج إثررجوعه من مصر ثـُمَّ رزق إبنه البکر اَبا القاسم الشابی شاعرنا قبل أن ینال شهادة التطویع. [1]
ولد أبو القاسم الشابی یوم الأربعاء فی الثالث من شهر صفر سنة 1327هـ و المواقف للرابع والعشرین من شباط عام 1909فی بلدة توزر، ثم عنی الوالد بتعلیم إبنه فی البیت. [2]
و فی سنة 1920م التحق بجامع الزیتونة فأتقن القرآن و العربیة و تمرس بالأدب و کان له میل شدید إلی المطالعة، فحصل بها و بنشاطة علی ثقافة واسعة جمع ما بین التراث العربی القدیم و معطیات الفکر و الحدیث و الأدب الحدیث. [3]
و ذکرزکی أبو شادی أن الشابی کان فاشلا ً فی زواجه و أنّه قد أقنع بضرورة الزواج إرضاءً لأبیة ثـُمَّ رزق من زواجه ولدین. [4]
حینَ بلغ الطفل الخامسة من عمره أرسله أبوه إلی الکتّاب فی بلد قابس ثـُمَّ أنّه کان یحضر حلقات دروس علماء البلدة و غذ ّی مواهبه بأدب النهضة فی مصر و لبنان و العراق و سوریة و المهجر، کما نمّی طاقاته الأدبیة الشعریة بمطالعة ما ترجم إلی العربیة من آداب الغرب، و لا سیمّا أدب الرومانطیقیة الفرنسیّة، و قد ظهر نبوغة الشعریّ و هو فی الخامسة عشرة من عمره و علی أثر تخرجه من جامع الزیتونیة التحق بکلیة الحقوق التونسیة، و کان تخرجه منها سنة 1930م، و فی هذه الأثناء توّفی والده ترک له عبء الحیاة، ثقیلا ً فحاول أن ینهض بالعبءِ و مسؤولیة العائلة، ولکنه أصیب بداء تضخّم القلب.
و هوفی الثانیة و العشرین من عمره نهاه الأطباء عن الإرهاق الفکری و لکنه واصل عمله و فی نفسه ثورة علی الحیاة، و فی قلبه تجهمّ قتّال و فی صیف 1934 م جمع دیوانه «أغانی الحیاة»، و نوی أن یطبعه فی مصر، ولکنّ الداء اشتدّ به و ألزمه الفراش، فنُقل إلی المستشفی الإیطالی بالعاصمة حیث فارق الحیاة فی التاسع من شهر تشرین الأول سنة 1934م، و نقل جثمانه إلی مسقط رأسه و دفن فی الشّابیة.
أدبه:
لشعر الشابّی مراحل من حیث الرّوح و الوحی تتجلـّی فیها نزعاته الکبری و محطـّات اختلاجاته النفسیة و العاطفیة، و هذه المراحل لیست فی الدیوان واضحة المعالم، بیّنه الحدود. إنّها متداخلة تداخلا ً زمنیا ً و إن کانت فی موضوعها و فنّها ذات صبغةٍ خاصّة، و ذات امتدادات و آفاق خاصّة.
- آلف) مرحلة الأدب الأندلسی و المهجری: عندما تفتحت قریحة الشاعرو راح یجاری الأندلسیین فی طریقة نظمهم و فی أسالیب تصوّرهم للحیاة، ثمّ فی نهج الزخرفة و التنمیق، حتّی لکأنّ شعره من شعرهم، و صیاغته من صیاغهم قال یصف جمیلا ً و یصف حاله معه:
رُبَّ ظبـــیّ ٍ عَـلِقـتـُهُ
بالبَهَـا قـد تقـرطـَقَــا
ثمّ من وصلِهِ الجمیل
غَـدا الـقـلبُ مُملقـَــا
سحـر اللـُّبَّ طـَرفـُهُ
مادَها الریقَ لوَرَقی
صــارَ مُلقــی بحُبّه
مُوثقـا ً لیس مطلَقـَـا
[5]
یستقی الوحی فی شعره من تصنیعات الدندلسیین. ولکنّ هذا التلمّس لم یدم طویلا ً. فقد ترامت إلیه أخبار أدباء المهجر فأطلـّع علی آثارهم و لاسیمّا آثار جبران خلیل جبران، و فعلت فی نفسه ثورتهم الاجتماعیة و تطلـّعاتهم المستقبلیة، و حرّک أوتارشاعریة أسلوبهم الجدید فی الکتابة و الشعر فأراد أن ینهج منهجهم فی النوعیة، و أراد أن یسلک مسلکهم فی الأدب. فنزع نزعة صوفیة وراقیة، و فتح نوافذ نفسیة علی الإنسانیة المعذّبة، و راح یهاجم المجتمع المتحجّر و یدعوا إلی التجدید فی الحیاة.
- ب) مرحلة الرومنطیقیة الأدبیة: و إلی الجانب التأثر المهجری نجد تأثیرا ً آخر کان له فی شعر الشابی أصداء بعیدة ألا و هو شعر الرومانطیقیة الأوربیة الحافل بالألم و القلق. الذکریات و الحنین المتدفـّق حزنا ً و فرحا ً، الغارق فی خضم من التأمل. و فی هذه المرحلة من حیاة الشابی الشعریة نلمس نفسا ً جیّاشة العواطف و تحاول أن تجمع ما بین العواطف الجبرانیة و اللـّین الرومنطیقی، فتنطلق فی معانی الکآبة و الحزن لاحدَّ له، و یذهب فی تفهّم الحیاة المذاهب المختلفة تختلج فیها الثورة و الیأس، و الألم، والشابّی بدا عمیق النظرة بعید عن الرؤیا، وافرالإنسانیة، فیّاض القریحة. [6]
قد یقول عمر فروخ عن حال الشابی بعد موت أبیه کأنّه مکسور الجناح مثقلا ً بأعباء الحیاة، یظهر ذلک کلـّه فی قصیدة «یا موت» التی رثی بها أباه: یا موتُ قد مزقتَ صدری و قضمت بالأزراء ظهری و فجعـتنـی فی مـن أحـبّ و مــن إلیــه أَبــتُّ ســـری ورزأتنـــی فی عـمــدتــی و مشــورتی فی کـل أمـــر (1974، ص100)
النزعة الاجتماعیة عند أبی القاسم الشابی:
أبو القاسم الشابی شاعر موهوب رقیق العاطفة، شفاف الحس، صادق الإیمان، اعتبر أحد الزعماء المجد دین فی الشعر العربی الحدیث فی تونس، و من المؤمنین بتحریر الشعر العربی من طرق قدیمة. نزع النزعة الرومانسیة فی لغة صافیة شفافة، فیها براعة الصیاغة و حسن التحلیل، امتاز فی جنوحه إلی الرّمز، و البحث عن المجهول، و الهروب من الواقع إلی الطبیعة و الخیال، و الأفکار الإنسانیة و المثالیة، و التمسک بالجمال و القوة و الخیر، عالج فی موضوعاته فلسفة البؤس و الشقاء و المآلم و الحزن و الحب و الحیاة و القوة و الثورة، فکان إنسانا ً ثائرا ً علی کل قیود عصره فی الشعر و الحیاة و المجتمع و السیاسة ظهرت عبقریته و هو علی مقاعد الدراسة. و نشرت له صحف تونسیة انتاجا ً شعریا ً و لفت إلیه الأنظار، فی مدة وجیزة ً، و نشرت له «مجلة أبولو» المصریة التی حملت لواء التجدید فی الشعر العربی، مجموعة من أشعاره لنغمة جدیدة و فنـّه الحدیث المبتکر. عشق الحیاة و الإنسان من أهم الموضوعات الاجتماعیة فی شعر الشابی حول قضایا بلاده و هموم المجتمع الذی یعیش فیه الشاعر و یقول إنّ الداء فی کلّ الداء المعبر لا فی روح الشعب. [7]
کان الشابی فی شعره الاجتماعی أصدق الناس عاطفة، و من أخلصهم شعورا ً بالمسؤولیة الاجتماعیة، و قد وعی أن بیئته مریضة یسیطر علیها الجهل و الفقر و تتنازعها السیاسات الاستعماریة و القوی المتحجرة التی تحالف الاستعمار أو استخدام لها، فراح یعمل علی إیقاظ الضمائر، بالمحاضرات، تأسیس النوادی، و نشر الکلمة المسؤولة، إنّه لم یکن رجل سیاسة یتطلب الدنیا التونسیة، و زلزل أرکانها، بل کان رجل العقل الذی یبصر الحقیقة، لقد أطلق صوته تسمعه الآذان و قد ذکر الکثیرون هذه الآراء الجدیدة و الجریئة و نکره الکثیر. (الفاخوری، حنا، ج4، 1991م، صص704 و 705) و عندما أخفق فی مسعاه ارتدّ علی شعبه کالعاصفة الهوجاء و قال:
أیُّّهــا الـشّــعـبُ کـُنـتُ حطـّـــابــا ً
فأهــوی عـلی الجذوع بفأســی
لیتنی کُنتُ کالســیول، إذا ســالت
تهُــدُّ القبـــــورَ رمســـا ً یَـرمـس
لیت لی قوّة العواصف، یا شـعبی
فـــألقی إلیـــک ثــــورة نفســی
لیت لــی قـوّة الأعاصـیـر… لکن
أنت حیُّ یقضی الحیاة بَرمـس!
[8]
و کانت تونس هاجسه فی نهاره و لیله، یرید لوطنه العزّة و الترقّی، و یرید فیه تحریر الشعب و المرأة کما یرید تحریر العقول و النفوس. ألم تکن تونس ملء عین التاریخ؟! ألم یکن تاریخها حافلا ً بالمجد و الرقی منذ أقدم العصور؟ ألم یقم فیها أمثال أوغسطنیوس و ابن خلدون و ابن منظور؟ إنها تونس الجمال، و تونس العلم و الفن و القیادة! ماذا حلّ بها، من أین تسرّب إلیها الخمول و الرکود؟! و ها هوذا الشاعر یقف علی أطلال هذا المجد الغابر و فی قلبه لوعة و فی نفسه أمل.
أنا یـا تـونس الجمیلة فـی لجٍّ
الهوى قـد سَــبَحت أی ســـباحه
سرعتی حبُّک العمیقُ و إنـّی
قـد تـذوَّقــــتُ مُــرّة و قـراحـــــة
لبســتُ الضــاع للواحی و لـو
متُّ و قامَت علی شبابی المناحَـه
إنَّ ذا عصـرُ ظلمةٍ غــیر أنّی
مـن وراء الظلام شــمت صباحـه
[9]
و لو أننا تناولنا مفهوم الشعر عند الشابی لوجدناه یقول: «الشعر تصویر و تعبیر، تصویر لهذه الحیاة التی تمرّ حوالیک مغنیة، ضاحکة، لاهیة أو مقطبة واجمة باکیة أو وادعة حالمة راضیة أو مجدفة ثائرة ساخطة، و تعبیر عن تلک الصور بأسلوب فنّی جمیل ملؤه القوة و الحیاة» [10] و هذا الذی قاله الشابی إنّما هو- و تکاد تکون بعض الکلمات واحدة و رسالة الشاعر عند الشابی هی نفسها التی نادی بها شعراء المهجر: فالشاعر نبی له رسالة تنزلت علیه من عالم الروح و علیه أن یذیعها فی الناس جمیلة رائعة طاهرة، یجد فیها المؤمن مراحه من عناد الحیاة، ملاذة من عنت الدهر، و یجد فیها المشارکة النفسیّة الدقیقیة لما یعتمل فی نفوسهم، و تجیش به صدورهم من عواطف و أحاسیس. [11]
حقیقة أنّ الـشابی تأثـّر بشعـراء الـمهجر فی تجویدهم للموسیقی الـشعـریة و نظام الـقصیدة و الصورالشعریة و الألفاظ و أسلوب الشعر بوجه عام، أمّا أسلوب الشّابی من الناحیة الفنیة فهو متصنع فی أکثر مواطنه کثیر الزخارف و التهاویل و الطلاء. [12]
1- النزعة الأولی فی الاجتماع: «الأم»
قلب الأم
یا أیّها الطفل الذی قد کان کاللـّحن الجمیل
و الوردة البیضاء، تعبق فی غیابات الأصیل
یا أیّها الطفل الذی قد کان فی هذا الوجود
فرحا ً، یناجی فتنة الدنیا بمعسول النّشید
هنا یصف الشاعر لنا الطفل عندما یبکی بلحن ٍ جمیل و کل ما یحتاجه أو یشعر به ینقل إلی الأم بلحن ٍ خاص و هذا الطفل مثل وردة بیضاء فی وقت أفول الشمس یقرعون له لکی ینام أو یحتاج إلی الراحة و السلامة التی تداریه الأم إلی الصباح و فی حالة ثانیة یقول بأحلی نشیده یناجی فتنة الدنیا بفرح ٍ و سرور ٍ الذی کان ما بین الکائنات و الموجودات.
و مضت بروحک للسماء عرائس النّورالحبیب
یحملن تیجـانا ً مُـذهـبة ً، مـن الــزَهـرالغـریب.
و هنا یصوّر الملائکة التی تنزل فی روح الطفل شبه العرائس التی تتکون من نور سماوی یحملن قطعا ً من الذهب و فیهنّ أزهار ملوّنة من أنحاء العالم. [13]
إنّ الحیاة و قد قضیت قـُبیل معـرفة الحیــاة
بحرٌ قرارتُهُ الرّدی، و نشیدُ لجته، شـکــاة
و علی شواطئه ٍ الـقلوب تئن، دامیة عُــراة
بحرٌ تجیشُ به العواطفُ فی العشیّة و الغداة
یصوّر الشاعر الحیاة تصویرا ً دقیقا ً و یقول الإنسان لما عُرف الحیاة علیه أن یغوص أو یتعمّق و یمرّ من ناحیة الهلاک و یتحمّل کل الشکایات و المسؤولیات العظیمة حتی یعرف ما تقول الحیاة فی هذا البحر تکون العواطف جیاشة لیل و نهار و علی سواحله القلوب تمیل إلی البعض واحدة ً تداوی جروح الآخرین. و علی الإنسان أن یجرّب کلّ الأمور و من خلال أحداث الحیاة و یذوقها لکی یکون محنکا ً أو صاحب تجربة.
فی لجّة الغابات، فی صوتِ الرّعود القاصفة
فی نـُغیَة الجمل الودیع، و فی أناشید الرُّعاة
یقول هنا إنّ الأم فی زمن الولادة أو الحمل صوتها مثل صوت الرعود من المطر الذی یسقی بعمقها و هذا الصوت یشبه الرعاة التی تنطبق أصواتها إلی الحیوانات لکی تمشی علی مسیرها الخاص و یدور من خلال فواصل البعیدة. [14]
بین الـمروج الخُضـر و السَّفـح المجلل بالنبات
فی آهة الشاکی، و ضوضاء الجموع الصاخبة
فی شـهـقة البـاکی یـؤجـِّجُهــا نُـواحُ الـنــادبَة
فی کلّ أصوات الوجود: طتروبها و کئیبها
و رخیمها و عَنیفها، و بغیضها، و حبیبُها
…
فی رقص اَمواج البحیرة تحت أضواء النجوم
یصف الأم التی تلد الطفل بالمطر الذی یعشّب الأرض و صفحة خضراء بأنواع النباتات و الآهات التی تشتکی منها بین جمیع الناس و تحدثُ الضوضاء بصوتها العالی یؤدی التحیة لها النواح بکلّ الأصوات الموجودة من الفرح و السرور إلی الحزن و البکاء و یصوّر لنا الحیاة بهاتین الحالتین فی حین الولادة ثـُمَّ هناک یدخل فی الطبیعة بما فیها من أحداث هی صورة من رومانطیقیة الشاعر التی توصل الحب بالطبیعة مباشرة ً. [15]
2- النزعة الثانیة فی الاجتماع: (المرأة)
کانت المرأة نعیم الشابّی و جحیمه فغنّی لها فی کلّ مراحل حیاته و إذا کنّا قد ذکرنا شیئا ً عن زواجه فی تلک المقدمة، فسندرس فی ما یلی حبّه خارج إطار العلاقة الزوجیة. فقد انقسم الناس حول حبّ الشابی قسمین: أحدهما یری أن الشاعر یصف فی غزله نساء من عالم الواقع، دعاه إلی وصفهنَّ میله إلیهنَّ فی وقت کانت فیه نفسه منصرفه إلی الحیاة، و کان یتمتع بصحـّة و نشاط، أو کان فی هدنة مع مرضه أما الفریق الآخر، فیری أنّ الشابی خلق لنفسه مثالا ً للمرأة و راح یتحدث إلیه، ملقیا ً علیه من خیاله الشیء الکثیر.
إنَّ الشابی أحب رفیقة طفولته، و تغنّی بحبها حبّا ً عذریا ً خاصا ً. ثمّ ماتت تلک الحبیبة و هما فی سن المراهقة، و ماتت و ترکته یندب الحبّ و یرثیها، إذ بقیت فی نفسه حاضرة، و قد جاء هذا الشعر عذریا ً عند الشابّی، فی مستهلّ صباه، و ذلک قبل أن یبلغ العشرین من عمره، کما جاء ضعیف الأسلوب بالمقارنة مع شعره الذی جاء فیما بعد، و کان یسیطر هذا الشعر لون من الحزن و الکآبة و الحنین:
ماتَ من تهوی! و هذا اللـّحد و قد ضَمَّ الحبیب،
فَابکِ، یا قـلبُ، بمـا فیک من الـحـزن الـمذیب [16]
أمّا الطور الثانی فقد أحبّ الشاعر حبّا ً صریحا ً مادّیا ً و أحبَّ نساءً بعینهنَّ. ذلک أن الشاعر نضج باکرا ً و انتقل فی بیئة منفتحة، بعیدة کلّ البعد عن الرقابة، و ملیئة بالمغریات. فساهم ذلک فی إذکاء الجانب الغریزی فی نفسه فقصیدته «صلوات فی هیکل الحبّ» لا یمکن إلاّ أن تکون فی فتاة بعینها حیث یقول عنه:
کلـّما أبصَرتکِ عینایَ، تمشیـ
ـــنَ بخطــو ٍ موقـّع ٍ کالنشـــید ِ
خفق القلبُ للحیــاة و رفّ الزّ
هـرُ فی حقل ِعُمریَ المجـرود ِ
کـُلّ شـئ ٍ مُوقـّع ٍ فیک ِ حتـی
لفَته َ الجیـد ِ و اهتـــزار النهــودِ
أمّا القصیدة فقصة متکاملة لما تحتوی علیه من السرّد و الوصف و الحوار حیث نجد فیها الأبیات التالیة:
راعـهـا مـنـه صـوتـُه و وجـومُــه
و شجاها شُحوبُه و سهـومُـه
فأمرت کــفـّا عـلی شــعـره الـعــا
ری بـرفـق ٍ کأنّتهــا ســتـنیمه
و أطلقت بـوجههـــا الــباسـم الحلـ
و عـلی خــدّه و قـالت تـلومــه
خـلّ عـبء الحیــاة عـنک، و هـیّا
بمحیّـا کالصـبح ِ طلـق ٍ أدیـمُـه
واحـتـضـنـّـی فـإنـنـــی لـک حـتـّـی
یتواری هـذا الـدّجـی و نجومـه
واقطفِ الورد من خدودی وجـیدی
و نهودی، و افعل به ما ترومُه
[17]
أمّا فی قصیدته، «تحت الغصون» فیصف الشاعر خلوة کانت فی منتهی الصّراحة، النزوع العاطفی، و جاءت وصفا ً لمغامرة واقعیة تعبّر عن رغبه مکتوبة عند الشاعر، و سنورد بعض أبیاتها للوقوف علی التطوّرالشعری عنده، و لیس لتتّبع العلاقات العاطفیِة و فیما یقول:
ها هنا فی حمائل الغاب تحت الرّمــ
ان و الــسِّـــنـدیـان و الــزّیـتـــــون
ما أرق الشـبـاب فی جســمک الـغــ
ض ِ و فـی جـیـدك البدیـع الثمیـن
قـُبُـلا ً عـلـّمــت فـــؤادی الأغــــانـی
و أنـارت لـه ظـــلام الــســـــنـیـن
أی خـمــــر رشـــفـتَ، بـل أی نــار ٍ
فـی شـــفــــــاه ٍ بـدیعـة الـتکــــویـن
و ســکرنـا هـنــاک فی عـالــم الأحــ
ــلام، تحت السماء، تحت الغصون ِ
و نســینـا الـحیـاة و المـــوت و الکــو
نَ، و مـــا فیـه مــن مـنیً و مـنآون ٍ
إنَّ الغزل فی هذه الأبیات حسّی مادّی، و إذا ترکنا المعانی و الصور- و بعضها یمکن أن نحمله علی المجاز- فلابدّ من التأکید، فی هذه القصیدة و فی غیرها بأن لا یمکن أن تؤخذ إلاّ علی سبیل العلاقة المادیة مثل: و أینا النهود تهتزُّ … وابعثی فی دمی الحرارة … واحتفنّی… قبـّلینی… آه ما أعذب الغرام… خضمّ یموج بالإثم.
علی أننا نبادر إلی التأکید علی أنَّ غزله لا یمکن أن یقارن بالغزل الروحی الذی رأیناه عند الصوفیین أمثال إبن الفارض، و إبن العربی و غیرهما، لأنَّ تعابیر الصوفیّة لا تنکشف انکشاف ألفاظ الشابی، بل تشکّل مع غیرها من القصائد وحدة منسجمة متکاملة لا یمکن تجزئتها. (المصدر نفسه، 1993م، ص 21)
المرأة الحالمة بین العواطفِ
أنت کالزهرة الجمیلة فی الغــاب
ولکـن مـا بـیـنَ شــوک ٍ ودود ِ
و الریاحین تحسبُ الحک الشریـ
ــرَ و الدودَ من ضوف ِ الورودِ
یصوّر المرأة کزهرة من الزهور فی البستان ما بین الشوک المترافق للمودة هذه الریاح تجعل لک صوتا ً من أی زاویة و هذه الصداقة و المرافقة هی من عادات أو ضعف الورود، یقول الشاعر إنّ الصداقة الحقیقیة أو الواقعیة فقط تأتی من الورود و تراهمك فی أیة حالةٍ من لحظات حیاتك.
فأفهمنی الناسَ: إنّما الناسُ خلـقٌ
مفسدٌ فی الوجودُ غیرُ رشید ِ
و السعید السعیدُ من عاش کاللیل
غریبا ً فی أهل هذا الوجـود
قبل أن تعرفین الناس علیک أن تواصلی لهم فی الکون إنما هؤلاء الناس هم من المفسدین و المتکبرین فی الأرض ولا فیهم حمیة و لا رجولیة و أحسنهم من یعیش عیشة ً مثل اللیالی التی تمرّ من حیاة الانسان و تقترب لأهل الحق و المصلحین بالوجود و یعبدون ربّهم لیل و نهار و یعملون الطیبات. [18]
و دعـیهــم یحیـــون فی ظلمة الإثــم
و عیشی فی طهرک المحمود ِ
کالملاک البریء، کالورود البیضاء
کالـمـوج فـی الخضــمّ الـبعیـد
کأغانی الطیــور، کالشــفق السـاحر
کالکوکـب ِ الـبعیـد ِ الســعـیـد ِ
کثلــوج الجبــال، یَغمــرُهــا النــورُ
و تسمــو عـلی غـبار الصعید ِ
یقول الشاعر إنّ الأشخاص الذین یتوالون إلی الأعـمال السیئة و الغـیر طیبة علیک أن تدعیهم إلی الظلمات و أنت عیشی عیشة ً فی الطیبات وطهارتک الحمیدة مثل شخص ٍ فارغ من الظلمات وعیشی فی الحیاة الحقیقة کوردة بیضاء و کإنسان فی السکون أو کموج ٍ عمیق من أمواج البحر و کأنّک تغریدین مثل الطیور و کالعطوفة الساحرة التی تنقلب فی قلب الإنسان مثل کوکب بعید عن الحیاة السعیدة و الملیئة بالأرواح مثل الثلج الذی یذوب و یصعد بخارا ً إلی السماء و یصبح غبارا ً أسود و یعطینا المطر. و فی آخر المطاف یصوّر لنا الشاعر الناس و طبائعهم فی الأرض و النساء الطیبات اللـّاتی یحملن الصفات الحمیدة و ینتقم من الأشخاص السیئین و المفسدین فی الأرض. [19]
3- النزعة الثالثة فی الاجتماع (الأسرة)
ذکری الأسرة
کـُنـُـا کزوجی طائــر، فی دوحة الحبّ الأمین
نتلو أناشــید المُنـی بینن الخمــائل و الغصــون
متغردین مع البلابل فی السهول و فی الحزون
ملأ الهوی کأس الحیاة لنا، و شعشعها الفُتون
یقول الشاعر فی هذه الأبیات و هی من بحر المجزوء الکامل نحن متزوجون علی سنة الله و رسوله فی ساحة واحدة أو کطائرین علی جناح الأشواق و الحبّ العاطفی و المقدس الذی یأتینا من خلال هذه الغربة و فی أسهل و أصعب الحیاة بالکلام المنطقی و العذب لکی نصل إلی مرحلة من الحیاة الملیئة بالعشق الشدید و کؤوسها تنوّرنا من خلال إعجابها بالکون.
حتـّی إذا کدنا نرشّف خمرها، غـُصب المنون
فتخطف الکأس الخلوب، و حطـّم الجام الـثمین
إذا أردنا أن نشرب من الخمر لیغضب الله بسبب أعمالنا فی الحیاة و هذا الانتقام کسـِّر هذا الجام الثمین و أغلافه. و أراق خمر الـحبّ فی وادی الکآبة و الأنیـن
و أهـاب بالحبّ الودیـع، فـودّع العُـشّ الأمیـــن
وشدا بلحن الموتِ فی الأفق الحزین المسـتکین
ثـم اختـفی خلـف الغیـوم کأنّه الطیـف الحـزین
و یقول الشاعر لمّا الإنسان یذوق شراب الحب علیه أن یتحمّل الصبر الجمیل فی وادی الحزن و العذاب، و عندما یتخلی عن هذا الصبر الجمیل فیودّع الحیاة الزوجیّة و یترک لها الوداع من أجل الحب الصادق و الخالص و عندما یسکن فی مکان ٍ وحده و یحسُّ بالحزن المدید و ینشدُ بصوت الموت و یخرجُ من ساحة الحیاة و یظلُّ کطیفٍ من الحزن و الکآبة. [20] و کان مصورا ً آلام وطنه، موقظا ً فی أمته الروح الوطنیة، منمّیا ً فیها روح الأخلاق و الجهاد فی موهبة نفسیة أصلیة و کان یعیش اللغة العربیة و الشعر العربی. یتکوّن شعره من روح الاجتماع و ما حوله من الجریانات التی تمرّ علی الانسان فی مجتمع فیه الصعوبات و الآلام و الکوارث و العواطف هی تهزّ الانسان العربی و الشاعر من خلال أبیاته الوجیزة و ذات المعنی. [21] و ینتفض فی کارثة الزلزال التی أصابت بلدته نابلس، و هو یری دموع النساء و الأطفال، فیصوّر ذلک ببراعة تامة، فیقول فی المطلع الأول.
دموعُ النساء و الأطفال
یجرح ُ القلبَ أم دموعُ الرجال ِ
بلـدٌ کـانَ آمنـا ً مطمئنا ً
فــََرمــاهُ الـقـضــاءُ بـالـزلـزال ِ [22]
4- النزعة الرابعة فی الاجتماع (الطفولة):
لله مــا أحـلـی الـطفــولة! إنّهـا حُلـمُ الـحیــاة
عهدٌ کمعسُول الرُّؤی ما بین أجنحة السـُّبات
ترنـو إلی الدّنیـا و مـاضیهــا بعیـن ٍ باســمة
و تسـیرفـی عـدواتِ وادیهـا بنـَفس حـالـمه
[23]
یتذکر الشاعر عهد الطفولة و یصوّرها أحلی أیام عمره و کأنّها أحلام تسیر إلی الأمام و شَبـَّهَها بالعسل ِ ما بین الراحة و النوم و هذه الأیام تنظر إلی الدنیا بعین ٍ مفرحة و یمشی بشکل ٍ صعب و فیها العذاب و الأحلام، ینظر إلی أول أیام عمره سهلة و فیها أحلی و أروع لحظات الزمان و حین تبدی هذه الأیام إلی الحرکة تسیر سیرا ً حامل المشقات و الآلام و الخمودُ و الیأس و الحرمان.
إنَّ الـطـفــولة تـهـتـزُّ فی قـلب الــرّبـیع
ریانة من ریّق الأنداء فی الفجر الودیع
غَنـّت لها الدنیا أغانی حبـّها و حُبورهـا
فَتأوَّدَت نشوی بأحلام الحیاة و نـورها
[24]
و من جهة ثانیة یقول إنَّ أیام طفولتی تهتزُّ قلوب الربیع و النوروز کأنّها أشجارٌ تتحرک و محرّکها الطبیعة الباسمة و فی الفخر الهادیء تسقی الأشجار و ترویها لکی تنمو و تصل إلی مرحلة النضوج و یغنّی لها النسیم و یفرح بحبّها و تسیر الأغصان و تعوّج إعواجا ً کأنّها شخص سکران فی العلوّ بنور الشمس، و الحیاة تنهب من حالة الحلم التی تعیش فیه، و تعطی لنا حیاة جدیدة فیها الکثیر من الأمانی و الشوق الشدید.
إنّ الطفولة حقبة ٌ شعریة بشعورها
و دموعها، و سرورها، و طموحها
لم تمش ِ فی دنیا الکآبة و التعاسة و العذاب
فتری علَی أضوائها ما فی الحیاة من کِذاب
[25]
و من جهة أخری طفولة الشاعـر کأنّها حقبة فیها الذکریات من عـمره بإحساس طیب. و هذه الخواطر کلـّها کذب و افتراء، الفرح و الحزن و المغامرات و الکبر و الغرور، لم تسر بطریق صحیح بل هی حاملة حقیقة الحزن، و الیأس و الحرمان، ترجع إلی أحلام العـمـر و تنتهی بشکل غیر صحیح و غـیر مباشر ربّما أحداث من الزمن و ما فیه من أهـوال مهلکة و ظاهره سیئة.
5- النزعة الخامسة فی الاجتماع (حمایة الدین)
لقد نـام أهـل العلم نوما ً منغـطســا ً
فلم یسـمعـوا مـاردَدتـُه العـوالــم
ولکنّ صوتا ً صارخا ً، متصاعـدا ً
من الروح یَدری کنهه المتصامِم
سـیوقظ ُ منهـم کلّ مَـن هــو نـائــم
و یُنطلقُ منهم کلّ من هو واجـِم
[26]
یقول الشاعر هنا عندما الشعب لم یجب ما قالته العوالم و العلماء یستمرُّ بنومه و له تکن له حرکة و سیر و لم یعط فکرة قویة للعالم و یکون صوته خافضا ً فیه السکون
سـکـتم حُمـاة الدین! ســکنة واجـم
و نمتم بملیء الجفن، و السیلُ داهم
سکتم و قد شمتُم ظلاما ً، غصونه
عـلائــــم کفـــر ثـائــر و مـعـالـــــمُ
مــواکـب إلحـادٍ وراء ســکوتِکــم
تضجّ، و هـتا إنّ الــفضــاء مـأثــــمُ
[27]
و فی هذه المرحلة یقول إنّ حماة الدین سکتوا سکوتا ً عمیقا ً و ناموا بعین ملیئة بالأحزان و هذه الأخطار مستمرّة و یصبحون کفرة. و یقول الأستاذ مختار بن محمود عن الشابی: إنّه رجلٌ قوی الإیمان، ثابت العقیدة، متلاعب بدینه. فلیس هو من اولئک الذین یستترون بحجاب الفلسفة و الذکاء و اتساع النظر لیتوصلوا إلی العبث بالأدیان و المعتقدات، ثمّ یتخذونها سخریة و یجعلون مبادئها مجالا ً لعبثهم و سخافاتهم، ذلک الأمر الذی لا یسلم منه الشعراء المتقدمون، و الکثیر من الشعراء المتأخرین و إنّی لأتعجّب من بعض الناس الذین یحکمون بسرعة علی شاعرنا بأنّه شاعر مستهتر متلاعب بدینه. [28] ها هو یرکز موقفه الإیجابی علی التندید بموقف «رجال الدین» المسلمین السلبی، و هم المسؤولون الأولون عنه.
أفیقوا قلیل النوم ولـّى شبابه
و لا حبّ لآلاء الصباح علائم [29]
و قال إن «حماة الدین لم یفیقوا من نومهم، نوم الرفاهیة و الاستسلام للاستعمار و لم تکتحل أبصارهم بنور الحق و الحریة و هذا النوم و الخمود أتاح الفرصة للاستعمار لکی یستمرّ فی طریق الاستغلال و الاسترتاق و أتاح الفرصة لحماة الدین لکی ینالوا فرصة المناصب الکبیرة و الرواتب العالیة». [30] ولکن الشابی لا یترک لهم و للاستعمار الفرصة لسلب الشعب قوته و حقّه فی الحیاة و الحریة و الکرامة.
6- النزعة السادسة فی الاجتماع: (الوطن)
و لابدَّ هنا من وقفة عند قصیدة الشابی الشهیرة «إرادة الحیاة» و فیها خلاصة من آرائه الاجتماعیّة و صورة واضحة لأسلوبة الشّعری و للحیاة المتأججّة فی شعره. دواعی القصیدة أنّه فی خضم الحیاة القلقة التی تعیشها الأمم، ینبری الشعراء فیطلقون کلمة وحیهم لیوقظوا العیون الغافیة، و یهتفون فی أعماق تلک الأمم لیثیروا أصالتها و نبوغها فتتحوّل هتافاتهم إلی دم جدید یمسح من جبینها تغضُن العجز، و تنقض عن کتفیها غبار الحمول. فالشعراء فی الحقبات الحالکة من تاریخ الأمّة یستنفرون قرائحهم منارات إشعاع و إثارة، فیقلقون الجمود، و یفجـّرون القوی الکامنة فی وجدان الأمة لتنبعث منه طاقات التغییر، و معطیات العافیة و الکرامة و السیادة. هذا ما فعله الشابی عندما فتح عینیه علی وطن یتخبّط فی قیوده و أدرک أن الأرض التونسیة، لم یزلزلها صوت یحمل نبرة النبوة لن ترتعش فیها نبضات العزة، . و أن هذا الشعب لن یحطـّم أصنامه إذا لم تهزّه صیحة واحدة من الأبناء و الأحرار إنّ إیمان أبی القاسم بدور الشعب و وعیه وإرادته، هذه الإرادة القادرة علی بناء المصیر المُشرق إنّ هذا الایمان هو الذی فجّر فی قلبه هذه الحُمم فکانت « إرادة الحیاة». الفکرة الرئیسة فی القصیدة هی أن الطموح هو الذی یهتک حجب اللیل و یُطلع الفجر تقیـّا ً، و حبّ الحیاة وحده یشحذ الطموح حتی جنون التضحیة و البذل، فیُحطم القید، و یشرق نور الحریة و الاعتزاز:
إذا الشعب یوما ً أراد الحیاة
فلابدّ أن یستجیب القدر
و لابـدَّ للـّیـل أن یـنـجـلـــی
و لابدّ للقید أن ینکسـر
إنّها إرادة الشعب التی تقهر، فعلی الشعب أن یرید الحیاة، و الذین لا یعشقون الحیاة الکریمة یندثرون کالهباء فی مهبّ الریاح. فالحیاة تکره النفوس الضعیفة و الأیام لا تلین لغیر الأقویاء تلک سنّة الوجود، و تلک هی الحقیقة التی یفضی بها إلی الشاعر روح الکون الخفیّ:
وَ مَن لم یعانقه شوق الحیاة
تبخّر فی جَوّها و اندثـر
کذلک قالـت لی الکائنـات
و حدّثنی روحها المستتر
[31]
و ما هی ذی الریح تروی حکایة الطموح و إذا هی جرأةٌ، و إقدام ٌ، و تطلّع ذلی الأعلی فی غیر خوفٍ و لا حَدَر:
وَ من لا یحبُّ صعودَ الجبال
یَعش أبَد الدهر بینَ الحفر
[32]
ثم یتوجه الشاعر إلی الأرض و یسألها قائلا ً«یا أمّ، هل تکرهین البشر؟!» فتجیب الأرض أنّها تبارک فی النّاس أهل الطموح، و تلعنُ من لا یماشی الزمان و لا یعرف الجمود، و ذلک أن الکون حیِ، و الحیاة حرکة متطورة:
هـو الکون حیٌّ، یحبُّ الحیـاة
و یحتقر المیتَ مهما کبـر
فلا الأفق یحضنُ میتَ الطیور
و لا النحل یلثم میت الزهر
[33]
و هکذا الوجود لا یکبر إلا أبناء الحیاة الـذین یعملون فی صراع مُمیّز و بإرادة، بطلة فی سبیل الحیاة، أما الموتی فیدوسهم و یرمیهم فی زوایا الیأس و ظلمات الکآبة و ینطلق الشاعر فی تفضیل حکایة الحیاة، و فی سَرد قصّة الطبیعة التی تنفجر، بعد الشتاء وآلامه، حیاة ً تملأ الدنیا أزهارا ً و ثمارا ً. و هکذا فالمعانی تتلاحق و تتدافع کأنّها أمواج بحر خضمّ، و کأنی بالشاعر یخاطب بنی قومه و یستنهض عزائمهم، و فی موسیقی شعره و قوافیه ما یواکب معاینه و ما یزید عصفا و شدة تأثیر. و تمتاز هذه المعانی بعمقها و بُعد الرؤیة الشعریة. فکأن أبا القاسم یُغمض عینیه عن الوجود و یغیب فی یقظة الشعوریة، فتفتح أمامه آفاق الإبداع طلیقة، و یرفرف جناحاه فی عوالم یکثر فیها الجمال فیختار منه أجمله، و إلی جانب العمق و البعد الشعوری تتجلـی العاطفة جیّاشة تتدفق من الألفاظ إندفاقا ً و هذه العاطفة ولیدة الثورة الصاخبة فی ضمیر الشاعر، و الإحساس العصبیّ النبـّاض المختلج فی أعصابه.
أمّا الخیال، فابتکارٌ فی الصورة علی بساطة، و شرود ذهنیّ تائه لا یصحو إلاّ علی صیحة خارجة من أعماق النفس التی تـُعانی:
فلا الأفق یحضنُ میتَ الطیور
و لا النحلُ یلثم میت الزهـر
و لـولا أمـومــة قـلبی الـرؤوم
لفرّت عن المیت تلک الحفر
ففی هذا البیت الأخیر، الذی جعله الشاعر من لسان أمنّا الأرض، و ثبة تـُثیر الدهشة و الخشوع لما فیها من قوة فی الابتکار و قدرة علی تصویر الاحتقار للأموات. [34] یتحدث الشاعر عن إرادة الشاعر (إرادة الحیاة) و کیف أنّه إذا أراد شعب ما أن یعیش حیاة التحرّر و الانطلاق و یفضّ أغلال الماضی، فلا یملک القدر، إلاّ یحقق هذه الرغبة، فکأن الشاعر یرید أن یکون بحقیقة مؤداها من إرادة الشعوب. (خورشا، صادق، 1381هـ.ش، صص 137-139) الفکرة فی هذه القصیدة یرید الوصول إلی غابة ٍ رکب الصعب و من لا یسعی إلی المعالی داسته الحیاة و لا وسط بین المرتبتین، حتی الأرض نفسها تبارک الأقویاء الساعین إلی مطامحهم و تحتقر الکسالی المتقاعسین، و لو لا حنان الأم للفظت القبور ما بها من موتی، کما یلاحظ الشاعرأن الشاعر خلع الطبیعة مشاعره، و مزج بینها و بین حالته النفسیة الداخلیة، و هو أسلوب شاع بین شعراء و کتّاب المدرسة الرومانسیة و خاصة مدرسة المهجر. [35] ذلک بأنَّ الشابی انطوی من تجاربه النفسیّة القاسیة علی مفکـّر عمیق التفکیر، فکان لا یکتفی بأحاسیسه، و إنّما یحاول دوما ً أن یواجهها و أن یصرفها عن المرارة، و أن یمیل بها إلی الحیاة و هی التی انصرفت بطبیعتها نحو الأسی و الکآبة، و وقفت عند الموت لا تریم، و لا تحول عنه و لا تزول. و هذا هو مغنی قصیدته «إرادة الحیاة» التی شاعت و انتشرت و أحبّها کلّ قاریء عربی:
إذا الشعب یوما ً أراد الحیاة
فلابدّ أن یستجیب القدر
و لابـدَّ للـّیـل أن یـنـجـلـــی
و لابدّ للقید أن ینکسـر
[36]
و هو معنی شاعریته نفسها فی صمیم العذاب الذی أطبق علی حیاته منذ أحبّ تلک التی ماتت إلی أن أصیب بالداء العضال فی قلبه أی أنّ الآلام التی عاناها أبوالقاسم کان من شأنها أن تصدّه عن الحیاة، و الحبّ و الأمل، و عن کلّ ما هو فرح و متعة و حماسة، ولکن قوة نفسه، و صلابة عوده، و تعلـّقه الأصیل بما یسمو علی الأوصاب و الآلام، أمور أیقظته علی الفنّ الشعری لا فی کیانه، بل فی العالم کلـّه و بهذا کان أقرب النالس من أبناء الشرق.
النتیجة:
إنّ الشابی کان شاعرا ً رومانسیا ً ولکن لیس من جهة الإبداع بل من جهة تقلید الغربیین و رومانطیقیتهم التی أتخذها فکرة حیـّة من خلال شعره مع أنّه أصبح من اًعظم الرومانسیین ولکنّ خبرته الفنیة عرضها من خلال آلام شعبه و الطبیعة الساحرة. هو شاعر ذو مواهب و انفعالات صادقة و إحساس حیّ من خلال الوجود، خلـّاق فی تعبیراته و تصنعاته الشعریة و شخصیته تتکون من وطنیة صادقة و رومنطیقیة متشائمة أو بعیدة الأغوار فی کلّ مکان و زمان و أحداث، و فی أشعاره یذکرلنا الحب و الحیاة هذان اللفظان یتأثر بهما فی کلّ منهج من مناهج قصائده. عشق الحیاة و الإنسان من أهم موضوعاته الاجتماعیة.
جمیع أشعاره تدور حول موضوعات ثلاثة: التشاؤم و التفاؤل و الخروج من التشاؤم إلی درجات الصفاء الروحی. و نری الشعرالاجتماعی عنده بأسالیب مختلفة و کثیرة و بهذا قد امتاز عن سائر شعراء زمانه.
المصـــادر
1. أبوالخشب، إبراهیم علی: تاریخ الأدب العربی فی العصر الحاضر، دار الکتاب مصر، ط4، 1992م.
2. البعینی، نجیب: شعراء عرب معاصرون، دار المناهل، لبنان، بیروت، 1991م.
3. الحر، عبدالمجید: أبوالقاسم الشابی کوکب السَّحر، دار الکتب العلمیة، لبنان، بیروت، 1995م.
4. خلیل، جحا میشال: الشعر العربی الحدیث، دار العودة و دار الثقافة، لبنان، بیروت، 1999م.
5. خورشا، صادق: مجانی الشعر الحدیث و مدارسه، دفتر فرهنگ اسلامی، ایران، تهران، 1381هـ. ش.
6. الزّیات، أحمد حسن: تاریخ الأدب العربی، دار الثقافة، لبنان، بیروت، ط29، 1995م.
7. الشابی، أبوالقاسم: أغانی الحیاة، دار صادر، لبنان، بیروت، 1996م.
8. شکیب أنصاری، محمود: تطوّر الأدب العربی المعاصر، دار النشر جامعة شهید چمران، أهواز، ط3، 1382هـ. ش.
9. شیخو، الأب لویس: تاریخ آداب العربیة، دار المشرق، لبنان، بیروت، ط3، 1995م.
10. طراد، مجید: دیوان أبی القاسم الشابی و رسائله، دار الکتاب العربی، لبنان، بیروت، 1993م.
11. الفاخوری، حنا: الموجز فی الأدب العربی و تاریخه، ج4، دار الجیل، لبنان، بیروت، 1991م.
12. فروخ، عمر: الشابی شاعر الحبّ و الحیاة، دار العلم للملایین، لبنان، بیروت، ط3، 1974م.
13. فروخ، عمر: تاریخ الأدب العربی فی المغرب العربی، دار الأوساط، الکتب العلمیة، لبنان، بیروت، 1982م.
14. فروخ، عمر: تاریخ الأدب العربی، دار النشر توس، ایران، طهران، ط2، 1382هـ. ش.
15. قدورة، زاهیة: تاریخ العرب الحدیث، دارالنهضة العربیة لبنان، بیروت، 1985م.
16. محمد، کرو: أبوالقاسم الشابی حیاته و شعره، دار المکتبة العلمیة، لبنان، بیروت، 1995م.
17. محمّد، کرو: الشابی فی مرآة معاصریه، ج6 و 7، دار صادر، لبنان، بیروت، 1999م.
18. محمّد، کرو: دیوان أبی القاسم الشابی «أغانی الحیاة»، ج2، دار صادر، لبنان، بیروت، 1999م.
19. هدارة، محمد مصطفی: بحوث فی الأدب العربی، دار النهضة العربیة، لبنان، بیروت، 1994م.
حواشی
[1] (فروخ، عمر، 1974م، ص84)
[2] (المصدر نفسه، 1974م، ص87)
[3] (الفاخوری، حنا، ج4، 1991م، ص699)
[4] (فروخ، عمر، 1974م، ص88)
[5] (الفاخوری، حنا، ج4، 1991م، ص701 و702)
[6] (المصدر نفسه، ج4، 1991م، ص703)
[7] (الیعینی، نجیب، 1994م، ص275)
[8] (المصدر نفسه، ج4، 1991م، صص704 و 705)
[9] (المصدر نفسه ، ج1، 1991، ص 557)
[10] (هدّارة، محمد مصطفی، ج4، 1994م، ص 127)
[11] (المصدر نفسه، 1994م، ص 127)
[12] (المصدر نفسه، 1994م، ص 135)
[13] (طراد، مجید، 1994م، ص 116)
[14] (المصدر نفسه، 1993م، صص 135 و 136)
[15] (المصدر نفسه، 1993م، ص 137)
[16] (المصدر نفسه، 1993، ص 19)
[17] (المصدر نفسه، 1993م، ص 20)
[18] (محمد، کرّو، ج2، 1999م، ص 187)
[19] (المصدر نفسه، ج2، 1999م، ص188)
[20] (المصدر نفسه، ج2، 1999م، ص75)
[21] (المصدر نفسه، ج2، 1999م، ص261)
[22] (المصدر نفسه، ج2، 1999م، ص270)
[23] (طراد، مجید، 1993م، صص 61 و 62)
[24] (المصدر نفسه، 1993م، صص 61 و 62)
[25] (المصدر نفسه، 1993م، صص 61 و 62)
[26] (الشابی، إبوالقاسم، 1996م، صص 161)
[27] (المصدر نفسه، 1996م، صص 161)
[28] (محمد، کرّو، ج6، 1999م، ص 109)
[29] (المصدر نفسه، ج5، 1999م، ص 354)
[30] (المصدر نفسه، ج5، ص 354)
[31] (الفاخوری، حنا ، 1991م، ص558)
[32] (المصدر نفسه ، 1991م، ص558)
[33] (المصدر نفسه ، 1991م، صص559 و 560)
[34] (المصدر نفسه ، 1991م، صص560 و 561)
[35] (المصدر نفسه، 1381هـ.ش، ص139)
[36] (الشابی، ابوالقاسم، 1996م، ص16)
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:51|
الروایة
العربیة نشأتها وتطورها
التمهید
قبل أن نتحدث عن موضوع الروایة ودراسة التحولات والتطورات التی یترتب علیها، یجدر بنا أن نصدر کلامنا حول القصة عندالعرب ونوضّح موضعنا من القصة.
«القصة أوالحکایة من أقدم الأنواع الأدبیة، وربّما سبقت الشعر؛ فإنسان منذکان، کان شغوفاً متطلعاً إلی معرفة الأحداث الإنسانیة… وأدرک الکتّاب هذه الحقیقة منذ القدم، فحکوا الحکایات ثمّ کتبوها وربّما أضافوإلیها شیئاً من خیالهم أورووا أحداثاً من صنع الخیال وحده، فأطفأوا بذلک عطشاً کان فی الصدور.» [1]
القصة عبرالزمن
القصة فی عصر الجاهلی:
إن العرب منذ العصر الجاهلی کان لهم قصص وأخبار تدور حول الوقائع الحربیة، وتروی الأساطیر القدیمة، وعند ما ظهر الاسلام ونزل القرآن الکریم جاءهم أحسن القصص ثمّ تکونت علی هامش القرآن وتفسیره، قصص وحکایات استمرت موضوعاتها وعناصرها من تعلیم الدین الجدید. فظهرت قصص الأنبیاء وقصص المعراج وسیر النبی: «فاقصُصِ القصَصَ لَعَلهَّم یَتَفَکّرَون» [2]
القصة فی العصر الأموی
«وعندما نصل إلی عصر الأموی نری القصّة ظفرت بعنایة کبیرة حیث صارت مهنة رسمیة یشتغل بها رجال یسألون علیها الأجر وهذا ما دفع الرواة علی الخروج إلی البارئة لتألیف الروایات وجمع أخبار الأحباء والشعراء العاشقین كقصّة عنترة وعبلة، لیلی ومجنون، جمیل وبثینة کثّیر وعزة وغیرهم.»
http://etudiantdz.com/vbl t33304.htm
القصة فی العصر العباسی
وقد تطورت القّصة فی العهد العباسی، إذ بدأت طائفة من الکتاب ینقلون القصص الأعجمیة إلی العربیة حیث بلغت حوالی ستین ترجمة:
«ومن أشهرها «کلیلة ودمنة» لعبدالله بن المقفع حیث فتح باباً جدیداً فی الأدب القصصی العربی، وصار نموذجاً مثالیاً سارعلی منواله کثیر من الکتاب المتاخرین الذین صاغوا أفکارهم الفلسفیة علی لسان الحیوانات؛ ومن القصص الأخری الهامة «الف لیلة ولیلة» من أصل هندی أوایرانی، وقد أثر هذا الکتاب فی الأدب القصصی الجدیدة.
ومن القصص المؤلفة التی صاغها العرب أنفسهم هی «البخلاء»، وقد صوّر فیها أخلاق فئات من الناس، وهم البخلاء متعرضاً لهم آخذاً علیهم، ثمّ رسالة «التوابع والزوابع» لإبن شهید الأندلسی وهی قصّة خیالیة موضوعها لقاءات مع الشیاطین الشعراء، ثم رسالة الغفران لأبی العلاء المعری، وهی قصة خیالیة موضوعها سفر خیالی إلی الجنة والجحیم، لقی فیه أبوالعلاء شعراء الجنة والجحیم، وانتقد من خلاله الشعر فی العصر الجاهلی والإسلامّی. وقد تمیّزت هذه الرسالة بخیال خصب کما قال طه حسین، حیث جعلها فی عداد الآثار النادرة. وأما المقامات فهی أقرب الأنواع القصصیة فی الأدب العربی إلی القصّة الفّنیة الجدیدة، واعتبرها بعض المستشرقین أول مظهر للقصة العربیة، وهی قصة قصیرة تدور حول مغامرات بطل موهوم یرویها راوٍ معین، غایتها تعلیمیة؛ وقدأجمع المؤرخون علی أن بدیع الزمان هومبدع المقامات، ومن أعلامها بعده هوالحریری. وإضافة إلی هذه الأعمال القصصّیة نری القصّة واصلت سیرها فی تضخم وکثرة، ودخلت فیها الرحلات «رحلة ابن جبیر وابن بطوطة» والخرافات وسیر الأشخاص «سیرة عنترة وسیرة بنی هلال.» [3]
ویمکن أن نقول بأن القصة العربیة نشأت وتطورت تحت ظروف وعوامل حسب المعتقدات والأساطیر وأن الادب العربی القدیم بما فیه تراث قصصی عظیم من القصص القرآنیة، قصص الأنبیاء وسیر النبی، والمقامات والرحلات والقصص الخیالیة والتراجم الذاتیة وقد ترک تراثاً ضخماً من مجال الأدب القصصی، وهوالذی أثر تأثیراً عمیقاً فی رأی بعض المعاصرین- فی نشأة الأدب القصصی الغربی وتطوره فیما بعد.
القصة فی عهد الانحطاط:
ومع هجمة التتار وسقوط الخلافة العباسیة بدأت فترة الانحطاط الأدبی فی الأدب العربی؛ الأمر الذی أدّی إلی خمود الحرکة الفکریة والأدبیة من جهة والتشاغل عن حفظ هذا التراث الضخم من جهة أخری، ولأجل ذلک قلّما نشاهد فی هذه الفترة التی امتدت ستة قرون إبداعاً بارزاً فی مجال القصة.
القصة فی الأدب العربی الحدیث:
«هناک اختلاف رأی بین العلماء المحدثین فی نشأة القصة العربیة الحدیثة؛ فمن یتحمّس منهم لأصلها العربی ویری أنها ولیدة التراث القدیم واستمراراً له، ومن ینفی أن تکون هناک أیة صلة بین القصّة الجدیدة وبین تلک الأنماط القصصیة القدیمة ویراها أنها ولیدة الاحتکاک بالغرب والتعریف إلی نتاجه القصصی ونقله إلی العربیة.» [4]
« إن أغلب الدراسات التی تناولت هذه القضیة، قد اتفقت علی أن الروایة هی نوع أدبی وفد إلینا من الغرب بعد الإتصال الحدیث به. وهذا الرأی هوالرأی الأصوب والأدق علمیا، لأن الرأی الآخر، والذی یری أن الروایة هی أمتداد لأنواع قصصیة عربیة قدیمة، لا یفهم الفارق الواضح بین فنیة تلک الأنواع القدیمة وتنوعها، وبین الخصائص الفنیة للروایة کنوع أدبی محدد. هذا بالاضافة إلی أنه یتصور أن الأنواع الأدبیة تسیر سیرتها الحیاتیة المستقلة، وتنقل من زمن إلی آخر بحریة مطلقة لا تقیدها حدود الزمن وتطور البشر منتجی هذه الأنواع الادبیة؛ أی أنهم یعزلون هذه الأنواع فی ذاتها، ویفصلونها عن تاریخیتها، التی هی المکون الأصلی لها.» [5]
وهناک قول آخر من یحیی حقی عن موضوع المذکورة. «القصة جاءتنا من الغرب… وأول من أقام قواعدها عندنا أفراد تأثروا بالأدب الأروبی والأدب الفرنسی بصفة خاصة.» [6]
هکذا قال یحیی حقی وأكد إسماعیل أدهم ومحمد تیمور وإبراهیم المصری ومحمد حسین هیکل: «لم تکن الصلّة قویة بین القصة العربیة الحدیثة وسابقیها القصّة العربیة القدیمة، فلم تبرز الأولی إلامن طریق الاتصال بالغرب. ففی النصف الثانی من القرن التاسع عشر المیلادین، هیأت الظروف للاتصال الفکری بالغرب، وعلی الأخص فی لبنان، فأعجب المثقفون بالقصّة الغربیة وبخاصة منها الفرنسیة.» [7]
کما لم یکن المصریون یطلبون فی ثورتهم هذه (1919) الاعتراف باستقلالهم وسیادتهم ویطلبون حیاة سیاسیة وصوراً من الحریة السیاسیة علی مثال ما فی الغرب سواء؟ فلتکن مظاهر الفن مصبوبة فی قوالب غریبة لتکون آیة للناس جمیعاً علی تقدمهم وعلی أنهم سابقون الغرب إلی میادین الحضارة وقد یسبقونه.» [8]
الرویایة العربیة المعاصرة
وإذا فحصنا فی القصة العربیة المعاصرة، فهی فن جدید یختلف شأنها عن شأنها القدیم، اتضحت لنا أنّها مرت بثلاث مراحل أساسیة ظهرت فی کل منها مجموعة هائلة من أنواع القصة وهی:
- الف: مرحلة التقلید والتعریب (1914- 1850)
- ب: مرحلة التکوین والإبداع (1939- 1914)
- ج: مرحلة التأصیل والنضج (1939- حتی الان)
الف: القصة العربیة فی مرحلة التقلید والتعریب:
«وعلی الرغم أن غالبیة الباحثین قد أنکرت الصلة بین القصة العربیة الحدیثة وبین التراث القصصی عند العرب، إلا أن هذا الإرتباط موجود بشکل بارز فی صیاغة الشکل والمضمون، إذ بدت القصّة الحدیثة فی بدء تطورها متأثرة بالأجناس القصصیة المأثورة کالتراجم والمقامة و…، ومن أوضح أمثلتها للتاثر بفن المقامة هو«حدیث عیسی بن هشام» للمویلحی (1900) حیث یبدوفیه التاثیر العربی واضحاً فی العنایة بالأسلوب والأحداث التی تحدث للبطل الذی یتصل بشخصیات متعددة، کما أن الأثر الغربی أیضاً یبدوفیه جلیاً من حیث تنویع المناظر، وتسلسل الحکایة، وبعض ملامح التحلیل النفسی.» [9]
«إن التسلیم بکون الروایة الحدیثة متاثرة أومنقولة عن الغرب، هوحقیقة تاریخیة سلم بهارواد هذا النوع الأدبی منذ البدایة، غیر أننا نستطیع أن نجد موقفین مختلفین لهؤلاء الرواد خلال العقود الأربعة الأولی من هذا القرن العشرین. فکل هولاء بدأوا بالتأکید هذه الحقیقة، مع الدعوة إلی الإیغال فی تقلید النموذج الروایی الغربی؛ وذلک خلال العقدین الأول والثانی من القرن.» [10]
وفی أواخر القرن التاسع عشر ظهرت موجة جدیدة فی الأدب القصصی الحدیث، وذلک إثر ترجمة القصص الغربیة ونمت هذه الموجة فی مصر ولبنان. فراحویترجمون القصص الغربیة التی کانت موضوعاتها فی الأغلب، رومانتکیة حول الحبّ والجنس وقد بدأت هذه الموجة علی ید اللبنانیین؛ منهم «سلیم السبتانی» الذی اعتبر الرائد الأول لهذا التیار. ومن أعلام القصة والروایة العربیة فی هذه المرحلة«فرح أنطوان»، «نقولاحداد»، «یعقوب صروف»، «لبیه هاشم»، «طاهر حقی» و«المنفلوطی».
«وصفوة القول فی القصة والروایة فی هذه المرحلة أن أعمال هؤلاء الکتاب کانت فی أغلبها تقلید القصة الغربیة، یغلب علیها السرد التاریخی أوالإجتماعی… ولکن هناک ظاهرة فنیة یجدر الوقوف عندها، وهی الجهود الروائیّة للذین مضوا إلی المحبر، فأتیح لهم الإطلاع علی النماذج القصصیة الغربیة بکامل الوجه، فتأثروا بها فنضجت أعمالهم حیث تختلف عن النماذج القصصیة فی البلد العربی، فلاشک أن إنتاجات جبران من القصة والروایة ک «عرائس المروج 1906» و«الأرواح المتمردة 1908» و«العواصف 1910» و«الأجنحة المتکسرة 1912» وکان لها طعم جدید، إذ یبدوفیها روح التمّرد علی عوامل الجمود وموانع التطور… ثمّ من الذین هاجروا خارج الوطن العربی وکتبوا فیه وخرج نتاجهم ثمرة لتزاوج المجتمعین العربی والأروبی، «الدکتور محمد حسین هیکل» الذی نشر روایة «زینب 1914» حیث اعتبرت هذه القصة فی رأی البعض بأنها بشّرت مرحلة جدیدة فی القصة العربیة، ألاوهی مرحلة التکوین القصصی العربی.» [11]
ب: مرحلة تکوین القصة العربیة الحدیثة (1939- 1914)
إن فترة ما بین الحربین العالمیتین اعتبرت مرحلة تکوین الأدب القصصی والروائی عند العرب، فالحرب العالمیة الأولی وما تبعها من أحداث وتحولات فی ترکیب المجتمعات العربیة، من تغییر فی القیم والموازین، ومن تطور فی الثقافة والسیاسة والوعی القومی والانتفاضات الوطنیة و… کل هذه خلقت جواً جدیداً وذوقاً مختفاً عن سابقه وتطلبت بناءً وأسلوباً جدیداً للتعبیر عن هذه التحولات الجدیدة. وتمتاز قصص هذه المرحلة بمایلی:
«تعالج موضوعات من تجارب الکتاب أنفسهم، فالبطل فی کل قصة کاد منها یکون الکاتب نفسه. أوهونفسه علی الاطلاق:
- استطاع فیها الکتاب أن یغوصوا فی أعماق نفوس الأبطال ویحلّلوها.
- طغت علیها کلها النزعة الرومانسیة التی کانت تسود العصر.
- عبرت عن قدرة الکّتاب علی تکییف الأسلوب اللغوی مع وسائل التعبیر فی القصّة من سرد وحوار ونجوی ووصف.» [12] «وهکذا أخذت القصة العربیة بعد الحرب العالمیة الأولی طابع المحلیة والقومیة، وبدأت تصور فئات من المجتمع المصری أواللبنانی أوالسوری أوالعراقی بغیة تحسین فضاءِ المجتمع…» [13]
من أعلام هذه المرحلة طه حسین الذی له دورهام فی إرساء قواعد الفن القصصی ومن أعماله: الأیّام (1929)، أدیب (1935) حیث انتقد فیها القضایا الاجتماعیة والتعلیمیة والتربویة فی المجتمع المصری. ومنهم توفیق الحکیم الذی عنی بتصور الواقع عن حیاة الاجتماعیة ومشکلاتها ومن آثاره: عودة الروح (1931)، یومیات نائب فی الأریاف (1937) وعصفور من الشرق (1938).
ج: مرحلة تأصیل القصة العربیة:
«هذه المرحلة هی المرحلة الأخیرة فی تطور القصّة والروایة العربیة، والتی اعتبرت قمة المراحل واتسمّت بمرحلة التأصیل وقد تداخلت هذه المرحلة بالمرحلة السابقة عقداً من الزمن حیث کانت الثلاثینات خاتمة مرحلة التکوین ومدخلاً إلی مرحلة التأصیل حیث اختارت الروایة والقصة العربیة اتجاهاً جدیداً نتیجة لأسباب وعوامل مختلفة لم تکن میسرة لهما فی المرحلة السابقة.» [14] ففی هذه المرحلة ظهر عمالقة القصة العربیة الحدیثة کنجیب محفوظ وتوفیق یوسف عوّاد وجبرا إبراهیم جبرا. «تناول هولاء الکّتاب وأمثالهم وهم کُثُر، الکثیر من القضایا الحیاة العربیة ببناء فنی قوی یختلف من کاتب إلی آخر. باختلاف المدارس الأدبیة والنزعات الفکریة والسیاسیة وهکذا غطت القصّة مساحة واسعة من حیاة الناس، فهناک القصة الإجتماعیة والقصّة السیاسیة، والقصة التاریخیة، والقصة الفلسفیة، فعولجت مشکلات الحرب وویلاتها فی قصة «الرغیف» لتوفیق یوسف عواد، ومشکلات العصر الإنسانیة، کعبثیة الحیاة، وغربة الانسان وضیاعه، والانفصال عن الواقع فی قصص «اللص والکلاب» و«الطریق» و«السمان والخریف» لنجیب محفوظ.» [15] اتجاهات الروایة العربیة:
لحد الان ماذکرنا حول نشأة الروایة والاتجاهات التی ظهرت فیها، کانت کلها مطبوعة بطابع الروایة التقلیدیة، لکن فی أواخر السنیات وبدایة السبعینات ظهرت ثورات عنیفة علی الروایة التقلیدیة المستهلکة، أدت إلی ظهور إتجاهات جدیدة، وإن کانت هی متأثرة بالغرب لحد بعید، إلا أن التاصیل والتکوین ظهرا فیها أسرع وقت ممکن وهذه الاتجاهات الجدیدة هی:
أ: روایة تیار الوعی:
کان هذا الاتجاة بمثابة ثورة عارمة علی الروایة التقلیدیة، وقد بدأ فی الأدب الغربی فی نهایة القرن التاسع وامتدت إلی النصف الأول علی ید «مارسل بروست» و«جیمس جویس»… وبظهور هذا التیار تغییر الأسلوب، وأصبح کتشاف العقل والباطن الخفی مثار الإهتمام، لأنه المحرک الأساسی للفکروالسلوک ومقومات هذا الاتجاه أوالتیار تتخلص فیما یلی:
- الف) المونولوج الداخلی المباشر، وفیه یغیب المؤلف، ویتم فیه بضمیر المفرد والغائب.
- ب) المونولوج الداخلی غیر المباشر: وفیه یحضر المؤلف عبر الوصف والتعلیق، ویقوم الحکی فیه بضمیر المتکلم.
- ج) وصف الوعی الذهنی للشخصیات
- د) مناجاة النفس
- ه) التداعی الحر من طریق الخیال والحواس
- و) المونتاج السینمایی عن طریق تعدد الصور وتوالیها.»
[16]
ب: الروایة الطلیعیة:
«والاتجاه الثانی فی الروایة العربیة بعد السبعینات هوالاتجاه الطبیعی أوالروایة الطلیعة. وهی تعنی استخدم تقنیات فنیة جدیدة تتجاوز الأسالیب والجمالیات السائدة والمعروفة، لکن بهدوء وبطءِ وتمهّل. وقد تمیزت الروایة الطلیعة باستخدام تقنیات السینما، والتقطیع إلی صور ولوحات مستقلة تعطی مجتمعة انطباعاً واحساساً واحداً، کما تمیزت باستخدام المونولوج الداخلی والفلاش بک فی تصویر ماضی الأبطال، کما أن میزانته الأخری أسلوبها الشعری، والنسبیة أوالنظر إلی الحادثة الواحدة من زوایا مختلفة وعدیدة. ومن الروائییئن العرب الذین تجلت هذه العناصر فی نتاجاتهم، «جمال الغیطانی»، «صنع الله إبراهیم»، «إمیل حبیبی»، «جبرا إبراهیم جبرا»، «الطاهر وطّار»، «عبدالرحمن منبف» و«الیاس خوری…» [17]
ج: الروایة التجربیة:
«هذا الاتجاه أحدث إتجاه ظهر فی العالم الروایی، والذی اعتمد علیه المعاصرون بوصفه تفنیة جدید، من أجل تجاوز واقعهم الفنی المستهلک، فقامت الروایة التجربیة علی توظیف البناءات والأحلام اللغویة، واستقلال تفنیات الشعور واللاشعور، وانثیال الوعی واللاوعی والأحلام، وإلغاء عنصری الزمان والمکان. وقد ظهر هذا الاتجاه بغیة بناء أدب مضادّاً للإبداع المتعارف علیه مسبقاً عن طریق تدمیر البنیات الشکلیه للروایة، والعناصر الفنیة، تفجیر اللغة، والخروج علی الأنماط الروائیة السائدة نحوالإبداع والابتکار والولوع إلی عالم مستقبلی مجهول منقطعاً عن الماضی والحاضر، متفاعلاً إلی الروائی السابق.» [18] وهناک مجموعة من العوامل، التی تکاتفت فی فترة استینات، فیما یختص الحداثة الروائیة بعامة وشعریة اللغة التی تعد العمود الفقری بخاصة وخصوصاً مرحلة ما قبل هزیمة حزیران وبعدها ونعرض لهذه العوامل قبل الهزیمة ومنها:
1) الروایة الجدیدة فی فرنسا، إذ ترجمت بعض النصوص خلال الستینات، ومن روادها «ناتالی ساروت» و«روب غربیة» و«میشل بوتور» و«کلود سیمون» وغیرهم … 2) التاثر بالاتجاه الرمزی فی اروبا الذی ولد فی النصف الثانی من القرون التاسع عشر، خاصة فی مجال الشعر علی ید أقطاب منهم «بودلیر» و«رامبو» و«مالارمیه» و«بول فالیری». 3) التاثر بالحرکة الرومانسیة العربیة التی شهدت تألقا فی الثلاثینات والأربعینات، فادا کانت الرومانسیة فی بعض مواضیعها تصور البؤس والجوانب الظلمة فی المجتمع. فروایة الستینات کذلک … 4) التاثر بأعمال أدباء المهجر، الذین تنحوأعمالهم النثریة المنحی الشعری فی لغتها وفی مقدمتهم جبران خلیل جبران، حیث نجد إشارة صریحة فی روایة «ستة أیام» لحلیم برکات إلی جبران وکتابه «النبی»، فقد اقتبس حلیم برکات فی أکثر من موضع من کتاب النبی لجبران.» [19] «لقد طّور جیل السنیات فی الروایة العربیة فی الشکل الروایة والروایة التی استقرت فی أعمال نجیب محفوظ الکلاسیکیة، وإن تجلی ذلک فی مرحلة السبعینات وما بعدها، وخصوصاً ما بعد هزیمة حزیران التی فضحت کل شیءِ بما فی ذلک طرائق الکتابة وأسالیبها ونظرتها الواثقة إلی العالم.» [20] الروایة عناصرها وأنواعها: فی الحقیقة إن الروایة نوع من أنواع القصة وعندما نرید أن نتحدث عن الروایة عناصرها وأنواعها لابدنا أن نتکلم عن أنواع القصة:
أنواع القصة:
للقصة ثلاثة أنواع اصطلح علی تمسیتها مایلی:
«الروایة: هی غالباً قصة طویلة، أشخاصها عدیدون وأحداثها متشابکة تعرض من خلالها طباع الشخصیات وتحلل فی نموها وتکاملها خلال العمل القصصی.
القصة: غالباً ما تکون متوسطة الحجم، تقوم علی اشخاص لاتضاح جوانب طباعهم کلها، إذ تقوم القصة علی جانب من جوانب الشخصیة ولیس علیها متکاملة.
الأقصوصة: قصة قصیرة، تصّور البطل فی حالة من حالاته وتکون أحداثها قلیلة لاتتجاوز هذه الحالة التی تصورّها.» [21]
عناصر الروایة الحدیثة:
الحدث والشخصیات والبیئة والأسلوب والهدف ما هوالحدث فی الروایة الحدیثة: «هوحدث واحد، أوجمله أحداث متشابکة مترابطة یسوقها الکاتب بفنیة عالیة وصولاً بها إلی هدفه أوإلی فکرته التی یرید أن یضعها فیعرفها القاری.» [22] ویستمد الکاتب هذه الحدث أوهذه الأحداث من مصادر وهی:
1. واقع حیاة الناس.
2. واقع حیاة الکاتب.
3. ثقافة الکاتب وتشمل التاریخ البشری.
4. خیال الکاتب.
«وقد تکون الروایة مستمده من واحد من هذه المصادر أواکثر غیر أن المصدر الرابع وهوالخیال، لا بد أن یکون صاحب دور فی کل حدث، إذ لا نهوض لعمل فنی نهوضاً صحیحاً ما لم یکن للخیال فیه دور، حتی ولوکان دور التنظیم أوالتقلید أوالإضافة.» [23]
العمل القصصی:
العمل القصصی هوجملة الأحداث التی تتشابک فی حبکة یحبک بها الکاتب هذه الأحداث، وتولّف هذه الأحداث مجتمعه موضوع القصّة من بدایة ها إلی نهایتها. ما هی الحبکة: «الحبکة هی عملیة نسج الأحداث فی ثوب فنی یتمثل فی بدایة تمهّد للحدث، وحبکة یتأزم فیها الحدث ونهایة یکون فیها حل الأزمة.» [24] لکل روایة «بدایة وحبکة ونهایة» لکن ترتیب هذه الأقسام الثلاثة لیس ضروریاً ونری فی الروایة ثلاث طرائق فی بناءها: «الطریقة التقلیدیة: وهی التی یتحرک فیها الحدث تحرکاً سبیاً أوزمنیاً من البدایة إلی الحبکة وإلی النهایة ومن أمثال ذلک قصة «أنا کارنینا» لتوستوی و«زقاق المدق» لنجیب محفوظ. الطریقة الحدیثة: فی هذه الطریقة یضعک الکاتب فی قلب القصة، فی أزمتها حیث یکون بطل القصة فی شده نفسّیة تمزّق روحه، ویسعی الکاتب إلی النهایة إلی الحل تارکا للبطل أن یتذکر الماضی… . وهذا ما نراه فی قصة «اللص والکلاب» لنجیب محفوظ.
الطریقة الخطف خلفاً: تبداً القصّة فی هذه الطریقة من النهایة، کان یضعک الکاتب أمام حدث مثیر، ثمَّ یأخذ بالبحث عن أسباب هذا الحدث المثیر، فیقودک البحث إلی البدایة وأکثر ما نجد هذه الطریقة فی القصص البولیسیة، مثل قصة «لغز الصورة» لأغاتا کریستی.» [25] نحن فی الروایة لدنیا نوعین من الحبكة من حیث ترابط الأحداث: 1- حبکة محکمة وهی أن تکون الأحداث تترابط وتتشابک بعضهم ببعض 2- حبکة مفککة: وهی أن الأحداث لا تترابط ولا تتشابک ببنهما بل یکون کل حدث یشبه بقصة قائمة فی ذاتها.
الشخصیات:
«الشخصیات القصصیة هی التی تحمل الحدث القصصی وتطوّرها من بدایاته إلی وسطه أوحبکته حیث الأزمة ، فالنهایة حیث تنحّل عقدة القصة ویشبع القاری فضوله.» [26] فی الروایة ثلاثة أنواع من الشخصیات:
1) شخصیة أساسیة أو(محوریة) : وتکون هی البطل فی القصة کشخصیة سعید «مهران« فی قصه «اللص والکلاب» وشخصیة «وکییل النائب« فی روایة «یومیات نائب فی الأریاف»، لتوفیق الحکیم …
2) شخصیة معارضة: ویقوم الصراع بینها وبین الشخصیة المحوریة کشخصیة «درویش عصفور» فی روایة «یومیات نائب فی الأریاف» لتوفیق الحکیم.
3) شخصیات مساعدة: فهم إلی جانب الشخصیتین المحوریه والمعارضة كرجال الشرط فی قصه «اللص والكلاب» لنجیب محفوظ.
والكتاب یرسم شخصیات القصة أوالروای علی إحدی الطریقتین: هما:
>> الطریقة التمثیلیة: وفیها یعمد الكاتب إلی رسم ملامح الشخصیة معتمداً علی الحوار تارة وعلی نجوی داخلیة علی لسان الشخصیة نفسها حیناً وعلی أحادیث تطلقها الشخصیات بعضها عن بعض أحیاناً أخری. 2- الطریقة التحلیلیة: وفیها یعمد الكاتب إلی أن یتدخل هونفسه تدخلاً مباشراً فیرسم بعض ملامح شخصیاته بالتعلیق المباشر علیها أوبتصویر ردّات أفعالعا تجاه الاحداث.» [27] البیئة:
«تشمل البیئة عنصری المكان والزمان تدور فیها أحداث الروایة وتتحرك شخصیاتها، فكل بیئة تترك طابعها علی الشخصیات وعلی الأحداث فشخصیات الكاتب حنامیته، الذی أدار معظم أحداث روایته علی شاطی البحر وفی موائته، تختلف كثیراً، فی أسلوب حركتها وردّات أفعالها تجاه الأحداث عن شخصیات الكاتب عبد السلام العجیلی. الذی یدیر أحداث روایاته ویحرك شخصیاته… نعنی بالبیئة القصصیة كل ما
یحیط بالأحداث والشخصیات من ظروف طبیعیة جغرافیة أواجتماعیة بشریة.» [28]
أسلوب الروایة:
«الأسلوب فی العمل القصصی هوجملة الأدوات الفنیة التی یستخدمها الكاتب للوصول بقصته إلی غایاتها. وهی السرد، الحوار، المناجاة، الوصف.» [29]
السرد:
«السرد هو روایة الحدث، أوحكایته بأسلوب لغوی یلائم أحداث الروایة ویلائم جماهیر العریضة التی ستقرأ هذا العمل بمختلف ثقافاتها ولهذا وجب أن تمتاز لغة السرد.» [30] «الحكی اوالسرد تعرف التحدیدات العربیة للعدید من المصطلحات المعاصرة من الخلط والغموض ولعل أهم مفهوم یستوقفنا أولاً، وقبل الحدیث عن «القصّة» و«الخطاب»، هومفهوم «الحكی» التی نضعه مقابل (levecit) فی الفرنسیة و(navvative) فی الانجلیزیة.» [31]
واللغة الغالبة علی هذا النوع من العمل القصصی هی لغة الاسلوب الفصحی الذی یتجه نحو السهولة ومجرد إیصال المعنی إلى القاری بأسهل الطرق.
یسرد الكاتب الروایة بإحدی طرائق الاربعة:
1) الطریقة الذاتیة: وهی التی یستخدم فیها الكاتب المتكلم مستعیناً عن دور الروایة فیها ومن هذه القصص «الحب الضائع» لطه حسین.
2) طریقة الرسائل أوالمذكرات: وهی طریقة تعتمد علی رسائل تتباد لها شخصیات القصّة، أوعلی مذكرات یومیة یكتبها بطل الروایة أوإحدی شخصیاتها ونذكر من هذا النوع «یومیات نائب فی الاریاف» لتوفیق الحكیم. وهذا تعتمد المذكرات یومیة.
3) الطریقة التقلیدیة: وهی الطریقة التاریخیة التی یعتمد فیها الراوی علی الضمیر الغائب وبهذه الطریقة كتب اكثر القصص ومنها «اللص والكلاب» لنجیب محفوظ.»
[32]
الحوار:
وهو من أسالیب فن القصصی:
«وقد أثر أسلوب الكاتب التقریری فی استخدام للحوار الذی یبدودوره ضئیلاً إلی حد كبیر، فی هذا النوع من الروایة، فهم یتجهون فی الغالب إلی التهرب منه ویعلنون هذا التهرب صراحة كما یفعل نقولا حداد فی روایته «العجائب والغرائب الامریكیة» فیقول بعد محادثة برهة فی عدة مواضیع لا یهتم القاری كثیراً نهضت البدینة مستأذنة فی الذّهاب. والوسیلة المتبعة فی التخلص من الحوار هی تحویلة إلی أسلوب السرد.» [33]
ولا نجاح للحوار فی الروایة إذا لم یتسم بمایلی: «1- أن یكون له دور فی بناء القصة. 2- أن یكون مرتبطاً ارتباطاً عضویاً بالشخصیة فلا یفرض علیها قرضاً. 3- أن تكون لغته الشخصیة التی تتكلم، وبحسب المواظف التی تقتضی هذا الكلام.» [34] النجوی الداخلیة:
النجوی هی صوت داخلی لا یسمعه إلا صاحبه أما دورها فكبیر فی الروایة. فهی:
«1- قد تسعید أحداثاً مفقودة فی لحمة القصة.
2- قد تكون وسیلة فی الكشف عن شخصیات أخرى وتصویرها.
3- قد تكون الوسیلة من وسائل تطویر الحدیث.
4- قد تكون الوسیلة الوحیدة فی بناء القصّة كلّها كما فی القصص التی تعتمد طریق «یتار الوعی» فی السرد ویلزم فی اللغة لمناجاة كما فی غیرها الخفة والسهولة إلی جانب مشاكلتها للشخص الذی ینطلق داخلة بها.» [35]
الوصف
الوصف هوأداة من أدوات الكتاب فی بناء الروایة وقد یكون فیه البیئة التی تجری فیها الأحداث وقد یرسم شكل الشخصیة من الخارج أوصورة للنفس والخ.
«للوصف دور إیجابی فی تكامل القصّة إذا جاء فی قصد، فلا یكون إلا تمهیداً لحدث قد یقع كما فی وصف الطبیعة، أوتهیئة للحوادث التی تنهض بها الشخصیات، حتی لا تكون هذه الحوادث مخالفة لطبیعة الأشیاء، كما فی وصف البیئة الأجتماعیة التی تجری الحادثة فیها، أوتكون كشفاً عن دواخل الشخصیة وتحلیلاً لا نفعالاتها.» [36]
الهدف:
«هوالفكرة التی یحملها الكاتب إلی القاریء بتجسیدها فی أحداث تنهض بها شخصیات فی بیئة معنیة، أی بتجسیدها فی قصّة، وبذلك القّصة كلها قد بنیت من أجل إیصال هذه الفكرة إلی القاریء، إلی جانب تسلیته وإمتناعه.» [37]
مثال ذلك الفكرة وجود الظلم السیاسی والمشكلات فی نظام الاداری فی مصر فی روایة «یومیات نائب فی الأریاف» لتوفیق الحكیم وأیضاً فكرة عبثیة الحیاة فی قصة «اللص الكلاب» لنجیب محفوظ علی كل حال یجب أن یكون هدفاً وراء الروایة وحتی یعرف القاریء هذا الهدف خلال قرائته الروایة.
حواشی
[1] جمع من المولفین، المفید فی الأدب العربی، الجزء الثانی. دارالعلم للملأبین، ص 363. لاتا
[2] القرآن الکریم. سوره الاعراف. الآیة 176
[3] المصدر السابق. الصفحة نفسها.
[4] المصدر نفسه
[5] الدکتورسید البحراوی: محتوی الشکل فی الروایة العربیة النصوص المصریة الاولی. الهیئة المصریة العامة للکتاب 1996.ص370
[6] یحیی حقی. فجرالقصة المصریة. المنبة الثقاضة، الهئبة المصریة العامة للکتاب القاهرة. 1986. ص 2
[7] المفید فی الادب العربی- دارالعلم للملائین. ص 38
[8] محمد حسین هیکل: ثورة الأدب. دار المعارف بمصر. ط 4. 1978. ص 75
[9] المقال http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/
[10] الدکتور سید البحراوی: محتوی الشکل فی الروایة العربیة. النصوص المصریة الأولی الهیئة المصریة العامة للکتاب 1996. ص 38
[11] . http://etuiantdz.com/vb/t33304.htm
[12] جمع من المؤلفین. المفید الأدب ابویی، الجزء الثانی. دارالعلم للملائین. ص 385 لاتا.
[13] HYPERLINK "http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/" http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/
[14] المصدر السابق. الصفحة نفسها.
[15] جمع من المولفین. المفید فی الادب العربی. الجزء الثانی. دار العلم للملائین. ص 385 لاتا
[16] HYPERLINK "http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/]" http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/
[17] المصدرالسابق . الصفحة نفسها
[18] المصدر السابق. الصفحة نفسها
[19] المصدر نفسه ص 13
[20] د. ناصر یعقوب:الغة الشعریة وتحلیلاتها فی الروایة العربیة(1970- 2000).المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت. ص 17
[21] جمع من المولفین. المفید فی الأدب العربی. الجزء الثانی. دار العلم للملائین. ص 365 .لاتا
[22] المصدر نفسه . ص 365
[23] المصدرالسابق . ص 366
[24] المصدر نفسه . ص366
[25] المصدر نفسه . ص376
[26] المصدر نفسه . ص 368
[27] المصدر نفسه . ص369
[28] المصدر نفسه ص 371
[29] المصدر نفسه ص 372
[30] المصدر نفسه ص 372
[31] سعید یقطین. تحلیل الخطاب الروایی. المركز الثقافی العربی 2005 . ص 46
[32] جمع من المولفین. المفید فی الادب العربی. الجزء الثانی. دار العلم للملائین. ص 373 لاتا
[33] الدكتور عبدالمحسن طه بدر: تطور الروایة العربیة الحدیثة فی مصر (1870 – 1938) دارالمعارف . ص 173 لاتا
[34] جمع من المولفین. المفید فی الادب العربی. الجزء الثانی. دار العلم للملائین. ص 374 لاتا
[35] المصدر نفسه. ص 375
[36] المصدرالسابق . ص375
[37] المصدر نفسه . ص
قبل أن نتحدث عن موضوع الروایة ودراسة التحولات والتطورات التی یترتب علیها، یجدر بنا أن نصدر کلامنا حول القصة عندالعرب ونوضّح موضعنا من القصة.
«القصة أوالحکایة من أقدم الأنواع الأدبیة، وربّما سبقت الشعر؛ فإنسان منذکان، کان شغوفاً متطلعاً إلی معرفة الأحداث الإنسانیة… وأدرک الکتّاب هذه الحقیقة منذ القدم، فحکوا الحکایات ثمّ کتبوها وربّما أضافوإلیها شیئاً من خیالهم أورووا أحداثاً من صنع الخیال وحده، فأطفأوا بذلک عطشاً کان فی الصدور.» [1]
القصة عبرالزمن
القصة فی عصر الجاهلی:
إن العرب منذ العصر الجاهلی کان لهم قصص وأخبار تدور حول الوقائع الحربیة، وتروی الأساطیر القدیمة، وعند ما ظهر الاسلام ونزل القرآن الکریم جاءهم أحسن القصص ثمّ تکونت علی هامش القرآن وتفسیره، قصص وحکایات استمرت موضوعاتها وعناصرها من تعلیم الدین الجدید. فظهرت قصص الأنبیاء وقصص المعراج وسیر النبی: «فاقصُصِ القصَصَ لَعَلهَّم یَتَفَکّرَون» [2]
القصة فی العصر الأموی
«وعندما نصل إلی عصر الأموی نری القصّة ظفرت بعنایة کبیرة حیث صارت مهنة رسمیة یشتغل بها رجال یسألون علیها الأجر وهذا ما دفع الرواة علی الخروج إلی البارئة لتألیف الروایات وجمع أخبار الأحباء والشعراء العاشقین كقصّة عنترة وعبلة، لیلی ومجنون، جمیل وبثینة کثّیر وعزة وغیرهم.»
http://etudiantdz.com/vbl t33304.htm
القصة فی العصر العباسی
وقد تطورت القّصة فی العهد العباسی، إذ بدأت طائفة من الکتاب ینقلون القصص الأعجمیة إلی العربیة حیث بلغت حوالی ستین ترجمة:
«ومن أشهرها «کلیلة ودمنة» لعبدالله بن المقفع حیث فتح باباً جدیداً فی الأدب القصصی العربی، وصار نموذجاً مثالیاً سارعلی منواله کثیر من الکتاب المتاخرین الذین صاغوا أفکارهم الفلسفیة علی لسان الحیوانات؛ ومن القصص الأخری الهامة «الف لیلة ولیلة» من أصل هندی أوایرانی، وقد أثر هذا الکتاب فی الأدب القصصی الجدیدة.
ومن القصص المؤلفة التی صاغها العرب أنفسهم هی «البخلاء»، وقد صوّر فیها أخلاق فئات من الناس، وهم البخلاء متعرضاً لهم آخذاً علیهم، ثمّ رسالة «التوابع والزوابع» لإبن شهید الأندلسی وهی قصّة خیالیة موضوعها لقاءات مع الشیاطین الشعراء، ثم رسالة الغفران لأبی العلاء المعری، وهی قصة خیالیة موضوعها سفر خیالی إلی الجنة والجحیم، لقی فیه أبوالعلاء شعراء الجنة والجحیم، وانتقد من خلاله الشعر فی العصر الجاهلی والإسلامّی. وقد تمیّزت هذه الرسالة بخیال خصب کما قال طه حسین، حیث جعلها فی عداد الآثار النادرة. وأما المقامات فهی أقرب الأنواع القصصیة فی الأدب العربی إلی القصّة الفّنیة الجدیدة، واعتبرها بعض المستشرقین أول مظهر للقصة العربیة، وهی قصة قصیرة تدور حول مغامرات بطل موهوم یرویها راوٍ معین، غایتها تعلیمیة؛ وقدأجمع المؤرخون علی أن بدیع الزمان هومبدع المقامات، ومن أعلامها بعده هوالحریری. وإضافة إلی هذه الأعمال القصصّیة نری القصّة واصلت سیرها فی تضخم وکثرة، ودخلت فیها الرحلات «رحلة ابن جبیر وابن بطوطة» والخرافات وسیر الأشخاص «سیرة عنترة وسیرة بنی هلال.» [3]
ویمکن أن نقول بأن القصة العربیة نشأت وتطورت تحت ظروف وعوامل حسب المعتقدات والأساطیر وأن الادب العربی القدیم بما فیه تراث قصصی عظیم من القصص القرآنیة، قصص الأنبیاء وسیر النبی، والمقامات والرحلات والقصص الخیالیة والتراجم الذاتیة وقد ترک تراثاً ضخماً من مجال الأدب القصصی، وهوالذی أثر تأثیراً عمیقاً فی رأی بعض المعاصرین- فی نشأة الأدب القصصی الغربی وتطوره فیما بعد.
القصة فی عهد الانحطاط:
ومع هجمة التتار وسقوط الخلافة العباسیة بدأت فترة الانحطاط الأدبی فی الأدب العربی؛ الأمر الذی أدّی إلی خمود الحرکة الفکریة والأدبیة من جهة والتشاغل عن حفظ هذا التراث الضخم من جهة أخری، ولأجل ذلک قلّما نشاهد فی هذه الفترة التی امتدت ستة قرون إبداعاً بارزاً فی مجال القصة.
القصة فی الأدب العربی الحدیث:
«هناک اختلاف رأی بین العلماء المحدثین فی نشأة القصة العربیة الحدیثة؛ فمن یتحمّس منهم لأصلها العربی ویری أنها ولیدة التراث القدیم واستمراراً له، ومن ینفی أن تکون هناک أیة صلة بین القصّة الجدیدة وبین تلک الأنماط القصصیة القدیمة ویراها أنها ولیدة الاحتکاک بالغرب والتعریف إلی نتاجه القصصی ونقله إلی العربیة.» [4]
« إن أغلب الدراسات التی تناولت هذه القضیة، قد اتفقت علی أن الروایة هی نوع أدبی وفد إلینا من الغرب بعد الإتصال الحدیث به. وهذا الرأی هوالرأی الأصوب والأدق علمیا، لأن الرأی الآخر، والذی یری أن الروایة هی أمتداد لأنواع قصصیة عربیة قدیمة، لا یفهم الفارق الواضح بین فنیة تلک الأنواع القدیمة وتنوعها، وبین الخصائص الفنیة للروایة کنوع أدبی محدد. هذا بالاضافة إلی أنه یتصور أن الأنواع الأدبیة تسیر سیرتها الحیاتیة المستقلة، وتنقل من زمن إلی آخر بحریة مطلقة لا تقیدها حدود الزمن وتطور البشر منتجی هذه الأنواع الادبیة؛ أی أنهم یعزلون هذه الأنواع فی ذاتها، ویفصلونها عن تاریخیتها، التی هی المکون الأصلی لها.» [5]
وهناک قول آخر من یحیی حقی عن موضوع المذکورة. «القصة جاءتنا من الغرب… وأول من أقام قواعدها عندنا أفراد تأثروا بالأدب الأروبی والأدب الفرنسی بصفة خاصة.» [6]
هکذا قال یحیی حقی وأكد إسماعیل أدهم ومحمد تیمور وإبراهیم المصری ومحمد حسین هیکل: «لم تکن الصلّة قویة بین القصة العربیة الحدیثة وسابقیها القصّة العربیة القدیمة، فلم تبرز الأولی إلامن طریق الاتصال بالغرب. ففی النصف الثانی من القرن التاسع عشر المیلادین، هیأت الظروف للاتصال الفکری بالغرب، وعلی الأخص فی لبنان، فأعجب المثقفون بالقصّة الغربیة وبخاصة منها الفرنسیة.» [7]
کما لم یکن المصریون یطلبون فی ثورتهم هذه (1919) الاعتراف باستقلالهم وسیادتهم ویطلبون حیاة سیاسیة وصوراً من الحریة السیاسیة علی مثال ما فی الغرب سواء؟ فلتکن مظاهر الفن مصبوبة فی قوالب غریبة لتکون آیة للناس جمیعاً علی تقدمهم وعلی أنهم سابقون الغرب إلی میادین الحضارة وقد یسبقونه.» [8]
الرویایة العربیة المعاصرة
وإذا فحصنا فی القصة العربیة المعاصرة، فهی فن جدید یختلف شأنها عن شأنها القدیم، اتضحت لنا أنّها مرت بثلاث مراحل أساسیة ظهرت فی کل منها مجموعة هائلة من أنواع القصة وهی:
- الف: مرحلة التقلید والتعریب (1914- 1850)
- ب: مرحلة التکوین والإبداع (1939- 1914)
- ج: مرحلة التأصیل والنضج (1939- حتی الان)
الف: القصة العربیة فی مرحلة التقلید والتعریب:
«وعلی الرغم أن غالبیة الباحثین قد أنکرت الصلة بین القصة العربیة الحدیثة وبین التراث القصصی عند العرب، إلا أن هذا الإرتباط موجود بشکل بارز فی صیاغة الشکل والمضمون، إذ بدت القصّة الحدیثة فی بدء تطورها متأثرة بالأجناس القصصیة المأثورة کالتراجم والمقامة و…، ومن أوضح أمثلتها للتاثر بفن المقامة هو«حدیث عیسی بن هشام» للمویلحی (1900) حیث یبدوفیه التاثیر العربی واضحاً فی العنایة بالأسلوب والأحداث التی تحدث للبطل الذی یتصل بشخصیات متعددة، کما أن الأثر الغربی أیضاً یبدوفیه جلیاً من حیث تنویع المناظر، وتسلسل الحکایة، وبعض ملامح التحلیل النفسی.» [9]
«إن التسلیم بکون الروایة الحدیثة متاثرة أومنقولة عن الغرب، هوحقیقة تاریخیة سلم بهارواد هذا النوع الأدبی منذ البدایة، غیر أننا نستطیع أن نجد موقفین مختلفین لهؤلاء الرواد خلال العقود الأربعة الأولی من هذا القرن العشرین. فکل هولاء بدأوا بالتأکید هذه الحقیقة، مع الدعوة إلی الإیغال فی تقلید النموذج الروایی الغربی؛ وذلک خلال العقدین الأول والثانی من القرن.» [10]
وفی أواخر القرن التاسع عشر ظهرت موجة جدیدة فی الأدب القصصی الحدیث، وذلک إثر ترجمة القصص الغربیة ونمت هذه الموجة فی مصر ولبنان. فراحویترجمون القصص الغربیة التی کانت موضوعاتها فی الأغلب، رومانتکیة حول الحبّ والجنس وقد بدأت هذه الموجة علی ید اللبنانیین؛ منهم «سلیم السبتانی» الذی اعتبر الرائد الأول لهذا التیار. ومن أعلام القصة والروایة العربیة فی هذه المرحلة«فرح أنطوان»، «نقولاحداد»، «یعقوب صروف»، «لبیه هاشم»، «طاهر حقی» و«المنفلوطی».
«وصفوة القول فی القصة والروایة فی هذه المرحلة أن أعمال هؤلاء الکتاب کانت فی أغلبها تقلید القصة الغربیة، یغلب علیها السرد التاریخی أوالإجتماعی… ولکن هناک ظاهرة فنیة یجدر الوقوف عندها، وهی الجهود الروائیّة للذین مضوا إلی المحبر، فأتیح لهم الإطلاع علی النماذج القصصیة الغربیة بکامل الوجه، فتأثروا بها فنضجت أعمالهم حیث تختلف عن النماذج القصصیة فی البلد العربی، فلاشک أن إنتاجات جبران من القصة والروایة ک «عرائس المروج 1906» و«الأرواح المتمردة 1908» و«العواصف 1910» و«الأجنحة المتکسرة 1912» وکان لها طعم جدید، إذ یبدوفیها روح التمّرد علی عوامل الجمود وموانع التطور… ثمّ من الذین هاجروا خارج الوطن العربی وکتبوا فیه وخرج نتاجهم ثمرة لتزاوج المجتمعین العربی والأروبی، «الدکتور محمد حسین هیکل» الذی نشر روایة «زینب 1914» حیث اعتبرت هذه القصة فی رأی البعض بأنها بشّرت مرحلة جدیدة فی القصة العربیة، ألاوهی مرحلة التکوین القصصی العربی.» [11]
ب: مرحلة تکوین القصة العربیة الحدیثة (1939- 1914)
إن فترة ما بین الحربین العالمیتین اعتبرت مرحلة تکوین الأدب القصصی والروائی عند العرب، فالحرب العالمیة الأولی وما تبعها من أحداث وتحولات فی ترکیب المجتمعات العربیة، من تغییر فی القیم والموازین، ومن تطور فی الثقافة والسیاسة والوعی القومی والانتفاضات الوطنیة و… کل هذه خلقت جواً جدیداً وذوقاً مختفاً عن سابقه وتطلبت بناءً وأسلوباً جدیداً للتعبیر عن هذه التحولات الجدیدة. وتمتاز قصص هذه المرحلة بمایلی:
«تعالج موضوعات من تجارب الکتاب أنفسهم، فالبطل فی کل قصة کاد منها یکون الکاتب نفسه. أوهونفسه علی الاطلاق:
- استطاع فیها الکتاب أن یغوصوا فی أعماق نفوس الأبطال ویحلّلوها.
- طغت علیها کلها النزعة الرومانسیة التی کانت تسود العصر.
- عبرت عن قدرة الکّتاب علی تکییف الأسلوب اللغوی مع وسائل التعبیر فی القصّة من سرد وحوار ونجوی ووصف.» [12] «وهکذا أخذت القصة العربیة بعد الحرب العالمیة الأولی طابع المحلیة والقومیة، وبدأت تصور فئات من المجتمع المصری أواللبنانی أوالسوری أوالعراقی بغیة تحسین فضاءِ المجتمع…» [13]
من أعلام هذه المرحلة طه حسین الذی له دورهام فی إرساء قواعد الفن القصصی ومن أعماله: الأیّام (1929)، أدیب (1935) حیث انتقد فیها القضایا الاجتماعیة والتعلیمیة والتربویة فی المجتمع المصری. ومنهم توفیق الحکیم الذی عنی بتصور الواقع عن حیاة الاجتماعیة ومشکلاتها ومن آثاره: عودة الروح (1931)، یومیات نائب فی الأریاف (1937) وعصفور من الشرق (1938).
ج: مرحلة تأصیل القصة العربیة:
«هذه المرحلة هی المرحلة الأخیرة فی تطور القصّة والروایة العربیة، والتی اعتبرت قمة المراحل واتسمّت بمرحلة التأصیل وقد تداخلت هذه المرحلة بالمرحلة السابقة عقداً من الزمن حیث کانت الثلاثینات خاتمة مرحلة التکوین ومدخلاً إلی مرحلة التأصیل حیث اختارت الروایة والقصة العربیة اتجاهاً جدیداً نتیجة لأسباب وعوامل مختلفة لم تکن میسرة لهما فی المرحلة السابقة.» [14] ففی هذه المرحلة ظهر عمالقة القصة العربیة الحدیثة کنجیب محفوظ وتوفیق یوسف عوّاد وجبرا إبراهیم جبرا. «تناول هولاء الکّتاب وأمثالهم وهم کُثُر، الکثیر من القضایا الحیاة العربیة ببناء فنی قوی یختلف من کاتب إلی آخر. باختلاف المدارس الأدبیة والنزعات الفکریة والسیاسیة وهکذا غطت القصّة مساحة واسعة من حیاة الناس، فهناک القصة الإجتماعیة والقصّة السیاسیة، والقصة التاریخیة، والقصة الفلسفیة، فعولجت مشکلات الحرب وویلاتها فی قصة «الرغیف» لتوفیق یوسف عواد، ومشکلات العصر الإنسانیة، کعبثیة الحیاة، وغربة الانسان وضیاعه، والانفصال عن الواقع فی قصص «اللص والکلاب» و«الطریق» و«السمان والخریف» لنجیب محفوظ.» [15] اتجاهات الروایة العربیة:
لحد الان ماذکرنا حول نشأة الروایة والاتجاهات التی ظهرت فیها، کانت کلها مطبوعة بطابع الروایة التقلیدیة، لکن فی أواخر السنیات وبدایة السبعینات ظهرت ثورات عنیفة علی الروایة التقلیدیة المستهلکة، أدت إلی ظهور إتجاهات جدیدة، وإن کانت هی متأثرة بالغرب لحد بعید، إلا أن التاصیل والتکوین ظهرا فیها أسرع وقت ممکن وهذه الاتجاهات الجدیدة هی:
أ: روایة تیار الوعی:
کان هذا الاتجاة بمثابة ثورة عارمة علی الروایة التقلیدیة، وقد بدأ فی الأدب الغربی فی نهایة القرن التاسع وامتدت إلی النصف الأول علی ید «مارسل بروست» و«جیمس جویس»… وبظهور هذا التیار تغییر الأسلوب، وأصبح کتشاف العقل والباطن الخفی مثار الإهتمام، لأنه المحرک الأساسی للفکروالسلوک ومقومات هذا الاتجاه أوالتیار تتخلص فیما یلی:
- الف) المونولوج الداخلی المباشر، وفیه یغیب المؤلف، ویتم فیه بضمیر المفرد والغائب.
- ب) المونولوج الداخلی غیر المباشر: وفیه یحضر المؤلف عبر الوصف والتعلیق، ویقوم الحکی فیه بضمیر المتکلم.
- ج) وصف الوعی الذهنی للشخصیات
- د) مناجاة النفس
- ه) التداعی الحر من طریق الخیال والحواس
- و) المونتاج السینمایی عن طریق تعدد الصور وتوالیها.»
[16]
ب: الروایة الطلیعیة:
«والاتجاه الثانی فی الروایة العربیة بعد السبعینات هوالاتجاه الطبیعی أوالروایة الطلیعة. وهی تعنی استخدم تقنیات فنیة جدیدة تتجاوز الأسالیب والجمالیات السائدة والمعروفة، لکن بهدوء وبطءِ وتمهّل. وقد تمیزت الروایة الطلیعة باستخدام تقنیات السینما، والتقطیع إلی صور ولوحات مستقلة تعطی مجتمعة انطباعاً واحساساً واحداً، کما تمیزت باستخدام المونولوج الداخلی والفلاش بک فی تصویر ماضی الأبطال، کما أن میزانته الأخری أسلوبها الشعری، والنسبیة أوالنظر إلی الحادثة الواحدة من زوایا مختلفة وعدیدة. ومن الروائییئن العرب الذین تجلت هذه العناصر فی نتاجاتهم، «جمال الغیطانی»، «صنع الله إبراهیم»، «إمیل حبیبی»، «جبرا إبراهیم جبرا»، «الطاهر وطّار»، «عبدالرحمن منبف» و«الیاس خوری…» [17]
ج: الروایة التجربیة:
«هذا الاتجاه أحدث إتجاه ظهر فی العالم الروایی، والذی اعتمد علیه المعاصرون بوصفه تفنیة جدید، من أجل تجاوز واقعهم الفنی المستهلک، فقامت الروایة التجربیة علی توظیف البناءات والأحلام اللغویة، واستقلال تفنیات الشعور واللاشعور، وانثیال الوعی واللاوعی والأحلام، وإلغاء عنصری الزمان والمکان. وقد ظهر هذا الاتجاه بغیة بناء أدب مضادّاً للإبداع المتعارف علیه مسبقاً عن طریق تدمیر البنیات الشکلیه للروایة، والعناصر الفنیة، تفجیر اللغة، والخروج علی الأنماط الروائیة السائدة نحوالإبداع والابتکار والولوع إلی عالم مستقبلی مجهول منقطعاً عن الماضی والحاضر، متفاعلاً إلی الروائی السابق.» [18] وهناک مجموعة من العوامل، التی تکاتفت فی فترة استینات، فیما یختص الحداثة الروائیة بعامة وشعریة اللغة التی تعد العمود الفقری بخاصة وخصوصاً مرحلة ما قبل هزیمة حزیران وبعدها ونعرض لهذه العوامل قبل الهزیمة ومنها:
1) الروایة الجدیدة فی فرنسا، إذ ترجمت بعض النصوص خلال الستینات، ومن روادها «ناتالی ساروت» و«روب غربیة» و«میشل بوتور» و«کلود سیمون» وغیرهم … 2) التاثر بالاتجاه الرمزی فی اروبا الذی ولد فی النصف الثانی من القرون التاسع عشر، خاصة فی مجال الشعر علی ید أقطاب منهم «بودلیر» و«رامبو» و«مالارمیه» و«بول فالیری». 3) التاثر بالحرکة الرومانسیة العربیة التی شهدت تألقا فی الثلاثینات والأربعینات، فادا کانت الرومانسیة فی بعض مواضیعها تصور البؤس والجوانب الظلمة فی المجتمع. فروایة الستینات کذلک … 4) التاثر بأعمال أدباء المهجر، الذین تنحوأعمالهم النثریة المنحی الشعری فی لغتها وفی مقدمتهم جبران خلیل جبران، حیث نجد إشارة صریحة فی روایة «ستة أیام» لحلیم برکات إلی جبران وکتابه «النبی»، فقد اقتبس حلیم برکات فی أکثر من موضع من کتاب النبی لجبران.» [19] «لقد طّور جیل السنیات فی الروایة العربیة فی الشکل الروایة والروایة التی استقرت فی أعمال نجیب محفوظ الکلاسیکیة، وإن تجلی ذلک فی مرحلة السبعینات وما بعدها، وخصوصاً ما بعد هزیمة حزیران التی فضحت کل شیءِ بما فی ذلک طرائق الکتابة وأسالیبها ونظرتها الواثقة إلی العالم.» [20] الروایة عناصرها وأنواعها: فی الحقیقة إن الروایة نوع من أنواع القصة وعندما نرید أن نتحدث عن الروایة عناصرها وأنواعها لابدنا أن نتکلم عن أنواع القصة:
أنواع القصة:
للقصة ثلاثة أنواع اصطلح علی تمسیتها مایلی:
«الروایة: هی غالباً قصة طویلة، أشخاصها عدیدون وأحداثها متشابکة تعرض من خلالها طباع الشخصیات وتحلل فی نموها وتکاملها خلال العمل القصصی.
القصة: غالباً ما تکون متوسطة الحجم، تقوم علی اشخاص لاتضاح جوانب طباعهم کلها، إذ تقوم القصة علی جانب من جوانب الشخصیة ولیس علیها متکاملة.
الأقصوصة: قصة قصیرة، تصّور البطل فی حالة من حالاته وتکون أحداثها قلیلة لاتتجاوز هذه الحالة التی تصورّها.» [21]
عناصر الروایة الحدیثة:
الحدث والشخصیات والبیئة والأسلوب والهدف ما هوالحدث فی الروایة الحدیثة: «هوحدث واحد، أوجمله أحداث متشابکة مترابطة یسوقها الکاتب بفنیة عالیة وصولاً بها إلی هدفه أوإلی فکرته التی یرید أن یضعها فیعرفها القاری.» [22] ویستمد الکاتب هذه الحدث أوهذه الأحداث من مصادر وهی:
1. واقع حیاة الناس.
2. واقع حیاة الکاتب.
3. ثقافة الکاتب وتشمل التاریخ البشری.
4. خیال الکاتب.
«وقد تکون الروایة مستمده من واحد من هذه المصادر أواکثر غیر أن المصدر الرابع وهوالخیال، لا بد أن یکون صاحب دور فی کل حدث، إذ لا نهوض لعمل فنی نهوضاً صحیحاً ما لم یکن للخیال فیه دور، حتی ولوکان دور التنظیم أوالتقلید أوالإضافة.» [23]
العمل القصصی:
العمل القصصی هوجملة الأحداث التی تتشابک فی حبکة یحبک بها الکاتب هذه الأحداث، وتولّف هذه الأحداث مجتمعه موضوع القصّة من بدایة ها إلی نهایتها. ما هی الحبکة: «الحبکة هی عملیة نسج الأحداث فی ثوب فنی یتمثل فی بدایة تمهّد للحدث، وحبکة یتأزم فیها الحدث ونهایة یکون فیها حل الأزمة.» [24] لکل روایة «بدایة وحبکة ونهایة» لکن ترتیب هذه الأقسام الثلاثة لیس ضروریاً ونری فی الروایة ثلاث طرائق فی بناءها: «الطریقة التقلیدیة: وهی التی یتحرک فیها الحدث تحرکاً سبیاً أوزمنیاً من البدایة إلی الحبکة وإلی النهایة ومن أمثال ذلک قصة «أنا کارنینا» لتوستوی و«زقاق المدق» لنجیب محفوظ. الطریقة الحدیثة: فی هذه الطریقة یضعک الکاتب فی قلب القصة، فی أزمتها حیث یکون بطل القصة فی شده نفسّیة تمزّق روحه، ویسعی الکاتب إلی النهایة إلی الحل تارکا للبطل أن یتذکر الماضی… . وهذا ما نراه فی قصة «اللص والکلاب» لنجیب محفوظ.
الطریقة الخطف خلفاً: تبداً القصّة فی هذه الطریقة من النهایة، کان یضعک الکاتب أمام حدث مثیر، ثمَّ یأخذ بالبحث عن أسباب هذا الحدث المثیر، فیقودک البحث إلی البدایة وأکثر ما نجد هذه الطریقة فی القصص البولیسیة، مثل قصة «لغز الصورة» لأغاتا کریستی.» [25] نحن فی الروایة لدنیا نوعین من الحبكة من حیث ترابط الأحداث: 1- حبکة محکمة وهی أن تکون الأحداث تترابط وتتشابک بعضهم ببعض 2- حبکة مفککة: وهی أن الأحداث لا تترابط ولا تتشابک ببنهما بل یکون کل حدث یشبه بقصة قائمة فی ذاتها.
الشخصیات:
«الشخصیات القصصیة هی التی تحمل الحدث القصصی وتطوّرها من بدایاته إلی وسطه أوحبکته حیث الأزمة ، فالنهایة حیث تنحّل عقدة القصة ویشبع القاری فضوله.» [26] فی الروایة ثلاثة أنواع من الشخصیات:
1) شخصیة أساسیة أو(محوریة) : وتکون هی البطل فی القصة کشخصیة سعید «مهران« فی قصه «اللص والکلاب» وشخصیة «وکییل النائب« فی روایة «یومیات نائب فی الأریاف»، لتوفیق الحکیم …
2) شخصیة معارضة: ویقوم الصراع بینها وبین الشخصیة المحوریة کشخصیة «درویش عصفور» فی روایة «یومیات نائب فی الأریاف» لتوفیق الحکیم.
3) شخصیات مساعدة: فهم إلی جانب الشخصیتین المحوریه والمعارضة كرجال الشرط فی قصه «اللص والكلاب» لنجیب محفوظ.
والكتاب یرسم شخصیات القصة أوالروای علی إحدی الطریقتین: هما:
>> الطریقة التمثیلیة: وفیها یعمد الكاتب إلی رسم ملامح الشخصیة معتمداً علی الحوار تارة وعلی نجوی داخلیة علی لسان الشخصیة نفسها حیناً وعلی أحادیث تطلقها الشخصیات بعضها عن بعض أحیاناً أخری. 2- الطریقة التحلیلیة: وفیها یعمد الكاتب إلی أن یتدخل هونفسه تدخلاً مباشراً فیرسم بعض ملامح شخصیاته بالتعلیق المباشر علیها أوبتصویر ردّات أفعالعا تجاه الاحداث.» [27] البیئة:
«تشمل البیئة عنصری المكان والزمان تدور فیها أحداث الروایة وتتحرك شخصیاتها، فكل بیئة تترك طابعها علی الشخصیات وعلی الأحداث فشخصیات الكاتب حنامیته، الذی أدار معظم أحداث روایته علی شاطی البحر وفی موائته، تختلف كثیراً، فی أسلوب حركتها وردّات أفعالها تجاه الأحداث عن شخصیات الكاتب عبد السلام العجیلی. الذی یدیر أحداث روایاته ویحرك شخصیاته… نعنی بالبیئة القصصیة كل ما
یحیط بالأحداث والشخصیات من ظروف طبیعیة جغرافیة أواجتماعیة بشریة.» [28]
أسلوب الروایة:
«الأسلوب فی العمل القصصی هوجملة الأدوات الفنیة التی یستخدمها الكاتب للوصول بقصته إلی غایاتها. وهی السرد، الحوار، المناجاة، الوصف.» [29]
السرد:
«السرد هو روایة الحدث، أوحكایته بأسلوب لغوی یلائم أحداث الروایة ویلائم جماهیر العریضة التی ستقرأ هذا العمل بمختلف ثقافاتها ولهذا وجب أن تمتاز لغة السرد.» [30] «الحكی اوالسرد تعرف التحدیدات العربیة للعدید من المصطلحات المعاصرة من الخلط والغموض ولعل أهم مفهوم یستوقفنا أولاً، وقبل الحدیث عن «القصّة» و«الخطاب»، هومفهوم «الحكی» التی نضعه مقابل (levecit) فی الفرنسیة و(navvative) فی الانجلیزیة.» [31]
واللغة الغالبة علی هذا النوع من العمل القصصی هی لغة الاسلوب الفصحی الذی یتجه نحو السهولة ومجرد إیصال المعنی إلى القاری بأسهل الطرق.
یسرد الكاتب الروایة بإحدی طرائق الاربعة:
1) الطریقة الذاتیة: وهی التی یستخدم فیها الكاتب المتكلم مستعیناً عن دور الروایة فیها ومن هذه القصص «الحب الضائع» لطه حسین.
2) طریقة الرسائل أوالمذكرات: وهی طریقة تعتمد علی رسائل تتباد لها شخصیات القصّة، أوعلی مذكرات یومیة یكتبها بطل الروایة أوإحدی شخصیاتها ونذكر من هذا النوع «یومیات نائب فی الاریاف» لتوفیق الحكیم. وهذا تعتمد المذكرات یومیة.
3) الطریقة التقلیدیة: وهی الطریقة التاریخیة التی یعتمد فیها الراوی علی الضمیر الغائب وبهذه الطریقة كتب اكثر القصص ومنها «اللص والكلاب» لنجیب محفوظ.»
[32]
الحوار:
وهو من أسالیب فن القصصی:
«وقد أثر أسلوب الكاتب التقریری فی استخدام للحوار الذی یبدودوره ضئیلاً إلی حد كبیر، فی هذا النوع من الروایة، فهم یتجهون فی الغالب إلی التهرب منه ویعلنون هذا التهرب صراحة كما یفعل نقولا حداد فی روایته «العجائب والغرائب الامریكیة» فیقول بعد محادثة برهة فی عدة مواضیع لا یهتم القاری كثیراً نهضت البدینة مستأذنة فی الذّهاب. والوسیلة المتبعة فی التخلص من الحوار هی تحویلة إلی أسلوب السرد.» [33]
ولا نجاح للحوار فی الروایة إذا لم یتسم بمایلی: «1- أن یكون له دور فی بناء القصة. 2- أن یكون مرتبطاً ارتباطاً عضویاً بالشخصیة فلا یفرض علیها قرضاً. 3- أن تكون لغته الشخصیة التی تتكلم، وبحسب المواظف التی تقتضی هذا الكلام.» [34] النجوی الداخلیة:
النجوی هی صوت داخلی لا یسمعه إلا صاحبه أما دورها فكبیر فی الروایة. فهی:
«1- قد تسعید أحداثاً مفقودة فی لحمة القصة.
2- قد تكون وسیلة فی الكشف عن شخصیات أخرى وتصویرها.
3- قد تكون الوسیلة من وسائل تطویر الحدیث.
4- قد تكون الوسیلة الوحیدة فی بناء القصّة كلّها كما فی القصص التی تعتمد طریق «یتار الوعی» فی السرد ویلزم فی اللغة لمناجاة كما فی غیرها الخفة والسهولة إلی جانب مشاكلتها للشخص الذی ینطلق داخلة بها.» [35]
الوصف
الوصف هوأداة من أدوات الكتاب فی بناء الروایة وقد یكون فیه البیئة التی تجری فیها الأحداث وقد یرسم شكل الشخصیة من الخارج أوصورة للنفس والخ.
«للوصف دور إیجابی فی تكامل القصّة إذا جاء فی قصد، فلا یكون إلا تمهیداً لحدث قد یقع كما فی وصف الطبیعة، أوتهیئة للحوادث التی تنهض بها الشخصیات، حتی لا تكون هذه الحوادث مخالفة لطبیعة الأشیاء، كما فی وصف البیئة الأجتماعیة التی تجری الحادثة فیها، أوتكون كشفاً عن دواخل الشخصیة وتحلیلاً لا نفعالاتها.» [36]
الهدف:
«هوالفكرة التی یحملها الكاتب إلی القاریء بتجسیدها فی أحداث تنهض بها شخصیات فی بیئة معنیة، أی بتجسیدها فی قصّة، وبذلك القّصة كلها قد بنیت من أجل إیصال هذه الفكرة إلی القاریء، إلی جانب تسلیته وإمتناعه.» [37]
مثال ذلك الفكرة وجود الظلم السیاسی والمشكلات فی نظام الاداری فی مصر فی روایة «یومیات نائب فی الأریاف» لتوفیق الحكیم وأیضاً فكرة عبثیة الحیاة فی قصة «اللص الكلاب» لنجیب محفوظ علی كل حال یجب أن یكون هدفاً وراء الروایة وحتی یعرف القاریء هذا الهدف خلال قرائته الروایة.
حواشی
[1] جمع من المولفین، المفید فی الأدب العربی، الجزء الثانی. دارالعلم للملأبین، ص 363. لاتا
[2] القرآن الکریم. سوره الاعراف. الآیة 176
[3] المصدر السابق. الصفحة نفسها.
[4] المصدر نفسه
[5] الدکتورسید البحراوی: محتوی الشکل فی الروایة العربیة النصوص المصریة الاولی. الهیئة المصریة العامة للکتاب 1996.ص370
[6] یحیی حقی. فجرالقصة المصریة. المنبة الثقاضة، الهئبة المصریة العامة للکتاب القاهرة. 1986. ص 2
[7] المفید فی الادب العربی- دارالعلم للملائین. ص 38
[8] محمد حسین هیکل: ثورة الأدب. دار المعارف بمصر. ط 4. 1978. ص 75
[9] المقال http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/
[10] الدکتور سید البحراوی: محتوی الشکل فی الروایة العربیة. النصوص المصریة الأولی الهیئة المصریة العامة للکتاب 1996. ص 38
[11] . http://etuiantdz.com/vb/t33304.htm
[12] جمع من المؤلفین. المفید الأدب ابویی، الجزء الثانی. دارالعلم للملائین. ص 385 لاتا.
[13] HYPERLINK "http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/" http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/
[14] المصدر السابق. الصفحة نفسها.
[15] جمع من المولفین. المفید فی الادب العربی. الجزء الثانی. دار العلم للملائین. ص 385 لاتا
[16] HYPERLINK "http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/]" http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/
[17] المصدرالسابق . الصفحة نفسها
[18] المصدر السابق. الصفحة نفسها
[19] المصدر نفسه ص 13
[20] د. ناصر یعقوب:الغة الشعریة وتحلیلاتها فی الروایة العربیة(1970- 2000).المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت. ص 17
[21] جمع من المولفین. المفید فی الأدب العربی. الجزء الثانی. دار العلم للملائین. ص 365 .لاتا
[22] المصدر نفسه . ص 365
[23] المصدرالسابق . ص 366
[24] المصدر نفسه . ص366
[25] المصدر نفسه . ص376
[26] المصدر نفسه . ص 368
[27] المصدر نفسه . ص369
[28] المصدر نفسه ص 371
[29] المصدر نفسه ص 372
[30] المصدر نفسه ص 372
[31] سعید یقطین. تحلیل الخطاب الروایی. المركز الثقافی العربی 2005 . ص 46
[32] جمع من المولفین. المفید فی الادب العربی. الجزء الثانی. دار العلم للملائین. ص 373 لاتا
[33] الدكتور عبدالمحسن طه بدر: تطور الروایة العربیة الحدیثة فی مصر (1870 – 1938) دارالمعارف . ص 173 لاتا
[34] جمع من المولفین. المفید فی الادب العربی. الجزء الثانی. دار العلم للملائین. ص 374 لاتا
[35] المصدر نفسه. ص 375
[36] المصدرالسابق . ص375
[37] المصدر نفسه . ص
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:51|
ظاهرة النحت فی اللغة العربیة
النحت
فی اللغة وفی الاصطلاحظاهرة النحت و وظیفته التی تقوم على مبدأ الاختصار والاختزال واضحة جلیة فی اللغة العربیة المعاصرة. یكون النحت من الأسالیب الأصیلة فی كلام العرب بحیث استخدموه فی الألفاظ الكثیرة الورود فی كلامهم ومحاوراتهم. و مردّ ذلك یعود إلى حدة أذهان العرب القدامى و جودة أفهامهم، و لذلك انتبهوا للرمزة الدقیقة و كثر فی كلامهم أنواع الإیجاز و الاختصار والحذف والاقتصار.
هنا لا بد من الإشارة، عندما نحن نتكلم عن النحت لانقصد منه تركیب الكلمات العربیة من بعض الجذور غیر العربیة و الأعجمیة كما یراه البعض، بل نقصد النحت العلمی و الأصولی الذی ینتج عددا غیر قلیل من الكلمات والتعبیرات المختزلة التی تكون العلوم الحدیثة تحتاج إلى أمثالها حاجة ماسة فی لغتنا الإسلامیة. النحت فی أصل اللغة: هو النشر والبری والقطع. و نحِت العود أی براه و الحجر أی سوّاه و أصلحه (المنجد فی اللغة، لویس معلوف) كذلك انظر(لسان العرب و تاج العروس مادة " ن. ح، ت"). و نحت الكلمة: أخذها و ركّبها من كلمتین أو أكثر نحو: الحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله و البسملة من: بسم الله الرحمن الرحیم (نفس المرجع). و یقال: نحت النجّار الخشب والعود إذا براه وهذب سطوحه. ومثله فی الحجارة والجبال. قال الله تعالى فی سورة الشعراء الآیة 149: " وتنحتون من الجبال بیوتاً ".
فی الاصطلاح عند الخلیل بن أحمد (المتوفى 175هـ): " أخذ كلمة من كلمتین متعاقبتین، واشتقاق فعل منها" (العین، تحقیق د. مهدی المخزومی و د. إبراهیم السامرائی، 60/1، دار الرشید ببغداد، 1980م). ویعتبر الخلیل الذی هو أوّل من أكتشف ظاهرة النحت فی اللغة العربیة حین قال: " إن العین لا تأتلف مع الحاء فی كلمة واحدة لقرب مخرجیهما، إلاّ أن یُشتَق فّـعِلٌ من جمع بین كلمتین مثل (حیّ على) كقول الشاعر: أقول لها ودمع العین جار ألم یحزنك حیعلة المنادی فهذه كلمة جمعت من (حیّ) ومن (على). و نقول منه " حیعل، یحیعل، حیعلة…" ( المرجع السابق). یعرّف الدكتور نهاد الموسى النحت فی كتابه " النحت فی اللغة العربیة " بقوله: " هو بناء كلمة جدیدة من كلمتین أو أكثر أو من جملة، بحیث تكون الكلمتان أو الكلمات متباینتین فی المعنى والصورة، وبحیث تكون الكلمة الجدیدة آخذة منهما جمیعاً بحظ فی اللّفظ، دالة علیهما جمیعاً فی المعنى" (ص67. كذلك لاحظ ص 65 وما بعدها للمزید من التوضیحات). الغرض من النحت كما ذكر هو تیسیر التعبیر بالاختصار والإیجاز. فالكلمتان أو الجملة تصیر كلمة واحدة بفضل النحت. یقول ابن فارس: "العرب تنحت من كلمتین كلمة واحدة، وهو جنس من الاختصار. وذلك " رجل عبشمیّ منسوب إلى اسمین") هما عبد و شمس). النحت هو انتزاع و إیجاد كلمة من كلمتین أو أكثر، بحیث نسمّی الكلمة المنزوعة، منحوتة. أو نوجد تركیبا من امتزاج كلمتین، بحیث یكون له معنى لم یكن له قبله فی الإفراد و هذا العمل یسمّى النحت (إما ان یكون بصورة النحت أو التركیب). و لكن بینهما فرق و هو كون الاختزال والاختصار فی النحت و لا یوجد فی التركیب. و نرى نفس هذا الفرق بینه و بین الإشتقاق على الرغم من أن یعدّ البعض النحت ظاهرة إشتقاقیة و یسمّى النحت الاشتقاق الكُبّار. یعنی؛ فی الاشتقاق إطالة لبنیة الكلمات غالبا و لكن فی النحت اختزال واختصار دون الإطالة.
و هكذا یصف إمیل بدیع یعقوب موقع النحت فی اللغة العربیة المعاصرة: " وعندنا أن اللغات الأجنبیة و بخاصة المنحدرة من اللغة اللاتینیة، أكثر قابلیة للنحت من اللغة العربیة، وأنه فی كثیر من الأحیان، یستحیل فی العربیة نحت كلمة من كلمتین. ولكن هذا لا یعنی أن لغتنا غیر قابلة للنحت، فإن أحدا لا یستطیع إنكار الكلمات المنحوتة فیها. والذین ذهبوا إلى أن العربیة لا تقبل النحت، اعترفوا أنها وفقت فی نحت بعض الكلمات ". بید أن ما یؤخذ على النص هو رؤیته الضیقة لمفهوم النحت، إذ لم یستطع أن یتجاوزها لیُدخل فی النحت ما ذهب إلیه تمام حسان قائلا: " ومما یرتبط بالاشتقاق أیضا ظاهرة النحت، وهی تمثل نوعا من أنواع الاختـزال المبنی على اختیار أشهر حروف العبارة لصیاغة كلمة منها abbreviation ". یبدو أن خیر منهج علمی ینبغی اتباعه فی هذا النمط من البحث هو اختیار متن معین ثم تحلیله ودراسته. وانطلاقا من نتائج ذلك یأتی الحكم على موقع النحت فی اللغات العالمیة المشهورة ومنها العربیة. لیكن إذن، المتن مكونا من كلمات منحوتة، شهرتها مسجلة فی الصحافة العالمیة، ثمّ لنحاول أن ننحت من ترجمتها مفردات باللغة العربیة.
ویبدو ان الكلمات التی تنحت یجب ان تكون مالوفة ومشهورة ومتكررة فمثلا نقول (سبحلَ وحوقلَ) وهنا نعنی: سبحان الله و لا حول ولا قوة الا بالله ونقول: بسملة أی: بسم الله الرحمن الرحیم. فالنحت هو أن تؤخذ كلمتان و تنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جمیعا بحظ. والأصل فی ذلك ما ذكره الخلیل من قولهم حیعل الرجل، إذا قال حیَّ على. ما یفهم من تعریف ابن فارس (المتوفى 395) هو إنشاء كلمة جدیدة، بعض حروفها موجودة من قبلُ فی كلمتین أو أكثر. وقد أدى هذا الفهم بالكثیر من العلماء إلى اعتبار النحت نوعا من الاشتقاق میزوه من الصغیر والكبیر بمصطلح الاشتقاق الكبّار. موقف المحدثین من النحت یقول الدكتور صبحی الصالح: " ولقد كان للنحت أنصار من أئمة اللغة فی جمیع العصور، وكلّما امتدّ الزمان بالناس ازداد شعورهم بالحاجة إلى التوسّع فی اللغة عن طریق هذا الاشتقاق الكبّار، وانطلقوا یؤیدون شرعیة ذلك التوسع اللغوی بما یحفظونه من الكلمات الفصیحات المنحوتات". ولكن النحت ظلّ -مع ذلك- قصّة محكیّة، أو روایة مأثورة تتناقلها كتب اللغة بأمثلتها الشائعة المحدودة، ولا یفكر العلماء تفكیراً جدیاً فی تجدید أصولها و ضبط قواعدها، حتى كانت النهضة الأدبیة واللغویة فی عصرنا الحاضر؛ و انقسم العلماء فی النحت إلى طائفتین: * طائفة تمیل إلى جواز النحت والنقل اللّفظی الكامل للمصطلحات. * طائفة یمثّلها الكرملی حیث یرى: " أن لغتنا لیست من اللّغات التی تقبل النحت على وجه لغات أهل الغرب كما هو مدوّن فی مصنفاتها. والمنحوتات عندنا عشرات، أمّا عندهم فمئات، بل ألوف، لأنّ تقدیم المضاف إلیه على المضاف معروفة عندهم، فساغ لهم النحت. أما عندنا فاللغة تأباه وتتبرأ منه " (دراسـات فی فقـه اللغـة، ص 264).
اتخذ الدكتور صبحی الصالح من الطائفتین موقفاً وسطاً حیث یقول: " وكلتا الطائفتین مغالیة فیما ذهبت إلیه؛ فإن لكلّ لغة طبیعتها وأسالیبها فی الاشتقاق والتوسّع فی التعبیر. و ما من ریب فی أنّ القول بالنحت إطلاقا یفسد أمر هذه اللغة، ولا ینسجم مع النسیج العربی للمفردات والتركیبات، و ربّما أبعد الكلمة المنحوتة عن أصلها العربی. وما أصوب الاستنتاج الذی ذهب إلیه الدكتور مصطفى جواد حول ترجمة الطب النفسی الجسمی psychosomatic)) فإنّه حكم بفساد النّحت فیه خشیة التفریط فی الاسم بإضاعة شیء من أحرفه، كأن یقال: " النفسجی أو النفجسمی" ممّا یبعد الاسم عن أصله، فیختلط بغیره و تذهب الفائدة المرتجاة منه" (المرجع السابق: ص266 ولاحظ هامشها وما بعدها من صفحات).
وقصارى القول أن الاشتقاق الكُبَّار اسم أطلقه الأستاذ عبد الله أمین على مایعرف بـالنَّحْت، وهو أخذُ كلمة من بعض حروف كلمتین أو كلمات أو من جملة مع تناسب المنحوتة والمنحوت منها فی اللفظ والمعنى. وقد استعملته العرب لاختصار حكایة المركَّبات كما قالوا: بَسْمَلَ وسَبْحَلَ وحَیْعَلَ : إذا قال: بسم الله، وسبحان الله، وحی على الفلاح. ومن المركَّب العلمُ المضاف، وهم إذا نسبوا إلیه نسبوا إلى الأول، وربما اشتقوا النسبة منهما، فقالوا: عَبْشَمیّ وعَبْقَسیّ ومَرْقَسیّ فی النسبة إلى عبد شمس وعبد القیس وامرئ القیس فی كندة. وهو قلیل الاستعمال فی العربیة. و ذهب ابن فارس إلى أن أكثر الألفاظ الرباعیة والخماسیة منحوت وفیها الموضوع وضعاً، وعلى هذا المذهب جرى فی كتابه مقاییس اللغة. و هذا القسم من أقسام الاشتقاق وسیلة من وسائل تولید كلمات جدیدة للدلالة على معان مستحدثة. وقد أجازه المجمع عندما تلجئ إلیه الضرورة العلمیة.
هل النحت ظاهرة قیاسیة؟ یعتقد الدكتور إبراهیم نجا فی كتابه فقه اللغة العربیة: " أن هذه الظاهرة سماعیة و لیس له قاعدة یسیر وفقها القائلون إلاّ فی النسبة للمركب الإضافی. فقد قال العلماء إنه مبنیّ على تركیب كلمة من اللفظین على وزن " فعلل" بأخذ الفاء والعین من كلّ لفظ ثم ینسب للفظ الجدید كعبشمیّ فی عبد شمس، وعبد ریّ فی عبد الدار، وتیملیّ فی تیم اللاّت. وفی غیر ذلك مبنى على السّماع والأخذ عن العرب" (ص 56). غیر أنّ بعض الباحثین المتأخرین فهموا نصّ ابن فارس: "… وهذا مذهبنا فی أن الأشیاء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت" (الصاحبی، ص271)، فهموه فهماً مختلفاً بحیث استنتج بعضهم من هذا النص أنّ ابن فارس یرى أنّ النحت قیاسی. یقول الدكتور إبراهیم أنیس: " ومع وفرة ما روی من أمثلة النحت تحرج معظم اللّغویین فی شأنه و اعتبروه من السّماع، فلم یبیحوا لنا نحن المولدین أن ننهج نهجه أو أن ننسج على منواله. مع هذا، فقد اعتبره ابن فارس قیاسیا، وعده ابن مالك فی كتابه التسهیل قیاسیّا كذلك"(من أسرار اللغة، د. إبراهیم أنیس، ص72). یقول ابن مالك فی التسهیل: قد یُبْنَى من جُزأی المركب " فَعْلَلَ " بفاء كل منهما وعینه، فإن اعتلّت عین الثانی كمل البناء بلامه أو بلام الأول و نسب إلیه. وقال أبو حیّان فی شرحه: وهذا الحكم لا یطّرد؛ إنّما یقال منه ما قالته العرب، والمحفوظ عَبْشمیّ فی عبد شمس، وعبد ریّ فی عبد الدار، ومرقسىّ فی امرئ القیس، وعَبْقَسَىّ فی عبد القیس، و تیملیّ فی تیم الله (لاحظ المزهر للسیوطی، 485 / 1). و لكنّ لجنة النحت بمجمع اللغة العربیة فی القاهرة علّقت على هذا الاختلاف بالقول: "… وقد نقلنا فیما تقدّم عبارة ابن فارس فی فقه اللغة، وهی لا تفید القیاسیة إلاّ إذا نظر إلى أنّ ابن فارس ادعى أكثریة النحت فیما زاد عن ثلاثة، ومع الكثرة تصحّ القیاسیة والاتساع " (لاحظ مجلة المجمع: 7/202، 203. أیضا راجع النحت فی اللغة العربیة، د. نهاد الموسى، ص284 وما بعدها). وهكذا یظلّ النحت بین قیاس وسماع بین اللغویین، و لكن مجمع اللغة العربیة وقف من ظاهرة النحت موقف المتردّد فی قبول قیاسیته حتى تجدد البحث أخیراً حول إباحته أو منعه، فرأى رجال الطبّ والصیدلة والعلوم الكیماویة والحیوانیة والنباتیة فی إباحته وسیلة من خیر الوسائل التی تساعدهم عند ترجمة المصطلحات الأجنبیة إلى اللغة العربیة (اللغة والنحو، عباس حسن، ص 245، دار المعارف بمصر1966). ومن هنا؛ انتهى مجمع اللغة العربیة بالقاهرة إلى قرار سنة 1948م حیث أفاد: " جواز النّحت فی العلوم والفنون للحاجة الملحّة إلى التعبیر عن معانیها بألفاظ عربیّة موجزة"(مجلة المجمع 7/203). ولكن بشرط انسجام الحروف عند تألیفها فی الكلمة المنحوتة، وتنـزیل هذه الكلمة على أحكام العربیة، وصیاغتها على وزن من أوزانها. وبتحقیق هذه الشروط یكون النّحت - كجمیع أنواع الاشتقاق- وسیلة رائعة لتنمیة هذه اللغة وتجدید أسالیبها فی التعبیر والبیان من غیر تحیّف لطبیعتها، أو عدوان على نسیجها المحكم المتین(دراسات فی فقه اللغة، د. صبحی الصالح، ص 274).
أقسام النحت
قبل أن ندخل فی بحث أقسام النحت، حری بنا أن نذكر أن هناك تأویلات ألفاظ قائمة على وجوه التفكه حیث نستطیع أن نحملها على النحت. و ذلك كالذی أورده الجاحظ (المتوفى 255هـ) عن أبی عبد الرحمن الثوری، إذ قال لابنه: " بنی! إنما صار تأویل الدرهم، دار الهمّ، وتأویل الدینار، یدنی إلى النار"( البخلاء، تحقیق طه الحاجری، ص 106، دار المعارف بمصر، 1958م). ومنه: " كان عبد الأعلى إذا قیل له: لم سمّی الكلب سلوقیا؟ قال: لأنه یستل ویلقى، وإذا قیل له: لم سمّی العصفور عصفوراً؟ قال: لأنه عصى و فرّ ".
كما یقول ابن فارس فی كتابه الصاحبی: " العرب تنحت من كلمتین كلمة واحدة، وهو جنس من الاختصار … وهذا مذهبنا فی أن الأشیاء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت. مثل قول العرب للرجل الشدید " ضِبَطْر" من ضَبَطَ و ضَبَرَ"( ص271). قام المتأخرون من علماء اللغة من خلال استقرائهم للأمثلة التی أوردها الخلیل بن أحمد و ابن فارس بتقسیم النّحت إلى أقسام عدّة، یمكن أن حصرها كما یلی: * النحت الفعلی: وهو أن تنحت من الجملة فعلاً، یدل على النطق بها، أو على حدوث مضمونها، مثل:
جعفد من: جعلت فداك. بسمل من: بسم الله الرحمن الرحیم * النحت الاسمی: و هو أن تنحت من كلمتین اسما. مثل: جلمود من: جمد و جلد. حَبْقُر للبرد، و أصله: حَبُّ و قُرّ. * النحت الوصفی: وهو أن تنحت كلمة واحدة من كلمتین، تدل على صفة بمعناها أو بأشدّ منه، مثل: ضِبَطْر للرجل الشدید، مأخوذة من ضَبَط و ضَبَر. الصّلدم وهو الشدید الحافر، مأخوذة من الصلد والصدم.
النحت التخفیفی
مثل بلحارث فی بنی الحارث، وبلخزرج فی بنی الخزرج وذلك لقرب مخرجی النون واللاّم، فلما لم یمكنهم الإدغام لسكون اللاّم حذفوا. وكذلك یفعلون بكلّ قبیلة تظهر فیها لام المعرفة، فأمّا إذا لم تظهر اللاّم فلا یكون ذلك، مثل: بنى الصیداء، وبنى الضباب، وبنى النجار(اقتباس من: فقه اللغة، د. إبراهیم أبو سكین، ص 23(. * النحت النسبی: وهو أن تنسب شیئاً أو شخصاً إلى بلدتین. مثل: طبرخزیّ: أی منسوب إلى المدینتین (طبرستان) و (خوارزم) تنحت من اسمیهما اسماً واحداً على صیغة اسم المنسوب.
شفعنتی یقال فی النسبة إلى " الشافعی و أبی حفیفة ". حنفلتی یقال فی النسبة إلى " أبی حنیفة و المعتزلة ". * النحت الحرفی: مثل قول بعض النحویین، إنّ (لكنّ) منحوتة، فقد رأى الفراء أنّ أصلها (لكن أنّ) طرحت الهمزة للتخفیف و نون (لكن) للساكنین. ذهب غیره من الكوفیین إلى أنّ أصلها (لا) و(أن) والكاف الزائدة لا التشبیهیّة، وحذفت الهمزة تخفیفا (لاحظ النحت بین مؤیدیه ومعارضیه، د. فارس البطاینة، ص 122نقلا عن كتاب شرح المفصّل لابن یعیش). وهنا نأتی بنماذج من المصطلحات و الكلمات المنحوتة ذكرناها على سبیل التمثیل لا الحصر رجاء بأنه یفید الطلاب و القارئین و المهتمین به و لیزیدوا لإكماله. أَزَنیّ: فی الرمح المنسوب إلى ذی یَزَن.
إِمّعَیّ: النسبة إلى إمّع و هو من قول إنّی معك (للذم، إذ أنّ الإمعة هو الذی لا رأْی له ولا عَزْم فهو یتابع كل أَحد على رأْیِه ولا یثبت على شیء).
البَرِیدَال: من البرید الإلكترونی و هی تعریب كلمة." E-mail" الأغْلِرضَانیَّة: كرة أرضیة من الأغِلفَة و الأرْضانیة بترودلار: منحوت من البترول و الدولار. البرمائی: منحوت من البرّ و الماء. * البرمائیّات. كل حیوان یعیش فی البر و الماء.
بسملَ: قال بسم الله الرحمن الرحیم و مأخوذ من بسم الله الرحمن الرحیم.
بلعنبر: منحوت من بنی العنبر.
التكبیر: قول الله أكبر.
التنظطبیعی: نظام بیئی من التناظمُ و الطبیعة.
جعفدَ: قال جعلت فداك.
حسبلَ: قال حسبی الله.
حَلْمَأ: مِن حلّ بالماء.
حمدل: قال الحمد لله.
حنفلتیّ: النسبة إلى أبی حنیفة مع المعتزلة.
حوقل: قال لا حول ولا قوة إلا بالله و مأخوذ من هذه العبارة.
الحیزمن: منحوت من الحیّز و الزمان.
حیعلَ أو حوعلَ: قال حی على الصلاة.
- زاد الثعالبی فی فقه اللغة:
الحَیْعَلَة (حكایة) قول المؤذن: حیّ على الصلاة، حیّ على الفلاح.
حیفل: قال حی على الفلاح.
الحینـَبات: منحوت من الحیوان و النبات.
دمعزَ: قال أدام الله عزك.
الرأسمال: منحوت من الرأس و المال.
- الدول الرأسمالیّة.
الركمجة: منحوت من الركوب و الموج.
الزمكان: منحوت من الزمان و المكان.
سبحلَ: قال سبحان الله و منها مأخوذة.
السّرنمة: منحوت من السیر و النوم.
* و كذلك مثله " السّرمنة " منحوت من السیر و المنام.
سمعلَ: قال السلام علیكم.
شفعنتیّ: ینسب إلى الشافعی مع أبی حنیفة.
شقحطب: منحوت من شقّ و حَطَب.
الشَنكبُوتِیة: من الشبكة العنكبوتیة و هی تعریب كلمة " " Internet.
صهْصلقَ: من صهل و صلق.
الضبْخن: منحوت من الضباب و الدخان.
طلبقَ: قال أطال الله بقاءك.
عبدریّ: نسبة إلى عبد الدار. عبشمی: من عبد شمس و نسبة إلیها. عبقسیّ: نسبة إلى عبد القیس.
* فی الصحاح : یقال فی النسبة إلى عبد شَمس: عَبْشَمیّ و إلى عبد الدار عَبْدَریّ و إلى عبد القیس عَبْقسیّ یُؤْخَذ من الأول حرفان و من الثانی حرفان ویقال: تعَبْشَم الرجلُ: إذا تعلَّق بسبب من أسباب عبد شمس إما بحلْف أو جوار أو وَلاَء و تَعَبْقس إذا تعلّق بعبد القیس. قال: وأما عَبْشَمس بنُ زید مناةَ بن تمیم فإن أبا عمرو بن العلاء یقول: أصله عَبُّ شمسٍ أو حبُّ شمس وهو ضوؤها والعین مبدلة من الحاء كما قالوا: حَبْقُرّ فی عَبُّ قُرٍّ وهو البَرد. و قال أبو حیّان فی شرحه: وهذا الحكم لا یطّرد إنما یقال منه ما قالته العرب والمحفوظ عَبْشمیّ فی عبد شمس وعَبْدریّ فی عبد الدار و مرقسیّ لغة فی امرىء القیس وعَبْقسیّ لغة فی عبد القیس و تیملی فی النسبة إلى تیم اللَّه.
العَجَمْضى: ضرب من التمر. من عجم وهو النّوى وضَاجم واد معروف. وفی الجمهرة: العَجَمْضى و ذلك ضرب من التمر وهما اسمان جُعلا اسماً واحداً: عجم وهو النّوى وضَاجم واد معروف.
العمطبیعة: منحوت من العوامل و الطبیعة.
غِبُّلوغ: منحوت من الغِبّ و البلوغ.
الفذلكة: من فذلك كذا و كذا.
قبتاریخ: منحوت من قبل التاریخ.
القروسطى: منحوت من القرون و الوسطى.
الكثاسَكَن: من الكثافة و السكان أی: كثافة سكانیة.
كهرضوئی: من كهرباء وضوء.
الكهرطیسی: منحوت من الكهرباء و المغنطیس.
كهرمائیّ: منحوت من الكهرباء و الماء.
مدرحی أو مدرحیة: منحوت من المادة و الروح.
مشأل: قال ما شاء الله. فلان كثیر المشألة إذا أكثر من هذه الكلمة.
المصطلاجدة: من المصادرالطبیعیة و اللامتجددة.
معْتَوطن: نوع مستوطن من مستوطن و وباء
النظجفة: منحوت من النظافة و الجفاف.
النَّفْسَجِسْمی: منحوت من النفس و الجسم.
هلـّل: قال لا إله إلا الله.
إذن النحت الطریقة التی یتم فیها جمع كلمتین أو أكثر باختیار أجزاء مناسبة من الكلمات المتعددة و المختلفة، لتعطی كلمة واحدة فی النهایة. هذه العملیة تستعمل بكثرة فی اللغات الأجنبیة، و بالخصوص الإنكلیزیة، و لكن قلّما یلجأ إلیها فی العربیة. و كما نلاحظ، فاللغة العربیة عبارة عن كائن حی یؤثر و یتأثر بالمحیط الخارجی، و هذه الظاهرة سوف تستمر ما دام هنالك أناس یستعملونها. و لكن الشیء الذی یصعب فهمه فی هذا العصر، لماذا أصابها نوع من العقم رغم الطرق العدیدة فی تكوین المصطلحات بالمقارنة مع اللغات الأخرى؟
على كل حال، عالج الباحثون هذا الموضوع بما فیه الكفایة فی أبحاث متعددة. و تكفینا هذه المجموعة لرسم صورة عامة عن النحت فی اللغة العربیة؛ إذ النماذج التمثیلیة كثیرة فی كتب اللغة. و ذكرناها على سبیل التمثیل لا الحصر. (للمزید من المعلومات راجع الاشتقاق والتعریب، للأستاذ عبد القادر المغربی، النحت بین مؤیدیه ومعارضیه للدكتور فارس فندى البطاینة، الاشتقاق للدكتور فؤاد ترزی، دراسات فی فقه اللغة للدكتور صبحی الصالح، فقه اللغة للدكتور إبراهیـم أبـو سكین، الاشتقاق عند اللغویین للدكتورفتحی الدّابولی، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام هارون، السیوطی، المزهر فی علوم اللغة وأنواعها، شرحه و ضبطه محمد أحمد جاد المولى وآخرون و فقه اللغة العربیة وخصائصها للدكتور إمیل بدیع یعقوب).
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:50|
أسطورة «تمّوز» بین الأساطیر المشهورة
الملخّص
من أبرز الظواهر الفنیة التّی تلفت النظر فی تجربة الشعرالجدیدة هوالإکثار من استخدام الرمز والأسطورة أداة للتعبیر. وفی أدبنا المعاصر،تلعب الأساطیر دوراً کبیراً. وکأن الأسطورة أصحبت وسیلة لتبیین الآمال والمقاصد الإنسانیة وهی الجزء الناطق من الشعائر البدائیة والذی نماه الخیال الإنسانی واستخدمته الآداب العالمیة. والأسطورة فی الواقع الرمز الأکبر ولیست سوی الحالة الرمزیة البدائیة الأولی. للأساطیر أنواع مختلفة ولکّل منها معنی خاص.
ومن هذا المنطلق یلقی هذا المقال الضوء علی بعض هذه الأساطیر المشهورة وکیفیة استخدامها فی الأدب العربی المعاصر ولاسیما أسطورة تمّوز وهو أسطورة الحیاة و الانبعاث.
الکلمات الدلیلیة: الرمز، الأسطورة، أدونیس،تمّوز
المقدمة
تتولّد الأسطورة من صمیم التاریخ والتاریخ البدائی لنوع البشر هو«الوقائع التّی ترویها الأساطیر وهی وقایع تاریخیة احتفظت بها الذاکرة البشریة لفترة طویلة قبل أن یکتشف الأنسان الکتابة. وعزّز هؤلاء نظریتهم بالقول إن عدداً غیر قلیل من الأساطیر القدیمة هونوع من التدوین البدائی للتاریخ بمعنی أنه یحفظ فی داخله بعض الحقائق التاریخیة الموغلة فی القدم.» (الصالح،2001م :13). للأسطورة صلة وثیقة بالأنواع الأدبیة.لأن الأسطورة هی الکلام المصور البشری. وللشعر مکانة مرموقة فی الأنواع الأدبیة التّی یمکن عدّها حلقات متصلة فی سلسلة النشاط الإبداعی للفکر البشری. ولعّل من أبرز الصلات التی تقیمها الأسطورة مع الشعر، هوأن لکلیهماجوهراً واحداً علی مستویی اللغة والأداء.فعلی المستوی الأول یشترک الإثنان فی تشییدهما لغة استعاریة تؤمی ولا تفصح وتلهث وراء الحقیقة دون أن تسعی إلی الإمساک بها. ویتجّلی الثانی من خلال عودة الشعر الدائمة إلی المنابع البکر للتجربة الإنسانیة ومحاولة التعبیر عن الإنسان بوسائل عذراء لم یمتهنها الاستعمال الیومی.
أشهر الأساطیر فی الأدب العربی المعاصر
لم یستفد الشعراء من الأساطیر فی آثارهم الأدبیة فی أی عصر من العصور کما استفادوا فی عصرنا الحاضر والّذی نعالج عوامله فی الفصول القادمة.« یستفی شعراءنا المعاصرون الذین یستخدمون الأساطیر من مصادر عدیدة تتخلص فی:
- ألف) الأساطیر : وهی بالطبع المصدر الأصلی.وقد لجاً شعرا ؤنا إلی الأساطیر الیونانیة، الفینیقیة، الأشوریة، البابلیة والفرعونیة. وألمّ بعضهم بالأساطیر الإفریقیة والصّینیة.
- ب) الحکایات الشعبیة : من أشهر مجموعات الحکایات الشعبیة التی أثرت فی شعرنا المعاصر کما أثرت فی کل الآداب العالمیة: کلیلة ودمنة وألف لیلة ولیلة….
- ج) التاریخ و الکتب المقدسة: کما اتخذ الشاعر أدونیس من مهیار الدیلمی ستاراً واتخّذ غیره من المتنبّی والخیام وأبی العلاء وأبی موسی الأشعری وغیرهم أقنعة أخرى وأیضا ینظر الشعر إلى الکتب المقدسة مثل قصة صلب المسیح أو عصیان ابن نوح لوالده فی القرآن» (داود، 1992: 90-92). فی الأدب العربی المعاصر أساطیر کثیرة وأشهرها هی:
- آلف) من الأساطیرالبابلیة: تمّوز وعشتروت
- ب) الأساطیر الیونانیة: سیزیف، فینوس، إذونیس ….
- ج) من الأساطیر العبریة: السندباد، شهرزاد،عنتر، قابیل وهابیل، المسیح…
المسیح
ممایظهر من معالجة الآثارالأدبیة المعاصرة هوأنّ استخدام کلمة "مسیح" فی آثارهم رمزیدلّ علی البعث والنشوء وهو رمزللقیامة والبعث بعد الموت. المسیح مات مصلوباً یتخذه شعراءنا دلالة علی المعاناة والمحنة کمافعل أمیرالشعراء، أحمدشوقی.وفی شعره کثیرمن الإشارات إلی شخصیة السید المسیح وما فیها من طیبّة ورحمة وطهارة نبل و یسری. ونری هذالمعنی فی أشعارشعراء المدارس الشعریة فیما قبل الحرب العالمیة الثانیة. وکما نری «بدرشاکرالسیاب یلبس فی قصیدته "أنشودة المطر" قناع المسیح وتتفاعل شخصیته مع هذا القناع.» (حلاوی، 1994م: 71) حیث یقول:
«بعد ما أنزلونی، سمعت الریاح
فی نواح طویل تسفّ النـْخیل،
والخطی وهی تتأی. إذن فالجراح
والصلیب الذ ّی سمّرونی علیه. طوال الأصیل
لم تُمتنی.» [1]
«هنا یظهر لناالمسیح الجریح الذی سمّر علی الصلیب ولکنه لم یمُت، هو إذن رمز إلهی ومخلّص یفتدی البشریة والسیاب یعتقد أن المسیح هو الذی یغطـی عری الفقراء ویکسو عظامهم وهوالغطاء الروحی یبلسم الجراح، أنه نورانی شفاف هو الشق الإلهی من البشر.» [2].
ربّما یمکن القول بأن الفقر والمجاعة المنتشرة فی أکثرالبلاد العربیة ولا سیما العراق سبّبت أن یکون المسیح رمزاً لإنقاذ عالم البشریة والقول بأنه سیأتی شخص وسیقوم بطل بإنهاء هذه المجاعة والفقر والجدب وهو الذی یعِد البشریة بولادة جدیدة.
السندباد
و أما السندباد فی الأدب العربی المعاصر فقد کان متطلعاً لمعرفة، باحثاًعما یشوق … یستحثه فضول لاهف للرحلة بعدالرحلة. فبواعث الرحلة مختلفة، إذن عند کل منهما، ولکن الاستخدام الشعری الحدیث یجد أحیاناً فی کل منهما ملاقاة الأخطار والترحیب بمواجهة المجهول والتعبیر عن الرغبة فی الانعتاق من أسر الواقع ورتابة الحیاة الاجتماعیة.یبدو أن السیاب فی أدبنا المعاصریعتبر رمزاً للولوج فی المخاطر والمغامرات صنعاً لحیاة أفضل وخلاصاً من الفقر والمجاعة. کما یقول خلیل حاوی فی دیوانه "النای والریح":
رحلاتی السبعُ وماکَنّزتُهُ
من نعمة الرحمان والتّجارَه
یومَ صرعَتُ الغول والشیطانَ
یومَ انشقتِ الأکفانُ عن جسمی
ولاح الشقُّ المغاره،
رویتُ مایروون عنّی عادةً
کَتَمتُ ما تَعیا لَهُ العِبَاره
وَلَم أزَل أمضِی وَ أمضِی خَلفَهُ
أحِسُّهُ عِندی وَ لا أعِیهِ. » [3]
والواضح«إنه یبحث عن شیء، یحسّه عنده ولایعیه والدائرة الثانیة ستوضّح لناطبیعة المشکلة السندبادیة الّتی منعته من الاستقرار وهناءة العیش فیقتحم دوخة البحار معترضاً لشتّی أنواع المخاطر فی سبیل الکشف عن ذلک الشیء الذی یحسّه عنده ولایعیه» [4]
العنقاء (الفینیق)
هما اسمان مختلفان لطائر واحدوهما أیضاً عنصرا النار والرّماد أوالحیاة والموت. تحدّث عنه کثیرمن الشعراء کما «نعرف أن الجاحظ فی الحیوان وأبانواس فی شعره أوردا تفضیلات إضافیة مهمة تقرن العنقاء بالسیمرغ الفارسی وهوطائر أسطوری استخدمه فریدالدین العطار(1224م)فی منطق الطیر رمزاً مرکزیاً لطائرالطیور وصورة الصور، مبیناً من خلال توجه رحلة الطیور إلیه، وتوحدها به عقیدتی وحدة الشهود و وحدة الوجود فی الفکر الصوفی» [5].
وفی أدبنا المعاصریستخدم خلیل حاوی أسطورة العنقاء فی قصیدة "بعد الجلید".القصیدة تتألف من لوحتین: الأولی بعنوان"عصرالجلید" أو عصرالموت والثانیة بعنوان"بعد الجلید" أو بعدالموت أی القیامة هذه الأسطورة تشیر إلی جمود الحضارة الشرقیة وإلی حالة یموت فیها التغّیر والتقدّم ویسیطرالموت والفناء علی البلاد العربیة. ولکـّن الحالة هذه ستزول وتنتبه الأجیال القادمة وستحصل علی تجربة جدیدة وستطیر فی الأجواء المناسبة کما فعلت العنقاء فی بناء أسس الحیاة بعد أن أحترقت نفسها فی النار لبناء حیاة جدیدة. کما یقول خلیل حاوی فی هذه القصیدة:
«ان یکن ربّاهُ
لایحیی عروقَ المیتینا
غیرُ نارٍ تَلِدُ العنقاءَ، نارٌ
تتغذّی من رمادِ الموت فینا
فی القرار.
فَلنُعانِ مِن جحیم النار.
مایمنَحُنا البعثَ الیقینا. [6]
یستخدم الشاعر هنا أسطورة العنقاء التی تحرق نفسها وتنبعث من رمادها تنضح نضارة وفتوة.
أسطورة تمّوز بین الأساطیر المشهورة
تمّوزأسطورة بابلیة و بابل هی مدینة تاریخیة تعود قدمتها إلی«بدایة الألفیة الثالثة قبل المیلاد. مطالعة حضارتی آشور وبابل، وهما من أقدم الأقوام التاریخیة، مفتاح للدخول فی تاریخ العالم القدیم» [7] . أما أسطورة "تموز" تعادل "دمُوز" فی الثقافة السومریة و"أدونیس" فی الثقافة الأغریقیة وفی بلاد سوریا وفلسطین. وفی الأدب الفارسی تمّوز یعادل "حاجی فیروز" الذی یظهر لیالی آخرکلّ سنة فی ثوب أحمر ووجه أسود. احمرار ثوبه یشیر إلی إعادة العیش والحیاة واسوداد وجه یشیر إلی اسوداد أرض الأموات وقد عاد من دیار الأموات حقیقة لإجراء الحیاة علی الأرض فی فصل الربیع.
أمافیما یتعلّق بمأساة تموّز أومراث لتمّوزفقد قیل: «عندما یرحل التمّوز إلی تحت الأرض، تصبح عشتار، عاشقته ، کئیبة وحزینة وتندبه وترثیه وهی مشهورة بمأتم تمّوز» [8]. ومن بعد ذلک کان الناس یقیمون مراسیم لمأتم هذه الأسطورة وفی کثیر من القصائد الدینیة البابلیة مراث لتمّوز الذی فجعت به الأرض یشبه فیها بالنباتات السریعة الذبول فهو مثلاً:
طرفاء فی الجنینة لم یسقها الماء
ولم تزهر بالنور قمتها فی الحقول
صفصافة لم تسعد بالمیاه الجاریة
صفصافة تمزّقت جذورها. [9]
تموّز فی أشعار الشعراء المعاصرین
الشعراء التموزیون مصطلح أطلقه جبرا إبراهیم جبرا علی کلّ من بدرشاکر السیاب خلیل حاوی، یوسف الخال، وأدونیس وجمیعهم کانوا من شعراء مجلة الشعر. کتب جبرا إبراهیم جبرا کتاباً تحت عنوان "تموّز فی المدینة" سنة 1959م وفیه رموز الموت والتمزیق والفتک ویقول فیه: «هذه القصائد تلخص لی سنواتی الأخیرة وبحثی فیها عن مصادر الإیناع والخصب.أکانت السنوات لغیری ماکانت لی أنا؟ مهمایکن الجواب، فلشدّ ما آمل أن نعود إلی المدینة راقصین.»(جبرا، 1959 م:6).
وینتمی السیاب إلی أسرة الشعراء التمّوزیین وتنعکس صورالأسطورة التمّوزیة ورموزها المختلفة وتنویعات موضوعها فی القصائد التالیة من شعره "النهروالموت"،"جیکورو المدینة"،"المسیح بعدالصلب"،"أغنیة فی شهرآب"،"أنشودة المطر"، "رسالة من قبر" ولاتظهرالأسطورة التموزیة بشکل واضح الملامح فی أغلب قصائد السیاب التی ذکرناها ولکن الصور والأفکار التّی تطالعنا فی تلک القصائد تشیرإلی مغزی الأسطورة التموزیة. مثلاً فی قصیدة"أنشودة المطر"یلبس فیها المسیح ثوب التموّز حینما یقول:
بعدما أنزلونی، سمعتُ الریاح
فی نواح طویلٍ تسّفُ النخیل
والخُطی وهی تنأی. إذن فالجراح
والصلیبُ الذّی سمّرونی علیه طوال الأصیل
لم تمتنی
ویواصل کلامه ویقول:
«حینما یزهَرُ التوتُ والبرتقال
حین تَمتدّ "جَیکُور" حتی حدودِ الخَیال،
حینَ تخضّرعشباً یغنی شذاها
والشموس الّتی أرضَعَتها سناها،
حین یخضرّ حتی دجاها،
یلمس الدفء قلبی فیجری دمی فی ثراها.»
[10]
ویطلّ علینا المسیح بوجه آخر فیقترب من تمّوز جوّ الاقتراب. إن المسیح هنا، یتقمّص شخصیة إله الخصب تمّوز، إذ إنه یعلن أنّ الدماء الدافئة ستجری فی قلبه بطلوع الربیع فی قریة جیکور. وهو یشیرفیها إلی خصائص أسطورة تموّز نفسها إلی الموت والفناء وبعد ذلک یشیر إلی البعث والحیاة.
وأما خلیل حاوی فهو أحد من الشعراء التموزیین الّذی یستخدم أسطورة تمّوز فی بعض قصائده. کقصیدة:"بعدالجلید"من دیوان"نهرالرماد". فی هذه القصیدة یفید الشاعرمن أسطورة تموّز وما ترمز إلیه من غلبة الحیاة والخصب علی الموت والجفاف. فی بدایة القصیدة یشیرإلی الجلید الذی تغشی کل مکان وقدحوّل کل شیء إلی الرکود والجمود حیث یقول:
«عندما ماتت عروقُ الأرض
فی عصرِ الجلید
مات فینا کلُّ عِرقٍ
یبُسَتˆ أعضاؤنا لحماً قدیدˆ
عبثاً کُنّا نًصُدُّ الریحَ
واللیلَ الحزینا
ونُداری رعشة
مقطوعة الأنفاس فینا
رعشة الموتِ الأکید
فی خلایا العظمِ فی سرِّ الخلایا …» [11]
یشیر الشاعرإلی الأجواء الباردة التی أحاطت کلّ مکان وإلی اللّیالی السوداء والمغمومة وإلی الحیاة النازحة وإلی الموت والفناء الذی یسیطرعلی کل شیء. ویرمز بصورة غیر مباشرة إلی تلک الحیاة التی قد هاجرت إلی تحت الأرض مع رحلة تمّوز. وفی هذه الأجواء المفعمة بالهموم والأحزان والموت والفناء، یبشّرالشاعربظهورأسطورة تمّوز فجأة کمایشیر إلی "بعل" وهو إله الخصب والحیاة عند الفینیقیین. وکأن الشاعرنفسه مشغول بانجاز الطقوس الدینیة أمام هذه الأساطیر ویقوم بمزج أسطورة تموّز ببعل فجأة حیث یقول:
«یا أله الخصبِ، یا بعلاً یفضّ
التربة العاقِرَ
یا شمس َ الحصیدˆ
یاإلهاً ینفضُ القبَر
ویا فِصحاً مجید
أنتَ یا تموّز، یا شمس الحَصید
نَجِّنا، نجِّ عروقَ الأرض
مِن عُقمٍ دَهاها ودهانا
أدفی ء المَوتی الحزانی
والجَلامیدَ العَبید
عَبرَ صحراء الجلید
أنتَ یا تمُّوزُ، یا شمسَ الحصید» [12]
یقوم الشاعر بتمجید هاتین الألهتین ویطلب من "بعل" أن تشقّ التراب العقیم وتعطیه حیاة جدیدة.
وقد تأثّر خلیل حاوی من الشعراء الغربیین وقصائدهم «ولاسیما قصائد تی اس. إلیوت، القصائد التی تضمّنت دلالات طقوس الخصب وأساطیره باعترافه هو فی هامش قصیدة "الأرض الخراب". قد شجعت خلیل حاوی وباقی الشعراء التموزیین بأن یستفیدوا من تراث المنطقة الأسطوری والشعری وهم أولی به.» (العظمة، 1996م:256). یشیرخلیل حاوی إلی أوضاع بلاده والبلدان العربیة وأحوالها وإلی الأجیال التی قد کتب الجهل والفناء علیها ولایمکن أن یغیرها أی قوة من الخارج ألا أن یغیرما بأنفسها. الأسطورة هنا رمز للتقدم، والمدنیة، والحضارة، و الثقافة التی ستغیر الشرق الأوسط یوماً من الأیام. و الشاعر یعتقد أنّ الجهل بالأمور والحوادث التی تسیطر علی بلاده هی الّتی تسبّب الجمود والرکود بین الأجیال. ثم یشیر إلی هاجة بلاده بنوع من الخروج من هذا الجلید. والشاعر الأخیرالذی نعالج بعض قصائده وهومن الشعراء التموّزیین والّذی یستفید من أسطورة تموّز، أو أدونیس أو بعل مرّات عدیدة مباشرة کانت أو غیرمباشرة هو یوسف الخال الشاعرالشهیر السوری. علی سبیل المثال أنّه یذکر بعض هذه الأساطیر مباشرة فی قصیدتی "الدعاء"و"السفر" وغیر مباشرة فی قصیدتی "البئرالمهجورة" و"القصیدة الطویلة". کما یقول فی قصیدته "الدعاء" مشیراً إلی أسطورة تمّوز:
«و أدَرنا وُجوهَنا: کانت الشمسُ
غُباراً علی السنابِکِ، والأفقُ
شراعاً مُحطّماً کان تمّوز
جراحاً علی العیون وعیسی
سورةً فی الکتاب.» [13]
یشیر الشاعرفی بدایة القصیدة إلی رکود الإنسان وخیمة الموت التی سیطرت علی کلّ مکان. ثمّ یتحدّث عن قتل تمّوز علی یدالخنزیر البرّی وذهابه إلی العالم السُفلی. وأمّا عیسی الّذی نجّی قومه أصبح سورة فی الکتاب أوصورة فی الأذهان فحسب. وکأنّ الیأس خیم علی العالم. ثمّ شیئاً فشیئاً تزدهر براعم الأمل فی ذهن الشاعر فیحاول أن یبعد حالة الیأس والخیبة السائدة علی القصیدة إلی جانب فیقول:
« یا نفسُ بوحی
بالّذی صار، مَزِّقی الحُجُبَ السُودَ،
أطِلّی علی الجدید وثوری
یفتح الشاطیءُ الخلاصُ ذِراعَیه
وتعلو علی مداه السفینُ.
أیها البحرُ. أیها الأملُ البحرُ
تَرَفّق بنا، تَرَفّق، تَرَفّق!» [14]
ثمّ بدلاً عن الإشارة المباشرة إلی أسطورة تموّز أو أسطورة أخری، یستخدم البحر رمزاً لإعادة العیش والحیاة إلی الأرض، وفی الحقیقة تحوّل البحرإلی إله یتضرّع إلیه الشاعر. ثم یتحدّث عن أمل جدید ودمع ودماء جدیدة فی مواصلة کلامه حیث یقول:
« أیها البحر، یا ذراعاً مددناها
إلی الله، رُدَّنا لک، دَعنا
نستردَّ الحیاة من نور عینیک
ودَعنا نَعود، نُرخی مع الریح
شراعاتنا، نروح ونغدو
حاملین السماء لِلأرض دمعاً
ودماءً جدیدةً.» [15]
فالبحر یصبح ذراع الخلاص وهو ینبوع الحیاة، أنّه الطریق إلی الله وهو الوحید القادر علی إنقاذ الإنسان ویتّضح لنا بأن رؤیا الشاعر دینیة ولایمکن استرداد الحیاة إلا من نورعینی الله.
وفی قصیدة أخری عنوانها "السفر" یستخدم الشاعرعدة من هذه الأساطیر ویقول:
« وقبلَما نَهُمُّ بالرّحیل نذبح الخراف
واحداً لعشتروت، واحداً لأدونیس
واحداً لِبعلَ، ثمّ نرفع المراسیَ
الحدیدَ من قرارة البحر
ونبدأ السفر.» [16]
« فی هذه الصورة ینحلّ الرمز القدیم إلی واقعة إنسانیة عامّة ذات مغزی رمزیّ. إذ کان الشاعر انّما یحدّثنا عن واقعه الشعوری الذّی یرتبط فی الوقت نفسه ارتباطاً شعوریاً وثیقا بتلک الواقعة الرمزیة القدیمة.» ( إسماعیل، 1962م: 214)
النتیجة
وأمّا الخلاصة التی نستنتجها من خلال هذا المقال فهو:
- ألف) ما کان یزدهر استخدام الأسطورة فی الأدب العربی من قبل کما ازدهر فی عصرنا المعاصر. بعد الحرب العالمیة الأولی، تعرّف الأدباء العرب علی الأدباء المشهورین الغربیین ثمّ أخذوا منهم استخدام الأساطیر مثل تمّوز أو آفرودیت.
- ب) فی هذه السنوات ومن بین هذا الجیل من الشعراء، ظهرت فئة من الشعراء المعاصرین العرب الذین یشتهرون بالشعراء التمّوزیین الذین عالجوا الأساطیر عامة و أسطورة تموّز خاصةً معالجة إبداعیة بإعطاء الصورة الجدیدة.
- ج) الشی إلواحد الذی یربط ما بین آثار هؤلاء الشعراء هوالاعتقاد بمیزة تمّوز فی انبعاثه و إعطائه الحیاة إلی الأرض.
- د) تحولّت هذه الأساطیر فی أشعارهؤلاء الشعراء المذکورین إلی رموزلانبعاث والإحیاء والرّجاء الذی یحتاج إلیها العالم الثالث والشرق الأوسط فی هذه اللیالی المظلمة وفی هذه الظروف الراهنة.
المصادر والمراجع
- إسماعیل، عزّالدین.1962م. الشعرالعربی المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة.بیروت: دارالثقافة .
- البعلبکی، منیر. 1992م. معجم أعلام المورد. الطبعة الأولی. بیروت: دارالعلم للملائین.
- جبرا، إبراهیم جبرا. 1959م. تموّز فی المدینة. الطبعة الثانیة. بیروت: الموسسة العربیة للدراسات.
- حاوی، خلیل. 1979م. الدیوان. الطبعة الثانیة. بیروت: دارالعودة.
- حلاوی، یوسف. 1994م. الأسطورة فی الشعرالعربی المعاصر. الطبعة الأولی. بیروت: دارالآداب.
- الخلال، یوسف. 1979م. الأعمال الشعریة الکاملة. الطبعة الثانیة. بیروت. دارالعودة.
- داود، أنس. 1992م. الأسطورة فی الشعرالعربی الحدیث. الطبعة الثالثة. بیروت. دارالمعارف.
- رزوّق، أسعد. 1959م. الشعراء التموزیون. الطبعة الأولی. بیروت: دارالحمراء.
- السیاب، بدرشاکر. 2000م. الأعمال الشعریة الکاملة. ج1. بیروت: دارالعودة.
- الصالح، نضال. 2001م. النزوع الأسطوری فی الروایة العربیة المعاصرة. بیروت: منشورات الکتاب العرب.
- العظمة، نذیر. 1996م. سفرالعنقاء حفریة ثقافیة فی الأسطورة. دمشق منشورات وزارة الثافیة فی الجمهوریة العربیة السوریة
- فریرز، جیمس. 1982م. أدونیس أو تموّز، دراسة فی الأساطیر والأدیان الشرقیة القدیمة. الطبعة الثالثة. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
المصادر الفارسیة
- ژیران، ف.دلاپورت، ل. لاکوئه، گ.1382 هـ ش. اساطیر آشور وبابل. ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور. چاپ سوم. انتشارات کاروان
- ساندرز، ن. ک. 1387 هـ ش. بهشت ودوزخ در اساطیر بین النهرین. چاپ سوم تهران. انتشارات کاروان.
حواشی
[1] (السیاب، 2000م: 457)
[2] (حلاوی، 1994 م:72)
[3] (حاوی 1979م:228-229)
[4] (حلاوی، 1994م: 164)
[5] (العظمة، 1996م :21)
[6] (حاوی، 1979م: 125-126)
[7] (ژیران،2001م:57)
[8] (ژیران 2001م،78)
[9] (فریزر،1982م:20)
[10] (السیاب، 2000م: 458و457)
[11] (حاوی، 1979م:117-118)
[12] (حاوی، 1979م: 119-120)
[13] الخال، 1979م: 227
[14] (الخال، 1979م: 228)
[15] (الخال 1979م: 230)
[16] (الخال 1979م: 234)
من أبرز الظواهر الفنیة التّی تلفت النظر فی تجربة الشعرالجدیدة هوالإکثار من استخدام الرمز والأسطورة أداة للتعبیر. وفی أدبنا المعاصر،تلعب الأساطیر دوراً کبیراً. وکأن الأسطورة أصحبت وسیلة لتبیین الآمال والمقاصد الإنسانیة وهی الجزء الناطق من الشعائر البدائیة والذی نماه الخیال الإنسانی واستخدمته الآداب العالمیة. والأسطورة فی الواقع الرمز الأکبر ولیست سوی الحالة الرمزیة البدائیة الأولی. للأساطیر أنواع مختلفة ولکّل منها معنی خاص.
ومن هذا المنطلق یلقی هذا المقال الضوء علی بعض هذه الأساطیر المشهورة وکیفیة استخدامها فی الأدب العربی المعاصر ولاسیما أسطورة تمّوز وهو أسطورة الحیاة و الانبعاث.
الکلمات الدلیلیة: الرمز، الأسطورة، أدونیس،تمّوز
المقدمة
تتولّد الأسطورة من صمیم التاریخ والتاریخ البدائی لنوع البشر هو«الوقائع التّی ترویها الأساطیر وهی وقایع تاریخیة احتفظت بها الذاکرة البشریة لفترة طویلة قبل أن یکتشف الأنسان الکتابة. وعزّز هؤلاء نظریتهم بالقول إن عدداً غیر قلیل من الأساطیر القدیمة هونوع من التدوین البدائی للتاریخ بمعنی أنه یحفظ فی داخله بعض الحقائق التاریخیة الموغلة فی القدم.» (الصالح،2001م :13). للأسطورة صلة وثیقة بالأنواع الأدبیة.لأن الأسطورة هی الکلام المصور البشری. وللشعر مکانة مرموقة فی الأنواع الأدبیة التّی یمکن عدّها حلقات متصلة فی سلسلة النشاط الإبداعی للفکر البشری. ولعّل من أبرز الصلات التی تقیمها الأسطورة مع الشعر، هوأن لکلیهماجوهراً واحداً علی مستویی اللغة والأداء.فعلی المستوی الأول یشترک الإثنان فی تشییدهما لغة استعاریة تؤمی ولا تفصح وتلهث وراء الحقیقة دون أن تسعی إلی الإمساک بها. ویتجّلی الثانی من خلال عودة الشعر الدائمة إلی المنابع البکر للتجربة الإنسانیة ومحاولة التعبیر عن الإنسان بوسائل عذراء لم یمتهنها الاستعمال الیومی.
أشهر الأساطیر فی الأدب العربی المعاصر
لم یستفد الشعراء من الأساطیر فی آثارهم الأدبیة فی أی عصر من العصور کما استفادوا فی عصرنا الحاضر والّذی نعالج عوامله فی الفصول القادمة.« یستفی شعراءنا المعاصرون الذین یستخدمون الأساطیر من مصادر عدیدة تتخلص فی:
- ألف) الأساطیر : وهی بالطبع المصدر الأصلی.وقد لجاً شعرا ؤنا إلی الأساطیر الیونانیة، الفینیقیة، الأشوریة، البابلیة والفرعونیة. وألمّ بعضهم بالأساطیر الإفریقیة والصّینیة.
- ب) الحکایات الشعبیة : من أشهر مجموعات الحکایات الشعبیة التی أثرت فی شعرنا المعاصر کما أثرت فی کل الآداب العالمیة: کلیلة ودمنة وألف لیلة ولیلة….
- ج) التاریخ و الکتب المقدسة: کما اتخذ الشاعر أدونیس من مهیار الدیلمی ستاراً واتخّذ غیره من المتنبّی والخیام وأبی العلاء وأبی موسی الأشعری وغیرهم أقنعة أخرى وأیضا ینظر الشعر إلى الکتب المقدسة مثل قصة صلب المسیح أو عصیان ابن نوح لوالده فی القرآن» (داود، 1992: 90-92). فی الأدب العربی المعاصر أساطیر کثیرة وأشهرها هی:
- آلف) من الأساطیرالبابلیة: تمّوز وعشتروت
- ب) الأساطیر الیونانیة: سیزیف، فینوس، إذونیس ….
- ج) من الأساطیر العبریة: السندباد، شهرزاد،عنتر، قابیل وهابیل، المسیح…
المسیح
ممایظهر من معالجة الآثارالأدبیة المعاصرة هوأنّ استخدام کلمة "مسیح" فی آثارهم رمزیدلّ علی البعث والنشوء وهو رمزللقیامة والبعث بعد الموت. المسیح مات مصلوباً یتخذه شعراءنا دلالة علی المعاناة والمحنة کمافعل أمیرالشعراء، أحمدشوقی.وفی شعره کثیرمن الإشارات إلی شخصیة السید المسیح وما فیها من طیبّة ورحمة وطهارة نبل و یسری. ونری هذالمعنی فی أشعارشعراء المدارس الشعریة فیما قبل الحرب العالمیة الثانیة. وکما نری «بدرشاکرالسیاب یلبس فی قصیدته "أنشودة المطر" قناع المسیح وتتفاعل شخصیته مع هذا القناع.» (حلاوی، 1994م: 71) حیث یقول:
«بعد ما أنزلونی، سمعت الریاح
فی نواح طویل تسفّ النـْخیل،
والخطی وهی تتأی. إذن فالجراح
والصلیب الذ ّی سمّرونی علیه. طوال الأصیل
لم تُمتنی.» [1]
«هنا یظهر لناالمسیح الجریح الذی سمّر علی الصلیب ولکنه لم یمُت، هو إذن رمز إلهی ومخلّص یفتدی البشریة والسیاب یعتقد أن المسیح هو الذی یغطـی عری الفقراء ویکسو عظامهم وهوالغطاء الروحی یبلسم الجراح، أنه نورانی شفاف هو الشق الإلهی من البشر.» [2].
ربّما یمکن القول بأن الفقر والمجاعة المنتشرة فی أکثرالبلاد العربیة ولا سیما العراق سبّبت أن یکون المسیح رمزاً لإنقاذ عالم البشریة والقول بأنه سیأتی شخص وسیقوم بطل بإنهاء هذه المجاعة والفقر والجدب وهو الذی یعِد البشریة بولادة جدیدة.
السندباد
و أما السندباد فی الأدب العربی المعاصر فقد کان متطلعاً لمعرفة، باحثاًعما یشوق … یستحثه فضول لاهف للرحلة بعدالرحلة. فبواعث الرحلة مختلفة، إذن عند کل منهما، ولکن الاستخدام الشعری الحدیث یجد أحیاناً فی کل منهما ملاقاة الأخطار والترحیب بمواجهة المجهول والتعبیر عن الرغبة فی الانعتاق من أسر الواقع ورتابة الحیاة الاجتماعیة.یبدو أن السیاب فی أدبنا المعاصریعتبر رمزاً للولوج فی المخاطر والمغامرات صنعاً لحیاة أفضل وخلاصاً من الفقر والمجاعة. کما یقول خلیل حاوی فی دیوانه "النای والریح":
رحلاتی السبعُ وماکَنّزتُهُ
من نعمة الرحمان والتّجارَه
یومَ صرعَتُ الغول والشیطانَ
یومَ انشقتِ الأکفانُ عن جسمی
ولاح الشقُّ المغاره،
رویتُ مایروون عنّی عادةً
کَتَمتُ ما تَعیا لَهُ العِبَاره
وَلَم أزَل أمضِی وَ أمضِی خَلفَهُ
أحِسُّهُ عِندی وَ لا أعِیهِ. » [3]
والواضح«إنه یبحث عن شیء، یحسّه عنده ولایعیه والدائرة الثانیة ستوضّح لناطبیعة المشکلة السندبادیة الّتی منعته من الاستقرار وهناءة العیش فیقتحم دوخة البحار معترضاً لشتّی أنواع المخاطر فی سبیل الکشف عن ذلک الشیء الذی یحسّه عنده ولایعیه» [4]
العنقاء (الفینیق)
هما اسمان مختلفان لطائر واحدوهما أیضاً عنصرا النار والرّماد أوالحیاة والموت. تحدّث عنه کثیرمن الشعراء کما «نعرف أن الجاحظ فی الحیوان وأبانواس فی شعره أوردا تفضیلات إضافیة مهمة تقرن العنقاء بالسیمرغ الفارسی وهوطائر أسطوری استخدمه فریدالدین العطار(1224م)فی منطق الطیر رمزاً مرکزیاً لطائرالطیور وصورة الصور، مبیناً من خلال توجه رحلة الطیور إلیه، وتوحدها به عقیدتی وحدة الشهود و وحدة الوجود فی الفکر الصوفی» [5].
وفی أدبنا المعاصریستخدم خلیل حاوی أسطورة العنقاء فی قصیدة "بعد الجلید".القصیدة تتألف من لوحتین: الأولی بعنوان"عصرالجلید" أو عصرالموت والثانیة بعنوان"بعد الجلید" أو بعدالموت أی القیامة هذه الأسطورة تشیر إلی جمود الحضارة الشرقیة وإلی حالة یموت فیها التغّیر والتقدّم ویسیطرالموت والفناء علی البلاد العربیة. ولکـّن الحالة هذه ستزول وتنتبه الأجیال القادمة وستحصل علی تجربة جدیدة وستطیر فی الأجواء المناسبة کما فعلت العنقاء فی بناء أسس الحیاة بعد أن أحترقت نفسها فی النار لبناء حیاة جدیدة. کما یقول خلیل حاوی فی هذه القصیدة:
«ان یکن ربّاهُ
لایحیی عروقَ المیتینا
غیرُ نارٍ تَلِدُ العنقاءَ، نارٌ
تتغذّی من رمادِ الموت فینا
فی القرار.
فَلنُعانِ مِن جحیم النار.
مایمنَحُنا البعثَ الیقینا. [6]
یستخدم الشاعر هنا أسطورة العنقاء التی تحرق نفسها وتنبعث من رمادها تنضح نضارة وفتوة.
أسطورة تمّوز بین الأساطیر المشهورة
تمّوزأسطورة بابلیة و بابل هی مدینة تاریخیة تعود قدمتها إلی«بدایة الألفیة الثالثة قبل المیلاد. مطالعة حضارتی آشور وبابل، وهما من أقدم الأقوام التاریخیة، مفتاح للدخول فی تاریخ العالم القدیم» [7] . أما أسطورة "تموز" تعادل "دمُوز" فی الثقافة السومریة و"أدونیس" فی الثقافة الأغریقیة وفی بلاد سوریا وفلسطین. وفی الأدب الفارسی تمّوز یعادل "حاجی فیروز" الذی یظهر لیالی آخرکلّ سنة فی ثوب أحمر ووجه أسود. احمرار ثوبه یشیر إلی إعادة العیش والحیاة واسوداد وجه یشیر إلی اسوداد أرض الأموات وقد عاد من دیار الأموات حقیقة لإجراء الحیاة علی الأرض فی فصل الربیع.
أمافیما یتعلّق بمأساة تموّز أومراث لتمّوزفقد قیل: «عندما یرحل التمّوز إلی تحت الأرض، تصبح عشتار، عاشقته ، کئیبة وحزینة وتندبه وترثیه وهی مشهورة بمأتم تمّوز» [8]. ومن بعد ذلک کان الناس یقیمون مراسیم لمأتم هذه الأسطورة وفی کثیر من القصائد الدینیة البابلیة مراث لتمّوز الذی فجعت به الأرض یشبه فیها بالنباتات السریعة الذبول فهو مثلاً:
طرفاء فی الجنینة لم یسقها الماء
ولم تزهر بالنور قمتها فی الحقول
صفصافة لم تسعد بالمیاه الجاریة
صفصافة تمزّقت جذورها. [9]
تموّز فی أشعار الشعراء المعاصرین
الشعراء التموزیون مصطلح أطلقه جبرا إبراهیم جبرا علی کلّ من بدرشاکر السیاب خلیل حاوی، یوسف الخال، وأدونیس وجمیعهم کانوا من شعراء مجلة الشعر. کتب جبرا إبراهیم جبرا کتاباً تحت عنوان "تموّز فی المدینة" سنة 1959م وفیه رموز الموت والتمزیق والفتک ویقول فیه: «هذه القصائد تلخص لی سنواتی الأخیرة وبحثی فیها عن مصادر الإیناع والخصب.أکانت السنوات لغیری ماکانت لی أنا؟ مهمایکن الجواب، فلشدّ ما آمل أن نعود إلی المدینة راقصین.»(جبرا، 1959 م:6).
وینتمی السیاب إلی أسرة الشعراء التمّوزیین وتنعکس صورالأسطورة التمّوزیة ورموزها المختلفة وتنویعات موضوعها فی القصائد التالیة من شعره "النهروالموت"،"جیکورو المدینة"،"المسیح بعدالصلب"،"أغنیة فی شهرآب"،"أنشودة المطر"، "رسالة من قبر" ولاتظهرالأسطورة التموزیة بشکل واضح الملامح فی أغلب قصائد السیاب التی ذکرناها ولکن الصور والأفکار التّی تطالعنا فی تلک القصائد تشیرإلی مغزی الأسطورة التموزیة. مثلاً فی قصیدة"أنشودة المطر"یلبس فیها المسیح ثوب التموّز حینما یقول:
بعدما أنزلونی، سمعتُ الریاح
فی نواح طویلٍ تسّفُ النخیل
والخُطی وهی تنأی. إذن فالجراح
والصلیبُ الذّی سمّرونی علیه طوال الأصیل
لم تمتنی
ویواصل کلامه ویقول:
«حینما یزهَرُ التوتُ والبرتقال
حین تَمتدّ "جَیکُور" حتی حدودِ الخَیال،
حینَ تخضّرعشباً یغنی شذاها
والشموس الّتی أرضَعَتها سناها،
حین یخضرّ حتی دجاها،
یلمس الدفء قلبی فیجری دمی فی ثراها.»
[10]
ویطلّ علینا المسیح بوجه آخر فیقترب من تمّوز جوّ الاقتراب. إن المسیح هنا، یتقمّص شخصیة إله الخصب تمّوز، إذ إنه یعلن أنّ الدماء الدافئة ستجری فی قلبه بطلوع الربیع فی قریة جیکور. وهو یشیرفیها إلی خصائص أسطورة تموّز نفسها إلی الموت والفناء وبعد ذلک یشیر إلی البعث والحیاة.
وأما خلیل حاوی فهو أحد من الشعراء التموزیین الّذی یستخدم أسطورة تمّوز فی بعض قصائده. کقصیدة:"بعدالجلید"من دیوان"نهرالرماد". فی هذه القصیدة یفید الشاعرمن أسطورة تموّز وما ترمز إلیه من غلبة الحیاة والخصب علی الموت والجفاف. فی بدایة القصیدة یشیرإلی الجلید الذی تغشی کل مکان وقدحوّل کل شیء إلی الرکود والجمود حیث یقول:
«عندما ماتت عروقُ الأرض
فی عصرِ الجلید
مات فینا کلُّ عِرقٍ
یبُسَتˆ أعضاؤنا لحماً قدیدˆ
عبثاً کُنّا نًصُدُّ الریحَ
واللیلَ الحزینا
ونُداری رعشة
مقطوعة الأنفاس فینا
رعشة الموتِ الأکید
فی خلایا العظمِ فی سرِّ الخلایا …» [11]
یشیر الشاعرإلی الأجواء الباردة التی أحاطت کلّ مکان وإلی اللّیالی السوداء والمغمومة وإلی الحیاة النازحة وإلی الموت والفناء الذی یسیطرعلی کل شیء. ویرمز بصورة غیر مباشرة إلی تلک الحیاة التی قد هاجرت إلی تحت الأرض مع رحلة تمّوز. وفی هذه الأجواء المفعمة بالهموم والأحزان والموت والفناء، یبشّرالشاعربظهورأسطورة تمّوز فجأة کمایشیر إلی "بعل" وهو إله الخصب والحیاة عند الفینیقیین. وکأن الشاعرنفسه مشغول بانجاز الطقوس الدینیة أمام هذه الأساطیر ویقوم بمزج أسطورة تموّز ببعل فجأة حیث یقول:
«یا أله الخصبِ، یا بعلاً یفضّ
التربة العاقِرَ
یا شمس َ الحصیدˆ
یاإلهاً ینفضُ القبَر
ویا فِصحاً مجید
أنتَ یا تموّز، یا شمس الحَصید
نَجِّنا، نجِّ عروقَ الأرض
مِن عُقمٍ دَهاها ودهانا
أدفی ء المَوتی الحزانی
والجَلامیدَ العَبید
عَبرَ صحراء الجلید
أنتَ یا تمُّوزُ، یا شمسَ الحصید» [12]
یقوم الشاعر بتمجید هاتین الألهتین ویطلب من "بعل" أن تشقّ التراب العقیم وتعطیه حیاة جدیدة.
وقد تأثّر خلیل حاوی من الشعراء الغربیین وقصائدهم «ولاسیما قصائد تی اس. إلیوت، القصائد التی تضمّنت دلالات طقوس الخصب وأساطیره باعترافه هو فی هامش قصیدة "الأرض الخراب". قد شجعت خلیل حاوی وباقی الشعراء التموزیین بأن یستفیدوا من تراث المنطقة الأسطوری والشعری وهم أولی به.» (العظمة، 1996م:256). یشیرخلیل حاوی إلی أوضاع بلاده والبلدان العربیة وأحوالها وإلی الأجیال التی قد کتب الجهل والفناء علیها ولایمکن أن یغیرها أی قوة من الخارج ألا أن یغیرما بأنفسها. الأسطورة هنا رمز للتقدم، والمدنیة، والحضارة، و الثقافة التی ستغیر الشرق الأوسط یوماً من الأیام. و الشاعر یعتقد أنّ الجهل بالأمور والحوادث التی تسیطر علی بلاده هی الّتی تسبّب الجمود والرکود بین الأجیال. ثم یشیر إلی هاجة بلاده بنوع من الخروج من هذا الجلید. والشاعر الأخیرالذی نعالج بعض قصائده وهومن الشعراء التموّزیین والّذی یستفید من أسطورة تموّز، أو أدونیس أو بعل مرّات عدیدة مباشرة کانت أو غیرمباشرة هو یوسف الخال الشاعرالشهیر السوری. علی سبیل المثال أنّه یذکر بعض هذه الأساطیر مباشرة فی قصیدتی "الدعاء"و"السفر" وغیر مباشرة فی قصیدتی "البئرالمهجورة" و"القصیدة الطویلة". کما یقول فی قصیدته "الدعاء" مشیراً إلی أسطورة تمّوز:
«و أدَرنا وُجوهَنا: کانت الشمسُ
غُباراً علی السنابِکِ، والأفقُ
شراعاً مُحطّماً کان تمّوز
جراحاً علی العیون وعیسی
سورةً فی الکتاب.» [13]
یشیر الشاعرفی بدایة القصیدة إلی رکود الإنسان وخیمة الموت التی سیطرت علی کلّ مکان. ثمّ یتحدّث عن قتل تمّوز علی یدالخنزیر البرّی وذهابه إلی العالم السُفلی. وأمّا عیسی الّذی نجّی قومه أصبح سورة فی الکتاب أوصورة فی الأذهان فحسب. وکأنّ الیأس خیم علی العالم. ثمّ شیئاً فشیئاً تزدهر براعم الأمل فی ذهن الشاعر فیحاول أن یبعد حالة الیأس والخیبة السائدة علی القصیدة إلی جانب فیقول:
« یا نفسُ بوحی
بالّذی صار، مَزِّقی الحُجُبَ السُودَ،
أطِلّی علی الجدید وثوری
یفتح الشاطیءُ الخلاصُ ذِراعَیه
وتعلو علی مداه السفینُ.
أیها البحرُ. أیها الأملُ البحرُ
تَرَفّق بنا، تَرَفّق، تَرَفّق!» [14]
ثمّ بدلاً عن الإشارة المباشرة إلی أسطورة تموّز أو أسطورة أخری، یستخدم البحر رمزاً لإعادة العیش والحیاة إلی الأرض، وفی الحقیقة تحوّل البحرإلی إله یتضرّع إلیه الشاعر. ثم یتحدّث عن أمل جدید ودمع ودماء جدیدة فی مواصلة کلامه حیث یقول:
« أیها البحر، یا ذراعاً مددناها
إلی الله، رُدَّنا لک، دَعنا
نستردَّ الحیاة من نور عینیک
ودَعنا نَعود، نُرخی مع الریح
شراعاتنا، نروح ونغدو
حاملین السماء لِلأرض دمعاً
ودماءً جدیدةً.» [15]
فالبحر یصبح ذراع الخلاص وهو ینبوع الحیاة، أنّه الطریق إلی الله وهو الوحید القادر علی إنقاذ الإنسان ویتّضح لنا بأن رؤیا الشاعر دینیة ولایمکن استرداد الحیاة إلا من نورعینی الله.
وفی قصیدة أخری عنوانها "السفر" یستخدم الشاعرعدة من هذه الأساطیر ویقول:
« وقبلَما نَهُمُّ بالرّحیل نذبح الخراف
واحداً لعشتروت، واحداً لأدونیس
واحداً لِبعلَ، ثمّ نرفع المراسیَ
الحدیدَ من قرارة البحر
ونبدأ السفر.» [16]
« فی هذه الصورة ینحلّ الرمز القدیم إلی واقعة إنسانیة عامّة ذات مغزی رمزیّ. إذ کان الشاعر انّما یحدّثنا عن واقعه الشعوری الذّی یرتبط فی الوقت نفسه ارتباطاً شعوریاً وثیقا بتلک الواقعة الرمزیة القدیمة.» ( إسماعیل، 1962م: 214)
النتیجة
وأمّا الخلاصة التی نستنتجها من خلال هذا المقال فهو:
- ألف) ما کان یزدهر استخدام الأسطورة فی الأدب العربی من قبل کما ازدهر فی عصرنا المعاصر. بعد الحرب العالمیة الأولی، تعرّف الأدباء العرب علی الأدباء المشهورین الغربیین ثمّ أخذوا منهم استخدام الأساطیر مثل تمّوز أو آفرودیت.
- ب) فی هذه السنوات ومن بین هذا الجیل من الشعراء، ظهرت فئة من الشعراء المعاصرین العرب الذین یشتهرون بالشعراء التمّوزیین الذین عالجوا الأساطیر عامة و أسطورة تموّز خاصةً معالجة إبداعیة بإعطاء الصورة الجدیدة.
- ج) الشی إلواحد الذی یربط ما بین آثار هؤلاء الشعراء هوالاعتقاد بمیزة تمّوز فی انبعاثه و إعطائه الحیاة إلی الأرض.
- د) تحولّت هذه الأساطیر فی أشعارهؤلاء الشعراء المذکورین إلی رموزلانبعاث والإحیاء والرّجاء الذی یحتاج إلیها العالم الثالث والشرق الأوسط فی هذه اللیالی المظلمة وفی هذه الظروف الراهنة.
المصادر والمراجع
- إسماعیل، عزّالدین.1962م. الشعرالعربی المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة.بیروت: دارالثقافة .
- البعلبکی، منیر. 1992م. معجم أعلام المورد. الطبعة الأولی. بیروت: دارالعلم للملائین.
- جبرا، إبراهیم جبرا. 1959م. تموّز فی المدینة. الطبعة الثانیة. بیروت: الموسسة العربیة للدراسات.
- حاوی، خلیل. 1979م. الدیوان. الطبعة الثانیة. بیروت: دارالعودة.
- حلاوی، یوسف. 1994م. الأسطورة فی الشعرالعربی المعاصر. الطبعة الأولی. بیروت: دارالآداب.
- الخلال، یوسف. 1979م. الأعمال الشعریة الکاملة. الطبعة الثانیة. بیروت. دارالعودة.
- داود، أنس. 1992م. الأسطورة فی الشعرالعربی الحدیث. الطبعة الثالثة. بیروت. دارالمعارف.
- رزوّق، أسعد. 1959م. الشعراء التموزیون. الطبعة الأولی. بیروت: دارالحمراء.
- السیاب، بدرشاکر. 2000م. الأعمال الشعریة الکاملة. ج1. بیروت: دارالعودة.
- الصالح، نضال. 2001م. النزوع الأسطوری فی الروایة العربیة المعاصرة. بیروت: منشورات الکتاب العرب.
- العظمة، نذیر. 1996م. سفرالعنقاء حفریة ثقافیة فی الأسطورة. دمشق منشورات وزارة الثافیة فی الجمهوریة العربیة السوریة
- فریرز، جیمس. 1982م. أدونیس أو تموّز، دراسة فی الأساطیر والأدیان الشرقیة القدیمة. الطبعة الثالثة. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
المصادر الفارسیة
- ژیران، ف.دلاپورت، ل. لاکوئه، گ.1382 هـ ش. اساطیر آشور وبابل. ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور. چاپ سوم. انتشارات کاروان
- ساندرز، ن. ک. 1387 هـ ش. بهشت ودوزخ در اساطیر بین النهرین. چاپ سوم تهران. انتشارات کاروان.
حواشی
[1] (السیاب، 2000م: 457)
[2] (حلاوی، 1994 م:72)
[3] (حاوی 1979م:228-229)
[4] (حلاوی، 1994م: 164)
[5] (العظمة، 1996م :21)
[6] (حاوی، 1979م: 125-126)
[7] (ژیران،2001م:57)
[8] (ژیران 2001م،78)
[9] (فریزر،1982م:20)
[10] (السیاب، 2000م: 458و457)
[11] (حاوی، 1979م:117-118)
[12] (حاوی، 1979م: 119-120)
[13] الخال، 1979م: 227
[14] (الخال، 1979م: 228)
[15] (الخال 1979م: 230)
[16] (الخال 1979م: 234)
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:49|
الیوتوبیا
فی شعر نازك الملائكة
المستخلص
راودت فكرة الیوتوبیا أو الطوباویة الكثیرین من الأدباء و الشعراء الذین یتمتعون بحسّ أخلاقی رفیع المستوى. و كان الحلم بمدینة فاضلة یعیش فیها الإنسان أحرارا متساوین أمام القانون -ولا یزال - حلما خصبا یستمد وجوده من وقائع شتى كغیاب العدالة، المكر، الخبث، الاحتیال، الظلم و الظلام الذی أحاط بالبشریة من كل ناحیة ردحا من الزمن .
كان افلاطون أول من أشارإلیها فی كتابه " الجمهوریة" و یعتقد أن الناس سواء فی كل شیء و بعده رسم الفارابی دنیاه المثالیة فی كتابه " المدینة الفاضلة" و یرى مساواة الناس أمام میزان العدل. والحالمون بذلك كثیرون من العباقرة أمثال القدیس اوغسطین، شیشرون، دانتی، فرنسیس بیكن و توماس مور و غیرهم.
فی هذه المقالة أتناول میزات الیوتوبیا فی شعر نازك الملائكة، عنایة بأنها كانت متشائمة شدیدة التشاؤم فی بدایة حیاتها الأدبیة. الیوتوبیا – توماس مور– مدینة فاضلة – الكلمات الرئیسیة: الطوباویة
المقدمة
یوتوبیا كلمة یونانیة معناها لا مكان أو المكان الذی لا وجود له. قد استقیت من الكلمتین الیونانییتین بمعنى" مكان" و الكلمة فی مجموعها تعنیtopos بمعنی "لا" و ou لیس فی مكان، لكنّه أسقط حرف ال- O و كتبت الكلمة باللاتینیة utopia الیوتوبیا مكان خیالی قصی جدا و هی دنیا مثالیة و بخاصة من حیث قوانینها و حكوماتها و أحوالها الاجتماعیة. و هی عالم یجوز تسمیته بالخیال أو صورة ماوراء العین، مكان یتحقق فیه التعاون الاجتماعی بصورة كاملة التحقیق لسعادة الأفراد.
حلم الإنسان منذ القدیم بمدینة مثالیة نموذجیة یأخذ كل فرد فیها حقّه و یؤدّی ما علیه من واجبات تجاه نفسه و تجاه الآخرین. مدینة بلا جوع و لا ظلم ولا فقر و مدینة القانون و العدالة، دولة مثالیة تتحقّق فیها السعادة لجمیع الناس و تمحو الشرور، فالناس فیها سواء فیما یملكون و یحصلون على ما یحتاجون إلیه حاجة حقیقیة، متساوون أمام میزان العدل، و هی مدینة المثل العلیا، مدینة العلم والمعرفة وكأنها تنادی الإنسان بالعودة الی فطرته الطاهرة.
حلم الإنسان منذ النشأة البشریة؛ فإنها تبحث عن النموذج المجتمعی الخیالی و المثالی، ذلك الذی یعوضها عن الفردوس المفقود الذی فیه یتحقق الكمال أو یقترب منه على الأقل و یتحرر من الشرور التی تعانی منها البشریة و هو أمر حسب أنه لا یوجد سوى فی ذهن الكاتب نفسه و خیاله قبل كل شیء.
كان أول من حلم بذلك الفیلسوف الیونانی " افلاطون " من خلال كتابه " الجمهوریة " ویرى فیه أن الناس سواء فی كل ما یكتسبون و یملكون و یحتاجون إلیه و بالروح نفسها رسم المعلم الثانی " الفارابی " دنیاه المثالیة من خلال كتابه " المدینة الفاضلة " حیث یعیش فیها الناس متساوین أمام المیزان میزان العدل. و استمرّ رسم الیوتوبیا فی خیالها الخصب من عباقرة الشعر و الأدب و الفلسفة مدى التاریخ .و مما یلفت النظر أن الكتابة عن یوتوبیا تطوّرت تطوّرا ملحوظا و برز تقدّمها فی العصر الكلاسیكی أی حوالی القرنین السادس والسابع عشر.
و من هؤلاء " توماس مور " فی كتابه " یوتوبیا " سنة 1516م الذی یتحدث فیه عن مدینة فاضلة و أعقبه بعد ذلك " توماس كامبانیلا " سنة 1623 م فی كتابه " مدینة الشمس " و بعده " فرنسیس بیكون " سنة 1627 م فی كتابه " اطلنطس الجدیدة " و أیضا " ایتین كابی " سنة 1840 م الذی سمّى مدینته المثالیة " إیكاریا " فی كتابه "رحلةإلی إیكاریا ".
وغیر هؤلاء كتب كثیرون أحلامهم عن مدنهم المتّصفة بسمات العدل و الحق و المساواة؛ ولكن عندما نمعن النظر نرى أن أمانیهم قد فشلت و كانت هذه شعارات التی یحاربها غالبیة المدّعین بها والمدافعین عنها بقدر ما التصقت فی أذهاننا بعض المدن الواقعیة التی خلدها الأدب و نراها كأثر أدبی بحت نقش رسم هذه المدن الخیالیة الفانتزیة على جدران ذاكرتنا بل نشعر أنّها مدن تنتمی إلى الخیال أكثر من انتمائها الی الواقع و غالبا لیست فی متناول الید.
والواقع أنّ التعبیر عن الیوتوبیا تخطّى مرحلة المعنى الأدبی الخیالی فأطلق على كل اصطلاح سیاسی أو احتمالات تتعلق بالعلوم والفنون فی مجملها؛ بید أنه یظلّ تصوّرا فلسفیا ینشدانسجام الإنسان مع نفسه و مع الآخرین فی عالمه الواسع. نشعر كلنا بالسرّ الموحود فی الزمان ولكنّنا غیر قادرین عن التعبیر عنه؛ فالزمن قدرنا، ألمنا و یأسنا وتجربه الإنسان بزمانیته هی تجربته الحزینة بزواله و انقضائه، فشكوى الإنسان من الزمان أزلیة و أغلب الظّنّ أنها ستبقى أبدیة. إنّ تجربة اللقاء بالمستقبل تثیر فی النفوس شعورا عجیبا، لیس من الضّروری أن یكون هذا المستقبل المتوقع خطیرا ولأن یحمل فی أحشائه و أمعائه النقمة أو النعمة؛ فالمهمّ أن یصبح حقیقة حیّة و هذا شعور لطیف لكلّ شخص أنّ فرصة الانتظار أحلى و أجمل من سعادة التحقیق.
و مهما كان صوت المستقبل للإنسان - لصالحه أو لطالحه، متوعّدا أو واعدا - لكن إشاراته دائما فی هالة إلهیة ولهذا كانت و ستبقى بالرهبة والجلال و یقف الإنسان منه موقف الحب والشوق كما یقف فی الماضی موقف الخشوع و الإشفاق. أمّا نازك الملائكة فشاعرة عربیة عراقیة من عمالقة الشعر الحدیث ومن روّاد الأوائل لحركة الشعر الحرّ . ولدت فی بغداد سنة 1923 م، درست الأدب العربیة فیها فسافرت إلى الولایات المتحده لدراسة الأدب الإنجلیزی و إكمال دراستها، درست الأدب المقارن بجامعة وسكونسن و حصلت على درجة الماجستیر سنة ٦195 م. ولها معرفة بالأدب الغربی وكانت الرومانسیة غالبة على شعرها و تولع بآثار الرومنظیقیین الإنجلیزیین مثل " شلی " و "كیتس ". و تحسّ بالقلق وتشعر بالحزن كشأن سائر الرومنسیین ممّا یجعلها الهروب إلى الطبیعة أو إلى نفسها والانطواء على ذاتها للتفتیش عنها؛ فهربت من الواقع و انطلقت إلى عالم الخیال الذی یمثل لها عالما مثالیا خاصا غیر محدود بزمان أو مكان و بحثت عن السعادة فیه؛ لجأت إلیه و عاشت فی كنفه.
تلجأ شاعرتنا إلى دائرة الأزمان و هی التی سمتها " یوتوبیا " منطقة یتعطّل فیها حكم الزمن و لكنّ الصفة الثابتة لها أنها أفق أزلی لا یدركها الفناء - كما یعتقد الدكتور شوقی ضیف - (فصول فی الشعر و نقده. ص 96).
ومما یلفت انتباهنا هنا أن الشاعرة استعملت " یوتوبیا " دلالة على مدینة شعریة خیالیة بدون وجود إلا فی أحلامها و طبعا لا علاقة لهذه المدینة بیوتوبیا التی تخیّلها الكاتب الإنكلیزی "توماس مور" و رسم فیها صورة سیاسیة إداریة للجزیرة المثلى كما یریدها قیاسا على "جمهوریة افلاطون " أو غیره.
أما من میزات هذا العالم فهی كما تصفها الشاعرة یكاد یكون خالیا عن الشرّ أو ینبغی أن یكون كذلك و تتذكره دائما فی حیاتها ومماتها و هناك لا یوجد أی قید یثقل علیها و القیود تذوب كلها و یفسح لها أن تفكر لتنطلق من الأسر، فهی تحبّ الهروب من مواجهة الواقع و الیوتوبیا تبدو لها مفارقة للواقع و كأنّها ترفض الواقع رفضا كلیا و قطعیا؛ لأنّها:
قد سئمتُ الواقعَ المرّ المملّا ولقد عدتُ خیالاً مُضمحلّا
فاتركینی بخیالی أتسلّى آه كاد الیأسُ یعرونی،لولا
أنّنی لُذتُ بأحلامِ السّماء وتَخیّرتُ خیالَ الشّعراء
( دیوان نازك الملائكة . ج 1. ص.599).
سئم الشیء و منه : ملّه. اضمحلّ الشیءُ : تلاشى و انحلّ . عرا ُ فلاناً أمر : ألمّ به. لاذَ ُ بالشیء : استتر به و التجأ إلیه ترى الشاعرة أن الواقع مرّ و مملّ فتبرّمت به، و بما أنها التجأت بأحلام السماء و تخیّرت لنفسها عالم الخیال و هو خیال الشعراء، هذا هو سبب خلاصها و إلا یلمّ بها الیأس و یثقل علیها.
تسارع الشاعرة لتهرب حیث لا علاقة لها بالزمان والمكان وهذا كلّه قید یغلّه ولكن فی یوتوبیا تذوب هذه القیود فتحسّ بشباب لایزول:
ویوتوبیا حُلمٌ فی دمی أموتُ و أحیا على ذكره
تخیّلتُه بلداً منْ عَبیر على أفق جرتُ فی سرّه
هنالك عبرَ فضاءٍ بعید تذوب الكواكب فی سحره
هنالك حیثُ تذوبُ القیود وینطلق الفكرُ من أسره
وحیثُ تنامُ عُیونُ الحَیاة هنالك َتمتدّ یوتوبیا
ویوتوبیا حَیثُ یَبقى الضّیاء ولاتغربُ الشّمْسُ أو تَغلَسُ
وحیثُ تَضیْعُ حُدودُ الزّمان وحیثُ الكَواكبُ لاتنْعَسُ
هناك الحَیاة امتدادُ الشّباب تفورُ بِنشْوتهِ الأنفُسُ
هناك یَظِلّ الّربیعُ رَبیعا یُظلّلُ سُكّانَ یوتوبیا
( دیوان .ج.2 ص. 40 ).
عبیر : أخلاط من الطیب، نكهة طیبة . الغَلَس : ظلمة آخر اللیل . نعس َ : فتر . فارت القدر: غلت وارتفعت ما فیها؛ فار ُ المسكُ : تضوّع و انتشر . النشوة : الرائحة، السكر أوّله تعتقد الشاعرة أن عالم الیوتوبیا كحلم اختلط فی دمها، تذكر هذا العالم فی محیاها و مماتها؛ و هی تصفها هكذا: بلد من عبیر، عالم لغز و سحر، تنصهر الكواكب و النجوم فی هذا السحر الموجود فی فضاء بعید، تذوب القیود، الفكر حرّ، الضیاء أبدیّ لأنّه لا زمان موجود ولا غروب للشمس ولاتفتر الكواكب ولاأثر للمشیب و الشباب سرمدیّ وتلتذّ الأنفس بهذه النشوة والفصل الوحید هناك هو الربیع الذی یظلّل سكّانه. وتعانق نازك الملائكة أمنیاتها الخیالیة أمنیات الطفولة فی هذا العالم حیث تقول:
وتَمرّ السّاعاتُ بی و أنا أبْ نِی خفایا مَدینةِ الأحْلام
أی یوتوبیا فقدْتُ و عَزّ الآ نَ إدراكُها على أیّامی
تلك یوتوبیا الطّفُولةِ لوْ تَر جعُ لو لمْ تكُنْ خیالَ مَنام
إیه تَلّ الرّمالِ ماذا تَرى أبْ قیْتَ لی منْ مَدیْنةِ الأحْلام
( دیوان .ج.1.ص.255).
عزّعلیّ الشیءُ: اشتدّ و صعب .، من الأضداد قوی و ضعف . ایه : اسم فعل للاستزادة من حدیث أو فعل . وتبنى الشاعرة فی هذا العالم خفایا مدینة الأحلام، و ترید أن تلجأ الی الماضی الجمیل بكلّ ما فیه و لاسیّما أیّام الطفولة و ترید أن تعیش فیها ولیس ذلك خیالا و تحسّ بالملل و الكآبة فی هذه الأیام التی تمرّ الساعات علیها بسرعة و لهذا ترید أن ترتبط بالماضی و ألا تنفصل عنه. وما زالت تردّد شكواها الدائمه من زوال الحیاة و انقضائها و لیس من المحتمل أن تتوقف هذه الشكوى ولا ینبغی لها كذلك أن تتوقف و تفارق الماضی و الحاضر و اتّجاهها حاسم للمستقبل و ظلّت تحلم بالمستقبل و تصوّره فی الیوتوبیا عندما تحسّ بضیاع الماضی و عبثیّة الحیاة و تحیرّها:
و مَرّتْ حَیاتی مرّتْ سُدى ً و لا شَیء یُطْفئ نارَ الحَنین
سُدى ً قدْعَبرْتُ صَحاری الوُجود سُدى ً قد جَررْتُ قیودَ السنین
یَطول ُ على قَلبی الاْنتظار و أغْرقُ فی بَحْرِ یأسٍ حَزین
أحاوِلُ أنْ أتعَزّى بشیء ٍ بغابٍ ، بوادٍ ، بظَلّة تین
دقائقَ ثُمّ أخیْبُ و أهْتِف لا شیءَ یُشْبِه یوتوبیا
( دیوان .ج.2 .ص.5٤ ).
أسدى الأمر :أهمله .ذهب كلامه سدى :باطلاً . تعّزى : تسلّى و تصبّر
خاب یخیبُ : لم یظفر بطلب، انقطع أمله
عندما تفشل فی محاولتها للبحث عن معنى للوجود الإنسانی و تؤمن بعبثیة الحیاة و مضت الحیاة باطلة وسدى و الزمان كلّه قیود تثقل علیها والهموم و الأحزان كأمواج البحر یغرقها فتنتظر دائما لتتخلّص من الكآبة الموجودة داخل نفسها و فی حیاتها - كانت الشاعرة فی هذا الأوان متشائمة أشدّ التشاؤم - وهذا كلّه ممّا یجعلها إلى الهروب، الهروب إلى الطبیعة لتتعزّى فیها بشیء، بغابة، بوادٍ، أو بظلّة تین لتستریح لدقائق.؛ فتصل إلى هذه النتیجة أنّ عالم الیوتوبیا، عالم الخیال شیء لا مثیل له. و ظلت تحلم بحالة مقبلة تبدو علیها الأشیاء فی صورة أكمل و أحیانا تبنى عالمها هذا بعیدا عن الناس حیث لا یسكن فیه أحد و خالٍ عن الإنسان و تبناه فی:
فَوقَ البِساط ِالسّفْح بینَ التّلالْ
فی المُنْحنى حیثُ تَموجُ الظّلالْ
تَحتَ امْتداد ِالغُصونْ
تفجّری بالجَمالْ
وَشَیّدیْ یوتوبیا فی الجبالْ
یوتوبیا منْ شَجَراتِ القِممْ
ومنْ خَریْرِ المیاهْ
یوتوبیا من َنَغمْ
(دیوان ج.2.ص.155).
شیَّدَ البناء : رَفعَه . القِمَم ج القمّة أعلى كلّ شیء . النَّغَم : التطریب فی الغناء و حسن الصوت .
ترید الشاعرة أن تصنع عالمها فی التلال فوق سفح الجبال ، بین الظّلال الموجودة تحت أغصان الأشجار الشاهقة و من الأنغام و الصوت الحسن الذی فی خریر المیاه.
و من میزات عالمها المثالی كما تصفه الشاعرة لنا هی:
وشَیّدیْ یُوتُوبِیا منْ قُلوبْ منْ كلّ قلبٍ لمْ تَطأه الحقودْ
ولمْ تُدنّسْهُ أكُفُّ الرّكودْ منْ كلّ قلبٍ شاعریّ عَمیقْ
لم َیتمرّغْ بخطایا الوجود ْ ومنْ كلّ قلبٍ لا یُطیقُ الجُمودْ
( دیوان .ج.2.ص.157).
أكفّ ج الكفّ الید أو الراحة مع الإصبع . أطاق الشیءَ : قدر علیه .
وطىء یطأ وطأً الشیءَ برِجْله: داسَه
.وتعتقد أنّ الیوتوبیا لابدّ أن تشید فی باطن الإنسان و فی قلبه، القلب الذی لیس له أیّ حقد و ركود، من قلب شاعریّ لم یرتكب أیَّ خطأ وهو عمیق ولیس سطحیا و لم یقدر الجمود علیه حتى یكون نابضا بحرارة للعالم البشری. نعم؛ للانسان أن یهرب من الحقیقة و الواقع المرّ الذی یفرض علیه الألم و الأسر و یعتصم بالخیال حیث یلاقی هناك عالم النقاء والطهر و العالم الذی یحبّه كما یرید؛ هذا شأن الرومنسی و من حیث تتّصل نازك إلى هذا المكتب، و فضلا عن ذلك من أجل انثویتها یتشدّد هذا الموضوع و تتّصل بعالم المثل حینما ترى قصور العقل الإنسانی عن إدراك كثیر من الألغاز و الأسرار الموجودة فی الحیاة و ماوراءها و فلسفة الكون أو عندما تجد نفسها فی محاصرة الأحزان تدفع بها إلى حالة من التأمل و المعاناة أو حین كل ما ترى فی المجتمع حولها یناقض الحیاة فتحسّ بخواء أعماقها العاطفیة و تحاول للبحث عن معنى للوجود الإنسانی و تؤمن بعبثیة الحیاة و أنّ الإنسان لعبة بین مخالب الأقدار و بید الفلك فی حیاة كلّها خیبة آمال و سقوط.
إذن لا غرو أن تبنى أمنیاتها و أحلامها فی عالم لایوجد مثل هذه القضایا و تبنى لنفسها العالم المثالی الذی تتخیّله و تحبّ أن تعیش فیه و تعتصم به؛ فتعشق الدجى و الظلام و ما هو إلّا الخیال الذی تلوذ به و تثور على الشمس التی هی رمز للحقیقة فی قصیدتها " ثورة على الشمس" و تهدیها إلى المتمرّدین:
یا شمسُ ، أما أنتِ ماذا؟ما الذی تَلْقاهُ فیك عَواطِفی و خَواطری؟
لا تَعْجبیْ أن كنْتُ عاشِقةَ الدّجَى یا ربّةَ الّلَّهبِ المُذیبِ الصّاهِر
یا منْ تُمزّقُ كُلّ َ حُلم ٍ مُشْرقٍ للْحالمینَ و كلّ طَیفٍ سَاحر
یا من ْ تُهدّم ُ ما تُشَیّده ُ الدّجَى و الصّمْت ُ فِی أعْماقِ قلْبِ الشّاعرِ
( دیوان .ج.1 ص.490).
اللَّهَب : حرّ النار ، لسان النار صَهر الشیءَ : أذابَه.
حلم : ما یراه النائم فی نومه ج.أحلام طیف : الخیال الطائف فی النوم.
بعد بناء عالمها المثالی ، غیر عالم الواقع الذی سئم العیش فیه ، تثور علیه؛ لأنّها تشاهد من حولها فی الحیا ة و فی المجتمع شرورا ومعاصی وآثاما فیكتئب قلبها و تهرب من الشمس التی هی رمز الحقیقة؛ لأنّها تبید حلمها المشرق و طیفها الساحر و تهدّم كلّ ما تشیّده الدّجى و الصمت فی أعماق قلب الشاعرة.
ومما لا بد أن یؤخذ بعین الاعتبار، أنِ الشاعرة كانت متشائمة شدیدة التشاؤم فی بدایة حیاتها الشعریة؛ لأنها كانت مفعمة باتجاهات الرومنسیة و غلب علیها التشاؤم المطلق و كانت تشعر بالضیق و الألم و لاترى غیر الأزمة و الشقاء فی الحیاة و أنّ الحیاة كلّها ألم و إبهام و تعقید؛ و لكن تدریجیاغیّرت نظرتها حول الموت و فلسفة الحیاة و بدأت تنظر إلى الحیاة بمنظار جدید فیه مسحة من التفاؤل لیكون بلسما لدائها و مرهما لشفائها و نرى هذا التغییر حتّی فی عنوان مطوّلتها من" مأساة الحیاة" إلى " أغنیة للإنسان " فی الواقع آراؤها المتشائمة قد زالت و حلّ محلّها الإیمان بالله و الاطمئنان إلى الحیاة و جوّ مأساة الحیاة تبدّد شیئا فشیئا؛ وقد عبرت عن تمسّكها بالحیاة فی هذه الحیاة الدنیا لأنّ حبّ الحیاة أمر لا ینفصل عن الحیاة نفسها و أنّ الإنسان یجد لذّة كبرى فی أن یحیاها مهما كان طبعها و صعدت من إحساسها بالیأس و العدم إلى قمّة الرجاء و الأمل و آمنت بأننا یجب أن نستسلم للقدر خاضعین و أنّ العالم یواصل سیرته حتى بدوننا و آمنت بأنّ الإنسان مهما یفكّر فی آلامه و آلام أبنائه و مواطنیه و المجهولات و الأسرار و الألغاز، فلكن یجب ألّا یعكس الیأس و القنوط و الألم فقط، بل یجب أن یكون للتفاؤل مكانه.
ومهما یتأمّل الإنسان فی هذه القضایا فلا بدّ ألّا ینصرف عن الحیاة لأنّه لم یجئ إلى الحیاة لیشقى و یصبّ الهموم على نفسه بل أتاها لیتنعّم بها و أن یكون مسلكها تجاه الحیاة و فلسفتها إیجابیّا و ینظر إلیها بمنظار التفاؤل و لتكن فلسفتها الابتسام دائما مادام حیّا و ینتهز فرصة الحیاة قبل أن تفلت من یده.
رسمت الشاعرة لنفسها هذا العالم الذی فرض على نفسها لتعیش فیه؛ لأن ّالعالم الواقع عالم ملیء بالأحزان و الآلام والحیاة فیه جافّة و باردة و لامعنى للعیش فیه و یجب استقبال الموت .و تنفر من كلّ شیء و تحسّ بالسآمة حتى فی التفكیر و البقاء. وإذا تطرّفنا الی أشعارها رأینا أنّ روح التشاؤم سرت فی نفسیتها، و فی نفسها نوع من الیأس و التشاؤم الذی قد تسرّب فی كلماتها و لغاتها .و قد آل بها المطاف أن تتضجّر من كل شیء موجود فی حیاة الواقع و تعیش فی الیوتوبیا.
المراجع والمصادر
1) احسان عباس ،فن الشعر، دار الثقافة، بیروت .1959 م.
2) احمد ملكی الطاهر، الشعر الحر، دار المعارف.
3) احمد ملكی الطاهر، فی الأدب المقارن، دار المعارف ،الطبعة الثانیة ،1992 م.
٤) سید حسینی رضا، مكتب های ادبی، انتشارات نگاه، چاپ یازدهم، 1376 ه.ش.
5) شفیعی كدكنی مخمد رضا، شعرای معاصر عرب، تهران، توس ،1359.ه.ش.
6) د.شوقی ضیف، فصول فی الشعر و نقده، دار المعارف بمصر.
7) العلمی الادریسی، رشید،.مقالة الیوتوبیا، بین الخیال المتعالی و تقدّم الإنسانیة
8) غنیمی هلال محمد، الرومانتیكیة، دار النهضة بمصر.
9) محمد فتوح احمد، الرمز و الرمزیة فی الشعر المعاصر.
10) مجلة الشعر، مجلة فصلیة مصریة العدد 1٤، ینایر 1986 م.
11) نازك الملائكة ،دیوان، دار العودة، بیروت، لبنان.
12) نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، الطبعة الثانیة، 1989 م.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:48|
أدب نسائی فی عالم عربی
أمیل الى الاعتقاد بأن مصطلح الأدب النسائى یفید عن معنى الاهتمام وإعادة الاعتبار الى نتاج المرأة العربیة الأدبی ولیس عن مفهوم ثنائی, أنثوی - ذكوری, یضع هذه النتاج فی علاقة اختلاف ضدّی - تناقضی, مع نتاج الرجل الأدبی.
والمصطلح, بهذا المعنى, یحیلنا على تاریخ للأدب العربی ساهمت فیه المرأة منذ عهود قدیمة, تعود الى ما قبل الفتح الإسلامی (مثل الشاعرة سلمى بنت مالك بن حذیفة), الا ان مساهمتها أُهملت بسبب من معاییر قیمیّة ربطت بین الفنون والآداب وثقافاتهما وبین نظام قبلی قوامه القوّة, أو سلطة على رأسها رجل ینزع الى التسلّط.
هكذا جرى تفضیل شعر الفخر والمدیح والهجاء (بصفته, ای الهجاء, الوجه الآخر للمدیح) على شعر الرثاء, ای تفضیل ما یعبّر عن القوة ویخدم السلطة على شعر "الضعف والضعفاء".
ولئن كانت المرأة معتبرة, فی نظام القیم الاجتماعی, من جنس الضعفاء, فقد أُهمل امرأة وفتاة بریشة ماتیس. شعرها وسقط ذكر الشاعرات اللواتی بلغ عددهن 242 شاعرة, من الخنساء الى ولادة بنت المستكفی.
كما أُهملت فنون النساء كالتهویدات التی تغنیها الامهات لأطفالهن, لأنها لیست من الفنون التی ترتبط بالسلطة, او تندرج فی مسرات البلاط.
اما الخنساء التی برزت دون نظیراتها من امثال لیلى الاخیلیة, ورابعة العدویة (المتصوفة), والفارعة بنت طریف, وعائشة بنت المهدی, والسیدة زبیدة بنت جعفر (زوجة الخلیفة هارون الرشید وأم ولده الأمین), ودنانیر, ومحبوبة… فإن شعرها الرثائی لأخیها صخر لم یقوّم الا بتخلیها عن الدمع والانتقال الى الفخر منشدة:
"وإن صخراً لوالینا وسیّدنا / كأنه علم فی رأسه نار".
ویمكن القول إن استعمال مصطلح "الأدب النسائی" یعود, فی العالم العربی, الى مرحلة النهضة التی أدرك فیها المتنورون أهمیة دور المرأة فی نهوض المجتمع, وهو ما استدعى تعلیمها وأفسح لها, من ثم, إمكان المشاركة فی النشاطات الاجتماعیة والثقافیة والانتاج الأدبی.
فی هذه المرحلة - مرحلة النهضة - عرفت اللغة العربیة مجموعة من المفردات تخص نشاطات المرأة وتشیر الى ما یبذل من اجلها, مثل:
- تعلیم النساء (سنة 1881 أسست السیدتان إملی سرسق ولبیبة جهشان اول معهد علم للفتیات) - الجمعیات النسائیة (لقد انشأت سیدات بیروت سنة 1880 جمعیة "زهرة الاحسان, وسنة 1914 جمعیة "یقظة الفتاة العربیة") - المجلات النسائیة (أصدرت هند نوفل مجلة "الفتاة" سنة 1892 فی الاسكندریة, ومدیحة الصابونی مجلة "المرأة" سنة 1893 فی حلب, ولبیبة هاشم مجلة "فتاة الشرق" سنة 1906, وعفیفة كرم مجلة "المرأة السوریة" سنة 1911 - الصالونات الأدبیة النسائیة (صالون مریانا مراش فی حلب, وصالون الأمیرة نازلی فاضل, وصالون می زیادة فی القاهرة)…
مثل هذه النشاطات وسمت بـ"النسائیة", وإن شارك فیها الرجل (فقد عمل الطهطاوی (1801-1873) على إقامة مدرسة لتعلیم البنات, وخصص قاسم أمین (1864-1980) كتابین هما: "تحریر المرأة" و"المرأة الجدیدة").
وعلیه فإن "النسائی" یشیر, وفی شكل اساس, الى حیز دال على حضور المرأة ونشاطها فی الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والأدبیة.
وبالنظر فی خطاب المرأة الأدبی ففی إمكان القارئ, او الباحث, ان یلاحظ أنه لیس خطاباً نسویاً بمعنى الثنائیة الضدیة بین خطاب أنثوی وخطاب ذكوری. ولئن كان من ضدیة, فإن لها, وبحسب لسان العرب, معنى الخلافیة الندیة (فقد جاء فی "لسان العرب" واستناداً الى "ابن سیدة" فی إحالته على ثعلب: "ضد الشیء خلافه, وضده, ایضاً, مثله"… وجاء استناداً الى الأخفش: "الند الضد والشبه". أو, حسب ابن الاعرابی: "ند الشیء مثله وضده خلافه".
ویقال (والكلام لابن الأعرابی): "لقی القوم أضدادهم وأندادهم ای أقرانهم"), ای معنى الخطاب القرین. ما یعنی ان المرأة بهذا الخطاب الضدّی, او الخلافی, تعلن عن وجودها ككائن مبدع, شأن الرجل إذ یعلن, فی خطابه, عن وجوده ككائن مبدع.
ان خطاب المرأة, الموصوف بالنسائی, هو خطاب یؤكد حضورها الذاتی ویمیزه.
یضمر "النسائی" فی الخطاب الأدبی العربی معنى الدفاع عن الـأنا الأنثویة, بما هی ذات لها هویتها المجتمعیة والانسانیة. ومن موقع الندیة, یواجه "النسائی", لا الرجل بصفته الانسانیة, بل آخر هو, تاریخیاً, قامع ومتسلّط.
ففی روایة "أنا أحیا" (1956) للیلى بعلبكی (لبنانیة) تتمرد لینا, بطلة الروایة, على الرجل بصفته فی مواقع السلطة فی المجتمع (أب, ورئیس شركة, واستاذ جامعی, وحزبی) ویمارس, من هذه المواقع قمعه علیها. لینا, ومن خلفها المؤلفة الضمنیة, ضد هذا القمع ولیست ضد رجل تودّ, كما تقول, ان تشبك بذراعه ذراعها. وفی "حجر الضحك" (1990) لهدى بركات (لبنانیة) یحیل خلیل, بطل الروایة, عنف الحرب الاهلیة فی لبنان, على وعی ثقافی - اجتماعی, ولیس على تكوین فیزیولوجی - جینی. ذلك ان خلیل, وبأثر من هذا الوعی السائد, یرفض الجینات الانثویة فیه النازعة به الى الهدوء والسلام لینخرط فی ممارسة العنف الذكوری. لم تكتب المرأة ضد الرجل الانسان حین تناولت فی كتاباتها الابداعیة العلاقة بین الأنوثة والذكورة, بل كتبت ضد ایدیولوجیا السلطة الذكوریة, وضد وعی ذكوری سائد غیر مدرك, شأن سامح, بطل روایة "باب الساحة" (1990) لسحر خلیفة (فلسطینیة) بأن التحرر لا یتحقق لمجتمع یعاقب المرأة حیث یسامح الرجل. تكتب المرأة لتعبر عن سبل تستعید بها الانثى ثقتها بذاتها المفقودة, فتحكی لنا مدى, بطلة روایة "شجرة الحب غابة الاحزان" (2000) لأسیمة درویش (سعودیة من أصل سوری), عن غربتها فی وطنها الذی یتسید فیه الرجل, وعن استعادتها لذاتها فی بلاد الغربة التی وفّرت لها العلم والحب والحریة. یُفصح ما تكتبه المرأة عن قدراتها الابداعیة فی مواجهة ما لحق بها من ظلم على مدى تاریخ طویل: فتواجه عالیه ممدوح (روائیة عراقیة) ظلم الرجل بمنح النساء حیزاً واسعاً من عوالم روایاتها: ففی "الولع" (1995), كما فی "المحبوبات" (2003) تنسج الشخصیات النسائیة عالماً رحباً قوامه الالفة بینهن, وسمته التعالی على الألم, بحیث تبدو النساء مشفقات على الرجل, هازئات, بكبریاء, من ظلم یبدو فیه التاریخ اكثر ذكوریة من الرجل نفسه.
یسعى خطاب العلاقة الضدیة بین الانوثة والذكورة, فی ادب المرأة العربیة - ای خطاب الضدیة التی لها معنى القرین - الى تثمین الانوثة بإضاءة دلالاه المرتبطة بالهویة واللغة والحیاة.
هكذا, فلئن كان الشعر ینسب, غالباً, الى ضمیر الأنا, وبالتالی یمكننا اعتبار ما تكتبه المرأة من شعر هو, وفی شكل عام, تثمین لأنوثتها, فإننا, وبالنظر فی ما تكتبه سرداً, نعثر على أعمال تستهدف, دون غیرها, مثل هذا التثمین. ففی روایة "شجرة الفهود" (2002) لسمیحة خریس (أردنیة) تبدو الذات الانثویة (شخصیة فریدة الرامز اسمها الى فرادتها) هی الوریث لسلالة الفهود. فهی, فریدة, التی تحمل البذرة, وهی التی - بحسب منظور الروایة - تجسد الانتماء وتكفل دیمومة الهویة. وتنیط علویة صبح (لبنانیة) عودة المنطوق الحی الى السرد الروائی العربی بالانثى, مریم, بطلة روایتها التی تحمل اسمها "مریم الحكایا" (2002). كذلك تنیط بهذه الانثى نمطاً حكائیاً یتوالد شأن الكلان فی توالده على لسان ربّته التراثیة شهرزاد.
وفی "غرناطة" (1994), و"مریمة والرحیل" (1995) لرضوى عاشور (مصریة), تبرز الانثى بصفتها حافظة للغة العربیة ولتراثها الذی أحرق. قد یكون علی, ومن منطلق منهجی, ان افترض امكان اعتبار ما سبق وذكرته من أمثلة, أدباً نسائیاً, وذلك - وخلافاً لما ذهبت الیه - على اساس من هذه العلاقة نفسها بین الذكورة والانوثة, ومن هذا التثمین نفسه. لذا أجدنی معنیة بالاشارة الى بعض ما قدمته المرأة من اعمال أدبیة, بخاصة فی مرحلة الریادة, ومما هو لا ینبنی على اساس من هذه العلاقة, او من هذا التثمین, ومع هذا یوضع تحت یافطة "الأدب النسائی": فروایة "حسن العواقب" (1899) لزینب فواز (1846-1914), مثلاً, تنبنی على اساس من الصراع بین الامراء الاقطاعیین على السلطة, ولیس على اساس من علاقة بین الأنوثة والذكــورة.
كذلك تتركز الحكایة فی روایة "قلب الرجل" (1904) للبیبة هاشم (1882-1952) على ما جرّته احداث سنة 1860, او النكبة بحسب تعبیر الروایة, من ویلات على اللبنانیین, ذكوراً وإناثاً, وذلك على حد انتماءاتهم الطائفیة. ومع تقدم كتابة المرأة الروائیة تبرز روایة "الباب المفتوح" (1960) للطیفة الزیات (مصریة) كعلامة على علاقة وثیقة بین ما هو ذاتی, او أنا أنثوی, وما هو مجتمعی تحرری مشترك.
كما تبرز, فی ما بعد, روایة "ذاكرة الجسد" (1993) لأحلام مستغانمی (جزائریة) التی تتمارى فیها المرأة بالوطن, ویبرز العشق وثیق الصلة بالشهداء الذین یخلصون ویضحون من اجل أوطانهم, فی مقابل الذین یبیعون بالمال هذه الاوطان. كما تستوقفنا, فی هذا الصدد, روایات وقصص عدة منها: روایة "مراتیج" (1985) لعروسیة النالوتی (تونسیة) التی تقدّم صورة جیل یعیش قلق الاسئلة الصعبة. وروایة "الاقلاع عكس الزمن" (1980) لإمیلی نصرالله (لبنانیة) التی تحكی عن الحرب والغربة والتعلق بالجذور.
وروایة "لیل نهار" (1997) لسلوى بكر (مصریة), وروایة "بیروت 2002" (2003) لرینیه الحایك (لبنانیة). ومجموعة غادة السمان (سوریة) القصصیة, "رحیل المرافئ القدیمة" (1973), ومجموعة هادیا السعید (لبنانیة) القصصیة "رحیل" (1989). ففی هذه الاعمال السردیة یمتزج الخاص بالعام, ویتداخل الذاتی والاجتماعی على نحو فنی یدعو الى نسبتها الى الابداع اكثر مما یحمل على نسبتها الى أدب نسائی.
ویبدو الذهاب فی هذا الاتجاه - ای نسبة أدب المرأة العربیة الى الابداع - اكثر إلحاحاً مع انخراط انتاجها فی ما یمكن تسمیته: "مشروع الروایة العربیة". ففی اطار هذا المشروع مارست المرأة الروائیة التجریب, وتوسلت عناصر من التاریخ مضمِرة سؤالاً حول معنى الحقیقة وعلاقة المتخیل الروائی بالسرد التاریخی, كما تجاوزت القواعد التقلیدیة وداخلت بین الشهادة والوثیقة والرسالة منوعة فی السرد وأسالیبه, شأن رضوى عاشور (مصریة) فی روایتها "قطعة من أوروبا" (2003). وشأن نجوى بركات (لبنانیة) فی عودتها الى التراث فی روایتها "لغة السر" (2004) وطرح أسئلتها المضمرة على المقدّس فی رموزه اللغویة. وشأن رجاء عالم (سعودیة) فی روایتها "سیدی وحدانه" (1998) التی تستعید فیها فصاحة العرب وتحیی ثراء لغتهم.
لقد قدمت المرأة العربیة الكاتبة أنماطاً من البناء تحدثن بها السرد العربی على خلفیة منظور فكری یقول بالاختلاف على أساس التعدد والتنوع, ولیس على أساس من معاییر قیمیة تضم الانوثة ضد الذكورة او دونها. فقدمت می التلمسانی (مصریة) فی روایتها "دنیا زاد" (1997) بناء فنیاً یجاور بین صوتین سردیین (الأم والأب) یشتركان فی مشاعر الفقدان. وقدمت نجوى بركات فی روایتها "باص الأوادم" (1996) بناء تمیز بمونتاج سینمائی وبطابع حركی بصری, وبشخصیات تنوعت سلوكاتها على اساس انتماءاتها الاجتماعیة لا الذكوریة او الانثویة. وكما فی تحدیث السرد, ساهمت المرأة, بصفتها شاعرة, فی تحدیث القصیدة العربیة شأن نازك الملائكة التی كان لها, بقدر ما كان للشاعر بدر شاكر السیاب, فضل الریادة فی نقل القصیدة العربیة من شعریة الوزن والقافیة الى شعریة التفعیلة والایقاع.
وعندما نتكلم عن الشعریة - شعریة الشعر وشعریة السرد - ت Poژtique, فإننا نتكلم على أدب یتطور بتغیر قواعد تخصه ولا علاقة لها بذكورة او أنوثة.
ان الثورات الادبیة التحدیثیة التی كان یمارسها الخطاب الادبی العربی, كانت ثورات معنیة بعلاقة هذا الخطاب بالحیاة, وبرؤیة الكاتب / الكاتبة الذی یعیش فیه, كما كان یشترط كسر تقالید البنى الأدبیة وقواعدها, ویستدعی تجدید اللغة, وتفكیك تراكیبها البلاغیة الجامدة. وهو ما كان یمارسه المبدع / المبدعة, بغض النظر عن جنسه.
وبالنظر الى الاجناس الأدبیة, فقد یعلل البعض إقبال المرأة على النثر وسردیاته, او على النثر الشعری اكثر من إقبالها على القصیدة العمودیة, بالأنوثة: فالأنوثة, كما یقال, كلام شفوی یحكی, والذكورة عقل یفكر ویكتب.
ولكن بالعودة الى الواقع والتاریخ, ندرك أن قلة عدد الشاعرات, بخاصة فی مرحلة سیادة القصیدة العمودیة وكثرة الشعراء, یرجع الى حرمان المرأة من التعلیم, كما ان استمرار عدم اقبال المرأة على قول الشعر العمودی, او كتابته, حتى بعد ان ارتادت المدرسة, فی الأربعینات والخمسینات من القرن العشرین - فترة ازدهار الشعر وبروز الشعراء الرومنطیقیین - یجد سببه فی نظام تعلیمی لا یدرس عروض الشعر وبحوره وما یتعلق بقواعده الشعریة الجمالیة فی مدارس البنات, ولا یجد سببه فی أنوثة المرأة او فی طبیعتها الانثویة.
وعلیه, فإن وردة الیازجی (1838-1924), وزینب فواز, وعائشة تیمور (1840-1904), وفدوى طوقان (1917-2004), لسن, بصفتهن شاعرات, استثناء یثبت القاعدة التی تربط بین الانوثة والكلام, بل یشرن بأنسابهن المعروفة, الى نخب عائلیة, او الى بیوت علم, وفّرت لبناتها العلم فی خدورهن وأعانت مواهبهن الشعریة على النضج والظهور.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:47|
معالم شخصیة أبی العتاهیة فی الأندلس
مقدمة:
لا جدال أن دراسة الشعر الأندلسی لا تكون بمنأى عن دراسة تیاراته وشعرائه فی المشرق، إذ إن الشاعر فی البیئة الأندلسیة ظل مشدوداً إلى أجداده المشارقة، ینهل من روافد ثقافتهم العربیة الأصیلة، إلى جانب تأثره بالقرآن الكریم والأحادیث النبویة والحكم والأمثال والخطب والرسائل، كما تأثر بالفلسفة والتاریخ وغیرها من العلوم والفنون.
والحقیقة أن الشعر الأندلسی فی بدایاته الأولى قد تأثر بالشعر الجاهلی والإسلامی والأموی، بید أن هذا التأثیر قوی وتعمق عند اتصاله بالأعلام المجددین من طلیعة شعراء العصر العباسی الذین كانت لهم مكانة ومنزلة مرموقة فی المشرق، من أمثال: بشار بن برد وأبی نواس وأبی العتاهیة فی القرن الثانی الهجری وابن المعتز وأبی تمام والبحتری وأبی العلاء المعری، والمتنبی فی القرنین الثالث والرابع الهجریین.
وقد تفاوت تأثیر هؤلاء الشعراء فی الشعر الأندلسی، فمنهم من كان أثره واضحاً كل الوضوح، بحیث استأثر باهتمام الأندلسیین أكثر من غیره نظیر: أبی تمام والمتنبی وأبی العلاء، ومنهم من كان تأثیره محدوداً فی نفوس الأندلسیین.
ومن بین الشعراء المشارقة الذین كان لهم تأثیر بارز فی الشعر الأندلسی الشاعر أبو العتاهیة، الذی تبدت معالم شخصیته واضحة، بینة القسمات، واحتلت شخصیته مكانة مرموقة فی نفوس الأندلسیین، إذ تعددت مظاهر شخصیته وتنوعت مما بین معان وصور شعریة، وبناء قصیدة، وأسالیب، ولغة وموسیقى، فقد عُرف عن أبی العتاهیة أنه تغزل ومدح وهجا، ولكن فنه الذی عرف به، وقدره معاصروه من أجله هو فن الزهد، وفن صیاغة الحكم والأمثال، فقد فتح باباً واسعاً من أبواب الشعر العربی هو شعر الزهد، الذی اتخذ منه فناً غلب على فنون شعره كلها، انقطع إلیه، لا ینظم فی غیره، لفترة طویلة من فترات حیاته، ولم یكن هذا الغرض باباً واسعاً مستقلاً، حتى كان أبو العتاهیة شاعر الزهد.
ویعد الشاعر أبو العتاهیة إلى جانب الشاعرین: بشار بن برد وأبی نواس، من أبرز زعماء الاتجاه التجدیدی المحدث فی العصر العباسی، ذلك أن مذهبه الفنی قائم على التجدید فی الموضوع والمبنى الشعری معاً.
وأبو العتاهیة هو إسماعیل بن القاسم، ولد سنة 130 سنة هـ ونشأ قرب الكوفة، وسكن بغداد، كان فی بدء أمره یبیع الجِرَار، ثم برع فی نظم الشعر، وخالط أهل اللهو والمجون، اتصل بالخلفاء العباسیین بخاصة الرشید؛ وفی عهد هذا الخلیفة تحول من حیاة اللهو والمجون على حیاة الزهد فی الدنیا والتقشف، فطلب إلیه أن یعود، فأبى، فحبسه فی منزل مهیأ حتى عاد إلى الشعر، ولزم الرشید، وقد مدح بعد الرشید الأمین، فالمأمون، وتوفی سنة 211هـ (2: 4 /310).
ومن یتتبع سیرة الزاهد أبی العتاهیة، یجده أنه بعد أن تاب ورجع إلى طریق الله قطع صلته بحیاته اللاهیة العابثة، وأصبح یجاهد نفسه الأمارة بالسوء، ویدعو الى ترك الدنیا وتحقیرها، وهجر لذائذها وترفها تارة، ویحث على التقى والتفرغ إلى العبادة وطاعة الله، والتمسك بالصالح من الأعمال، وأداء الفرائض، ویذكر الموت وملاحقته للخلق، محاولاً إقناع النفس بأن الموت مصیر كل شی، ویظهر فی مواقف أخرى الندم ویبدی الضراعة ویطمع فی الغفران.
مظاهر اهتمام الأندلسیین بأبی العتاهیة:
یبدو أن أشعار أبی العتاهیة قد وصلت إلى الأندلس عن طرق ثلاثة:
أولها: طریق الوافدین الأندلس من علماء المشرق وأدبائه، الذین جلبوا عددا وافرا من كتب المشارقة فی الزهد والرقائق والمواعظ، وطبقات النساك وغیرها، حیث كانت تروى وتشرح وتحفظ، بل إن أشعار بعض الزهاد المشارقة وأخبارهم كانت تروی فی مجالسهم الخاصة. ومن هؤلاء إبراهیم بن سلیمان الشامی الذی دخل الأندلس فی أواخر أیام الحكم بن هشام، إذ یروی المقری: أنه أدرك بالمشرق كبار الشعراء المشارقة المحدثین، وأنه لقی ببغداد الشاعر أبی العتاهیة، واستمع إلیه، وروى عنه شعره، وأشاعه بین الأندلسیین(19: 2 / 748).
وثانیها: عن طریق أولئك الأندلسیین الذین رحلوا إلى المشرق؛ طلباً للعلم والأدب، ثم عادوا بما حصلوا علیه من ذلك، بما یتیح لهم أن یمتلكوا من كتب الأدب والدواوین الشعریة وكتب المنتخبات الأدبیة، مثل: كتاب الأغانی للأصفهانی، وعیون الأخبار لابن قتیبة، ویتیمة الدهر للثعالبی، دیوان أبی نواس، وابن المعتز، أبی العتاهیة، ومن هؤلاء وفدوا على المشرق وعادوا إلى الأندلس الشاعر عباس بن ناصح ویحیی الغزال وغیرهما.
وآخرها: الموسوعات الأدبیة والمختارات الشعریة للكتاب الأندلسیین التی أدت دوراً كبیراً فی نشر أشعار أبی العتاهیة فی ربوع الأندلس، وفی هذا المجال یمكن الإشارة إلى كتابین من كتب المختارات الأدبیة هما: العقد الفرید لابن عبد ربه فی " الزمردة فی المواعظ والزهد"، وبهجة المجالس لابن عبد البر، وهذان الكتابان یعدان موسوعة أدبیة حافلة بالنصوص المشرقیة والمغربیة القیمة شعراً ونثراً فی شتى الفنون والأغراض والمواقف، وقد أردا أن ینقلا إلى الأندلسیین ثقافة عامة عن المشرق تغنیهم عن الرجوع إلى كثیر من الكتب والمراجع والدواوین الشعریة وغیرها.
قد ورد فی هذین الكتابین شواهد عدیدة من أخبار أبى العتاهیة وأشعاره، فی مختلف الأغراض الشعریة من: مدح وزهد وهجاء وغزل، بید أن النصیب الأكبر كان لغرض الزهد، ولیس من شك فی أن هذا العمل كان من أهم العوامل التی زادت من اهتمام بالأندلسیین بشخصیة الشاعر أبى العتاهیة والاتجاه الشعری الذی كان یسیر فیه، والمذهب الفنی الذی یأخذ به.
ولعل من أبرز مظاهر اهتمام الأندلسیین بشخصیة شاعر الزهد المشرقی أبی العتاهیة فی الأندلس ما قام به العلماء الأندلسیون من انتقاء واختیار لأشعار أبى العتاهیة وجمع أخباره، وهو یعد عملاً ذا تأثیر واضح فی التعریف بشخصیة أبی العتاهیة، فقد قام الفقیه ابن عبد البر النمر القرطبی (ت 463 هـ) بجمع أشعار أبى العتاهیة فی دیوان مستقل سماه " الاهتبال بما فی شعر أبى العتاهیة من الحكم والأمثال" (3: 26)، أما أبو الحسن على بن أحمد بن العباسی، فقد انتقی من أشعار أبى العتاهیة وأخباره الشیء الكثیر؛ الأمر الذی دفعه إلى أن یضمنها فی كتاب له وسمه بـ"المختار من شعر أبى العتاهیة وأخباره"(17: 2/ 541).
وتشیر الروایات التی تناقلها أدباء الأندلس إلى أن أبا العتاهیة یعد من طلیعة الشعراء الذین اهتم الأندلسیون بهم، واستساغوا شعرهم وأحبوه، لاسیما شعره الزهدی الذی كان محط إعجابهم، وقد لجئوا إلى طریقته فی النظم، فقد شغفوا بشعره، وأخذوا یتدارسونه فی مجالسهم، وكان للأندلسیین غرام بحفظ أشعاره التی ذاعت على الألسنة، وتناقلها الناس لمقامها ومنزلتها، فعمدوا إلی الاقتباس منها، والاستشهاد بها فی مصنفاتهم الأندلس، وكان تأثیره فی بعضهم عظیماً، إذ لا یكاد القارئ یلم بشعر الزهد الاندلسی حتى یدرك أثر أبى العتاهیة واضحا فیه، ولا یخفى على أحد أن أشعار أبی العتاهیة الزهدیة كانت أحد الروافد الأساسیة التی أسهمت فی استقواء حركة الزهد فی الأندلس (1:40).
فابن بسام یذكر فی ذخیرته أن مذهب أبی العتاهیة الزهدی قد انتشر وذاع لدى بعض الأفراد الزهاد الأندلسیین، إلى الدرجة التی جعلت أحد الشعراء الأندلسیین یتشبّه به فی طریقته: كالشیخ أبی الحسن علی بن إسماعیل القرشی الأشبونی أحد الأدباء النبلاء والشعراء المحسنین، له أشعار فی التذكیر والتدبر فی معنى الحیاة، وأنه أنفد فی التلبس بذلك صدراً من عمره، ثم مال إلى النسك والتقشف ونظم فی تلك المعانی أشعاراً رائقة وضروباً فی رقعة من جنة له على بحیرة "شقبان" عرفت برابطة "الطیطل"، ولزم العبادة بها إلى أن توفی". ویقول ابن بسام فی ترجمته:" وكان یعرف عندنا بـ"الطَّیْطًل" ممن نظم الدر المفصل، لا سیما فی الزهد، فإن أهل أوانه كانوا یشبهونه بأبی العتاهیة فی زمانه"(14: 2 / 305).
ولا ریب فی أن الشاعر "الطَّیْطًل" كان یتمتع بمقدرة شعریة عالیة، وأن أشعاره على قدر من الذیوع والشهرة، وأنها كانت تتردد على ألسنة الأندلسیین، لذا لقبوه بشاعر الزهد فی المشرق أبی العتاهیة، ومن نظم الطیطل(15: 1/5 /195):
یــا غافلا شأنـــه الرقــاد
كأنما غیــــرك المـــراد
والموت یـــرعاك كل حیــن
فكیـــف لم یجفك المهـــاد
ما حال سفر بغیـــــر زاد
والأرض قفـــر ولا مــزاد
وكانت "النملة" من المخلوقات التی اتخذها هذا الشیخ الزاهد آیة من آیات الله فی خلقه، فی تأمل خلقتها، وكدها فی رزقها، وهی مما یسلك فی هذا الفن الزهدی، ویستدل بها على قدرة الله تعالى وعظمتهن فی مثل قوله(15: 1 /5/196):
وذات كشح أهیــف شختِ
كأنما بولغ فی النـــحتِ
زنجیــــة تحمل أقواتـها
فی مثـل حـدی طرف الجفتِ
كأنما آخـــــرها قطـرة
صغیـرة من آخر قطرة الزفتِ
وهو یرید من هذا الوصف الاستدلال على عظمة الخالق وبدیع صنعه فی الخلق، إذ یقول:
تشهد أن اللـــه فی ملكه
خالقها فی ذلك الســـمتِ
سبحان من یعلم تسبیـحها
ووزنها من زنة البــختِ
فنسبتی منها لفرط الضـنى
نسبتها منــــه بلا كّتِ
كلا ولو حاولت من رقــة
لحلت بین الثوب والتـختِ
مظاهر تأثر الأندلسیین بشخصیة أبی العتاهیة ومذهبه الشعری:
تعددت مظاهر تأثر الشعراء واختلفت باختلاف تجربة الشاعر ونفسیته والظروف التی وقع تحت تأثیرها ووفق ثقافته، وفی الإمكان توزیع هذا التأثر على مجالات ثلاثة هی: الثورة على الحكام الظلمة وانغماسهم فی الترف، والمعانی والأفكار، والسمات الفنیة، وسیتم تناولها على النحو الآتی:
أولاً ـ الثورة على الحكام الظلمة وانغماسهم فی الترف.
المتتبع حیاة الشاعر أبی العتاهیة یجده فی مرحلة من مراحل حیاته یتخذ من الشعر الزهدی سلاحاً یشهره فی وجه سادة عصره من الخلفاء والأمراء، مهاجماً ما فی حیاتهم من میل إلى الملذات والشهوات، والانصراف إلى الدنیا بما فیها من زخرف كاذب ومتاع زائل بدلاً من التعلق بالآخرة، والعمل الصالح، یقول موجهاً شعره إلى الخلیفة هارون الرشید، معبراً فیه عن نقمة حقیقیة على الملوك فی كل زمان ومكان(9: 38):
إن كنــت تطمع فی الحیـــاة فهات
كم من أب لك صـــار فی الأمـواتِ
زرت القبـور قبـور أهل الملـك فی
الدنیا وأهل الرتــــع فی الشهواتِ
كانــوا ملوك مآكــــل ومشارب
وملابس وروائــح عطـــــراتِ
فإذا بأجســـاد عریــن مـن الكسا
وبأوجــه فی التــرْب منــعفراتِ
لم تبــق منــها الأرض غیر جماجم
بیــض یلحن وأعظــم نخــراتِ
وفی الأندلس اتخذ الشعر من الزهد أداة للهجوم على سادة العصر من الحكام والأمراء، إذ اشتهر الأمیر الحكم بن هشام الملقب بالربضی بأنه كان طاغیاً مسرفاً منهمكاً فی لذاته ومباذله، حتى شاع أمره، وتعقبه الناس بألسنتهم، وفی أیامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد، والحض على قیام اللیل فی الصوامع، أعنی صوامع المساجد، وأمروا أن یخلطوا مع ذلك شیئاً من التعریض به، مثل أن یقولوا:"أیها المسرف المتمادی فی طغیانه، المصر على كبره، المتهاون بأمر ربه، أفق من سكرتك، وتنبه من غفلتلك… وما نحا هذا النحو، وكان أشد الناس علیه فی أمر هذه الفتنة الفقهاءُ، هم الذین یحرضون العامة ویشجعونها"(19: 30).
ومما یؤسف له أن الأشعار الزهدیة التی قیلت فی الهجوم على الحكم الربضی وانتقاد سلوكه المتصف بالظلم والفساد والانهماك فی الشهوات لم تصل إلینا، ویبدو أنها ضاعت من جملة ما ضاع من التراث العربی فی الأندلس، ولو أنها وصلت إلى أیدی الباحثین، لكان فی الإمكان رصد دور الزهاد من الفقهاء الذین ضمنوا أشعارهم الزهدیة معانی حث العامة من الأندلسیین على الثورة على أمثال هؤلاء الحكام الذین مالوا إلى حیاة العبث واللهو، وغرقوا فی الملذات والشهوات.
ثانیاً ـ المعانی والأفكار:
الدارس المتمعن للأشعار التی خلفها الشعراء الزهاد فی الأندلس، یدرك أن هناك تشابهاً كبیراً بینها وبین أشعار أبی العتاهیة الزهدیة، ذلك أن شخصیة أبی العتاهیة بأفكاره ونظراته فی الحیاة والموت تسری واضحة جلیة فی تلك الأشعار، وفی المجال یرى أحد الباحثین أن أثر أبی العتاهیة فی تقویة النزعة والاتجاه الشعری لا یمكن إنكاره، بید أن یذهب فی الوقت نفسه إلى القول بأنه من العسیر أن یحكم المرء بأن الأندلسیین قد استعاروا هذا الموضوع من أبی العتاهیة أو اقتبسوا تماماً فنه الشعری، ویعلل ذلك بأن "الزهد موضوع مشترك بین أناس ینظرون إلى الحیاة الدنیا من خلال نظرهم إلى الموت والحیاة الفانیة؛ ولأن الزهد نزعة لها أصولها الاجتماعیة، ولیست تجیء كلها اقتباساً"(5: 116، 117).
أول ما یلقى القارئ من الشعراء الأندلسیین الذین تأثروا فی سلوكهم وأفكارهم ومعانیهم بشعر أبی العتاهیة هو الشاعر یحیى الغزال، فالمتتبع حیاة هذا الشاعر، یجد أن ثمة تشابهاً كبیراً فی المسلك الحیاتی بینه وبین أبی العتاهیة، فقد انغمس الحكم الغزال فی مطلع شبابه فی حیاة اللهو والمجون، ثم صحا من غفلته وتزهد فی أخرة من عمره، وقد أشار إلى هذه الحقیقة ابن دحیة فی قوله:"وقد ترك شرب الخمر، وتزهد فی الشعر وشارف الستین، وركب النهج المبین"(18: 147، 148).
ومن یراجع المقطعات الشعریة التی قالها الحكم الغزال فی الزهد یجد أنه قد تأثر فی كثیر منها بروح أبی العتاهیة ومعانیه وأفكاره، فهو فی إحدى مقطعاته الزهدیة یذكر القارئ بأبی العتاهیة، حین یذكر الموت وفناء الحیاة، یقول (7: 315):
ومن إنعام خالقنا علیــنا
بأن ذنوبــنا لیست تفوحْ
فلو فاحت لأصبحنا هروباً
فرادى بالفلا ما نستـریحْ
وضاق بكل منتحل صلاحاً
لنتن ذنوبه البــلد الفسیحْ
فهو فی هذه الأبیات ینسج على منوال أبی العتاهیة فی القصیدة التی بها قوله (9: 59،60):
خانك الطرف الطموح
أیها القلب الجمــوح
أحسنَ اللـهُ بنـــا
إن الخطایــا لا تفوحْ
فإذا المستور منـــا
تحت ثوبیه فضــوح
ویعثر القارئ فی شعر الغزال الزهدی على نقدات اجتماعیة لما كان علیه سلوك الأفراد فی مجتمعه حیث تعد المصالح الفردیة هی المحرك الأساسی للأفراد، یقول فی بیتین من الشعر تتشح نظرته فیهما بالتشاؤم القاتم (5: 130):
ما أرى هاهنا من النــاس إلا
ثعلباً یطلب الدجـاج وذیــبا
أو شبیــهاً بالقط ألقى بعینیـ
ـه إلى فأرة یریـد الوثـوبا
أما الشاعر الزبیدی، فقد تأثر بمعانی أبی العتاهیة ونظرته الزهدیة فی قوله(21:1 /410):
لقد فاز الموفق للصــواب
وعاتب نفسه قبل العتــاب
ومن شغل الفؤاد بحب مولى
یجازی بالجزیل من الثواب
فذاك ینـــال عزاً لا كعز
من الدنیا یصیـر إلى ذهاب
تفكر فی الممات فعن قریب
یُنادى بالرحیل إلى الحساب
وقدم ما ترجی النفع منــه
لدار الخلد واعمل بالكتـاب
ولا تغتر بالدنیـــا فعمَّا
قریب سوف تؤذن بالخراب
إذا سمعنا هذا الشعر وجدنا الموضوع والشكل قد اتفقا على النظر معاً إلی أبی العتاهیة فی مثل قوله(9: 23):
لدوا للموت وابنـوا للخراب
فكلكم یصیـــر إلى تباب
لمن نبنی ونحن إلى تراب
نصیر كما خلقنا من تراب
أما الشاعر ابن عبد ربه الذی عرف عنه أن كان یمیل إلى معارضة المشارقة، والسیر فی ركابهم، فقد اجتهد ما استطاع فی الأخذ من أفكارهم ومعانیهم، مضیفاً علیها، وكان فی ذلك یختار فی كل موضوع من موضوعات شعره إماماً من المشارقة، وفی مجال الزهد اختار إمامه أبا العتاهیة(16:3 / 124).
لقد نظم ابن عبد ربه قصائد زهدیة دارت حول معانی الزهد والتوبة سمیت" بالممحصات" التی نقض فیها ما قاله فی أیام الصبا والشباب بقصائد فی المواعظ والزهد، والتزم فیها الوزن والقافیة وحركة الروی ومن أمثلتها قوله (9:1 / 165، 166):
یا عاجزاً لیس یعفو حین یقتدرُ
ولا یقضی له من عیشه وطرُ
فقد عارض فی البیت الأخیر قطعة قالها أیام الصبا واللهو تبدأ بقوله:
هلاّ ابتكرت لبین أنت مبتكر
هیهات یأبى علیك الله والقدرُ
ومن المعروف أن الشاعر ابن عبد ربه فی نظمه "الممحصات" كأنما عدّ شعره فی شبابه ذنوباً وآثاماً، إنما كان محاكاة للشعراء العباسیین ـ لا سیما شاعر الزهد أبا العتاهیة ـ، لا اقترافاً حقیقیاً للآثام؛ لأنه لم یكن مهیئاً لذلك بحكم روحه المحافظة (6: 188).
وأما شاعریة الشاعر أبو إسحاق الإلبیری، فهی تقترب كثیراً من شاعریة زاهد المشرقی أبى العتاهیة، وذلك بأمرین: أحدهما: هو النفس الشعری الطویل، أی اللجوء إلى بناء القصائد فی صورة مطولات بدلاً مما هو شائع فی غرض الزهد أنه یجیء عادة فی شكل مقطعات، ولعل مرجع ذلك إلى الاقتدار الماهر على طرق المعنی ذاته بأسالیب وصور متنوعة ومتعددة، إذ لا یزال الشاعر یلح على وجوه متعددة للمعنى الواحد یدور بها فی سیاقات مختلفة ومتشابهة.
والآخر: الشعبیة اللفظیة واللغویة، إلى جانب شعبیة الفكرة فی قربها وبساطتها، بمعنى: اقتراب هذا الشعر لدى كلا الشاعرین من نفوس العامة، إذ كانا یعمدان إلى المعانی والأفكار المطروحة فی طرقات العامة، وینتشلانها، ویحیلانها إلى عمل شعری، یتمیز بسهولة اللفظ، وحلاوة الإیقاع؛ الأمر الذی أدى إلى تعلق العامة وولعها بها ولعلاً شدیداً؛ لما تتمتع به من تعبیر صادق عن معاناتها وأحاسیسها، وبذلك اكتسبت أشعارهما طابع الشعبیة.
ومن الأمثلة التی تنم على تأثر الشاعر أبى إسحاق الإلبیری بأشعار أبی العتاهیة یذكر الباحث ـ مثلاً ـ اتفاق الإلبیری مع أبی العتاهیة بمطلع قصیدته التی یقول فیها(8: 111):
كل امرئ فیما یدیــن یدان
سبحان من لم یخل فیه مكان
فهی مطلع قصیدة لأبی العتاهیة یقول فیها(9: 219):
كل امرئ فكما تــدین یدان
سبحان من لم یخل فیه مكان
إضافة لتضمنیه هذه القصیدة بیتین آخرین من قصیدة أبی العتاهیة(8: 220):
أأسر فی الدنیا بكل زیـادة
وزیادتی فیها هی النقصان
یا عامر الدنیا لیسكنها وما
هی بالتی یبقی بها سكان
ویوازن أحد الباحثین بین أبی العتاهیة زاهد المشرق وزمیله أبى إسحاق الإلبیری زاهد الأندلس ویرى أن الخیر ربما فاق زمیله فی معانیه وجوهر رؤیته الزهدیة، من حیث اتصالها الوثیق بالتراث الإسلامی، فأبو العتاهیة یتخذ من الموت موقفاً ساخطاً متشائماً، ویبدى خوفاً شدیداً ورهبة بالغة من الموت والقبر، إذ یشعر بأن شبح الموت یطارده فی كل حین، أما الإلبیری فزاهد قد آمن بالموت، وأقبل علیه، وعلم أن الموت حق، وأن الدنیا معبر للآخرة(4: 508)
ویحس القارئ بأصداء أشعار أبی العتاهیة ومذهبه الزهدی ودعوته إلى القناعة بما قسم الله من الرزق، والاكتفاء بالقلیل والرضا به فی المسكن والمأكل والمشرب والملبس، تتردد فی شعر الزاهد ابن قسوم، یقول أبو العتاهیة فی مقطعة له صاغها بأسلوب بسیط عبر فیها تعبیراً واقعیاً(15:):
سلیخة وحصیـــر
لبیت مثلی كثیـــر
وفیــه شكر لربی
خبز وماء نمیـــر
وفوق جسـمی ثوب
من الهواء ستیــر
إن قلت: إنـی مقل
إنــی إذاً كفــور
قررت عیـناً بعیش
فدون حالی الأمیـر
وهذه الأبیات تذكرنا بأبیات أبی العتاهیة التی تتجلى فیها نظرته إلى القناعة والتعفف والاكتفاء بالقلیل من متاع الدنیا الزائل(9: 206):
رغیف خبــز یابس
تأكله فی زاویـــهْ
وكــوز ماء بـارد
تشربه من صافیــهْ
وغرفــة ضیــقة
نفسك فیها خالیــهْ
أو مسجد بمـــعزل
عن الورى فی ناحـیه
خیـرٌ من الساعات فی
فیء القصور العالیـهْ
ومن یقرأ دیوان الشاعر ابن حمدیس قراءة متمعنة، یكتشف أنه كان شاعراً شاكیاً؛لأن المحنة التی حلت بوطنه الأول"صقلیة" جعلته دائم الأسى والحزن، فأخذ یشكو الزمان، ولؤم الناس، ویتبرم بالحیاة، وبما ناله من غدر الزمان، تصرف الحدثان، وقد سار فی ذلك على طریقة أبی العتاهیة، یقول فی البكاء على الشیب الذى غزاه فی وقت مبكر من العمر (11: 40):
وعظت بلمتك الشائبـــه
وفقد شبیبتك الذاهبــــه
وسبعین عاماً ترى شمسها
بعینیك طالعة غاربــــه
فیا حاضراً أبداً ذنبــــه
وتوبته أبداً غائبـــــه
أذب منك قلباً تجاری بــه
سوابق عبرتك الساكبــه
من یقرأ مثل هذه الأبیات یحس بأنه یردد ما شاع فی أشعار أبی العتاهیة من شكوى الزمان ومزج ذلك بالتطلع إلى التوبة، یقول(:9 23):
بكیت على الشباب بدمع عیـنی
فلم یغن البكاء ولا النحیــــبُ
فیا أسفا أسفت على شبـــاب
نعاه الشیب والرأس الخضیــب
عریت من الشباب وكنـت غصناً
كما یعرى من الورق القضیــب
فیا لیت الشباب یعــــود یوماً
فأخبــره بما فعل المشیـــب
ولم یقف تأثر الشعر الأندلسیین بشعر أبی العتاهیة وطریقته الفنیة عند غرض الزهد، وإنما تعداها إلى غیرها من الأغراض مثل غرض المدیح، فالشاعر طاهر بن محمد المعروف "بالمهند" الذی تزهد فی آخر عمره وأنشأ شعراً ورسائل فی معانی الزهد، یقول مادحاً الخلیفة الأندلسی الحكم المستنصر فی یوم عید الفطر سنة 363 هـ بقصیدة یقول فیها(7 / 229):
تولى الخلافة فی عصـرها
فأحسن تقواه إكمالهـــا
وكانت دیانته زینــــها
وأیامه الزهر أشكالهـــا
فلو رفعت خطة فوقهـــا
لما كان یصلح إلا لهـــا
وما صفة حسنت فی الهدى
من الذكر إلا وقد نالهـــا
فهنأه اللــــــه أعیاده
وبلغه اللـــــه أمثالها
یلمح القارئ هذه الأبیات معارضة الشاعر المهند لأبی العتاهیة فی قصیدة بارك فیها للخلیفة العباسی المهدی بالخلافة، إذ یقول(2: 4 /33):
أتتـه الخلافة منــقادة
إلیه تجرر أذیـــالهـا
فلم تكُ تصلح إلا لــه
ولم یكُ یصلح إلا لهــا
ولو رامها أحد غیــره
لزلزلت الأرض زلزالــــها
ولو لم تعطه نیات القلوب
لما قبل الله أعمالـــها
وإن الخلیـفة من قول لا
إلیه لیــبغض من قالها
ثالثاً ـ السمات الفنیة:
المتتبع لأشعار أبی العتاهیة، یجد أن لغته تمتاز بسمات فنیة طبعته بطوابع خاصة منها جنوحه للبساطة والوضوح، إذ مال أبو العتاهیة إلى السهولة فی الألفاظ واستعمالها، والبساطة فی العبارة وصیاغتها وبنائها، حتى تقترب لغته من لغة الناس الیومیة.
ولا یخفى على القارئ المتمعن تأثر شعراء الزهد فی الأندلس بهذه السمة الفنیة فمالت بعض زهدیاتهم إلى البساطة والسهولة، یقول ابن خفاجة معبراً عن ازدراء الدنیا، والإقبال على الآخرة:(12: 213، 214)
ألا قصر كل بقــاء ذهــاب
وعمران كل حیـــاة خـراب
وكل مدیـن بما كـــان دان
فثم الجزاء، وثم الحســاب
وخطة غیر إحـدى اثنیـــن
إما نعیم، وإمـا عــــذاب
فرحماك ! یا من علیه الحسـاب
وزلفاك! یا من إلیـه المـآب
أول ما یطالع القارئ فى هذه الأبیات سهولة اللغة، وبساطة التراكیب، فهی قریبة من لغة الناس العادیة التی تجرى على ألسنتهم فى الحیاة الیومیة، وقد استخدم الشاعر للوصول إلى هذه البساطة وسائل متنوعة منها: انتقاء الألفاظ العذبة، والإیقاع النغمی المتدفق، والمحسنات البدیعیة من تكرار، وطباق، وإطناب، وحسن تقسیم، بالإضافة إلى المراوحة بین الأسالیب الخبریة والإنشائیة، بخاصة أسلوب المناجاة والتضرع القادر على التأثیر فى النفس، وإیصال المعنى مباشرة إلى العقل والقلب.
ومن الأمثلة على هذه البساطة والسهولة تضرع ابن الزقاق ومناجاته خالقه: (13:274):
یاعالم السر منى
اصفح بفضلك عنی
منیّت نفسی بعفو
مولاى منك ومنـى
وكــان ظنى جمیلا
فكن إذا عند ظنـی
اتصفت هذه المقطوعة بسهولة فی العبارة، وسلاسة فی الأسلوب مع لغة مألوفة بعیدة عن الغرابة والتعقید، ومما أسهم فی هذه البساطة أن المعنى الذی عبر عنه الشاعر معنى شائع لا تعقید فیه, إلى جانب خفة الإیقاع ورشاقته، والتنغیم الداخلی المتدفق من تكرار أصوات المیم والنون واللام وتآلفها مع بقیة الأصوات الذی یلائم النفحات الروحیة المنسابة فی رقة وعذوبة، تمدها عاطفة صادقة فیاضة.
وهذا الأسلوب الذی طبع بطابع الأسلوب الوعظی فی بساطته ووضوحه، وما یتضمنه من أدعیة وابتهالات قریب فی مضمونه ومبناه الشعری من أسلوب أبی العتاهیة فی مثل قوله(9: 223):
إلـهی لا تعذبــنی فإنــی
مقر بالذی قــد كان منـی
مالی حیــلة إلا رجائـی
لعفوك ان عفت وحسن ظنی
ومن الصور الفنیة التی تأثر فیها شعراء الأندلس بصور الشاعر أبی العتاهیة الفنیة، واستعاروها للتعبیر عن تجاربهم الذاتیة ورؤیتهم للحیاة صورة الدنیا التی تشبه البحر، یقول ابن أبى زمنین محذرا من الدنیا، وحاثاً على القناعة، فهى وسیلة العاقل للنجاة(21:2 / 71):
أیها المرء إن دنیــــاك بحر
طافح موجه فلا تأمننـــها
وسبیل النجاة فیه مهیــــن
وهو أخذ الكفاف والقوت منها
أما الشاعر الأعمى التطیلى، فیقول(10: 27):
عزاءكم إنما الدنیا وزینتها
بحر طفونا على آذیه زبدا
ویقول الشاعر عبد المنعم بن عمر الغسانی فى المعنى ذاته:(20: 2 / 614):
ألا إنما الدنیا بحار تلاطمــت
فما أكثر الغرقى على الجنـبات !
وأكثر من لاقیـــت یغرق إلفه
وقل فتى ینجی من الغمــرات
فالدنیا عند الشعراء الأندلسیین بحر لجی متلاطم، وأهلها ما بین غریق وناج، وهذه الصورة قریبة الشبه بصورة الدنیا عند شاعر الزهد أبى العتاهیة إذ یقول(9:147):
كل أهل الدنیا تعوم على الغفـ
ـلة منها فی غمر بحر عمیق
یتبارون فی السباح فهم من
بین ناج منهم وبین غریـق
والمتأمل فى صور الأندلسیین وصورة أبى العتاهیة، یلمس تشابهاً بین عناصرها وجزئیاتها، ومع ذلك فإنه یشعر باختلاف بین شاعر وآخر فى طریقة التعبیر عن هذه الصورة، إذ أكسب الشاعر الأندلسی صورته طابعاً ذاتیاً جعلها تنتمی إلى بیئته، كما أضفى علیها شیئا من الطرافة، فبدت كأنها أندلسیة الطابع، فالصورة الأندلسیة عمدت إلى تصویر الظروف المظلمة، والأهوال المضطربة التی ألمت بالأندلس، وأفضت إلى غرق المدن الأندلسیة فى بحر حركة الاسترداد المسیحیة المحتدمة، وربما كان تخاذل المسلمین وتفریطهم سبباً فى هذا الغرق، حیث قل من یحاول أن ینقذ الأندلس من السقوط فی حجر حملة الصلیب.
وإذا كانت صورة الدنیا التی تشبه البحر قد تسربت إلى تجربة الشاعر الأندلسی من الشعر المشرقی، فلا غرابة فی ذلك؛ لأن لدى الشاعر الأندلسی رصیداً مختزناً من الصور والتجارب والثقافات استمدها من دراسته أدب المشارقة، وعنایته بمطالعته وحفظه.
وصفوة القول، إن التشابه بین شعراء الأندلس وبین الشاعر المشرقی أبی العتاهیة هو فی حد ذاته شیء طبیعی؛ لتوحد المنابع الثقافیة والروافد الفكریة للأدبین، ولتماثل الدوافع التی أسهمت فی بعث أدب الزهد بعامه، بید أن هذا التشابه لا یقلل بأی حال من أصالة الشعراء الأندلسیین، ذلك أن الشعر الأندلسی یعد ثمرة طبیعیة لظروف المجتمع الاندلسی المتنوعة عن قرینتها المشرقیة بحكم اختلاف العناصر المكونة للمجتمع، وبحكم البیئة بعناصرها المختلفة، وأن هذا التشابه لم یكن مبعثه كله التقلید والمحاكاة، وإنما إعجاب الأندلسیین بالنتاج المشرقی، ورغبتهم فی إثبات مقدرتهم الفنیة وتفوقهم.
[1]
حواشی
[1]
(1) أدب الزهد فی عصر المرابطیــن والموحدین بالأندلس، عبد الرحیم حمدان حمدان، رسالة دكتوراه،(غیر منشورة)، جامعة عین شمس، القاهرة، 1998.
(2) الأغانی، أبو فرج الأصفهانی، تحقیق إبراهیم الإبیاری، دار الشعب، القاهرة، 1969 م.
(3) بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس،ابن عبد البر النمری: تحقیق محمد مرسی الخولی، دار الكاتب العربی للطباعة والنشر، القاهرة.
(4)البیئة الأندلسیة وأثرها فی الشعر عصر ملوك الطوائف، سعد إسماعیل شلبی، النهضة المصریة، القاهرة، 1979.
(5) تاریخ الأدب الأندلسی، عصر سیادة قرطبة، إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، ط2، 1971.
(6) تاریخ الأدب الأندلسی، -عصر الدول والأمارات (الأندلس)، شوقی ضیف، دار المعارف، مصر، 1989 م.
(7) جذوة المقتبس، الحمیدی، تحقیق الإبیاری، دار الكتاب المصری، ط2، القاهرة 1989.
(8) دیوان أبی إسحاق الإلبیری، تحقیق محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة، بیروت 1976
(9) دیوان أبی العتاهیة، جمع وتحقیق كرم البستانی، دار صادر، بیروت 1964 م
(10) دیوان الأعمى التطیلی، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت 1963 م.
(11) دیوان ابن حمدیس، تحقیـق د. إحسان عباس، دار صادر، بیروت 1960 م.
(12) دیوان ابن خفاجة، تحقیق السید غازی، منشأة المعارف، الإسكندریة 1960م.
(13) دیوان ابن الزقاق، تحقیق عفیفة دیرانی، دار صادر، بیروت 1983
(14)الذخیرة فی محاسن أهل الجزیرة، ابن بسام، تحقیق إحسان عباس، الدار العربیة للكتاب (لیبیا -تونس) 1978
(15) الذیل والتكملة لكتابی الموصول والصلة، عبد الملك المراكشی تحقیق محمد بن شریفة ج 2,1، ج 3 - 6 تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت من سنة 1964: 1975م.
(16)ظهر الإسلام: أحمد أمین، دار الكتاب اللبنانی ط 5، 1980 م.
(17) فهرسة ابن خیر، تحقیق إبراهیم الإبیاری، دار الكتاب المصری ط2, 1989 م.
(18)المطرب فی أشعار أهل المغرب، ابن دحیة: تحقیق الإبیاری وعابدین، القاهرة 1945 م.
(19)المعجب فی تلخیص أخبار المغرب، المراكشی. تحقیق محمد زینهم عزب، دار الفرجانی، القاهرة، 1994 م.
(20) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب المقری، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، 1988.
(21)یتیمة الدهر، الثعالبی، تحقیق مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت ط1، 1983.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:46|
الرمزیة المیثولوجیة فی شعر محمود درویش
فی هذه المدینة اللزجة صیفاً
حین تنعطف الى الیمین من الشارع التاسع والخمسین باتجاه المركز الطبی فی
هیوستن ینتابك حزن عمیق، فقبل عام من الآن فی التاسع من آب عام 2008 توفی
الشاعر محمود درویش فی غرفة العنایة المركزة فی مستشفى میموریال هیرمان
الشاخص الآن أمام عینیك، وهناك على یسارك یسترخی متنزه هیرمان الذی تمشى
فیه الشاعر قبل رحیله بأیام. إنها غیمة الحزن الدائمة هذه التی تظلنا نحن
سكان هیوستن كلما مررنا بمنطقة المركز الطبی، وكأنه جرح سیبقى فی ذاكرة
المدینة وذاكرة سكانها العرب الى الأبد، فهنا مات شاعرنا. كم كنا نتمنى أن
یغادرنا سلیماً معافى، ولكن العنایة الإلهیة شاءت أن تنتهی حیاته بین
أیدینا وفی یوم سبت، وكأنه كما الماء انساب من بین أصابعنا ولم ننتبه. لم
نكن سبباً فی وفاته، ولكننا ما زلنا، وربما سنبقى، نحمّل أنفسنا ذنباً لم
نقترفه.
من مآثر محمود الكثیرة أنه یحاصرنی فی شوارع المدن، فقبل ربع قرن أذكر أننی قابلته فجأة فی أحد شوارع موسكو فی منطقة مسارح وسط المدینة، حیث كان أحد المسارح یعلن عن تقدیم مسرحیة المحاكمة المستوحاة من روایة المحاكمة لكافكا. وعندما قرأت اسم كافكا داهمنی محمود فوراً، فقد كان السبب فی بحثی عن أدب كافكا حین ذكره فی قصیدة بیروت (1982):
(ووجدتُ كافكا تحت جلدی نائماً/ وملائماً لعباءة الكابوس، والبولیس فینا)
كان یستفزنی ویتحدانی فی قصائده للبحث عن تلك الشیفرة الثقافیة التی یستودعها فی نصوصه، مثل شیفرة كافكا: ماذا أراد أن یقول؟ ما هو المعنى فی هذا البیت؟ ما علاقة كافكا؟ بل من هو كافكا هذا؟ كنت أسأل نفسی قبل ثلاث سنوات من مداهمته لی فی شارع مسرح الاوبیریت، الأمر الذی دفعنی الى قراءة فرانز كافكا (1883 – 1924) حتى لو كان ذلك باللغة الروسیة.
وهكذا على طول رحلتی مع شعر محمود كان یتحدى ثقافتی ومعرفتی، ویجبرنی على البحث والتقصی عن الرمزیات الثقافیة التی كان یُكثّف بها معانی نصوصه، وأهمها بالنسبة لی كانت الرموز المیثولوجیة. وعلی أن أعترف الآن أمام حضور غیابه الشاهق أنه كان السبب فی شغفی المزمن بالمیثولوجیا والانثروبولوجیا والأركیولوجیا. لهذا ارتأیت أن أكتب عن رمزیة المیثولوجیا فی شعر محمود درویش بمناسبة مرور عام على رحیله، علنی أرد له بعضاً من الجمیل. ولكن قبل البدء أود أن أشیر الى بعض النقاط المهمة، الأولى هی أننی لست بصدد قراءة الرمزیة المیثولوجیة عند محمود قراءة سیاسیة كما فعل بعض النقاد فی دراسة الرمزیة التوراتیة عند محمود، لأن ما یهمنی من محمود هو الابداع الأدبی الشعری، وأنا لا أرى فی شعره بیاناً سیاسیاً وإن كان لقصائده امتداد سیاسی. والثانیة هی أننی سأستخدم مصطلح میثولوجیا كمصطلح شامل یشمل اساطیر الشعوب والقصص الفولكلوریة والدیانات. والثالثة أننی لست بصدد اعطاء نقد أدبی ینتمی الى هذه المدرسة الادبیة أو تلك، وانما بصدد عرض فهمی وانطباعی الشخصیین للرمزیة المیثولوجیة عند محمود، فأنا أصلاً لست متخصصاً فی الأدب وإنما فی أبعد ما یكون عن الأدب: المعادلات التفاضلیة والهندسة والمیاه والبیئة.
فی احدى المقابلات سُئل محمود عن كیفیة قراءته للتوراة فأجاب بأنه "لا ینظر الى التوراة نظرة دینیة وانما یقرأها كعمل أدبی ولیس دینیاً او تاریخیاً". وهنا یكون محمود قد وضع قدمه على المسار الصحیح فی التعامل مع الكتاب المقدس خصوصاً والأدیان والمیثولوجیا عموماً، حیث بامكاننا القول أنه ینتمی الى مدرسة المُقلّین التی ینتمی الیها أصحاب كوبنهاغن وعلى رأسهم استاذ الكتابیات توماس تومسون. وهذا المسار یجعل من محمود مثقفاً وأدیباً بامتیاز كون الأدب یبدأ من ملحمة جلجامش حیث بدأت الحضارة فی سومر، وما الأدب سوى اعادة انتاج المیثولوجیا باستمرار، إنه اعادة التألیف أو التولیف كما یقولون. ولهذا عندما یتحدث محمود فی شعره عن رمزیة میثولوجیة ما فهو لا یتحدث عنها لیتقرب من أصحابها ویتودد الیهم كما ذهب بعض النقاد، وإنما لأنه یُعید تولیف الحكایة بتكثیف المعنى المكتنز فی الرمزیة المیثولوجیة لما تتمتع به من قوة ساحرة وآسرة كونها جاءت من نتاج جمعی قامت به جماعة ما على مدى فترة زمنیة طویلة نسبیاً.
[*الرمزیة التوراتیة *]
إذا ما أردنا أن نتتبع الرمزیة المیثولوجیة عند محمود حسب التصاعد الزمنی لأعماله الشعریة نجد أنه وظفها فی بدایاته الأولى فی مجموعته الشعریة عاشق من فلسطین (1966) فی قصیدة أبی، حیث یقول:
"فی حوارٍ مع العذاب/ كان أیوبُ یشكرُ/ خالقَ الدودِ والسحاب"
حیث نلاحظ هنا أنه كان مطلعاً على الكتاب المقدس، فأیوب الذی یتحدث عنه محمود هو أیوب التوراتی بدلیل استخدامه لكلمة دود التی ترد فی سفر أیوب فی الاصحاح السابع، ولا عجب فی ذلك ففی تلك الفترة كان محمود یعیش فی داخل الأرض المحتلة وكان بحكم دراسته خاضعاً لمنهاج اسرائیل وبرامجها التی كانت تعلم الطلاب أسفار العهد القدیم باللغة العبریة، كما صرح محمود فی احدى مقابلاته. ولكن ما یهمنا هنا هو أن محمود یتعامل مع النص التوراتی فی سفر أیوب معاملة أدبیة، فهو یرى فیه نصاً أدبیاً یعالج ثیمة الصبر والابتلاء والخلاص بالإیمان، فیفكك الشاعر النص من التوراة ویعید تركیبه فی قصیدته بحكم تشابه المعاناة التی یعیشها الشاعر بالمعاناة التی عاشها أیوب (او ما یسمى أدبیاً بالتناص)، وكأنه یعید تولیف الحكایة، لأنه كان واعیاً بأن القصة التوراتیة نفسها لم تكن سوى اعادة تولیف من أدب سابق على العهد القدیم، فاستاذ السومریات، كرامر، قد قام بترجمة صلاة سومریة قدیمة تشبه قصة أیوب، هذه الصلاة السومریة تتحدث عن ما أصبح یُعرف بأیوب البابلی. ولكن لماذا اختار الشاعر توظیف رمزیة ایوب المیثولوجیة؟ الجواب فی نظری هو لما تتمتع به هذه الرمزیة من قوة ساحرة وآسرة، فهی من ناحیة معروفة للكبیر والصغیر بحكم اعادة تولیفها مسیحیاً واسلامیاً وفولكلوریاً، ومن ناحیة ثانیة فإن كثافتها الدلالیة وفرت على محمود الكثیر من الجهد لعرض معاناته، أو كما یقول نقاد الأدب جنّبته الحشو والضجیج اللغوی، فأوصل المعنى المراد بأقصر الطرق وأبلغ الدلالات. هذا بالإضافة الى حمل معاناته الشخصیة والوطنیة الى مستوى العالمیة والانسانیة كون رمزیة أیوب رمزیة عالمیة.
فی مجموعته العصافیر تموت فی الجلیل (1969) فی قصیدة ضباب على المرآة یستضیف محمود النبی إرمیا من التوراة فی عملیة تناص شائكة بعض الشیء تنم عن عمق معرفی بالعهد القدیم:
"لم أجد جسمكِ فی القاموس/ یا مَن تأخذین/ صیغة الأحزان من طروادة الأولى/ ولا تعترفین/ بأغانی إرمیا الثانی.."
فرغم وضوح التناص بین احتلال القدس الفلسطینیة وبین سقوط طروادة الاغریقیة إلا أن هویة إرمیا الثانی تبدو مربكة بعض الشیء، لولا أن الشاعر أسعفنا بإشارته الى الأحزان، وكأنه یتحدث عن مراثی إرمیا، وهی مراثی تبكی سقوط اورشلیم فی قبضة البابلیین عام 586 ق.م. تم جمعها فی نهایة سفر النبی ارمیا كونها لیست لإرمیا نفسه، ولهذا استخدم محمود اسم إرمیا الثانی، وهو تناص داخلی، إن صح التعبیر، مع اشعیا الثانی كما هو معروف لدى فقهاء الكتاب المقدس (بعكس مصطلح ارمیا الثانی الذی لا یستخدمه علماء الكتاب المقدس، بل نحته محمود على ما یبدو من عملیة تناص داخل التوراة نفسها). لقد استفاد الشاعر من رمزیة طروادة ومراثی إرمیا لیُغنی المعنى المراد من النص بكثافة التثاقف أولاً وببلاغة البیاض المتروك للقارئ العارف بقصة كل من حروب طروادة والسبی البابلی ثانیاً.
وبما أننا تطرقنا لذكر النبی أشعیا فلا بد لنا من استعراض توظیف رمزیته فی قصائد محمود، حیث یقول فی قصیدة بیروت (1983):
"أنادی أشعیا/ أخرجْ من الكتب القدیمة مثلما خرجوا/ أزقة أورشلیم تعلّق اللحم الفلسطینی فوق مطالع العهد القدیم/ وتدّعی أن الضحیة لم تغیر جلدها/ یا أشعیا لا ترثِ/ بل أهجُ المدینة كی أحبك مرتین"
ولا شك أن شغف محمود بإرمیا وأشعیا له ما یبرره، فهما من أنبیاء الحصر المحوری كما یقول فقهاء الكتاب المقدس، وقد أحدثا ثورة لاهوتیة فی الفكر الیهودی، وذلك بتطویر مفهوم الألوهة، فلم یعد الإله الاسرائیلی یهوة إلهاً قبلیاً عسكریاً (رب الجنود)، بل أصبح شبیهاً بالله الكونی المحب لجمیع البشر. فهل هذا ما قصده محمود بقوله "اخرج من الكتب القدیمة"؟. إن استضافة محمود لإرمیا وأشعیا تعنی فی ما تعنی رفضه للعسكرة والحروب المقدسة التی تشن باسم الدین والآلهة تماماً كما رفض إرمیا وأشعیا الحروب. وكما فی التناص السابق مع إرمیا یعقد الشاعر هنا تناصاً بین سقوط أورشلیم وبین حصار بیروت، ففی كلا الحالتین دفع الفلسطینی الثمن، لهذا یدعو محمود النبی إشعیا أن لا یرثی أورشلیم كما فعل فی سفره بل یدعوه الى أن یهجو أورشلیم الآثمة (حسب أشعیا) التی تسببت بإثمها بتعلیق اللحم الفلسطینی مرتین (حسب محمود)، مرة فی زمن أشعیا، ومرة فی حصار جیش الاحتلال "الأورشالیمی" لبیروت فی زمن محمود.
ثیمة الاحتلال والتهجیر والأسر (السبی) تأخذ من محمود الكثیر من العنایة فی قصائده، فهو یستحضر قصة السبی البابلی فی عملیة اسقاط على الحاضر، یقول الشاعر فی مجموعة أحبك أو لا أحبك (1972):
"ونغنی القدسَ/ یا أطفال بابلْ/ یا موالید السلاسل/ ستعودون الى القدس قریباً/ وقریباً تكبرون/ وقریباً تحصدون القمح من ذاكرة الماضی/ قریباً یصبح الدمع سنابل/ آه یا أطفال بابل"
فلم یقل الشاعر: ونغنی القدس یا أطفال القدس او فلسطین، بل قال یا أطفال بابل، وهی عملیة قفز فوق الزمن باستحضار الماضی حیث هُجّر أبناء یهودا الكنعانیة الى بابل، وكذا حال الفلسطینی المعاصر. وبما أن أبناء یهودا عادوا من السبی البابلی كذلك سیعود أبناء فلسطین لأنهم سیحصدون القمح من ذاكرة الماضی. والشاعر نفسه عانى من التهجیر والأسر (الاعتقال)، فكان توظیف رمزیة السبی الى بابل خیر تعبیر عن مأساة الشاعر وشعبه. ولا أظن أن محمود قد فاته أن الاسرائیلی المعاصر لا علاقة له بیولوجیاً بأبناء یهودا اللذین تم سبیهم الى بابل، فهو كان واعیاً تماماً لحقیقة أن تاریخ یهودا وثقافتها جزء من التاریخ الفلسطینی وثقافته، كما هو واضح من قوله فی قصیدة بیروت (1983):
"وأحملُ أرضَ كنعان التی اختلف الغزاة على مقابرها/ وما اختلف الرواةُ على الذی اختلف الغزاة علیه"
ففی هذا النص یبدو محمود واعیاً للثقافة الكنعانیة الشاملة وأن الرواة (التألیف والتولیف) لم یختلفوا على ثقافة أرض كنعان، بل الخلاف جاء من تسییس الروایات لصالح مشروع سیاسی استیطانی (الغزاة). وما یؤكد هذا الاستنتاج قول الشاعر فی مجموعة العصافیر تموت فی الجلیل (1969) فی قصیدة بعنوان المزمور الحادی والخمسون بعد المئة:
"والمزامیر صارت حجارة/ رمونی بها/ وأعادوا اغتیالی/ قرب بیارة البرتقال/ صار جلدی حذاء/ للأساطیر والأنبیاء"
فالشاعر یتعامل مع مزامیر داود على أنها مزامیره ومزامیر شعبه، بمعنى أنها من منتجات الثقافة الكنعانیة وإن تم نسبها توراتیاً الى النبی داود، فهذا النسب لیس إلا من أساطیر الأنبیاء، أو هو إعادة تولیف النص الأدبی الكنعانی القدیم، فمن المعروف من الاكتشافات الأثریة فی الساحل الكنعانی الكبیر (من شمال سوریا الى جنوب فلسطین) أن مزامیر داود لیست إلا ابتهالات وأغانی فولوكلوریة كنعانیة قدیمة، وحتى رافدیة تم اكتشاف مثلها فی العراق. إن تعامل الشاعر مع النصوص التوراتیة على أنها نصوص ثقافته واضح فی قوله فی قصیدة شتاء ریتا من مجموعة أحد عشر كوكباً (1992):
"لی حصةٌ من مشهد الموج المسافر مع الغیوم، وحصةٌ/ من سفر تكوین البدایة، حصةٌ من سفر أیوب، ومن/ عید الحصاد"
فهو هنا یجمع سفرین من العهد القدیم، التكوین وأیوب، وعید الحصاد الكنعانی. ویتضح لنا أكثر كیف أن محمود یتعامل مع النصوص الدینیة على أنها نصوص أدبیة یُعید العقل الجمعی إعادة انتاجها باستمرار. یقول محمود بهذا الصدد: "إن النضج الأدبی هو أن نتذكر أسلافنا وأن نشعر بأن وراء هذا النص الشعری أسلافاً.. فی كل شاعر تاریخ الشعر منذ الرعویات الشفهیة الى الشعر المكتوب، من الشعر الكلاسیكی الى الشعر الحدیث". كما یجدر بنا التأكید هنا على عمق معرفة محمود بالكتاب المقدس، فالمزامیر عددها مائة وخمسون مزموراً، الأمر الذی دفع محمود الى تسمیة قصیدته هذه بالمزمور الحادی والخمسون بعد المئة، وكأن الشاعر یصر على التعامل الأدبی مع الكتاب المقدس، فهو من ناحیة یعتبر هذه المزامیر انتاجاً جمعیاً لأجداده الكنعانیین، ومن ناحیة أخرى ها هو الشاعر نفسه یشارك فی هذا الانتاج فیضیف مزموراً جدیداً لمجموعة المزامیر. هذا الوعی الدرویشی بالأدب الكنعانی یقوله محمود بصراحة فی قصیدة مأساة الفضة وملهاة النرجس من مجموعة أرید ما أرید (1990):
(توراة كنعان الدفینة تحت أنقاض الهیاكل بین صور وأورشلیم)
فالتوراة بالنسبة لمحمود عمل أدبی كنعانی یُعید تولیف الحكایات الكنعانیة إیاها مع التركیز على نفس الثیمات والموتیفات الأدبیة التی كانت وما زالت تشغل الحیز الأكبر من فكر الإنسان وانتاجه الدینی الجمعی، إلا أن الشاعر یرفض خطف هذا الأدب الكنعانی من قبل جماعة دینیة معینة، لذلك استخدم كلمة "أنقاض الهیاكل" وما یعنیه ذلك من انهیار عملیة الخطف هذه وانفضاح أمرها، مع الإشارة الى ما تحمله الكلمة من عمل أركیولوجی. وهذا ما یؤكد على علو شأن الرمزیة عند محمود وقوتها، فاستخدامه لـ"أنقاض الهیاكل" كان موفقاً بامتیاز نظراً للإحتقان الهائل للرمز فیها. ولا یكاد القاریء یلتقط أنفاسه من هذه الرمزیة حتى ینهال علیه الشاعر برمزیة أخرى لا تقل إحتقاناً، إنها الثنائی صور وأورشلیم، فمن ناحیة تفصح هذه الثنائیة عن كنعانیة التوراة، ومن ناحیة ثانیة عن كنعانیة الهیكل الأوشلیمی الذی بناه مهندسو صور الكنعانیة (سأتجنب هنا استعمال مصطلح فینیقیا كونه مسمى إغریقی لبلاد كنعان). هذا الوعی نراه أیضاً فی نفس المجموعة الشعریة فی قصیدة ربّ الأیائل یا أبی ربّها، حیث یقول الشاعر:
"فانهضْ یا أبی من بین أنقاض الهیاكل، واكتبْ/ اسمكَ فوق خاتمها كما كتبَ الأوائل، یا أبی، أسماءَهم"
فمحمود هنا یستعمل رمزیة الأب بما تحمله من معانی الجذور المترسخة، داعیاً هذه الجذور أن تنفض عنها ركام الهیاكل لتتضح الحقیقة. وسیدخل محمود فی صراع على ذاكرة المكان كما سیمر معنا لاحقاً.
وتجاوز محمود رمزیة الهیكل الى توظیف رمزیة سلیمان فی قصائده، ففی قصیدة خطبة الهندی الأحمر من مجموعة أحد عشر كوكباً، یقول الشاعر على لسان الهندی الأحمر مخاطباً السید الأبیض:
".. وأشعار كنعان والبابلیین، تنقصُكُم/ أغانی سلیمان عن شولمیت.."
فأغانی سلیمان بالنسبة لمحمود لیست إلا من أشعار الشرق الأوسط القدیم (كنعان وبابل)، وهو هنا یشیر الى سفر نشید الأناشید الذی لسلیمان من العهد القدیم من الكتاب المقدس، وهی مجموعة من أناشید الحب والغزل العذری والفاحش تذكّر علماء المیثولوجیا بأغانی الكنعانیین المعنیة بالخصب، فسلیمان یبدو كإله خصب (بعل الكنعانی) وشولمیت (صیغة المؤنث لسلیمان لغویاً) تبدو إلهة الخصب المؤنثة. وقد اكتشف علماء الآثار صلوات كنعانیة فی أوغاریت تتطابق مع بعض أناشید سلیمان. إلا أن الشاعر یتجاوز استخدام رمزیة سلیمان الثقافیة الكنعانیة الى حالة من التناص الخاص بینه وبین سلیمان فی معرض تفكیر الشاعر بمعنى الموت والحیاة والوجود فی مُطولته الرائعة "الجداریة" (1999)، حیث یبدو محمود مغرماً بسفر الجامعة المنسوب أیضاً لسلیمان، وهو مجموعة من الحكم، یقول الشاعر:
"وكل شیء باطلٌ أو زائل، أو/ زائل أو باطل/ من أنا؟/ أنشیدُ الأناشید/ أم حكمةُ الجامعة؟/ وكلانا أنا../ وأنا شاعرٌ/ وملِك/ وحكیمٌ على حافة البئر"
فمحمود فی الجداریة حین "طار به الموت نحو السدیم" على حد تعبیره یستدعی حكمة سلیمان فی سفر الجامعة، فقد كان سلیمان ملكاً وحكیماً وشاعراً ووصل الى ذروة المجد، إلا أنه فی النهایة اعترف بأن كل شیء باطل وزائل: "باطل الأباطیل یقول الحكیم. باطل الأباطیل، كل شیء باطل" (سفر الجامعة، 1 – 2). وكذلك محمود فی تجربته مع الموت اختار حكمة سلیمان، لهذا یستعمل جملة "باطل، باطل الأباطیل باطل" كلازمة یعید تكرارها فی القصیدة تماماً كما هو الحال فی سفر الجامعة. ویتعمق محمود فی سفر الجامعة أكثر ویعید تولیف بعض من نصوصه بما یخدم تصوره الخاص، وكأنه یشارك فی نسج ثوب الحكمة الشرق أوسطیة، فنراه یقول فی الجداریة:
"عشتُ كما لم یعش شاعر/ ملكاً وحكیماً../ هرمت، سئمت من المجد/ لا شیء ینقصنی/ ألهذا إذاً/ كلما زاد علمی/ تعاظم همّی؟/ فما اورشلیم وما العرش؟/ لا شیء یبقى على حاله/ للولادة وقت/ وللموت وقت/ وللصمت وقت/ وللنطق وقت/ وللحرب وقت/ وللصلح وقت/ وللوقت وقت/ ولا شیء یبقى على حاله../ كل نهر سیشربه البحر/ والبحر لیس بملآن/ لا شیء یبقى على حاله/ كل حی یسیر الى الموت/ والموت لیس بملآن/ لا شیء یبقى سوى اسمی المَذهّب/ بعدی: / "سلیمانَ كان".. / فماذا سیفعل موتى بأسمائهم/ هل یضیء الذهب/ ظلمتی الشاسعة/ أم نشید الأناشید/ والجامعة؟"
هكذا یتعامل محمود مع التوراة والكتب المقدسة تعاملاً أدبیاً، فیرى فیها تولیفات (روایات) قامت بها الجماعة للتعبیر عن همومها وانشغالاتها، وهذه التولیفات لیست إلا اعادة انتاج روایات میثولوجیة سابقة علیها، لهذا اعتبر محمود التوراة جزءاً من تراثه، ورأى أن من مهمته كشاعر ینتمی لأرض فلسطین أن یشارك فی اعادة تولیف الروایات، فكانت الاقتباسات والرمزیات التوراتیة جزءاً من عملیة إعادة التولیف هذه.
[*الرمزیة المسیحیة والاسلامیة *]
فی قصیدة الجداریة وأمام تجربة الموت الرهیبة یقف محمود بین تجربة السید المسیح علیه السلام وتجربة سلیمان الحكیم، فیختار حكمة سلیمان كما مر معنا أعلاه، ربما لأنه وجد صعوبة فی اختیار تجربة قیامة المسیح، ولهذا نراه یقول:
"مثلما سار المسیحُ على البحیرة/ سرتُ فی رؤیایَ. لكنی نزلتُ عن/ الصلیب لأننی أخشى العلوّ، ولا/ أبشّرُ بالقیامة.."
فتجربة محمود بشریة، بعكس تجربة المسیح الإلهیة، لهذا یقول الشاعر فی نفس القصیدة نافیاً عن نفسه امكانیة الخلود على طریقة المسیح:
"وانتظرْ/ ولداً سیحمل عنك روحك/ فالخلود هو التناسل فی الوجود"
ومما لا شك فیه أن شخصیة السید المسیح لها حضور كبیر فی قصائد محمود، فالتشابه كبیر بینهما، فكلاهما من الجلیل، وكلاهما تعرض للإضطهاد، وكلاهما رأى فی الفداء خلاصاً، ولهذا نجد رمزیة المسیح فی قصائد محمود المبكرة، ففی قصیدة قال المغنی من مجموعة عاشق من فلسطین (1966) یقول الشاعر:
"المغنی على صلیب الألم/ جرحه ساطع كنجم/ قال للناس حوله/ كلّ شیء.. سوى الندم/ هكذا متّ واقفاً/ واقفاً متّ كالشجر/ هكذا یصبح الصلیب/ منبراً او عصا نغم/ ومسامیره وتر"
بهذه الطریقة یعید محمود تولیف الحكایة فی عملیة تناص بین فداء المسیح من أجل الخلاص وبین الموت وقوفاً من أجل النصر. إلا أنه بعد سقوط القدس عام 1967 یصبح لمعنى الصلیب بعداً آخراً هو المحبة والعطاء والخیر، كما هو فی قصیدة أغنیة حب على الصلیب من مجموعة آخر اللیل (1967) التی یخاطب فیها مدینة القدس أو مدینة كل الجروح الصغیرة كما یقول فی مطلع القصیدة:
"أحبكِ، كونی صلیبی/ وكونی، كما شئتِ، برجَ حمام/ إذا ذوّبتنی یداك/ ملأت الصحارى غمام"
عملیة التولیف الشعری تنهال على محمود بغزارة فی قصیدة مدیح الظل العالی (1983) التی كتبها عن حصار بیروت، وكأن قساوة الحصار والحرب قد أخرجته عن طوره فإذا بالتولیف وكأنه وحی ینزل علیه من السماء، وذلك بتولیف قرآنی من سورة العلق وانجیلی عن المسیح الفادی الذی سیهدم هیكل جسده ویبنیه فی ثلاثة أیام:
"الله أكبر/ هذه آیاتنا فاقرأ/ باسم الفدائی الذی خلقا/ من جرحه شفقا/ باسم الفدائی الذی یرحل/ من وقتكم.. لندائه الأول/ الأولِ الأول/ سندمر الهیكل/ باسم الفدائی الذی یبدأ/ اقرأ.. / بیروت صورتنا/ بیروت سورتنا"
التولیف القرآنی من سورة یوسف والكتابی من سفر التكوین نجده عند محمود فی قصیدة أخرى بحكم التناص بین قضیته وقضیة شعبه التی تخلى عنها العرب وبین تخلی أبناء یعقوب عن أخیهم الصغیر یوسف بعد أن غدروا به وأودعوه البئر، یقول الشاعرفی قصیدة أنا یوسف یا أبی من مجموعة ورد أقل (1986):
"أنا یوسف یا أبی، یا أبی اخوتی لا یحبوننی، لا یریدوننی بینهم یا أبی، یعتدون علی ویرموننی بالحصى والكلام، یریدوننی أن أموت لكی یمدحوننی، وهم أوصدوا باب بیتك دونی، وهم طردونی من الحقل، هم سمموا عنبی یا أبی... فماذا فعلت أنا یا أبی، ولماذا أنا؟، أنت سمیتنی یوسفاً، وهمو أوقعونی فی الجب، واتهموا الذئب، والذئب ارحم من اخوتی.. أبتِ! هل جنیت على أحد عندما قلت انی: رأیت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر، رأیتهم لی ساجدین"
وفی مرحلة ما بعد بیروت حین یحس الشاعر بأن الكل قد تخلى عنه وعن قضیة شعبه یبدأ حواراً مع الله فینهل من الرموز الانجیلیة كقول المسیح على الصلیب قبل أن یلفظ الروح، فی قصیدة إلهی لماذا تخلیت عنی؟ من مجموعة ورد أقل:
"الهی.. الهی.. لماذا تخلیت عنی؟ لماذا تزوجت مریم؟ لماذا وعدت الجنود بكرمی الوحید.. لماذا؟ أنا الأرملة/ أنا بنت هذا السكون، أنا بنت لفظتك المهملة/ لماذا تخلیت عنی؟ الهی، إلهی لماذا تزوجت مریم؟"
ویسأل الشاعر الله كما سأله المسیح بأن لا یبعد عنه كأس الموت فی قصیدة یطول العشاء الأخیر من نفس المجموعة:
"یطول العشاء الأخیر، تطول وصایا العشاء الأخیر/ أبانا الذی معنا كن رحیماً بنا، وانتظرنا قلیلاً، أبانا/ ولا تبعد الكأس عنا/ تمهل لنسأل أكثر مما سألنا"
إلا أن الشاعر فی مزاج آخر فی قصیدة كتب فیها عن هاجس العودة الى الوطن یحتفی بعودة المسیح ومریم الى العشاء الذی یریده الشاعر أن یُنهی الاحتلال، یقول فی القصیدة الملحمة "مأساة الفضة ملهاة النرجس" من مجموعة أرید ما أرید (1990):
"عاد المسیحُ الى العشاء، كما نشاء، ومریمٌ عادتْ إلیه/ على جدیلتها الطویلة كی تغطی مسرحَ الرومان فینا"
وفی قصیدة الجداریة فی بحث الشاعر عن معنى الخلود یستحضر امتحان الشیطان للسید المسیح كما ورد فی الأناجیل، ولكنه یُسقط هذه الحكایة على نفسه حین كان بین الموت والحیاة، وكأن الاختبار كان له:
"أعلى من الأغوار كانت حكمتی/ إذ قلتُ للشیطان: لا، لا تمتحنّی/ لا تضعنی فی الثنائیات، واتركنی/ كما أنا زاهداً بروایة العهد القدیم/ وصاعداً نحو السماء، هناك مملكتی/ خُذ التاریخ، یا ابن أبی، خذ/ التاریخَ.. واصنع بالغرائز ما تریدُ"
وكما فی الرمزیة التوراتیة فإن محمود ینهل من الرموز المسیحیة والاسلامیة فی عملیة تناص یعید من خلالها كتابة السردیة الشعریة الشرق أوسطیة بما یلائم حاضره وأمانی مستقبله مرتكزاً على الثیمات والموتیفات نفسها، وكأن الحكایة هی نفس الحكایة ولم یتغیر شیء سوى الزمن.
[*الرموز العربیة والرافدیة والمصریة والكنعانیة *]
فی نفس القصیدة السابقة یجمع محمود فی أسطر قلیلة ثقافة شرق المتوسط فی مشهد تخیلی یفترض أن العائدین الى فلسطین یستعیدونه مع عودتهم، إنها تقنیة لربط الاستعادة المادیة بالاستعادة الثقافیة لیغلق الخارطة من النیل الى الفرات:
".. واستعادوا/ ما ضاع من قاموسهم: زیتون روما فی مخیلة الجنود/ توراة كنعان الدفینة تحت أنقاض الهیاكل بین صور وأورشلیم/ وطریق رائحة البخور الى قریش تهبّ من شام الورود/ وغزالة الأبد التی زُفّت الى النیل الشمالی الصعود/ والى فحولة دجلة الوحشی وهو یزف سومرَ للخلود"
هكذا یتنقل الشاعر بین رمزیات الشرق الأوسط القدیم غیر عابئ بالزمن الذی ینحل بین یدیه، فیستدعی ثقافة الأمة من العراق الى مصر وما بینهما، ویدعو القاریء لأن یستعید معه هذه الثقافة، لأن العودة لا تكتمل إن كانت فیزیائیة، بل لا بد لها من استعادة ثقافیة لتكتمل.
فی قصیدته الرائعة بعنوان رحلة المتنبی الى مصر من مجموعة حصار لمدائح البحر (1984) یعقد الشاعر تناصاً بین حاضره وبین الماضی العربی غیر البعید، فیستحضر حكایة المتنبی مع كافور مُطرزاً القصیدة برموز تاریخیة عربیة اسلامیة، حیث یشبه نفسه تارةً بالمتنبی وتارةً بالقرمطی، وكأنه یرثی حال مصر والأمة معها:
"قد جئتُ من حلبٍ، وإنی لا أعود الى العراق/ سقطَ الشمالُ فلا ألاقی/ غیر هذا الدرب یسحبنی الى نفسی.. ومصر/ .. أمشی الى نفسی فتطردنی من الفسطاط../ .. لا مصر فی مصر التی أمشی الى أسرارها/ فأرى الفراغ، وكلما صافحتُها/ شقتْ یدینا بابلُ/ فی مصر كافورٌ وفیّ زلازل/.. هل تتركین النیلَ مفتوحاً/ لأرمی جثتی فی النیل؟/ لا، لن یستبیح الكاهن الوثنی زوجاتی/ ولا، لن أبنی الأهرام ثانیة، ولا/ .. والقرمطی أنا، ولكن الرفاق هناك فی حلبٍ/ أضاعونی وضاعوا.."
إنها نفس الخارطة الجغرافیة الشعریة یرسمها الشاعر فی فترتین زمنیتین مختلفتین من التاریخ العربی، الأولى فی الزمن المیثولوجی الغابر، والثانیة فی الزمن الحقیقی القریب. ولكن ضمن نفس الحدود ما بین مصر والعراق وبلاد الشام. وفی مجموعة سریر الغریبة (1999) یحرر محمود المرأة من رمزیة الوطن فی شعره ویتعامل معها كإمرأة لا أكثر، وفی هذه المجموعة یعقد حواراً مع جمیل بثینة ومع مجنون لیلى فی قصیدتین منفصلتین باحثاً عن معنى الحب عند العرب:
"هل تشرح الحبَ لی ، یا جمیلُ/ لأحفظه فكرةً فكرة؟/ أعرفُ الناس بالحب أكثرهم حیرةً/ فاحترق، لا لتعرف نفسك، ولكن/ لتُشعلَ لیلَ بثینة.."
فی نفس المجموعة یرحل الشاعر عمیقاً فی الزمن فی البحث عن معنى الحب فی الشرق الأوسط القدیم، فیصل الى إنانا، إلهة السومریین، لیجد معنى الحب فی الخصب او فی زفاف السماء والأرض المقدس:
"فلیصقُل الثورُ، ثورُ العراق/ المُجنّح قرنیه بالدهر والهیكل المتصدع/ فی فضة الفجر. ولیحمل الموتُ آلته/ المعدنیة فی جوقة المنشدین القدامى/ لشمس نبوخنصّر. أما أنا، المتحدر/ من غیر هذا الزمان، فلا بد لی/ من حصان یلائم هذا الزفاف. وإن كانَ/ لا بدّ من قمرٍ فلیكن عالیاً.. عالیاً/ ومن صنع بغداد، لا عربیاً ولا فارسیاً/ ولا تدّعیه الإلهات من حولنا. ولیكن خالیاً/ من الذكریات وخمر الملوك القدامى/ لنُكمل هذا الزفاف المقدس، نكمله یا ابنةَ/ القمر الأبدی هنا فی المكان الذی نزّلتهُ/ یداكِ على طرف الأرض من شرفة الجنة الآفلة"
مفهوم الخصوبة، او زفاف الآلهة المقدس، یؤكد علیه محمود فی الثقافة الكنعانیة أیضاَ حیث یستدعی، عناة، إلهة الخصب الكنعانیة، حیث یقول فی الجداریة:
"فغنّی یا إلهتی الأثیرة، یا عناةُ/ قصیدتی الأولى عن التكوین ثانیةً"
مبیناً دور عناة فی استمرار التكوین، او دورات الخصب، حین یتحدى الموت قائلاً له فی نفس القصیدة:
"فماذا یفعل التاریخ، صنوُكَ او عدوك/ بالطبیعة عندما تتزوج الأرضَ السماءُ/ وتذرفُ المطرَ المقدس؟"
عناةُ الكنعانیة هذه سیهیم الشاعر بحبها فی نفس الجداریة لدرجة العبادة مستخدماً مصطلحاً قرآنیاً ولا أجمل "یممتُ وجهی شطرَ" وما یحمله من معانی التعلق والقداسة والعبادة، ولكنه یمم وجهه شطر كنعان، بلاد الإرجوان:
"كلما یممتُ وجهی شطرَ آلهتی/ هنالك، فی بلاد الأرجوان أضائنی/ قمرٌ تُطوّقهُ عناةُ، عناةُ سیدةُ/ الكنایة فی الحكایة.."
فمحمود هنا سومری وكنعانی یشارك فی نسج ثقافة المنطقة بشعره بعملیات اعادة تولیف الملاحم السومریة والكنعانیة، وكأنها مشاركة منه فی النقاش الثقافی حول ثیمات مثل الحب والخصب والموت والحیاة والخلود. وفی نفس الجداریة فی بحثه عن الموت والخلود یستضیف أوزیریس الفرعونی والسید المسیح على قاعدة البعث من الموت، وكأن الشاعر یرید أن یؤكد لنا أن هذه الروایات لیست إلا توالیف لا نعرف مُؤلفها الحقیقی الأولانی، وإنما نقوم كشعب شرق أوسطی بإعادة التولیف لإبراز المعنى والمفهوم:
".. من أنا فی الموت/ بعدی؟ من أنا فی الموت قبلی/ قال طیفٌ هامشی: كان أوزیریسُ/ مثلكَ، كان مثلی. وابنُ مریم/ كان مثلكَ. كان مثلی.."
یجد محمود فی ملحمة جلجامش السومریة، التی یعود تاریخها الى مدینة أوروك فی الألف الثالثة قبل المیلاد، مادةً غنیة لمناقشة ثیمة الموت والخلود فی قصیدة الجداریة، وكأنه یشارك فی اضافات (تولیفات) على هذه الملحمة التی خضعت عبر الزمن الى الكثیر من الاضافات عبر العصور حتى وصلت الى بابل الكلدانیة. فجلجامش ملك اوروك مولود من الإلهة ننسون التی حملت به من ملك أوروك لوجلیندا، فكان ثلث جلجامش بشراً وثلثاه إلهاً. ولكنه كان مشغولاً بتجاوز الموت الى الخلود، فصاحبَ الوحش البری أنكیدو، ومضیا الى غابة حیث سر الخلود. ووصلا إلیها، وظن جلجامش أنه أمسك بسر الخلود. إلا أن الآلهة قررت موت أنكیدو، فمات بین یدی جلجامش الذی اكتشف أن الموت حق وأن الخلود یكمن فی أعمال الانسان:
".. أنكیدو! خیالی لم یعُد/ یكفی لأكملَ رحلتی. لا بدّ لی من/ قوة لیكون حلمی واقعیاً. هاتِ/ الدمعَ، أنكیدو، لیبكی المیتُ فینا/ الحیَّ . ما أنا؟ من ینامُ الآن/ أنكیدو؟ أنا أم أنتَ؟.."
وهكذا أدخل الشاعر نفسه فی نفس التجربة وهو بین حدود الوجود والعدم، ولكنه یخلص لمفهوم الخلود، وكأنها اضافة درویشیة رائعة للملحمة السومریة:
"هزمتكَ یا موتُ الفنونُ جمیعها/ هزمتكَ یا موتُ الأغانی فی بلاد/ الرافدین. مسلّةُ المصریّ/ مقبرةُ الفراعنة/ النقوش على حجارة معبدٍ هزمتكَ/ وانتصرتْ، وأفلتَ من كمائنكَ/ الخلودُ..."
[*الصراع على ذاكرة المكان *]
كان محمود واعیاً للصراع الثقافی على أرض فلسطین بین الذاكرة الفلسطینیة وبین المشروع الثقافی الصهیونی الذی ما انفكّ الى الآن یحاول تجییر ثقافة الأرض لصالحه عبر ربطها بالتوراة من جهة وربط المشروع الصهیونی بیهودا الكنعانیة وثقافتها من جهة أخرى (بما فیها الكتاب المقدس نفسه)، ففی إحدى مقابلاته یقول محمود: "یأخذنی شعوری الى أن الصراع بیننا لیس عسكریاً فقط وأننا نحن مدفوعون الى صراع ثقافی عمیق"، لهذا نجده ومنذ وقت مبكر ینبه فی شعره الى هذا الصراع، فیقول فی قصیدة یومیات جرح فلسطینی التی أهداها الى الشاعرة فدوى طوقان فی مجموعة حبیبتی تنهض من نومها (1970):
"عالمُ الآثار مشغولٌ بتحلیل الحجارة/ إنه یبحث عن عینیه فی ردم الأساطیر/ لكی یُثبت أنی/ عابرٌ فی الدروب لا عینین لی/ لا حرفَ فی سِفر الحضارة"
لا شك أن محمود كان مطلعاً على علم الآثار فی فلسطین والذی كان آنذاك توراتیاً منحازاً، حیث كان جل اهتمام الباحث الآثاری العثور على أی نص او قطعة أثریة لكی یقوم بتأویلها توراتیاً بما یخدم مقولة أرض الآباء الصهیونیة، وهذا التوجه الصهیونی فی علم الآثار سرعان ما انهار مع بدایة الثمانینات من القرن العشرین بسبب الاكتشافات الآثاریة الهائلة التی تتعارض مع اطروحات المشروع الاستیطانی الصهیونی الكولونیالی وتؤكد على كنعانیة الأرض وثقافتها، فقد أكد على ذلك علماء غربیون مثل توماس تومسون فی كتابه "الماضی الخرافی" وكیث وایتلام فی كتابه "اختلاق اسرائیل القدیمة، طمس التاریخ الفلسطینی". وكما قلنا أعلاه فإن الشاعر وجد نفسه منخرطاً فی الصراع على ذاكرة المكان فی شعره، فهو فی نثریة عابرون فی كلام عابر (1987) یستند على الفعل "عبَرَ" لما یحمله من معانی البداوة والمرور الذی لا یستقر، فهم عابرون ومشروعهم كلام عابر:
"أیها المارون بین الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم فی حفرة مهجورة، وانصرفوا.."
وفی قصیدة على ساحل البحر الأبیض المتوسط من مجموعة حصار لمدائح البحر (1984) یبحث محمود عن آثار أجداده التی یعرف تماماً أنها مدفونة فی أماكن كثیرة على ساحل المتوسط:
"یا بحرَ البدایات/ یا جثتنا الزرقاء، یا غبطتنا، یا روحنا الهامد بین یافا وقرطاج/ یا ابریقنا المكسور، یا لوح الكتابات التی ضاعت/ بحثنا عن أساطیر الحضارات/ فلم نجد سوى جمجمة الانسان قرب البحر"
ففی تلك الفترة بعد حصار بیروت والخروج منها یبحث الشاعر عن جذوره ومكانه على ساحل البحر الذی حمل شعبه بعیداً، إلا أن جماجم هذا الشعب ستبقى على سواحل هذا البحر تماماً مثل جماجم الانسان الأول التی تم اكتشافها على سفوح الكرمل، والتی ستبقى شاهدة على انتماء الانسان لهذه الأرض. ففی مجموعة هی أغنیة هی أغنیة (1986) یخاطب الشاعر أصحاب المشروع الصهیونی الاستیطانی بأن لا یُتعبوا أنفسهم فی البحث الآثاری لأنهم لن یجدوا ما یدل علیهم:
"ولن تجدوا جثةً تحفرون علیها مزامیر رحلتكم فی الخرافة/ ولن تجدوا شرفةً كی تُطلّوا على الأبیض المتوسط فینا/ ولن تجدوا ما یدل علیكم.."
وفی نفس المجموعة یفضح الشاعر أعمال المشروع الاستیطانی فی تجییر ذاكرة المكان لنفسه ونفیها عن الفلسطینی:
"لصوصُ المدافن لم یتركوا للمؤرخ شیئاً یدلّ علیّ/ ینامون فی جثتی أینما طلع العشب منها، وقام الشبح/ یقولون ما لا أفكر، ینسون ما أتذكر..."
إلا أن هذا الغریب القادم مع المشروع الاستیطانی یبقى غریباً عن ثقافة هذه الأرض وذاكرتها، ولهذا فإنه یجد صعوبة فی التماهی فیها، لهذا تراه یعتمد على جمالیات السرد لكی یثبت حقه فی الأرض، فكلما كتب عن الأرض بشكل أجمل كلما استحق المكان أكثر، من وجهة نظره. ومحمود كان واعیاً لهذه المسألة، فهو یقول فی احدى مقابلاته: "الشاعر الفلسطینی لم یشعر یوماً بأنه محتاج الى تقدیم براهین على حقه بالمكان، وعلاقته بالأرض تلقائیة وعفویة ولا تحتاج الى أی إیدیولوجیا أو تبریر. الشاعر الإسرائیلی الذی یعرف كیف تمّ مشروعه وماذا كان قبل إسرائیل، والذی یعرف أیضاً ان هذا المكان له اسم آخر وسابق هو فلسطین، یبدو هذا الشاعر فی حاجة الى شحذ كل طاقته الإبداعیة من أجل امتلاك المكان باللغة كجزء مكمل للمشروع الاستیطانی". ألهذا أكثر محمود من استدعاء الرمزیات المیثولوجیة فی شعره، ودخل فی ثنایا سردیاتها لیشارك فی نسج هذه الروایات؟ وكأنه یقول للآخر: إنی لا أجد صعوبة فی الاحتفاء بعناة وبعل وإنانا وجلجامش وأوزیریس وأشعیا وأرمیا والمسیح والعذراء وغیرهم، لأنهم جزء من ثقافتی وأنا امتداد لهم، وأستطیع أن ألج روایاتهم بتلقائیة وأشاركهم فی نسج الحكایات، حكایاتنا. فلننظر الى هذا النص الدرویشی الجمیل الذی یذكرنا بملاحم الكنعانیین فی قصیدة ربّ الأیائل یا أبی ربّها من مجموعة أرید ما أرید (1990):
".. منفایَ أرضُ/ أرضٌ من الشهوات، كنعانیةٌ، ترى الأیائل والوعولْ... / لو كنتَ من حجر لكان الطقسُ آخر، یا ابن كنعان القدیم/ لكنهم كتبوا علیكَ نشیدهم لتكون أنت هو الوحید... / سرقَ المؤرخ، یا أبی لغتی وسوسنتی وأقصانی عن الوعد الإلهی/ وبكى المؤرخ عندما واجهته بعظام أسلافی.../ فانهض یا أبی من بین أنقاض الهیاكل واكتبْ/ اسمكَ فوق خاتمها كما كتب الأوائل یا أبی أسماءهم.../ وأنا حزین، یا أبی، سلّم على جدی إذا قابلتهُ/ قبّلْ یدیه نیابة عنی وعن أحفاد بعلٍ أو عناة/ واملأ له ابریقه بالخمر من عنب الجلیل أو الخلیل.."
أما الأبلغ والأجمل من هذا فی الصراع على ذاكرة المكان فهو استحضار محمود لعدة تناصّات من أمكنة مختلفة وأزمنة مختلفة لیقیم الحجة على المشروع الاستیطانی الصهیونی، ففی قصیدة خطبة الهندی الأحمر أمام الرجل الأبیض من مجموعة أحد عشر كوكباً (1992) یخاطب محمود المشروع الصهیونی عن طریق مخاطبة الهندی الأحمر للرجل الأبیض الذی استوطن فی أرضه، مستخدماً رمزیات من میثولوجیا الهنود الحمر:
"لكم ربكم ولنا ربنا، ولكم دینكم ولنا دیننا/ فلا تدفنوا الله فی كتبٍ وعدتكم بأرضٍ على أرضنا/ كما تدعون، ولا تجعلوا ربكم حاجباً فی بلاط الملك... / .. هذه الأرضُ جدّتنا/ مقدسةٌ كلها، حجراً حجراً، هذه الأرض كوخٌ/ لآلهة سكنت معنا، نجمةً نجمةً، وأضاءت لنا/ لیالی الصلاة... / ... تاریخنا كان تاریخها"
فی مجموعة أحد عشر كوكباً یبدو أن الوحی الكنعانی قد سیطر على محمود، فنراه فی معظم قصائد المجموعة مشغولاً بهذا الهم، ناسجاً قصائد كنعانیة كأنها تعود الى شاعر كنعانی مات فی أوغاریت او سفوح الكرمل او بیبلوس جبیل، وكأن ما نقرأه الآن لیس لمحمود وإنما لأحد أسلافنا الذی اكتشف مخطوطاته علماء الآثار، یقول الشاعر فی قصیدة على حجر كنعانی فی البحر المیت:
".. یا غریبُ/ علّقْ سلاحكَ فوق نخلتنا، لأزرع حنطتی/ فی حقل كنعان المقدس.. / خذ نبیذاً من جراری/ خذ صفحة من سِفر آلهتی.. وقسطاً من طعامی/ وخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوی، خذ/ صلواتٍ كنعانیة فی عید كرمتها، وخذ عاداتنا/ فی الری، خذ منا دروس البیت.../ واترك أریحا تحت نخلتها، ولا تسرق منامی... / أأتیتَ.. ثم قتلتَ.. ثم ورثتَ... / .. والأنبیاء جمیعهم أهلی، ولكنّ السماءَ بعیدةٌ/ عن أرضها، وأنا بعیدٌ عن كلامی"
هكذا یعترف محمود أن جمیع الأنبیاء هم أهله، وأن ثقافته هی امتداد لكتبهم المقدسة وطقوسهم المقدسة، لهذا قال للغریب: "خذ صفحة من سِفر آلهتی". وفی قصیدة بعنوان سنختار سوفوكلیس من نفس المجموعة یؤكد الشاعر على حقه فی هذه الطقوس:
"وإن كان هذا الخریفُ الخریفَ النهائیّ، فلنختصرْ/ مدائحنا للأوانی القدیمة، حیث حفرنا علیها مزامیرنا/ فقد حفر الآخرون على ما حفرنا مزامیرَ أخرى/ ولم تنكسر بعد... /.. كأن أناشیدنا فی الخریف أناشیدهم فی الخریف/ كأن البلادَ تُلقننا ما نقول.../ ولكن عید الشعیر لنا، وأریحا لنا، ولنا/ تقالیدنا فی مدیح البیوت وتربیة القمح والأقحوان/ سلاماً على أرض كنعان/ أرض الغزالة/ والأرجوان"
[*وفی الجداریة یعید محمود التأكید على حقه فی هذه الطقوس والأعیاد:*]
"فی عید الشعیر أزور أطلالی/ البهیة مثل وشم فی الهویة.. / وفی عید الكروم أعبّ كأساً/ من نبیذ الباعة المتجولین.. خفیفةٌ/ روحی، وجسمی مُثقلٌ بالذكریات وبالمكان"
هذه الذكریات وهذا المكان استحضرها محمود فی المشهد الافتراضی للعودة فی القصیدة الملحمة بعنوان مأساة الفضة ملهاة النرجس كما أسلفنا أعلاه:
"عادوا على أطراف هاجسهم الى جغرافیا السحر الإلهی/ والى بساط الموز فی أرض التضاریس القدیمة:/ جبلٌ على بحر/ وخلف الذكریات بحیرتان/ وساحلٌ للأنبیاء"
هذا الصراع على ذاكرة المكان یختتمه محمود فی قصیدة الجداریة كونه كان بین الوجود والعدم، فربما لأنه كان، شعریاً، على مسافة قصیرة من الموت، فقد استحضر مدینة عكا برمزیتها، كونها أجمل المدن القدیمة أو أقدم المدن الجمیلة كما قال، وعلى جسدها یكتب التاریخ كله، وكأنه یقول لأصحاب المشروع الاستیطانی: هذا هو آخر الكلام عندی:
"لدیّ ما یكفی من الماضی/ وینقصنی غدٌ../ سأسیرُ فی الدرب القدیم على/ خطایَ، على هواء البحر.../ هذا البحر لی/ هذا الهواء الرطب لی/ هذا الرصیف وما علیه/ من خطایَ وسائلی المنوی لی/ ومحطة الباص القدیمة لی.. ولی/ شبحی وصاحبه، وآنیة النحاس/ وآیة الكرسی، والمفتاح لی/ والبابُ والحراس والأجراس لی/ لی حذوة الفرس التی طارت/ عن الأسوار.. لی/ ما كان لی، وقصاصة الورق التی/ انتُزعتْ من الانجیل لی/ والملحُ من أثر الدموع على/ جدار البیت لی.. "
ویرحل الشاعر عنا، وتبقى عكا وسائر أرض كنعان وثقافة المتوسط له، فسلاماً على أرض كنعان، أرض الغزالة والأرجوان.
من مآثر محمود الكثیرة أنه یحاصرنی فی شوارع المدن، فقبل ربع قرن أذكر أننی قابلته فجأة فی أحد شوارع موسكو فی منطقة مسارح وسط المدینة، حیث كان أحد المسارح یعلن عن تقدیم مسرحیة المحاكمة المستوحاة من روایة المحاكمة لكافكا. وعندما قرأت اسم كافكا داهمنی محمود فوراً، فقد كان السبب فی بحثی عن أدب كافكا حین ذكره فی قصیدة بیروت (1982):
(ووجدتُ كافكا تحت جلدی نائماً/ وملائماً لعباءة الكابوس، والبولیس فینا)
كان یستفزنی ویتحدانی فی قصائده للبحث عن تلك الشیفرة الثقافیة التی یستودعها فی نصوصه، مثل شیفرة كافكا: ماذا أراد أن یقول؟ ما هو المعنى فی هذا البیت؟ ما علاقة كافكا؟ بل من هو كافكا هذا؟ كنت أسأل نفسی قبل ثلاث سنوات من مداهمته لی فی شارع مسرح الاوبیریت، الأمر الذی دفعنی الى قراءة فرانز كافكا (1883 – 1924) حتى لو كان ذلك باللغة الروسیة.
وهكذا على طول رحلتی مع شعر محمود كان یتحدى ثقافتی ومعرفتی، ویجبرنی على البحث والتقصی عن الرمزیات الثقافیة التی كان یُكثّف بها معانی نصوصه، وأهمها بالنسبة لی كانت الرموز المیثولوجیة. وعلی أن أعترف الآن أمام حضور غیابه الشاهق أنه كان السبب فی شغفی المزمن بالمیثولوجیا والانثروبولوجیا والأركیولوجیا. لهذا ارتأیت أن أكتب عن رمزیة المیثولوجیا فی شعر محمود درویش بمناسبة مرور عام على رحیله، علنی أرد له بعضاً من الجمیل. ولكن قبل البدء أود أن أشیر الى بعض النقاط المهمة، الأولى هی أننی لست بصدد قراءة الرمزیة المیثولوجیة عند محمود قراءة سیاسیة كما فعل بعض النقاد فی دراسة الرمزیة التوراتیة عند محمود، لأن ما یهمنی من محمود هو الابداع الأدبی الشعری، وأنا لا أرى فی شعره بیاناً سیاسیاً وإن كان لقصائده امتداد سیاسی. والثانیة هی أننی سأستخدم مصطلح میثولوجیا كمصطلح شامل یشمل اساطیر الشعوب والقصص الفولكلوریة والدیانات. والثالثة أننی لست بصدد اعطاء نقد أدبی ینتمی الى هذه المدرسة الادبیة أو تلك، وانما بصدد عرض فهمی وانطباعی الشخصیین للرمزیة المیثولوجیة عند محمود، فأنا أصلاً لست متخصصاً فی الأدب وإنما فی أبعد ما یكون عن الأدب: المعادلات التفاضلیة والهندسة والمیاه والبیئة.
فی احدى المقابلات سُئل محمود عن كیفیة قراءته للتوراة فأجاب بأنه "لا ینظر الى التوراة نظرة دینیة وانما یقرأها كعمل أدبی ولیس دینیاً او تاریخیاً". وهنا یكون محمود قد وضع قدمه على المسار الصحیح فی التعامل مع الكتاب المقدس خصوصاً والأدیان والمیثولوجیا عموماً، حیث بامكاننا القول أنه ینتمی الى مدرسة المُقلّین التی ینتمی الیها أصحاب كوبنهاغن وعلى رأسهم استاذ الكتابیات توماس تومسون. وهذا المسار یجعل من محمود مثقفاً وأدیباً بامتیاز كون الأدب یبدأ من ملحمة جلجامش حیث بدأت الحضارة فی سومر، وما الأدب سوى اعادة انتاج المیثولوجیا باستمرار، إنه اعادة التألیف أو التولیف كما یقولون. ولهذا عندما یتحدث محمود فی شعره عن رمزیة میثولوجیة ما فهو لا یتحدث عنها لیتقرب من أصحابها ویتودد الیهم كما ذهب بعض النقاد، وإنما لأنه یُعید تولیف الحكایة بتكثیف المعنى المكتنز فی الرمزیة المیثولوجیة لما تتمتع به من قوة ساحرة وآسرة كونها جاءت من نتاج جمعی قامت به جماعة ما على مدى فترة زمنیة طویلة نسبیاً.
[*الرمزیة التوراتیة *]
إذا ما أردنا أن نتتبع الرمزیة المیثولوجیة عند محمود حسب التصاعد الزمنی لأعماله الشعریة نجد أنه وظفها فی بدایاته الأولى فی مجموعته الشعریة عاشق من فلسطین (1966) فی قصیدة أبی، حیث یقول:
"فی حوارٍ مع العذاب/ كان أیوبُ یشكرُ/ خالقَ الدودِ والسحاب"
حیث نلاحظ هنا أنه كان مطلعاً على الكتاب المقدس، فأیوب الذی یتحدث عنه محمود هو أیوب التوراتی بدلیل استخدامه لكلمة دود التی ترد فی سفر أیوب فی الاصحاح السابع، ولا عجب فی ذلك ففی تلك الفترة كان محمود یعیش فی داخل الأرض المحتلة وكان بحكم دراسته خاضعاً لمنهاج اسرائیل وبرامجها التی كانت تعلم الطلاب أسفار العهد القدیم باللغة العبریة، كما صرح محمود فی احدى مقابلاته. ولكن ما یهمنا هنا هو أن محمود یتعامل مع النص التوراتی فی سفر أیوب معاملة أدبیة، فهو یرى فیه نصاً أدبیاً یعالج ثیمة الصبر والابتلاء والخلاص بالإیمان، فیفكك الشاعر النص من التوراة ویعید تركیبه فی قصیدته بحكم تشابه المعاناة التی یعیشها الشاعر بالمعاناة التی عاشها أیوب (او ما یسمى أدبیاً بالتناص)، وكأنه یعید تولیف الحكایة، لأنه كان واعیاً بأن القصة التوراتیة نفسها لم تكن سوى اعادة تولیف من أدب سابق على العهد القدیم، فاستاذ السومریات، كرامر، قد قام بترجمة صلاة سومریة قدیمة تشبه قصة أیوب، هذه الصلاة السومریة تتحدث عن ما أصبح یُعرف بأیوب البابلی. ولكن لماذا اختار الشاعر توظیف رمزیة ایوب المیثولوجیة؟ الجواب فی نظری هو لما تتمتع به هذه الرمزیة من قوة ساحرة وآسرة، فهی من ناحیة معروفة للكبیر والصغیر بحكم اعادة تولیفها مسیحیاً واسلامیاً وفولكلوریاً، ومن ناحیة ثانیة فإن كثافتها الدلالیة وفرت على محمود الكثیر من الجهد لعرض معاناته، أو كما یقول نقاد الأدب جنّبته الحشو والضجیج اللغوی، فأوصل المعنى المراد بأقصر الطرق وأبلغ الدلالات. هذا بالإضافة الى حمل معاناته الشخصیة والوطنیة الى مستوى العالمیة والانسانیة كون رمزیة أیوب رمزیة عالمیة.
فی مجموعته العصافیر تموت فی الجلیل (1969) فی قصیدة ضباب على المرآة یستضیف محمود النبی إرمیا من التوراة فی عملیة تناص شائكة بعض الشیء تنم عن عمق معرفی بالعهد القدیم:
"لم أجد جسمكِ فی القاموس/ یا مَن تأخذین/ صیغة الأحزان من طروادة الأولى/ ولا تعترفین/ بأغانی إرمیا الثانی.."
فرغم وضوح التناص بین احتلال القدس الفلسطینیة وبین سقوط طروادة الاغریقیة إلا أن هویة إرمیا الثانی تبدو مربكة بعض الشیء، لولا أن الشاعر أسعفنا بإشارته الى الأحزان، وكأنه یتحدث عن مراثی إرمیا، وهی مراثی تبكی سقوط اورشلیم فی قبضة البابلیین عام 586 ق.م. تم جمعها فی نهایة سفر النبی ارمیا كونها لیست لإرمیا نفسه، ولهذا استخدم محمود اسم إرمیا الثانی، وهو تناص داخلی، إن صح التعبیر، مع اشعیا الثانی كما هو معروف لدى فقهاء الكتاب المقدس (بعكس مصطلح ارمیا الثانی الذی لا یستخدمه علماء الكتاب المقدس، بل نحته محمود على ما یبدو من عملیة تناص داخل التوراة نفسها). لقد استفاد الشاعر من رمزیة طروادة ومراثی إرمیا لیُغنی المعنى المراد من النص بكثافة التثاقف أولاً وببلاغة البیاض المتروك للقارئ العارف بقصة كل من حروب طروادة والسبی البابلی ثانیاً.
وبما أننا تطرقنا لذكر النبی أشعیا فلا بد لنا من استعراض توظیف رمزیته فی قصائد محمود، حیث یقول فی قصیدة بیروت (1983):
"أنادی أشعیا/ أخرجْ من الكتب القدیمة مثلما خرجوا/ أزقة أورشلیم تعلّق اللحم الفلسطینی فوق مطالع العهد القدیم/ وتدّعی أن الضحیة لم تغیر جلدها/ یا أشعیا لا ترثِ/ بل أهجُ المدینة كی أحبك مرتین"
ولا شك أن شغف محمود بإرمیا وأشعیا له ما یبرره، فهما من أنبیاء الحصر المحوری كما یقول فقهاء الكتاب المقدس، وقد أحدثا ثورة لاهوتیة فی الفكر الیهودی، وذلك بتطویر مفهوم الألوهة، فلم یعد الإله الاسرائیلی یهوة إلهاً قبلیاً عسكریاً (رب الجنود)، بل أصبح شبیهاً بالله الكونی المحب لجمیع البشر. فهل هذا ما قصده محمود بقوله "اخرج من الكتب القدیمة"؟. إن استضافة محمود لإرمیا وأشعیا تعنی فی ما تعنی رفضه للعسكرة والحروب المقدسة التی تشن باسم الدین والآلهة تماماً كما رفض إرمیا وأشعیا الحروب. وكما فی التناص السابق مع إرمیا یعقد الشاعر هنا تناصاً بین سقوط أورشلیم وبین حصار بیروت، ففی كلا الحالتین دفع الفلسطینی الثمن، لهذا یدعو محمود النبی إشعیا أن لا یرثی أورشلیم كما فعل فی سفره بل یدعوه الى أن یهجو أورشلیم الآثمة (حسب أشعیا) التی تسببت بإثمها بتعلیق اللحم الفلسطینی مرتین (حسب محمود)، مرة فی زمن أشعیا، ومرة فی حصار جیش الاحتلال "الأورشالیمی" لبیروت فی زمن محمود.
ثیمة الاحتلال والتهجیر والأسر (السبی) تأخذ من محمود الكثیر من العنایة فی قصائده، فهو یستحضر قصة السبی البابلی فی عملیة اسقاط على الحاضر، یقول الشاعر فی مجموعة أحبك أو لا أحبك (1972):
"ونغنی القدسَ/ یا أطفال بابلْ/ یا موالید السلاسل/ ستعودون الى القدس قریباً/ وقریباً تكبرون/ وقریباً تحصدون القمح من ذاكرة الماضی/ قریباً یصبح الدمع سنابل/ آه یا أطفال بابل"
فلم یقل الشاعر: ونغنی القدس یا أطفال القدس او فلسطین، بل قال یا أطفال بابل، وهی عملیة قفز فوق الزمن باستحضار الماضی حیث هُجّر أبناء یهودا الكنعانیة الى بابل، وكذا حال الفلسطینی المعاصر. وبما أن أبناء یهودا عادوا من السبی البابلی كذلك سیعود أبناء فلسطین لأنهم سیحصدون القمح من ذاكرة الماضی. والشاعر نفسه عانى من التهجیر والأسر (الاعتقال)، فكان توظیف رمزیة السبی الى بابل خیر تعبیر عن مأساة الشاعر وشعبه. ولا أظن أن محمود قد فاته أن الاسرائیلی المعاصر لا علاقة له بیولوجیاً بأبناء یهودا اللذین تم سبیهم الى بابل، فهو كان واعیاً تماماً لحقیقة أن تاریخ یهودا وثقافتها جزء من التاریخ الفلسطینی وثقافته، كما هو واضح من قوله فی قصیدة بیروت (1983):
"وأحملُ أرضَ كنعان التی اختلف الغزاة على مقابرها/ وما اختلف الرواةُ على الذی اختلف الغزاة علیه"
ففی هذا النص یبدو محمود واعیاً للثقافة الكنعانیة الشاملة وأن الرواة (التألیف والتولیف) لم یختلفوا على ثقافة أرض كنعان، بل الخلاف جاء من تسییس الروایات لصالح مشروع سیاسی استیطانی (الغزاة). وما یؤكد هذا الاستنتاج قول الشاعر فی مجموعة العصافیر تموت فی الجلیل (1969) فی قصیدة بعنوان المزمور الحادی والخمسون بعد المئة:
"والمزامیر صارت حجارة/ رمونی بها/ وأعادوا اغتیالی/ قرب بیارة البرتقال/ صار جلدی حذاء/ للأساطیر والأنبیاء"
فالشاعر یتعامل مع مزامیر داود على أنها مزامیره ومزامیر شعبه، بمعنى أنها من منتجات الثقافة الكنعانیة وإن تم نسبها توراتیاً الى النبی داود، فهذا النسب لیس إلا من أساطیر الأنبیاء، أو هو إعادة تولیف النص الأدبی الكنعانی القدیم، فمن المعروف من الاكتشافات الأثریة فی الساحل الكنعانی الكبیر (من شمال سوریا الى جنوب فلسطین) أن مزامیر داود لیست إلا ابتهالات وأغانی فولوكلوریة كنعانیة قدیمة، وحتى رافدیة تم اكتشاف مثلها فی العراق. إن تعامل الشاعر مع النصوص التوراتیة على أنها نصوص ثقافته واضح فی قوله فی قصیدة شتاء ریتا من مجموعة أحد عشر كوكباً (1992):
"لی حصةٌ من مشهد الموج المسافر مع الغیوم، وحصةٌ/ من سفر تكوین البدایة، حصةٌ من سفر أیوب، ومن/ عید الحصاد"
فهو هنا یجمع سفرین من العهد القدیم، التكوین وأیوب، وعید الحصاد الكنعانی. ویتضح لنا أكثر كیف أن محمود یتعامل مع النصوص الدینیة على أنها نصوص أدبیة یُعید العقل الجمعی إعادة انتاجها باستمرار. یقول محمود بهذا الصدد: "إن النضج الأدبی هو أن نتذكر أسلافنا وأن نشعر بأن وراء هذا النص الشعری أسلافاً.. فی كل شاعر تاریخ الشعر منذ الرعویات الشفهیة الى الشعر المكتوب، من الشعر الكلاسیكی الى الشعر الحدیث". كما یجدر بنا التأكید هنا على عمق معرفة محمود بالكتاب المقدس، فالمزامیر عددها مائة وخمسون مزموراً، الأمر الذی دفع محمود الى تسمیة قصیدته هذه بالمزمور الحادی والخمسون بعد المئة، وكأن الشاعر یصر على التعامل الأدبی مع الكتاب المقدس، فهو من ناحیة یعتبر هذه المزامیر انتاجاً جمعیاً لأجداده الكنعانیین، ومن ناحیة أخرى ها هو الشاعر نفسه یشارك فی هذا الانتاج فیضیف مزموراً جدیداً لمجموعة المزامیر. هذا الوعی الدرویشی بالأدب الكنعانی یقوله محمود بصراحة فی قصیدة مأساة الفضة وملهاة النرجس من مجموعة أرید ما أرید (1990):
(توراة كنعان الدفینة تحت أنقاض الهیاكل بین صور وأورشلیم)
فالتوراة بالنسبة لمحمود عمل أدبی كنعانی یُعید تولیف الحكایات الكنعانیة إیاها مع التركیز على نفس الثیمات والموتیفات الأدبیة التی كانت وما زالت تشغل الحیز الأكبر من فكر الإنسان وانتاجه الدینی الجمعی، إلا أن الشاعر یرفض خطف هذا الأدب الكنعانی من قبل جماعة دینیة معینة، لذلك استخدم كلمة "أنقاض الهیاكل" وما یعنیه ذلك من انهیار عملیة الخطف هذه وانفضاح أمرها، مع الإشارة الى ما تحمله الكلمة من عمل أركیولوجی. وهذا ما یؤكد على علو شأن الرمزیة عند محمود وقوتها، فاستخدامه لـ"أنقاض الهیاكل" كان موفقاً بامتیاز نظراً للإحتقان الهائل للرمز فیها. ولا یكاد القاریء یلتقط أنفاسه من هذه الرمزیة حتى ینهال علیه الشاعر برمزیة أخرى لا تقل إحتقاناً، إنها الثنائی صور وأورشلیم، فمن ناحیة تفصح هذه الثنائیة عن كنعانیة التوراة، ومن ناحیة ثانیة عن كنعانیة الهیكل الأوشلیمی الذی بناه مهندسو صور الكنعانیة (سأتجنب هنا استعمال مصطلح فینیقیا كونه مسمى إغریقی لبلاد كنعان). هذا الوعی نراه أیضاً فی نفس المجموعة الشعریة فی قصیدة ربّ الأیائل یا أبی ربّها، حیث یقول الشاعر:
"فانهضْ یا أبی من بین أنقاض الهیاكل، واكتبْ/ اسمكَ فوق خاتمها كما كتبَ الأوائل، یا أبی، أسماءَهم"
فمحمود هنا یستعمل رمزیة الأب بما تحمله من معانی الجذور المترسخة، داعیاً هذه الجذور أن تنفض عنها ركام الهیاكل لتتضح الحقیقة. وسیدخل محمود فی صراع على ذاكرة المكان كما سیمر معنا لاحقاً.
وتجاوز محمود رمزیة الهیكل الى توظیف رمزیة سلیمان فی قصائده، ففی قصیدة خطبة الهندی الأحمر من مجموعة أحد عشر كوكباً، یقول الشاعر على لسان الهندی الأحمر مخاطباً السید الأبیض:
".. وأشعار كنعان والبابلیین، تنقصُكُم/ أغانی سلیمان عن شولمیت.."
فأغانی سلیمان بالنسبة لمحمود لیست إلا من أشعار الشرق الأوسط القدیم (كنعان وبابل)، وهو هنا یشیر الى سفر نشید الأناشید الذی لسلیمان من العهد القدیم من الكتاب المقدس، وهی مجموعة من أناشید الحب والغزل العذری والفاحش تذكّر علماء المیثولوجیا بأغانی الكنعانیین المعنیة بالخصب، فسلیمان یبدو كإله خصب (بعل الكنعانی) وشولمیت (صیغة المؤنث لسلیمان لغویاً) تبدو إلهة الخصب المؤنثة. وقد اكتشف علماء الآثار صلوات كنعانیة فی أوغاریت تتطابق مع بعض أناشید سلیمان. إلا أن الشاعر یتجاوز استخدام رمزیة سلیمان الثقافیة الكنعانیة الى حالة من التناص الخاص بینه وبین سلیمان فی معرض تفكیر الشاعر بمعنى الموت والحیاة والوجود فی مُطولته الرائعة "الجداریة" (1999)، حیث یبدو محمود مغرماً بسفر الجامعة المنسوب أیضاً لسلیمان، وهو مجموعة من الحكم، یقول الشاعر:
"وكل شیء باطلٌ أو زائل، أو/ زائل أو باطل/ من أنا؟/ أنشیدُ الأناشید/ أم حكمةُ الجامعة؟/ وكلانا أنا../ وأنا شاعرٌ/ وملِك/ وحكیمٌ على حافة البئر"
فمحمود فی الجداریة حین "طار به الموت نحو السدیم" على حد تعبیره یستدعی حكمة سلیمان فی سفر الجامعة، فقد كان سلیمان ملكاً وحكیماً وشاعراً ووصل الى ذروة المجد، إلا أنه فی النهایة اعترف بأن كل شیء باطل وزائل: "باطل الأباطیل یقول الحكیم. باطل الأباطیل، كل شیء باطل" (سفر الجامعة، 1 – 2). وكذلك محمود فی تجربته مع الموت اختار حكمة سلیمان، لهذا یستعمل جملة "باطل، باطل الأباطیل باطل" كلازمة یعید تكرارها فی القصیدة تماماً كما هو الحال فی سفر الجامعة. ویتعمق محمود فی سفر الجامعة أكثر ویعید تولیف بعض من نصوصه بما یخدم تصوره الخاص، وكأنه یشارك فی نسج ثوب الحكمة الشرق أوسطیة، فنراه یقول فی الجداریة:
"عشتُ كما لم یعش شاعر/ ملكاً وحكیماً../ هرمت، سئمت من المجد/ لا شیء ینقصنی/ ألهذا إذاً/ كلما زاد علمی/ تعاظم همّی؟/ فما اورشلیم وما العرش؟/ لا شیء یبقى على حاله/ للولادة وقت/ وللموت وقت/ وللصمت وقت/ وللنطق وقت/ وللحرب وقت/ وللصلح وقت/ وللوقت وقت/ ولا شیء یبقى على حاله../ كل نهر سیشربه البحر/ والبحر لیس بملآن/ لا شیء یبقى على حاله/ كل حی یسیر الى الموت/ والموت لیس بملآن/ لا شیء یبقى سوى اسمی المَذهّب/ بعدی: / "سلیمانَ كان".. / فماذا سیفعل موتى بأسمائهم/ هل یضیء الذهب/ ظلمتی الشاسعة/ أم نشید الأناشید/ والجامعة؟"
هكذا یتعامل محمود مع التوراة والكتب المقدسة تعاملاً أدبیاً، فیرى فیها تولیفات (روایات) قامت بها الجماعة للتعبیر عن همومها وانشغالاتها، وهذه التولیفات لیست إلا اعادة انتاج روایات میثولوجیة سابقة علیها، لهذا اعتبر محمود التوراة جزءاً من تراثه، ورأى أن من مهمته كشاعر ینتمی لأرض فلسطین أن یشارك فی اعادة تولیف الروایات، فكانت الاقتباسات والرمزیات التوراتیة جزءاً من عملیة إعادة التولیف هذه.
[*الرمزیة المسیحیة والاسلامیة *]
فی قصیدة الجداریة وأمام تجربة الموت الرهیبة یقف محمود بین تجربة السید المسیح علیه السلام وتجربة سلیمان الحكیم، فیختار حكمة سلیمان كما مر معنا أعلاه، ربما لأنه وجد صعوبة فی اختیار تجربة قیامة المسیح، ولهذا نراه یقول:
"مثلما سار المسیحُ على البحیرة/ سرتُ فی رؤیایَ. لكنی نزلتُ عن/ الصلیب لأننی أخشى العلوّ، ولا/ أبشّرُ بالقیامة.."
فتجربة محمود بشریة، بعكس تجربة المسیح الإلهیة، لهذا یقول الشاعر فی نفس القصیدة نافیاً عن نفسه امكانیة الخلود على طریقة المسیح:
"وانتظرْ/ ولداً سیحمل عنك روحك/ فالخلود هو التناسل فی الوجود"
ومما لا شك فیه أن شخصیة السید المسیح لها حضور كبیر فی قصائد محمود، فالتشابه كبیر بینهما، فكلاهما من الجلیل، وكلاهما تعرض للإضطهاد، وكلاهما رأى فی الفداء خلاصاً، ولهذا نجد رمزیة المسیح فی قصائد محمود المبكرة، ففی قصیدة قال المغنی من مجموعة عاشق من فلسطین (1966) یقول الشاعر:
"المغنی على صلیب الألم/ جرحه ساطع كنجم/ قال للناس حوله/ كلّ شیء.. سوى الندم/ هكذا متّ واقفاً/ واقفاً متّ كالشجر/ هكذا یصبح الصلیب/ منبراً او عصا نغم/ ومسامیره وتر"
بهذه الطریقة یعید محمود تولیف الحكایة فی عملیة تناص بین فداء المسیح من أجل الخلاص وبین الموت وقوفاً من أجل النصر. إلا أنه بعد سقوط القدس عام 1967 یصبح لمعنى الصلیب بعداً آخراً هو المحبة والعطاء والخیر، كما هو فی قصیدة أغنیة حب على الصلیب من مجموعة آخر اللیل (1967) التی یخاطب فیها مدینة القدس أو مدینة كل الجروح الصغیرة كما یقول فی مطلع القصیدة:
"أحبكِ، كونی صلیبی/ وكونی، كما شئتِ، برجَ حمام/ إذا ذوّبتنی یداك/ ملأت الصحارى غمام"
عملیة التولیف الشعری تنهال على محمود بغزارة فی قصیدة مدیح الظل العالی (1983) التی كتبها عن حصار بیروت، وكأن قساوة الحصار والحرب قد أخرجته عن طوره فإذا بالتولیف وكأنه وحی ینزل علیه من السماء، وذلك بتولیف قرآنی من سورة العلق وانجیلی عن المسیح الفادی الذی سیهدم هیكل جسده ویبنیه فی ثلاثة أیام:
"الله أكبر/ هذه آیاتنا فاقرأ/ باسم الفدائی الذی خلقا/ من جرحه شفقا/ باسم الفدائی الذی یرحل/ من وقتكم.. لندائه الأول/ الأولِ الأول/ سندمر الهیكل/ باسم الفدائی الذی یبدأ/ اقرأ.. / بیروت صورتنا/ بیروت سورتنا"
التولیف القرآنی من سورة یوسف والكتابی من سفر التكوین نجده عند محمود فی قصیدة أخرى بحكم التناص بین قضیته وقضیة شعبه التی تخلى عنها العرب وبین تخلی أبناء یعقوب عن أخیهم الصغیر یوسف بعد أن غدروا به وأودعوه البئر، یقول الشاعرفی قصیدة أنا یوسف یا أبی من مجموعة ورد أقل (1986):
"أنا یوسف یا أبی، یا أبی اخوتی لا یحبوننی، لا یریدوننی بینهم یا أبی، یعتدون علی ویرموننی بالحصى والكلام، یریدوننی أن أموت لكی یمدحوننی، وهم أوصدوا باب بیتك دونی، وهم طردونی من الحقل، هم سمموا عنبی یا أبی... فماذا فعلت أنا یا أبی، ولماذا أنا؟، أنت سمیتنی یوسفاً، وهمو أوقعونی فی الجب، واتهموا الذئب، والذئب ارحم من اخوتی.. أبتِ! هل جنیت على أحد عندما قلت انی: رأیت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر، رأیتهم لی ساجدین"
وفی مرحلة ما بعد بیروت حین یحس الشاعر بأن الكل قد تخلى عنه وعن قضیة شعبه یبدأ حواراً مع الله فینهل من الرموز الانجیلیة كقول المسیح على الصلیب قبل أن یلفظ الروح، فی قصیدة إلهی لماذا تخلیت عنی؟ من مجموعة ورد أقل:
"الهی.. الهی.. لماذا تخلیت عنی؟ لماذا تزوجت مریم؟ لماذا وعدت الجنود بكرمی الوحید.. لماذا؟ أنا الأرملة/ أنا بنت هذا السكون، أنا بنت لفظتك المهملة/ لماذا تخلیت عنی؟ الهی، إلهی لماذا تزوجت مریم؟"
ویسأل الشاعر الله كما سأله المسیح بأن لا یبعد عنه كأس الموت فی قصیدة یطول العشاء الأخیر من نفس المجموعة:
"یطول العشاء الأخیر، تطول وصایا العشاء الأخیر/ أبانا الذی معنا كن رحیماً بنا، وانتظرنا قلیلاً، أبانا/ ولا تبعد الكأس عنا/ تمهل لنسأل أكثر مما سألنا"
إلا أن الشاعر فی مزاج آخر فی قصیدة كتب فیها عن هاجس العودة الى الوطن یحتفی بعودة المسیح ومریم الى العشاء الذی یریده الشاعر أن یُنهی الاحتلال، یقول فی القصیدة الملحمة "مأساة الفضة ملهاة النرجس" من مجموعة أرید ما أرید (1990):
"عاد المسیحُ الى العشاء، كما نشاء، ومریمٌ عادتْ إلیه/ على جدیلتها الطویلة كی تغطی مسرحَ الرومان فینا"
وفی قصیدة الجداریة فی بحث الشاعر عن معنى الخلود یستحضر امتحان الشیطان للسید المسیح كما ورد فی الأناجیل، ولكنه یُسقط هذه الحكایة على نفسه حین كان بین الموت والحیاة، وكأن الاختبار كان له:
"أعلى من الأغوار كانت حكمتی/ إذ قلتُ للشیطان: لا، لا تمتحنّی/ لا تضعنی فی الثنائیات، واتركنی/ كما أنا زاهداً بروایة العهد القدیم/ وصاعداً نحو السماء، هناك مملكتی/ خُذ التاریخ، یا ابن أبی، خذ/ التاریخَ.. واصنع بالغرائز ما تریدُ"
وكما فی الرمزیة التوراتیة فإن محمود ینهل من الرموز المسیحیة والاسلامیة فی عملیة تناص یعید من خلالها كتابة السردیة الشعریة الشرق أوسطیة بما یلائم حاضره وأمانی مستقبله مرتكزاً على الثیمات والموتیفات نفسها، وكأن الحكایة هی نفس الحكایة ولم یتغیر شیء سوى الزمن.
[*الرموز العربیة والرافدیة والمصریة والكنعانیة *]
فی نفس القصیدة السابقة یجمع محمود فی أسطر قلیلة ثقافة شرق المتوسط فی مشهد تخیلی یفترض أن العائدین الى فلسطین یستعیدونه مع عودتهم، إنها تقنیة لربط الاستعادة المادیة بالاستعادة الثقافیة لیغلق الخارطة من النیل الى الفرات:
".. واستعادوا/ ما ضاع من قاموسهم: زیتون روما فی مخیلة الجنود/ توراة كنعان الدفینة تحت أنقاض الهیاكل بین صور وأورشلیم/ وطریق رائحة البخور الى قریش تهبّ من شام الورود/ وغزالة الأبد التی زُفّت الى النیل الشمالی الصعود/ والى فحولة دجلة الوحشی وهو یزف سومرَ للخلود"
هكذا یتنقل الشاعر بین رمزیات الشرق الأوسط القدیم غیر عابئ بالزمن الذی ینحل بین یدیه، فیستدعی ثقافة الأمة من العراق الى مصر وما بینهما، ویدعو القاریء لأن یستعید معه هذه الثقافة، لأن العودة لا تكتمل إن كانت فیزیائیة، بل لا بد لها من استعادة ثقافیة لتكتمل.
فی قصیدته الرائعة بعنوان رحلة المتنبی الى مصر من مجموعة حصار لمدائح البحر (1984) یعقد الشاعر تناصاً بین حاضره وبین الماضی العربی غیر البعید، فیستحضر حكایة المتنبی مع كافور مُطرزاً القصیدة برموز تاریخیة عربیة اسلامیة، حیث یشبه نفسه تارةً بالمتنبی وتارةً بالقرمطی، وكأنه یرثی حال مصر والأمة معها:
"قد جئتُ من حلبٍ، وإنی لا أعود الى العراق/ سقطَ الشمالُ فلا ألاقی/ غیر هذا الدرب یسحبنی الى نفسی.. ومصر/ .. أمشی الى نفسی فتطردنی من الفسطاط../ .. لا مصر فی مصر التی أمشی الى أسرارها/ فأرى الفراغ، وكلما صافحتُها/ شقتْ یدینا بابلُ/ فی مصر كافورٌ وفیّ زلازل/.. هل تتركین النیلَ مفتوحاً/ لأرمی جثتی فی النیل؟/ لا، لن یستبیح الكاهن الوثنی زوجاتی/ ولا، لن أبنی الأهرام ثانیة، ولا/ .. والقرمطی أنا، ولكن الرفاق هناك فی حلبٍ/ أضاعونی وضاعوا.."
إنها نفس الخارطة الجغرافیة الشعریة یرسمها الشاعر فی فترتین زمنیتین مختلفتین من التاریخ العربی، الأولى فی الزمن المیثولوجی الغابر، والثانیة فی الزمن الحقیقی القریب. ولكن ضمن نفس الحدود ما بین مصر والعراق وبلاد الشام. وفی مجموعة سریر الغریبة (1999) یحرر محمود المرأة من رمزیة الوطن فی شعره ویتعامل معها كإمرأة لا أكثر، وفی هذه المجموعة یعقد حواراً مع جمیل بثینة ومع مجنون لیلى فی قصیدتین منفصلتین باحثاً عن معنى الحب عند العرب:
"هل تشرح الحبَ لی ، یا جمیلُ/ لأحفظه فكرةً فكرة؟/ أعرفُ الناس بالحب أكثرهم حیرةً/ فاحترق، لا لتعرف نفسك، ولكن/ لتُشعلَ لیلَ بثینة.."
فی نفس المجموعة یرحل الشاعر عمیقاً فی الزمن فی البحث عن معنى الحب فی الشرق الأوسط القدیم، فیصل الى إنانا، إلهة السومریین، لیجد معنى الحب فی الخصب او فی زفاف السماء والأرض المقدس:
"فلیصقُل الثورُ، ثورُ العراق/ المُجنّح قرنیه بالدهر والهیكل المتصدع/ فی فضة الفجر. ولیحمل الموتُ آلته/ المعدنیة فی جوقة المنشدین القدامى/ لشمس نبوخنصّر. أما أنا، المتحدر/ من غیر هذا الزمان، فلا بد لی/ من حصان یلائم هذا الزفاف. وإن كانَ/ لا بدّ من قمرٍ فلیكن عالیاً.. عالیاً/ ومن صنع بغداد، لا عربیاً ولا فارسیاً/ ولا تدّعیه الإلهات من حولنا. ولیكن خالیاً/ من الذكریات وخمر الملوك القدامى/ لنُكمل هذا الزفاف المقدس، نكمله یا ابنةَ/ القمر الأبدی هنا فی المكان الذی نزّلتهُ/ یداكِ على طرف الأرض من شرفة الجنة الآفلة"
مفهوم الخصوبة، او زفاف الآلهة المقدس، یؤكد علیه محمود فی الثقافة الكنعانیة أیضاَ حیث یستدعی، عناة، إلهة الخصب الكنعانیة، حیث یقول فی الجداریة:
"فغنّی یا إلهتی الأثیرة، یا عناةُ/ قصیدتی الأولى عن التكوین ثانیةً"
مبیناً دور عناة فی استمرار التكوین، او دورات الخصب، حین یتحدى الموت قائلاً له فی نفس القصیدة:
"فماذا یفعل التاریخ، صنوُكَ او عدوك/ بالطبیعة عندما تتزوج الأرضَ السماءُ/ وتذرفُ المطرَ المقدس؟"
عناةُ الكنعانیة هذه سیهیم الشاعر بحبها فی نفس الجداریة لدرجة العبادة مستخدماً مصطلحاً قرآنیاً ولا أجمل "یممتُ وجهی شطرَ" وما یحمله من معانی التعلق والقداسة والعبادة، ولكنه یمم وجهه شطر كنعان، بلاد الإرجوان:
"كلما یممتُ وجهی شطرَ آلهتی/ هنالك، فی بلاد الأرجوان أضائنی/ قمرٌ تُطوّقهُ عناةُ، عناةُ سیدةُ/ الكنایة فی الحكایة.."
فمحمود هنا سومری وكنعانی یشارك فی نسج ثقافة المنطقة بشعره بعملیات اعادة تولیف الملاحم السومریة والكنعانیة، وكأنها مشاركة منه فی النقاش الثقافی حول ثیمات مثل الحب والخصب والموت والحیاة والخلود. وفی نفس الجداریة فی بحثه عن الموت والخلود یستضیف أوزیریس الفرعونی والسید المسیح على قاعدة البعث من الموت، وكأن الشاعر یرید أن یؤكد لنا أن هذه الروایات لیست إلا توالیف لا نعرف مُؤلفها الحقیقی الأولانی، وإنما نقوم كشعب شرق أوسطی بإعادة التولیف لإبراز المعنى والمفهوم:
".. من أنا فی الموت/ بعدی؟ من أنا فی الموت قبلی/ قال طیفٌ هامشی: كان أوزیریسُ/ مثلكَ، كان مثلی. وابنُ مریم/ كان مثلكَ. كان مثلی.."
یجد محمود فی ملحمة جلجامش السومریة، التی یعود تاریخها الى مدینة أوروك فی الألف الثالثة قبل المیلاد، مادةً غنیة لمناقشة ثیمة الموت والخلود فی قصیدة الجداریة، وكأنه یشارك فی اضافات (تولیفات) على هذه الملحمة التی خضعت عبر الزمن الى الكثیر من الاضافات عبر العصور حتى وصلت الى بابل الكلدانیة. فجلجامش ملك اوروك مولود من الإلهة ننسون التی حملت به من ملك أوروك لوجلیندا، فكان ثلث جلجامش بشراً وثلثاه إلهاً. ولكنه كان مشغولاً بتجاوز الموت الى الخلود، فصاحبَ الوحش البری أنكیدو، ومضیا الى غابة حیث سر الخلود. ووصلا إلیها، وظن جلجامش أنه أمسك بسر الخلود. إلا أن الآلهة قررت موت أنكیدو، فمات بین یدی جلجامش الذی اكتشف أن الموت حق وأن الخلود یكمن فی أعمال الانسان:
".. أنكیدو! خیالی لم یعُد/ یكفی لأكملَ رحلتی. لا بدّ لی من/ قوة لیكون حلمی واقعیاً. هاتِ/ الدمعَ، أنكیدو، لیبكی المیتُ فینا/ الحیَّ . ما أنا؟ من ینامُ الآن/ أنكیدو؟ أنا أم أنتَ؟.."
وهكذا أدخل الشاعر نفسه فی نفس التجربة وهو بین حدود الوجود والعدم، ولكنه یخلص لمفهوم الخلود، وكأنها اضافة درویشیة رائعة للملحمة السومریة:
"هزمتكَ یا موتُ الفنونُ جمیعها/ هزمتكَ یا موتُ الأغانی فی بلاد/ الرافدین. مسلّةُ المصریّ/ مقبرةُ الفراعنة/ النقوش على حجارة معبدٍ هزمتكَ/ وانتصرتْ، وأفلتَ من كمائنكَ/ الخلودُ..."
[*الصراع على ذاكرة المكان *]
كان محمود واعیاً للصراع الثقافی على أرض فلسطین بین الذاكرة الفلسطینیة وبین المشروع الثقافی الصهیونی الذی ما انفكّ الى الآن یحاول تجییر ثقافة الأرض لصالحه عبر ربطها بالتوراة من جهة وربط المشروع الصهیونی بیهودا الكنعانیة وثقافتها من جهة أخرى (بما فیها الكتاب المقدس نفسه)، ففی إحدى مقابلاته یقول محمود: "یأخذنی شعوری الى أن الصراع بیننا لیس عسكریاً فقط وأننا نحن مدفوعون الى صراع ثقافی عمیق"، لهذا نجده ومنذ وقت مبكر ینبه فی شعره الى هذا الصراع، فیقول فی قصیدة یومیات جرح فلسطینی التی أهداها الى الشاعرة فدوى طوقان فی مجموعة حبیبتی تنهض من نومها (1970):
"عالمُ الآثار مشغولٌ بتحلیل الحجارة/ إنه یبحث عن عینیه فی ردم الأساطیر/ لكی یُثبت أنی/ عابرٌ فی الدروب لا عینین لی/ لا حرفَ فی سِفر الحضارة"
لا شك أن محمود كان مطلعاً على علم الآثار فی فلسطین والذی كان آنذاك توراتیاً منحازاً، حیث كان جل اهتمام الباحث الآثاری العثور على أی نص او قطعة أثریة لكی یقوم بتأویلها توراتیاً بما یخدم مقولة أرض الآباء الصهیونیة، وهذا التوجه الصهیونی فی علم الآثار سرعان ما انهار مع بدایة الثمانینات من القرن العشرین بسبب الاكتشافات الآثاریة الهائلة التی تتعارض مع اطروحات المشروع الاستیطانی الصهیونی الكولونیالی وتؤكد على كنعانیة الأرض وثقافتها، فقد أكد على ذلك علماء غربیون مثل توماس تومسون فی كتابه "الماضی الخرافی" وكیث وایتلام فی كتابه "اختلاق اسرائیل القدیمة، طمس التاریخ الفلسطینی". وكما قلنا أعلاه فإن الشاعر وجد نفسه منخرطاً فی الصراع على ذاكرة المكان فی شعره، فهو فی نثریة عابرون فی كلام عابر (1987) یستند على الفعل "عبَرَ" لما یحمله من معانی البداوة والمرور الذی لا یستقر، فهم عابرون ومشروعهم كلام عابر:
"أیها المارون بین الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم فی حفرة مهجورة، وانصرفوا.."
وفی قصیدة على ساحل البحر الأبیض المتوسط من مجموعة حصار لمدائح البحر (1984) یبحث محمود عن آثار أجداده التی یعرف تماماً أنها مدفونة فی أماكن كثیرة على ساحل المتوسط:
"یا بحرَ البدایات/ یا جثتنا الزرقاء، یا غبطتنا، یا روحنا الهامد بین یافا وقرطاج/ یا ابریقنا المكسور، یا لوح الكتابات التی ضاعت/ بحثنا عن أساطیر الحضارات/ فلم نجد سوى جمجمة الانسان قرب البحر"
ففی تلك الفترة بعد حصار بیروت والخروج منها یبحث الشاعر عن جذوره ومكانه على ساحل البحر الذی حمل شعبه بعیداً، إلا أن جماجم هذا الشعب ستبقى على سواحل هذا البحر تماماً مثل جماجم الانسان الأول التی تم اكتشافها على سفوح الكرمل، والتی ستبقى شاهدة على انتماء الانسان لهذه الأرض. ففی مجموعة هی أغنیة هی أغنیة (1986) یخاطب الشاعر أصحاب المشروع الصهیونی الاستیطانی بأن لا یُتعبوا أنفسهم فی البحث الآثاری لأنهم لن یجدوا ما یدل علیهم:
"ولن تجدوا جثةً تحفرون علیها مزامیر رحلتكم فی الخرافة/ ولن تجدوا شرفةً كی تُطلّوا على الأبیض المتوسط فینا/ ولن تجدوا ما یدل علیكم.."
وفی نفس المجموعة یفضح الشاعر أعمال المشروع الاستیطانی فی تجییر ذاكرة المكان لنفسه ونفیها عن الفلسطینی:
"لصوصُ المدافن لم یتركوا للمؤرخ شیئاً یدلّ علیّ/ ینامون فی جثتی أینما طلع العشب منها، وقام الشبح/ یقولون ما لا أفكر، ینسون ما أتذكر..."
إلا أن هذا الغریب القادم مع المشروع الاستیطانی یبقى غریباً عن ثقافة هذه الأرض وذاكرتها، ولهذا فإنه یجد صعوبة فی التماهی فیها، لهذا تراه یعتمد على جمالیات السرد لكی یثبت حقه فی الأرض، فكلما كتب عن الأرض بشكل أجمل كلما استحق المكان أكثر، من وجهة نظره. ومحمود كان واعیاً لهذه المسألة، فهو یقول فی احدى مقابلاته: "الشاعر الفلسطینی لم یشعر یوماً بأنه محتاج الى تقدیم براهین على حقه بالمكان، وعلاقته بالأرض تلقائیة وعفویة ولا تحتاج الى أی إیدیولوجیا أو تبریر. الشاعر الإسرائیلی الذی یعرف كیف تمّ مشروعه وماذا كان قبل إسرائیل، والذی یعرف أیضاً ان هذا المكان له اسم آخر وسابق هو فلسطین، یبدو هذا الشاعر فی حاجة الى شحذ كل طاقته الإبداعیة من أجل امتلاك المكان باللغة كجزء مكمل للمشروع الاستیطانی". ألهذا أكثر محمود من استدعاء الرمزیات المیثولوجیة فی شعره، ودخل فی ثنایا سردیاتها لیشارك فی نسج هذه الروایات؟ وكأنه یقول للآخر: إنی لا أجد صعوبة فی الاحتفاء بعناة وبعل وإنانا وجلجامش وأوزیریس وأشعیا وأرمیا والمسیح والعذراء وغیرهم، لأنهم جزء من ثقافتی وأنا امتداد لهم، وأستطیع أن ألج روایاتهم بتلقائیة وأشاركهم فی نسج الحكایات، حكایاتنا. فلننظر الى هذا النص الدرویشی الجمیل الذی یذكرنا بملاحم الكنعانیین فی قصیدة ربّ الأیائل یا أبی ربّها من مجموعة أرید ما أرید (1990):
".. منفایَ أرضُ/ أرضٌ من الشهوات، كنعانیةٌ، ترى الأیائل والوعولْ... / لو كنتَ من حجر لكان الطقسُ آخر، یا ابن كنعان القدیم/ لكنهم كتبوا علیكَ نشیدهم لتكون أنت هو الوحید... / سرقَ المؤرخ، یا أبی لغتی وسوسنتی وأقصانی عن الوعد الإلهی/ وبكى المؤرخ عندما واجهته بعظام أسلافی.../ فانهض یا أبی من بین أنقاض الهیاكل واكتبْ/ اسمكَ فوق خاتمها كما كتب الأوائل یا أبی أسماءهم.../ وأنا حزین، یا أبی، سلّم على جدی إذا قابلتهُ/ قبّلْ یدیه نیابة عنی وعن أحفاد بعلٍ أو عناة/ واملأ له ابریقه بالخمر من عنب الجلیل أو الخلیل.."
أما الأبلغ والأجمل من هذا فی الصراع على ذاكرة المكان فهو استحضار محمود لعدة تناصّات من أمكنة مختلفة وأزمنة مختلفة لیقیم الحجة على المشروع الاستیطانی الصهیونی، ففی قصیدة خطبة الهندی الأحمر أمام الرجل الأبیض من مجموعة أحد عشر كوكباً (1992) یخاطب محمود المشروع الصهیونی عن طریق مخاطبة الهندی الأحمر للرجل الأبیض الذی استوطن فی أرضه، مستخدماً رمزیات من میثولوجیا الهنود الحمر:
"لكم ربكم ولنا ربنا، ولكم دینكم ولنا دیننا/ فلا تدفنوا الله فی كتبٍ وعدتكم بأرضٍ على أرضنا/ كما تدعون، ولا تجعلوا ربكم حاجباً فی بلاط الملك... / .. هذه الأرضُ جدّتنا/ مقدسةٌ كلها، حجراً حجراً، هذه الأرض كوخٌ/ لآلهة سكنت معنا، نجمةً نجمةً، وأضاءت لنا/ لیالی الصلاة... / ... تاریخنا كان تاریخها"
فی مجموعة أحد عشر كوكباً یبدو أن الوحی الكنعانی قد سیطر على محمود، فنراه فی معظم قصائد المجموعة مشغولاً بهذا الهم، ناسجاً قصائد كنعانیة كأنها تعود الى شاعر كنعانی مات فی أوغاریت او سفوح الكرمل او بیبلوس جبیل، وكأن ما نقرأه الآن لیس لمحمود وإنما لأحد أسلافنا الذی اكتشف مخطوطاته علماء الآثار، یقول الشاعر فی قصیدة على حجر كنعانی فی البحر المیت:
".. یا غریبُ/ علّقْ سلاحكَ فوق نخلتنا، لأزرع حنطتی/ فی حقل كنعان المقدس.. / خذ نبیذاً من جراری/ خذ صفحة من سِفر آلهتی.. وقسطاً من طعامی/ وخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوی، خذ/ صلواتٍ كنعانیة فی عید كرمتها، وخذ عاداتنا/ فی الری، خذ منا دروس البیت.../ واترك أریحا تحت نخلتها، ولا تسرق منامی... / أأتیتَ.. ثم قتلتَ.. ثم ورثتَ... / .. والأنبیاء جمیعهم أهلی، ولكنّ السماءَ بعیدةٌ/ عن أرضها، وأنا بعیدٌ عن كلامی"
هكذا یعترف محمود أن جمیع الأنبیاء هم أهله، وأن ثقافته هی امتداد لكتبهم المقدسة وطقوسهم المقدسة، لهذا قال للغریب: "خذ صفحة من سِفر آلهتی". وفی قصیدة بعنوان سنختار سوفوكلیس من نفس المجموعة یؤكد الشاعر على حقه فی هذه الطقوس:
"وإن كان هذا الخریفُ الخریفَ النهائیّ، فلنختصرْ/ مدائحنا للأوانی القدیمة، حیث حفرنا علیها مزامیرنا/ فقد حفر الآخرون على ما حفرنا مزامیرَ أخرى/ ولم تنكسر بعد... /.. كأن أناشیدنا فی الخریف أناشیدهم فی الخریف/ كأن البلادَ تُلقننا ما نقول.../ ولكن عید الشعیر لنا، وأریحا لنا، ولنا/ تقالیدنا فی مدیح البیوت وتربیة القمح والأقحوان/ سلاماً على أرض كنعان/ أرض الغزالة/ والأرجوان"
[*وفی الجداریة یعید محمود التأكید على حقه فی هذه الطقوس والأعیاد:*]
"فی عید الشعیر أزور أطلالی/ البهیة مثل وشم فی الهویة.. / وفی عید الكروم أعبّ كأساً/ من نبیذ الباعة المتجولین.. خفیفةٌ/ روحی، وجسمی مُثقلٌ بالذكریات وبالمكان"
هذه الذكریات وهذا المكان استحضرها محمود فی المشهد الافتراضی للعودة فی القصیدة الملحمة بعنوان مأساة الفضة ملهاة النرجس كما أسلفنا أعلاه:
"عادوا على أطراف هاجسهم الى جغرافیا السحر الإلهی/ والى بساط الموز فی أرض التضاریس القدیمة:/ جبلٌ على بحر/ وخلف الذكریات بحیرتان/ وساحلٌ للأنبیاء"
هذا الصراع على ذاكرة المكان یختتمه محمود فی قصیدة الجداریة كونه كان بین الوجود والعدم، فربما لأنه كان، شعریاً، على مسافة قصیرة من الموت، فقد استحضر مدینة عكا برمزیتها، كونها أجمل المدن القدیمة أو أقدم المدن الجمیلة كما قال، وعلى جسدها یكتب التاریخ كله، وكأنه یقول لأصحاب المشروع الاستیطانی: هذا هو آخر الكلام عندی:
"لدیّ ما یكفی من الماضی/ وینقصنی غدٌ../ سأسیرُ فی الدرب القدیم على/ خطایَ، على هواء البحر.../ هذا البحر لی/ هذا الهواء الرطب لی/ هذا الرصیف وما علیه/ من خطایَ وسائلی المنوی لی/ ومحطة الباص القدیمة لی.. ولی/ شبحی وصاحبه، وآنیة النحاس/ وآیة الكرسی، والمفتاح لی/ والبابُ والحراس والأجراس لی/ لی حذوة الفرس التی طارت/ عن الأسوار.. لی/ ما كان لی، وقصاصة الورق التی/ انتُزعتْ من الانجیل لی/ والملحُ من أثر الدموع على/ جدار البیت لی.. "
ویرحل الشاعر عنا، وتبقى عكا وسائر أرض كنعان وثقافة المتوسط له، فسلاماً على أرض كنعان، أرض الغزالة والأرجوان.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:45|
المرأة
فی أدب نجیب محفوظ
صورة المرأة تعد مرآة تعكس قیم وثقافة المجتمع الذی تنتمی إلیه،
وقد یعكس النتاج الأدبی للمجتمع الوضع الصحیح للمرأة داخله، وقد یعكس صورة
مشوهة، فإذا نظرنا لبعض الأعمال الأدبیة فإننا نجد تشویها متعمدا لصورة
المرأة فی المجتمع العربی، فهناك بعض الأدباء یجنحون بالمرأة فی أعمالهم
لیعكسوا صورة مغلوطة أو تحمل جانبا واحدا من وضعیة المرأة داخل مجتمعها
لیعمم هذا الجانب السیئ على جمیع نساء المجتمع.
وإذا نظرنا للأدباء الذین نقلوا صورة مشوهة للمرأة فی المجتمع المصری نجد "نجیب محفوظ" متصدرا هؤلاء، فقد اتخذ محفوظ من عالم المرأة إطارا لمناقشة قضایا ذات أبعاد عدة ووظفها بصورة سیئة؛ فصورها فتاة لیل وصورها بالعاهرة وصورها أیضا بالعاشقة.أما صورة المرأة المكافحة العفیفة، والفلاحة المصریة المجاهدة لم تجد لها مكانا فی روایات نجیب محفوظ، رغم أن نجیب محفوظ ـ فی كل أعماله ـ شكلت المرأة جانبا مهما، حیث یظهر شغفه الهائل بعالمها وما یكتنفها من غموض وأسرار وما یحیط بها من محاذیر، واقتحم نجیب محفوظ هذا العالم لیقدم تأریخا لعالم المرأة بكل عنفها وصخبها وضجیجها وإحجامها ومراوغتها.
لقد قدم نجیب محفوظ المرأة على أنها سلبیة خنوع خائفة متداعیة سلیطة اللسان سیئة الخلق ساقطة، سواء بإرادتها أو بإرادة الآخرین ومن خلال أعمال نجیب الروائیة سنقدم بعض شخصیات روایاته النسائیة التی استخدمها فی هذه الأعمال وكیف كان یوظف صورة المرأة فی أعماله، على العكس لم یقدم نجیب محفوظ المرأة على أنها السیدة المكافحة التی تقوم على تربیة الأبناء أو الواقفة بجوار زوجها، لكنه استخدمها فی أسوأ صورة، وما یأتی من أمثال یوضح ذلك. القاهرة الجدیدة
ففی روایة "القاهرة الجدیدة" توجد شخصیة "إحسان شحاته" وقد وظفها نجیب محفوظ فی هذا العمل على أنها طالبة معهد التربیة، شدیدة الفقر، تعیش فی أسرة مثقلة بأعباء الحیاة، ولكنها تشعر بقوة جمالها كما تشعر بقسوة فقرها، وفی غمار هذه المشاعر المتضاربة تسقط إحسان صریعة لمجتمع لا یعترف إلا بالثروة والنفوذ، تسوده المحسوبیة والانتهازیة وتحكمه البراجماتیة القاسیة، مجتمع لا یعترف بحق الحیاة الكریمة لأفراده، ولم لا وهو مقطع الأوصال بین فساد سیاسی تحكمه الأهواء والمصالح وظلم اقتصادی یظهر فی سوء توزیع الثروة؟ وبین هذا وذاك تلعب إحسان دورها ببراعة فی مسرحیة عبثیة هزلیة مأساویة، فی الوقت ذاته یخرج فیها جمیع الممثلین عن النص ثم یسقطون جمیعا صرعى فی مشهد النهایة. زقاق المدق
وفی روایة "زقاق المدق" یأتی نجیب محفوظ بشخصیة "حمیدة" وهی فتاة جملیة تعیش بین شخصیات زقاق المدق الذی تصفه فی النهایة بأنه زقاق العدم، وحمیدة كما یصورها "نجیب محفوظ" فی الروایة هی شخصیة شدیدة الطموح شدیدة الطمع، عیونها الجمیلة تتطلع إلى ما هو أبعد من عالم الزقاق وقلبها یخفق لمرأى البنات الجمیلات وهن یرفلن فی ملابسهن الجمیلة، فلا تملك إلا أن تقول ما قیمة الدنیا بدون الملابس الجدیدة، حمیدة متمردة شغوف بأن تعیش حیاة أخرى فی عالم آخر ولم تكن الظروف تعمل لصالحها دائما حینما قذفت بنفسها إلى قلب المدینة الصاخبة وهی تعیش فی أجواء الحرب العالمیة الثانیة، وكانت الحرب بآثارها المادیة والاجتماعیة هی التی دفعت بحمیدة إلى الانحراف كما یذكر نجیب محفوظ متناسیا أن الدین والقیم یجب أن تصون الأعراض وتحفظ المرأة من الوقوع فی براثن الخطیئة.
نأتی إلى ثلاثیة نجیب محفوظ وهی ملیئة بالشخصیات النسائیة المتحررة، وهذا واضح فی شخصیة "سوسن حماد" زوجة الحفید "أحمد عبد المنعم" فی روایة "السمان والخریف" توجد شخصیة "ریری" وهی نموذج فرید للفتاة المنحرفة التی تخرج لیلا ولا تعود إلا فی الفجر، وأصبحت ماعونا ملوثا لكل من هب ودب، ثم تقرر العودة للأخلاق.
وحول هذه الشخصیة تقول الدكتورة "نعمات أحمد فؤاد"ـ فی مقال لها نشرته صحیفة "الأهرام" القاهریة ـ إن نجیب محفوظ كثیرا ما قدم نماذج سیئة للمرأة لكنه قرر بعد ذلك أن یتصالح مع المرأة ویقدم نموذجا للكبریاء المتسامح والقدرة على الصمود أمام الإغراء والزهد فی الإثم الذی ذاقت هوانه وتعاسته وذلك فی روایة الثلاثیة. البدایة والنهایة
أما شخصیة "نفیسة" فی روایة "بدایة ونهایة"فیصورها نجیب محفوظ على أنها ساقطة یائسة، ویعلل ذلك بفقرها وجهلها ودمامتها، وهی شابة فی مقتبل العمر، یمتلئ جسدها بالحیویة والرغبة فی الحیاة، ولكن وجهها الدمیم یخذلها وجهلها یقودها مغمضة العینین إلى مصیرها المحتوم وفقرها لا یترك لها أملا فی الزواج، لقد تحالف علیها ما یدمر حیاة أی فتاة، ولو كانت نفیسة غنیة لربما وجدت من یتغاضى عن دمامتها ویتناسى قبحها، وربما وجدت من یغفر زلتها ویعفو عن خطیئتها فالشرف قید لا یغل إلا أعناق الفقراء وحدهم، نفیسة أقرب ما تكون إلى ملامح البطل التراجیدی الذی تضعه الحیاة فی مأزق، وقد زلت قدم نفیسة فماتت مرتین، یوم أن استسلمت لضعفها ویأسها ویوم أن قفزت إلى أعماق النیل بلا رجعة.
فی روایة "میرامار" نجد شخصیة "زهرة"ابنة الریف الفلاحة الجمیلة التی هربت من قریتها لتعمل خادمة فی "بنسیون" میرامار بالإسكندریة یطمع فیها جمیع نزلاء البنسیون.
هذه كلها نماذج توضح أن عالم المرأة لدى نجیب محفوظ هو من أسوأ الشخصیات، وقد اتخذ نجیب محفوظ هذه الشخصیات الساقطة عن عمد، ولم یفسر لنا ما المقصود باختیاره لهذا السقوط حیث جعل المرأة تسبح فی عالم الرذیلة دون رادع من قیم أو دین أو أخلاق، متجاهلا نماذج مشرفة یذخر بها المجتمع المصری، وبذلك ظلم نجیب محفوظ المرأة عشرات المرات فی أدبه.
وإذا نظرنا للأدباء الذین نقلوا صورة مشوهة للمرأة فی المجتمع المصری نجد "نجیب محفوظ" متصدرا هؤلاء، فقد اتخذ محفوظ من عالم المرأة إطارا لمناقشة قضایا ذات أبعاد عدة ووظفها بصورة سیئة؛ فصورها فتاة لیل وصورها بالعاهرة وصورها أیضا بالعاشقة.أما صورة المرأة المكافحة العفیفة، والفلاحة المصریة المجاهدة لم تجد لها مكانا فی روایات نجیب محفوظ، رغم أن نجیب محفوظ ـ فی كل أعماله ـ شكلت المرأة جانبا مهما، حیث یظهر شغفه الهائل بعالمها وما یكتنفها من غموض وأسرار وما یحیط بها من محاذیر، واقتحم نجیب محفوظ هذا العالم لیقدم تأریخا لعالم المرأة بكل عنفها وصخبها وضجیجها وإحجامها ومراوغتها.
لقد قدم نجیب محفوظ المرأة على أنها سلبیة خنوع خائفة متداعیة سلیطة اللسان سیئة الخلق ساقطة، سواء بإرادتها أو بإرادة الآخرین ومن خلال أعمال نجیب الروائیة سنقدم بعض شخصیات روایاته النسائیة التی استخدمها فی هذه الأعمال وكیف كان یوظف صورة المرأة فی أعماله، على العكس لم یقدم نجیب محفوظ المرأة على أنها السیدة المكافحة التی تقوم على تربیة الأبناء أو الواقفة بجوار زوجها، لكنه استخدمها فی أسوأ صورة، وما یأتی من أمثال یوضح ذلك. القاهرة الجدیدة
ففی روایة "القاهرة الجدیدة" توجد شخصیة "إحسان شحاته" وقد وظفها نجیب محفوظ فی هذا العمل على أنها طالبة معهد التربیة، شدیدة الفقر، تعیش فی أسرة مثقلة بأعباء الحیاة، ولكنها تشعر بقوة جمالها كما تشعر بقسوة فقرها، وفی غمار هذه المشاعر المتضاربة تسقط إحسان صریعة لمجتمع لا یعترف إلا بالثروة والنفوذ، تسوده المحسوبیة والانتهازیة وتحكمه البراجماتیة القاسیة، مجتمع لا یعترف بحق الحیاة الكریمة لأفراده، ولم لا وهو مقطع الأوصال بین فساد سیاسی تحكمه الأهواء والمصالح وظلم اقتصادی یظهر فی سوء توزیع الثروة؟ وبین هذا وذاك تلعب إحسان دورها ببراعة فی مسرحیة عبثیة هزلیة مأساویة، فی الوقت ذاته یخرج فیها جمیع الممثلین عن النص ثم یسقطون جمیعا صرعى فی مشهد النهایة. زقاق المدق
وفی روایة "زقاق المدق" یأتی نجیب محفوظ بشخصیة "حمیدة" وهی فتاة جملیة تعیش بین شخصیات زقاق المدق الذی تصفه فی النهایة بأنه زقاق العدم، وحمیدة كما یصورها "نجیب محفوظ" فی الروایة هی شخصیة شدیدة الطموح شدیدة الطمع، عیونها الجمیلة تتطلع إلى ما هو أبعد من عالم الزقاق وقلبها یخفق لمرأى البنات الجمیلات وهن یرفلن فی ملابسهن الجمیلة، فلا تملك إلا أن تقول ما قیمة الدنیا بدون الملابس الجدیدة، حمیدة متمردة شغوف بأن تعیش حیاة أخرى فی عالم آخر ولم تكن الظروف تعمل لصالحها دائما حینما قذفت بنفسها إلى قلب المدینة الصاخبة وهی تعیش فی أجواء الحرب العالمیة الثانیة، وكانت الحرب بآثارها المادیة والاجتماعیة هی التی دفعت بحمیدة إلى الانحراف كما یذكر نجیب محفوظ متناسیا أن الدین والقیم یجب أن تصون الأعراض وتحفظ المرأة من الوقوع فی براثن الخطیئة.
نأتی إلى ثلاثیة نجیب محفوظ وهی ملیئة بالشخصیات النسائیة المتحررة، وهذا واضح فی شخصیة "سوسن حماد" زوجة الحفید "أحمد عبد المنعم" فی روایة "السمان والخریف" توجد شخصیة "ریری" وهی نموذج فرید للفتاة المنحرفة التی تخرج لیلا ولا تعود إلا فی الفجر، وأصبحت ماعونا ملوثا لكل من هب ودب، ثم تقرر العودة للأخلاق.
وحول هذه الشخصیة تقول الدكتورة "نعمات أحمد فؤاد"ـ فی مقال لها نشرته صحیفة "الأهرام" القاهریة ـ إن نجیب محفوظ كثیرا ما قدم نماذج سیئة للمرأة لكنه قرر بعد ذلك أن یتصالح مع المرأة ویقدم نموذجا للكبریاء المتسامح والقدرة على الصمود أمام الإغراء والزهد فی الإثم الذی ذاقت هوانه وتعاسته وذلك فی روایة الثلاثیة. البدایة والنهایة
أما شخصیة "نفیسة" فی روایة "بدایة ونهایة"فیصورها نجیب محفوظ على أنها ساقطة یائسة، ویعلل ذلك بفقرها وجهلها ودمامتها، وهی شابة فی مقتبل العمر، یمتلئ جسدها بالحیویة والرغبة فی الحیاة، ولكن وجهها الدمیم یخذلها وجهلها یقودها مغمضة العینین إلى مصیرها المحتوم وفقرها لا یترك لها أملا فی الزواج، لقد تحالف علیها ما یدمر حیاة أی فتاة، ولو كانت نفیسة غنیة لربما وجدت من یتغاضى عن دمامتها ویتناسى قبحها، وربما وجدت من یغفر زلتها ویعفو عن خطیئتها فالشرف قید لا یغل إلا أعناق الفقراء وحدهم، نفیسة أقرب ما تكون إلى ملامح البطل التراجیدی الذی تضعه الحیاة فی مأزق، وقد زلت قدم نفیسة فماتت مرتین، یوم أن استسلمت لضعفها ویأسها ویوم أن قفزت إلى أعماق النیل بلا رجعة.
فی روایة "میرامار" نجد شخصیة "زهرة"ابنة الریف الفلاحة الجمیلة التی هربت من قریتها لتعمل خادمة فی "بنسیون" میرامار بالإسكندریة یطمع فیها جمیع نزلاء البنسیون.
هذه كلها نماذج توضح أن عالم المرأة لدى نجیب محفوظ هو من أسوأ الشخصیات، وقد اتخذ نجیب محفوظ هذه الشخصیات الساقطة عن عمد، ولم یفسر لنا ما المقصود باختیاره لهذا السقوط حیث جعل المرأة تسبح فی عالم الرذیلة دون رادع من قیم أو دین أو أخلاق، متجاهلا نماذج مشرفة یذخر بها المجتمع المصری، وبذلك ظلم نجیب محفوظ المرأة عشرات المرات فی أدبه.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:39|
نزعة الحریة عند شعراء العراق المحدثین
لا یفوت قارئ الشعر الحدیث فی العراق أن یلاحظ ملاحظة هی غایة فی الأهمیة، تلك الظاهرة التی تستفزه وتثیر انتباهه حتى وإن تغافل عنها هو ألا وهی النزوع إلى الحریة وإباء الضیم والثورة على الواقع المتردی وعلى نمط الفكر والحیاة، إنها نفوس رهیفة الحس، تنفجر منها براكین تململ وتمرد فتسیل حممها من كل بیت ومن كل سطر حتى لتهدد تلك الحمم بأن تحرق القارئ وتكلفه من الأمر عنتا.
وفی میل العراقیین إلى التمرد وإبائهم الجور ونزوعهم إلى الحریة سبب قوی حتم ذلك یعود إلى تاریخ البلاد الذی أبى فی ماضیه العریق الضیم منذ عهد البابلیین وصراعهم ضد الفارسیین ثم العبرانیین وصولا إلى الإسلام وما لاقاه الإمام علی من تمرد لأسباب سیاسیة انتهت به مقتولا فی الكوفة ثم تمرد العراقیین على دولة بنی أمیة وإشعالهم فتن الثورة هنا وهناك لولا حزم الحجاج وعزمه على إخماد تلك الفتن بحد السیف وأنهار الدم التی سفكت وقد حدثنا عنها التاریخ بإسهاب كبیر.
ولا تختلف قصة العراق الحدیث عن العراق القدیم فالبلد الذی أسماه أسلافنا" أرض السواد" على سبیل الكنایة عن كثرة نخیله وكثرة رزقه كان لا یعرف الاستقرار فمن اضطراب إلى آخر ومن ثورة إلى أخرى، سواء أكان البلد ملكیا، وقد انتهت الملكیة ذاتها بنهر من الدم وأعلنت الجمهوریة لتزداد الانقلابات والاضطرابات السیاسیة ومن اغتیال سیاسی إلى آخر ومن فتنة إلى أخرى ولا یزال شأن العراق ذلك إلى الیوم.
و العراقیون على اختلاف نحلهم وأطیافهم السیاسیة یمقتون الضیم ویأبون الخسف ویثورون على الجور وینزعون إلى الحریة فی الفكر والحیاة، وقد شاء حظهم التعس أن ینكبوا بالمتسلطین فی الحكم وكأن قدرهم هو الهیمنة علیهم سواء من بنی جلدتهم أو من الأجانب ولا یتخلصون من عدو بالدم والنار إلا نكبوا بآخر ولعل هذا ما عناه الشاعر محمد مهدی الجواهری:
1- ولقد رأى المستعمرون منا فرائسا
[!ورأوا كلب صید سائبا!] 2- فتعهدوه فراح طوع بنانهم
[!یبرون أنیابا له ومخـــــــــالبا!] 3- أعرفت مملكة یباح شهید ها
[!للخائنین الخادمین أجانبا؟!] 4- مستأجرین یخربون دیارهم
[!ویكافأون على الخراب رواتبا!!]
ولعل نزعة التمرد ونقمة الثورة أظهر ما تكون فی هذا الشاعر بالذات الذی ذاق مرارة التشرید وألم المنافی غیر أن هذا كله لم یثنه عن النضال فی سبیل حریته وحریة شعبه ألم یقل الجواهری منددا بسكوت الشعب منكرا علیه عبودیته:
لم یعرفوا لون السمــــــاء
[!لفرط ما انحنت الرقاب!] و لفرط مادیست رؤوسهم
[!كما دیــــــــــس التراب!] وفی مطولته " تنویمه الجیاع " صب جام غضبه على الرعیة الساكتة على جبروت الحاكم المستسلمة لظلمه المفرطة فی حریتها وكرامتها وفی هذه القصیدة نزع الشاعر منزع السخریة تنفیسا عن غیظه وبلسمة لجرحه العمیق:
نامی جیاع الشعب نامی
[!حرستك آلهة الطعام!] نامی فجدران السجون
[!تعج بالموت الزؤام!] نامی على جوركما
[!وقع الحسام على الحسام!] أعطی القیادة للقضاء
[!وحكمیه فی الزمام!] واستسلمی للحادثات
[!المشفقات على النیام!] وأما شعراء التفعیلة ورواد الشعر الحدیث فقد تبنوا خطا عروبیا ومسارا قومیا نزعوا فیه إلى حریة بلدهم وحریة الوطن العربی وثورته على الاستعمار الأوروبی الذی اقتسم البلاد العربیة ونهب خیراتها وتفرق أبناء الوطن شذر مذر أو ذهبوا أیدی سبأ وقد التزم هؤلاء الشعراء بقضیة الحریة وتحدیدا الحریة السیاسیة وأشهر شعراء العراق فی هذا المضمار نازك الملائكة وعبد الوهاب البیاتی وبدر شاكر السیاب.
ولنازك الملائكة قصیدة "الشهید" وهی من أجود شعرها تحی فیها روح البسالة فی الشهید والثبات على المبدأ والإصرار على الكرامة إنها هبة الدم الزكی فی سبیل حریة الوطن وعزة أبنائه:
حسبوا الإعصار یلوى
إن تحاموه بستر أو جدرا
و رأوا أن یطفئوا ضوء النهار
غیر أن المجد أقوى
ومن القبر المعطر
لم یزل منبعثا صوت الشهید
طیفه أثبت من جیش عنید
جاثم لا یتقهقر
وقد اشتهر السیاب بقصائده المؤیدة للثورة الجزائریة لأنها ثورة عربیة فی الأساس بل ثورة انسانیة، وكان البیاتی كالسیاب فی نصرة قضایا الحریة لیس فی العراق وحده بل فی العالمین العربی والأعجمی، وقصیدته عن "جمیلة بوحیرد" مشهورة، وتندیده بالعدوان الثلاثی على مصر موقف شهم وإنسانی وقومی مأثور.أما السیاب فیقول فی قصیدة "المغرب العربی" مباركا الثورة على الاستبداد والظلم:
وكان یطوف من جدی
مع المد
هتاف یملأ الشطآن یا ودیاننا ثوری
أیا إرث الجماهیر
تشظ الآن واسحق هذه الأغلال
وكالزلزال
تحد النیر أو فا سحقه واسحقنا مع النیر
وأما البیاتی فیقول فی العدوان الثلاثی على مصر (البریطانی،الإسرائیلی، الفرنسی)
على جبین الشمس بورسعید
مدینة شامخة الأسوار
شامخة كالنار كالإعصار
فی أوجه اللصوص
لصوص أروبا من التجار من مجرمی الحروب
وشاربی الدماء
وأما الحریة الفكریة فلشعراء العراق قصب السبق فی المطالبة بها، فلقد نعوا على الإنسان جموده وتقلیده كما نددوا بالقهر الفكری ولعل الشاعر جمیل صدقی الزهاوی خیر من یمثل هذا الاتجاه وما نزع الشاعر إلى العلم إلا فرارا من الجهل وبعدا عن الخرافة وتشفیا فی أمس عقیم سیطر فیه الجهل وحكم فیه الدجل وأظهر ما تظهر فیه هذه النزعة فی مطولته "ثورة فی الجحیم" وهی مطولة تنحاز إلى الفكر الحر وتثور على ثقافة العامة وتنعى علیهم الاستسلام والخنوع، وإذا كان الفكر الحر ینتهی بصاحبه إلى الخروج على السائد والمألوف ویجعل منه مضغة فی الأفواه ویرمی فی دینه وعقله وعرضه، بل ربما یدفع حیاته ثمنا لإصراره على حریة فكره حتى ینتهی به الأمر إلى الجحیم، فترى الشاعر یرحب بهذا المصیر مادام فی صحبة سقراط ودیكارت ونیوتن وهوغو ولامارتین وأبی نواس وكل أفذاذ الإنسانیة وأنصار الفكر الحر، وما ترجمة الزهاوی "لرباعیات الخیام" إلا تأكید على مبدأ الحریة الفكریة وقد كان الخیام من أكبر أنصارها وفی الرباعیات مقاطع تنتصر لهذا المبدأ على الرغم من تبعاته النفسیة والاجتماعیة والفكریة.
ولقد دافع الزهاوی عن العقل فی شعره دفاعا مستمیتا على الرغم من وصمه بالزندقة والمروق عن الدین وما لاقاه من مضایقات العامة وعنتهم وأنصار الثقافة الرسمیة إلى الحد الذی جعل شعره خالیا من الدفق العاطفی والحرارة الوجدانیة وهو ما أخذه علیه نقاد الشعر، وتحیزه للعقل وللفكر الحر واضح جلی یعبر عنه هذان البیتان:
غیر أنی أرتاب من كل ما قد
[!عجز العقل عنه والتفـكیر!] لـــم یكن فی الكتاب من خطأ
[!كلا ولكن قد أخطأ التفسیر!] والشاعر معروف الرصافی كان فی شعره كما كان فی حیاته مثلا للاستبسال فی الدفاع عن الحریة ضد القهر السیاسی والفكری وقد أعطى بحیاته المستقیمة وخصاصته المثل للمثقف الذی یأبى أن یبتذل عرضه لقاء أی عرض من أعراض الدنیا وهو القائل:
كتبت لنفسی عهد تحریرها شعرا
[!وأشهدت فیما كتبت لهــــا الدهـرا!] ومن بعد إتمــامی كتـــــابة عهدها
[!جــعلت الثریا فوق عنوانه طغرا!] وعـــلقته كیــــلا تنــــالـــه یـــــــد
[!بمنبعث الأنوار من ذروة الشعرى!]
وقد خاطب الحریة أجمل خطاب:
أحریتی إننی اتخــذتــــك قبــلة
[!أوجـــه وجهی كل یوم لها عشرا!] وأمســــك الــــــركن مستســلما
[!وفی ركنها استبدلت بالحجر الحجرا!] إذا كـــنت فی قفر تخذتك مؤنسا
[!وإن كنت فی لیل جعلتك لی بدرا!] وإن لامنی خطب ضممتك لاثما
[!فقبلت منك الصدر والنحر والثغرا!] وإن لامنی قوم علیك فإننی
[!لملتمس للقوم من جهلهم عذرا!] واقرأ هذه الأبیات وقدر ما فی نفس الشاعر من غضب إنها صرخة فی وجه الاستبداد الذی عاث فی البلد فسادا ودجن الناس ونهب أرزاقهم وكمم أفواههم ولقد حالت الكلمات هنا حمما ناریة تسفع الجلود وتلهب النفوس وتحرض الناس على الثورة لقاء حریتهم المهضومة:
أما أسد یحمی البلاد غضنفر
[!فقد عاث فیها بالمظالم سیدها؟!] عجبت لقوم یخضعون لدولة
[!یسوسهم بالموبقات عمیدها!] وأعجب من ذا أنهم یرهبونها
[!وأموالهم منها ومنهم جنودها!!] ولقد جر التحمس للعقل والإیمان بالفكر الحر الشاعر أحمد الصافی النجفی إلى الإقبال على كل فكر والاغتراف من كل نبع والأكل من كل مائدة فكریة ذلك أن القهر الفكری الذی عاناه أسلافه والسیاج الدوغمائی الذی أجبروا على الإقامة داخله قرونا قد عفن نفوسهم وأصاب بالبلى عقولهم وبالصدأ قلوبهم فلیتشف الشاعر من ذلك القهر بالإقبال على الأفكار الجدیدة والعقائد الوافدة یحتضنها وینزلها من نفسه منزلة الحقائق حتى إذا شك عقله فیها اطرحها وطلب غیرها وكأنه نحلة حوامة تطیر من روض إلى روض وتشرب الرحیق من كل زهرة ولو أدى ذلك إلى عذاب الشك وجحیم التناقض ولكن لا بأس فالحریة أغلى مكسب:
تناقضت الأفكار عندی كأنما
[!أنا جمع أشخاص وما أنا واحد!] أرى كل فكر حل عقلی بوقته
[!صحیحا وفكر وقته مر فاسد!] فكم ذرة تفنى وتولد ذرة
[!بجسمی كما تحیا وتفنى العقائد!] فلی كل حین مأتم وولادة
[!وشخصی مولود وشخصی والد!]
ولا نعجب إذا رأینا شاعرا كبیرا بحجم بدر شاكر السیاب یتبنى الشیوعیة مسفها أحیانا الأدیان ثائرا فی وجه الحاكم، ناقما على الظروف قهرها وجبرها، فقد كانت تلك الثورة بحثا عن الحریة فی الأساس، فالفقر والخصاصة قید یغل الإنسان ویرهن حریته وربما اضطره إلى ابتذال كرامته وشرفه لقاء لقمة یتبلغ بها،لقد كانت یساریتة كما كانت یساریة غیره المتطرفة ثأرا من الظروف وتندیدا بهذا القهر التاریخی الذی یحد من الحریة بل یشظیها، حتى إذا اكتشف الشاعر أن الشیوعیة ذاتها لا تخلو من عیوب وأنها قهر آخر یمارسه الحزب عبر قادته وأمنائه، طلقها الشاعر إیثارا لمرونته الفكریة وتعطشه للحریة الإنسانیة التی ظل یحلم بها ویبحث عنها كما ظل أورفیوس یبحث عن زوجته فی عالم الموتى.
ولیس أدل على نزوع شعراء العراق منزع الحریة وإیثار المرونة الفكریة وحریة المناورة من إحداثهم تلك الثورة فی الشعر الحدیث فقد ظل الشعر إلى الأربعینات من القرن الماضی شعرا كلاسیكیا فی ملمحه العام یسیر على طریق القدماء ویسلك طریق المتنبی وأبی تمام والبحتری فی توخی الألفاظ الفخمة والمدویة واقتناص الحكم والتشبیهات البدیعة والاستعارات غیر المسبوقة، ذلك ما عهدناه فی شعر البارودی وشوقی وحافظ، غیر أن شعراء العراق واستجابة لنداء المغامرة ودعوة الحریة فی أنفسهم وهی دعوة فطریة كامنة فیها، ضاربة بجذورها فی غور التاریخ وبتأثیر من الثقافة الغربیة التی تشجع على الحریة وتعضدها خالفوا المسلك المألوف وتبنوا شعرا جدیدا یستجیب لروح العصر وثقافته وسواء أذهبنا مذهب من یضع السیاب رائد لهذا الشعر بعد صدور قصیدته "هل كان حبا" أو ذهبنا مذهب من یقدم علیه نازك الملائكة بصدور قصیدتها "الكولیرا" فكلا الشاعرین من العراق یؤكدان ما زعمناه من نزعة التمرد والثورة الكامنتین فی أنفسهم وهو نفس النهج الذی سار فیه شعراء العراق الآخرون كعبد الوهاب البیاتی ثم مظفر النواب من بعده.
وهی الحركة الشعریة التی أتت أكلها فتجدد وجه شعرنا لیصبح شابا طافحا بالقوة والمناعة مستجیبا لروح العصر وفلسفته متخلیا عن طرائق الماضی وأشكاله التعبیریة شكلا ومضمونا وكانت تلك الثورة المستجیبة لنداء عمیق فی النفس العراقیة هو نداء الحریة سببا قویا فی استجابة شعراء العالم العربی لهذه الحركة فما هی إلا سنوات قلائل حتى صار شعر التفعیلة حدثا فكریا وفنیا وجمالیا مشمخر الصروح وطید الأركان، غالب على أمره له شعراؤه الكبار فی العالم العربی كمحمود درویش وسمیح القاسم وأمل نقل وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطی حجازی وأدونیس ونزار قبانی وغیرهم.
وإنه لیحز فی النفس ما آل إلیه العراق الیوم عراق البابلیین وحدائقهم المعلقة وعراق الرشید والأمین والمأمون ودار الحكمة وعراق " أرض السواد" والرافدین وكان بود كل عربی أن یظل العراق فی طلیعة البلدان العربیة حركة فكریة وشعریة وعلمیة واصلا الحاضر الزاهر بالماضی التلید لولا نكد السیاسة وتآمر المطامع الإمبریالیة على حاضر ومستقبل هذا البلد الذی نأمل لها أن تقبر فی هذا البلد الكریم، بفضل وحدة ووعی ونضال الشعب العراقی الذی سیعید وجه دار السلام الخالد الخلاق والمتألق كما عهدناه بالأمس القریب والبعید.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:38|
شعرنا بین مد التجدید وجزر
التقلی
ألا یاطـــــــائر الــــفردو س إن الشعـــــــر
وجــدان [1]
الشعر صورة من الحیاة ونسل من رحمها ، وهو ترجمان الشعور ، وفیض من توتر الروح وسبحات الوجدان، وكل موضوع من مواضیع الحیاة ،سما أو انحّطٌََُُّّّ مثالیا كان أو واقعیا، وكل همسة أو خفقة قلب أو شرارة انقدحت فی الوجدان هی مجالات الشعر.
ولیس یعنی الشاعر فی شعره بالمثل و القیم العلیا فما هو بفیلسوف ولا داعیة ولا مصلح إنسانی ، وإذا جاء شىء من هذا فی شعره فهو من طریق غیر مباشر وإلا فسدت رسالة الشعر ، ورسالته تجمل فی كلمة فحواها أن الشعر تعبیر عن الوجدان.
إن الشاعر الحقیقی صنو للإنسان الحقیقی فكما لا یكون الشاعر شاعرا إلا إذا امتلك زمام اللغة وتبحر فی بلاغتها وعرف أوزان الشعر وقواعده فلیس هو بشاعر إن خلا قلبه من الحب – حب الكائنات والطبیعة – والسعی إلى إضافة شیء فی المعمار الإنسانی.
ومن ثمة تسقط الدعوة التی یروج لها بعض الناس وهی أن الشعر لا یكون شعرا إلا إذا تضمن الأشیاء العظیمة وحلق فی سماء الفضیلة وماعداه ففحش ومجون.
وفی الواقع فشاعریة الشاعر لا تقاس بنوع الموضوع الذی یتطرق إلیه فی شعره ومن ثمة الحكم بالإبداع أو الرداءة وإنما بطریقة الآداء وكیفیة التصویر ودلالة اللفظ على المعنى وتدفق الشعور كتیار مصاحب للصور الشعریة وهی وحدها العناصر التی یحاسب علیها الشاعر.
وفی تراثنا الشعری القدیم كثیر من المنظوم الذی لیس بشعر، فمنه ما یخلو من صدق الشعور وأكثر شعر المدیح من هذا القبیل وفی دواوین الشعراء الكبار كالمتنبی وأبی تمام والبحتری كثیر من هذه السقطات التی ابتغى بها هؤلاء الشعراء حطام الدنیا مقابل التزییف والقفز على قناعات عقولهم وأحاسیس وجدانهم فالمتنبی الذی قال فی كافور:
قواصد كافور توارك غیره
ومن قصد البحر استقل السواقیا
یعود لیقول فیه :
ومثلك یؤتى من بلاد بعیدة
لیضحك ربات الحداد البواكیا!
ولا لشىء إلا لكونه انتظر إمارة من كافور ولم ینلها:
أبا المسك هل فی الكأس فضل أناله
فإنی منذ حین أغنی وتشرب ؟
فأین هو صدق الشعور الذی انقلب من الضد إلى الضد فی أمد قصیر ولم یسلم شعراء الجاهلیة على علو كعبهم فی الشاعریة من آفة تسىء إلى الشعر وهی آفة التقلید فإذا كان امرؤ القیس قد وقف على الدیار وبكى واستبكى حسب غیره من الشعراء أن علیهم سداد دین لآلهة الشعر لیترصدن خطى الملك الضلیل حتى ولو لم یكن لأحدهم فی سوق الهوى الذیوع وماوقف حقیقة على طلل. ولذا عد أبو نواس شاعرا بحق لأنه قال:
عاج الشقی عن رسم یســـائله
وعجت أسأل عن خمارة البلد
لقد جعل الشعر ترجماناعن وجدانه ولسانا یبین عن حاله، وقد كان أبو نواس رجلا غاص فی الرذیلة إلى الأذقان، ولم تكن حیاته إلا السكر والإمعان فی الفجور وهو یبدع حین یصف عربدته ودعارته ولیس أبدع فی وصف الخمرة وتأثیرها من قوله:
صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها
إن مسها حجر مسته ســـــــراء
وحیاة أبى نواس لا ترضی المثل ولا یرضى عنها أهل المروءة ولكن شعر أبی نواس هو فی القمة من حیث استفائه على عناصر الشعر ومكوناته.
والشعر إذا تخلى عن جوهره وسایر مجالا غیر مجاله فقد صفة الشاعریة وتحول إلى نظم وقل مثل هذا عن الشعر الأخلاقی والوعظی المباشر ودیوان الشافعی ولامیة ابن الوردی خیر مثال على هذا.
والشعر موسیقی فی الصمیم فهو على حد تعریف القدماء له الكلام الجمیل الموزون المقفى، وقد حافظ الشعر العربی على نسقه العمودی أحقابا طویلة، واقتضت ضرورة الحیاة وتطوراتها وتباین البیئة من إحداث تجدید فیه دون التخلی عن الأوزان الخلیلیة وأفضل مثال على ذلك الموشحات الأندلسیة واستعمال الأبحر المجزوءة واستحداث التغییر فی بحر بعینه كمخلع البسیط وقد نظم علیة ابن الرومی هجائیته المشهورة:
وجهك یاعمرو فیه طول
وفی وجوه الكلاب طول
ولكن فی العصر الحدیث ونتیجة لاحتكاك الشعراء بالثقافة الغربیة الوافدة وبتأثیر من الشاعر الإنجلیزی توماس إلیوت، ثار لفیف من الشعراء العرب على عمود الشعر، ذلك أنهم رأوا فیه إكراهات وقیود تعیق حریة الشاعر ولعل أهمها تبعیة الشاعر للغة قصد الاستجابة لدواعی الوزن، وعلى الرغم من أن هؤلاء الشعراء بإمكانهم تنویع القافیة كسرا لهذا الغل، إلا أن هذه الحریة فی معتقدهم لا تشفی الغلیل ، فالشعر تیار نفسی مسكون بالرغائب والهواجس والانفعالات مسكوب فی قوالب لفظیة ودرجة الانفعال وحدته هی التی تتحكم فی طول وقصر البیت وهو مایسمونه بالسطر ولقد كان السیاب ونازك الملائكة والبیاتی وصلاح عبد الصبور وخلیل حاوی وأمل دنقل ونزار قبانی خیر من یمثل هذه الحركة التجدیدیة ، التی لاقت معارضة شرسة من قبل المحافظین على عمود الشعر ولعل أبرز المعارضین العقاد ، وله فی ذلك حجة ذكیة تستحق النظر وفحواها أن الشعر حركة ومناورة فی فن محكوم بالقیود (الوزن والقافیة) والشاعر الحقیقی هو الذی یتحرك بخفة ورشاقة دون أن تحد تلك القیود من مرونة حركته، فهو یعبر عن رغائبه وبنات أفكاره ومشاعره أتم تعبیر وأكمل تصویر وكأن تلك القیود غیر موجودة أصلا وله فی ذلك قصیدة طریفة بعنوان " حانوت القیود"
لا ریب أن العقاد قد غالى فی حملته على الشعر الجدید، وقد جانب الصواب حین أحاله على لجنة النثر للاختصاص، فالبحورالشعریة وشكل القصیدة العربیة المتوارثة لیست وحیا منزلا وما على الخلف إلا الاتباع، فلأبناء هذا العصر ثقافتهم وظروف حیاة تختلف عن حیاة آبائهم وعالم یعیشون فیه یمتلأ حركة ونموا ومرونة فمن السخف غض النظر عن كل هذه الأشیاء والركون إلى میراث الأجداد لاستهلاكه دون أن یضیف إلیه الأبناء شیئا جدیدا.
إن فی الشعر الحدیث إنجازات شعریة كبیرة هی ترجمان الشاعر والعصر على السواء وهی قصائد تستحق البقاء حتى وإن كانت الذاكرة قد ألفت حفظ الشعر العمودی وتردید حكم المتنبی وغزلیات امرىء القیس وخمریات الأعشى ومواجد ابن الفارض .
وإن القارىء الحصیف الحی الضمیر ، المرهف الاحساس ، الغنی العقل لیجد فی قصائد من مثل
" دار جدی " و " أنشودة المطر " للسیاب و "الظل والصلیب" لصلاح عبد الصبور ، الفن الكبیر الذی یغذی العقل والوجدان على السواء
و لا أدل على ذلك من هذا المقطع لخلیل حاوی من دیوان " نهر الرماد " :
خـلــنی للبحــــر للریــــــــــح لموت
ینشـــــر الأكـفـان زرقــــــا للغریـق
مبحـر ماتت بعینیه منارات الطریق
مات ذاك الضـوء فی عینیـه مـــات
لا البطولات تنجـیـه و لاذل الصلاة !
فهو مقطع قد تكاثفت فیه الروح الشعریة ، وتعددت فیه صور الضیاع ومشاعر الكآبة و الانسحــاق ، وموسیقاه مناسبة تماما لهذا الغرض أی الأزمة الوجودیة الخانقة التی یحیاها الشاعر .
والشاعر یعتمد تكرار ( فاعلاتن ) من بحر الرمل فی كل سطر حسب حاجته النفسیة:
فاعلاتـــن فاعلاتــــن فعلاتـــن
فاعلاتــــن فاعلاتـــن فاعـلـــن
فاعلاتن فاعلاتـــن فعلاتـــن فاعلن
فاعلاتــــن فاعلاتـــن فاعـلـــن
فاعلاتــــن فعلاتـــن فعلاتـــن فاعـلـــن
فمن غیر المقبول اعتبار هذا الإبداع الشعری المحكم البنیان ،الغنی بالصورالشعریة ،والطاقة الشعوریة المتدفقة من وجدان الشاعرمحالا على لجنة النثر للاختصاص.
وأزمة الشعر الحدیث فی رأینا تأتی من كون الجیل اللاحق لجیل الكبار ( السیاب، الملائكة ،البیاتی، دنقل، عبد الصبور) لم تستقم له الملكة الشعریة ولاتهیأت له أسباب السیطرة على اللغة العربیة ولاتعمق فی دراسة الشعر العربی الكلاسیكی ، ولاتمرس بدراسة المذاهب والنظریات النقدیة الغربیة والشرقیة على السواء، ناهیك عن الجهل التام بالعروض وقواعده والقافیة وأصولها، وأغلبهم یعجز عن إنشاء قصیدة عمودیة، ولذا تراه تحت دعاوى التجدید والحداثة ومابعد الحداثة یحاول إخفاء عورته والتستر على فقره بهذه الرطانات التی یسمیها صاحبها شعرا حدیثا وفی الواقع هی مؤشر الأنیمیا الشعریة والسقوط الفاضح.
ومانحسب أن هؤلاء الكبار الذین أشرنا إلیهم كانوا یعجزون عن النظم حسب أصول القصیدة العمودیة، وللملائكة والسیاب بل ولعبد الصبور قصائد عمودیة، تدل على تمكن هؤلاء الشعراء من القصیدة العمودیة، ولكنها الروح التجدیدیة الوثابة هی التی حدت بهؤلاء الكبار إلى إنتاج شعری جدید شكلا ومضمونا
الشعر صورة من الحیاة ونسل من رحمها ، وهو ترجمان الشعور ، وفیض من توتر الروح وسبحات الوجدان، وكل موضوع من مواضیع الحیاة ،سما أو انحّطٌََُُّّّ مثالیا كان أو واقعیا، وكل همسة أو خفقة قلب أو شرارة انقدحت فی الوجدان هی مجالات الشعر.
ولیس یعنی الشاعر فی شعره بالمثل و القیم العلیا فما هو بفیلسوف ولا داعیة ولا مصلح إنسانی ، وإذا جاء شىء من هذا فی شعره فهو من طریق غیر مباشر وإلا فسدت رسالة الشعر ، ورسالته تجمل فی كلمة فحواها أن الشعر تعبیر عن الوجدان.
إن الشاعر الحقیقی صنو للإنسان الحقیقی فكما لا یكون الشاعر شاعرا إلا إذا امتلك زمام اللغة وتبحر فی بلاغتها وعرف أوزان الشعر وقواعده فلیس هو بشاعر إن خلا قلبه من الحب – حب الكائنات والطبیعة – والسعی إلى إضافة شیء فی المعمار الإنسانی.
ومن ثمة تسقط الدعوة التی یروج لها بعض الناس وهی أن الشعر لا یكون شعرا إلا إذا تضمن الأشیاء العظیمة وحلق فی سماء الفضیلة وماعداه ففحش ومجون.
وفی الواقع فشاعریة الشاعر لا تقاس بنوع الموضوع الذی یتطرق إلیه فی شعره ومن ثمة الحكم بالإبداع أو الرداءة وإنما بطریقة الآداء وكیفیة التصویر ودلالة اللفظ على المعنى وتدفق الشعور كتیار مصاحب للصور الشعریة وهی وحدها العناصر التی یحاسب علیها الشاعر.
وفی تراثنا الشعری القدیم كثیر من المنظوم الذی لیس بشعر، فمنه ما یخلو من صدق الشعور وأكثر شعر المدیح من هذا القبیل وفی دواوین الشعراء الكبار كالمتنبی وأبی تمام والبحتری كثیر من هذه السقطات التی ابتغى بها هؤلاء الشعراء حطام الدنیا مقابل التزییف والقفز على قناعات عقولهم وأحاسیس وجدانهم فالمتنبی الذی قال فی كافور:
قواصد كافور توارك غیره
ومن قصد البحر استقل السواقیا
یعود لیقول فیه :
ومثلك یؤتى من بلاد بعیدة
لیضحك ربات الحداد البواكیا!
ولا لشىء إلا لكونه انتظر إمارة من كافور ولم ینلها:
أبا المسك هل فی الكأس فضل أناله
فإنی منذ حین أغنی وتشرب ؟
فأین هو صدق الشعور الذی انقلب من الضد إلى الضد فی أمد قصیر ولم یسلم شعراء الجاهلیة على علو كعبهم فی الشاعریة من آفة تسىء إلى الشعر وهی آفة التقلید فإذا كان امرؤ القیس قد وقف على الدیار وبكى واستبكى حسب غیره من الشعراء أن علیهم سداد دین لآلهة الشعر لیترصدن خطى الملك الضلیل حتى ولو لم یكن لأحدهم فی سوق الهوى الذیوع وماوقف حقیقة على طلل. ولذا عد أبو نواس شاعرا بحق لأنه قال:
عاج الشقی عن رسم یســـائله
وعجت أسأل عن خمارة البلد
لقد جعل الشعر ترجماناعن وجدانه ولسانا یبین عن حاله، وقد كان أبو نواس رجلا غاص فی الرذیلة إلى الأذقان، ولم تكن حیاته إلا السكر والإمعان فی الفجور وهو یبدع حین یصف عربدته ودعارته ولیس أبدع فی وصف الخمرة وتأثیرها من قوله:
صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها
إن مسها حجر مسته ســـــــراء
وحیاة أبى نواس لا ترضی المثل ولا یرضى عنها أهل المروءة ولكن شعر أبی نواس هو فی القمة من حیث استفائه على عناصر الشعر ومكوناته.
والشعر إذا تخلى عن جوهره وسایر مجالا غیر مجاله فقد صفة الشاعریة وتحول إلى نظم وقل مثل هذا عن الشعر الأخلاقی والوعظی المباشر ودیوان الشافعی ولامیة ابن الوردی خیر مثال على هذا.
والشعر موسیقی فی الصمیم فهو على حد تعریف القدماء له الكلام الجمیل الموزون المقفى، وقد حافظ الشعر العربی على نسقه العمودی أحقابا طویلة، واقتضت ضرورة الحیاة وتطوراتها وتباین البیئة من إحداث تجدید فیه دون التخلی عن الأوزان الخلیلیة وأفضل مثال على ذلك الموشحات الأندلسیة واستعمال الأبحر المجزوءة واستحداث التغییر فی بحر بعینه كمخلع البسیط وقد نظم علیة ابن الرومی هجائیته المشهورة:
وجهك یاعمرو فیه طول
وفی وجوه الكلاب طول
ولكن فی العصر الحدیث ونتیجة لاحتكاك الشعراء بالثقافة الغربیة الوافدة وبتأثیر من الشاعر الإنجلیزی توماس إلیوت، ثار لفیف من الشعراء العرب على عمود الشعر، ذلك أنهم رأوا فیه إكراهات وقیود تعیق حریة الشاعر ولعل أهمها تبعیة الشاعر للغة قصد الاستجابة لدواعی الوزن، وعلى الرغم من أن هؤلاء الشعراء بإمكانهم تنویع القافیة كسرا لهذا الغل، إلا أن هذه الحریة فی معتقدهم لا تشفی الغلیل ، فالشعر تیار نفسی مسكون بالرغائب والهواجس والانفعالات مسكوب فی قوالب لفظیة ودرجة الانفعال وحدته هی التی تتحكم فی طول وقصر البیت وهو مایسمونه بالسطر ولقد كان السیاب ونازك الملائكة والبیاتی وصلاح عبد الصبور وخلیل حاوی وأمل دنقل ونزار قبانی خیر من یمثل هذه الحركة التجدیدیة ، التی لاقت معارضة شرسة من قبل المحافظین على عمود الشعر ولعل أبرز المعارضین العقاد ، وله فی ذلك حجة ذكیة تستحق النظر وفحواها أن الشعر حركة ومناورة فی فن محكوم بالقیود (الوزن والقافیة) والشاعر الحقیقی هو الذی یتحرك بخفة ورشاقة دون أن تحد تلك القیود من مرونة حركته، فهو یعبر عن رغائبه وبنات أفكاره ومشاعره أتم تعبیر وأكمل تصویر وكأن تلك القیود غیر موجودة أصلا وله فی ذلك قصیدة طریفة بعنوان " حانوت القیود"
لا ریب أن العقاد قد غالى فی حملته على الشعر الجدید، وقد جانب الصواب حین أحاله على لجنة النثر للاختصاص، فالبحورالشعریة وشكل القصیدة العربیة المتوارثة لیست وحیا منزلا وما على الخلف إلا الاتباع، فلأبناء هذا العصر ثقافتهم وظروف حیاة تختلف عن حیاة آبائهم وعالم یعیشون فیه یمتلأ حركة ونموا ومرونة فمن السخف غض النظر عن كل هذه الأشیاء والركون إلى میراث الأجداد لاستهلاكه دون أن یضیف إلیه الأبناء شیئا جدیدا.
إن فی الشعر الحدیث إنجازات شعریة كبیرة هی ترجمان الشاعر والعصر على السواء وهی قصائد تستحق البقاء حتى وإن كانت الذاكرة قد ألفت حفظ الشعر العمودی وتردید حكم المتنبی وغزلیات امرىء القیس وخمریات الأعشى ومواجد ابن الفارض .
وإن القارىء الحصیف الحی الضمیر ، المرهف الاحساس ، الغنی العقل لیجد فی قصائد من مثل
" دار جدی " و " أنشودة المطر " للسیاب و "الظل والصلیب" لصلاح عبد الصبور ، الفن الكبیر الذی یغذی العقل والوجدان على السواء
و لا أدل على ذلك من هذا المقطع لخلیل حاوی من دیوان " نهر الرماد " :
خـلــنی للبحــــر للریــــــــــح لموت
ینشـــــر الأكـفـان زرقــــــا للغریـق
مبحـر ماتت بعینیه منارات الطریق
مات ذاك الضـوء فی عینیـه مـــات
لا البطولات تنجـیـه و لاذل الصلاة !
فهو مقطع قد تكاثفت فیه الروح الشعریة ، وتعددت فیه صور الضیاع ومشاعر الكآبة و الانسحــاق ، وموسیقاه مناسبة تماما لهذا الغرض أی الأزمة الوجودیة الخانقة التی یحیاها الشاعر .
والشاعر یعتمد تكرار ( فاعلاتن ) من بحر الرمل فی كل سطر حسب حاجته النفسیة:
فاعلاتـــن فاعلاتــــن فعلاتـــن
فاعلاتــــن فاعلاتـــن فاعـلـــن
فاعلاتن فاعلاتـــن فعلاتـــن فاعلن
فاعلاتــــن فاعلاتـــن فاعـلـــن
فاعلاتــــن فعلاتـــن فعلاتـــن فاعـلـــن
فمن غیر المقبول اعتبار هذا الإبداع الشعری المحكم البنیان ،الغنی بالصورالشعریة ،والطاقة الشعوریة المتدفقة من وجدان الشاعرمحالا على لجنة النثر للاختصاص.
وأزمة الشعر الحدیث فی رأینا تأتی من كون الجیل اللاحق لجیل الكبار ( السیاب، الملائكة ،البیاتی، دنقل، عبد الصبور) لم تستقم له الملكة الشعریة ولاتهیأت له أسباب السیطرة على اللغة العربیة ولاتعمق فی دراسة الشعر العربی الكلاسیكی ، ولاتمرس بدراسة المذاهب والنظریات النقدیة الغربیة والشرقیة على السواء، ناهیك عن الجهل التام بالعروض وقواعده والقافیة وأصولها، وأغلبهم یعجز عن إنشاء قصیدة عمودیة، ولذا تراه تحت دعاوى التجدید والحداثة ومابعد الحداثة یحاول إخفاء عورته والتستر على فقره بهذه الرطانات التی یسمیها صاحبها شعرا حدیثا وفی الواقع هی مؤشر الأنیمیا الشعریة والسقوط الفاضح.
ومانحسب أن هؤلاء الكبار الذین أشرنا إلیهم كانوا یعجزون عن النظم حسب أصول القصیدة العمودیة، وللملائكة والسیاب بل ولعبد الصبور قصائد عمودیة، تدل على تمكن هؤلاء الشعراء من القصیدة العمودیة، ولكنها الروح التجدیدیة الوثابة هی التی حدت بهؤلاء الكبار إلى إنتاج شعری جدید شكلا ومضمونا
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:38|
الشعر
القصصی فی دیوان ایلیا ابی ماضی شاعر المَهاجَر الاكبر
تتناول
هذه الدراسة ادب المهاجَر و القصة الشعریة فی هذا الادب عامةً و القصة
الشعریةعند اَبی ماضی خاصةً. یُعْتَبُر ادب المهاجر مِن اَغنی الآداب
قیمةً، و یُعتبر ایلیا أبی ماضی مِن أحد اكبر شعراء القصه المهاجرین ومن
اَشهر الشعراء المعاصرین. اِنَّ دراسة وتحلیل القصة الشعریة ـ التی هی مِن
اَروع فنون الادب ـ لها اَهمیة كبیرة. حیثما ندرس القصة الشعریة حقیقةً
نری شیئین متلازمین: الشعر و القصة و هماكانامِن اَغنی فنون الادب فی
تاریخ البشر كله مِن البدایة حتی الان. دراسة القصة فی شعر اَبی ماضی
دراسةً شاملةَ فی الواقع ستنكشف آفاقاً جدیدةً فی الادب و ستزود محبی
الادب عامةَ و اِلی دارسی الشعر و القصة خاصةً بمعلومات مفیدة.
إن السبب فی اختیار هذا الموضوع للدراسة هو شخصیة هذا الشاعر المعاصر الكبیر و كثرة الشعر القصصی فی دیوانه الذی یصل اِلی حوالی اَربعین قصیدة اَواكثر.كما أن الدراسات لم تتناول شعره القصصی بالدراسة مثلما تنازلت قضایاأخرﻯ كالتفاؤل والتساؤل. إنَّ الهدف فی هذه الدراسة هو: 1. تحدید مفهوم الشعر القصصی، 2. نظرةٌ عامةٌ اِلی اَدب المهاجَر و شعراء القصة فی المهاجَر، 3. خلفیة القصة الشعریة فی الادب العربی 4. وعرض تصویراً واضحاً مِن الشعر القصصی فی دیوان اَبی ماضی و شرح وتحلیل بعض مِن اشعاره القصصی، إذ لایمكن تحلیل كُلِّ أشعاره فی مقالة واحدة.
ماهو الشعرالقصصی؟
الشعرالقصصی، هوالذی یعتمد فی مادته علی ذكر وقائع و تصویر حوادث فی ثوب قصة تساق مقدماتها، و تحكی مناظرها و ینطق أشخاصها. فالشاعرالقصصی قد یطوف بحیاته حادث مِن الحوادث تنفعل به نفسه و تتجاوب له مشاعره و یهتزإحساسه، فیعمد اِلی تصویر هذا الحادث كما تمثل لدیه فی قصة ینسج خیوطها و یرسم ألوانها و یطرز حواشیها.(1) كل مافی الامرأنّ القصیدة القصصیة صارت تكتب الان علی أنها نوع ادبی متمیز، تحكی بأجمعها قصة، هی بطبیعة الحال، قصة خیالیة اكثر منها واقعیة و لا یعد هذا عیبا فطیبعی أن یعتمد الشاعر علی عنصر الخیال و قد یبنی مِن تجربة خیالیة عملاً فنیاً كاملاً. فماذا نقرأ نحن فی القصیده القصصیة أنقرأ شعراً اَم قصة؟ و دون أن نستغرق فی التفكیر نرى أنّ التسمیة نفسها تحمل الجواب عن هذا السؤال، فبحكم أنها قصیدة، لابد أن تَكون شعراً و بحكم أنها قصصیة لابد أن تنقل إلینا قصة. فهی شعر و قصة فی آن واحد، و بمقدار متساوٍ. اِنّما تستفید القصة مِن الشعر التعبیر الموحی المؤثر و یستفید الشعر مِن القصة التفعیلات المُثیرة الحیة. فهی بنیة متفاعلة، یستفید كل شقِ فیها مِن الشق الآخر و ینعكس علیه فی الوقت نفسه.(2)
الشعرالقصصی فیالادب العربی:
قاریء الشعر العربی یقع علی كثیر مِن الحكایات التی تؤكد النزعة القصصیة عند بعض شعرائنا القدامی كامریء القیس الذی تبدو هذه الظاهرة فی شعره (عند وصفه للصید) حدیث یبدو الموضوع ذا مقدمة وعقده وحل، و غالباً ماتكون المقدمة وصفاً للفرس اَوالناقة و تنسب العقدة عندما یعن لسرب مِن البقرالوحشی فیطارده و یكر ویفرّ حوله حتی یعود و قد اوقع طریده او عدّة طرائد(3). والفرزدق عرض لحادثة وقعت بینه و بین الذئب فی قصیدة تكاد تخرج عن طبیعة الوصف النقلی التقلیدی للذئب لانه التفت فیها اِلی الجانب القصصی، و أفاض علیها شیئاً مِنالرقة الوجدانیة، اِذقال:
ولیلةٍ بتنا با لفریین ضافنا علی الزاد ممشوق الذراعین أطلسُ تَلَمّسنا حتی أتانا ولم یزلْ لَـــدُنْ فطمتـْــه امـــــّه یتـــلمّـــسُ(4) ویرى الدكتور احمد امین أنّ عمربن ابی ربیعه هو مبتكر فن القصص الشعری ،و كان حریاً بتجربته أن تسهم فی تطویر القصیدة العربیة و تخرجها عن ما رأى لتقلید القصیدة الجاهلیة(5).
اِنّ ما تقدم عن الظاهرة القصصیة فی شعری امرؤ القبس و الفرزدق ماهواِلاّ حكایة لحال، كان یمكن لها أن تكون خطوة علی طریق الفن القصصی الشعری بما تنبی عنه مِن جیشان العواطف و صدق الانفعالات اِلاَ اَنّ العنایة بها لم تتجاوز هذا البوح الوجدانی. لم تعرف العربیة اذن الشعر القصصی بمعناه الغربی و انّما عرضَتْ ضروباً مِن نظم التاریخ تشبه اَن تكون متوناً للحفظ و التسمیع و مازال هذا شأننا حتی اتصلنا بأورباو آدابها فی القرن التاسع عشر و لم یلبث سلیمان البستانی أن نقل إلیاذه هومیروس اِلی لغتنا شعراً و بذلك رأی شعراءنا تحت أعینهم هذااللون من الشعرالقصصی ورأوا مایجری فیه مِن حروب و حوادث مثیرة تدورحول أبطال الیونان و طروادة. إذن القصص الشعری بمفهومه الغربی لم یظهر اِلاّ فی العصر الحدیث(6).
ادب المَهاجَر(7): هو أدب المهاجرین العرب الذین تركوا بلادهم فترة الحكم العثمانی للعالم العربی و استقروا فی الأمیریكیتین الشمالیة و الجنوبیة و أنتجوا أدباً و ابدعو شعراً و أصدروا صحفاً وكونوا جالیات و جمعیات و روابط ثقافیة، و كان إبداعهم الادبی له صفة التمایز عن أدب الشرق بما یجمع مِن ملامح شرقیة و ملامح غربیة(8).
وباستقرارهم فی الأمیركییتین الشمالیة والجنوبیة أنشاؤارابطتین ادبیتین،إحداهما فی المهجرالشمالی و الثانیة فی المهجر الجنوبی، و هما الرابطة القلمیة و العصبة الأندلسیة. أهم أعضاء الرابطة هم: جبران خلیل جبران، میخائل نعیمة، نسیب عریضة، رشیدایوب، ایلیا اَبوماضی و … اما اعضاء العصبة فأهمهم رشید الخوری، الیاس فرحات، شكرالله الجر، جبران سعاده، امین الریحانی، سعید الیازجی …(9). القصة فی شعرالشعراء المُهاجَریین:
كانت القصة فی شعرالشعراء المهاجریین مِن أهم فنون شعرهم، فهی التی تتناول كل احداث الحیاة، و تصور كل مادقّ و جلّ مِن امور الوجود. و لعلّ الشعرالقصصی هو مما أخذه المهاجریون عن أخوانهم مِن شعراء لبنان و الأقطار العربیة الثانیة، كما یعترف بذلك البعض منهم. حیث تری فریقاً ینسب الفضل فی ذلك اِلی شاعر الارزشبلی ملاط و آخر یعود به الی خلیل مطران. القصة الشعریة التی نظم فیها مِن شعراء المشرق: مطران (1872- 1949)، و الرصافی (1875- 1945)، و حافظ ابراهیم (1871- 1932)، والیاس ابوشبكه (1903- 1947) و بشارة الخوری (1889- 1968)، نظمها شعراءالمهجرو صوروا فیها حیرتهم و تساؤلهم و ألمهم و أملهم و بكاء هم و فرحهم. نظمها إلیاس فرحات (1893- 1977)، و رشید ایوب (1871-1941)، و ابوشادی (1892- 1955). والشاعر القروی (1887- 1984)، و فوزی المعلوف (1899- 1930)، وایلیا ابوماضی. اِذن القصة الشعریة كثیرةٌ فی دواوین الشعراء المهاجریین، منها: لإلیاس فرحات قصة شعریة بعنوان «احلام الراعی» و قصة «الاحتجاج علی مذهب داروین» و كذلك قصة الراهبة. و لفوزی المعلوف قصتُةُ المشهورة: آدم و حواء. و لنسیب عریضة مسرحیة شعریة عنوانها: «احتضار أبی فراس»(10). و اَشهر مَنْ برع فی القصة الشعریة، هو إیلیا ابو ماضی، و كثیراً مایعتمد اَبو ماضی علی أسلوب القصص فی شعره ،اَو القصص الأسطوریة و یستخرج منها دروساً إنسانیة ذات قیمة، یعتمد فیها علی عنصری المفاجأة و التشویق. و مهما یكن من أمر یظلّ أبو ماضی مِن الرواد الذین فتحوا صدر الشعر لغیر الغنائیة الذاتیة فزرعوا فیه مواسم جدیدة لموضوعات شعریة جدیدة تتناول الإنسان، فی شتی صوره و تتناوله فكرةً وجوهراً، نفساً و عقلاً. و مثل هذا الغنی فی الطاقة الشعریة، مجموعاً الی القدرة علی التمثل الجماعی لنفسیة الاُمَّة، هوالذی یجعل مِن أبی ماضی شاعراً كبیراً(11).
ترجمةُ حیاة ایلیا أبی ماضی:
یُعْتَبر ایلیا ابو ماضی أحداكبرشعراءالمهاجرومِن اكبرالشعراء العرب المعاصرین(12). وُلِدَ فی قریة «المحیدثة» القریبة مِن بكفیا فی لبنان، سنة 1889(13). حیث تلقی علومه الا بتدائیة ، ثم رحل اِلی مصر و نزل الاسكندریة حوالی (1900)، حیث مكث فیها اِحدى عشَرْسنة. أصدر دیوانه الاول «تذكار الماضی» قبل أن یهاجراِلی أمیركا الشمالیة، عام 1911. ففی مصر بدأت موهبته الشعریة تتفتح و كان للأدیب اللبنانی أنطون الجمیل، الفضل فی اكتشافها و نشر بعض قصائدة فی مجلة «الزهور» المصریة (1910-1913). عمل ابوماضی فی حقل التجارة و الصحافة، قبل أن یهاجر اِلی مدینة «سنسناتی» فی أمیركا حیث أمضی خمس سنوات فیها، ثمّ اتجّه نحو نیویورك سنة 1916. لیواصل عمله فی نظم الشعر و الاتصال بالأدباء و الكتاب فی بعض الصحف التی كانت تصدر هناك. ثم أصْدَر دیوانه الثانی «دیوان ایلیا ابو ماضی» سنة 1918، مما حقق له شهرة واسعة فی عالم الاغتراب و كذلك فی المشرق العربی. ثم صدر دیوانه الثالث «الجداول» سنة 1927 و فی سنة 1929 أصدر مجلة السمیر، و فی سنة 1946 صدر دیوانه «الخمائل» و ظلّ مقیماً بنیویورك اِلی أن توُفّی سنة 1957(14).
القصة الشعریة عند ایلیا أبی ماضی:
فی قراءَ تنا للقصص الشعریة التی تحفل بها دواوین اَبی ماضی، نجدها قصصاً تفیض ألواناً شتی مِن واقع الحیاة و خیالها و رمزها و تشعبات مذاهبها فی الرومانسیة و الرمزیة و الأسطوریة. و قدخاف أنْ یؤخذ علیه حصر قصصه بأبناء وطنه، فعمد اِلی ابراز واقع الشرق ممزوجاً بجوانب الغرب و معطیاته الرمزیة و الرومانسیة، التی تستمد عناصرها مِن خیاله تارة، اَومِن الاساطیر القدیمة طوراً و حرص أیضاً أن یجعل تلك العناصر تتلوّن بألوان الوحدة المعبّرة عن الوحشیّة، الألم الموحی بالعصر، كما أنّه اهتمَّ اهتماماً بالغاً بالحوار القصصی المعبر عن الضیاع المحیط بالمجتمع الغربی و الشرقی فی آنٍ واحد. و هو فی كل ماذكرنا كان ملماً اِلماماً ناجحاً بفن القصة الشعریة و أصول نظمها المعبّر(15). إذن قد تنوعت هذه العناصر القصصیة عند اَبی ماضی، فهی تاره: عناصر قصصیة واقعیة،و تارةً اُخری حكایات خیالیة، و تارة ثالثة حكایات رمزیة(16).
مِن قصصه الواقعیة:
«حكایة حال»: و هی قصة رجل مسن أخلص لزوجته، ولكنها غدرت به لِكبرسنه. «أنت و الكاس»: و خلاصتها أن الحب لایدوم، و آفته أنّه كالنار فی الهشیم… «قتل نفسه»: و هی قصة شاب أضاع غناه، فتخلی عنه صحبه، فانتحر بعد افتقاره «العاشق المخدوع»: و هی تحكی حب فتی لفتاة، تزوجت مِن غیره، فلّما مات الزوج تزوجها الحبیب الاول، فشیبتهُ باسرافها، و نزواتها، فخرج منها بتجربة خلاصتها (لاتمدح حتی تجرب). «أناهو»: و هی قصة فتاة تعطلت سیارتها فی الصحراء، و باتت فی رعب مِن قاطع طریق معروف فی المنطقة، و فی النهایة اتضح لها أنه اخوها الذی افتقدته… و هكذا مع العسر یسر، و مَنْ یصبر ینل خیراً.
«الشاعر والامة»: و مغزاها أن الشعوب النائمة یستبد بها الظالمون. «طبیبی الخاص»: و هی قصة فتی ادعی المرض، و ادّعَتْ حبیبتة أنها الطبیب فجاءَت لزیارته. «بائعة الورد»: و هی تحكی حال فتاة غدربها حبیبها بعد أن خدعها فقتلتْه، و انتحرت. «ضیف ثقیل» و فیها نقمه علی رجال الدین. «ذكری و عبرة»: وخلاصتها أنّه أسكر حبیبته حتی اعترفَتْ بحب غیره فأعرض عنها و هجرها… «حكایة حا ل» و له قصیدة اُخری بهذا العنوان، و لكن هذه القصیدة تحكی قصة شاب كان ثریاً، ثم عضه الدهر بنابه فقررالانتحار، و لكن امرأة محسنة انقذته مِن كبوته.
«وردة و إمیل» و هی قصة شبیهة بقصة رومیو و جولیت، فقد مات الحبیبان شهیدی الحب . «حكایة حال» و هذه قصة اُخری بهذا العنوان، و فحواها ینطبق علیه قول الشاعر:
اذا كان رب البیت بالدف ضارباً فشیمة اهل البیت كلهم الرقص
«الشاعر و الملك الجائر» و خلاصتها أن افكار الشاعر و نصائحه و حكمه باقیه خالدة ، و أنه أبقی علی التاریخ مِن أی سلطان ظالم(17). و منِ حكایاته الرمزیة: دودة و بلبل، رؤیا، الضفادع و النجوم، الغدیر الطموح، الصغیرالصغیر،السجینة،الغراب والبلبل،التینة الحمقاء، الابریق، ابن اللیل، العیر المتنكر، العلیقة، الكنارالصامت و…
و من حكایاته الخیالیة: الاسطورة الأزلیه… أمنیة إلهة … و الشاعرفی السماء(18) و… و سنكتفی فیما یلی بدراسة نماذج لهذه العناصرالقصصیة من حیث المضمون و الأسلوب .
شرح و تحلیل نماذج من قصصه الواقعیة:
الف: الشاعر و الملك الجائر(19):
مضمونها: تندید جورالحكام
ملحض القصة أن ملكاً ظالماً معتداً بنفسه یری حدود العالم و ما فیه مِن شؤون و شجون ینتهی فی حدود سلطانه الذی تمثّل فی مملكة واسعة حوت القصور الفخمة و الجنائن المعلقة و العزّ البراق و مظاهر العظمة و الفخامة التی شُیّدت بدماء المساكین و علی حساب حیاتهم و بالمقابل جعل ابوماضی مِن شاعر موهوب، حرّ و طلیق یتغنی بسّر الكون و یتحلی بفكر جّم و بنفس عالیة المثال… جعله نقیضاً للملك، فالشاعر مثال للحكمة الأزلیة الشاهدة علی بقاء القیم، و الملك نموذج للمغترّین الذین نظروا لآنهم و كأنه دیمومة، و صدروا عن أحكامهم و كأنهم خُلقوا وحیدین فی هذا العالم.
تبدأ لحظة الصراع بالاحتكاك بین هاتین الشخصیتین النقیضتین… اِذ یستدعی الملكُ الشاعر و یطلب منه أن یصف جاهه و سطوته و ملكه…
قال: صِفْ جاهی، ففی و صفك لی للشعرجاهُ اِنّ لـی القصر الذی لاتبلُغ الطیُرذُراهُ
ولــــی الروض الـــذی یعبَقُ بالمســـك ثراه ولــی الجیش الذی ترشحُ بالموتِ ظِباهُ
فماكان مِن الشاعر اِلاّ أن سخر مِن الملك و مِن طلبه … و أجاب بأبیاتِ لاذعة تنم عن هزء و استخفاف، تصور مجد الملك الباطل و قوته المصطنعة الزائلة و عرشه المزعوم المشاد مِن جماجم البشر و قال اَبو ماضی متابعاً وصف الموقف(20):
ضـــحك الشــاعرُ ما سمعتهُ اُذناهُ و تمنـــی أن یُــــداجی فعــصتهُ شفتاهُ
قال: اِنیّ لاأری الأمرَ كما أنت تراه اِنّ ملكی قدطوی ملكك عنی و مَحاهُ
فا لشاعر ضحك مِن كلام السلطان و لم یطاوعة قلبه و لسانه علی أن یحابی اَویتملق، فإنّ لَهُ منِ نفسه ملكاً یتضاءل أمامه اَی سلطان آخر. و لذلك أجابَ السلطانَ بقوله:
القصر ینْبیء عن مهارة شاعر لبق، و یخبر بُعْدَه عنكـــــــــا
هو لـــلالی یَدرون كُنه جماله فـــــإذا مضوا فكأنه دُكــــــــا
ستزول أنت ولایزول جلاله كالفُلكِ تبقی، إنْ خَلَتْ، فُلكا
ثمّ تحدث عن الروض و الجیش، والبحر، و الجبل التی یدعی السلطان أنّه یملكها، و ختم حدیثه بقوله:
و مررتُ بالجبلِ الأشْمَّ فما زوى عنی محاسنََه ولستُ أمیراً
و عند ذاك احتدم غیظ السلطان علیه فأمرالجلادَ أن یدحرج رأس الشاعر عن كتفیه، فلما. سقط رأسه یتدحرج علی الأرض، غضب السلطان و قال: "ذوجنة، أمسی بلاجنتهْ"(21). فانظر اِلی هذه الصورة التی یحشد فیها ابو ماضی جملة مِن الشروط الفنیة للعمل القصصی:
فاحتدمَ السلطانُ ایَّ احتــــدام ولاحَ حـــُبُّ البطش فی مقلتیهْ
وصاح بالجلاد: هاتِ الحسام فـــأسرعَ الــجلّادُ یسعــــی إلیهْ
فقال: دحـــرجْ رأسَ هذا الغلام فــــرأسُهُ عبءٌ علـــــی منكبیه
سمعاً و طوعاً، سیّدی: وانتضی عَضَباً یموج الموتُ فی شفرتیهْ
نشیر فی هذا المقطع الی جملة مِن الامور:
اولها: الموقف الانفعالی للملك… و هو تتبع لحركة نفسه الداخلیه التی استثارها الشاعر بحدیثه المطول حتی نال مِن الملك و بلغ عمقه النفسی البشْع، ولعلّه یعرفه مسبقاً و یعرف اَی مورد یورد نفسه… و هو موقف فیه مِن التزواج و الانسجام بین ظاهر الملك و باطنه. أماثانیها: فهوا الحوار السریع الذی رافق المشهد: احتدام الملك و توجیهه الاوامر للجلاد و اسراع هذا الآخیر للتلبیة… ثالثها: میّزات الشخصیات التی تتحرك أمامنا: فالملك مغتّر بنفسه و الجلاد عبدٌ مطواع ینفذ من دون اعتراض، بطبعه و بحكم مهنته خاضع مسیر(22).
أكدّ الشاعرفی هذه القصیدة أن الجاه الحقیقی هو فی غنی النفس و ترفعها عن السفاسف. فلم یَرفی الملك اِلاّ عظمة مفتعلة واهنة و فی العرش كرسیاً مِن حطام خشب(23).
یعتمد ابوماضی اذاً علی الزمن اعتماداً كلیاً لیرینا نتائج موعظته… فإذا المغتر بقوته یدور علیه هذا الزمن و یفقد عرشه و تتحول مملكتهِ إلی هشیم. و یزحف إلیه سلطان الموت لیلتقی بالشاعرفی العالم الآخرلقاء مواجهة اُخری تظهر عظمة الفكر و انتصار الشاعر بآرائه التی عمّت العالمین و خلدت صاحبها، بینما المجد الباطل و السؤدد المصطنع ینهار ویندثر مع الزمن و لایعود ذكر فی الآفاق، علی عكس اقوال الشاعر التی لاتزال حیّة یتوارثها الناس مِن جیل اِلی جیل و یردد و نها حكمة اُزلیة(24). و فی النهایة: فی لیلة طامسة الانجم تسلّل الموتُ اِلی القصرِِ
بین حراب الجند و الأسهَمِ و الأسیفِ الهندیه الحمرِ
اِلی سریر الملكِ الأعظم اِلـــــــــی أمیر البَّروالبحرِ
فی حومة الموتِ و ظلِّ البلی قــــد التقی السلطانُ و الشاعر
لایجزع الشاعرأن یُقتلا لیس و راء القبر سیفٌ و رمحُ
و الشاعر المقتول باقیةٌ أقــــــــواله فكانــــــــها الأبَـــد
الأسلوب:نجد أبا ماضی تارةً ینظم القصیدة الواحدة متعددة البحور و القوافی منها: هذه القصیده یعنی «الشاعر و الملك الجائر». هذه القصیده، قصیدةٌ طویلة نسبیاً، فی نحو سبعین بیتاً، مقسمة اِلی ستة مقاطع، و اختلفت فیها البحور و القوافی (نّوع ابو ماضی فی اوزان القصیدة الواحدة و قوافیها)،المقطع الأول بحرهُ الرمل و قافیتهُ «ها» المضموم و فی المقطع الثانی، بحرهُ الكامل و المقطع الثالث، والرابع و الخامس، بحرهُ السریع و المقطع السادس بحرهُ الرمل. ونری اختلاف القافیة فی المقاطع المختلفة أو فی الأبیات التی جاءت فی مقطع واحد. ب: الشاعر والامُة(25)
(مضمونها: الحكمة: مَنْ یَعْرَف حقَّهُ لَنْ یُظْلَم)
فی قصیدة «الشاعر و الأمة» و هی تتألف مِن 59 بیتاً ـ یتحدث الشاعر عن اُمَّةٍ كانت تعیش فی رخاء و منعةِ و حریةِ، فی كنف ملكٍ عادلٍ یُحِبّ شعُبه ویتفانی فی خدمته، حتی اوصل شعبه اِلی اَفضل ما تتمناه اُمّةٌ مِن العیش و الرغید. (26)
كان فی ماضی اللیالی اُمَّةٌ خلـــع العِزُّ علیها حـِبَرَهْ
یجِدُ النازلُ فی أكنافها اُوجهاً ضاحـکــَةً مستبشرهْ
كان فیها ملكٌ ذوفطنة حازمٌ یصفحُ عندالمقدره
ثم مات الملك و خلفه ملك طائشُ الراُی، أفسدتْهُ حاشیة سوءٍ لاتُحب الخیر للشعب، و زینت له آثامه و شروره فركب رأسه و مضی فی طرق البغی، لایلتفت اِلی مصلحة شعبه ولایعتنی بمملكته، وسكت الشعب علی شروره فلم یحاسبوه، حتی استفحل فیهم ظلمه و بطشْهُ، فراحوا یبكون علی قبر سلفه العادل الأمین.
مات عنها، فأقامت مَلِكاً طائش الرأی كثیرَ الثَرثَرَه
حولَهُ عُصْبةُ سُوءٍ كُلّما جاءَ إذاً اَقبَلـــَتْ مُعْتــــَذَرَهْ
و فی أحد الایام مرّشاعرٌ بمقبرة البلدة، فرأی شیوخها یبكون عند قبرالملك السابق. فلما سألهم عن سبب بكائهم،أجابوه بأنهم یبكون العدل و الرحمة و الحریة و العزة فی ذلك القبر، و شكوا مِن جور ملكهم الحالی وطغیانه و فجوره.
مرَّیـــــوماً فــــرأی أشباهَ جـــلسوا یبكون عندالمقبره
قال مالكم؟ … ما خطبكم اَیُّ كنزٍ فی الثَری اَوجوهَرَهْ
قال شیخٌ منهم مُحْدَودِبٌ ودموعُ الیَأسِ تْغشَی بَصَرَهْ
اِنّ مَنْ نبكیه لو أبْصَرَهُ قیصــــرٌ أبصر فیه قیصَرَهْ
كلّما جاءَ إلیه خائــــن و اشیــــاً قَرَّبَهُ و استـــَوْزرهْ
وعند ذالك:
هزأ الشاعر منهم قائلاً بلغ السوسُ أصولَ الشجرة
رحمةُ اللهِ علی اسلافكُم إنهـــــّم كانــــــوا تُقاةً بَرَرَهْ
إنّ من تبكونَه یاسادتی كالـــذی تشكون فیكم بَطَرهْ
لوفعلتم فِعْل أجدادكـــم ماقضی الظالمُ منكم و طرَه والعبرة مِن هذه القصة الشعریة واضحةٌ جداً، فطغیان الحاکم وبغیه لا یمکن أن یسود شعباً یعرف حقوقه و واجباته، و یعمل لرفا هیة نفسه و عزة بلادِه و یوقف الطغیان و الفساد و الفجور عند حدودها(27).
الأسلوب:اِنها قصیدة طویلة نسبیاً فی نحو ستین بیتاً، علی بحرالرمل و روی واحد وهؤ«الراء»، مقسمةً إلی اَربعة مقاطع ویبدو تغییر المقاطع یرتبط بالتغییرالزمنی والمكانی و الموضوعی.
ج: هی(28) مضمونها: تمجید الأم
هذه قصة محفل مِن الاخوان عندأحدسراتهم، تدورعلیهم الكؤوس، و تغمرهم امواج المرح و البشر، و یدعوهم صاحب الحفل اِلی أن یشربوا نخب صاحبته، ثم یدعوهم اِلی أن یشربَ كل منهم نخب صاحبته فی الحفل.
قام أمیرالقصــرِ فــــی كفّهِ كأسٌ أعارنهُ مــعانیها
و قال: یا صحبُ علی ذكركم أملأها حبّاً و أحسوها
ولكن فتی ظل ساكناً دون أن یرفع كأساً اَویشارك فی نخب فسأله صحبه:وأنتَ؟
قال: أجل، اَشرب سرالتی بالروح تفدینی و أفدیــــــــها
صورتها فی القلب مطبوعة لاشیء حتی الموت یمحوها
قد وهَبَتنی روحــــها كلــــها و لم تخف أنی أضحیــــها
ولكن السیدات استشطن غضباً، و تحفر الرجال اِلی الانتصاف منه لهذه الإهانة الموجهة لسیدات فی مجلس أنس و شراب.
و هكذا یتاُزم الموقف و تتعقدالقصة و حینئذٍ یتقدم صاحب الدعوة و یقول
فصاح رب الدار: یاسیدی وصفتها لم لاتسمیها
أتخجل باسم من تهوی أحسناء بغیــر اسم؟
و عندها تصل لحظة «التنویر« اِلی غایتها:
فاطرق غیر مكترث وتمتم خاشعاً … اُمی
تمتاز هذه القصه بالحركة و الحیویة. و ممالاریب فیه أن الحوارالذی سیطرعلی مواقفها هوالذی أضفی علیها هذه الصفة الواضحة، حتی قد بدت القصة فی جملتها تصویراً لمجلس شراب جری فیه هذا الحوار الحیوی. فقد بدأ الشاعر بروایة القصة دون مقدمة و تمهید و انتهی كذلك بانتهاء الحدث، بل بآخر كلمة تتضمن الفكرة العامة فی القصة، و هذا بلاریب یكشف عن براعة فی السبك. و أصالته. فقد ظل یماطل القاری و یشوقه حتی النهایه، ثم فاجأه بهذا النتیجه غیر المتوقعة، و قد بلغت براعة الشاعر فی تصویر تلك العادة، اَن جعلها فذة فریدة. و القصة فی جملتها مركزة، موجزة و قدعینت با براز الفكر المجردة و تجیدهادون الالتفات اِلی النواحی الفنیه الاُخری(29) الأسلوب:قصیدة «هی» مقسمة علی مقطعین اِثنین ، بحره السریع و قافیته «ها»فی نحو سبعة و ثلاثین بیتاً.
شرح و تحلیل نماذج مِن قصصه الرمزیة:
لیس المقصود بالرمزیة هنا تلك الرمزیة التی یفهمها الغربیون فیالادب، لكن المقصود بها ذلك اللون الموضوعی الذی یرمز بالقصیدة كلها مثلاً، اَوبالعمل الادبی كله اِلی شیء معین،كالرمزفی حكایات كلیلة و دمنة و خرافات لافونتین الفرنسیة الدالة علی مصیر الظالم و جزاء الواشی، اَوعاقبة المغرور فی مساق حكایة علی لسان البهائم و الطیور و اذاكان اَبو ماضی یوحی فی كثیرٍ مِن قصائده بأفكار، فلیس ایحاؤه ایحاء الرمزیین، لأنّ هؤلاء ینتقلون أحیاناً فی قصائدهم مِن فكرة اِلی فكرة علی أساس الإحساس و الشعور النفسی مع ضعف الرابطة المنطقیة بین الفكرتین، ولكن أبا ماضی بجانب عنایته بالاحساس و الشعور النفسی فهوأ یضاًً یعنی بالرابطة المنطقیة فی قصائده الرمزیة.(30).
التینة الحمقاء(31) مضمونها: عاقبة التكبرهى الفناء
التینة الحمقاء التی و هبها الله الأفنان الباسقة، والجذع القوی، و الثمرالذكی، و لكنها رغم جمال منظرها، فقد اعتراها الكبر و الحمق حین قالت لِأترابها لا اُرید أن اَمتع الناس بثمری اَو جمالی، و لا اُعطی الطیر منِ ثمری و أغصانی. و فی سبیل ذلك سأجعل حجمی مفصلاً علی مایحتاجه جسمی(32)و فی ذلك یقول:
اِنی مفصلةٌ ظلی علی جَسَدی فلایكـــون به طولٌ و لاقِصَرُ
ولستُ مثمرةً اِلاّ علــــی ثِقَةٍ أنْ لیس یطرُقُنی طیرٌ ولابشرُ
وعندماجاءَ الربیع، وقدزین الدنیا بالأخضرالسندسی من الورق، والطیب الزّكیّ مِن الثمر، ظَهَرَتْ التینة الحمقاء عاریة، لامنظرَ یجملّها ولاكساءَ یكملها، فكانت النهایة الحزینة التی قال عنها الشاعر:
ولم یُطِقْ صاحـبُ البستانِ رؤیتها فاجتثها فهوتْ فیالنار تَستعر
مَن لیس یسخو بما تسخوالحیاة به فإنّه أحمقٌ بالحـــــرص یَنتَحِرُ
هذه التینة هی نقیضُ "الحجرالصغیر"(33) لِآنّ الطبیعة فاضَتْ علیها بكل خیرٍ فیها، توهم «الحجرأنّه عاطل منه كل عطلٍ. و كلاهما انتحر بوعی و اختیار. الشجرة ساقت الموت الی نفسها سوقاً، إذا امتنعت بذل ماسخت علیها الطبیعة به،وعطلت فی ذاتها وظیفة الحیاة. لِكل موجودٍ مبررٌ لوجوده فیما یهبه للحیاة، والعطاء هو كالدم الذی یُغذی عروقها، فإذا ضنّ كلّ من ابنائها بخیره یبسَتْ شجرتها و ماتت. العطاء هو الفرح و التجدد، و فی هذه القصیدة، أیضاً، تنساق المعانی و توقع لتخدم الخاتمه الحكمیة التفاؤلیه.
وقد لانعثر فیالحیاة علی مایشابه هذه التینة إذیعمد المرء اِلی البطالة خموداً اَوكسلاَ اَولهواً و مجوناً ولایطالعنا امروٌ یكف عن العمل لیمنع خیره عن الآخرین.
اِلاّ أن لَأبی ماضی مَرمیّ آخر،یقصد فیه القتل والانتحار المعنویین اَواِلی افتقاد السعادة اِذا لاسعادةَ بلاعمل و عطاء(34) و أخیراً: فی قصیدة «التینة الحمقاء» یرینا الشاعر أن مالا ینفع الناس لایسمح له الناس بالبقاء، و المنطوی علی نفسه لانفع منه و لافائدة فی بقائه(35) الاسلوب:قصیدة قصیرة نسبیاً فی أحدعشربیتاً،وروی واحد وهو حرف "الراء"فی البحر البسیط.
الضفادع و النجوم(36):
مضمونها: الهجاء السیاسی
قصیدة «الضفادع و النجوم» فهی اسطورة ساخرة mockepic صوّر فیها ابو ماضی زعیمة الضفادع،و قدت تطلعت اِلی النجوم ذات لیلة،وهی تلقی ظلالها فی السماء، فخیل إلیها، و متی كان للضفدع قدرة علی التفكیر و التمییز، أنّ النجوم قد نزلت من سمائها و أغارت علی الماء، فصاحت الضفدعةفی رفاقها:
یا رفاقیا! یا جنـــودی! احتشدوا عَبَرَ الأعداءُ فی الیل التخوم
فاطردوهم، واطردوا اللیل معاً إنـــــه مثلــــــهم بــــاغٍ أثیمْ
ولاشكَّ أنّ زعیمة الضفادع و جنودها رغم ضآلة أجسامها و حقارة شأنها، قدملأت الدنیا ضجیجاً، و أرسلت فی الفضاء، أصواتاً مدویة مفزعة:
فی أدیم السماء مِن أصواتها رعدة الحمی، وفی اللیل وجومْ
واحتشد الجنود وظلتْ تنق و تضج حتی طلع الفجر، و ماذا تستطیع أن تصنع الصنفادع حیال النجوم غیر الضجیج و النقیق، و ما أن بزغت أنوار الفجر حتی ارتفعت ظلال النجوم،فظنتْ زعیمةالضفادع، أنّها قد أرعبت النجوم فطارت خوفاَ وفزعاَ إلی السماء(37). فماذا صنعت زعیمةالضفادع؟ مشت فی سرها:
أیها التاریخ سجَّل أننا اُمّةٌ قد غَلَبَتْ حتی النجومْ
هذه صورة رمزیة للحقیرالذی یدعی أنه صنع شیئاً عظیماً، ثمّ یتفاخر بمالم یفعل دلالة علی حقارته وادعائه، یسخربها الشاعر مِن طبائع صنف مِن الناس طغت علیهم الكبریاء، علی الرغم من فشلهم و تقصیرهم و قداستعان الشاعر فی ابراز هذه الفكرة بمظهر طبیعی وهواللیل و النجوم و الضفادع…(38)و فی الحقیقة «الضفادع و النجوم» تفسیر لفكرة الغرور والخداع النفسی(39).
الاسلوب: قصیدة قصیرة نسبیاَ فی أحد عشربیتاً، فی بحرالرمل و روی واحد و هو میم الساكنة. دودة و بلبل(40)
لأبی ماضی قصیدة بعنوان «دودة و بلبل » یرمز فیها اِلی أن الحقیر یلتزم الخنوع دائماً، یرضی بالذل، لان طلب المجد یتطلب سلاح المغامرة و الاقدام… و الحقیر خلوٌ منِ هذا السلاح فها هی دودةٌ نقمت علی حیاتها و شكت لأنها لم تخلق طائرة كالبلبل، فقالت لها زمیلتها النملة: لاتتمنی أن تكونی طیراً یصاد فالأرض لمثلك طیبة والخنوع مریح، و طلب المجد مغامرة لیست مأمونة العواقب…
(و هذه لفتة لتبریر عدم طموح الوضیع و ایثاره السلامة) و هی فكرة تذكرنابقول المتنبی
واذاكانت النفوس كباراً تَعِبَت فی مُرادها الأجسامُ
و شاعرنا استخدم الطبیعة الحیة فی ابراز هذه الفكرة وزج العظة التی یبغیها مِن ورائها(41).
نَظَرَتْ دودةٌ تـــدبُّ علـــی الأرض إلی بلبل یطیرُ و یصـــــــــدَحْ
فمضَتْ تشتكی اِلی الورق الساقط فـــــی الحق أنها لم تجنـــــــّحْ
فَأتَتْ نمـــــلةٌ إلیــــها و قالَــــــــتْ اقنعی و اسكتی فمالك أصلجْ
مــــــــــا تمنیـــــْتِ اِذا تمنیــــتِ اِلاّ أنْ تصیری طیراً یُصادُ و یُذبَح
فالزمی الارض فهی أحنی علی الدودِ و خلّی الكلامَ فالصمــتُ أریح
الاسلوب: قصیده قصیرة جدا فی خمسه أبیات، فی بحر الخفیف و روی واحد و هو الحاء الساكنة، استفادالشاعر فیها من اسلوب التهكم.
دراسة و تحلیل نماذج من قصصه الخیالیة:
الشاعر فی السماء(42): مضمونها: حُبُّ الوطن
فی قصیدة «الشاعر فی السماء» یفترض مشهداً خیالیاً، فیزعم أنَ الله رقّ لبؤسه علی أرض الشقاء، فأرجعه اِلی السماء، و شید له ملكاً علی الفضاء و جعل الضیاء و الشهُب مِن دونه و سلّطهُ علی الصبح و المساء،و الغیوِم والریح. اِلاّ أن ذلك لم یُجْدِه عزاءً، وأقام علی وجومه و همومه، فخیل اِلی الله أنّه مازال یحِنّ اِلی الغید و الخمرة، فاستل مِن قلبه حبهما، فطلب منه أن یتمنی فیحوله اِلی مایشاء، نجماً اَو طیراً اَوذا ثراء و قصور، لكن الشاعر أبی ذلك كله و أجاب الله(43):
فقُلْتُ: یاربُّ فصــلَ صَیْفٍ فی أرض لبنانَ اَوشتــــــاءْ
فإنّنی مهــــــنا غـــــــریبٌ ولیـــــس فی غُربة هنـــــاء
فاستضحك اللهُ مِن كلامی و قــــــال: هذا هُوَ الغَبــــَاء
فقال: ما أنـــــــــت ذوجنون وَاِنّمــــــــا أنـــــــتَ ذووفـــاء
فإنَّ لبنانَ لیــــــــــس طَوْداً و لابــــــــلاداً، لكنْ سمــــاء!
انهّا القفلة المدهشة ذاتها فی نهایة القصیده، إلا أنَّ القصیدة بمجملها ذات شفافیة و رقّة إذتمثل مطامع الإنسان و تورد شریطاً مِن الصوروالبهجة فی مثل أجواء الاسطورة(44)
هذه القصیدة الوطن الذی یؤثرهُ الشاعر علی الجنة، و قد جاء بمعانیها علی ایقاع السرد، حیناً و اِلی النجوی التی یتنفس فیها حلم الحریة و تسقط شهوات النفس و نزواتها ولایصمد فیها اِلاّ حب الوطن و الحنین إلیه حیناً آخر.(45).
الاسلوب: قصیده مطوسطة الطول نسبیاً ، فی نحو سبعة و ثلاثین بیتاً، فی بحرالمنسرح و روی الهمزة الممتدة المسبوقه بحرف المد(اء) مقسمة علی ثلاثه مقاطع و یبدو تغییر المقاطع مرتبطً بتغییر الموضوع.
الأسطورةالأزلیة(46) (مضمونها: كل شیء فی مكانه أجدر)
تتلخص هذه الحكایة فی أنّ الناس قد ضجّوا مرّةً بالشكوی اِلی اللهِ، وودّوا لوأعاد تكوینهم مِن جدید، فنزل دوالجلال علی مشیئتهم، و هبط إلیهم فیلبلة قمراء، یستمع اِلی شكایاتهم و یتساءَل عن مصدرهیاجهم، فتقدم إلیه كل منهم بشكواه، و اول المتقدمین شاب ناقم علی حظه مِن الحیاة، لأنّ الله قد جعله شاباً یعیش بین جماعات مِن الشیوخ لایرون فی الشباب اِلاّ طیشاً و رعونة و حمقاً فهولذلك یرید اَن یسرع به الزمن لیغدو شیخاً حكیماً، فیتخلص مِن احلام الشباب التی یشقی بها كثیراً:
عِبٌ علی نفسی هذا الصبّی الجائش المستوفزُ الطّامی
ولایكاد الفتی ینتهی من شكواه، حتی یقف بین الجمع شیخ «مشتعل اللمة، بالی الإهاب، فیصرخ سائلاً خالقه أن یأخذ كل حكمته و یرّد علیه الشباب، فقد ذبلت حیاته بذبول أمانیه، و هو یریدالمنی اَمامه لاوراءه، و لوزادت بها متاعبه:
مُرْتقِف الأیامُ عن سیرها فإنها تركض مثل السحاب
و نهضت بعده فتاة حسناء، تعاتب ربها لانها خلقها جمیلة، و الجمال لایورث اِلاّ الفضائح و الأقاویل:
وجهی سنیٌ مشرقٌ، اِنّما مرعی عیون الخلق هذا السَّنی
فهی لاتسلم من ثرثرات الألسنة، ومِن خیانة الأعین التی تلاحقها لِغمزات الحنیةو الریبة. ثمّ تسكت الحسناء، فهبت الجاریة الدمیمة، حانقه ناقمه علی قسمتها القبیحه فتقول:
ذنبی اِلی هذا الوری خلقتی فهل أنا المجرمة الجانیة؟
فهی تعلم أنّ للجمال الرتبة العالیة،فلوكانت جمیلة و تری أنّها تعیش فی عالم أحكامه جائرةً، من جور هذه الأحكام أنه:
لیس لذات القبح مِن غافِر وفیه مَن یغفر للزّانیة
وقد ذكر التاریخ أن السید المسیح قد غفرللزانیة، و اَنقذها مِن الرجم، فمن هوالذی غفر لفتاة دمیمة دمامتها؟ و لِمَ لایهبها الله الحسن، و هوالذی خلق نفسها علی صورته و مثاله ؟
وهكذا یأتی دوراالصعلوك الفقیر و الغنی، والأبله و العبقری اللبیب و…
قال الغنی: اِننی فیالقصر الرفیع الذرا كطائـــــــر فی قفــص میت
اِن كنـــــــت اِنسانــــــــاً فلم یــــــاتری لست بادراكی كباقی العباد؟
قال الفقیر: یصرخ یا ربّاهُ حتّی متــــی تُحَكَّمُ المِـــــوسرَ فی نفسی؟
و تضــــــــعُ التــــــــاجَ علــــــی رأسه و تضعُ الشوك علی رأسی؟
و أخیراً:
تنتهی الشكایات كلها ویقف الجمیع فیانتظار حكم الكائن الأعلی … و…
لمّا و عی اللهُ شكایا الوری قال لهم: كونوا كماتشتهون
فكانوا كمایشتهون، ویطلع الصباح علی الكون، فإذا الحیاة هی مِن جدید: فیها الشاب و الشیخ، الحسناء و القبیحة و الفقیر و الغنی، والأبله(47) و اَما الحقیقه التی لاتتغیر ـ كمایراها ابوماضی ـ فهی أنه:
ولیسَ مِن نقص ولا مِن كمال فالشوك فی التحقیق مثل الاقاح
و ذرة الرمل ككلّ الجبــــال وكالّـــــــذی عَزّ الـــــــذّی هانا
و هكذا الحقیقة لمن أمعن فیها: لانقص و لاكمال، و الشوك كالزهر، و ذرة الرمل كالجبل الاشم، و العزیز كالمهان و الناس یتمردون علی كل واقع.
و قد قال «ایلیا ابوماضی» فی مقدمة نشره لهذه القصة الخیالیة اول ما نشرت فی مجلة «السمیر» سنة 1933: «اِنّ یوماً یرضی فیه الانسان عن نفسه لهو الیوم الذی تنتهی فیه مهمة الانسان علی الأرض(48).
الاسلوب: قصیده طویلة نسبیاً فی نحومئة و أربعین بیتاً مع تنوع القوافی و وحدة البحور، مقسمة علی عشرة مقاطع و فی كل المقاطع البحر هو السریع ولكن القوافی تختلف. فی المقطع الاول، حرف الروی هو«الهاء» الساكنة،و فی الثانی المیم،و فی الثالث، الباء الساكنة، و فیالرابع،«النون»، و فی الخامس «الیاء»،و فی السادس، «السین»، و فی السابع،«ة»،و فیالثامن،"الدال الساكنة"و فی التاسع،"الباء الساكنة"ویبدوا تغییر المقاطع مرتبط بتغییر الموضوع. حین تكلم كلٌّ مِن الفتی، الشیخ، الجاریة، الغنی، الفقیر، الأبله، الأدیب و… نظرة عامة اِلی القصائد الثمانیة المدروسة:
وأخیراًفقد رأینا أن دواوین أبی ماضی تحتوی حوالی 40 قصیدة شعریة قصصیة
أکثرها واقعیٌّ ورمزیٌ ثّمّ خیالیٌّ وقد حاول ابو ماضی اَن ینوع فی اوزانه و قوافیه و كان تنویعه محموداً جدّاً. ففی مجال تنویع أبی ماضی فی الاوزان والقوافی، نجدهُ ینظم القصیده الواحدة متعددة البحور و القوا فی، كما ینظمها متنوعة القافیه فقط، و علاوةً علی هذا لم یحاول ابوماضی اَنْ ینتَقض علی أسالیب التعبیر العربیة وظلّ فی معظم أشعاره یتبع عمودالشعرالعربی ویلتزم بقوا فیه واوزانه(49). رُعم أنَّه فی فاتحة دیوانه «الجداول» یقول:
لست منی اِن حسبتَ اﻟَََﺷ ﻌرألفاظاً و وزنا
فهو لایعترف ـ رغم أنه شاعرـ باللفظ والوزن(50). الخاتمة:
1. بحثنا و فهمنا اَنّ القصیدة القصصیة بحكم أنها قصیدةٌ لا بد اَن تكون شعراً و بحكم أنها قصصیة لابد أن تنقل إلینا قصةٌ.فهی شعروقصةٌفی آن واحدو بمقدار متساوٍ.
2. تطَرَّقنااِلیاَدب المهاجروشعراءالقصه فیالمهاجروفهمنااَن للقصةالشعریةجذورٌعمیقة فی ادب المهاجر إذلم یكن فقط ابوماضی شاعر القصة بل شعراء القصة فیالمهاجَر كثیرون.
3. العنصر القصصی فی الشعر مِن سمات التجدید فی الشعر العربی الحدیث و لیس معنی ذلك خلو الشعر العربی مِن نوع ما مِن القصص،ولكن كل هذه الالوان لم تكن قصصیة بالمعنی الدقیق، لأنّ القصة شیء و الحوار الذی یرد خلال القصه شیء آخر. اِذن الشعر القصصی بالمعنی المصطلح علیه فلم یكن من طبیعة العرب و لاهومِن مقتضیات اجتماعاتهم.
4. توجدحوالی اَربعین قصیدة شعریة قصصیة فی دیوان اَبی ماضی، اكثرها واقعیٌّ و رمزیٌ، ثمّ خیالی. عناصر القصه و الشعر كلتاهما موجودة فیهذه القصص الشعریة. لِكلٍّ منها وزن و قافیةٌ و فكرة ولِكل منها بدایة، وعقدة وحل.
5. بعث ابوماضی فی قصصه الواقعیة عظةً و تنبیهاُ،فهو یدعو اِلی جعلها عنواناً لما یصیب المجتمع مِن مفارقاتٍ قد تصبح مواجع اجتماعیه قاتله. و قد تجنّب ابوماضی فی رمزیته الاسراف و الغموض، و قد تنوعت أشكال الحكایات الرمزیه التی تناولها ابوماضی فی ایحاءات افكاره المختلفه ولكن اكثرها یدخل فی نطاق «الطبیعة» بقسمیها «الحیة و الجامدة»..
الهوامش
. محمد عبدالمنعم خفاجی: دراسات فیالعصر الجاهلی. ص 90.
.2 عزالدین اسماعیل: الشعر العربی المعاصر. ص 301 - 300
3. ایلیا الحاوی: فن الوصف و تطوره فی الشعرالعربی. ص 181 و یوسف الصمیلی: الشعر اللبنانی، اتجاهات و مذاهب ص 111
4. یوسف الصمیلی: الشعر اللبنانی، اتجاهات و مذاهب. ص 112 ـ 111
5. المصدر نفسه: ص 112.
6. شوقی ضیف: دراسات فیالشعرالعربی المعاصر، ص 44.
7. قد استفاد شوقی ضیف فیكتابه«دراسات فی الشعر العربی المعاصر» كلمة المهاجَر بدلامِن المهجَر. جدیرٌ بالذكر اِنَّ فی الاستفادة مِن المهجَر و المهاجَر اختلافٌ لكن یقول الشاعر القروی فی قصیدیة «الوطن البعید»:
ما البرازیلُ مَهجَری لیس لبنان لی حمی (شوقی ضیف: دراسات فی الشعر العربی المعاصر، ص 279).
8. صادق خورشا, مجانی فیالشعر العربی الحدیث و مدارسه، ص 164 - 163
9. أمین ودیع دیب: الشعرالعربی فی المهجر الامریكی. ص 18
10. محمد عبدالمنعم خفاجی: قصة الأدب المهجری. ص 315.
11 . اكدكتوران احسان عباس و محمد یوسف نجم: الشعرا العربی فی المهجر امیر كا الشمالیه. ص 158والجامع فی تاریخ
12. میشال خلیل جحا: الشعرا العربی الحدیث. ص 112
13. هناك اختلافٌ غیر قلیل فی مولده، فجریدة «السائح» فی عددها الممتاز عام 1927 تذكر بأنه ولدسنة 1889، غیر أنّ الاُستاذ محمد قرة علی فی جریدة «الحیاة» اللبنانیة یقول أنه ساله مولده حین زار لبنان، فأجابه اَبو ماضی باُنهُ ولد عام 1890، اما الاستاذ جورج صیدح فی كتابه «أدبنا و أدبا ؤنا فی المهجر، فقد ذكر أنَّ أبا ماضی ولدعام 1891(عیسی الناعوری: ادب المهجر، ص 375)
14. عیسی الناعوری: ادب المهجر، ص 382 و جاء فی الادب و النصوص: ابراهیم عابدین و آخرون ، ص 334، سنة موته 1958.
15. عبدالمجید الحر: ایلیا ابو ماضی باعث الأمل و مفجر ینابیع التفاؤل . ص 100
16. محمود سلطان: ایلیا ابو ماضی بین الروما نسیة و الواقعیة. ص 258.
17. محمود سلطان: ایلیا ابوماضی بین الرومانسیة و الواقعیة ص 258
18. المصدر نفسه؛ ص 259
19. ایلیا ابوماضی: الدیوان. ص 770
20. سالم المعوش: ایلیا ابوماضی بین الشرق و الغرب فی رحلة التشردو الفلسفة و الشاعریه. ص 352.
21. عیسی الناعوری: ادب المهجر. ص 177 ـ 176.
22. سالم المعوش: ایلیا ابو ماضی بین الشرق و الغرب فی رحلة التشرد و الفلسفه و الشاعریة. ص 356.
23. المصدر نفسه: ص 353.
24. المصدر نفسه: ص 354.
25. ایلیا ابوماضی الدیوان ص 427
26. عیسی الناعوری: ادب المهجر. ص 175
27. عیسی الناعوری: ادب المهجر، ص 176
28. ایلیا ابوماضی: الدیوان، ص 811
28. عزیزة مریدان : القصه الشعریة فی العصر الحدیث. ص 303
29. محمد غنیمی هلال: النقدالأدبی الحدیث. ص80
30 ایلیا ابوماضی: الدیون ص 337
31. عبدالمجید الحر: ایلیا ابوماضی باعث الأمل و مفجرینا بیع التفاول ص 101
32. ایلیا ابوماضی: الدیوان، ص 121.
33. ایلیا الحاوی: ایلیا ابوماضی شاعر التساؤل و التفاؤل، ص 78
34. عیسی الناعوری: ادب المهجر. ص 178
35. ایلیا اَبو، ماضی: الدیوان. ص 667.
36. عبدالمجید عابدین: بین شاعرین مجددین ایلیا ابوماضی و علی محود طه المهندس، ص 104 - 103
37. محمود سلطان: ایلیا ابوماضی بین الرومانسیة والواقعیة. ص 270.
38. الدكتوران احسان عباس و محمد یوسف نجم، ص 254
39. ایلیا ابو ماضی: الدیوان، ص 242
40. محمود سلطان: ایلیا ابوماضی بین الرومانسیه و الواقعیة ص 268- 267
41. ایلیا ابوماضی: الدیوان، ص 125
42. ایلیا الحاوی: ایلیا ابوماضی شاعر التساول و التفاول ص 338 ـ
43. المصدر السابق ، ص 40
44. یوسف عید: المدارس الادیبه و مذاهبها، ص 169 و ایلیا الحاوی: ایلیا ابوماضی، شاعر التفاؤل و التساؤل . ص 178
45. ایلیا ابوماضی: الدیوان، ص 829
46 عیسی الناعوری: ادب المهجر ص 285- 280
47. محمود سلطان: ایلیا ابوماضی بین الرومانسیة و الواقعیه ص 265
48. عبداللطیف شراره: ایلیا ابوماضی ص 53
49. ایلیا ابو ماضی: الجد اول، ص المقدم
فهرس المراجع و المصادر:
1. اَبوماضی، إیلیا: دیوان إیلیا أبوماضی، دارالعودة، بیروت، د. تا.
2. اَبو ماضی، إیلیا: الجداول، دارالعلم للملایین، بیروت، 1986 م.
3. اسماعیل، عزالدین: الشعرالعربی المعاصر، دارالعودة، بیروت، الطبعة الخامسه، 1988.
4. الحاوی، ایلیا: فن الوصف و تطوره فیالشعر العربی، دارالكتاب البنانی، بیروت الطبع الثانی ، 1967.
5. الحاوی، ایلیا: ایلیا ابوماضی شاعر التساؤل و التفاؤل، دارالكتاب اللبنانی، بیروت، 1981، م.
6. الحر، عبدالمجید: ایلیا ابو ماضی باعث الأمل و مفجرینا بیع التفاؤل، دارالفكر العربی، بیروت الطبعة الاولی، 1995.
7. خلیل حجا، میشال: الشعرالعربی الحدیث، درالعودة، بیروت، المطبعةالاولی، 1999.م.
8. خفاجی، محمد عبدالمنعم: قصة الادب المهجری، دارالكتاب البنانی، بیروت، 1986.
9. خفاجی، محمد عبدالمنعم: دراسات فی الادب العربی الحدیث و مدراسه، دارالجیل، بیروت، الجزء الاول، 1992 م.
10. خفاجی، محمدعبدالمنعم: دراسات فیالادب الجاهلی و الاسلامی، الطبعة الاولی، قاهرة، دارالجیل، 1992م.
11. خورشا، صادق: مجانی الشعرالعربی الحدیث و مدارسه، سازمان سمت، تهران، چاپ اول، 1381.
12. سلطان، محمود: ایلیا ابو ماضی بن الرومانسیه و الواقعیه، منشورات دارالقبس، الكویت، 1979.
13. شراره، عبداللطیف: ایلیا ابوماضی دراسة تحلیلیة، دار بیروت للطباعة و االنشر،بیروت، 1982.
14. الصمیلی، یوسف: الشعر اللبنانی… اتجاهات و مذاهب، دارالوحدة، بیروت، الطبعة الاولی، 1980.
15. ضیف، شوقی: دراسات فیالشعر العربی المعاصر، دارالمعارف، مصر، الطبعة السابعة.
16. عابدین، ابراهیم و آخرون: ألادب و النصوص، وزارة التربیة الكویت و ادارة المناهج و الكتب المدرسیة, الطبعة الثالثه عشرة، 1993ـ 1994.م.
17. عابدین، عبدالمجید: بین شاعرین مجددین، ایلیا ابو ماضی و علی محمود طه المهندس دارالمعرفة الجامعیه، اسكندریه، الطبع الثانی.
18. عباس، إحسان و نجم، محمد یوسف: الشعرالعربی فیالمهجر، امیر كا الشمالیه، دارصا در، بیروت، الطبعة الثالثه، 1982.
19. عید، یوسف: المدارس الأدبیه و مذاهبها، دارالفكرالبنانی، بیروت، الطبعة الاولی. 1994. م.
20. غنیمی هلال، محمد: النقد الادبی الحدیث، بیروت، دارالثافة، 1973 م.
21. الفاخوری، حنا: الجامع فیتاریخ الأدب العربی، الحدیث، دارالجیل، بیروت، د.تا.
22. مریدان، عزیزه: القصه الشعریه فی العصر الحدیث، دارالفکر،دمشق، 1984.
23. المعوش، سالم: ایلیا ابوماضی بین الشرق و الغرب، فیرحلة النشرد و الفسلفه و الشاعریة، مؤسسة بحسون للنشر و التوزیع، بیروت، الطبعة الاولی، 1997م.
24. الناعوری، عیسی: ادب المهجر، دارالمعارف، مصر، قاهره، 1959.
25. ودیع دیب، اَمین: الشعر العربی فیالمهجر الأمریكی، دار ریحانی للطباعة و النشر، بیروت،
إن السبب فی اختیار هذا الموضوع للدراسة هو شخصیة هذا الشاعر المعاصر الكبیر و كثرة الشعر القصصی فی دیوانه الذی یصل اِلی حوالی اَربعین قصیدة اَواكثر.كما أن الدراسات لم تتناول شعره القصصی بالدراسة مثلما تنازلت قضایاأخرﻯ كالتفاؤل والتساؤل. إنَّ الهدف فی هذه الدراسة هو: 1. تحدید مفهوم الشعر القصصی، 2. نظرةٌ عامةٌ اِلی اَدب المهاجَر و شعراء القصة فی المهاجَر، 3. خلفیة القصة الشعریة فی الادب العربی 4. وعرض تصویراً واضحاً مِن الشعر القصصی فی دیوان اَبی ماضی و شرح وتحلیل بعض مِن اشعاره القصصی، إذ لایمكن تحلیل كُلِّ أشعاره فی مقالة واحدة.
ماهو الشعرالقصصی؟
الشعرالقصصی، هوالذی یعتمد فی مادته علی ذكر وقائع و تصویر حوادث فی ثوب قصة تساق مقدماتها، و تحكی مناظرها و ینطق أشخاصها. فالشاعرالقصصی قد یطوف بحیاته حادث مِن الحوادث تنفعل به نفسه و تتجاوب له مشاعره و یهتزإحساسه، فیعمد اِلی تصویر هذا الحادث كما تمثل لدیه فی قصة ینسج خیوطها و یرسم ألوانها و یطرز حواشیها.(1) كل مافی الامرأنّ القصیدة القصصیة صارت تكتب الان علی أنها نوع ادبی متمیز، تحكی بأجمعها قصة، هی بطبیعة الحال، قصة خیالیة اكثر منها واقعیة و لا یعد هذا عیبا فطیبعی أن یعتمد الشاعر علی عنصر الخیال و قد یبنی مِن تجربة خیالیة عملاً فنیاً كاملاً. فماذا نقرأ نحن فی القصیده القصصیة أنقرأ شعراً اَم قصة؟ و دون أن نستغرق فی التفكیر نرى أنّ التسمیة نفسها تحمل الجواب عن هذا السؤال، فبحكم أنها قصیدة، لابد أن تَكون شعراً و بحكم أنها قصصیة لابد أن تنقل إلینا قصة. فهی شعر و قصة فی آن واحد، و بمقدار متساوٍ. اِنّما تستفید القصة مِن الشعر التعبیر الموحی المؤثر و یستفید الشعر مِن القصة التفعیلات المُثیرة الحیة. فهی بنیة متفاعلة، یستفید كل شقِ فیها مِن الشق الآخر و ینعكس علیه فی الوقت نفسه.(2)
الشعرالقصصی فیالادب العربی:
قاریء الشعر العربی یقع علی كثیر مِن الحكایات التی تؤكد النزعة القصصیة عند بعض شعرائنا القدامی كامریء القیس الذی تبدو هذه الظاهرة فی شعره (عند وصفه للصید) حدیث یبدو الموضوع ذا مقدمة وعقده وحل، و غالباً ماتكون المقدمة وصفاً للفرس اَوالناقة و تنسب العقدة عندما یعن لسرب مِن البقرالوحشی فیطارده و یكر ویفرّ حوله حتی یعود و قد اوقع طریده او عدّة طرائد(3). والفرزدق عرض لحادثة وقعت بینه و بین الذئب فی قصیدة تكاد تخرج عن طبیعة الوصف النقلی التقلیدی للذئب لانه التفت فیها اِلی الجانب القصصی، و أفاض علیها شیئاً مِنالرقة الوجدانیة، اِذقال:
ولیلةٍ بتنا با لفریین ضافنا علی الزاد ممشوق الذراعین أطلسُ تَلَمّسنا حتی أتانا ولم یزلْ لَـــدُنْ فطمتـْــه امـــــّه یتـــلمّـــسُ(4) ویرى الدكتور احمد امین أنّ عمربن ابی ربیعه هو مبتكر فن القصص الشعری ،و كان حریاً بتجربته أن تسهم فی تطویر القصیدة العربیة و تخرجها عن ما رأى لتقلید القصیدة الجاهلیة(5).
اِنّ ما تقدم عن الظاهرة القصصیة فی شعری امرؤ القبس و الفرزدق ماهواِلاّ حكایة لحال، كان یمكن لها أن تكون خطوة علی طریق الفن القصصی الشعری بما تنبی عنه مِن جیشان العواطف و صدق الانفعالات اِلاَ اَنّ العنایة بها لم تتجاوز هذا البوح الوجدانی. لم تعرف العربیة اذن الشعر القصصی بمعناه الغربی و انّما عرضَتْ ضروباً مِن نظم التاریخ تشبه اَن تكون متوناً للحفظ و التسمیع و مازال هذا شأننا حتی اتصلنا بأورباو آدابها فی القرن التاسع عشر و لم یلبث سلیمان البستانی أن نقل إلیاذه هومیروس اِلی لغتنا شعراً و بذلك رأی شعراءنا تحت أعینهم هذااللون من الشعرالقصصی ورأوا مایجری فیه مِن حروب و حوادث مثیرة تدورحول أبطال الیونان و طروادة. إذن القصص الشعری بمفهومه الغربی لم یظهر اِلاّ فی العصر الحدیث(6).
ادب المَهاجَر(7): هو أدب المهاجرین العرب الذین تركوا بلادهم فترة الحكم العثمانی للعالم العربی و استقروا فی الأمیریكیتین الشمالیة و الجنوبیة و أنتجوا أدباً و ابدعو شعراً و أصدروا صحفاً وكونوا جالیات و جمعیات و روابط ثقافیة، و كان إبداعهم الادبی له صفة التمایز عن أدب الشرق بما یجمع مِن ملامح شرقیة و ملامح غربیة(8).
وباستقرارهم فی الأمیركییتین الشمالیة والجنوبیة أنشاؤارابطتین ادبیتین،إحداهما فی المهجرالشمالی و الثانیة فی المهجر الجنوبی، و هما الرابطة القلمیة و العصبة الأندلسیة. أهم أعضاء الرابطة هم: جبران خلیل جبران، میخائل نعیمة، نسیب عریضة، رشیدایوب، ایلیا اَبوماضی و … اما اعضاء العصبة فأهمهم رشید الخوری، الیاس فرحات، شكرالله الجر، جبران سعاده، امین الریحانی، سعید الیازجی …(9). القصة فی شعرالشعراء المُهاجَریین:
كانت القصة فی شعرالشعراء المهاجریین مِن أهم فنون شعرهم، فهی التی تتناول كل احداث الحیاة، و تصور كل مادقّ و جلّ مِن امور الوجود. و لعلّ الشعرالقصصی هو مما أخذه المهاجریون عن أخوانهم مِن شعراء لبنان و الأقطار العربیة الثانیة، كما یعترف بذلك البعض منهم. حیث تری فریقاً ینسب الفضل فی ذلك اِلی شاعر الارزشبلی ملاط و آخر یعود به الی خلیل مطران. القصة الشعریة التی نظم فیها مِن شعراء المشرق: مطران (1872- 1949)، و الرصافی (1875- 1945)، و حافظ ابراهیم (1871- 1932)، والیاس ابوشبكه (1903- 1947) و بشارة الخوری (1889- 1968)، نظمها شعراءالمهجرو صوروا فیها حیرتهم و تساؤلهم و ألمهم و أملهم و بكاء هم و فرحهم. نظمها إلیاس فرحات (1893- 1977)، و رشید ایوب (1871-1941)، و ابوشادی (1892- 1955). والشاعر القروی (1887- 1984)، و فوزی المعلوف (1899- 1930)، وایلیا ابوماضی. اِذن القصة الشعریة كثیرةٌ فی دواوین الشعراء المهاجریین، منها: لإلیاس فرحات قصة شعریة بعنوان «احلام الراعی» و قصة «الاحتجاج علی مذهب داروین» و كذلك قصة الراهبة. و لفوزی المعلوف قصتُةُ المشهورة: آدم و حواء. و لنسیب عریضة مسرحیة شعریة عنوانها: «احتضار أبی فراس»(10). و اَشهر مَنْ برع فی القصة الشعریة، هو إیلیا ابو ماضی، و كثیراً مایعتمد اَبو ماضی علی أسلوب القصص فی شعره ،اَو القصص الأسطوریة و یستخرج منها دروساً إنسانیة ذات قیمة، یعتمد فیها علی عنصری المفاجأة و التشویق. و مهما یكن من أمر یظلّ أبو ماضی مِن الرواد الذین فتحوا صدر الشعر لغیر الغنائیة الذاتیة فزرعوا فیه مواسم جدیدة لموضوعات شعریة جدیدة تتناول الإنسان، فی شتی صوره و تتناوله فكرةً وجوهراً، نفساً و عقلاً. و مثل هذا الغنی فی الطاقة الشعریة، مجموعاً الی القدرة علی التمثل الجماعی لنفسیة الاُمَّة، هوالذی یجعل مِن أبی ماضی شاعراً كبیراً(11).
ترجمةُ حیاة ایلیا أبی ماضی:
یُعْتَبر ایلیا ابو ماضی أحداكبرشعراءالمهاجرومِن اكبرالشعراء العرب المعاصرین(12). وُلِدَ فی قریة «المحیدثة» القریبة مِن بكفیا فی لبنان، سنة 1889(13). حیث تلقی علومه الا بتدائیة ، ثم رحل اِلی مصر و نزل الاسكندریة حوالی (1900)، حیث مكث فیها اِحدى عشَرْسنة. أصدر دیوانه الاول «تذكار الماضی» قبل أن یهاجراِلی أمیركا الشمالیة، عام 1911. ففی مصر بدأت موهبته الشعریة تتفتح و كان للأدیب اللبنانی أنطون الجمیل، الفضل فی اكتشافها و نشر بعض قصائدة فی مجلة «الزهور» المصریة (1910-1913). عمل ابوماضی فی حقل التجارة و الصحافة، قبل أن یهاجر اِلی مدینة «سنسناتی» فی أمیركا حیث أمضی خمس سنوات فیها، ثمّ اتجّه نحو نیویورك سنة 1916. لیواصل عمله فی نظم الشعر و الاتصال بالأدباء و الكتاب فی بعض الصحف التی كانت تصدر هناك. ثم أصْدَر دیوانه الثانی «دیوان ایلیا ابو ماضی» سنة 1918، مما حقق له شهرة واسعة فی عالم الاغتراب و كذلك فی المشرق العربی. ثم صدر دیوانه الثالث «الجداول» سنة 1927 و فی سنة 1929 أصدر مجلة السمیر، و فی سنة 1946 صدر دیوانه «الخمائل» و ظلّ مقیماً بنیویورك اِلی أن توُفّی سنة 1957(14).
القصة الشعریة عند ایلیا أبی ماضی:
فی قراءَ تنا للقصص الشعریة التی تحفل بها دواوین اَبی ماضی، نجدها قصصاً تفیض ألواناً شتی مِن واقع الحیاة و خیالها و رمزها و تشعبات مذاهبها فی الرومانسیة و الرمزیة و الأسطوریة. و قدخاف أنْ یؤخذ علیه حصر قصصه بأبناء وطنه، فعمد اِلی ابراز واقع الشرق ممزوجاً بجوانب الغرب و معطیاته الرمزیة و الرومانسیة، التی تستمد عناصرها مِن خیاله تارة، اَومِن الاساطیر القدیمة طوراً و حرص أیضاً أن یجعل تلك العناصر تتلوّن بألوان الوحدة المعبّرة عن الوحشیّة، الألم الموحی بالعصر، كما أنّه اهتمَّ اهتماماً بالغاً بالحوار القصصی المعبر عن الضیاع المحیط بالمجتمع الغربی و الشرقی فی آنٍ واحد. و هو فی كل ماذكرنا كان ملماً اِلماماً ناجحاً بفن القصة الشعریة و أصول نظمها المعبّر(15). إذن قد تنوعت هذه العناصر القصصیة عند اَبی ماضی، فهی تاره: عناصر قصصیة واقعیة،و تارةً اُخری حكایات خیالیة، و تارة ثالثة حكایات رمزیة(16).
مِن قصصه الواقعیة:
«حكایة حال»: و هی قصة رجل مسن أخلص لزوجته، ولكنها غدرت به لِكبرسنه. «أنت و الكاس»: و خلاصتها أن الحب لایدوم، و آفته أنّه كالنار فی الهشیم… «قتل نفسه»: و هی قصة شاب أضاع غناه، فتخلی عنه صحبه، فانتحر بعد افتقاره «العاشق المخدوع»: و هی تحكی حب فتی لفتاة، تزوجت مِن غیره، فلّما مات الزوج تزوجها الحبیب الاول، فشیبتهُ باسرافها، و نزواتها، فخرج منها بتجربة خلاصتها (لاتمدح حتی تجرب). «أناهو»: و هی قصة فتاة تعطلت سیارتها فی الصحراء، و باتت فی رعب مِن قاطع طریق معروف فی المنطقة، و فی النهایة اتضح لها أنه اخوها الذی افتقدته… و هكذا مع العسر یسر، و مَنْ یصبر ینل خیراً.
«الشاعر والامة»: و مغزاها أن الشعوب النائمة یستبد بها الظالمون. «طبیبی الخاص»: و هی قصة فتی ادعی المرض، و ادّعَتْ حبیبتة أنها الطبیب فجاءَت لزیارته. «بائعة الورد»: و هی تحكی حال فتاة غدربها حبیبها بعد أن خدعها فقتلتْه، و انتحرت. «ضیف ثقیل» و فیها نقمه علی رجال الدین. «ذكری و عبرة»: وخلاصتها أنّه أسكر حبیبته حتی اعترفَتْ بحب غیره فأعرض عنها و هجرها… «حكایة حا ل» و له قصیدة اُخری بهذا العنوان، و لكن هذه القصیدة تحكی قصة شاب كان ثریاً، ثم عضه الدهر بنابه فقررالانتحار، و لكن امرأة محسنة انقذته مِن كبوته.
«وردة و إمیل» و هی قصة شبیهة بقصة رومیو و جولیت، فقد مات الحبیبان شهیدی الحب . «حكایة حال» و هذه قصة اُخری بهذا العنوان، و فحواها ینطبق علیه قول الشاعر:
اذا كان رب البیت بالدف ضارباً فشیمة اهل البیت كلهم الرقص
«الشاعر و الملك الجائر» و خلاصتها أن افكار الشاعر و نصائحه و حكمه باقیه خالدة ، و أنه أبقی علی التاریخ مِن أی سلطان ظالم(17). و منِ حكایاته الرمزیة: دودة و بلبل، رؤیا، الضفادع و النجوم، الغدیر الطموح، الصغیرالصغیر،السجینة،الغراب والبلبل،التینة الحمقاء، الابریق، ابن اللیل، العیر المتنكر، العلیقة، الكنارالصامت و…
و من حكایاته الخیالیة: الاسطورة الأزلیه… أمنیة إلهة … و الشاعرفی السماء(18) و… و سنكتفی فیما یلی بدراسة نماذج لهذه العناصرالقصصیة من حیث المضمون و الأسلوب .
شرح و تحلیل نماذج من قصصه الواقعیة:
الف: الشاعر و الملك الجائر(19):
مضمونها: تندید جورالحكام
ملحض القصة أن ملكاً ظالماً معتداً بنفسه یری حدود العالم و ما فیه مِن شؤون و شجون ینتهی فی حدود سلطانه الذی تمثّل فی مملكة واسعة حوت القصور الفخمة و الجنائن المعلقة و العزّ البراق و مظاهر العظمة و الفخامة التی شُیّدت بدماء المساكین و علی حساب حیاتهم و بالمقابل جعل ابوماضی مِن شاعر موهوب، حرّ و طلیق یتغنی بسّر الكون و یتحلی بفكر جّم و بنفس عالیة المثال… جعله نقیضاً للملك، فالشاعر مثال للحكمة الأزلیة الشاهدة علی بقاء القیم، و الملك نموذج للمغترّین الذین نظروا لآنهم و كأنه دیمومة، و صدروا عن أحكامهم و كأنهم خُلقوا وحیدین فی هذا العالم.
تبدأ لحظة الصراع بالاحتكاك بین هاتین الشخصیتین النقیضتین… اِذ یستدعی الملكُ الشاعر و یطلب منه أن یصف جاهه و سطوته و ملكه…
قال: صِفْ جاهی، ففی و صفك لی للشعرجاهُ اِنّ لـی القصر الذی لاتبلُغ الطیُرذُراهُ
ولــــی الروض الـــذی یعبَقُ بالمســـك ثراه ولــی الجیش الذی ترشحُ بالموتِ ظِباهُ
فماكان مِن الشاعر اِلاّ أن سخر مِن الملك و مِن طلبه … و أجاب بأبیاتِ لاذعة تنم عن هزء و استخفاف، تصور مجد الملك الباطل و قوته المصطنعة الزائلة و عرشه المزعوم المشاد مِن جماجم البشر و قال اَبو ماضی متابعاً وصف الموقف(20):
ضـــحك الشــاعرُ ما سمعتهُ اُذناهُ و تمنـــی أن یُــــداجی فعــصتهُ شفتاهُ
قال: اِنیّ لاأری الأمرَ كما أنت تراه اِنّ ملكی قدطوی ملكك عنی و مَحاهُ
فا لشاعر ضحك مِن كلام السلطان و لم یطاوعة قلبه و لسانه علی أن یحابی اَویتملق، فإنّ لَهُ منِ نفسه ملكاً یتضاءل أمامه اَی سلطان آخر. و لذلك أجابَ السلطانَ بقوله:
القصر ینْبیء عن مهارة شاعر لبق، و یخبر بُعْدَه عنكـــــــــا
هو لـــلالی یَدرون كُنه جماله فـــــإذا مضوا فكأنه دُكــــــــا
ستزول أنت ولایزول جلاله كالفُلكِ تبقی، إنْ خَلَتْ، فُلكا
ثمّ تحدث عن الروض و الجیش، والبحر، و الجبل التی یدعی السلطان أنّه یملكها، و ختم حدیثه بقوله:
و مررتُ بالجبلِ الأشْمَّ فما زوى عنی محاسنََه ولستُ أمیراً
و عند ذاك احتدم غیظ السلطان علیه فأمرالجلادَ أن یدحرج رأس الشاعر عن كتفیه، فلما. سقط رأسه یتدحرج علی الأرض، غضب السلطان و قال: "ذوجنة، أمسی بلاجنتهْ"(21). فانظر اِلی هذه الصورة التی یحشد فیها ابو ماضی جملة مِن الشروط الفنیة للعمل القصصی:
فاحتدمَ السلطانُ ایَّ احتــــدام ولاحَ حـــُبُّ البطش فی مقلتیهْ
وصاح بالجلاد: هاتِ الحسام فـــأسرعَ الــجلّادُ یسعــــی إلیهْ
فقال: دحـــرجْ رأسَ هذا الغلام فــــرأسُهُ عبءٌ علـــــی منكبیه
سمعاً و طوعاً، سیّدی: وانتضی عَضَباً یموج الموتُ فی شفرتیهْ
نشیر فی هذا المقطع الی جملة مِن الامور:
اولها: الموقف الانفعالی للملك… و هو تتبع لحركة نفسه الداخلیه التی استثارها الشاعر بحدیثه المطول حتی نال مِن الملك و بلغ عمقه النفسی البشْع، ولعلّه یعرفه مسبقاً و یعرف اَی مورد یورد نفسه… و هو موقف فیه مِن التزواج و الانسجام بین ظاهر الملك و باطنه. أماثانیها: فهوا الحوار السریع الذی رافق المشهد: احتدام الملك و توجیهه الاوامر للجلاد و اسراع هذا الآخیر للتلبیة… ثالثها: میّزات الشخصیات التی تتحرك أمامنا: فالملك مغتّر بنفسه و الجلاد عبدٌ مطواع ینفذ من دون اعتراض، بطبعه و بحكم مهنته خاضع مسیر(22).
أكدّ الشاعرفی هذه القصیدة أن الجاه الحقیقی هو فی غنی النفس و ترفعها عن السفاسف. فلم یَرفی الملك اِلاّ عظمة مفتعلة واهنة و فی العرش كرسیاً مِن حطام خشب(23).
یعتمد ابوماضی اذاً علی الزمن اعتماداً كلیاً لیرینا نتائج موعظته… فإذا المغتر بقوته یدور علیه هذا الزمن و یفقد عرشه و تتحول مملكتهِ إلی هشیم. و یزحف إلیه سلطان الموت لیلتقی بالشاعرفی العالم الآخرلقاء مواجهة اُخری تظهر عظمة الفكر و انتصار الشاعر بآرائه التی عمّت العالمین و خلدت صاحبها، بینما المجد الباطل و السؤدد المصطنع ینهار ویندثر مع الزمن و لایعود ذكر فی الآفاق، علی عكس اقوال الشاعر التی لاتزال حیّة یتوارثها الناس مِن جیل اِلی جیل و یردد و نها حكمة اُزلیة(24). و فی النهایة: فی لیلة طامسة الانجم تسلّل الموتُ اِلی القصرِِ
بین حراب الجند و الأسهَمِ و الأسیفِ الهندیه الحمرِ
اِلی سریر الملكِ الأعظم اِلـــــــــی أمیر البَّروالبحرِ
فی حومة الموتِ و ظلِّ البلی قــــد التقی السلطانُ و الشاعر
لایجزع الشاعرأن یُقتلا لیس و راء القبر سیفٌ و رمحُ
و الشاعر المقتول باقیةٌ أقــــــــواله فكانــــــــها الأبَـــد
الأسلوب:نجد أبا ماضی تارةً ینظم القصیدة الواحدة متعددة البحور و القوافی منها: هذه القصیده یعنی «الشاعر و الملك الجائر». هذه القصیده، قصیدةٌ طویلة نسبیاً، فی نحو سبعین بیتاً، مقسمة اِلی ستة مقاطع، و اختلفت فیها البحور و القوافی (نّوع ابو ماضی فی اوزان القصیدة الواحدة و قوافیها)،المقطع الأول بحرهُ الرمل و قافیتهُ «ها» المضموم و فی المقطع الثانی، بحرهُ الكامل و المقطع الثالث، والرابع و الخامس، بحرهُ السریع و المقطع السادس بحرهُ الرمل. ونری اختلاف القافیة فی المقاطع المختلفة أو فی الأبیات التی جاءت فی مقطع واحد. ب: الشاعر والامُة(25)
(مضمونها: الحكمة: مَنْ یَعْرَف حقَّهُ لَنْ یُظْلَم)
فی قصیدة «الشاعر و الأمة» و هی تتألف مِن 59 بیتاً ـ یتحدث الشاعر عن اُمَّةٍ كانت تعیش فی رخاء و منعةِ و حریةِ، فی كنف ملكٍ عادلٍ یُحِبّ شعُبه ویتفانی فی خدمته، حتی اوصل شعبه اِلی اَفضل ما تتمناه اُمّةٌ مِن العیش و الرغید. (26)
كان فی ماضی اللیالی اُمَّةٌ خلـــع العِزُّ علیها حـِبَرَهْ
یجِدُ النازلُ فی أكنافها اُوجهاً ضاحـکــَةً مستبشرهْ
كان فیها ملكٌ ذوفطنة حازمٌ یصفحُ عندالمقدره
ثم مات الملك و خلفه ملك طائشُ الراُی، أفسدتْهُ حاشیة سوءٍ لاتُحب الخیر للشعب، و زینت له آثامه و شروره فركب رأسه و مضی فی طرق البغی، لایلتفت اِلی مصلحة شعبه ولایعتنی بمملكته، وسكت الشعب علی شروره فلم یحاسبوه، حتی استفحل فیهم ظلمه و بطشْهُ، فراحوا یبكون علی قبر سلفه العادل الأمین.
مات عنها، فأقامت مَلِكاً طائش الرأی كثیرَ الثَرثَرَه
حولَهُ عُصْبةُ سُوءٍ كُلّما جاءَ إذاً اَقبَلـــَتْ مُعْتــــَذَرَهْ
و فی أحد الایام مرّشاعرٌ بمقبرة البلدة، فرأی شیوخها یبكون عند قبرالملك السابق. فلما سألهم عن سبب بكائهم،أجابوه بأنهم یبكون العدل و الرحمة و الحریة و العزة فی ذلك القبر، و شكوا مِن جور ملكهم الحالی وطغیانه و فجوره.
مرَّیـــــوماً فــــرأی أشباهَ جـــلسوا یبكون عندالمقبره
قال مالكم؟ … ما خطبكم اَیُّ كنزٍ فی الثَری اَوجوهَرَهْ
قال شیخٌ منهم مُحْدَودِبٌ ودموعُ الیَأسِ تْغشَی بَصَرَهْ
اِنّ مَنْ نبكیه لو أبْصَرَهُ قیصــــرٌ أبصر فیه قیصَرَهْ
كلّما جاءَ إلیه خائــــن و اشیــــاً قَرَّبَهُ و استـــَوْزرهْ
وعند ذالك:
هزأ الشاعر منهم قائلاً بلغ السوسُ أصولَ الشجرة
رحمةُ اللهِ علی اسلافكُم إنهـــــّم كانــــــوا تُقاةً بَرَرَهْ
إنّ من تبكونَه یاسادتی كالـــذی تشكون فیكم بَطَرهْ
لوفعلتم فِعْل أجدادكـــم ماقضی الظالمُ منكم و طرَه والعبرة مِن هذه القصة الشعریة واضحةٌ جداً، فطغیان الحاکم وبغیه لا یمکن أن یسود شعباً یعرف حقوقه و واجباته، و یعمل لرفا هیة نفسه و عزة بلادِه و یوقف الطغیان و الفساد و الفجور عند حدودها(27).
الأسلوب:اِنها قصیدة طویلة نسبیاً فی نحو ستین بیتاً، علی بحرالرمل و روی واحد وهؤ«الراء»، مقسمةً إلی اَربعة مقاطع ویبدو تغییر المقاطع یرتبط بالتغییرالزمنی والمكانی و الموضوعی.
ج: هی(28) مضمونها: تمجید الأم
هذه قصة محفل مِن الاخوان عندأحدسراتهم، تدورعلیهم الكؤوس، و تغمرهم امواج المرح و البشر، و یدعوهم صاحب الحفل اِلی أن یشربوا نخب صاحبته، ثم یدعوهم اِلی أن یشربَ كل منهم نخب صاحبته فی الحفل.
قام أمیرالقصــرِ فــــی كفّهِ كأسٌ أعارنهُ مــعانیها
و قال: یا صحبُ علی ذكركم أملأها حبّاً و أحسوها
ولكن فتی ظل ساكناً دون أن یرفع كأساً اَویشارك فی نخب فسأله صحبه:وأنتَ؟
قال: أجل، اَشرب سرالتی بالروح تفدینی و أفدیــــــــها
صورتها فی القلب مطبوعة لاشیء حتی الموت یمحوها
قد وهَبَتنی روحــــها كلــــها و لم تخف أنی أضحیــــها
ولكن السیدات استشطن غضباً، و تحفر الرجال اِلی الانتصاف منه لهذه الإهانة الموجهة لسیدات فی مجلس أنس و شراب.
و هكذا یتاُزم الموقف و تتعقدالقصة و حینئذٍ یتقدم صاحب الدعوة و یقول
فصاح رب الدار: یاسیدی وصفتها لم لاتسمیها
أتخجل باسم من تهوی أحسناء بغیــر اسم؟
و عندها تصل لحظة «التنویر« اِلی غایتها:
فاطرق غیر مكترث وتمتم خاشعاً … اُمی
تمتاز هذه القصه بالحركة و الحیویة. و ممالاریب فیه أن الحوارالذی سیطرعلی مواقفها هوالذی أضفی علیها هذه الصفة الواضحة، حتی قد بدت القصة فی جملتها تصویراً لمجلس شراب جری فیه هذا الحوار الحیوی. فقد بدأ الشاعر بروایة القصة دون مقدمة و تمهید و انتهی كذلك بانتهاء الحدث، بل بآخر كلمة تتضمن الفكرة العامة فی القصة، و هذا بلاریب یكشف عن براعة فی السبك. و أصالته. فقد ظل یماطل القاری و یشوقه حتی النهایه، ثم فاجأه بهذا النتیجه غیر المتوقعة، و قد بلغت براعة الشاعر فی تصویر تلك العادة، اَن جعلها فذة فریدة. و القصة فی جملتها مركزة، موجزة و قدعینت با براز الفكر المجردة و تجیدهادون الالتفات اِلی النواحی الفنیه الاُخری(29) الأسلوب:قصیدة «هی» مقسمة علی مقطعین اِثنین ، بحره السریع و قافیته «ها»فی نحو سبعة و ثلاثین بیتاً.
شرح و تحلیل نماذج مِن قصصه الرمزیة:
لیس المقصود بالرمزیة هنا تلك الرمزیة التی یفهمها الغربیون فیالادب، لكن المقصود بها ذلك اللون الموضوعی الذی یرمز بالقصیدة كلها مثلاً، اَوبالعمل الادبی كله اِلی شیء معین،كالرمزفی حكایات كلیلة و دمنة و خرافات لافونتین الفرنسیة الدالة علی مصیر الظالم و جزاء الواشی، اَوعاقبة المغرور فی مساق حكایة علی لسان البهائم و الطیور و اذاكان اَبو ماضی یوحی فی كثیرٍ مِن قصائده بأفكار، فلیس ایحاؤه ایحاء الرمزیین، لأنّ هؤلاء ینتقلون أحیاناً فی قصائدهم مِن فكرة اِلی فكرة علی أساس الإحساس و الشعور النفسی مع ضعف الرابطة المنطقیة بین الفكرتین، ولكن أبا ماضی بجانب عنایته بالاحساس و الشعور النفسی فهوأ یضاًً یعنی بالرابطة المنطقیة فی قصائده الرمزیة.(30).
التینة الحمقاء(31) مضمونها: عاقبة التكبرهى الفناء
التینة الحمقاء التی و هبها الله الأفنان الباسقة، والجذع القوی، و الثمرالذكی، و لكنها رغم جمال منظرها، فقد اعتراها الكبر و الحمق حین قالت لِأترابها لا اُرید أن اَمتع الناس بثمری اَو جمالی، و لا اُعطی الطیر منِ ثمری و أغصانی. و فی سبیل ذلك سأجعل حجمی مفصلاً علی مایحتاجه جسمی(32)و فی ذلك یقول:
اِنی مفصلةٌ ظلی علی جَسَدی فلایكـــون به طولٌ و لاقِصَرُ
ولستُ مثمرةً اِلاّ علــــی ثِقَةٍ أنْ لیس یطرُقُنی طیرٌ ولابشرُ
وعندماجاءَ الربیع، وقدزین الدنیا بالأخضرالسندسی من الورق، والطیب الزّكیّ مِن الثمر، ظَهَرَتْ التینة الحمقاء عاریة، لامنظرَ یجملّها ولاكساءَ یكملها، فكانت النهایة الحزینة التی قال عنها الشاعر:
ولم یُطِقْ صاحـبُ البستانِ رؤیتها فاجتثها فهوتْ فیالنار تَستعر
مَن لیس یسخو بما تسخوالحیاة به فإنّه أحمقٌ بالحـــــرص یَنتَحِرُ
هذه التینة هی نقیضُ "الحجرالصغیر"(33) لِآنّ الطبیعة فاضَتْ علیها بكل خیرٍ فیها، توهم «الحجرأنّه عاطل منه كل عطلٍ. و كلاهما انتحر بوعی و اختیار. الشجرة ساقت الموت الی نفسها سوقاً، إذا امتنعت بذل ماسخت علیها الطبیعة به،وعطلت فی ذاتها وظیفة الحیاة. لِكل موجودٍ مبررٌ لوجوده فیما یهبه للحیاة، والعطاء هو كالدم الذی یُغذی عروقها، فإذا ضنّ كلّ من ابنائها بخیره یبسَتْ شجرتها و ماتت. العطاء هو الفرح و التجدد، و فی هذه القصیدة، أیضاً، تنساق المعانی و توقع لتخدم الخاتمه الحكمیة التفاؤلیه.
وقد لانعثر فیالحیاة علی مایشابه هذه التینة إذیعمد المرء اِلی البطالة خموداً اَوكسلاَ اَولهواً و مجوناً ولایطالعنا امروٌ یكف عن العمل لیمنع خیره عن الآخرین.
اِلاّ أن لَأبی ماضی مَرمیّ آخر،یقصد فیه القتل والانتحار المعنویین اَواِلی افتقاد السعادة اِذا لاسعادةَ بلاعمل و عطاء(34) و أخیراً: فی قصیدة «التینة الحمقاء» یرینا الشاعر أن مالا ینفع الناس لایسمح له الناس بالبقاء، و المنطوی علی نفسه لانفع منه و لافائدة فی بقائه(35) الاسلوب:قصیدة قصیرة نسبیاً فی أحدعشربیتاً،وروی واحد وهو حرف "الراء"فی البحر البسیط.
الضفادع و النجوم(36):
مضمونها: الهجاء السیاسی
قصیدة «الضفادع و النجوم» فهی اسطورة ساخرة mockepic صوّر فیها ابو ماضی زعیمة الضفادع،و قدت تطلعت اِلی النجوم ذات لیلة،وهی تلقی ظلالها فی السماء، فخیل إلیها، و متی كان للضفدع قدرة علی التفكیر و التمییز، أنّ النجوم قد نزلت من سمائها و أغارت علی الماء، فصاحت الضفدعةفی رفاقها:
یا رفاقیا! یا جنـــودی! احتشدوا عَبَرَ الأعداءُ فی الیل التخوم
فاطردوهم، واطردوا اللیل معاً إنـــــه مثلــــــهم بــــاغٍ أثیمْ
ولاشكَّ أنّ زعیمة الضفادع و جنودها رغم ضآلة أجسامها و حقارة شأنها، قدملأت الدنیا ضجیجاً، و أرسلت فی الفضاء، أصواتاً مدویة مفزعة:
فی أدیم السماء مِن أصواتها رعدة الحمی، وفی اللیل وجومْ
واحتشد الجنود وظلتْ تنق و تضج حتی طلع الفجر، و ماذا تستطیع أن تصنع الصنفادع حیال النجوم غیر الضجیج و النقیق، و ما أن بزغت أنوار الفجر حتی ارتفعت ظلال النجوم،فظنتْ زعیمةالضفادع، أنّها قد أرعبت النجوم فطارت خوفاَ وفزعاَ إلی السماء(37). فماذا صنعت زعیمةالضفادع؟ مشت فی سرها:
أیها التاریخ سجَّل أننا اُمّةٌ قد غَلَبَتْ حتی النجومْ
هذه صورة رمزیة للحقیرالذی یدعی أنه صنع شیئاً عظیماً، ثمّ یتفاخر بمالم یفعل دلالة علی حقارته وادعائه، یسخربها الشاعر مِن طبائع صنف مِن الناس طغت علیهم الكبریاء، علی الرغم من فشلهم و تقصیرهم و قداستعان الشاعر فی ابراز هذه الفكرة بمظهر طبیعی وهواللیل و النجوم و الضفادع…(38)و فی الحقیقة «الضفادع و النجوم» تفسیر لفكرة الغرور والخداع النفسی(39).
الاسلوب: قصیدة قصیرة نسبیاَ فی أحد عشربیتاً، فی بحرالرمل و روی واحد و هو میم الساكنة. دودة و بلبل(40)
لأبی ماضی قصیدة بعنوان «دودة و بلبل » یرمز فیها اِلی أن الحقیر یلتزم الخنوع دائماً، یرضی بالذل، لان طلب المجد یتطلب سلاح المغامرة و الاقدام… و الحقیر خلوٌ منِ هذا السلاح فها هی دودةٌ نقمت علی حیاتها و شكت لأنها لم تخلق طائرة كالبلبل، فقالت لها زمیلتها النملة: لاتتمنی أن تكونی طیراً یصاد فالأرض لمثلك طیبة والخنوع مریح، و طلب المجد مغامرة لیست مأمونة العواقب…
(و هذه لفتة لتبریر عدم طموح الوضیع و ایثاره السلامة) و هی فكرة تذكرنابقول المتنبی
واذاكانت النفوس كباراً تَعِبَت فی مُرادها الأجسامُ
و شاعرنا استخدم الطبیعة الحیة فی ابراز هذه الفكرة وزج العظة التی یبغیها مِن ورائها(41).
نَظَرَتْ دودةٌ تـــدبُّ علـــی الأرض إلی بلبل یطیرُ و یصـــــــــدَحْ
فمضَتْ تشتكی اِلی الورق الساقط فـــــی الحق أنها لم تجنـــــــّحْ
فَأتَتْ نمـــــلةٌ إلیــــها و قالَــــــــتْ اقنعی و اسكتی فمالك أصلجْ
مــــــــــا تمنیـــــْتِ اِذا تمنیــــتِ اِلاّ أنْ تصیری طیراً یُصادُ و یُذبَح
فالزمی الارض فهی أحنی علی الدودِ و خلّی الكلامَ فالصمــتُ أریح
الاسلوب: قصیده قصیرة جدا فی خمسه أبیات، فی بحر الخفیف و روی واحد و هو الحاء الساكنة، استفادالشاعر فیها من اسلوب التهكم.
دراسة و تحلیل نماذج من قصصه الخیالیة:
الشاعر فی السماء(42): مضمونها: حُبُّ الوطن
فی قصیدة «الشاعر فی السماء» یفترض مشهداً خیالیاً، فیزعم أنَ الله رقّ لبؤسه علی أرض الشقاء، فأرجعه اِلی السماء، و شید له ملكاً علی الفضاء و جعل الضیاء و الشهُب مِن دونه و سلّطهُ علی الصبح و المساء،و الغیوِم والریح. اِلاّ أن ذلك لم یُجْدِه عزاءً، وأقام علی وجومه و همومه، فخیل اِلی الله أنّه مازال یحِنّ اِلی الغید و الخمرة، فاستل مِن قلبه حبهما، فطلب منه أن یتمنی فیحوله اِلی مایشاء، نجماً اَو طیراً اَوذا ثراء و قصور، لكن الشاعر أبی ذلك كله و أجاب الله(43):
فقُلْتُ: یاربُّ فصــلَ صَیْفٍ فی أرض لبنانَ اَوشتــــــاءْ
فإنّنی مهــــــنا غـــــــریبٌ ولیـــــس فی غُربة هنـــــاء
فاستضحك اللهُ مِن كلامی و قــــــال: هذا هُوَ الغَبــــَاء
فقال: ما أنـــــــــت ذوجنون وَاِنّمــــــــا أنـــــــتَ ذووفـــاء
فإنَّ لبنانَ لیــــــــــس طَوْداً و لابــــــــلاداً، لكنْ سمــــاء!
انهّا القفلة المدهشة ذاتها فی نهایة القصیده، إلا أنَّ القصیدة بمجملها ذات شفافیة و رقّة إذتمثل مطامع الإنسان و تورد شریطاً مِن الصوروالبهجة فی مثل أجواء الاسطورة(44)
هذه القصیدة الوطن الذی یؤثرهُ الشاعر علی الجنة، و قد جاء بمعانیها علی ایقاع السرد، حیناً و اِلی النجوی التی یتنفس فیها حلم الحریة و تسقط شهوات النفس و نزواتها ولایصمد فیها اِلاّ حب الوطن و الحنین إلیه حیناً آخر.(45).
الاسلوب: قصیده مطوسطة الطول نسبیاً ، فی نحو سبعة و ثلاثین بیتاً، فی بحرالمنسرح و روی الهمزة الممتدة المسبوقه بحرف المد(اء) مقسمة علی ثلاثه مقاطع و یبدو تغییر المقاطع مرتبطً بتغییر الموضوع.
الأسطورةالأزلیة(46) (مضمونها: كل شیء فی مكانه أجدر)
تتلخص هذه الحكایة فی أنّ الناس قد ضجّوا مرّةً بالشكوی اِلی اللهِ، وودّوا لوأعاد تكوینهم مِن جدید، فنزل دوالجلال علی مشیئتهم، و هبط إلیهم فیلبلة قمراء، یستمع اِلی شكایاتهم و یتساءَل عن مصدرهیاجهم، فتقدم إلیه كل منهم بشكواه، و اول المتقدمین شاب ناقم علی حظه مِن الحیاة، لأنّ الله قد جعله شاباً یعیش بین جماعات مِن الشیوخ لایرون فی الشباب اِلاّ طیشاً و رعونة و حمقاً فهولذلك یرید اَن یسرع به الزمن لیغدو شیخاً حكیماً، فیتخلص مِن احلام الشباب التی یشقی بها كثیراً:
عِبٌ علی نفسی هذا الصبّی الجائش المستوفزُ الطّامی
ولایكاد الفتی ینتهی من شكواه، حتی یقف بین الجمع شیخ «مشتعل اللمة، بالی الإهاب، فیصرخ سائلاً خالقه أن یأخذ كل حكمته و یرّد علیه الشباب، فقد ذبلت حیاته بذبول أمانیه، و هو یریدالمنی اَمامه لاوراءه، و لوزادت بها متاعبه:
مُرْتقِف الأیامُ عن سیرها فإنها تركض مثل السحاب
و نهضت بعده فتاة حسناء، تعاتب ربها لانها خلقها جمیلة، و الجمال لایورث اِلاّ الفضائح و الأقاویل:
وجهی سنیٌ مشرقٌ، اِنّما مرعی عیون الخلق هذا السَّنی
فهی لاتسلم من ثرثرات الألسنة، ومِن خیانة الأعین التی تلاحقها لِغمزات الحنیةو الریبة. ثمّ تسكت الحسناء، فهبت الجاریة الدمیمة، حانقه ناقمه علی قسمتها القبیحه فتقول:
ذنبی اِلی هذا الوری خلقتی فهل أنا المجرمة الجانیة؟
فهی تعلم أنّ للجمال الرتبة العالیة،فلوكانت جمیلة و تری أنّها تعیش فی عالم أحكامه جائرةً، من جور هذه الأحكام أنه:
لیس لذات القبح مِن غافِر وفیه مَن یغفر للزّانیة
وقد ذكر التاریخ أن السید المسیح قد غفرللزانیة، و اَنقذها مِن الرجم، فمن هوالذی غفر لفتاة دمیمة دمامتها؟ و لِمَ لایهبها الله الحسن، و هوالذی خلق نفسها علی صورته و مثاله ؟
وهكذا یأتی دوراالصعلوك الفقیر و الغنی، والأبله و العبقری اللبیب و…
قال الغنی: اِننی فیالقصر الرفیع الذرا كطائـــــــر فی قفــص میت
اِن كنـــــــت اِنسانــــــــاً فلم یــــــاتری لست بادراكی كباقی العباد؟
قال الفقیر: یصرخ یا ربّاهُ حتّی متــــی تُحَكَّمُ المِـــــوسرَ فی نفسی؟
و تضــــــــعُ التــــــــاجَ علــــــی رأسه و تضعُ الشوك علی رأسی؟
و أخیراً:
تنتهی الشكایات كلها ویقف الجمیع فیانتظار حكم الكائن الأعلی … و…
لمّا و عی اللهُ شكایا الوری قال لهم: كونوا كماتشتهون
فكانوا كمایشتهون، ویطلع الصباح علی الكون، فإذا الحیاة هی مِن جدید: فیها الشاب و الشیخ، الحسناء و القبیحة و الفقیر و الغنی، والأبله(47) و اَما الحقیقه التی لاتتغیر ـ كمایراها ابوماضی ـ فهی أنه:
ولیسَ مِن نقص ولا مِن كمال فالشوك فی التحقیق مثل الاقاح
و ذرة الرمل ككلّ الجبــــال وكالّـــــــذی عَزّ الـــــــذّی هانا
و هكذا الحقیقة لمن أمعن فیها: لانقص و لاكمال، و الشوك كالزهر، و ذرة الرمل كالجبل الاشم، و العزیز كالمهان و الناس یتمردون علی كل واقع.
و قد قال «ایلیا ابوماضی» فی مقدمة نشره لهذه القصة الخیالیة اول ما نشرت فی مجلة «السمیر» سنة 1933: «اِنّ یوماً یرضی فیه الانسان عن نفسه لهو الیوم الذی تنتهی فیه مهمة الانسان علی الأرض(48).
الاسلوب: قصیده طویلة نسبیاً فی نحومئة و أربعین بیتاً مع تنوع القوافی و وحدة البحور، مقسمة علی عشرة مقاطع و فی كل المقاطع البحر هو السریع ولكن القوافی تختلف. فی المقطع الاول، حرف الروی هو«الهاء» الساكنة،و فی الثانی المیم،و فی الثالث، الباء الساكنة، و فیالرابع،«النون»، و فی الخامس «الیاء»،و فی السادس، «السین»، و فی السابع،«ة»،و فیالثامن،"الدال الساكنة"و فی التاسع،"الباء الساكنة"ویبدوا تغییر المقاطع مرتبط بتغییر الموضوع. حین تكلم كلٌّ مِن الفتی، الشیخ، الجاریة، الغنی، الفقیر، الأبله، الأدیب و… نظرة عامة اِلی القصائد الثمانیة المدروسة:
وأخیراًفقد رأینا أن دواوین أبی ماضی تحتوی حوالی 40 قصیدة شعریة قصصیة
أکثرها واقعیٌّ ورمزیٌ ثّمّ خیالیٌّ وقد حاول ابو ماضی اَن ینوع فی اوزانه و قوافیه و كان تنویعه محموداً جدّاً. ففی مجال تنویع أبی ماضی فی الاوزان والقوافی، نجدهُ ینظم القصیده الواحدة متعددة البحور و القوا فی، كما ینظمها متنوعة القافیه فقط، و علاوةً علی هذا لم یحاول ابوماضی اَنْ ینتَقض علی أسالیب التعبیر العربیة وظلّ فی معظم أشعاره یتبع عمودالشعرالعربی ویلتزم بقوا فیه واوزانه(49). رُعم أنَّه فی فاتحة دیوانه «الجداول» یقول:
لست منی اِن حسبتَ اﻟَََﺷ ﻌرألفاظاً و وزنا
فهو لایعترف ـ رغم أنه شاعرـ باللفظ والوزن(50). الخاتمة:
1. بحثنا و فهمنا اَنّ القصیدة القصصیة بحكم أنها قصیدةٌ لا بد اَن تكون شعراً و بحكم أنها قصصیة لابد أن تنقل إلینا قصةٌ.فهی شعروقصةٌفی آن واحدو بمقدار متساوٍ.
2. تطَرَّقنااِلیاَدب المهاجروشعراءالقصه فیالمهاجروفهمنااَن للقصةالشعریةجذورٌعمیقة فی ادب المهاجر إذلم یكن فقط ابوماضی شاعر القصة بل شعراء القصة فیالمهاجَر كثیرون.
3. العنصر القصصی فی الشعر مِن سمات التجدید فی الشعر العربی الحدیث و لیس معنی ذلك خلو الشعر العربی مِن نوع ما مِن القصص،ولكن كل هذه الالوان لم تكن قصصیة بالمعنی الدقیق، لأنّ القصة شیء و الحوار الذی یرد خلال القصه شیء آخر. اِذن الشعر القصصی بالمعنی المصطلح علیه فلم یكن من طبیعة العرب و لاهومِن مقتضیات اجتماعاتهم.
4. توجدحوالی اَربعین قصیدة شعریة قصصیة فی دیوان اَبی ماضی، اكثرها واقعیٌّ و رمزیٌ، ثمّ خیالی. عناصر القصه و الشعر كلتاهما موجودة فیهذه القصص الشعریة. لِكلٍّ منها وزن و قافیةٌ و فكرة ولِكل منها بدایة، وعقدة وحل.
5. بعث ابوماضی فی قصصه الواقعیة عظةً و تنبیهاُ،فهو یدعو اِلی جعلها عنواناً لما یصیب المجتمع مِن مفارقاتٍ قد تصبح مواجع اجتماعیه قاتله. و قد تجنّب ابوماضی فی رمزیته الاسراف و الغموض، و قد تنوعت أشكال الحكایات الرمزیه التی تناولها ابوماضی فی ایحاءات افكاره المختلفه ولكن اكثرها یدخل فی نطاق «الطبیعة» بقسمیها «الحیة و الجامدة»..
الهوامش
. محمد عبدالمنعم خفاجی: دراسات فیالعصر الجاهلی. ص 90.
.2 عزالدین اسماعیل: الشعر العربی المعاصر. ص 301 - 300
3. ایلیا الحاوی: فن الوصف و تطوره فی الشعرالعربی. ص 181 و یوسف الصمیلی: الشعر اللبنانی، اتجاهات و مذاهب ص 111
4. یوسف الصمیلی: الشعر اللبنانی، اتجاهات و مذاهب. ص 112 ـ 111
5. المصدر نفسه: ص 112.
6. شوقی ضیف: دراسات فیالشعرالعربی المعاصر، ص 44.
7. قد استفاد شوقی ضیف فیكتابه«دراسات فی الشعر العربی المعاصر» كلمة المهاجَر بدلامِن المهجَر. جدیرٌ بالذكر اِنَّ فی الاستفادة مِن المهجَر و المهاجَر اختلافٌ لكن یقول الشاعر القروی فی قصیدیة «الوطن البعید»:
ما البرازیلُ مَهجَری لیس لبنان لی حمی (شوقی ضیف: دراسات فی الشعر العربی المعاصر، ص 279).
8. صادق خورشا, مجانی فیالشعر العربی الحدیث و مدارسه، ص 164 - 163
9. أمین ودیع دیب: الشعرالعربی فی المهجر الامریكی. ص 18
10. محمد عبدالمنعم خفاجی: قصة الأدب المهجری. ص 315.
11 . اكدكتوران احسان عباس و محمد یوسف نجم: الشعرا العربی فی المهجر امیر كا الشمالیه. ص 158والجامع فی تاریخ
12. میشال خلیل جحا: الشعرا العربی الحدیث. ص 112
13. هناك اختلافٌ غیر قلیل فی مولده، فجریدة «السائح» فی عددها الممتاز عام 1927 تذكر بأنه ولدسنة 1889، غیر أنّ الاُستاذ محمد قرة علی فی جریدة «الحیاة» اللبنانیة یقول أنه ساله مولده حین زار لبنان، فأجابه اَبو ماضی باُنهُ ولد عام 1890، اما الاستاذ جورج صیدح فی كتابه «أدبنا و أدبا ؤنا فی المهجر، فقد ذكر أنَّ أبا ماضی ولدعام 1891(عیسی الناعوری: ادب المهجر، ص 375)
14. عیسی الناعوری: ادب المهجر، ص 382 و جاء فی الادب و النصوص: ابراهیم عابدین و آخرون ، ص 334، سنة موته 1958.
15. عبدالمجید الحر: ایلیا ابو ماضی باعث الأمل و مفجر ینابیع التفاؤل . ص 100
16. محمود سلطان: ایلیا ابو ماضی بین الروما نسیة و الواقعیة. ص 258.
17. محمود سلطان: ایلیا ابوماضی بین الرومانسیة و الواقعیة ص 258
18. المصدر نفسه؛ ص 259
19. ایلیا ابوماضی: الدیوان. ص 770
20. سالم المعوش: ایلیا ابوماضی بین الشرق و الغرب فی رحلة التشردو الفلسفة و الشاعریه. ص 352.
21. عیسی الناعوری: ادب المهجر. ص 177 ـ 176.
22. سالم المعوش: ایلیا ابو ماضی بین الشرق و الغرب فی رحلة التشرد و الفلسفه و الشاعریة. ص 356.
23. المصدر نفسه: ص 353.
24. المصدر نفسه: ص 354.
25. ایلیا ابوماضی الدیوان ص 427
26. عیسی الناعوری: ادب المهجر. ص 175
27. عیسی الناعوری: ادب المهجر، ص 176
28. ایلیا ابوماضی: الدیوان، ص 811
28. عزیزة مریدان : القصه الشعریة فی العصر الحدیث. ص 303
29. محمد غنیمی هلال: النقدالأدبی الحدیث. ص80
30 ایلیا ابوماضی: الدیون ص 337
31. عبدالمجید الحر: ایلیا ابوماضی باعث الأمل و مفجرینا بیع التفاول ص 101
32. ایلیا ابوماضی: الدیوان، ص 121.
33. ایلیا الحاوی: ایلیا ابوماضی شاعر التساؤل و التفاؤل، ص 78
34. عیسی الناعوری: ادب المهجر. ص 178
35. ایلیا اَبو، ماضی: الدیوان. ص 667.
36. عبدالمجید عابدین: بین شاعرین مجددین ایلیا ابوماضی و علی محود طه المهندس، ص 104 - 103
37. محمود سلطان: ایلیا ابوماضی بین الرومانسیة والواقعیة. ص 270.
38. الدكتوران احسان عباس و محمد یوسف نجم، ص 254
39. ایلیا ابو ماضی: الدیوان، ص 242
40. محمود سلطان: ایلیا ابوماضی بین الرومانسیه و الواقعیة ص 268- 267
41. ایلیا ابوماضی: الدیوان، ص 125
42. ایلیا الحاوی: ایلیا ابوماضی شاعر التساول و التفاول ص 338 ـ
43. المصدر السابق ، ص 40
44. یوسف عید: المدارس الادیبه و مذاهبها، ص 169 و ایلیا الحاوی: ایلیا ابوماضی، شاعر التفاؤل و التساؤل . ص 178
45. ایلیا ابوماضی: الدیوان، ص 829
46 عیسی الناعوری: ادب المهجر ص 285- 280
47. محمود سلطان: ایلیا ابوماضی بین الرومانسیة و الواقعیه ص 265
48. عبداللطیف شراره: ایلیا ابوماضی ص 53
49. ایلیا ابو ماضی: الجد اول، ص المقدم
فهرس المراجع و المصادر:
1. اَبوماضی، إیلیا: دیوان إیلیا أبوماضی، دارالعودة، بیروت، د. تا.
2. اَبو ماضی، إیلیا: الجداول، دارالعلم للملایین، بیروت، 1986 م.
3. اسماعیل، عزالدین: الشعرالعربی المعاصر، دارالعودة، بیروت، الطبعة الخامسه، 1988.
4. الحاوی، ایلیا: فن الوصف و تطوره فیالشعر العربی، دارالكتاب البنانی، بیروت الطبع الثانی ، 1967.
5. الحاوی، ایلیا: ایلیا ابوماضی شاعر التساؤل و التفاؤل، دارالكتاب اللبنانی، بیروت، 1981، م.
6. الحر، عبدالمجید: ایلیا ابو ماضی باعث الأمل و مفجرینا بیع التفاؤل، دارالفكر العربی، بیروت الطبعة الاولی، 1995.
7. خلیل حجا، میشال: الشعرالعربی الحدیث، درالعودة، بیروت، المطبعةالاولی، 1999.م.
8. خفاجی، محمد عبدالمنعم: قصة الادب المهجری، دارالكتاب البنانی، بیروت، 1986.
9. خفاجی، محمد عبدالمنعم: دراسات فی الادب العربی الحدیث و مدراسه، دارالجیل، بیروت، الجزء الاول، 1992 م.
10. خفاجی، محمدعبدالمنعم: دراسات فیالادب الجاهلی و الاسلامی، الطبعة الاولی، قاهرة، دارالجیل، 1992م.
11. خورشا، صادق: مجانی الشعرالعربی الحدیث و مدارسه، سازمان سمت، تهران، چاپ اول، 1381.
12. سلطان، محمود: ایلیا ابو ماضی بن الرومانسیه و الواقعیه، منشورات دارالقبس، الكویت، 1979.
13. شراره، عبداللطیف: ایلیا ابوماضی دراسة تحلیلیة، دار بیروت للطباعة و االنشر،بیروت، 1982.
14. الصمیلی، یوسف: الشعر اللبنانی… اتجاهات و مذاهب، دارالوحدة، بیروت، الطبعة الاولی، 1980.
15. ضیف، شوقی: دراسات فیالشعر العربی المعاصر، دارالمعارف، مصر، الطبعة السابعة.
16. عابدین، ابراهیم و آخرون: ألادب و النصوص، وزارة التربیة الكویت و ادارة المناهج و الكتب المدرسیة, الطبعة الثالثه عشرة، 1993ـ 1994.م.
17. عابدین، عبدالمجید: بین شاعرین مجددین، ایلیا ابو ماضی و علی محمود طه المهندس دارالمعرفة الجامعیه، اسكندریه، الطبع الثانی.
18. عباس، إحسان و نجم، محمد یوسف: الشعرالعربی فیالمهجر، امیر كا الشمالیه، دارصا در، بیروت، الطبعة الثالثه، 1982.
19. عید، یوسف: المدارس الأدبیه و مذاهبها، دارالفكرالبنانی، بیروت، الطبعة الاولی. 1994. م.
20. غنیمی هلال، محمد: النقد الادبی الحدیث، بیروت، دارالثافة، 1973 م.
21. الفاخوری، حنا: الجامع فیتاریخ الأدب العربی، الحدیث، دارالجیل، بیروت، د.تا.
22. مریدان، عزیزه: القصه الشعریه فی العصر الحدیث، دارالفکر،دمشق، 1984.
23. المعوش، سالم: ایلیا ابوماضی بین الشرق و الغرب، فیرحلة النشرد و الفسلفه و الشاعریة، مؤسسة بحسون للنشر و التوزیع، بیروت، الطبعة الاولی، 1997م.
24. الناعوری، عیسی: ادب المهجر، دارالمعارف، مصر، قاهره، 1959.
25. ودیع دیب، اَمین: الشعر العربی فیالمهجر الأمریكی، دار ریحانی للطباعة و النشر، بیروت،
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:36|
النحو والمنطق الأرسطوطاليسي
إن البصرة كانت أول مدينة في العالم الإسلامي تعني بعلم النحو وتضع أصوله. ومما يجدر ذكره هنا أن البصرة كانت كذلك أول مدينة يترجم فيها المنطق الأرسطوطاليسي.
يقال أن ابن المقفع كان أول من اشتغل بترجمة كتب أرسطو المنطقية في البصرة. وقد ترجمها عن الفارسية. وكان منها كتاب المقولات ( قاطيغورياس)، وكتاب العبارة (باريمينياس)، وكتاب المدخل (إيساغوجي)، وكتاب المقارنة (أنالوطيقا).
وقبل ذلك بزمن قليل نشأ في البصرة مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء، ونشأ معه علم الكلام. فصارت البصرة من جراء ذلك مباءة للجدل المنطقي والبحث في أصول الدين.
وهذه ظاهرة اجتماعية تلفت النظر فما هو السبب فيها؟ إننا قد عرفنا فيما مضى السبب الذي أدى إلى ظهور علم النحو في البصرة، ونريد الآن أن نعرف السبب الذي أدى إلى ترجمة المنطق ونشوء الاعتزال وعلم الكلام فيها.
معركة الجمل:
في اعتقادي أن نشوب معركة الجمل في البصرة كان من العوامل الرئيسية في ذلك. ومن المؤسف أن نجد المؤرخين لايعنون بهذه الناحية من معركة الجمل. فهم يذكرونها كما يذكرون أية معركة أخرى في التاريخ، إذ لا يجدون فيها غير جيشين يتقاتلان ثم ينتصر أحدهما على الآخر.
الواقع أن لهذه المعركة أهمية فكرية واجتماعية تفوق مالها من أهمية سياسية وعسكرية. وسبب ذلك أنها كانت أول معركة تنشب بين المسلمين في تاريخ الإسلام، حيث اقتتل فيها أناس يؤمنون بدين واحد ويتلون كتاباً واحداً ويصلون إلى قبلة واحدة.
لقد كان المسلمون قبل تلك المعركة يحاربون أقواماً من غير دينهم، وكانوا في حربهم واثقين بأن الحق معهم وأن الباطل مع أعدائهم. وعلى حين غرة جاءت عائشة إلى البصرة تقود جيشاً عرمرماً. ثم يأتي علي بن أبي طالب بجيش آخر فيصطدم الجيشان اصطداماً مريراً أريقت فيه سيول من الدماء.
وهنا لابد لأهل البصرة من أن يتجادلوا ويشتدوا في الجدال. فقد كانوا حائرين يتساءلون عن الحق في أي جانب يكون؟ أيكون الحق مع علي وبهذا تمسي عائشة أم المؤمنين مبطلة، أم يكون الحق مع عائشة فيمسي علي أمير المؤمنين مبطراً؟
ومثل هذا الجدل لا يصل بالناس إلى نتيجة عقلية حاسمة. فكل فريق يملك من البراهين ما يؤيد بها موقفه. فكان علي ينادي الناس من جهة، وكانت عائشة تناديهم من الجهة الأخرى. ووقف كثير من الناس حائرين لا يدرون أين يذهبون.
وقد تمثلت الحيرة يومذاك في الزبير بأجلى مظاهرها. يروي الطبري عنه أنه قال: “ما كنت في موطن، منذ عقلت، إلا وأنا أعرف فيه أمري، غير موطني هذا”. وقد أدت به الحيرة إلى الانسحاب من المعركة والذهاب في الأرض لا يلوي على شيء.
والآن بعد أن مضى على المعركة ثلاثة عشر قرناً، لا يزال المسلمون يتجادلون ويتخاصمون في أمرها دون أن يصلوا إلى نتيجة. فكيف ياترى كان حالهم يوم اشتداد القتل؟
جاء رجل إلى علي بن أبي طالب أثناء المعركة يسأله: “أيمكن أن يجتمع الزبير وطلحة وعائشة على باطل؟” فأجابه الإمام:”انك لملبوس عليك. ان الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال. اعرف الحق تعرف أهله.”
وهذا يدل على مدى الحيرة التي أصابت عقول الناس آنذاك. فلقد التبس الأمر عليهم، وهالهم أن يجدوا علياً ومعه خيرة الصحابة في جانب، ثم يجدوا عائشة ومعها طلحة والزبير في الجانب الآخر. فلابد أن يكون أحد الجانبين على حق، وأن يكون الآخر على باطل. وهذا أمر يصعب عليهم تصوره، وقد كان النبي يقول: “أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم أهديتم.”
النتائج الفكرية:
انتهت المعركة بانتصار علي بن أبي طالب. ورجعت عائشة إلى المدينة. ولكن المعركة الفكرية لم تنته بالرغم من ذلك. فقد بقى الناس يتجادلون ويتلاومون. ومما زاد في الطين بلة انتصار معاوية بعدئذ واستيلائه على الخلافة. وكان من سياسة معاوية أن ينتقص من شأن علي بن أبي طالب وأن يعلى من شأن عائشة.
صارت عائشة في نظر معاوية رمزاً يمثل المطالبة بدم عثمان. ودم عثمان -كما لايخفى - هو الأساس الذي قامت عليه الدولة الأموية.ولهذا أخذت الدولة تقدس عائشة وتشجع الناس على تقديسها في كل سبيل. ففي الوقت الذي صار علي بن أبي طالب يشتم على المنابر، أصبحت عائشة سيدة نساء العالم، وتهافت الناس عليها ليسمعوا من فمها حديث زوجها رسول الله …
أهل البصرة:
وإذ نرجع إلى أهل البصرة نجدهم منقسمين إلى فريقين: عثمانيين وعلويين، والجدل بينهم قائم على قدم وساق. والظاهر أن البصرة فاقت بانقسامها هذا أي قطر آخر. ففيها وقعت معركة الجمل، ولابد أن يكون فيها أناس يذهبون مذهب عائشة في الحزن على عثمان، وآخرون يذهبون مذهب علي بن أبي طالب في الثورة على عثمان وعلى قومه من بني أمية.
أما الأمصار الإسلامية الأخرى فقد اتخذت في الأمر طريقاً واضحاً، إلى هذا الجانب أو ذاك، وقلما نجد فيها ما وجدنا في البصرة من انقسام مذهبي عنيف. وهذا الانقسام لابد أن يؤدي إلى الجدال في مفهوم الحق والباطل وفي المقاييس المنطقية التي تفرق بينهما.
ولا عجب بعد أن يظهر مذهب الاعتزال وعلم الكلام، ثم يترجم المنطق. في البصرة قبل غيرها من الأمصار الإسلامية.
النحو والمنطق:
في مثل هذا الجو المشحون بالجدل المنطقي نشأ النحو العربي. ومن الطبيعي اذن أن يتأثر النحو بالمنطق على وجه من الوجوه. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ان ابن المقفع الذي ترجم المنطق كان صديقاُ للخليل بن أحمد الفراهيدي. وكانت بينهما مودة وإعجاب متبادل. ولعل هذا من أسباب مارأينا في الخيل من ميل شديد للقياس حيث استخدمه في النحو استخداماً واسعاً.
ومهما يكن الحال فقد اشتهر نحاة البصرة بأنهم قياسون، إذ جعلوا للقياس المنطقي شأناً كبيراً في وضع قواعدهم، حتى أطلق عليهم لقب أهل المنطق. والمعروف عنهم انهم كانوا يضعون القواعد أولاً، ثم يختارون من الشواهد واللهجات ما يلائم تلك القواعد. فإذا اسمعوا اعرابياًَ ينطق بخلاف اقيستهم أهملوا كلامه وعدوه ملحوناً. أما إذا وجدوا الخلاف في القرآن أو في شاهد لايمكن تخطئته لجأوا إلى التأويل والتعليل.
يقول الأستاذ أحمد أمين عن نحاة البصرة: “فهم قد فضلوا القياس وأمنوا بسلطانه وجروا عليه وأهدروا ماعداه، وإذا رأوا لغتين: لغة تسير مع القياس، ولغة لاتسير عليه، فضلوا التي تسير عليه، وأضعفوا من قيمة غيرها. فهم في الواقع أرادوا أن ينظموا اللغة ولو بإهدار بعضها. وأرادوا أن يكون ماسمع من العرب مخالفاً لهذا التنظيم مسائل شخصية جزئية يتسامحون فيها نفسها ولا يتسامحون في مثلها والقياس عليها حتى لا تكثر فتفسد القواعد والتنظيم، هذا إذا لم يتمكنوا من أن يؤولوا الشاذ تأويلاً يتفق وقواعدهم ولو بنوع تكلف.
النحو في الكوفة:
بعد أن نشأ النحو في البصرة وترعرع، تناوله أهل الكوفة. وهناك ظهرت مدرسة في النحو لها طابع خاص. فقد أخذ نحاة الكوفة يعترضون على نحاة البصرة في إخضاع النحو للقياس، وصاروا يناقشونهم في ذلك نقاشاً عنيفاً أدى في بعض الأحيان إلى الخصومة وسفك الدماء.
يقول أهل الكوفة إن القضايا النحوية سبيلها السماع والاستقراء لا الإمعان المنطقي في القياس. فهم يريدون أن يخضعوا في أحكام النحو للذوق الطبيعي، ويطرحون ما يحول دون إحساسهم بالطبيعة اللغوية من أحكام عقلية وأقيسة منطقية.
إذا سمع الكوفيون من أحد الأعراب مثالاً شاذاَ أخذوا به، إذ هو يمثل في نظرهم لهجة بعينها وينبغي أن يحسب حسابها. فإهدار هذا المثال الشاذ إنما هو إهدار لجانب لغوي لا تتم الدراسة إلا به.
ان مدرسة الكوفة كانت تجري في تطوير النحو على أساس الاحترام المتبادل التام لكل ما يصدر من بادية العرب، كأنها تحسب أهل البادية معصومين من الخطأ. أما مدرسة البصرة فكانت تنظر إلى أهل البادية نظرة التقاط واختيار، وهي لا تنزههم من الخطأ واللحن. وكانت تستخرج القواعد بالقياس على الأعم الأغلب من لغة الأعراب. فإذا وجدت فيه شذوذاً أهدرته ولم تقس عليه.
نتيجة النزاع:
أخذ النزاع بين أهل البصرة والكوفة يخمد تدريجياً بمرور الأيام. والظاهر ان المدرستين تداخلت إحداهما بالأخرى وامتزجتا، فأصبحتا مدرسة واحدة. وكان هذا من سوء حظ النحو العربي.
لقد كان الجدير بالنحاة المتأخرين أن يتبعوا إحدى المدرستين ويهملوا الأخرى. ولكننا رأيناهم يأخذون بآرائهما معاً ويعدون أساتذتهما أئمة في النحو بلا تفريق. فضيعوا على النحو بذلك فرصة كبيرة كان المفروض فيها أن تنقذ النحو من الورطة التي وقع فيها أخيراً.
صار النحاة من جهة يقلدون مدرسة الكوفة في عنايتها بكل ما يروى عن اعراب البادية، وصاروا من الجهة الأخرى يقلدون مدرسة البصرة في عنايتها بالقياس. انهم، بعبارة أخرى، أخذوا يهتمون بكل مايردهم من البادية من شواهد شاذة وغير شاذة، فيقيسون عليها. وبهذا صارت القواعد النحوية في وضعها النهائي معقدة ومتشبعة جداً، فابتعدت عما تقتضيه السليقة الفطرية من بساطة ووضوح.
والذي يدرس القواعد النحوية الموجودة بين أيدينا، دراسة موضوعية، يشعر بأنها قواعد اصطناعية غير طبيعية، وليس من المعقول أن يتكلم بها بشر على هذه الأرض.
انتفاضات نحوية:
لم يخل تاريخ النحو، على كل حال، من انتفاضات صغيرة تنهج نهج الكوفة في الاعتراض على استعمال القياس المنطقي في النحو.
يحدثنا أبو حيان التوحيدي في كتاب “المقابسات” عن بعض المناظرات التي كانت تعرض في القرن الرابع الهجري ويدور النقاش فيها حول المنطق والنحو. ونكاد نتلمح في ثنايا تلك المناظرات صراعاً فكرياً يشبه الصراع الذي نشب بين البصرة والكوفة قبل قرنين. فقد كان بعض المشتركين فيها يريدون أن يصبوا أساليب اللغة العربية في قوالب المنطق الإغريقي، بينما كان البعض الآخر يريد الاعتزاز بخصائص اللغة العربية ويستنكر إخضاعها لمنطق غريب عنها.
وفي المغرب، في عهد الموحدين، ظهر أعظم ثائر على النحو العربي، هو ابن مضاء القرطبي. وقد كتب هذا الرجل ثلاثة كتب هي: (1) المشرق في النحو، (2) تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان، (3) الرد على النحاة. وقد حاول بهذه الكتب أن يهدم نحو سيبويه وأقيسته.
والظنون أن هناك شبهاً كبيراً بين رأي مضاء ورأي الأستاذ ابراهيم مصطفى الذي أشرنا إليه في مقالة ماضية. ولكن رأي ابن مضاء لم يقدر له النجاح. فقد كان الناس مشغوفين بنحو سيبويه، فلم يستطع ابن مضاء أو غيره أن يثنيهم عنه.
ابن مالك:
وفي القرن السابع ظهر ابن مالك. وقد اشتهر هذا الرجل في النحو شهرة سيبويه، وإليه يرجع الفضل في تجميد النحو وصبه في قالبه الأخير. فقد نظم ابن مالك نحو سيبويه ووضحه وفصله وقربه إلى أذهان الناس.
ومن أعمال ابن مالك أنه نظم في النحو أرجوزة تبلغ ألف بيت، جمع فيها قواعد النحو. واشتهرت ألفية ابن مالك هذه شهرة واسعة ونالت حظوة كبيرة، حتى حفظها أكثر المتعلمين في الشرق والغرب، وصارت مرجعاً لطلاب النحو فيما يختلفون فيه، وكثرت عليها الشروح المستفيضة.
ولا تزال المدارس الدينية واللغوية حتى يومنا هذا تعتبر ألفية ابن مالك جزءاً مهماً من مناهجها الدراسية. يكفي الطالب أن يحفظ الألفية حتى يصعر خده للناس ويعد نفسه علامة في النحو. فلا يكاد يعترض معترض حتى يشهر عليه “العلامة” بيتاً من الألفية فيفخمه به.
كان النحاة قبل ظهور الألفية يستطيعون أن يبحثوا ويتجادلوا في بعض مبادئ النحو وقواعده، ولكنهم لم يكادوا يرون القواعد النحوية قد قيدت في أبيات من الشعر حتى رضخوا وسكنوا. واستطيع أن أعد ألفية ابن مالك بداية العهد الذي بدا فيه النحو العربي يدخل في طور الجمود.
الصيغة النهائية:
لاحظ الباحثون المحدثون ان الصيغة النهائية التي جمد فيها النحو العربي متأثرة بالمنطق الأرسطوطاليسي تأثراً كبيراً. يقول الدكتور ابراهيم بيومي مدكور ان النحو العربي تأثر، عن قرب أو بعد، بما ورد على لسان أرسطو في كتبه المنطقية من قواعد نحوية، وأن المنطق الأرسطوطاليسي أثر في النحو من جانبين: أحدهما موضوعي والآخر منهجي. وأريد بالقياس النحوي أن يحدد ويوضع على نحو ماحدده القياس المنطقي.
ومما يلفت النظر في كتب النحاة المتأخرين انهم يسلكون في بحوثهم مسلك المناطقة. وكثيراً مانجد القوانين المنطقية التي جاء بها أرسطو مسيطرة على عقولهم، كأنهم يتصورون القواعد النحوية تجري على نفس النمط الذي تجري عليه ظواهر الكون.
ومن الجدير بالذكر هنا أن القوانين المنطقية القديمة ظهر بطلانها أخيراً، فهي لا تصلح اليوم لتفسير ظواهر الكون. ولكن أصحابنا لا يزالون مصرين على التمسك بهاز وهم لا يكتفون بالاعتماد عليها من الناحية الميتافيزيقية، بل نراهم يعتمدون عليها في تعليل قواعدهم النحوية أيضاً. وهذا دليل على اننا نسير متخلفين عن الركب العالمي بمراحل عديدة.
نظرية العامل في النحو:
من قوانين المنطق القديم: أن لكل شيء سبباً وأن لكل حادث محدثاً. وهذا مايعرف لدى المناطقة بقانون السببية. وقد شغف به النحاة وجعلوه أساساً لعلمهم. ومن هنا نشأت عندهم نظرية العامل. وهي نظرية تشغل حيزاً كبيراً من كتبهم، وتعد أهم موضوع عندهم.
ونظرية العامل هذه تدور حول السبب الذي يجعل الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. فالنحاة يرون الحركات الاعرابية تتبدل في الكلمة مرة بعد مرة على نظام مطرد. فقالوا أن هذا التبدل عرض حادث وهو لابد له من محدث كما يقول المناطقة. فما هو هذا المحدث؟ وفي البحث وراء هذا المحدث صار النحاة يخلطون ويخبطون خبط عشواء.
ثم ذهبوا إلى القول بأن اجتماع عاملين على معمول واحد غير ممكن. وهم يستندون في ذلك على قانون عدم التناقض الذي جاء في المنطق القديم. فهم يقولون: إذا اتفق العاملان في العمل لزم تحصيل الحاصل وهو محال، أما إذا اختلفا فالنقيضان يجتمعان في المعمول، حيث يكون مثلاً منصوباً ومرفوعاً في آن واحد، وهذا محال أيضاً.
طبيعة العامل:
لو أنهم جعلوا العامل معنوياً لهان الأمر وصار لبحثهم قيمة. ولكنهم استهانوا بالعامل المعنوي وآثروا عليه العامل اللفظي. فهم يعزون رفع الفاعل مثلاُ إلى الفعل الذي يسبقه. وكان الأولى بهم أن يعزوه إلى الفاعلية أو الإسناد، كما يصنع النحاة في اللغات الحديثة.
نشب جدل بينهم ذات مرة حول العامل الذي جعل المبتدأ والخبر مرفوعين. قال الكوفيون: ان عامل رفع المبتدأ هو الخبر، وعامل رفع الخبر هو المبتدأ. فاحتج عليهم البصريون قائلين: ان الكلمتين لا تتبادلان العمل إذ يكون كل منهما عاملاً ومعمولاً في آن واحد. وحجة البصريين في هذا الشيء لا يمكن أن يكون سبباً ونتيجة في الوقت ذاته. وقد أخذوا ذلك من المناطقة طبعاً.
ومن المبادئ التي نادى بها ابن مضاء القرطبي في إصلاح النحو هو إلغاء نظرية العامل من أساسها. ولكن صيحته لم تلق أذناً صاغية، فماتت في مهدها مع الأسف.
تقدير العامل:
كان من الصعب على النحاة أن يجدوا لكل حركة إعرابية عاملاً لفظياً يأتي قبلها. ولهذا لجأوا إلى التقدير، ووصل بهم الأمر في هذا المجال إلى درجة من السخف لا تطاق.
فإذا جئت لهم على سبيل المثال بجملة ” زيداً رأيته” وسألتهم عن العامل الذي نصب “زيداً” أجابوك انه فعل مستتر تقديره “رأيت”ز وبهذا تصبح الجملة عندهم: “رأيت زيداً رأيته”.
وإذا ذكرت لهم الآية القرآنية: “وإن أحد من المشركين من استجارك….” وسألتهم عن العامل الذي رفع كلمة “أحد” أجابوك انه فعل مستتر تقديره “استجارك” فتصبح الآية: “وان استجارك أحد من المشركين استجارك…”.
دكتاتورية النحاة:
وصار النحاة حكاماً بأمرهم يفترضون العامل كما يشاؤون، فلا يعترض عليهم أحد.
يحكى أن الكسائي كان في مجلس الرشيد ذات يوم فقرأ أبياتاً من الشعر. وكان الأصمعي حاضراً فأراد أن ينافس الكسائي في علمه بالنحو فاعترض على كلمة جاء بها الكسائي مرفوعة. فانتهره الكسائي وقال له: “اسكت، ماأنت وهذا..” ثم أخذ يتباهى على الأصمعي ويأتي بالكلمة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. وكان قادراً أن يخترع في سبيل ذلك ماشاء من العوامل. فسكت الأصمعي، وهبطت مكانته في عين أمير المؤمنين.
ويحكى أيضاً: ان أحد أمراء بني بويه سأل نحوياً عن العامل الذي جعل المستثنى منصوباً في نحو “قام القوم إلا زيداً”ز فقال النحوي أن عامل النصب محذوف تقديره “استثنى زيداً”، وهنا اعترض الأمير فقال: “لماذا لا يمكن تقدير عامل آخر غير ذلك العامل الناصب، حيث يقدر “امتنع زيد”، وبهذا يصبح زيد مرفوعاً. فسكت النحوي…
ويبدو ان النحوي سكت لأن المعترض عليه كان سلطاناً يجلد ويقتل. ولو كان المعترض رجلاً مستضعفاً كالأصمعي لانتهره النحوي وقال له: اسكت، ماأنت وهذا!
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 21:16|
الحداثة - مفهومها ـ نشأتها ـ
روادها
مفهوم الحداثة :
قبل أن نخوض فی مفهوم الحداثة الاصطلاحی ، نرى من المفید أن نعرج على مضمونها اللغوی ، فهی مصدر من الفعل " حَدَثَ " ، وتعنی نقیض القدیم ، والحداثة أول الأمر وابتداؤه ، وهی الشباب وأول العمر .
وبهذا المفهوم اللغوی سطعت شمس الحداثة فی عالمنا العربی المعاصر ، وتوافقت مع ما یحمل عصرنا من عقد نفسیة ، وقلق ذاتی من القدیم الموروث ، ومحاولة الثورة علیه ، والتخلص منه ، والبحث عن كل ما هو جدید یتوافق وروح عصر التطور العلمی والمادی ، ویواكب الایدولوجیات الوافد على عالمنا العربی . أما ما تعنیه الحداثة اصطلاحا فهی : " اتجاه فكری أشد خطورة من اللبرالیة والعلمانیة والماركسیة ، وكل ما عرفته البشریة من مذاهب واتجاهات هدامة ، ذلك أنها تضمن كل هذه المذاهب الفكریة ، وهی لا تخص مجالات الإبداع الفنی ، والنقد الأدبی ، ولكنها تخص الحیاة الإنسانیة فی كل مجالاتها المادیة والفكریة على حد سواء " ، وهی بهذا المفهوم الاصطلاحی " اتجاه جدید یشكل ثورة كاملة على كل ما كان وما هو كائن فی المجتمع " . الحداثة فی الأدب المعاصر ـ هل انفض سامرها ، د . محمد مصطفى هدارة ، مجلة الحرس الوطنی ربیع الآخر 1410 هـ .
ویقول أحد الباحثین فی معرض حدیثه عن الحداثة كمنهج فكری یسعى لتغییر الحیاة " إن من دعاوى أهل الحداثة أن الأدب یجب أن ینظر إلیه من الناحیة الشكلیة والفنیة فقط بغض النظر عما یدعوا إلیه ذلك الأدب من أفكار ، وینادی به من مبادئ وعقائد وأخلاق ، فما دام النص الأدبی عندهم جمیلا من الناحیة الفنیة ، فلا یضیر أن یدعو للإلحاد أو الزنا أو اللواط أو الخمریات أو غیر ذلك " عوض القرنی ، الحداثة فی میزان الإسلام ص 47 .
ویقول د . عدنان النحوی فی كتابه الحداثة من منظور إسلامی ص 13 : " لم تعد لفظة الحداثة فی واقعنا الیوم تدل على المعنى اللغوی لها ن ولم تعد تحمل فی حقیقتها طلاوة التجدید ، ولا سلامة الرغبة ، إنها أصبحت رمزا لفكر جدید ، نجد تعریفة فی كتابات دعاتها وكتبهم ن فالحداثة تدل الیوم على مذهب فكری جدید یحمل جذوره وأصوله من الغرب ، بعیدا عن حیاة المسلمین ن بعیدا عن حقیقة دینهم ، ونهج حیاتهم ، وظلال الإیمان والخشوع للخالق الرحمن " .
فالحداثة إذن من منظور إسلامی عند كثیر من الدعاة تتنافى مع دیننا وأخلاقنا الإسلامیة ، وهی معول هدم جاءت لتقضی على كل ما هو إسلامی دینا ولغة وأدبا وتراثا ، وتروج لأفكار ومذاهب هدامة ، بل هی أخطر تلك المذاهب الفكریة ، وأشدها فتكا بقیم المجتمع العربی الإسلامیة ومحاولة القضاء علیه والتخلص منه ، وإحلال مجتمع فكری عربی محله یعكس ما فی هذه المجتمعات الغربیة من حقد وحنق على العالم الإسلامی ، ویروجون بكل اهتمام وجدیه من خلال دعاتها ممن یدعون العروبة لهذه المعتقدات والقیم الخبیثة بغرض قتل روح الإسلام ولغته وتراثه .
وتقول الكاتبة سهیلة زین العابدین فی مقالة نشرت لها فی جریدة الندوة السعودیة الغدد 8424 فی 14 / 3 / 1407 هـ ص 7 : " الحداثة من أخطر قضایا الشعر العربی المعاصر لأنها أعلنت الثورة والتمرد على كل ما هو دینی وإسلامی وأخلاقی ، فهی ثورة على الدین على التاریخ على الماضی على التراث على اللغة على الأخلاق ، واتخذت من الثورة على الشكل التقلیدی للقصیدة الشعریة العربیة بروازا تبروز به هذه الصورة الثوریة الملحدة " .
ویذكر د . محمد خضر عریف فی معرض حدیثه عن الحداثة وتعلیقه على بعض الدراسات التی صدرت حولها من غیر مفكریها وروادها فی الوطن العربی فی كتابه الحداثة مناقشة هادئة لقضیة ساخنة ص 11 و 12 قائلا : " إننا بصدد فكر هدام یتهدد أمتنا وتراثنا وعقیدتنا وعلمنا وعلومنا وقیمنا ، وكل شیء فی حاضرنا وماضینا ومستقبلنا " ، ویفرق الدكتور / خضر عریف فی كتابة الحداثة مناقشة هادئة لقضیة ساخنة بین مصطلح الحداثة والتجدید والمعاصر فیقول : " والذی یدفع إلى ذلك الظن الخاطئ هو الخلط بین مصطلح الحداثة ( modernism ) ، والمعاصرة ( modernity ) ، والتحدیث ( modernization ) وجمیع تلك المصطلحات كثیرا ما تترجم إلى " الحداثة " على ارعم من اختلافها شكلا ومضمونا وفلسفة وممارسة . والواقع أن الاتجاه الفكری السلیم یتفق مع التحدیث ، ولكنه لا یتفق مع الحداثة . وإن یكن مصطلحا modernity و modernization یمكن الجمع بینهما لیعنیا المعاصرة أو التجدید ، فإن مصطلح modernism یختلف عنهما تماما . إذ ینبغی أن نفرق بین مصطلحین أجنبیین ، من المؤسف أن كلیهما یترجم ترجمة واحدة وهی ( الحداثة ) أما المصطلح الأول فهو : modernity الذی یعنی إحداث تجدید وتغییر فی المفاهیم السائدة المتراكمة عبر الأجیال نتیجة وجود تغییر اجتماعی أو فكری أحدثه اختلاف الزمن .
أما الاصطلاح الثانی فهو modernism ویعنی مذهبا أدبیا ، بل نظریه فكریة لا تستهدف الحركة الإبداعیة وحدها ، بل تدعو إلى التمرد على الواقع بكل جوانبه السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة . . . وهو المصطلح الذی انتقل إلى أدبنا العربی الحدیث ، ولیس مصطلح modernity الذی یحسن أن نسمیه المعاصرة ، لأنه یعنی التجدید بوجه عام دون الارتباط بنظریة ترتبط بمفاهیم وفلسفات متداخلة متشابكة .
ونحن فی تعریفنا لمفهوم الحداثة لا نرید أن نتوقف عند ما قال به خصومها ، ولكن لا بد أن نتعرف علیه مما قال به أصحابها ومفكروها وسدنتها أیضا . یقول على أحمد سعید الملقب بأودنیس وهو من رواد الحداثة العربیة ومفكریها رابطا بینها وبین الحریة الماسونیة : " إن الإنسان حین یحرق المحرم یتساوى بالله " . ثم یتنامى المفهوم الماسونی لكلمة الحریة إلى صیغته التطبیقیة الكاملة فی قوله " : إن التساوی بالله یقود إلى نفیه وقتله ، فهذا التساوی یتضمن رفض العالم كما هو ، أو كما نظمه الله ن والرفض هنا یقف عند حدود هدمه ، ولا یتجاوزها إلى إعادة بنائه ، ومن هنا كان بناء عالم جدید یقتضی قتل الله نفسه مبدأ العالم القدیم ، وبتعبیر آخر لا یمكن الارتفاع إلى مستوى الله إلا بأن یهدم صورة العالم الراهن وقتل الله نفسه " محاضرة الحداثة والتراث د . محمد هدارة .
وقد عرف رولان بارت الحداثة بأنها انفجار معرفی لم یتوصل الإنسان المعاصر إلى السیطرة علیه فیقول : " فی الحداثة تنفجر الطاقات الكامنة ، وتتحرر شهوات الإبداع فی الثورة المعرفیة مولدة فی سرعة مذهلة ، وكثافة مدهشة أفكارا جدیدة ، وأشكالا غیر مألوفة ، وتكوینات غریبة ، وأقنعة عجیبة ، فیق بعض الناس منبهرا بها ، ویقف بعضهم الآخر خائفا منها ، هذا الطوفان المعرفی یولد خصوبة لا مثیل لها ، ولكنه یغرق أیضا " محاضرة الحداثة والتراث د . محمد هدارة .
ویتابع الدكتور هدارة قائلا : كما یصفها بعض الباحثین الغربیین " بأنها زلزلة حضاریة عنیفة ، وانقلاب ثقافی شامل ، وأنها جعلت الإنسان الغربی یشك فی حضارته بأكملها ، ویرفض حتى أرسخ معتقداته الموروثة " .
جذور الحداثة فی الغرب
ظهر تیار الحداثة فی الغرب نتیجة للمد الطبیعی الذی دخلته أوروبا منذ العصور الوثنیة فی العهدین الیونانی والرومانی ، امتدادا إلى عصر الظلمات ، مرورا بالعصور المتلاحقة التی تزاحمت بكل أنواع المذاهب الفكریة ، والفلسفات الوثنیة المتناقضة والمتلاحقة ، وقد كان كل مذهب عبارة عن ردة فعل لمذهب سابق ، وكل مذهب من هذه المذاهب كان یحمل فی ذاته عناصر اندثاره وفنائه .
لقد عشق الغرب شتى المذاهب والتیارات الفكریة بدءا من اعتناق الوثنیة ، وانتهاء بالانفجار الفكری الیائس الذی عرف بالحداثة ، مرورا بالمسیحیة وما ترتب علیها من مفاسد الكنیسة وظلمها وظلامها ، وبالطبیعة التی هجرها شعراؤها وكتابها لیعشقوا الواقعیة المزیفة التی ما لبثوا أن هجروها هربا إلى الكفر والإلحاد بالله كفرا صریحا جاهرا ، ثم تحولوا بكفرهم حاملینه من بعد یأس على كواهلهم باحثین عن الخلاص الذی ینتشلهم من غرقهم الإلحادی لیجدوا أنفسهم یغوصون فی وحول المادیة التاریخیة ، والجدلیة السفسطائیة ، غیر أنهم لم یجدوا ضالتهم فیما بحثوا عنه فارتدوا هاربین لیلقوا بأنفسهم فی أحضان الفن للفن ، ولكنهم لم تستقر لهم حال فتخبطوا خبط عشواء حتى استقر بهم السبیل إلى مهاوی الوجودیة التی كشفت عن كل شیء فجعلت الحریة فوضى ، والالتزام تفلتا ، والإیمان بالأشیاء كفرا " فلم یعد فی حیاة الغربی إلا أن تنفجر هذه المذاهب انفجارا رهیبا یحطم كل شیء ، یحطم كل قیمة ، لتعلن یأس الإنسان الغربی وفشله فی أن یجد أمنا أو أمانا " الحداثة من منظور إیمانی ص 17 . وقد جاءت الحداثة لتمثل هذا الانفجار الفكری الرهیب الیائس ، انفجار الإنسان الذی لا یعرف الأمن والأمان فی ذاته آلاف السنین .
وقد اختلف كثیر من الذین أرخوا ونظروا للحداثة الغربیة حول بدایاتها الأولى ، وعلى ید من من كتابهم ظهرت ونشأت ، ورغم ذلك یتفق بعضهم على أن إرهاصاتها المبكرة بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر المیلادی على یدی " بودلیر " الفرنسی صاحب دیوان " أزهار الشر " . ولكنها لم تنشأ من فراغ ، بل هی امتداد لإفرازات المذاهب والتیارات الفكریة ولاتجاهات الأدبیة والایدلوجیة المتعاقبة التی عاشتها أوروبا فی القرون الخوالی ، والتی قطعت فیها صلتها بالدین والكنیسة وتمردت علیه ، وقد ظهر ذلك جلیا منذ ما عرف بعصر النهضة فی القرن الخامس عشر المیلادی ، عندما انسلخ المجتمع الغربی عن الكنیسة وثار علی سلطاتها الروحیة ، التی كانت بالنسبة لهم كابوسا مخیفا ، وسیفا مسلطا على رقابهم محاربا لك دعوة للعلم الصحیح ، والاحترام لعقل الإنسان وتفكیره ، وفكره . وكان من الطبیعی أن نرى تخبط الغرب ، وتقلباته وثوراته على كل شیء من حوله ، ما دام لا توجد أرضیة صلبة مستویة ینطلق منها ، لتصور مقبول للحیاة والإنسان والكون عامة ولا توابث قویة لهم لتكون مرتكزا یتكئون علیه نحو تقدمهم المادی ، ورقیهم الفكری والحضاری ، مما أدى إلى ظهور كثیر من المتناقضات والتضاد ، وأن یهدموا الیوم بمعاول التمرد والثورة ما بنوه بالأمس ، إضافة إلى انعدام الروابط المتینة بین هذه الأفكار على اختلاف مشاربها وتباین اتجاهاتها سوى أنها تلتقی فی مستنقع المادیة الملحدة ، لذا نجدهم یتقلبون خلال المذاهب الفكریة والأدبیة التی ووسمتهم بخاتمها ، وطبعتهم بطابعها ، ولونتهم باتجاهاتها فتولدت عندهم الكلاسیكیة التی كانت امتدادا طبیعیا لنظریة المحاكاة والتقلید التی أطلقها أرسطو ، والتی تعنی أن الإنسان محدود الطاقات ، متمسك بأهداب التقلید ، مع المیل إلى التحفظ واللیاقة ، ومراعاة المقام ، والخیال المركزی المجند فی خدمة الواقع .
تم تأسس الاتجاه الرومانسی على أنقاض الكلاسیكیة التی وقفت عاجزة أمام تحقیق ما كان یصبو إلیه الغرب من التخلص من آثار القدیم ومحاكاته ، فوجدوا ضالتهم فی مذهب توری متمرد على كل أشكال القدیم وآثاره ، فقدست الرومانسیة الذات ، ورفضت الواقع ، وثارت على الموروث ، وادعت أن الشرائع والعادات والتقالید هی التی أفسدت المجتمع ، ویجب العمل على تحطیمها ، والتخلص منها ، ولكن الأمر غیر المتوقع مع ما نادت به الرومانسیة ، وجاهدت من أجل تحقیقه أنها قد فشلت فشلا ذریعا فی تعییر الواقع ، فأوغل دعاتها فی الخیال والأحلام ، والتحلیق نحو المجهول .
وقد تحول الغرب كما هی طبیعته فرارا من المجهول إلى المجهول ، ومن الضلال إلى الضلال ، ومن اللاواقع إلى ما هو أبعد من اللاواقع وكان ذلك دیدنهم على مدى قرون طوال یبحثون عن لا شیء لعلهم یجدون ذواتهم الضائعة فی اتجاه جدید یخلصهم من معاناتهم وضیاعهم وتیه نفوسهم ، فاتجهوا نحو ما عرف بالبرناسیة ، ثم فروا منها لإلى ما عرف بالواقعیة التی تطورت فیما بعد إلى الرمزیة التی كانت حلقة الوصل بین تلك المذاهب الفكریة والأدبیة وبین ما عرف الیوم بالحداثة ، وعلاقتها بالجانب الأدبی على أقل تقدیر ، وكان على رأس المذهب الرمزی الكاتب والأدیب الأمریكی المشهور " إدغار آلان بو " الذی تأثر به رموز الحداثة وروادها فی العرب أمثال مالارامیه ، وفالیری ، وموبسان ، كما كان المؤثر الأول والمباشر فی فكر وشعر عمید الحداثیین فی الغرب والشرق على حد سواء الشاعر الفرنسی المشهور " بودلیر " كما ذكرنا آنفا .
وقد نادى إدغار بأن یكون الأدب كاشفا عن الجمال ، ولا علاقة له بالحق والأخلاق ، وهذا ما انعكس على حیاته بشكل عام ، حیث كان موزعا بین القمار والخمر والفشل الدراسی والعلاقات الفاسدة ، ومحاولة الانتحار . وعلى خطا إدغار سار تلمیذه بودلیر ممعنا فی الضلال ومجانبا للحق والفضیلة .
ویعد بودلیر مؤسس تیار الحداثة من الناحیة الفنیة الأدبیة ، والذی نادى بالغموض فی الأحاسیس والمشاعر ، والفكر والأخلاق ، كما قام المذهب الرمزی الذی أراده على تغییر وظیفة اللغة الوضعیة بإیجاد علاقات لغویة جدیدة تشیر إلى مواضع لم تعهدها من قبل . . . ویطمح أیضا إلى تغییر وظیفة الحواس عن طریق اللغة الشعریة ، لذا لا یستطیع القارئ ، أو السامع أن یجد المعنى الواضح المعهود فی الشعر الرمزی . كما یذكر د . عبد الحمید جیدة فی كتابه الاتجاهات الجدیدة فی الشعر العربی المعاصر ص 121 . ومما لا جدال فیه أن الحداثة كمذهب أدبی تجدیدی قامت فی أساسها الأول على الغموض وتغییر اللغة ، والتخلص من الموروث بكل أشكاله ، وأجناسه ، وتجاوزهم للسائد والنمطی .
وكان بودلیر الذی نمت وترعرعت على یدیه بذرة الحداثة من أسوأ ما عرفت الآداب العالمیة خلقا وإمعانا فی الرذیلة ، وممارسة لكل ما یتنافی مع الأخلاق والعقیدة . یقول عنه مصطفى السحرتی فی مقدمة ترجمة دیوان أزهار الشر لبودلیر " لقد كانت مراحل حیاته منذ الطفولة نموذجا للضیاع والشذوذ ، ثم بعد نیل الشهادة الثانویة قضى فترة فی الحی اللاتینی ، حیث عاش عیشة فسوق وانحلال ، وهناك أصیب بداء الزهری ، وعاش فی شبابه عیشة تبذل ، وعلاقات شاذة مع مومسات باریس ، ولاذ فی المرحلة الأخیرة من حیاته بالمخدرات والشراب " .
ویقول عنه الشاعر إبراهیم ناجی مترجم دیوان أزهار الشر " لإن بودلیر كان یحب تعذیب الآخرین ویتلذذ به ، وكان یعیش مصابا بمرض انفصام الشخصیة " .
ولم یكن الطعن على شخصیة بودلیر متوقفة على بعض الشعراء والنقاد العرب الذین عرفوه من خلال شعره ، وعایشوه فی مرحلة زمنیة معینة فی النصف الأول من القرن العشرین ، بل كان لأبناء جلدته أقوالا وآراء كثیرة حول هذه الشخصیة الحیة المیتة ، یقول عنه أحد كتاب الغرب : " إن بودلیر شیطان من طراز خاص " . ویقول عنه آخر : " إنك لا تشم فی شعره الأدب والفن ، وإنما تشم منه رائحة الأفیون " عوض القرنی : الحداثة فی میزان الإسلام ص 23 .
وقد عرف بودلیر إضافة إلى ما عرف عن شخصیته الذاتیة بنزعته الماركسیة الثوریة الفردیة التی لا تنسجم مع المثل والمبادئ التی ینادی بها عصره آنذاك . یقول عنه محمد برادة فی مجلة فصول العدد الثالث ص 13 ، 14 : " إن الخیبة التی انتهى إلیها بودلیر من مراهنته على حداثته ، لیس فقط أنه یعانی موت الجمال ویبكیه ، بل یعانی كذلك غیابا ، لا غیاب الله ، أو موته ، بل أكثر من ذلك ، فالحداثة تغلف ، وتقنّع غیاب البراكسیس وإخفاقه بمعناه الماركسی ، الباركسیسی الثوری الشامل ، وأنها تكشف هذا الغیاب ، وستكون الحداثة داخل المجتمع البرجوازی هی ظل الثورة الممكنة " . كما یقول عنه غالی شكری فی كتابه شعرنا الحدیث إلى أین ص 16 " وقدیما كان بودلیر نبیا للشعر الحدیث ، حیث تبلور إحساسه المفاجئ العلیل بحیاة فردیة لا تنسجم مع المثل الذی ینادی بها العصر الذی یعیش فیه " .
ثم أعقب بودلیر رائد من رواد الحداثة فی الغرب وهو رامبو الذی لا یقل شأنا عنه فی المناداة إلى الهدم العقلانی لكل الحواس ، وأشكال الحب والعذاب والجنون ، ودعا إلى أن یكون الشعر رؤیة ما لا یرى ، وسماع ما لا یسمع ، وفی رأیه أن الشاعر لا بد أن یتمرد على التراث ن وعلى الماضی ، ویقطع أی صلة مع المبادئ الأخلاقیة والدینیة ، وتمیز شعره بغموضه ، وتغییره لبنیة التراكیب ، والصیاغة اللغویة عما وضعت علیه ، وتمیز أیضا بالصور المتباعدة المتناقضة الممزقة كما یذكر د . عبد الحمید جیدة فی كتابه الاتجاهات الحدیثة فی الشعر العربی المعاصر ص 148 .
وقد تعاقب ركب الحداثیین فی الغرب ، وسلكوا نفس الطریق الذی بدأه بودلیر ، ورامبو ، وساروا على نهجهما ، ومن هؤلاء مالارمییه ، وبول فالیری ، حتى وصلت الحداثة الغربیة شكلها المتكامل النهائی على ید الأمریكی الیهودی عزرا باوند ، والإنجلیزی توماس الیوت .
وغدت الحداثة الغربیة سلسلة متصلة الحلقات یتناقلها اللاحقون عن السابقین ، وهی إلى جانب ذلك متصلة شدیدة الاتصال بما سبقها من وجودیة ورمزیة وسریالیة ومادیة جدلیة ومادیة تاریخیة وواقعیة واشتراكیة علمیة وبرناسیة ، ورومانسیة ، وبكثیر من الأفكار والمبادئ والتیارات التی كانت قاعدة لها ، ومنطلقا فكریا مدها بكل ما حملته تلك المذاهب من فكر وأیدلوجیات ، وتمرد على كل ما هو سائد وموروث ، وتجاوزت حدود الأدب واللغة لیطال الدین والأخلاق والقیم والعلم . فهی تحطیم للماضی والحاضر والمستقبل . وهكذا نمت الحداثة الغربیة وترعرعت فی أوحال الرذیلة ، ومستنقعات اللاأخلاق ، وأینعت ثمارها الخبیثة على أیدی الشیوعیین من أمثال نیرودا ، ولوركا ، وناظم حكمت ، وفتشنكو ، والوجودیین أمثال سارتر ، وسیمون دی بوفوار ، وألبیر كامو ، وآتت أكلها على أیدی الجیل المنظر والداعم لها والمحفز على السیر فی ركابها من أمثال ألوی أراجون ، وهنری لوفیفر ، وأوجین جراندال ، ورولان بارت ، ورومان یاكوبسون ، ولیفی شترواس ، وبیاجیه ، وغیرهم كثر .
الحداثة العربیة
تسللت الحداثة الغربیة إلى أدبنا ولغتنا العربیة وفكرنا ومعتقداتنا وأخلاقیاتنا كما تتسلل الأفعى الناعمة الملمس لتقتنص فریستها ، أن تشعر الفریسة بها إلا وهی جثة هامدة تزدردها رویدا رویدا ، هكذا كان تسلل الحداثة إلى عقول معتنقیها وروادها وسدنتها من أدباء ونقاد ومفكرین على امتداد الوطن العربی . وهی كغیرها من المذاهب الفكریة ، والتیارات الأدبیة التی سبقتها إلى البیئة العربیة كالبرناسة ، والواقعیة ، والرمزیة ، والرومانسیة ، والوجودیة ، وجدت لها فی فكرنا وأدبنا العربی تربة خصبة ، سرعان ما نمت وترعرعت على أیدی روادها العرب ، أمثال غالی شكری ، وكاهنها الأول والمنظر لها على أحمد سعید المعروف " بأدونیس " ، وزوجته خالدة سعید من سوریا ، وعبد الله العروی من المغرب ، وكمال أبو دیب من فلسطین ، وصلاح فضل ، وصلاح عبد الصبور من مصر ، وعبد الوهاب البیاتی من العراق ، وعبد العزیز المقالح من الیمن ، وحسین مروة من لبنان ، ومحمود درویش ، وسمیح القاسم من فلسطین ، ومحمد عفیفی مطر ، وأمل دنقل من مصر ، وعبد الله القذامی ، وسعید السریحی من السعودیة ، وغیرهم .
وقد أشار غالی شكری فی كتابه الشعر الحدیث إلى أین إلى الروافد التی غذت بذرة الحداثة العربیة فقال : " كانت هذه المجموعة من الكشوف تفصح عن نظرة تاریخیة تستضیء بالماضی لتفسر الحاضر ، وتنبئ بالمستقبل . فالمنهج الجدلی ، والمادیة التاریخیة یتعرفان على أصل المجتمع ، ثم یفسران أزمة العصر ، أو النظام الرأسمالی ، ثم یتنبآن بالمجتمع الاشتراكی الذی ینعدم فیه الصراع الطبقی " .
ویقول أدونیس فی كتابه التابث والمتحول كما ذكر الدكتور محمد هدارة فی مقال له نشر فی مجلة الحرس الوطنی السعودی : " لا یمكن أن تنهض الحیاة العربیة ، ویبدع الإنسان العربی إذا لم تنهدم البنیة التقلیدیة السائدة للفكر العربی ، ویتخلص من المبنى الدینی التقلیدی الاتباعی " . وهذه الدعوة الصریحة والخبیثة فی حد ذاتها دعوة جاهرة للثورة على الدین الإسلامی ، والقیم والأخلاق العربیة الإسلامیة ، والتخلص منها ، والقضاء علیها .
ثم یقول أدونیس أیضا فی مقابلة أجرتها معه مجلة فكر وفن عام 1987 م : " إن القرآن هو خلاصة ثقافة لثقافات قدیمة ظهرت قبله . . . وأنا أتبنى التمییز بین الشریعة والحقیقة ، إن الشریعة هی التی تتناول شؤون الظاهر ، والحقیقة هی التی یعبرون عنها بالخفی ، والمجهول ، والباطن ، ولذلك فإن اهتمامی بالمجهول ربما یأتی ، ویتغیر باستمرار ، وهذا ما یتناقض مع الدین " .
مما سبق یتضح أن رواد الحداثة لم یكونوا دعاة للتجدید بمفهومه المتعارف علیه فی اللغة ولا یعنی بالأدب والشعر كما یدعون ، وإنما هم دعاة للهدم والتخریب ، كما یعلنون عن ذلك صراحة فی كتبهم النقدیة ودواوینهم الشعریة ومؤلفاتهم بشكل عام . فقد ضل كثیر منهم یخلط بین الحداثة كمنهج فكری ، یدعو إلى الثورة والتمرد على الموروث والسائد والنمطی بأنواعه المختلفة عقیدا ولغة وأدبا وأخلاقا ، وبین المعاصرة والتجدید الذی یدعو إلى تطویر ما هو موجود من میراث أدبی ولغوی ، والإضافة علیه بما یواكب العصر ، ویتواءم مع التطور ، منطلقا من ذلك الإرث الذی لا یمكن تجاوزه بحال من الأحوال ، فهو عنوان الأمة ، ورمز حضارتها ، والأمة التی لا موروث لها لا حضارة لها ، وجدیدها زائف ممجوج .
وقد تسللت الحداثة الغربیة إلى فكرنا العربی فی غفلة دینیة لدى الكثیرین من المثقفین العرب المسلمین ، وإن كان القلة منهم هم الذین تنبهوا لهذا الخطر الداهم للغتهم وعقیدتهم وأدبهم على حد سواء ، فحاولوا التصدی لها بشتى الطرق والوسائل المتاحة والممكنة ، ولكن سدنتها كانوا أسرع إلى التحایل على الجهلة وأنصاف المثقفین ممن یدعون أنهم منفتحون على الفكر الغربی وثقافته ، ولا بد أن یواكبوا هذا التطور ویتعاملوا معه بما یقتضیه الواقع ، وإن كان واقعا مزیفا لا یخطف بریقه إلا عقول الجهلاء والأتباع . فأخذ دعاتها على عواتقهم تمریر هذه البدعة الجدیدة ، وجاهدوا فی الوصول إلى أغراضهم الزائفة حتى استطاعوا أن یقنعوا الكثیرین بها باعتبارها دعوة إلى التجدید والمعاصرة تهدف إلى الانتقال بالأدب العربی المتوارث نقلة نوعیة جدیدة تخلصه مما علق به من سمات الجمود والتخلف لیواكب التطور الحضاری الذی یفرضه واقع العصر الذی نعیشه ، والذی تفرضه سنن الحیاة . لذلك نجد أدونیس یقول فی كتابه الثابت والمتحول ج 3 ص 9 : " ومبدأ الحداثة هو الصراع القائم بین السلفیة والرغبة العاملة لتغییر هذا النظام ن وقد تأسس هذا الصراع فی أثناء العهدین الأموی والعباسی ، حیث نرى تیارین للحداثة : الأول سیاسی فكری ، ویتمثل من جهة فی الحركات الثوریة ضد النظام القائم ، بدءا من الخوارج ، وانتهاء بثورة الزنج ، مرورا بالقرامطة ، والحركات الثوریة المتطرفة ، ویتمثل من جهة ثانیة فی الاعتزال والعقلانیة الإلحادیة وفی الصوفیة على الأخص " .
ثم یواصل أدونیس حدیثة قائلا : " هكذا تولدت الحداثة تاریخیا من التفاعل والتصادم بین موقفین وعقلیتین فی مناخ تغیر ، ونشأت ظروف وأوضاع جدیدة ، ومن هنا وصف عدد من مؤسسی الحداثة الشعریة بالخروج " المرجع السابق ج3 ص11 .
ویعتبر أدونیس المنظر الفكری للحداثیین العرب الذی أخذ على عاتقه نبش كتب التراث لیستخرج منها كل شاذ ومنحرف من الشعراء والأدباء والمفكرین من أمثال بشار بن برد وأبی نواس ، لأن فی شعرهم كثیر من المروق على الإسلام ، والتشكیك فی العقائد ، والسخریة منها ، والدعوة للانحلال الجنسی كما یذكر عوض القرنی فی كتابه الحداثة فی میزان الإسلام ص 28 . ویواصل القرنی حدیثه : " وهكذا بعد أن حاول الحداثیون العرب أن یوجدوا لهم جذورا تاریخیة عند فساق وزنادقة ، وملاحدة العرب فی الجاهلیة والإسلام ، انطلقت سفینتهم غیر الموفقة فی العصر الحدیث تنتقل من طور إلى آخر متجاوزة كل شیء إلى ما هو أسوء منه ، فكان أول ملامح انطلاقتهم الحدیثة هو استبعاد الدین تماما من معاییرهم وموازینهم بل مصادرهم ، إلا أن یكون ضمن ما یسمونه بالخرافة ، أو الأسطورة ، ویستشهد على صحة قوله بما نقله عن الكاتبة الحداثیة خالد سعید فی مجلة فصول بعنوان الملامح الفكریة للحداثة حیث تقول : " إن التوجهات الأساسیة لمفكری العشرینات تقدم خطوطا عریضة تسمح بالمقول إن البدایة الحقیقیة للحداثة من حیث هی حركة فكریة شاملة ، قد انطلقت یوم ذاك ، فقد مثل فكر الرواد الأوائل قطیعة مع المرجعیة الدینیة والتراثیة كمعیار ومصدر وحید للحقیقة ، وأقام مرجعین بدیلین : العقل والواقع التاریخی ، وكلاهما إنسانی ، ومن ثم تطوری ، فالحقیقة عن رائد كجبران ، أو طه حسین لا تلمس بالعقل ، بل تلمس بالاستبصار عند جبران ، والبحث المنهجی العقلانی عند طه حسین " الحداثة فی میزان الإسلام ص 29 ، 30 عوض القرنی .
ومن دعاة الحداثة العربیة ـ وهم كثر ـ نذكر منهم على سبیل المثال ، علی أحمد سعید " أدونیس " وزوجته خالد سعید، وعبد الله العروی ، وكمال أبودیب ، وصلاح فضل، وصلاح عبد الصبور ، وعبد العزیز المقالح، وحسین مروة، ومحمد عفیفی مطر ، وأمل دنقل وعبد الوهاب البیاتی، ومحمود درویش ، وسمیح القاسم ، وعبد الله الغذامی ، وسعید السریحی ، وعبد الصیخان ، ومحمد التبیتی ، وأحمد نائل فقیه من المملكة العربیة السعودیة .
قبل أن نخوض فی مفهوم الحداثة الاصطلاحی ، نرى من المفید أن نعرج على مضمونها اللغوی ، فهی مصدر من الفعل " حَدَثَ " ، وتعنی نقیض القدیم ، والحداثة أول الأمر وابتداؤه ، وهی الشباب وأول العمر .
وبهذا المفهوم اللغوی سطعت شمس الحداثة فی عالمنا العربی المعاصر ، وتوافقت مع ما یحمل عصرنا من عقد نفسیة ، وقلق ذاتی من القدیم الموروث ، ومحاولة الثورة علیه ، والتخلص منه ، والبحث عن كل ما هو جدید یتوافق وروح عصر التطور العلمی والمادی ، ویواكب الایدولوجیات الوافد على عالمنا العربی . أما ما تعنیه الحداثة اصطلاحا فهی : " اتجاه فكری أشد خطورة من اللبرالیة والعلمانیة والماركسیة ، وكل ما عرفته البشریة من مذاهب واتجاهات هدامة ، ذلك أنها تضمن كل هذه المذاهب الفكریة ، وهی لا تخص مجالات الإبداع الفنی ، والنقد الأدبی ، ولكنها تخص الحیاة الإنسانیة فی كل مجالاتها المادیة والفكریة على حد سواء " ، وهی بهذا المفهوم الاصطلاحی " اتجاه جدید یشكل ثورة كاملة على كل ما كان وما هو كائن فی المجتمع " . الحداثة فی الأدب المعاصر ـ هل انفض سامرها ، د . محمد مصطفى هدارة ، مجلة الحرس الوطنی ربیع الآخر 1410 هـ .
ویقول أحد الباحثین فی معرض حدیثه عن الحداثة كمنهج فكری یسعى لتغییر الحیاة " إن من دعاوى أهل الحداثة أن الأدب یجب أن ینظر إلیه من الناحیة الشكلیة والفنیة فقط بغض النظر عما یدعوا إلیه ذلك الأدب من أفكار ، وینادی به من مبادئ وعقائد وأخلاق ، فما دام النص الأدبی عندهم جمیلا من الناحیة الفنیة ، فلا یضیر أن یدعو للإلحاد أو الزنا أو اللواط أو الخمریات أو غیر ذلك " عوض القرنی ، الحداثة فی میزان الإسلام ص 47 .
ویقول د . عدنان النحوی فی كتابه الحداثة من منظور إسلامی ص 13 : " لم تعد لفظة الحداثة فی واقعنا الیوم تدل على المعنى اللغوی لها ن ولم تعد تحمل فی حقیقتها طلاوة التجدید ، ولا سلامة الرغبة ، إنها أصبحت رمزا لفكر جدید ، نجد تعریفة فی كتابات دعاتها وكتبهم ن فالحداثة تدل الیوم على مذهب فكری جدید یحمل جذوره وأصوله من الغرب ، بعیدا عن حیاة المسلمین ن بعیدا عن حقیقة دینهم ، ونهج حیاتهم ، وظلال الإیمان والخشوع للخالق الرحمن " .
فالحداثة إذن من منظور إسلامی عند كثیر من الدعاة تتنافى مع دیننا وأخلاقنا الإسلامیة ، وهی معول هدم جاءت لتقضی على كل ما هو إسلامی دینا ولغة وأدبا وتراثا ، وتروج لأفكار ومذاهب هدامة ، بل هی أخطر تلك المذاهب الفكریة ، وأشدها فتكا بقیم المجتمع العربی الإسلامیة ومحاولة القضاء علیه والتخلص منه ، وإحلال مجتمع فكری عربی محله یعكس ما فی هذه المجتمعات الغربیة من حقد وحنق على العالم الإسلامی ، ویروجون بكل اهتمام وجدیه من خلال دعاتها ممن یدعون العروبة لهذه المعتقدات والقیم الخبیثة بغرض قتل روح الإسلام ولغته وتراثه .
وتقول الكاتبة سهیلة زین العابدین فی مقالة نشرت لها فی جریدة الندوة السعودیة الغدد 8424 فی 14 / 3 / 1407 هـ ص 7 : " الحداثة من أخطر قضایا الشعر العربی المعاصر لأنها أعلنت الثورة والتمرد على كل ما هو دینی وإسلامی وأخلاقی ، فهی ثورة على الدین على التاریخ على الماضی على التراث على اللغة على الأخلاق ، واتخذت من الثورة على الشكل التقلیدی للقصیدة الشعریة العربیة بروازا تبروز به هذه الصورة الثوریة الملحدة " .
ویذكر د . محمد خضر عریف فی معرض حدیثه عن الحداثة وتعلیقه على بعض الدراسات التی صدرت حولها من غیر مفكریها وروادها فی الوطن العربی فی كتابه الحداثة مناقشة هادئة لقضیة ساخنة ص 11 و 12 قائلا : " إننا بصدد فكر هدام یتهدد أمتنا وتراثنا وعقیدتنا وعلمنا وعلومنا وقیمنا ، وكل شیء فی حاضرنا وماضینا ومستقبلنا " ، ویفرق الدكتور / خضر عریف فی كتابة الحداثة مناقشة هادئة لقضیة ساخنة بین مصطلح الحداثة والتجدید والمعاصر فیقول : " والذی یدفع إلى ذلك الظن الخاطئ هو الخلط بین مصطلح الحداثة ( modernism ) ، والمعاصرة ( modernity ) ، والتحدیث ( modernization ) وجمیع تلك المصطلحات كثیرا ما تترجم إلى " الحداثة " على ارعم من اختلافها شكلا ومضمونا وفلسفة وممارسة . والواقع أن الاتجاه الفكری السلیم یتفق مع التحدیث ، ولكنه لا یتفق مع الحداثة . وإن یكن مصطلحا modernity و modernization یمكن الجمع بینهما لیعنیا المعاصرة أو التجدید ، فإن مصطلح modernism یختلف عنهما تماما . إذ ینبغی أن نفرق بین مصطلحین أجنبیین ، من المؤسف أن كلیهما یترجم ترجمة واحدة وهی ( الحداثة ) أما المصطلح الأول فهو : modernity الذی یعنی إحداث تجدید وتغییر فی المفاهیم السائدة المتراكمة عبر الأجیال نتیجة وجود تغییر اجتماعی أو فكری أحدثه اختلاف الزمن .
أما الاصطلاح الثانی فهو modernism ویعنی مذهبا أدبیا ، بل نظریه فكریة لا تستهدف الحركة الإبداعیة وحدها ، بل تدعو إلى التمرد على الواقع بكل جوانبه السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة . . . وهو المصطلح الذی انتقل إلى أدبنا العربی الحدیث ، ولیس مصطلح modernity الذی یحسن أن نسمیه المعاصرة ، لأنه یعنی التجدید بوجه عام دون الارتباط بنظریة ترتبط بمفاهیم وفلسفات متداخلة متشابكة .
ونحن فی تعریفنا لمفهوم الحداثة لا نرید أن نتوقف عند ما قال به خصومها ، ولكن لا بد أن نتعرف علیه مما قال به أصحابها ومفكروها وسدنتها أیضا . یقول على أحمد سعید الملقب بأودنیس وهو من رواد الحداثة العربیة ومفكریها رابطا بینها وبین الحریة الماسونیة : " إن الإنسان حین یحرق المحرم یتساوى بالله " . ثم یتنامى المفهوم الماسونی لكلمة الحریة إلى صیغته التطبیقیة الكاملة فی قوله " : إن التساوی بالله یقود إلى نفیه وقتله ، فهذا التساوی یتضمن رفض العالم كما هو ، أو كما نظمه الله ن والرفض هنا یقف عند حدود هدمه ، ولا یتجاوزها إلى إعادة بنائه ، ومن هنا كان بناء عالم جدید یقتضی قتل الله نفسه مبدأ العالم القدیم ، وبتعبیر آخر لا یمكن الارتفاع إلى مستوى الله إلا بأن یهدم صورة العالم الراهن وقتل الله نفسه " محاضرة الحداثة والتراث د . محمد هدارة .
وقد عرف رولان بارت الحداثة بأنها انفجار معرفی لم یتوصل الإنسان المعاصر إلى السیطرة علیه فیقول : " فی الحداثة تنفجر الطاقات الكامنة ، وتتحرر شهوات الإبداع فی الثورة المعرفیة مولدة فی سرعة مذهلة ، وكثافة مدهشة أفكارا جدیدة ، وأشكالا غیر مألوفة ، وتكوینات غریبة ، وأقنعة عجیبة ، فیق بعض الناس منبهرا بها ، ویقف بعضهم الآخر خائفا منها ، هذا الطوفان المعرفی یولد خصوبة لا مثیل لها ، ولكنه یغرق أیضا " محاضرة الحداثة والتراث د . محمد هدارة .
ویتابع الدكتور هدارة قائلا : كما یصفها بعض الباحثین الغربیین " بأنها زلزلة حضاریة عنیفة ، وانقلاب ثقافی شامل ، وأنها جعلت الإنسان الغربی یشك فی حضارته بأكملها ، ویرفض حتى أرسخ معتقداته الموروثة " .
جذور الحداثة فی الغرب
ظهر تیار الحداثة فی الغرب نتیجة للمد الطبیعی الذی دخلته أوروبا منذ العصور الوثنیة فی العهدین الیونانی والرومانی ، امتدادا إلى عصر الظلمات ، مرورا بالعصور المتلاحقة التی تزاحمت بكل أنواع المذاهب الفكریة ، والفلسفات الوثنیة المتناقضة والمتلاحقة ، وقد كان كل مذهب عبارة عن ردة فعل لمذهب سابق ، وكل مذهب من هذه المذاهب كان یحمل فی ذاته عناصر اندثاره وفنائه .
لقد عشق الغرب شتى المذاهب والتیارات الفكریة بدءا من اعتناق الوثنیة ، وانتهاء بالانفجار الفكری الیائس الذی عرف بالحداثة ، مرورا بالمسیحیة وما ترتب علیها من مفاسد الكنیسة وظلمها وظلامها ، وبالطبیعة التی هجرها شعراؤها وكتابها لیعشقوا الواقعیة المزیفة التی ما لبثوا أن هجروها هربا إلى الكفر والإلحاد بالله كفرا صریحا جاهرا ، ثم تحولوا بكفرهم حاملینه من بعد یأس على كواهلهم باحثین عن الخلاص الذی ینتشلهم من غرقهم الإلحادی لیجدوا أنفسهم یغوصون فی وحول المادیة التاریخیة ، والجدلیة السفسطائیة ، غیر أنهم لم یجدوا ضالتهم فیما بحثوا عنه فارتدوا هاربین لیلقوا بأنفسهم فی أحضان الفن للفن ، ولكنهم لم تستقر لهم حال فتخبطوا خبط عشواء حتى استقر بهم السبیل إلى مهاوی الوجودیة التی كشفت عن كل شیء فجعلت الحریة فوضى ، والالتزام تفلتا ، والإیمان بالأشیاء كفرا " فلم یعد فی حیاة الغربی إلا أن تنفجر هذه المذاهب انفجارا رهیبا یحطم كل شیء ، یحطم كل قیمة ، لتعلن یأس الإنسان الغربی وفشله فی أن یجد أمنا أو أمانا " الحداثة من منظور إیمانی ص 17 . وقد جاءت الحداثة لتمثل هذا الانفجار الفكری الرهیب الیائس ، انفجار الإنسان الذی لا یعرف الأمن والأمان فی ذاته آلاف السنین .
وقد اختلف كثیر من الذین أرخوا ونظروا للحداثة الغربیة حول بدایاتها الأولى ، وعلى ید من من كتابهم ظهرت ونشأت ، ورغم ذلك یتفق بعضهم على أن إرهاصاتها المبكرة بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر المیلادی على یدی " بودلیر " الفرنسی صاحب دیوان " أزهار الشر " . ولكنها لم تنشأ من فراغ ، بل هی امتداد لإفرازات المذاهب والتیارات الفكریة ولاتجاهات الأدبیة والایدلوجیة المتعاقبة التی عاشتها أوروبا فی القرون الخوالی ، والتی قطعت فیها صلتها بالدین والكنیسة وتمردت علیه ، وقد ظهر ذلك جلیا منذ ما عرف بعصر النهضة فی القرن الخامس عشر المیلادی ، عندما انسلخ المجتمع الغربی عن الكنیسة وثار علی سلطاتها الروحیة ، التی كانت بالنسبة لهم كابوسا مخیفا ، وسیفا مسلطا على رقابهم محاربا لك دعوة للعلم الصحیح ، والاحترام لعقل الإنسان وتفكیره ، وفكره . وكان من الطبیعی أن نرى تخبط الغرب ، وتقلباته وثوراته على كل شیء من حوله ، ما دام لا توجد أرضیة صلبة مستویة ینطلق منها ، لتصور مقبول للحیاة والإنسان والكون عامة ولا توابث قویة لهم لتكون مرتكزا یتكئون علیه نحو تقدمهم المادی ، ورقیهم الفكری والحضاری ، مما أدى إلى ظهور كثیر من المتناقضات والتضاد ، وأن یهدموا الیوم بمعاول التمرد والثورة ما بنوه بالأمس ، إضافة إلى انعدام الروابط المتینة بین هذه الأفكار على اختلاف مشاربها وتباین اتجاهاتها سوى أنها تلتقی فی مستنقع المادیة الملحدة ، لذا نجدهم یتقلبون خلال المذاهب الفكریة والأدبیة التی ووسمتهم بخاتمها ، وطبعتهم بطابعها ، ولونتهم باتجاهاتها فتولدت عندهم الكلاسیكیة التی كانت امتدادا طبیعیا لنظریة المحاكاة والتقلید التی أطلقها أرسطو ، والتی تعنی أن الإنسان محدود الطاقات ، متمسك بأهداب التقلید ، مع المیل إلى التحفظ واللیاقة ، ومراعاة المقام ، والخیال المركزی المجند فی خدمة الواقع .
تم تأسس الاتجاه الرومانسی على أنقاض الكلاسیكیة التی وقفت عاجزة أمام تحقیق ما كان یصبو إلیه الغرب من التخلص من آثار القدیم ومحاكاته ، فوجدوا ضالتهم فی مذهب توری متمرد على كل أشكال القدیم وآثاره ، فقدست الرومانسیة الذات ، ورفضت الواقع ، وثارت على الموروث ، وادعت أن الشرائع والعادات والتقالید هی التی أفسدت المجتمع ، ویجب العمل على تحطیمها ، والتخلص منها ، ولكن الأمر غیر المتوقع مع ما نادت به الرومانسیة ، وجاهدت من أجل تحقیقه أنها قد فشلت فشلا ذریعا فی تعییر الواقع ، فأوغل دعاتها فی الخیال والأحلام ، والتحلیق نحو المجهول .
وقد تحول الغرب كما هی طبیعته فرارا من المجهول إلى المجهول ، ومن الضلال إلى الضلال ، ومن اللاواقع إلى ما هو أبعد من اللاواقع وكان ذلك دیدنهم على مدى قرون طوال یبحثون عن لا شیء لعلهم یجدون ذواتهم الضائعة فی اتجاه جدید یخلصهم من معاناتهم وضیاعهم وتیه نفوسهم ، فاتجهوا نحو ما عرف بالبرناسیة ، ثم فروا منها لإلى ما عرف بالواقعیة التی تطورت فیما بعد إلى الرمزیة التی كانت حلقة الوصل بین تلك المذاهب الفكریة والأدبیة وبین ما عرف الیوم بالحداثة ، وعلاقتها بالجانب الأدبی على أقل تقدیر ، وكان على رأس المذهب الرمزی الكاتب والأدیب الأمریكی المشهور " إدغار آلان بو " الذی تأثر به رموز الحداثة وروادها فی العرب أمثال مالارامیه ، وفالیری ، وموبسان ، كما كان المؤثر الأول والمباشر فی فكر وشعر عمید الحداثیین فی الغرب والشرق على حد سواء الشاعر الفرنسی المشهور " بودلیر " كما ذكرنا آنفا .
وقد نادى إدغار بأن یكون الأدب كاشفا عن الجمال ، ولا علاقة له بالحق والأخلاق ، وهذا ما انعكس على حیاته بشكل عام ، حیث كان موزعا بین القمار والخمر والفشل الدراسی والعلاقات الفاسدة ، ومحاولة الانتحار . وعلى خطا إدغار سار تلمیذه بودلیر ممعنا فی الضلال ومجانبا للحق والفضیلة .
ویعد بودلیر مؤسس تیار الحداثة من الناحیة الفنیة الأدبیة ، والذی نادى بالغموض فی الأحاسیس والمشاعر ، والفكر والأخلاق ، كما قام المذهب الرمزی الذی أراده على تغییر وظیفة اللغة الوضعیة بإیجاد علاقات لغویة جدیدة تشیر إلى مواضع لم تعهدها من قبل . . . ویطمح أیضا إلى تغییر وظیفة الحواس عن طریق اللغة الشعریة ، لذا لا یستطیع القارئ ، أو السامع أن یجد المعنى الواضح المعهود فی الشعر الرمزی . كما یذكر د . عبد الحمید جیدة فی كتابه الاتجاهات الجدیدة فی الشعر العربی المعاصر ص 121 . ومما لا جدال فیه أن الحداثة كمذهب أدبی تجدیدی قامت فی أساسها الأول على الغموض وتغییر اللغة ، والتخلص من الموروث بكل أشكاله ، وأجناسه ، وتجاوزهم للسائد والنمطی .
وكان بودلیر الذی نمت وترعرعت على یدیه بذرة الحداثة من أسوأ ما عرفت الآداب العالمیة خلقا وإمعانا فی الرذیلة ، وممارسة لكل ما یتنافی مع الأخلاق والعقیدة . یقول عنه مصطفى السحرتی فی مقدمة ترجمة دیوان أزهار الشر لبودلیر " لقد كانت مراحل حیاته منذ الطفولة نموذجا للضیاع والشذوذ ، ثم بعد نیل الشهادة الثانویة قضى فترة فی الحی اللاتینی ، حیث عاش عیشة فسوق وانحلال ، وهناك أصیب بداء الزهری ، وعاش فی شبابه عیشة تبذل ، وعلاقات شاذة مع مومسات باریس ، ولاذ فی المرحلة الأخیرة من حیاته بالمخدرات والشراب " .
ویقول عنه الشاعر إبراهیم ناجی مترجم دیوان أزهار الشر " لإن بودلیر كان یحب تعذیب الآخرین ویتلذذ به ، وكان یعیش مصابا بمرض انفصام الشخصیة " .
ولم یكن الطعن على شخصیة بودلیر متوقفة على بعض الشعراء والنقاد العرب الذین عرفوه من خلال شعره ، وعایشوه فی مرحلة زمنیة معینة فی النصف الأول من القرن العشرین ، بل كان لأبناء جلدته أقوالا وآراء كثیرة حول هذه الشخصیة الحیة المیتة ، یقول عنه أحد كتاب الغرب : " إن بودلیر شیطان من طراز خاص " . ویقول عنه آخر : " إنك لا تشم فی شعره الأدب والفن ، وإنما تشم منه رائحة الأفیون " عوض القرنی : الحداثة فی میزان الإسلام ص 23 .
وقد عرف بودلیر إضافة إلى ما عرف عن شخصیته الذاتیة بنزعته الماركسیة الثوریة الفردیة التی لا تنسجم مع المثل والمبادئ التی ینادی بها عصره آنذاك . یقول عنه محمد برادة فی مجلة فصول العدد الثالث ص 13 ، 14 : " إن الخیبة التی انتهى إلیها بودلیر من مراهنته على حداثته ، لیس فقط أنه یعانی موت الجمال ویبكیه ، بل یعانی كذلك غیابا ، لا غیاب الله ، أو موته ، بل أكثر من ذلك ، فالحداثة تغلف ، وتقنّع غیاب البراكسیس وإخفاقه بمعناه الماركسی ، الباركسیسی الثوری الشامل ، وأنها تكشف هذا الغیاب ، وستكون الحداثة داخل المجتمع البرجوازی هی ظل الثورة الممكنة " . كما یقول عنه غالی شكری فی كتابه شعرنا الحدیث إلى أین ص 16 " وقدیما كان بودلیر نبیا للشعر الحدیث ، حیث تبلور إحساسه المفاجئ العلیل بحیاة فردیة لا تنسجم مع المثل الذی ینادی بها العصر الذی یعیش فیه " .
ثم أعقب بودلیر رائد من رواد الحداثة فی الغرب وهو رامبو الذی لا یقل شأنا عنه فی المناداة إلى الهدم العقلانی لكل الحواس ، وأشكال الحب والعذاب والجنون ، ودعا إلى أن یكون الشعر رؤیة ما لا یرى ، وسماع ما لا یسمع ، وفی رأیه أن الشاعر لا بد أن یتمرد على التراث ن وعلى الماضی ، ویقطع أی صلة مع المبادئ الأخلاقیة والدینیة ، وتمیز شعره بغموضه ، وتغییره لبنیة التراكیب ، والصیاغة اللغویة عما وضعت علیه ، وتمیز أیضا بالصور المتباعدة المتناقضة الممزقة كما یذكر د . عبد الحمید جیدة فی كتابه الاتجاهات الحدیثة فی الشعر العربی المعاصر ص 148 .
وقد تعاقب ركب الحداثیین فی الغرب ، وسلكوا نفس الطریق الذی بدأه بودلیر ، ورامبو ، وساروا على نهجهما ، ومن هؤلاء مالارمییه ، وبول فالیری ، حتى وصلت الحداثة الغربیة شكلها المتكامل النهائی على ید الأمریكی الیهودی عزرا باوند ، والإنجلیزی توماس الیوت .
وغدت الحداثة الغربیة سلسلة متصلة الحلقات یتناقلها اللاحقون عن السابقین ، وهی إلى جانب ذلك متصلة شدیدة الاتصال بما سبقها من وجودیة ورمزیة وسریالیة ومادیة جدلیة ومادیة تاریخیة وواقعیة واشتراكیة علمیة وبرناسیة ، ورومانسیة ، وبكثیر من الأفكار والمبادئ والتیارات التی كانت قاعدة لها ، ومنطلقا فكریا مدها بكل ما حملته تلك المذاهب من فكر وأیدلوجیات ، وتمرد على كل ما هو سائد وموروث ، وتجاوزت حدود الأدب واللغة لیطال الدین والأخلاق والقیم والعلم . فهی تحطیم للماضی والحاضر والمستقبل . وهكذا نمت الحداثة الغربیة وترعرعت فی أوحال الرذیلة ، ومستنقعات اللاأخلاق ، وأینعت ثمارها الخبیثة على أیدی الشیوعیین من أمثال نیرودا ، ولوركا ، وناظم حكمت ، وفتشنكو ، والوجودیین أمثال سارتر ، وسیمون دی بوفوار ، وألبیر كامو ، وآتت أكلها على أیدی الجیل المنظر والداعم لها والمحفز على السیر فی ركابها من أمثال ألوی أراجون ، وهنری لوفیفر ، وأوجین جراندال ، ورولان بارت ، ورومان یاكوبسون ، ولیفی شترواس ، وبیاجیه ، وغیرهم كثر .
الحداثة العربیة
تسللت الحداثة الغربیة إلى أدبنا ولغتنا العربیة وفكرنا ومعتقداتنا وأخلاقیاتنا كما تتسلل الأفعى الناعمة الملمس لتقتنص فریستها ، أن تشعر الفریسة بها إلا وهی جثة هامدة تزدردها رویدا رویدا ، هكذا كان تسلل الحداثة إلى عقول معتنقیها وروادها وسدنتها من أدباء ونقاد ومفكرین على امتداد الوطن العربی . وهی كغیرها من المذاهب الفكریة ، والتیارات الأدبیة التی سبقتها إلى البیئة العربیة كالبرناسة ، والواقعیة ، والرمزیة ، والرومانسیة ، والوجودیة ، وجدت لها فی فكرنا وأدبنا العربی تربة خصبة ، سرعان ما نمت وترعرعت على أیدی روادها العرب ، أمثال غالی شكری ، وكاهنها الأول والمنظر لها على أحمد سعید المعروف " بأدونیس " ، وزوجته خالدة سعید من سوریا ، وعبد الله العروی من المغرب ، وكمال أبو دیب من فلسطین ، وصلاح فضل ، وصلاح عبد الصبور من مصر ، وعبد الوهاب البیاتی من العراق ، وعبد العزیز المقالح من الیمن ، وحسین مروة من لبنان ، ومحمود درویش ، وسمیح القاسم من فلسطین ، ومحمد عفیفی مطر ، وأمل دنقل من مصر ، وعبد الله القذامی ، وسعید السریحی من السعودیة ، وغیرهم .
وقد أشار غالی شكری فی كتابه الشعر الحدیث إلى أین إلى الروافد التی غذت بذرة الحداثة العربیة فقال : " كانت هذه المجموعة من الكشوف تفصح عن نظرة تاریخیة تستضیء بالماضی لتفسر الحاضر ، وتنبئ بالمستقبل . فالمنهج الجدلی ، والمادیة التاریخیة یتعرفان على أصل المجتمع ، ثم یفسران أزمة العصر ، أو النظام الرأسمالی ، ثم یتنبآن بالمجتمع الاشتراكی الذی ینعدم فیه الصراع الطبقی " .
ویقول أدونیس فی كتابه التابث والمتحول كما ذكر الدكتور محمد هدارة فی مقال له نشر فی مجلة الحرس الوطنی السعودی : " لا یمكن أن تنهض الحیاة العربیة ، ویبدع الإنسان العربی إذا لم تنهدم البنیة التقلیدیة السائدة للفكر العربی ، ویتخلص من المبنى الدینی التقلیدی الاتباعی " . وهذه الدعوة الصریحة والخبیثة فی حد ذاتها دعوة جاهرة للثورة على الدین الإسلامی ، والقیم والأخلاق العربیة الإسلامیة ، والتخلص منها ، والقضاء علیها .
ثم یقول أدونیس أیضا فی مقابلة أجرتها معه مجلة فكر وفن عام 1987 م : " إن القرآن هو خلاصة ثقافة لثقافات قدیمة ظهرت قبله . . . وأنا أتبنى التمییز بین الشریعة والحقیقة ، إن الشریعة هی التی تتناول شؤون الظاهر ، والحقیقة هی التی یعبرون عنها بالخفی ، والمجهول ، والباطن ، ولذلك فإن اهتمامی بالمجهول ربما یأتی ، ویتغیر باستمرار ، وهذا ما یتناقض مع الدین " .
مما سبق یتضح أن رواد الحداثة لم یكونوا دعاة للتجدید بمفهومه المتعارف علیه فی اللغة ولا یعنی بالأدب والشعر كما یدعون ، وإنما هم دعاة للهدم والتخریب ، كما یعلنون عن ذلك صراحة فی كتبهم النقدیة ودواوینهم الشعریة ومؤلفاتهم بشكل عام . فقد ضل كثیر منهم یخلط بین الحداثة كمنهج فكری ، یدعو إلى الثورة والتمرد على الموروث والسائد والنمطی بأنواعه المختلفة عقیدا ولغة وأدبا وأخلاقا ، وبین المعاصرة والتجدید الذی یدعو إلى تطویر ما هو موجود من میراث أدبی ولغوی ، والإضافة علیه بما یواكب العصر ، ویتواءم مع التطور ، منطلقا من ذلك الإرث الذی لا یمكن تجاوزه بحال من الأحوال ، فهو عنوان الأمة ، ورمز حضارتها ، والأمة التی لا موروث لها لا حضارة لها ، وجدیدها زائف ممجوج .
وقد تسللت الحداثة الغربیة إلى فكرنا العربی فی غفلة دینیة لدى الكثیرین من المثقفین العرب المسلمین ، وإن كان القلة منهم هم الذین تنبهوا لهذا الخطر الداهم للغتهم وعقیدتهم وأدبهم على حد سواء ، فحاولوا التصدی لها بشتى الطرق والوسائل المتاحة والممكنة ، ولكن سدنتها كانوا أسرع إلى التحایل على الجهلة وأنصاف المثقفین ممن یدعون أنهم منفتحون على الفكر الغربی وثقافته ، ولا بد أن یواكبوا هذا التطور ویتعاملوا معه بما یقتضیه الواقع ، وإن كان واقعا مزیفا لا یخطف بریقه إلا عقول الجهلاء والأتباع . فأخذ دعاتها على عواتقهم تمریر هذه البدعة الجدیدة ، وجاهدوا فی الوصول إلى أغراضهم الزائفة حتى استطاعوا أن یقنعوا الكثیرین بها باعتبارها دعوة إلى التجدید والمعاصرة تهدف إلى الانتقال بالأدب العربی المتوارث نقلة نوعیة جدیدة تخلصه مما علق به من سمات الجمود والتخلف لیواكب التطور الحضاری الذی یفرضه واقع العصر الذی نعیشه ، والذی تفرضه سنن الحیاة . لذلك نجد أدونیس یقول فی كتابه الثابت والمتحول ج 3 ص 9 : " ومبدأ الحداثة هو الصراع القائم بین السلفیة والرغبة العاملة لتغییر هذا النظام ن وقد تأسس هذا الصراع فی أثناء العهدین الأموی والعباسی ، حیث نرى تیارین للحداثة : الأول سیاسی فكری ، ویتمثل من جهة فی الحركات الثوریة ضد النظام القائم ، بدءا من الخوارج ، وانتهاء بثورة الزنج ، مرورا بالقرامطة ، والحركات الثوریة المتطرفة ، ویتمثل من جهة ثانیة فی الاعتزال والعقلانیة الإلحادیة وفی الصوفیة على الأخص " .
ثم یواصل أدونیس حدیثة قائلا : " هكذا تولدت الحداثة تاریخیا من التفاعل والتصادم بین موقفین وعقلیتین فی مناخ تغیر ، ونشأت ظروف وأوضاع جدیدة ، ومن هنا وصف عدد من مؤسسی الحداثة الشعریة بالخروج " المرجع السابق ج3 ص11 .
ویعتبر أدونیس المنظر الفكری للحداثیین العرب الذی أخذ على عاتقه نبش كتب التراث لیستخرج منها كل شاذ ومنحرف من الشعراء والأدباء والمفكرین من أمثال بشار بن برد وأبی نواس ، لأن فی شعرهم كثیر من المروق على الإسلام ، والتشكیك فی العقائد ، والسخریة منها ، والدعوة للانحلال الجنسی كما یذكر عوض القرنی فی كتابه الحداثة فی میزان الإسلام ص 28 . ویواصل القرنی حدیثه : " وهكذا بعد أن حاول الحداثیون العرب أن یوجدوا لهم جذورا تاریخیة عند فساق وزنادقة ، وملاحدة العرب فی الجاهلیة والإسلام ، انطلقت سفینتهم غیر الموفقة فی العصر الحدیث تنتقل من طور إلى آخر متجاوزة كل شیء إلى ما هو أسوء منه ، فكان أول ملامح انطلاقتهم الحدیثة هو استبعاد الدین تماما من معاییرهم وموازینهم بل مصادرهم ، إلا أن یكون ضمن ما یسمونه بالخرافة ، أو الأسطورة ، ویستشهد على صحة قوله بما نقله عن الكاتبة الحداثیة خالد سعید فی مجلة فصول بعنوان الملامح الفكریة للحداثة حیث تقول : " إن التوجهات الأساسیة لمفكری العشرینات تقدم خطوطا عریضة تسمح بالمقول إن البدایة الحقیقیة للحداثة من حیث هی حركة فكریة شاملة ، قد انطلقت یوم ذاك ، فقد مثل فكر الرواد الأوائل قطیعة مع المرجعیة الدینیة والتراثیة كمعیار ومصدر وحید للحقیقة ، وأقام مرجعین بدیلین : العقل والواقع التاریخی ، وكلاهما إنسانی ، ومن ثم تطوری ، فالحقیقة عن رائد كجبران ، أو طه حسین لا تلمس بالعقل ، بل تلمس بالاستبصار عند جبران ، والبحث المنهجی العقلانی عند طه حسین " الحداثة فی میزان الإسلام ص 29 ، 30 عوض القرنی .
ومن دعاة الحداثة العربیة ـ وهم كثر ـ نذكر منهم على سبیل المثال ، علی أحمد سعید " أدونیس " وزوجته خالد سعید، وعبد الله العروی ، وكمال أبودیب ، وصلاح فضل، وصلاح عبد الصبور ، وعبد العزیز المقالح، وحسین مروة، ومحمد عفیفی مطر ، وأمل دنقل وعبد الوهاب البیاتی، ومحمود درویش ، وسمیح القاسم ، وعبد الله الغذامی ، وسعید السریحی ، وعبد الصیخان ، ومحمد التبیتی ، وأحمد نائل فقیه من المملكة العربیة السعودیة .
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:42|
المقامات الأندلسیّة
لقد تأثر الأندلسیون بمقامات البدیع الهمذانی
وخلفه الحریری تأثراً جلیاً، إذ كان من الطبیعی أن تثیر إنجازاتهما إعجاباً
بین الأدباء، وتخلق تیاراً من المحاكاة فی میدان الكتابة عموماً وفی فن
كتابة المقامات خصوصاً.
وبدخول الأندلس عهد ملوك الطوائف كانت مقامات الهمذانی ورسائله قد انتشرت انتشاراً واسعاً حتى غدا الكثیر من الأدباء یؤلفون فی هذا الصنف من الأدب.
وفی مقدمة هؤلاء ابن شرف القیروانی الذی كتب مقامات تحدى بها البدیع فی حماه، كما قال ابن بسام(1). وابن بسام هذا أورد مقتطفات لكاتبین من كتاب المقامات...
وأبو محمد بن مالك القرطبی اللذان كانا یقیمان فی المریة فی عهد المعتصم ابن صمادح (443-483هـ/ 1051-1091م)(2).
وما دمنا بصدد الكلام عن أثر الهمذانی وأسلوبه فی الأندلس، یمكننا القول إن أثر مقاماته كان محصوراً فی دائرة ضیقة إذا ما قورن بأثر رسائله التی لاقت ترحیباً حاراً من ابن شُهید الذی استخدمها نموذجاً لنثره الذی انغمس فیه بوصف مفصل لأشیاء كثیرة كالماء والبراغیث والثعالب والحلویات(3) كما لاقت ترحیباً من أبی المغیرة ابن حزم الذی ألف رسالة یحاكی بها إحدى رسائل البدیع(4).
ظهرت مقامات الحریری فی مطلع عهد المرابطین وسرعان ما تداولها الناس على نطاق واسع. ویخبرنا ابن الأبار أن العدید من الأندلسیین سمعوا الحریری یبسط مقاماته فی حدیقته ببغداد، ثم عادوا إلى الأندلس لینشروا ما سمعوا(5). وبعد موت الحریری تابع تلامیذه بدورهم بسط المقامات باعتبارهم معتمدین من قبل أسیادهم(6).
درس الأندلسیون المقامات أیام المرابطین والموحدین على أیدی هؤلاء وتلامذتهم(7).
ولم یكتف الأندلسیون بدراسة المقامات ونقلها، بل أنشؤوا تعلیقات علیها أشهرها تعلیق الشریشی الذی قرأ التعلیقات السابقة كلها، وعندما عثر على تعلیق الفنجدیهی نقح كل شیء كتبه من قبل(8).
وما یعنینا فی هذه المقالة هو المقامة كما كتبها الأندلسیون، وخصوصاً تلك المقامات التی بقیت مخطوطات لمّا تنشرْ.
وكان أول من كتب فی هذا اللون الأدبی من الأندلسیین "ذو الوزارتین" أبو عبد الله محمد بن مسعود بن أبی الخصال (465-540 هـ/ 1073-1146م)(9) وعلى الرغم من تأثره بالحریری، كانت مقاماته تتصف بخصائص متمیزة، سواء فی الشكل أو فی الأسلوب. ومن الأمثلة على ذلك مقامة نجدها فی مجموعة رسائله المحفوظة فی مكتبة الاسكوریال مخطوطة رقم 519 یحاكی فیها الحریری محاكاة تامة حتى إنه سمى أبطال مقامته هذه بأسماء بطلی الحریری، أی "الحارث بن همام وأبو زید السروجی"(10).
كان المشهد فی الریف، حیث یصف ابن أبی الخصال ممثلاً شخص الحریری فرحة الریفیین بشؤبوب المطر الغزیر عندما فاضت الأنهار وانتعشت الخضار. وفیما هو یتجول فی الریف یلتقی حشداً من الناس تجمعوا حول بیت حیث كان یخاطبهم شیخ ببلاغة فائقة.
فجمع له الناس مالاً وفیراً، ورجاه الحارث أن یبیت عنده فی بیته قاصداً سرقته. ولكن غایته أحبطت، إذ تظاهر الشیخ بالنوم، وعندما استیقظ الحارث لم یجد الشیخ. لقد انسل الشیخ من فراشه تاركاً قصاصة من الورق كتب علیها ثلاث قصائد. الأولى من عشرة أبیات والثانیة من أربعة عشر بیتاً یبسط فیها الشیخ ما أصاب من الحب وما عاناه منه. أما الثالثة فمن تسعة عشر بیتاً یشكر فیها الریفیین على اللطف الذی غمروه فیه.
ثم یكتشف الحارث بن همام أن العجوز لم ینصرف عنه إلا لیذهب إلى الحانة حیث أنفق ماله كله، ثم أودع السجن بسبب الدیون التی ترتبت علیه لصاحب الحانة. وهنا یقدم ابن أبی الخصال وصفاً دقیقاً مفصلاً ورائعاً للحانة وزبائنها والعاملین فیها.
وجاء هذا الوصف على لسان الحارث بن همام عندما قدم الحانة وجال فیها بحثاً عن العجوز، وأخیراً قضى وقتاً لیس قصیراً یحاول إقناع صاحب الحانة أن یتیح له رؤیة ذلك العجوز. ثم یقول الحارث: "وعلى غُرّة فاجأناه".
ثم یجری حدیث مطول بین الرجلین، یطلب بعده الحارث من العجوز أن یخلد له اسمه بالشعر، فیضطر العجوز أن یقول فیه قصیدة من ثمانیة عشر بیتاً.
إننا نجد من هذا العرض الموجز أن هذه المقامة تختلف عن مقامات الحریری من حیث الشكل، فهی أطول ومن حیث مادتها أیضاً؛ إذ هی لا تعالج حكایة واحدة خاصة فحسب، بل تحكی سلسلة من الأحداث یرتبط بعضُها ببعض من خلال شخصیة البطل، العجوز.
وهی أشبه بعدة مقامات منفصلة تتضمن سلسلة من المعالم، كصورة الریف والفلاحین، وبیوتهم، وصورة الجمهور وكرمه، وصورة الحانة واللقاء الأخیر بین الشیخ والحارث.
ومن الواضح أن غایة ابن أبی الخصال كانت إظهار براعته الفنیة الفائقة فی التصویر الكلامی بجمعه مقامات عدیدة فی مقامة واحدة. ومن الجدیر بالذكر أن ابن أبی الخصال قد قام بمحاولة أخرى فی میدان الكتابة بأسلوب المقامات، وإن لم یكن مدیناً للحریری فیها بالقدر الذی كان فی المقامة السابقة. وأشیر بذلك إلى عمله الرائد فی ذلك النمط من الرسائل الأدبیة التی كتبها الأندلسیون عن طائر الزرزور. وكانت المقالات من هذا النوع تتسم بأسلوب المواعظ فی أنها تُفتتح بالصلوات والأدعیة والبركات، ثم تنتقل إلى وصف الزرزور وتعداد مآثره.
ثم یقول الزرزور قصیدة فی موضوع الكرم واللطف مزكیاً التصمیم على ممارستها.
وكان ابن أبی الخصال یستخدم الزرزور ناطقاً باسمه ینبئ عن طریقة مستمعیه عن توبته لیكسب عطفهم ومالهم. والواقع أنه كان یقوم بدور بطل المقامة الذی یمزج الشعر بالنثر لیعرض خبرته وتفوقه فی كلا النوعین. ولقد قام ابن أبی الخصال بمحاولتین فی هذا اللون من الأدب، الأولى موجودة فی "ورقة 2 آ- 4 ب" من الاسكوریال المذكورة فی أعلاه. ویتضمن هذا العمل قصیدتین الأولى من ستة أبیات والثانیة من سبعة عشر. أما محاولته الثانیة فهی موجودة یف "ورقة 68 آ – 71آ" وتتضمن أربع قصائد، الأولى من ثلاثة عشرة بیتاً، والثانیة من عشرة، والثالثة من أربعة عشر بیتاً، والرابعة من تسعة عشر.
المقامة القرطبیة:
إن هذه المقامة، التی عرفت بهذا الاسم عند الأندلسیین الذین عزوها إلى الفتح بن خاقان، تُشتهر بالفیلسوف العلاّمة والأدیب ابن السید البطلیوسی وتقذف به. إلا أننا لا نستطیع الجزم بنسبة هذه المقامة إلى ابن خاقان الذی عرف عنه أنه كتب سیرة مرموقة فی مدح ابن السید. ویوجد نص هذه المقامة القرطبیة فی الاسكوریال (مخطوطة) 488 (ورقة 80ب-83ب). وتتخذ حبكتها شكل رحلة قام بها البطل علی بن هشام من أرض الشام إلى الأندلس لیكتشف الوضع الأدبی فیها. وتبدأ المقامة بالكلمات التالیة:
"قال علی بن هشام: انطلقت من بلاد الشام إلى الأندلس لأجوب أقالیمها وأدرس البلدان وألتقی الأدباء والفقهاء وأتجنب أهل الخیال والریب".(11) (ورقة 80 ب). ثم ینتقل إلى وصف رحلته ونزوله فی بلنسیة، ویصف الأرض وأهلها وصفاً مفصلاً (ورقة 81آ).
ثم یأتی إلى صلب موضوع رحلته وهو السؤال عن البطلیوسی لیتمكن من مهاجمته وشتمه، والتقى أثناء استفساراته عن البطلیوسی "بفتى له لألاء ورواء، عمامته بین الرجال لواء، فرعه أفرع وجیده أتلع، وأنفه ممطول وخلقه مجدول..." ومع الفتى رفیق له یدعى ابن الطویل وآخر هو یوسف بن خلیل وقعد إلیهما فتناشدوا الأشعار. ثم سألهما ابن هشام عن البطلیوسی فانبرى أحدهما للقذف بحقه والتشهیر به، وانضم إلیه الآخر واصفین أفعال البطلیوسی الشریرة وكاشفین جهله بالعلم والأدب "یأتی المناكر فی كل ناد ویهیم فی العمه فی كل واد لا یرجى له إرعواء ولا یأسو جرحه دواء" (ورقة 83 ب).
وتعرف لنا المقامة صورة مفصلة لحیاة البطلیوسی وخصوصاً حیاته فی بلنسیة التی لجأ إلیها بعد أن ورط نفسه عاطفیاً مع ثلاثة شباب هم أبناء مواطنین قرطبیین متنفذین؛ كما ترسم لنا صورة مقنعة لجانب الحیاة المظلم فی ذلك الزمن، وهو الجانب الذی مر ذكره فی مصادر أندلسیة أخرى مروراً متعجلاً. لقد أثارت هذه المقامة فتنة كبیرة فی الحیاة الأدبیة بالأندلس بسبب المركز المرموق الذی كان یحتله البطلیوسی. ومن الواضح أن كثیراً من أدباء الأندلس قد استاؤوا استیاء عمیقاً وهبوا للرد على كاتب هذه المقامة. وكان أول من انتصر للبطلیوسی الوزیر العلامة أبو جعفر بن أحمد الذی كتب رسالة عنوانها "الانتصار فی الرد على صاحب المقامة القرطبیة. "وتوجد هذه الرسالة فی الاسكوریال المخطوطة المذكورة أعلاه (ورقة 104-105ب). وجهد الكاتب نفسه فی الدفاع عن البطلیوسی ضد التهم التی ألصقت به: ویرى أن على (صاحب المقامة القرطبیة أن یتبین مثالبه قبل أن یبین مثالب غیره..." (ورقة 104 ب).
وتتضمن مخطوطة الاسكوریال ذاتها (ورقة 116 ب –117 ب) رداً آخر على هذه المقامة هو رد أبی الحسن المرسی الذی كتب مقامة تعد مثالاً رائعاً للنثر الطنان والمفعم بالبلاغة والبیان. ویعد هذا العمل أقرب فی شكله إلى الرسالة الأدبیة منه إلى المقامة لافتقاره لأكثر معالم المقامة وضوحاً: تعقیدات الأسلوب والبطلین المألوفین.
لقد هیأ هذا العمل وغیره مما كتب فی الوقت ذاته الركن الأكبر الذی كان على المقامة أن تحتله فی میدان الأدب الأندلسی. ونتیجة لذلك یمكن القول أن المقامة الأندلسیة الجدیدة، مع كونها تنتمی فعلاً إلى هذا اللون الأدبی، تتسم بصفات مشتركة مع فن الرسالة، مما أدى إلى استعمالها لخدمة أغراض أدبیة عدیدة متنوعة. وهكذا استخدمه الأندلسیون فی المدح والرثاء والذم والغزل ووصف المدن.
وتعد مقامات عدیدة من هذا النمط الجدید مصادر هامة لجغرافیة الأندلس وشمالی أفریقیة. وخیر أمثلة على هذا النمط ما جاء فی مقامات لسان الدین بن الخطیب العدیدة والتی عرفت بـ "معیار الاختبار فی أحوال المعابد والدیار"(12).
كما استخدم الأندلسیون المقامة وسیطاً لوصف الإدارة العامة والعدالة، ومثال ذلك مقالة كتبها ابن الخطیب ذاته، عنوانها "خطرة الطیف ورحلة الشتاء والصیف"(13).
واستخدمت المقامة كذلك لأغراض تعلیمیة وتربویة كما هو حال المقامة النخیلة(14) للقاضی أبی الحسن النباهی المالقی(15) (المتوفى فی نهایة القرن الثامن الهجری) وقد استخدم المقامة وسیلة لتعلیم الأدب والقواعد لیوفر على التلامیذ مشقة الرجوع إلى مؤلفات أكبر فی هذه المواضیع.
-المقامات اللزومیة:
ربما كانت المقامات اللزومیة من أهم ما أنتج فی الأندلس فی میدان هذا اللون الأدبی. ولقد حُفظت فی مخطوطات عدیدة قیمة أقدمها وأكثرها موثوقیة، على ما یبدو، هی مخطوطة الفاتیكان (عربی 372)(16).
وقدم لنص هذه المخطوطة بما یلی: "ألف هذه المقامات الخمسین أبو طاهر محمد بن یوسف التمیمی السرقسطی (المتوفى عام 538هـ.) فی قرطبة إحدى مدن الأندلس (نتیجة لقراءة مؤلفات أبی محمد الحریری البصروی الأكبر) وأدت إلى إتعاب ذهن المؤلف واستلاب النوم من عینیه. إن مواظبته على إنشاء النثر والشعر لهذه المقامات لا تضاهى فوصل بها إلى ذروة الإتقان والكمال".
(ورقة 4 آ). أما التعلیق الختامی فكان كالآتی: "لقد أنجزت المقامات اللزومیة للتمیمی یوم الأربعاء الرابع من شهر رجب من عام 650هـ. نسخها صالح بن محمود بن فایق" (ورقة 222 ب).
ومن الملاحظ أن المؤلف لم یعط كل مقامة عنواناً متمیزاً كما فعل بدیع الزمان والحریری. إذ كان بعضها یسمى باسم نوع السجع الذی یغلب علیها، وهكذا سمیت المقامة السادسة عشرة (ورقة 72 آ- 76 آ) بالمقامة المثلثة، والسابعة عشرة (ورقة 76-81آ) بالمرصعة، والثامنة عشرة (ورقة 81 آ- 85آ) بالمدّبجة. أما المقامات الأُخر التی لها عناوین فهی: 7 (ورقة 25 آ- 32 آ) "البحریة"؛ 26 (ورقة 105 آ – 114 آ) "النجومیة"؛ 28 (ورقة 120 ب – 124 ب) "الحمقاء"، 30 (ورقة 128 آ- 140 آ) "مقامة الشعراء"؛ 41 (ورقة 170 ب- 174 آ) "مقامة الدُّب"
42 (ورقة 174 آ- 178 ب) "الفرسیة"؛
43 (ورقة 178 ب – 182 ب) "الحمامیة"؛
44 (ورقة 182 ب – 191 آ) "العنقاویة"؛
45 (ورقة 191 آ – 195 ب) "الأسدیة".
أما بالنسبة للمقامات ذات الأرقام 32-40 (ورقة 145 آ – 170 آ) فقد استخدم السرقسطی نمطاً خاصاً من السجع، ورتب المقامات حسب النظام الأبجدی، ولهذا السبب نراها تحمل أسماء حسب حرف القافیة فیها، مثل "الهمزیة" و "البائیة" و "الجیمیة" و "الدالیَّة" و "النونیة"... الخ.
ویدعى بطلا هذه المقامات: السائب بن تمام (ویعرف كذلك باسم أبی الغمر) وأبا حبیب، وهو عجوز ماكر من عُمان.
وبالإضافة إلى هذین البطلین هناك الراوی واسمه المنذر بن هُمام، وولدا العجوز وهما غریب وحبیب اللذان یظهران من حین إلى حین. وتدور أحداث المقامات كلها ما خلا المقامتین الثلاثین والخمسین حول أعمال الاحتیال المتنوعة التی یقوم بها العجوز، وحول مهارته فی الوعظ فی موضوع الموت والحیاة الآخرة عادة. ویرسم لنا السرقسطی دائماً صورة یخفی فیها حقیقة شخصیة شیخه الفصیح هذا الذی یظهر فی بیئات متجددة باستمرار، إذ یظهر أحیاناً فی هیئة شائنة وأخرى فی هیئة محترمة. ثم ینطلق فی بیان مكره وبراعته فی تنویع استراتیجیته لتلائم الحاجة التی تلوح له. ولنضرب مثلاً على احتیاله لا بد من ذكر الفصل الذی یقدم فیه ابنته للبیع كأمة، وعندما یتم البیع ویقبض ثمنها یرفض الحاكم الاعتراف بصحة البیع لامرأة حرة. وفی مناسبة أخرى یغری أبو حبیب السائب الذی التقاه فی الطریق بالتظاهر بحب ابنته حباً جنونیاً ولكنه غیر قادر على الزواج منها لافتقاره إلى المال.
فیقوم السائب بدوره خیر قیام حتى إنه جمع مالاً ممن رأوا حاله ورأفوا به، ولكن ما أن حصل أبو حبیب على المال حتى اختفى بالمال مخلفاً السائب وراءه. ولا یضع السرقسطی حداً لتجوال بطله، بل یتیح له أن یتجول بحریة یتسول حیثما یذهب، ولا یكاد یدخل أرضاً حتى یرتحل عنها إلى بلد آخر یحتال دائماً على الأبریاء، لیس ممن یلتقیهم فی طریقه، بل من القضاة والحكام، ثم ینكشف أمره على ید السائب بن تمام فیهرب ولكن لیس قبل أن یترك وراءه مقامة فیها حیاته واحتیالاته.
وینقل السرقسطی بطله فی رحلاته من الصین شرقاً إلى الأندلس غرباً. ولیس للمقامات نسق جغرافی فی ترتیبها؛ فمثلاً فی المقامة العشرین یكون أبو حبیب فی مصر، وفی المقامة الحادیة والعشرین ینتقل إلى البحرین، وفی المقامة الثانیة والعشرین یكون فی القیروان، وفی المقامة السادسة والأربعین یكون فی طنجة ومن هناك ینتقل فی المقامة السابعة والأربعین إلى الهند.
وفی المقامة الثامنة والأربعین (ورقة 203 ب – 208 ب) یكون البطل فی الأندلس موطن السرقسطی. ویحكی لنا الراوی كیف جاء ذات مرة وهو یتجول فی البلاد إلى بقعة جمیلة جمالاً فاتناً، هی جزیرة الطریف (وتسمى الیوم التِرفة)، حیث وجد جماعة من الناس یتحلقون على شكل خاتم منقوش، حجر النقش فیه شیخ یحكی أساطیر تاریخیة وحكایات عن ملوك العرب وإنجازاتهم متلاعباً بمشاعر مستمعیه وهو یسرد علیهم الحكایات تلاعباً بارعاً بالإشارة إلى جزیرة الطریف مراراً وتكراراً وباختراع الحكایات التی یمكن أن تقرن الجزیرة بفتح الأندلس.
وكان أثره على سامعیه كبیراً جداً مما جعلهم كالفراش المتهافت على اللهب، ویتبارون فی صب المال علیه كالمطر حتى امتلأت یداه، فأطال إقامته، وأقام فی بحبوحة لیلة ونهاراً.
وفی المقامة السادسة والأربعین (ورقة 195 ب- 199 ب)، یزور الشیخ هذا طنجة فی شمالی إفریقیة. ولهذه المقامة أهمیة خاصة لكونها أحد المصادر الأدبیة التی توثق عداء الطبقة الأندلسیة المثقفة للبربر ولنضالهم من أجل توكید استقلالهم. فلقد أفسد وصف السرقسطی لأهل طنجة بولائه لشعبه. وهذه هی كلمات راویته: "وجدت نفسی بین أناس كالنعام أو البقر، بین شعب كالأفاعی أو الضباع لم أستطع فهم كلامهم ولا یتفق تفكیرهم مع أی تفكیر. شعرت وكأنی وقعت بین حیوانات مفترسة أو كراع بین حیوانات لا تُقاد ولا تستقر، ولا تُربط ولا تصبر. كنت أسمع عن الأندلس وعن ثقافتها ومهرجاناتها وغناها حتى إن صدری التهب شوقاً إلیها وغدوت مستعداً للتضحیة بأثمن ما أملك من أجلها". (ورقة 195 ب –196 آ).
ولهذه المقامة أهمیة كذلك لما عرضه فیها السرقسطی من وصف لمظاهر حیاة البربر الاجتماعیة وعاداتهم وأغانیهم وطعامهم وشرابهم (ورقة 198 ب).
أما مسرح المقامة الثانیة والعشرین فهو القیروان حیث وجد بطلنا یتجول مشیداً بأمجاد القیروان التاریخیة ویندب سوء المعاملة التی عانتها على أیدی العرب والبدو.
لیس وصف المقامات للأندلس فقط هو الذی أضفى علیها قیمة خاصة، بل كذلك وصفها لبلاد المشرق، سواء كانت شبه الجزیرة العربیة (نجد، والحجاز، وتهامة، والیمامة) أو العراق والجزیرة وبلاد الفرس (بغداد، وسنجار، وحرّان، والأنبار، والرقة، وواسط، والزّاب، والأهواز، وأصفهان، ومرو، والری) أو مصر وسوریة (الاسكندریة، ودمیاط، وحلوان، وحلب، وفلسطین) أو الشرق (الهند، والصین، وغزنة). ومن الأمور البارزة بشكل خاص فی هذه المقامات هو حب السرقسطی للیمن وتاریخها، كما یُرى من أن أربع مقامات تدور أحداثها فی الیمن. وههنا وصف لأعاجیب الیمن: "إنها أرض الكوارث ومیدان الحوادث؛ إن روائعها وعجائبها تخدع الخادعین. "وعن شعبها یقول السرقسطی: "بین ظهرانیكم كل أنواع الرجال: الأقویاء والمتواضعون، الأغنیاء والفقراء، البله والحكماء، الانفعالیون والمتبلدون. إنی بینكم كابن سبیل وأخی قبیلة وعشیرة، بید أن مصیری فصلنی عنهم، واتسعت المسافة بینی وبینهم.
أتیت بأخبار غریبة عنی ولسوف أثیر الذكی واللا مبالی كلیهما". (ورقة 14 آ –ب).
أما مشهد المقامة الخامسة والثلاثین (ورقة 157 ب- 160 ب) فهو فی زبید: "أقمت فی زبید أتاجر بالخیل وبالعبید، أرفل فی ثیاب الرخاء، وأستمتع بحلاوة الحیاة".
وكانت عدن، بمینائها الناشط الذی یعج بالأنشطة التجاریة ویضج بالمسافرین القادمین والراحلین، مكاناً طبیعیاً ینجذب إلیه بطل السرقسطی؛ وهكذا نجده هناك فی المقامة السادسة محفوفاً بجمهرة من المسافرین ممتدحاً روحهم المبدعة وحبهم للحریة داعیاً الله أن یمن علیهم بالنجاح ویعیدهم إلى وطنهم سالمین. (ورقة 23 ب). وفی هذه المقامة نجد لأول مرة ذلك الاهتمام بحیاة الموانئ والرحلات البحریة الذی یظهر ثانیة فی المقامة السابعة (ورقة 25 آ –32 آ). وهنا یكون الشیخ قد انتقل إلى میناء شحر حیث یُرى مُسدیاً نصحه للتجار حول السلوك القومی الذی یجب أن یتحلوا به وهم یركبون البحر. إن آفاق هذه المقامة أوسع من آفاق المقامات السابقة، كما یُضمِّن السرقسطی "المقامة العنقاویة" المماثلة والتی تجری أحداثها فی الصین، كثیراً من حكایات البحارة.
ویمكننا تقدیر أهمیة العناصر البحریة هذه إذا ما قرأنا هذه المقامات مقرونة بما یعرضه الرحالة الأندلسیون من وصف للرحلات البحریة وخصوصاً بقصة حی بن یقظان لابن طفیل.
ومن الجدیر بالملاحظة أن السرقسطی مشوش بالنسبة لعمان موطن بطله التی یسمیها جزءاً من الیمن فی المقامة الرابعة والمقامة الثانیة عشرة (ورقة 53 ب- 57 ب) التی جرت أحداثها فی ظفار البلد التی یهیم بها بطله حباً.
ونجد الشیخ فی المقامة الحادیة والعشرین (ورقة 93آ – 96 آ) یقیم فی البحرین یتحدث فی المحتشدین وفی المساجد.
وهناك مقامتان هامتان تصوران معالم الحیاة الاجتماعیة هما "مقامة الدب" (ورقة 170 ب – 174 آ، والمقامة التاسعة والأربعون (ورقة 208 ب- 213 ب) حیث یكسب الشیخ فی الأول معاشه بعروض لدب راقص، وینتحل فی الثانیة شخصیة طبیب.
ویخصص السرقسطی مقامتین من مقاماته للنقد الأدبی، هما المقامة الثلاثون ذات العنوان "الشعراء" والخمسون ذات العنوان "الشعر والنثر". وتشكل هاتان المقامتان إضافة هامة لمصادرنا الشحیحة لتاریخ النقد الأدبی فی هذه الفترة، خصوصاً أنهما تحتلان وجهات نظر المحدثین الذین یتزعمهم السرقسطی، كما یساعداننا على تقدیر مدى أثر هذه المدرسة فی الشعر والنثر عموماً، وأثر أبی العلاء المعری خصوصاً.
ویستعمل السرقسطی فی مقاماته صیغة صارمة من السجع (أشد صرامة من سجع المعری) من غیر أن یحدث انطباعاً لدى القارئ بالتكلف أو المبالغة.
وباستثناء المقامتین الثانیة والثلاثین والأربعین، فإن السرقسطی یتجنب عادة الأسلوب المعقد والمبهم الذی یفضله الحریری، إذ أن اختیاره لكلماته وعباراته أقل تكلفاً، وزخرفته البیانیة أقل تنمیقاً. ویبدو أنّه نخل الأعمال الأدبیة واحتفظ لنفسه بالصور البیانیة الأكثر جمالاً وسحراً. على أیة حال أجدنی عاجزاً عن إیفاء هذه المقامات حقها فی مقالة موجزة؛ وآمل أن تتاح فرصة أخرى لإلقاء ضوء على المقامة الأندلسیة..
الهوامش
(1)احتفظ ابن بسام باثنتین من مقاماته فی الذخیرة ص، 154-167، القاهرة، 1939). وقد نشر حسن حسنی عبد الوهاب التونسی إحداهما وهی رسائل الانتقاد لابن شرف القیروانی، ثم أدرجها محمد كرد علی فی رسائل البُلغاء" (القاهرة، 1913 و 1936). وهناك مقامة تضمنتها الورقات التسع من مخطوطة اسكوریال رقم 536 التی كُتبت عن مشاهیر الشعراء فی القرن الثامن الهجری بخط مغربی.
(2)انظر إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسی، عصر الطوائف والمرابطین (ص 303، بیروت 1963) وانظر ابن بسام، الذخیرة، ص 183-195، ص 248، 257- القاهرة 1942).
(3)انظر "رسالة الثعلب" (المؤلف المنوه عنه، 1، ص 325).
(4)انظر "رسالة الثعلب" (المؤلف المنوه عنه، 1، ص 117).
(5)انظر ابن الأبار، "التكملة لكتاب الصلة"، 1، ص 16 (رقم 35) و 2، ص 732 (رقم 2076) (مدرید، 1887-90)، وكذلك الضبی، بغیة الملتمس رقم 1446، ص 477 (مدرید، 1884).
(6)انظر الأبار، المؤلف المنوه عنه، ص 213-214 (رقم 727)، وابن خیر، فهرست، 1، ص 387 و 451 (سرقسطة، 1893).
(7)انظر مثلاً ابن الأبار، المؤلف المنوه عنه، المادة تحت الأرقام التالیة 727، 756، 764، 849، 855، 931، 937، 958، 1423، 1658، 1779، 1874، 1894، والمقری، نفح الطیب، 2، ص 421 (القاهرة، 1949).
(8)شرح المقامات، 1، ص 3- 4 (القاهرة 1300هـ.).
(9) انظر بروكلمان، 3981 –9؛ 629-30.
(10)هذه المخطوطة محفوظة فی الاسكوریال (رقم 519). إن المواعینی الذی أقوم بإخراج عمله "ریحان الألباب، هو مؤلف بعض الرسائل غیر المنشورة الموجودة فی الاسكوریال مخطوطة (ورقة 88 ب، 95 آ). وكان أبو الحسن ابن سراج أول من كتب فی هذا الجنس والذی هو نوع من عرض العضلات اللغوی لإظهار مهارة الكاتب فی الفكاهة.
وما تزال هذه الرسالة غیر منشورة فی الجزء الباقی من ذخیرة ابن بسام التی تخص جامعة بغداد والمحفوظة فی جامعة القاهرة. وتوجد كذلك فی الاسكوریال مخطوطة رقم 488 (ورقة 109 آ- 110 آ). ولقد أحدث أسلوب هذا العمل المجازی والإیمائی انطباعاً كبیراً فی الدوائر الأدبیة بالأندلس. وهذا أبو القاسم ابن الجد یحاكیه فی رسائل ثلاثة ما زالت محفوظة فی الذخیرة (ورقة 290 آ- ب). الدكتور إحسان عباس یذكر لقبه أبا الحسین بن سراج فی تاریخ الأدب الأندلسی (المترجم).
(11)لم تقع بین أیدینا المخطوطة ولا صورة عنها فنحن نكتفی بترجمة النص (المترجم).
(12) هذه المقامة بالفعل وصف لأهم مدن المغرب ولأربع وثلاثین مدینة من مدن مملكة غرناطة. ولقد نشر النص المتعلق بغرناطة فرنسیسكو سیمونیه فی كتابه "وصف مملكة غرناطة" (مدرید، 1860) ونشر النص المتعلق بالمغرب م. ج موللر فی كتابه بیتراجی 1، ص 47-99" (میونیخ، 1866).
(13)نشرها موللر (المؤلف المنوه عنه، ص 15-40) عن مخطوطة ریحانة الكتاب لابن الخطیب (ورقة 220)، على الرغم من إدراكه لوجود نص آخر فی (مخطوطة الاسكوریال 470، ورقة 50 آ- 71 ب). وتتخذ هذه المقامة شكل وصف لرحلة استكشاف قام بها سلطان غرناطة أبو الحجاج یوسف مع وزیره ابن الخطیب. ومن المقامات التی تعرض صورة رائعة للأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة فی غرناطة، مقامة العید لأبی محمد عبد الله الأزدی (المتوفى عام 750هـ/ 1350م) لقد نشر هذه المقامة أحمد مختار العبادی فی مجلة العهد المصری للدراسات الإسلامیة (1954، ص 159-173).
(14)نشر هذه المقامة م. ج موللر (المؤلف المنوه عنه) عن النص الموجود فی الاسكوریال مخطوطة رقم 1653. وإن طبعة جدیدة لهذه المقامة ربما یساعد على توضیع تطور هذا اللون فی هذه المنطقة لأن مخطوطة جدیدة قد اكتشفت فی المغرب وتحتوی هذه المخطوطة التی قمت بدراستها نصاً أكثر اكتمالاً من النص الذی فی مخطوطة الاسكوریال. وتوجد هذه المخطوطة برقم 198، ونسخة أخرى بقم 328 من بین مخطوطات الأوقاف التی فی الأرشیف والبیبلیوغرافیا العامة بالرباط.
(15) للإطلاع على سیرة المؤلف، انظر ابن الأبار، التكملة، رقم 117 (المعجم، رقم 124)، (بروكلمان، ص 542).
(16)نسخ أخرى: باریس، رقم 3972، 2، رقم 1275، 2. أمبروزیانا تتمة 8455 لالیلی، 1928 و 1933؛ دحداح، 196؛ وانظر بروكلمان، ص 543.
من برید التراث العربی
السید رئیس التحریر
بعد التحیة..
تصفحت العدد السابع – السنة الثانیة من مجلة التراث العربی فوجدت فیها مقالات جیدة یستحق أصحابها الشكر على ما قدموه.
ولقد لفت نظری بیت من الشعر ورد فی القسم الثانی من نظم اللآل فی الحكم والأمثال صفحة 131 رقم 996 ورد هذا البیت على النحو التالی:
وجدت أقل الناس عقلاً إذا انتشى أشفهمو عقلاً إذا كان صاحیا
وقد شرح الأستاذ عبد المعین الملوحی معنى البیت على النحو التالی:
"أقل الناس عقلاً إذا سكر أكثرهم عقلاً إذا صحا".
وأنا أذكر أبیاتاً لأبی نواس كنت حفظتها من دیوانه أوردها كما أذكرها:
أرى الخمر تربی فی العقول فتنتضی كوامن أخلاق تثیر الدواهیا
تزید سفیه القوم فضل سفاهة وتترك أخلاق الكریم كما هیا
وجدت أقل الناس عقلاً إذا انتشى أقلهمو عقلاً إذا كان صاحیا
ومع مقارنة البیت الأخیر بالبیت الذی ورد فی المجلة نجد اختلاف المعنى مع تغییر كلمة واحدة فقط وهی أشفهمو بـ أقلهمو. وما أظن أن النواسی –وهو ما هو- یسرق البیت بكامله مع تغییر كلمة واحدة. ولكننی أجد المعنى فی بیت النواسی أشرف من المعنى الذی ساقه بیت المجلة.
وربما ضاق الحسن بن هانی بالمعربدین فقال هذه الأبیات والبیت الثالث فی القطعة ینسجم مع البیت الأول لأنه یفید أن الخمر تزید فی العقل كما تزید فی السفه. فهی محرضة وربما كانت الروایة الثانیة أسفهمو بالسین المهملة. ولعل أستاذنا القدیر عبد المعین الملوحی یوضح هذا الأمر ویرجح إحدى الروایتین.
هذا وعندنا أن الخمر على خلاف الروایتین تغتال العقل وتزید فی السفه.
إننی أحب التراث والشعر القدیم وإن كانت مهنتی بعیدة بعض الشیء من الشعر والنقد.
دبی –الإمارات العربیة المهندس: نزار السباعی
علم من أعلام التراث یغیب
غاب فی مدینة ابن الولید بتاریخ 7/9/1982 وجه بارز من وجوه العاملین فی حقل العلم والأدب المشتغلین فی قضایا التراث العربی، هو المربی والأدیب الكبیر الأستاذ محیی الدین الدرویش الذی كان علماً من أعلام اللغة والأدب لا فی مدینة حمص وحدها وإنما فی بقیة مدن العالم العربی. وقد وافته المنیة عن عمر ناهز الرابعة والسبعین وكان حافلاً بالعطاء الأدبی نثراً وشعراً وبالتوجیه التربوی وقد زرع الروح الوطنیة والقومیة والأدبیة فی نفوس الناشئة من خلال عمله الدؤوب فی التعلیم وفی الصحافة. وكان مرجعاً وثقة فی شؤون اللغة والتراث وتراجم الأعلام والأغفال فی أدبنا العربی مما ترك له مكانة طیبة فی نفوس تلامذته ومعارفه وهم كثیر.. وكان آخر عطاء علمی له مؤلفه (إعراب القرآن وبیانه) الذی صدر منه حتى الآن تسعة أجزاء، ورحل الفقید قبل أن یتمه، ولهذا كانت الفاجعة بفقده خسارة كبیرة للغة والأدب والتراث.
ولد الفقید فی العام 1908 من أسرة كسبت لقبها من صوفیتها المغرقة، وتلقى علومه فی حمص. وفی العام 1927 تخرج من الصف الخاص الذی أحدث فی دمشق لتخریج المعلمین ثم احترف صناعة التعلیم وانصرف بحكم موهبته ومیله الخاص إلى أمهات الكتب والآثار الأدبیة ودواوین الشعراء أمثال المتنبی وأبی تمام والمعری وغیرهم یطالعها ویستظهرها وعكف على التبحر فی علوم اللغة والنحو حتى بلغ شأوا عالیاً فی مجالها.
وقد اختیر فی العام 1964 لیكون عضواً فی "لجنة الشعر" بالمجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، كما تولى رئاسة تحریر عدد من الصحف بحمص.
رحم الله الفقید رحمة واسعة وعوض الأمة واللغة والأدب بفقده خیراً.
نذیر الحسامی
أقلام النسر
رصاص وملون
بامتیاز
من شركة فابر العالمیّة
المحتوى
ملامح لمستوى المعیشة فی التاریخ العربی الإسلامی ودراسته فی العصر الحاضر د. عبد الكریم الیافی
الاشتقاق صلاح الدین الزعبلاوی
مفاهیم عربیة وملامح نضالیة فی التراث اللغوی والأدبی والحضاری د. عمر موسى باشا
لغة الطیر.. من كتاب "رموز العلم المقدس" بقلم: رونی غینون
تقدیم: فاطمة عصام صبری
التوفیق بین الحكمة والشریعة فی نظر ابن رشد د. غسان فنیانس
من التراث الشعبی.. حكایة لقب أسرة دمشقیة د. عدنان الخطیب
مشابه فی التراث العالمی د. عبد الكریم الیافی
رائد التألیف المعجمی فی الأندلس.. أبو علی القالی د. عمر الدقاق
اللسان العربی المبین د. جعفر دك الباب
أبو الفتح علی بن محمد البستی دریة الخطیب ولطفی الصقال
بحثاً عن رؤیة كونیة فی شعر أبی تمام د. فهد عكام
المخطوطات العربیة بین یدی التحقیق د. محمد ألتونجی
توضیح المشتبه لابن ناصر الدین الدمشقی مطاع الطرابیشی
من العبر فی تاریخنا –وقفة لصلاح الدین الأیوبی أمام عكا نذیر الحسامی
الشعر الحدیث والتراث فاطمة عصام صبری
المقامات الأندلسیة بقلم: هـ. نیمة
ترجمة: إبراهیم یحیى الشهابی
وبدخول الأندلس عهد ملوك الطوائف كانت مقامات الهمذانی ورسائله قد انتشرت انتشاراً واسعاً حتى غدا الكثیر من الأدباء یؤلفون فی هذا الصنف من الأدب.
وفی مقدمة هؤلاء ابن شرف القیروانی الذی كتب مقامات تحدى بها البدیع فی حماه، كما قال ابن بسام(1). وابن بسام هذا أورد مقتطفات لكاتبین من كتاب المقامات...
وأبو محمد بن مالك القرطبی اللذان كانا یقیمان فی المریة فی عهد المعتصم ابن صمادح (443-483هـ/ 1051-1091م)(2).
وما دمنا بصدد الكلام عن أثر الهمذانی وأسلوبه فی الأندلس، یمكننا القول إن أثر مقاماته كان محصوراً فی دائرة ضیقة إذا ما قورن بأثر رسائله التی لاقت ترحیباً حاراً من ابن شُهید الذی استخدمها نموذجاً لنثره الذی انغمس فیه بوصف مفصل لأشیاء كثیرة كالماء والبراغیث والثعالب والحلویات(3) كما لاقت ترحیباً من أبی المغیرة ابن حزم الذی ألف رسالة یحاكی بها إحدى رسائل البدیع(4).
ظهرت مقامات الحریری فی مطلع عهد المرابطین وسرعان ما تداولها الناس على نطاق واسع. ویخبرنا ابن الأبار أن العدید من الأندلسیین سمعوا الحریری یبسط مقاماته فی حدیقته ببغداد، ثم عادوا إلى الأندلس لینشروا ما سمعوا(5). وبعد موت الحریری تابع تلامیذه بدورهم بسط المقامات باعتبارهم معتمدین من قبل أسیادهم(6).
درس الأندلسیون المقامات أیام المرابطین والموحدین على أیدی هؤلاء وتلامذتهم(7).
ولم یكتف الأندلسیون بدراسة المقامات ونقلها، بل أنشؤوا تعلیقات علیها أشهرها تعلیق الشریشی الذی قرأ التعلیقات السابقة كلها، وعندما عثر على تعلیق الفنجدیهی نقح كل شیء كتبه من قبل(8).
وما یعنینا فی هذه المقالة هو المقامة كما كتبها الأندلسیون، وخصوصاً تلك المقامات التی بقیت مخطوطات لمّا تنشرْ.
وكان أول من كتب فی هذا اللون الأدبی من الأندلسیین "ذو الوزارتین" أبو عبد الله محمد بن مسعود بن أبی الخصال (465-540 هـ/ 1073-1146م)(9) وعلى الرغم من تأثره بالحریری، كانت مقاماته تتصف بخصائص متمیزة، سواء فی الشكل أو فی الأسلوب. ومن الأمثلة على ذلك مقامة نجدها فی مجموعة رسائله المحفوظة فی مكتبة الاسكوریال مخطوطة رقم 519 یحاكی فیها الحریری محاكاة تامة حتى إنه سمى أبطال مقامته هذه بأسماء بطلی الحریری، أی "الحارث بن همام وأبو زید السروجی"(10).
كان المشهد فی الریف، حیث یصف ابن أبی الخصال ممثلاً شخص الحریری فرحة الریفیین بشؤبوب المطر الغزیر عندما فاضت الأنهار وانتعشت الخضار. وفیما هو یتجول فی الریف یلتقی حشداً من الناس تجمعوا حول بیت حیث كان یخاطبهم شیخ ببلاغة فائقة.
فجمع له الناس مالاً وفیراً، ورجاه الحارث أن یبیت عنده فی بیته قاصداً سرقته. ولكن غایته أحبطت، إذ تظاهر الشیخ بالنوم، وعندما استیقظ الحارث لم یجد الشیخ. لقد انسل الشیخ من فراشه تاركاً قصاصة من الورق كتب علیها ثلاث قصائد. الأولى من عشرة أبیات والثانیة من أربعة عشر بیتاً یبسط فیها الشیخ ما أصاب من الحب وما عاناه منه. أما الثالثة فمن تسعة عشر بیتاً یشكر فیها الریفیین على اللطف الذی غمروه فیه.
ثم یكتشف الحارث بن همام أن العجوز لم ینصرف عنه إلا لیذهب إلى الحانة حیث أنفق ماله كله، ثم أودع السجن بسبب الدیون التی ترتبت علیه لصاحب الحانة. وهنا یقدم ابن أبی الخصال وصفاً دقیقاً مفصلاً ورائعاً للحانة وزبائنها والعاملین فیها.
وجاء هذا الوصف على لسان الحارث بن همام عندما قدم الحانة وجال فیها بحثاً عن العجوز، وأخیراً قضى وقتاً لیس قصیراً یحاول إقناع صاحب الحانة أن یتیح له رؤیة ذلك العجوز. ثم یقول الحارث: "وعلى غُرّة فاجأناه".
ثم یجری حدیث مطول بین الرجلین، یطلب بعده الحارث من العجوز أن یخلد له اسمه بالشعر، فیضطر العجوز أن یقول فیه قصیدة من ثمانیة عشر بیتاً.
إننا نجد من هذا العرض الموجز أن هذه المقامة تختلف عن مقامات الحریری من حیث الشكل، فهی أطول ومن حیث مادتها أیضاً؛ إذ هی لا تعالج حكایة واحدة خاصة فحسب، بل تحكی سلسلة من الأحداث یرتبط بعضُها ببعض من خلال شخصیة البطل، العجوز.
وهی أشبه بعدة مقامات منفصلة تتضمن سلسلة من المعالم، كصورة الریف والفلاحین، وبیوتهم، وصورة الجمهور وكرمه، وصورة الحانة واللقاء الأخیر بین الشیخ والحارث.
ومن الواضح أن غایة ابن أبی الخصال كانت إظهار براعته الفنیة الفائقة فی التصویر الكلامی بجمعه مقامات عدیدة فی مقامة واحدة. ومن الجدیر بالذكر أن ابن أبی الخصال قد قام بمحاولة أخرى فی میدان الكتابة بأسلوب المقامات، وإن لم یكن مدیناً للحریری فیها بالقدر الذی كان فی المقامة السابقة. وأشیر بذلك إلى عمله الرائد فی ذلك النمط من الرسائل الأدبیة التی كتبها الأندلسیون عن طائر الزرزور. وكانت المقالات من هذا النوع تتسم بأسلوب المواعظ فی أنها تُفتتح بالصلوات والأدعیة والبركات، ثم تنتقل إلى وصف الزرزور وتعداد مآثره.
ثم یقول الزرزور قصیدة فی موضوع الكرم واللطف مزكیاً التصمیم على ممارستها.
وكان ابن أبی الخصال یستخدم الزرزور ناطقاً باسمه ینبئ عن طریقة مستمعیه عن توبته لیكسب عطفهم ومالهم. والواقع أنه كان یقوم بدور بطل المقامة الذی یمزج الشعر بالنثر لیعرض خبرته وتفوقه فی كلا النوعین. ولقد قام ابن أبی الخصال بمحاولتین فی هذا اللون من الأدب، الأولى موجودة فی "ورقة 2 آ- 4 ب" من الاسكوریال المذكورة فی أعلاه. ویتضمن هذا العمل قصیدتین الأولى من ستة أبیات والثانیة من سبعة عشر. أما محاولته الثانیة فهی موجودة یف "ورقة 68 آ – 71آ" وتتضمن أربع قصائد، الأولى من ثلاثة عشرة بیتاً، والثانیة من عشرة، والثالثة من أربعة عشر بیتاً، والرابعة من تسعة عشر.
المقامة القرطبیة:
إن هذه المقامة، التی عرفت بهذا الاسم عند الأندلسیین الذین عزوها إلى الفتح بن خاقان، تُشتهر بالفیلسوف العلاّمة والأدیب ابن السید البطلیوسی وتقذف به. إلا أننا لا نستطیع الجزم بنسبة هذه المقامة إلى ابن خاقان الذی عرف عنه أنه كتب سیرة مرموقة فی مدح ابن السید. ویوجد نص هذه المقامة القرطبیة فی الاسكوریال (مخطوطة) 488 (ورقة 80ب-83ب). وتتخذ حبكتها شكل رحلة قام بها البطل علی بن هشام من أرض الشام إلى الأندلس لیكتشف الوضع الأدبی فیها. وتبدأ المقامة بالكلمات التالیة:
"قال علی بن هشام: انطلقت من بلاد الشام إلى الأندلس لأجوب أقالیمها وأدرس البلدان وألتقی الأدباء والفقهاء وأتجنب أهل الخیال والریب".(11) (ورقة 80 ب). ثم ینتقل إلى وصف رحلته ونزوله فی بلنسیة، ویصف الأرض وأهلها وصفاً مفصلاً (ورقة 81آ).
ثم یأتی إلى صلب موضوع رحلته وهو السؤال عن البطلیوسی لیتمكن من مهاجمته وشتمه، والتقى أثناء استفساراته عن البطلیوسی "بفتى له لألاء ورواء، عمامته بین الرجال لواء، فرعه أفرع وجیده أتلع، وأنفه ممطول وخلقه مجدول..." ومع الفتى رفیق له یدعى ابن الطویل وآخر هو یوسف بن خلیل وقعد إلیهما فتناشدوا الأشعار. ثم سألهما ابن هشام عن البطلیوسی فانبرى أحدهما للقذف بحقه والتشهیر به، وانضم إلیه الآخر واصفین أفعال البطلیوسی الشریرة وكاشفین جهله بالعلم والأدب "یأتی المناكر فی كل ناد ویهیم فی العمه فی كل واد لا یرجى له إرعواء ولا یأسو جرحه دواء" (ورقة 83 ب).
وتعرف لنا المقامة صورة مفصلة لحیاة البطلیوسی وخصوصاً حیاته فی بلنسیة التی لجأ إلیها بعد أن ورط نفسه عاطفیاً مع ثلاثة شباب هم أبناء مواطنین قرطبیین متنفذین؛ كما ترسم لنا صورة مقنعة لجانب الحیاة المظلم فی ذلك الزمن، وهو الجانب الذی مر ذكره فی مصادر أندلسیة أخرى مروراً متعجلاً. لقد أثارت هذه المقامة فتنة كبیرة فی الحیاة الأدبیة بالأندلس بسبب المركز المرموق الذی كان یحتله البطلیوسی. ومن الواضح أن كثیراً من أدباء الأندلس قد استاؤوا استیاء عمیقاً وهبوا للرد على كاتب هذه المقامة. وكان أول من انتصر للبطلیوسی الوزیر العلامة أبو جعفر بن أحمد الذی كتب رسالة عنوانها "الانتصار فی الرد على صاحب المقامة القرطبیة. "وتوجد هذه الرسالة فی الاسكوریال المخطوطة المذكورة أعلاه (ورقة 104-105ب). وجهد الكاتب نفسه فی الدفاع عن البطلیوسی ضد التهم التی ألصقت به: ویرى أن على (صاحب المقامة القرطبیة أن یتبین مثالبه قبل أن یبین مثالب غیره..." (ورقة 104 ب).
وتتضمن مخطوطة الاسكوریال ذاتها (ورقة 116 ب –117 ب) رداً آخر على هذه المقامة هو رد أبی الحسن المرسی الذی كتب مقامة تعد مثالاً رائعاً للنثر الطنان والمفعم بالبلاغة والبیان. ویعد هذا العمل أقرب فی شكله إلى الرسالة الأدبیة منه إلى المقامة لافتقاره لأكثر معالم المقامة وضوحاً: تعقیدات الأسلوب والبطلین المألوفین.
لقد هیأ هذا العمل وغیره مما كتب فی الوقت ذاته الركن الأكبر الذی كان على المقامة أن تحتله فی میدان الأدب الأندلسی. ونتیجة لذلك یمكن القول أن المقامة الأندلسیة الجدیدة، مع كونها تنتمی فعلاً إلى هذا اللون الأدبی، تتسم بصفات مشتركة مع فن الرسالة، مما أدى إلى استعمالها لخدمة أغراض أدبیة عدیدة متنوعة. وهكذا استخدمه الأندلسیون فی المدح والرثاء والذم والغزل ووصف المدن.
وتعد مقامات عدیدة من هذا النمط الجدید مصادر هامة لجغرافیة الأندلس وشمالی أفریقیة. وخیر أمثلة على هذا النمط ما جاء فی مقامات لسان الدین بن الخطیب العدیدة والتی عرفت بـ "معیار الاختبار فی أحوال المعابد والدیار"(12).
كما استخدم الأندلسیون المقامة وسیطاً لوصف الإدارة العامة والعدالة، ومثال ذلك مقالة كتبها ابن الخطیب ذاته، عنوانها "خطرة الطیف ورحلة الشتاء والصیف"(13).
واستخدمت المقامة كذلك لأغراض تعلیمیة وتربویة كما هو حال المقامة النخیلة(14) للقاضی أبی الحسن النباهی المالقی(15) (المتوفى فی نهایة القرن الثامن الهجری) وقد استخدم المقامة وسیلة لتعلیم الأدب والقواعد لیوفر على التلامیذ مشقة الرجوع إلى مؤلفات أكبر فی هذه المواضیع.
-المقامات اللزومیة:
ربما كانت المقامات اللزومیة من أهم ما أنتج فی الأندلس فی میدان هذا اللون الأدبی. ولقد حُفظت فی مخطوطات عدیدة قیمة أقدمها وأكثرها موثوقیة، على ما یبدو، هی مخطوطة الفاتیكان (عربی 372)(16).
وقدم لنص هذه المخطوطة بما یلی: "ألف هذه المقامات الخمسین أبو طاهر محمد بن یوسف التمیمی السرقسطی (المتوفى عام 538هـ.) فی قرطبة إحدى مدن الأندلس (نتیجة لقراءة مؤلفات أبی محمد الحریری البصروی الأكبر) وأدت إلى إتعاب ذهن المؤلف واستلاب النوم من عینیه. إن مواظبته على إنشاء النثر والشعر لهذه المقامات لا تضاهى فوصل بها إلى ذروة الإتقان والكمال".
(ورقة 4 آ). أما التعلیق الختامی فكان كالآتی: "لقد أنجزت المقامات اللزومیة للتمیمی یوم الأربعاء الرابع من شهر رجب من عام 650هـ. نسخها صالح بن محمود بن فایق" (ورقة 222 ب).
ومن الملاحظ أن المؤلف لم یعط كل مقامة عنواناً متمیزاً كما فعل بدیع الزمان والحریری. إذ كان بعضها یسمى باسم نوع السجع الذی یغلب علیها، وهكذا سمیت المقامة السادسة عشرة (ورقة 72 آ- 76 آ) بالمقامة المثلثة، والسابعة عشرة (ورقة 76-81آ) بالمرصعة، والثامنة عشرة (ورقة 81 آ- 85آ) بالمدّبجة. أما المقامات الأُخر التی لها عناوین فهی: 7 (ورقة 25 آ- 32 آ) "البحریة"؛ 26 (ورقة 105 آ – 114 آ) "النجومیة"؛ 28 (ورقة 120 ب – 124 ب) "الحمقاء"، 30 (ورقة 128 آ- 140 آ) "مقامة الشعراء"؛ 41 (ورقة 170 ب- 174 آ) "مقامة الدُّب"
42 (ورقة 174 آ- 178 ب) "الفرسیة"؛
43 (ورقة 178 ب – 182 ب) "الحمامیة"؛
44 (ورقة 182 ب – 191 آ) "العنقاویة"؛
45 (ورقة 191 آ – 195 ب) "الأسدیة".
أما بالنسبة للمقامات ذات الأرقام 32-40 (ورقة 145 آ – 170 آ) فقد استخدم السرقسطی نمطاً خاصاً من السجع، ورتب المقامات حسب النظام الأبجدی، ولهذا السبب نراها تحمل أسماء حسب حرف القافیة فیها، مثل "الهمزیة" و "البائیة" و "الجیمیة" و "الدالیَّة" و "النونیة"... الخ.
ویدعى بطلا هذه المقامات: السائب بن تمام (ویعرف كذلك باسم أبی الغمر) وأبا حبیب، وهو عجوز ماكر من عُمان.
وبالإضافة إلى هذین البطلین هناك الراوی واسمه المنذر بن هُمام، وولدا العجوز وهما غریب وحبیب اللذان یظهران من حین إلى حین. وتدور أحداث المقامات كلها ما خلا المقامتین الثلاثین والخمسین حول أعمال الاحتیال المتنوعة التی یقوم بها العجوز، وحول مهارته فی الوعظ فی موضوع الموت والحیاة الآخرة عادة. ویرسم لنا السرقسطی دائماً صورة یخفی فیها حقیقة شخصیة شیخه الفصیح هذا الذی یظهر فی بیئات متجددة باستمرار، إذ یظهر أحیاناً فی هیئة شائنة وأخرى فی هیئة محترمة. ثم ینطلق فی بیان مكره وبراعته فی تنویع استراتیجیته لتلائم الحاجة التی تلوح له. ولنضرب مثلاً على احتیاله لا بد من ذكر الفصل الذی یقدم فیه ابنته للبیع كأمة، وعندما یتم البیع ویقبض ثمنها یرفض الحاكم الاعتراف بصحة البیع لامرأة حرة. وفی مناسبة أخرى یغری أبو حبیب السائب الذی التقاه فی الطریق بالتظاهر بحب ابنته حباً جنونیاً ولكنه غیر قادر على الزواج منها لافتقاره إلى المال.
فیقوم السائب بدوره خیر قیام حتى إنه جمع مالاً ممن رأوا حاله ورأفوا به، ولكن ما أن حصل أبو حبیب على المال حتى اختفى بالمال مخلفاً السائب وراءه. ولا یضع السرقسطی حداً لتجوال بطله، بل یتیح له أن یتجول بحریة یتسول حیثما یذهب، ولا یكاد یدخل أرضاً حتى یرتحل عنها إلى بلد آخر یحتال دائماً على الأبریاء، لیس ممن یلتقیهم فی طریقه، بل من القضاة والحكام، ثم ینكشف أمره على ید السائب بن تمام فیهرب ولكن لیس قبل أن یترك وراءه مقامة فیها حیاته واحتیالاته.
وینقل السرقسطی بطله فی رحلاته من الصین شرقاً إلى الأندلس غرباً. ولیس للمقامات نسق جغرافی فی ترتیبها؛ فمثلاً فی المقامة العشرین یكون أبو حبیب فی مصر، وفی المقامة الحادیة والعشرین ینتقل إلى البحرین، وفی المقامة الثانیة والعشرین یكون فی القیروان، وفی المقامة السادسة والأربعین یكون فی طنجة ومن هناك ینتقل فی المقامة السابعة والأربعین إلى الهند.
وفی المقامة الثامنة والأربعین (ورقة 203 ب – 208 ب) یكون البطل فی الأندلس موطن السرقسطی. ویحكی لنا الراوی كیف جاء ذات مرة وهو یتجول فی البلاد إلى بقعة جمیلة جمالاً فاتناً، هی جزیرة الطریف (وتسمى الیوم التِرفة)، حیث وجد جماعة من الناس یتحلقون على شكل خاتم منقوش، حجر النقش فیه شیخ یحكی أساطیر تاریخیة وحكایات عن ملوك العرب وإنجازاتهم متلاعباً بمشاعر مستمعیه وهو یسرد علیهم الحكایات تلاعباً بارعاً بالإشارة إلى جزیرة الطریف مراراً وتكراراً وباختراع الحكایات التی یمكن أن تقرن الجزیرة بفتح الأندلس.
وكان أثره على سامعیه كبیراً جداً مما جعلهم كالفراش المتهافت على اللهب، ویتبارون فی صب المال علیه كالمطر حتى امتلأت یداه، فأطال إقامته، وأقام فی بحبوحة لیلة ونهاراً.
وفی المقامة السادسة والأربعین (ورقة 195 ب- 199 ب)، یزور الشیخ هذا طنجة فی شمالی إفریقیة. ولهذه المقامة أهمیة خاصة لكونها أحد المصادر الأدبیة التی توثق عداء الطبقة الأندلسیة المثقفة للبربر ولنضالهم من أجل توكید استقلالهم. فلقد أفسد وصف السرقسطی لأهل طنجة بولائه لشعبه. وهذه هی كلمات راویته: "وجدت نفسی بین أناس كالنعام أو البقر، بین شعب كالأفاعی أو الضباع لم أستطع فهم كلامهم ولا یتفق تفكیرهم مع أی تفكیر. شعرت وكأنی وقعت بین حیوانات مفترسة أو كراع بین حیوانات لا تُقاد ولا تستقر، ولا تُربط ولا تصبر. كنت أسمع عن الأندلس وعن ثقافتها ومهرجاناتها وغناها حتى إن صدری التهب شوقاً إلیها وغدوت مستعداً للتضحیة بأثمن ما أملك من أجلها". (ورقة 195 ب –196 آ).
ولهذه المقامة أهمیة كذلك لما عرضه فیها السرقسطی من وصف لمظاهر حیاة البربر الاجتماعیة وعاداتهم وأغانیهم وطعامهم وشرابهم (ورقة 198 ب).
أما مسرح المقامة الثانیة والعشرین فهو القیروان حیث وجد بطلنا یتجول مشیداً بأمجاد القیروان التاریخیة ویندب سوء المعاملة التی عانتها على أیدی العرب والبدو.
لیس وصف المقامات للأندلس فقط هو الذی أضفى علیها قیمة خاصة، بل كذلك وصفها لبلاد المشرق، سواء كانت شبه الجزیرة العربیة (نجد، والحجاز، وتهامة، والیمامة) أو العراق والجزیرة وبلاد الفرس (بغداد، وسنجار، وحرّان، والأنبار، والرقة، وواسط، والزّاب، والأهواز، وأصفهان، ومرو، والری) أو مصر وسوریة (الاسكندریة، ودمیاط، وحلوان، وحلب، وفلسطین) أو الشرق (الهند، والصین، وغزنة). ومن الأمور البارزة بشكل خاص فی هذه المقامات هو حب السرقسطی للیمن وتاریخها، كما یُرى من أن أربع مقامات تدور أحداثها فی الیمن. وههنا وصف لأعاجیب الیمن: "إنها أرض الكوارث ومیدان الحوادث؛ إن روائعها وعجائبها تخدع الخادعین. "وعن شعبها یقول السرقسطی: "بین ظهرانیكم كل أنواع الرجال: الأقویاء والمتواضعون، الأغنیاء والفقراء، البله والحكماء، الانفعالیون والمتبلدون. إنی بینكم كابن سبیل وأخی قبیلة وعشیرة، بید أن مصیری فصلنی عنهم، واتسعت المسافة بینی وبینهم.
أتیت بأخبار غریبة عنی ولسوف أثیر الذكی واللا مبالی كلیهما". (ورقة 14 آ –ب).
أما مشهد المقامة الخامسة والثلاثین (ورقة 157 ب- 160 ب) فهو فی زبید: "أقمت فی زبید أتاجر بالخیل وبالعبید، أرفل فی ثیاب الرخاء، وأستمتع بحلاوة الحیاة".
وكانت عدن، بمینائها الناشط الذی یعج بالأنشطة التجاریة ویضج بالمسافرین القادمین والراحلین، مكاناً طبیعیاً ینجذب إلیه بطل السرقسطی؛ وهكذا نجده هناك فی المقامة السادسة محفوفاً بجمهرة من المسافرین ممتدحاً روحهم المبدعة وحبهم للحریة داعیاً الله أن یمن علیهم بالنجاح ویعیدهم إلى وطنهم سالمین. (ورقة 23 ب). وفی هذه المقامة نجد لأول مرة ذلك الاهتمام بحیاة الموانئ والرحلات البحریة الذی یظهر ثانیة فی المقامة السابعة (ورقة 25 آ –32 آ). وهنا یكون الشیخ قد انتقل إلى میناء شحر حیث یُرى مُسدیاً نصحه للتجار حول السلوك القومی الذی یجب أن یتحلوا به وهم یركبون البحر. إن آفاق هذه المقامة أوسع من آفاق المقامات السابقة، كما یُضمِّن السرقسطی "المقامة العنقاویة" المماثلة والتی تجری أحداثها فی الصین، كثیراً من حكایات البحارة.
ویمكننا تقدیر أهمیة العناصر البحریة هذه إذا ما قرأنا هذه المقامات مقرونة بما یعرضه الرحالة الأندلسیون من وصف للرحلات البحریة وخصوصاً بقصة حی بن یقظان لابن طفیل.
ومن الجدیر بالملاحظة أن السرقسطی مشوش بالنسبة لعمان موطن بطله التی یسمیها جزءاً من الیمن فی المقامة الرابعة والمقامة الثانیة عشرة (ورقة 53 ب- 57 ب) التی جرت أحداثها فی ظفار البلد التی یهیم بها بطله حباً.
ونجد الشیخ فی المقامة الحادیة والعشرین (ورقة 93آ – 96 آ) یقیم فی البحرین یتحدث فی المحتشدین وفی المساجد.
وهناك مقامتان هامتان تصوران معالم الحیاة الاجتماعیة هما "مقامة الدب" (ورقة 170 ب – 174 آ، والمقامة التاسعة والأربعون (ورقة 208 ب- 213 ب) حیث یكسب الشیخ فی الأول معاشه بعروض لدب راقص، وینتحل فی الثانیة شخصیة طبیب.
ویخصص السرقسطی مقامتین من مقاماته للنقد الأدبی، هما المقامة الثلاثون ذات العنوان "الشعراء" والخمسون ذات العنوان "الشعر والنثر". وتشكل هاتان المقامتان إضافة هامة لمصادرنا الشحیحة لتاریخ النقد الأدبی فی هذه الفترة، خصوصاً أنهما تحتلان وجهات نظر المحدثین الذین یتزعمهم السرقسطی، كما یساعداننا على تقدیر مدى أثر هذه المدرسة فی الشعر والنثر عموماً، وأثر أبی العلاء المعری خصوصاً.
ویستعمل السرقسطی فی مقاماته صیغة صارمة من السجع (أشد صرامة من سجع المعری) من غیر أن یحدث انطباعاً لدى القارئ بالتكلف أو المبالغة.
وباستثناء المقامتین الثانیة والثلاثین والأربعین، فإن السرقسطی یتجنب عادة الأسلوب المعقد والمبهم الذی یفضله الحریری، إذ أن اختیاره لكلماته وعباراته أقل تكلفاً، وزخرفته البیانیة أقل تنمیقاً. ویبدو أنّه نخل الأعمال الأدبیة واحتفظ لنفسه بالصور البیانیة الأكثر جمالاً وسحراً. على أیة حال أجدنی عاجزاً عن إیفاء هذه المقامات حقها فی مقالة موجزة؛ وآمل أن تتاح فرصة أخرى لإلقاء ضوء على المقامة الأندلسیة..
الهوامش
(1)احتفظ ابن بسام باثنتین من مقاماته فی الذخیرة ص، 154-167، القاهرة، 1939). وقد نشر حسن حسنی عبد الوهاب التونسی إحداهما وهی رسائل الانتقاد لابن شرف القیروانی، ثم أدرجها محمد كرد علی فی رسائل البُلغاء" (القاهرة، 1913 و 1936). وهناك مقامة تضمنتها الورقات التسع من مخطوطة اسكوریال رقم 536 التی كُتبت عن مشاهیر الشعراء فی القرن الثامن الهجری بخط مغربی.
(2)انظر إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسی، عصر الطوائف والمرابطین (ص 303، بیروت 1963) وانظر ابن بسام، الذخیرة، ص 183-195، ص 248، 257- القاهرة 1942).
(3)انظر "رسالة الثعلب" (المؤلف المنوه عنه، 1، ص 325).
(4)انظر "رسالة الثعلب" (المؤلف المنوه عنه، 1، ص 117).
(5)انظر ابن الأبار، "التكملة لكتاب الصلة"، 1، ص 16 (رقم 35) و 2، ص 732 (رقم 2076) (مدرید، 1887-90)، وكذلك الضبی، بغیة الملتمس رقم 1446، ص 477 (مدرید، 1884).
(6)انظر الأبار، المؤلف المنوه عنه، ص 213-214 (رقم 727)، وابن خیر، فهرست، 1، ص 387 و 451 (سرقسطة، 1893).
(7)انظر مثلاً ابن الأبار، المؤلف المنوه عنه، المادة تحت الأرقام التالیة 727، 756، 764، 849، 855، 931، 937، 958، 1423، 1658، 1779، 1874، 1894، والمقری، نفح الطیب، 2، ص 421 (القاهرة، 1949).
(8)شرح المقامات، 1، ص 3- 4 (القاهرة 1300هـ.).
(9) انظر بروكلمان، 3981 –9؛ 629-30.
(10)هذه المخطوطة محفوظة فی الاسكوریال (رقم 519). إن المواعینی الذی أقوم بإخراج عمله "ریحان الألباب، هو مؤلف بعض الرسائل غیر المنشورة الموجودة فی الاسكوریال مخطوطة (ورقة 88 ب، 95 آ). وكان أبو الحسن ابن سراج أول من كتب فی هذا الجنس والذی هو نوع من عرض العضلات اللغوی لإظهار مهارة الكاتب فی الفكاهة.
وما تزال هذه الرسالة غیر منشورة فی الجزء الباقی من ذخیرة ابن بسام التی تخص جامعة بغداد والمحفوظة فی جامعة القاهرة. وتوجد كذلك فی الاسكوریال مخطوطة رقم 488 (ورقة 109 آ- 110 آ). ولقد أحدث أسلوب هذا العمل المجازی والإیمائی انطباعاً كبیراً فی الدوائر الأدبیة بالأندلس. وهذا أبو القاسم ابن الجد یحاكیه فی رسائل ثلاثة ما زالت محفوظة فی الذخیرة (ورقة 290 آ- ب). الدكتور إحسان عباس یذكر لقبه أبا الحسین بن سراج فی تاریخ الأدب الأندلسی (المترجم).
(11)لم تقع بین أیدینا المخطوطة ولا صورة عنها فنحن نكتفی بترجمة النص (المترجم).
(12) هذه المقامة بالفعل وصف لأهم مدن المغرب ولأربع وثلاثین مدینة من مدن مملكة غرناطة. ولقد نشر النص المتعلق بغرناطة فرنسیسكو سیمونیه فی كتابه "وصف مملكة غرناطة" (مدرید، 1860) ونشر النص المتعلق بالمغرب م. ج موللر فی كتابه بیتراجی 1، ص 47-99" (میونیخ، 1866).
(13)نشرها موللر (المؤلف المنوه عنه، ص 15-40) عن مخطوطة ریحانة الكتاب لابن الخطیب (ورقة 220)، على الرغم من إدراكه لوجود نص آخر فی (مخطوطة الاسكوریال 470، ورقة 50 آ- 71 ب). وتتخذ هذه المقامة شكل وصف لرحلة استكشاف قام بها سلطان غرناطة أبو الحجاج یوسف مع وزیره ابن الخطیب. ومن المقامات التی تعرض صورة رائعة للأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة فی غرناطة، مقامة العید لأبی محمد عبد الله الأزدی (المتوفى عام 750هـ/ 1350م) لقد نشر هذه المقامة أحمد مختار العبادی فی مجلة العهد المصری للدراسات الإسلامیة (1954، ص 159-173).
(14)نشر هذه المقامة م. ج موللر (المؤلف المنوه عنه) عن النص الموجود فی الاسكوریال مخطوطة رقم 1653. وإن طبعة جدیدة لهذه المقامة ربما یساعد على توضیع تطور هذا اللون فی هذه المنطقة لأن مخطوطة جدیدة قد اكتشفت فی المغرب وتحتوی هذه المخطوطة التی قمت بدراستها نصاً أكثر اكتمالاً من النص الذی فی مخطوطة الاسكوریال. وتوجد هذه المخطوطة برقم 198، ونسخة أخرى بقم 328 من بین مخطوطات الأوقاف التی فی الأرشیف والبیبلیوغرافیا العامة بالرباط.
(15) للإطلاع على سیرة المؤلف، انظر ابن الأبار، التكملة، رقم 117 (المعجم، رقم 124)، (بروكلمان، ص 542).
(16)نسخ أخرى: باریس، رقم 3972، 2، رقم 1275، 2. أمبروزیانا تتمة 8455 لالیلی، 1928 و 1933؛ دحداح، 196؛ وانظر بروكلمان، ص 543.
من برید التراث العربی
السید رئیس التحریر
بعد التحیة..
تصفحت العدد السابع – السنة الثانیة من مجلة التراث العربی فوجدت فیها مقالات جیدة یستحق أصحابها الشكر على ما قدموه.
ولقد لفت نظری بیت من الشعر ورد فی القسم الثانی من نظم اللآل فی الحكم والأمثال صفحة 131 رقم 996 ورد هذا البیت على النحو التالی:
وجدت أقل الناس عقلاً إذا انتشى أشفهمو عقلاً إذا كان صاحیا
وقد شرح الأستاذ عبد المعین الملوحی معنى البیت على النحو التالی:
"أقل الناس عقلاً إذا سكر أكثرهم عقلاً إذا صحا".
وأنا أذكر أبیاتاً لأبی نواس كنت حفظتها من دیوانه أوردها كما أذكرها:
أرى الخمر تربی فی العقول فتنتضی كوامن أخلاق تثیر الدواهیا
تزید سفیه القوم فضل سفاهة وتترك أخلاق الكریم كما هیا
وجدت أقل الناس عقلاً إذا انتشى أقلهمو عقلاً إذا كان صاحیا
ومع مقارنة البیت الأخیر بالبیت الذی ورد فی المجلة نجد اختلاف المعنى مع تغییر كلمة واحدة فقط وهی أشفهمو بـ أقلهمو. وما أظن أن النواسی –وهو ما هو- یسرق البیت بكامله مع تغییر كلمة واحدة. ولكننی أجد المعنى فی بیت النواسی أشرف من المعنى الذی ساقه بیت المجلة.
وربما ضاق الحسن بن هانی بالمعربدین فقال هذه الأبیات والبیت الثالث فی القطعة ینسجم مع البیت الأول لأنه یفید أن الخمر تزید فی العقل كما تزید فی السفه. فهی محرضة وربما كانت الروایة الثانیة أسفهمو بالسین المهملة. ولعل أستاذنا القدیر عبد المعین الملوحی یوضح هذا الأمر ویرجح إحدى الروایتین.
هذا وعندنا أن الخمر على خلاف الروایتین تغتال العقل وتزید فی السفه.
إننی أحب التراث والشعر القدیم وإن كانت مهنتی بعیدة بعض الشیء من الشعر والنقد.
دبی –الإمارات العربیة المهندس: نزار السباعی
علم من أعلام التراث یغیب
غاب فی مدینة ابن الولید بتاریخ 7/9/1982 وجه بارز من وجوه العاملین فی حقل العلم والأدب المشتغلین فی قضایا التراث العربی، هو المربی والأدیب الكبیر الأستاذ محیی الدین الدرویش الذی كان علماً من أعلام اللغة والأدب لا فی مدینة حمص وحدها وإنما فی بقیة مدن العالم العربی. وقد وافته المنیة عن عمر ناهز الرابعة والسبعین وكان حافلاً بالعطاء الأدبی نثراً وشعراً وبالتوجیه التربوی وقد زرع الروح الوطنیة والقومیة والأدبیة فی نفوس الناشئة من خلال عمله الدؤوب فی التعلیم وفی الصحافة. وكان مرجعاً وثقة فی شؤون اللغة والتراث وتراجم الأعلام والأغفال فی أدبنا العربی مما ترك له مكانة طیبة فی نفوس تلامذته ومعارفه وهم كثیر.. وكان آخر عطاء علمی له مؤلفه (إعراب القرآن وبیانه) الذی صدر منه حتى الآن تسعة أجزاء، ورحل الفقید قبل أن یتمه، ولهذا كانت الفاجعة بفقده خسارة كبیرة للغة والأدب والتراث.
ولد الفقید فی العام 1908 من أسرة كسبت لقبها من صوفیتها المغرقة، وتلقى علومه فی حمص. وفی العام 1927 تخرج من الصف الخاص الذی أحدث فی دمشق لتخریج المعلمین ثم احترف صناعة التعلیم وانصرف بحكم موهبته ومیله الخاص إلى أمهات الكتب والآثار الأدبیة ودواوین الشعراء أمثال المتنبی وأبی تمام والمعری وغیرهم یطالعها ویستظهرها وعكف على التبحر فی علوم اللغة والنحو حتى بلغ شأوا عالیاً فی مجالها.
وقد اختیر فی العام 1964 لیكون عضواً فی "لجنة الشعر" بالمجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، كما تولى رئاسة تحریر عدد من الصحف بحمص.
رحم الله الفقید رحمة واسعة وعوض الأمة واللغة والأدب بفقده خیراً.
نذیر الحسامی
أقلام النسر
رصاص وملون
بامتیاز
من شركة فابر العالمیّة
المحتوى
ملامح لمستوى المعیشة فی التاریخ العربی الإسلامی ودراسته فی العصر الحاضر د. عبد الكریم الیافی
الاشتقاق صلاح الدین الزعبلاوی
مفاهیم عربیة وملامح نضالیة فی التراث اللغوی والأدبی والحضاری د. عمر موسى باشا
لغة الطیر.. من كتاب "رموز العلم المقدس" بقلم: رونی غینون
تقدیم: فاطمة عصام صبری
التوفیق بین الحكمة والشریعة فی نظر ابن رشد د. غسان فنیانس
من التراث الشعبی.. حكایة لقب أسرة دمشقیة د. عدنان الخطیب
مشابه فی التراث العالمی د. عبد الكریم الیافی
رائد التألیف المعجمی فی الأندلس.. أبو علی القالی د. عمر الدقاق
اللسان العربی المبین د. جعفر دك الباب
أبو الفتح علی بن محمد البستی دریة الخطیب ولطفی الصقال
بحثاً عن رؤیة كونیة فی شعر أبی تمام د. فهد عكام
المخطوطات العربیة بین یدی التحقیق د. محمد ألتونجی
توضیح المشتبه لابن ناصر الدین الدمشقی مطاع الطرابیشی
من العبر فی تاریخنا –وقفة لصلاح الدین الأیوبی أمام عكا نذیر الحسامی
الشعر الحدیث والتراث فاطمة عصام صبری
المقامات الأندلسیة بقلم: هـ. نیمة
ترجمة: إبراهیم یحیى الشهابی
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:41|
بحث عن ذاتیّة الشاعِر الجاهلی
- راوی بوجوفتش المستشرق الیوغسلافی
- راوی بوجوفتش المستشرق الیوغسلافی
كان شیئاً ممتعاً وحافزاً على الدوام تجرید وإضاءة شخصیة الفنان، هذا المبدع الذی یثیر عمله الفنی الأحاسیس الرقیقة والحادة. لذا یرغب أی الباحث أو القارئ فی أن یغوص فی شخصیته وروحه ویبحث فی عوالمها، أی یبحث فی العلاقات والأسباب التی تؤثر فی تشكیل وجهات النظر الفنیة. غیر أن النقد وتاریخ الأدب كانا یهتمان، بشكل خاص، باكتشاف مصادر وطرق استلهام الفنان ومنابع قدرته الإبداعیة، وبكلمة أخرى، خصوصیة الفنان فی استخدام الرمز للتعبیر عن مكنوناته الإبداعیة والحوافز التی تمده بالقدرة على ذلك.
وبالطبع، لم تستطع مثل هذه الدراسة العجلى أن تستوعب كل تلك الجوانب التی ذكرناها، وبشكل خاص بدایات نشأة الشعر العربی القدیم ودور الشاعر فی ذلك الحین. لأن ذلك یتطلب بحثاً شاملاً یلجأ إلى شتى العلوم التی تساعد على خلق نظرة متكاملة. وفی الحقیقة نحن لا نعرف عن الشاعر الجاهلی سوى النزر الیسیر ولذلك كثیراً ما نعتمد فی بحوثنا على تصوراتنا الخاصة ونحاول أن نستعید ونجدد صورة هذا العصر البعید وروحه الحقة. وربما كان الفنان سلفادور دالی قد عبر عن أسرار الروح والنفس البشریة بأكثر دقة و أروع مجاز، حینما ظهر ذات یوم بین الجمهور مرتدیاً (بدلة) الغوص وأراد أن یتحدث أمامهم عن أغوار هذه النفس التی تنوی الكشف عن مكنوناتها.
ولكی نحدد وجهة بحثنا هذا فلنتوقف عند مسألة العلاقة بین المبدع (الشاعر) والإلهام. غیر أننا لن نمیل هنا إلى التحلیلات الشعریة والسیكولوجیة بل نلقی الضوء على هذه الجوانب التی ستكمل صورتنا عن العوامل الثقافیة المؤثرة فی تكوین خصوصیة الشاعر الجاهلی ودوره الحضاری المهم، كما نحاول أن نجمع كل المعلومات الواردة عن هذه الشخصیة ونشیر إلى أهم خصائص تلك العلاقة.
فلو نظرنا إلى تسمیة ذلك العصر لوجدنا أنها تشیر إلى ثقافة معینة، ثقافة البدوی التی أنجبت شعراً ظل یرمز إلى قمة الإبداع الأدبی عند العرب على مر الأزمنة والعصور. وبالرغم من أن العرب قد طوروا حضارتهم بعد ظهور الإسلام تطویراً مرموقاً فقد احتل هذا الشعر مكانة خاصة فی هذه الحضارة وأصبح معیاراً للإبداع فی العصور القادمة. وحتى المحاولات التی قام بها بعض الأدباء فی تجدید الشعر وتطویره كانت تستند فی ذلك إلى أیام ولادته وإلى القوانین التی حددت معالمه الأصلیة، وبذلك فإن هذه المحاولات تنطبق انطباقاً تاماً على تلك المحاولات التی أبداها أو قام بها رجال الدین فی تجدید القیم الإسلامیة. ولذا یمكننا القول أن الشعر عند العرب فی تلك العصور وخاصة فی العصر الجاهلی أصبح یمثل دیناً لهم، یحمل فی طیاته سلوكهم وأخلاقهم وفهمهم لوجودهم. ولذا وبذلك أصبح تعبیر "الشعر دیوان العرب" أكثر وضوحاً وأوسع فهماً:
ولكون الشعر دیوان العرب، حصلت ضجة فی الثلاثینات من هذا القرن عندما حاول الأدیب طه حسین أن یهز هذه القدسیة (ربما تحت تأثیر المستشرقین "الفرت" و"مرغولیوث") حیث طرح أفكاره فی كتابه الشهیر (فی الشعر الجاهلی)(1). وبطبیعة الحال كان أول من عارض ذلك بانفعال شدید هم رجال الدین. ویشیر طه حسین فی هذا الكتاب، الذی غیر بعد هذه الضجة عنوانه ومحتویاته إلى حد ما، عندما یتحدث عن الشعر الجاهلی كمعیار لقمة الشعر، قائلاً: فلست أعرف أمة من الأمم القدیمة استمسكت بمذهب المحافظة فی الأدب ولم تجدد فیه إلا بمقدار كالأمة العربیة. فحیاة العرب الجاهلیین ظاهرة فی شعر الفرزدق وجریر وذی الرمة والأخطل والراعی أكثر من ظهورها فی هذا الشعر الذی ینسب إلى "طرفة وعنترة وبشر بن أبی خازم"(2).
ولكن الباحث الكبیر ابن خلدون، الذی سبقه بعدة قرون، كان قد أشار إلى ذات الفكرة قائلاً أن العرب یتعصبون لشعرهم دون أن یلتفتوا إلى القدرة الشعریة عند الشعوب الأخرى، وإن الإغریق یمكنهم كذلك أن یفتخروا بشعرهم(3). ویحق لنا أن نسأل: ما الأسباب التی دفعت العرب أن یجعلوا شعرهم البدائی معیاراً على مر العصور، رغم ظهور شعر الموشح والزجل فی الأندلس والبند فی العراق ورغم الحقیقة الماثلة وهی ظهور الشعر الحر منذ بدایة الخمسینات (لا نرید الخوض فی هذا المجال)(4)؟...
ومن الممكن أن نجیب بأن شكل القصیدة الجاهلیة هو السبب الأول والرئیسی فی الرجوع المستمر إلى هذا الشعر. حیث أن هذه القصیدة تمثل منطلقاً فنیاً ذا تكوین عال ثم إن لغتها ما زالت تداعب الأحاسیس برقة وتفرض الإعجاب بشتى معانیها وقوة أفكارها التی تعكس قوة العقول فی ذلك العصر. وهذه القصیدة، من جهة أخرى باستثناء روحها الفردیة ما زالت تمتلك وعیها الاجتماعی، لذا یمكننا أن ندعو هذه القصیدة بأنها قصیدة ذات خصائص ملحمیة، وجدانیة. أی أنها تمثل شكلاً ممزوجاً. إن ارتباط العرب بلغتهم كوسیلة رمزیة، نراه متطبعاً فی تسمیة أشهر القصائد الجاهلیة، كما هو فی المعلقات، التی استند علیها المستشرق الفرنسی (شال بیلا) فی إطلاق صفة صانعی الجواهر على الشعراء الأقدمین، بینما أنا أعتقد بأن القصة الأخرى حول تسمیة المعلقات أكثر أهمیة ومتعة لأنها تشیر إلى ثقافة العصر الجاهلی وإلى عادات الأعراب، حیث نجد فیها عناصر میثولوجیة أسطوریة من خلال استعمال أرقام المعلقات السبع أو التسع. ومن تعلیق هذه القصائد على باب الكعبة التی كانت مكاناً دینیاً وسحریاً قبل مجیء الإسلام، یبدو لنا أن تلك القصائد كان لها دور ساحر فی حیاة ذلك المجتمع، إذ أن العلاقة بین الشاعر والطبیعة فی عموم الشعر البدائی، علاقة وطیدة وشدیدة الصلة. حیث أننا نرى كذلك فی الشعر البدوی تلك العلاقة الأصیلة نرى شدة ارتباط البدوی ببیئته واندهاشه بما یحیط به، لذا یستخدم الشاعر وصفاً دقیقاً قوی التعبیر لما یراه ویعیشه (انظر مثلاً وصف العاصفة، عند امرئ القیس)، ویدل على قوة هذه العلاقة وتوطدها أنها تركت آثار الأفكار الأسطوریة المثیولوجیة والتوتمیة(5). بالرغم من مجیء الإسلام الذی حاول مسح تلك الآثار من أجل توحید الناس لعبادة إله واحد (لن نستخدم تعبیر الإسلام "المتزمت" الذی أصبح منتشراً فی أوربا، إذ أن له معنى خطیراً یحاول أصحاب هذا التعبیر من ورائه الحط من شأن الحضارة الإسلامیة)، لقد كان لحیاة البدوی، ومجمل إبداعاته وأصالة الشعراء الأوائل الذین یعدون مؤسسی الثقافة العربیة القدیمة أو ثقافة القبائل تأثیر كبیر فی تاریخ العرب حتى أن الإسلام لم یستطع اجتناب هذه الحقیقة، یمكننا الاعتماد على ما یقوله الأدیب طه حسین من "أن القرآن أصدق مرآة للحیاة الجاهلیة". (6).
وحتى یكون بوسع الباحث أن یقدم صورة كاملة ودقیقة عن ذلك العالم، یجب علیه أن یكون مولعاً بكل جوانب هذا الموضوع إذ إن الشعر الجاهلی الذی یتمیز ببساطته وروحیته الطبیعیة قد وضع ركائز لثقافة جدیدة متطورة. بطبیعة الحال لا یتسع هنا المجال لتحلیل هذه الجوانب بأسرها ولذا سنلفت الانتباه إلى بعض الحقائق الثقافیة التی ربما ساعدتنا على تكوین انطباع مستفز عن ذلك. مثلاً لنأخذ عبادة الشمس، والقمر التی لها أهمیتها حسب رأیی فی تكوین الثقافة البدویة والجاهلیة بشكل عام، نجد ذلك الأثر فی جمیع الثقافات البدائیة تقریباً مع أننا نستطیع تتبع تینك العبادتین فی الثقافة العربیة الإسلامیة على أساس تطورهما وصراعهما من أجل تغلب إحداهما على الأخرى. إذ إن هذا الصراع كان قد ترك أثراً مهماً فی سیر الحضارة العربیة والإسلامیة بشكل عام. ویبدو لی أن هذا الصراع لا یظهر فقط فی صراع الطرفین، أی العقیدتین، بل یشیر بشكل واضح إلى محاولة تكوین الشعور القومی عند البدوی على أساس انتمائه القبلی.
وربما لن ندرك طول فترة ذلك الصراع إن لم نتوغل فی هذا الموضوع أن هذین الطرفین یتمیزان حتى جغرافیاً. فی الشمال العدنانیون وفی الجنوب القحطانیون الذین یمتلكون، دون ریب، حضارة أقدم. وكل من هذین الطرفین یتمثل فی ثقافة خاصة تحمل شعارها الخاص القمر (علامة الأنوثة) والشمس (علامة الرجولة)، بعض الأحیان لا نستطیع أن نضع حدوداً فاصلة بین حاملی هذین الشعارین لأنهما أحیاناً یعیشان فی اندماج وتنسیق فی البیئة والمجتمع. ویدل على ذلك أن الیمنیین قد سبقوا فی وضع التقویم القمری والمصریین القدامى (والأعراب بعد ذلك اشتركوا فی تكوین جنسیتهم بالفعل)، جاؤوا بالتقویم الشمسی. غیر أن الصراع یستمر بین الشمس والقمر، أی بین ثقافة البدو (القمر) وثقافة الحضر (الشمس)، ونتلمس آثار ذلك فی العصر الأموی، ویتبین لنا أن هذا الصراع قد تلاشى فی العصر العباسی بغلبة ثقافة البدو عقائدیاً كما یبدو لنا فی القرن العاشر، بعد هزیمة حركة الشعوبیة. ومع أن هذه الثقافة تبدو بسیطة، ساذجة بل بدائیة، فإنها تخفی فی طیاتها حسا مرهفاً وقیماً جمالیة. ویخیل إلینا كذلك أن هذا الانتصار تحقق خاصة أن طریق سمو الأدب البدوی بشكل عام ولذا یمكننا القول أن القمر البدوی تغلب على ثقافة الشمس على صعید الأدب. بینما هناك انتصارات حققتها ثقافة الشمس، مثلاً فی القرنین الثامن والتاسع، وكأن الإسلام هدنة بین الثقافتین المتنازعتین أوقف ولو مؤقتاً الصراع ولكن بدون نتیجة.
وینعكس التوتر بین نموذج الثقافتین (البدویة والحضریة)، انعكاساً لامعاً حتى فی الأبجدیة العربیة، حیث نجد فیها الحروف القمریة والشمسیة، وكأن تقسیم هذه الأبجدیة یشیر إلى أن التوازن الثقافی أمر متوقع لأن هناك أربعة عشر حرفاً شمسیاً مقابل أربعة عشر حرفاً قمریاً، وبذلك أخذ هذا الصراع كثیراً من حیویة الحضارة الإسلامیة والبدویة من قبلها مع أننا شخصیاً نرى أن فی هذا الصراع (الدائم) بذرة تحرك الثقافة العربیة من حین لآخر وقدرة شدیدة على إمكانیة تحریك هذه الحضارة على الدوام ومن جدید(7). ولو غصنا بعمق فی الدوافع الإبداعیة للثقافة البدویة لأمكننا الاستنتاج أن فی الشعر البدوی حافزاً حضاریاً هاماً قد یستطیع أن ینتج فی ظروف اجتماعیة وتاریخیة مناسبة(8) ثقافة أخرى أكثر إبداعاً حتى من هذه الثقافة التی جاء بها الأدب العباسی فی عصره الذهبی وإن هذا الحافز هو صنف من الأصناف الجمالیة: الإلهام.
وبطبیعة الحال لا یمكننا أن نناقش مثل هذا الصنف، وفی تلك الفترة، بل یمكننا الخوض بهذا الشیء بعد ظهور نظریة الشعر عند العرب. ولذا سنورد فی هذا المجال فكرة نظریة واحدة فقط تتحدث عن هذا الشیء نجد مصدرها فی القرون الوسطى. یضمها كتاب العقد الفرید المشهور لمحمد بن عبد ربه (القرن العاشر) وتحكی هذه القصة أن رجلاً كاتباً توسل إلیه أحد أصحابه أن یكتب رسالة باسمه، وعندما أخذ الكاتب قلمه توقف هنیهة. فسأله صاحبه عن سبب توقفه ظناً منه أنه فقد بلاغته، ولكن الكاتب لم یومئ برأسه بل أجاب أنه یبحث فی باله عن أفضل المعانی لكتابة الرسالة(9). ویجب علینا أن نعلم بأن الإلهام لم یكن یعنی شیئاً حتى بالنسبة لشعراء الجاهلیة دون الاعتماد على الجهد الإبداعی الأصیل وعلاقات الشاعر بأعماله الشعریة علاقة وطیدة جادة.
وهكذا نجد فی كتاب "الصناعتین فی الكتابة والشعر" لأبی هلال العسكری (القرن التاسع)، وهذا الكتاب مهم جداً للبحث فی نظریة الشعر فی القرون الوسطى عند العرب، نجد معلومات عن الجهد الذی بذله الشاعر زهیر أثناء نظمه للشعر، إذ إنه كان ینظم قصیدة واحدة فی ستة أشهر، ثم یتركها طی الكتمان ستة أشهر أخرى. وعندما كانت تنتهی هذه الفترة الطویلة إلى حد كبیر كان یلقی شعره(10). وأما الشاعر عنترة بن شداد فهو یشكو من مصیره الشعری لأن الشعراء الذین سبقوه لم یتركوا له مجالاً لیحمل شعره مضامین جدیدة وعلینا ألا ننسى أن هذا الكلام قیل فی القرن السادس.
إذن، إذا أراد الشاعر أن یضیف إلى شعره شیئاً إبداعیاً جدیداً فعلیه أن یكون ذا تناسق متواصل مع الإلهام الذی یحفز الشاعر للبحث عن فضاءات جدیدة. إنه یجب أن یستفز فیه المشاعر. حتى یوصله إلى اكتشاف الحقیقة وكسب المعرفة. ولذا لیس من الغریب إن كانت هناك صلة ولو خاطفة بین الشاعر والكاهن والشعر الجاهلی خاصة إذا لم ننس أن الفعل (شَعَر) كان فی البدء مرادفاً للفعل (عَلم)، وإن صلتهما تفهم بالذات وقبل كل شیء عن طریق (صنف) فی الإلهام. فهناك اعتقاد سائد بأن الكاهن كان یحصل على الإلهام بمساعدة إبلیس أو الشیطان، وإن هذا الاعتقاد قد امتد بعد ذلك إلى الشاعر أیضاً. كما أن هناك دلیلاً نجده فی تسلسل الشعراء الجاهلیین والمخضرمین الذین تقوم بینهم صلة القرابة (المهلهل امرؤ القیس عمرو بن كلثوم، طرفة المتلمس، زهیر كعب بن زهیر وغیرهم). وإن دل هذا على شیء فإنما یدل على أن أسرار نظم الشعر كانت تنتقل من شاعر إلى شاعر مختار آخر ضمن "طائفة" معینة ومحدودة.
وربما كانت هذه الصلة تساعد الشعراء مثل الكهنة على أن یعبروا عن أنفسهم بطریقة إبداعیة خاصة، مثلما كان الكهنة یستخدمون السجع فی خطبهم. ومن جهة أخرى، فإن لغة القرآن لغة مسجوعة ولذا كان بعض القرشیین یتهمون الرسول محمداً ( بانتمائه إلى صفوف الكهنة. ومن هذا یمكننا أن نتوقع بأن الصلة التی تربط الشعراء بالكهنة كانت لغة السجع. ولغة الشعراء هی لغة البیت والقافیة. وأما بخصوص الرسول محمد ( فقد اضطر أن یدافع عن نفسه ضد هذه التهمة كما ورد ذلك فی سورتی الحاقة والطور. ولكن بالنسبة لما نود الإشارة إلیه هو أن الرسول فی سورة الشعراء رد على الشعراء بالشعراء أنفسهم مثلما فعل أفلاطون فی جمهوریته ووسمهم بصفة الكاذبین. وفی الآیتین (210 211)، من نفس السورة نجد الفكرة التی تقول بأن القرآن لم ینزل على الشیاطین، أی على الكهنة أو الشعراء لأنهم "وماینبغی لهم و مایستطیعون "ویتهم القرآن الشیاطین الذین تآمروا على البشر ویتسمعون لما یجری فی السماء وبإمكانهم أن ینقلوا المعارف السریة كالأشخاص الذین یمتلكونها إلى الناس المختارین فی الدنیا.
ومن هذه الفكرة یبدو أن الشعراء قد أصبحوا مثل الكهنة السذج. ولكن هذه التهمة التی وردت بالقرآن قد لا تستطیع أن تحطم القدرة الشعریة (أو السحریة)، تحطیماً كاملاً. ولذا أضاف القرآن تهمة أشد وأقوى عندما ذكر بأن الشعراء یتكلمون بما لا یستطیعون تحقیقه ولذا فإن عملهم وشعرهم لیسا منسجمین وإن من یتبعهم هو فی ضلال ولكن ما أراه أهم هو هذه الصلة بین إبلیس أو الشیطان والشاعر، كما أن رأی الشاعر الجاهلی فی القدر وبحثه عن الحقیقة و المعرفة یذكرنا بما جرى، إلى حد ما، بفاوست غوته الأسطوری، وأخیراً بالثقافة الفاوستیة، هذه الثقافة الخاصة التی ولدت فی حضن الثقافة الجرمانیة، وهناك وجه آخر لنفس العملة، كما یقال، أی هذه الظاهرة تقول إن الكاهن أو الشاعر أو الإنسان بوجه عام یحصل على المعارف السریة ویبرزها فی أماكن الطقوس (وأنا أرى عكاظ والمربد والأسواق الأخرى أماكن للطقوس)، ویحرك نفوس المستمعین ومن ثم كل شیء ینتهی عند ذلك. ولذا اسمحوا لی بطرح السؤال التالی: لماذا لم تنجب هذه البذرة الفاوستیة التی نجدها فی بدایة الثقافة العربیة محاولة اللهاث وراء المعرفة ومحاصیلها؟ ولماذا لم تتحقق الثقافة الفاوستیة فی مفهومها الأوروبی الحدیث؟ وأعتقد أن الجواب الوحید الذی أستطیع أن أقدمه هنا هو عدم وجود الجو المناسب فی الأطراف الأخرى لحیاة المجتمع العربی آنذاك، لأن هذه الفكرة الفاوستیة ظهرت بشكل مبكر تقریباً، فی المرحلة البدائیة من تشكل العقل الإنسانی. ولكن هذه الظاهرة ساعدت مساعدة واضحة على ظهور الإسلام كمرحلة أرقى وأعلى فی سیر الثقافة نحو الأمام كما تمثلت هذه الظاهرة فی بدایة انتشار الإسلام فی "جوع" الأعراب للتعلم أكثر وتوسیع آفاقهم ولیعوضوا كل ما لم یعرفوا فی جاهلیتهم.
ولنتوقف الآن قلیلاً عند الفرق الجوهری بین النظریتین العربیة والأوروبیة تجاه مفهوم صنف الإلهام، وقد یحیرنا هذا الفرق لأننا نجد أن آلهة ما تقف وراء النظریة الأوربیة، بینما یقف وراء الشاعر الجاهلی الشیطان نفسه، قبیحاً مطروداً، مستفزاً. وفی اعتقادی أن هذا الشیطان هو الذی یسمو بهذا الشعر إلى مستوى الإبداع ویجعله شعراً مادیاً وتشكیل وتكوین نظریة الشعر الواقعی ولأنه كذلك فالقصیدة عند الشاعر الجاهلی تجد حاجة شدیدة فی سعیها للوصول إلى كشف مكنونات الطبیعة. والقصیدة تمثل، كما هو معروف، شكلاً أدبیاً ممزوجاً(11)، من ثلاثة أجزاء مختلفة: الجزء الأول منها، الذی نسمیه النسیب یشیر إلى میزة أساسیة عند الشاعر الجاهلی أو إلى (الموتیف) (MOTIV) الأساسی الحاجة الجامعة إلى الأسفار والبحث عن المجهول والمفقود. ولذا أرى فی هذا الجزء، عندما یبحث الشاعر الجاهلی عن حبیبته ویسرد ذكریاته معها ویقف مناجیاً أطلالها، إن هناك رمزاً أصیلاً یسری فی عروق الشعر العربی حتى أیامنا هذه. إن "موتیف" الفرار الدائم هو المحرك الحقیقی لیس للشعر الجاهلی فحسب بل وحتى للشعر المعاصر. یصف الشاعر تأبط شراً فی القرن السادس صاحباً له كان لاهث الشوق للأسفار غیر آبه برحاب القفار (وفی رأینا هذا رمز المغفرة)، والظمأ (رمز المعرفة) والخطر (رمز العقاب) الذی یداهم المسافر عند كل خطوة. ویمكن تتبع مثل أولئك المسافرین والتائهین بین الشعراء (أمثال تأبط شراً والشنفرى وامرئ القیس)، من خلال الشعر الجاهلی عامة، كما یمكن ذلك فی القرون الوسطى، ولكن بشكل أقل وضوحاً، باستثناء المقامات. ویبدو أن الحضارة الشمسیة تغلبت هذه الفترة (القرنین الحادی عشر والثانی عشر)، على الحضارة القمریة. وحتى فی أ یامنا هذه نشهد میول الشعراء إلى الأسفار والتیه وذلك على سبیل المثال من خلال أشعار بدر شاكر السیاب، وعبد الوهاب البیاتی، وسعدی یوسف، والفیتوری، ویمكننا تلمس هذه الظاهرة فی قصص ألف لیلة ولیلة، وإن كان الباحثون الأوربیون بشكل خاص یلاحظون تأثیر الهنود فی ذلك الموضوع، غیر أنی أعتبر هذا الرأی غیر سلیم.
والرجل المسافر یحتاج على الدوام إلى أن یعلم مصیره. والمصیر عند الشاعر امرئ القیس یعبر عن فضاء رحب الأشواق والعدو خلف ما یفلت من العقل البشری. ویعبر هذا الشاعر عن البشر والمستقبل فی شعره بعاملین أحدهما یبنی بوعی والآخر یهدم بجهله. ویمكننا الاستنتاج أن الشاعر الجاهلی یتعذب إلى حد ما من أجل كشف مكنونات الفضاء والطبیعة غیر أن بعض المستشرقین یصفونه بالمادیة ویتهمونه بجفاف الأسلوب وحتى یبدو بالنسبة إلیهم مملاً، ناسین أن أی شعر بدائی لا یستطیع أن یتجاوز عصره البدائی، ولكن ذاتیة هذا الشعر تجذبنا من جدید عندما نجدها قد تطورت فی القرنین 8 10 إلى الشك الذی اندثر بعد ذلك بسرعة مع شدید الأسف وتحول إلى الخفوت والركود (12).
بقی فقط الوهج البلاغی وتلاشى النبض الجمالی. ویبدو أن الشعر الكلاسیكی قد وصل إلى نصف العمود الذی یربط الأسفل والأعلى لیأتی الشعر المعاصر ویبدأ صعوده مع هذا العمود إلى أعلاه.
إن المصیر الذی یهتم به شعراء البادیة هو مصیر متقلب مستتر، ولذا لیس من الغریب أن ینظروا ولو نادراً خارج شخصیاتهم الضعیفة المحدودة التأثیر ولذا فإن هؤلاء الشعراء، حسب تقالید السامیین القدامى وحسب تقالید حضارات وادی الرافدین، یتطلعون إلى الطبیعة والنجوم للحصول على الأجوبة التی طرحتها روح متسائلة ومتعجبة وعلى سبیل المثال، الشعر المعاصر یواصل هذه "الخبرة" فإن الشاعر السیاب كثیراً ما یتطلع إلى النجوم ولكنه یرمز فی شعره بشیء معاكس للنجوم وهو الصدف. ویعنی هذا الربط عذاب الإنسان أمام الحقیقة، أی بین النور والظلام، بین التفاؤل والتشاؤم، بین الأسرار والمعرفة. وكان عرب الزمن القدیم یؤمنون بأن هبوط النجوم ینبئ بوفاة نبیل أو بولادته. ولكن شعراء القرون الوسطى یحاولون اجتیاز هذه الهاویة وعدم الانسجام بین البشر والفضاء عن طریق إهمال هذه المسألة.
ومن خلال هذا البحث السریع أود أن أبین للقارئ أن هذا الإلهام شبه الفاوستی ترك أثراً مهماً لیس فی الشعر العربی فحسب، وإنما فی الثقافة عموماً بالرغم من أنه لم یستطع أن یؤثر على ظروف هذا العصر البدائی والعصور التی تلته، ولذا كان الإلهام لمدة قصیرة محاولة للبحث عن مقاومة الحقیقة وبث الشكوك(13) ولكنه تحول بمرور القرون، إلى حركة جدیدة فی الشعر العربی المعاصر (القرن العشرین وبالخصوص منذ الخمسینات)، عندما أصبح الشعر الحر یبنی طرقه الجدیدة، مؤكداً على وجود الإنسان.
****
الحواشی:
(1) لأن القصیدة بلغت هذه الدرجة من المهارة الشعریة، وخاصة من جانب العروض بحیث أصبح بعض الباحثین یشكون فی أصالتها الباكرة مع أن فیلیب حتی، المؤرخ الشهیر، یضع القصیدة فوق ملاحم هومیروس وعلینا أن نتذكر أن هومیروس كان "مفاجأة كبیرة"، بحد ذاته فی ذلك الزمن.
(2) فی الأدب الجاهلی، القاهرة 1962، ص 71.
(3) مقدمة ابن خلدون، ج4، القاهرة، ص 1314.
(4) انظر دراسة نور الدین صمود المنشورة فی أعداد مجلة الفكر التونسیة لعام 1978، وبالخصوص العددین 5 و10.
(5) انظر باللغة الروسیة:
S.Y.SHIDFAR, Obraznaya sistema arabskyo Klasicheskoy literaturi, Moskva, 1974.
(6) طه حسین، المصدر المذكور، ص 71.
(7) إن هذا التغلب واضح فی العصر الأموی حیث یحترم الشعراء التقلید الجاهلی احتراماً شاملاً، وانظر إلى:
Papers on Islamic Kistory (950- 1750). Oxford 1973.
وفیه دراسة CI. Cahen.
(8) یقول القرآن: (أقرأ باسم ربك الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذی علم بالقلم، علم الإنسان مالم یعلم(.
(9) العقد الفرید، بیروت 1963، ص 44.
(10) المصدر المذكور، ص 65.
(11) ویقول ابن خلدون عن الشكل والمضمون إن الأول بمثابة القوالب للمعانی فكما أن الأوانی التی یغترف بها الماء من البحر منها آنیة الذهب والفضة والصدف، والزجاج والخزف والماء واحد فی نفسه، وتختلف الجودة فی الأوانی المملوءة بالماء، باختلاف جنسها لا باختلاف الماء (مقدمة، ص 1325).
(12) نجد أشكال الشك عند المعتزلة والمعری وأبی نواس الذی یقول:
دع عنك لومی فإن اللوم إغراء وداونی بالتی كانت هی الداء
وقل لمن یدعی فی العلم فلسفة حفظت شیئاً وغابت عنك أشیاء
(13) قد أكون مضطراً فی هذا المكان إلى شرح موقفی من جدوى الشك فی سیر البشر إلى الأمام. وابتداء من شكوك مونتسكیه الفرنسی بدأت الثقافة الأوروبیة أو الغربیة تتقدم فنیاً وفلسفیاً وتیكنولوجیاً، الشك هو ما یحركنا فی بحثنا عن الذات والعلم.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:40|
الظواهر التربویة فی عیون الشعر العربی
من المقطوع به أن الأخلاق
أفعال قبل أن تكون أقوالا، والتربیة سلوك ومنهج قبل ان تكون ألفاظا وكلاما،
والكلمات أجساد خاویة لا تتحرك إلا بروح العمل، فتكون الفعالیات السلوكیة
والتربویة من مصادیق الألفاظ وظواهرها، وكلما كانت الألفاظ أقرب الى النفس
الإنسانیة كانت حركة الروح باتجاه الخیر أكثر انسیابیة وأقرب الى مدارج
الرقی وسلم السمو.
ولعل ألفاظ التربیة المضغوطة فی أبیات الشعراء هی الأقرب الى النفس المرهفة بعد نصوص القرآن والسنة الشریفة، وهی فی مصاف الحكم الصادرة عن رجال الخیر، على ان الشعر لدى بعض الشعراء هی الحكمة بعینها تندلع من لسان القوافی حروف التربیة الآخذة بمسامع الناس ومشاعرهم نحو التفاعل والانفعال بها منتجة سلوكا واضح المعالم لا یشطط بصاحبه عن جادة الصواب، فلا یظلم نفسه ولا یعتدی على أقرانه، ویتمثل فی حیاته كل قیم الخیر، ویتوسم فیها المقاصد السلیمة الباعثة على الخیر والناهیة عن المنكرات ورفض الخصال السیئة التی تتنكب بصاحبها عن سبیل الرشاد.
ولا یختلف مسرح الحیاة عن خشبة المسرح التی یستعرض فیها المخرج عبر شخصیاته الصراع الخفی والظاهر بین قوى الخیر والشر، بل ان المسرح الفنی هو صورة مصغرة عن مسرح الحیاة الدنیا القائم على ثنائیة الخیر والشر أو الرحمن والشیطان، والشاعر المبدع هو الذی یستعرض ملامح الصراع على مسرح قوافیه، فیتلقى الإنسان الشعر بما یساعده على هضم القیم الصالحة ولفظ الخصال الطالحة. وفی الشعر القریض الذی نظم فی النهضة الحسینیة وما حصل فی كربلاء المقدسة یوم العاشر من محرم عام 61 هـ، الكثیر من الأبیات التی اختزنت فی صدورها وأعجازها قیما ومعانی سامیة، وفیها الكثیر من العادات السالبة التی یختزلها الشاعر فی كلمات جزیلة وهی تدعو المرء الى تجنبها.
الأكادیمی العراقی الدكتور عبد الحسین مهدی عواد، استاذ كلیة التربیة بجامعة البصرة، والمحاضر فی الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة بلندن، وقف على الدواوین الشعریة الصادرة عن المركز الحسینی للدراسات ضمن موسوعة دائرة المعارف الحسینیة لمؤلفها المحقق الشیخ الدكتور محمد صادق محمد الكرباسی، فاستوقفته الظواهر التربویة المبثوثة فی قصائد شعراء النهضة الحسینیة عبر القرون، فأطال النظر عند بعضها لكثرتها، فتناولها فی خمسة فصول فی كتاب صدر العام 2007 عن بیت العلم للنابهین فی بیروت فی 160 صفحة من القطع الوزیری وحمل عنوان: "الظواهر التربویة فی أشعار دائرة المعارف الحسینیة للعلامة الشیخ آیة الله محمد صادق الكرباسی".
وقد تناول الظواهر التربویة بمنظار أكادیمی، فجاءت فصول الكتاب متسلسلة یأخذ بكلیات الأمور لیصل الى جزئیاتها لینتهی بنتائج عامة، ولهذا فان الفصل الأول بحث "التربیة: مفهومها وأسسها"، وبحث فی الفصل الثانی: "أسس التربیة ومفاهیم الأحداث الحیاتیة"، وبحث فی الفصل الثالث: "الإمام الحسین (ع) وكمال التربیة الإنسانیة"، وبحث فی الفصل الرابع: "التهذیب الذاتی وشعر الشعائر الحسینیة"، وحتى تكون الفصول الأربعة تحت مدى منظاره وأفق آرائه وتصوراته، فان الفصل الأخیر تناول: "التطبیقات السلوكیة لفاعلیة الشعر الحسینی التربویة".
مفهوم التربیة وأسسها
لا تختص التربیة بالنظام الإسلامی، لأنها سلوك بشری فطری، یأتی الدین لتشذیبها وتهذیبها، وهی ممارسة یومیة تلاصق الإنسان كظله، ولذلك جاء البحث فی التربیة ومفهومها وفقا لمراحل البشریة لینتهی بالإسلام باعتبار ان محور الحدیث هو الإمام الثالث من أئمة أهل البیت (ع) وسبط النبی محمد (ص)، وما أفرزته الأشعار التی قیلت فیه وفی نهضته المباركة، من ظواهر تربویة وخلقیة. فالتربیة لكونها النشأة السلیمة للإنسان، فإنها تعنی: "عملیة التدریب والاكتساب التی ینمو الكائن البشری بفاعلیتها لیصل الى درجة الكمال الممكن فی جسمه وعقله وروحه وسلوكه الاجتماعیة"، وبناءاً علیه فإنها: "تصوغ الإنسان وتوجه سلوكه نحو الأفضل فی كل نواحی الحیاة"، فهی إذن: "النشاط الحیاتی الذی یكسو الحیاة الخیر والصلاح".
ولان التربیة تعنی بالدرجة الأولى تهذیب النفس البشریة، فان العلاقة جد وثیقة بین علم النفس وعلم النفس التربوی، بلحاظ: "إن علم النفس هو من المعارف ویعتبر من جهة هو أقدم العلوم فی المعارف الإنسانیة"، ولذلك أضحت النفس شعار فلسفة الفیلسوف الیونانی سقراط (Socrates) (470 -399 ق.م)، ومن بعده أفلاطون (Platon) (427-347 ق.م)، وسار أرسطوطالیس (Aristoteles) (384-322 ق.م) على منوال أستاذه أفلاطون، واهتم علماء الغرب بعلم النفس فی مجال التربیة لما توفر من كاشفیة لدى المربی فی سلوك أفضل الطریق وأنجحها لتربیة الفرد البشری.
أما الإسلام فانه أفرد للنفس البشریة مساحة كبیرة، بوصفها مركز الخیر والشر، وعلیها تنعقد كل فعالیات الإنسان، وبالتبع كل فعالیات البشریة، قال تعالى: (ونفس وما سوّاها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكّاها. وقد خاب من دسّاها) الشمس: 7-10، ولأن النفس خطرها عظیم، فان النبی محمد (ص) وصف جهادها وتزكیتها فی میدان معركة السلوك والمعاملة الیومیة بالجهاد الأكبر، فی قبال الجهاد الأصغر فی میدان المعركة العسكریة، وهذا الجهاد یبدأ من الطفولة، فصغار الأمس هم شباب الیوم ورجال الغد، وبالتالی كما یقرر الدكتور العواد انه: "من خلال صقل وترویض وتعلیم الطفل المسلم منذ مراحل نشأته الأولى یمكن تیقظ فطرته السلیمة وإبراز جوانب إنسانیته الحقة. فتكون حصیلة حرص المجتمع الإسلامی على إحراز الفطرة السلیمة والإنسانیة الحقة هی الحصیلة العملیة التربویة حتى لو استخدمت أی من التدریبات التربویة التی هی خلاصة آراء الفلاسفة والمربین".
البیئة والموروث الإنسانی
ویمثل المحیط الإجتماعی الذی تنشد فیه القصائد والخطابات المتضمنة لعیون الشعر الحسینی بیئة خصبة لإظهار الجوانب السلوكیة الطیبة، بخاصة إذا كانت القصائد دافعة للمجتمع لكل ما هو خیر ودافعة عنه كل ما هو شر، وتراكمات القصائد هی فی واقع الأمر موروث حی للأمة جیلا بعد آخر، والفرد الذی ینشأ فی بیئة تخللها المجالس الحسینیة وترتفع فیها أعواد المنابر هی بیئة سلیمة تستحث فی الفرد صغیرا كان أو كبیرا المؤثرات السلوكیة الدافعة بالمرء الى سبیل الخیر، ویأتی الدین لیشد من شبكة المؤثرات ویدعمها.
والخیر الذی تشع خیوطه من واقعة كربلاء وتتمثلها الأشعار هو عنوان عریض یشمل كل منقبة حسیة أو معنویة، وقد وجد المؤلف ان من أهم الظواهر التربویة التی یمكن استقراؤها من القصائد الحسینیة هی:
- خصال البطولة والشجاعة: على اعتبار ان البطولة "صفة جمع لعامة الكمالات"، وهی بذلك: "عنوان المحاسن وشعار الكمال ودلیل الثبات والإیثار والورع والزهد وهی لو اجتمعت فی إنسان لأصبح مصداقا للبطل".
- مبادئ العزم والتصمیم: بلحاظ تحقق خاصیة التلازم بین الشجاعة والبطولة وبین العزم والتصمیم. ولا یخفى: "إن خواص العزم والتصمیم تعنی ملازمة الطریق والحفاظ على العهود"، كما إن: "اطمئنان النفس وتعاظم ثقتها بالوفاء للهدف الذی ارتضته واطمأنت لصحته هی من الأمور المولّدة لخصال العزم"، وهذه المعانی ودلالاتها أهداف تربویة ینشدها كل إنسان.
- مفاهیم التسامی والإباء: وهذه من أشهر السجایا والأخلاق الكریمة، وقد تحققت فی كربلاء وأنشدها الشعراء، ذلك: "إن التسامی والإباء تتحقق كنتیجة لتحقق الشجاعة"، وقد كان الإمام الحسین مثالها: "لذا فان خصلتی التسامی والإباء من مستوحیات شخصیة الحسین (ع) ومكتسباته التربویة من حاضنة الرسول الأعظم (ص)، ناهیك عما جاء من تطبیقاتها فی حادثة استشهاده"، وتأسیسا على ذلك: "لابد لحدیث الخطیب عن حادثة استشهاد الحسین والناظم للشعر عن مآثر الحسین فی حادثة كربلاء من أن یستمد مخیلة أفكاره الخطابیة ومعالم صوره الشعریة من هذه الخصال وما ظهر من تطبیقاتها فی حادثة استشهاد الحسین".
- الإیثار والمواساة: فالخصلة الأولى من إفرازات علو الهمة وعظم النفس، والثانیة من دماثة الخلق ولطافة الشمائل.
أدب العِبرة والعَبرة
یذهب الدكتور عواد الى التأكید بان: "الفاعلیة لأی باعث تربوی تزداد قوة وتتعاظم أثراً إذا تم التعبیر عنها بنظم شعری صادق. ویستمد الشعر فاعلیته من صور موضوعات نظمه.. ویكسب مستمعیه الفهم لخصال من انتظمت القصائد فی مآثره".
ومن هذه الصور ما ینسب الى الإمام علی بن الحسین السجاد (ع) (ت 95 هـ) أو الى أبیه أو الى غیرهما:
قوم إذا نودوا لدفع ملمة
والخیل بین مدعس ومكردس
لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا
یتهافتون على ذهاب الأنفس
فهذه الأبیات كاشفة عن التطبیق العملی لخصال الشجاعة والتصمیم وشدة العزم، وعندما تتناهى الى أسماع المتلقی یستشعرها فی نفسه لیتمثلها فی حیاته الیومیة، وكلما كان الشعر مجیدا وأمكن استخدامه الحسن فی مجالس الخطابة كان نافذا الى القلوب لان: "الشعائر الحسینیة قد تنتظم بما تحتویها كلمتی عِبرة وعَبره"، كما: "إن العَبرة أو البكاء أو النیاح یجب أن یكون بعد استیعاب العِبرة. وبالعنایة بهذا التطبیق نتسامى بالحسین (ع) الى المستوى الذی أهّله له الخالق عز وجل بشهادته ونمتنع من أن نجعل من شهادة الحسین (ع) موضوعا عاطفیا لیس له إلا مظهر العویل والبكاء فقط"، فالعَبرة طریق الى العِبرة والاعتبار وهما أمران متلازمان لا ینفكان، وهذه الملازمة تفضی الى حساب دائرتی الاقتراب والابتعاد من مركز الهدف، وحسب الدكتور عواد: "ولعل الفارق بین الفهم أن الحسین (ع) قد مات بكربلاء والفهم على أنه استشهد هو الذی خلط بین الفهم على أن (البكاء) إنما حصل لحصول الموت، ولیس لمأساة العِبرة منه. وذلك لأن الشهادة هی تعبیر عن رضا الله فلا یُؤسى لها ولا یُبكى على من نالها. وهنا یتضح الفارق بین المعنى لجانب مهم لجوانب (العَبرة) و (العِبرة)".
كما ان الإمام الحسین (ع) كجده الذی قال فیه القرآن الكریم: (لقد كان لكم فی رسول الله أسوة حسنة) الأحزاب: 21، وهذا المعنى یتمثله الشاعر ابن الساعاتی علی بن رستم الخراسانی (ت 604) فی الأبیات التالیة:
ولكلِّ حیٍّ أسوةٌ بمحمدٍ
ومحمدٌ ذو الموقف المحمود
كم فی مصارع آله من عِبرةٍ
سوداء عدّوها من التسوید
فتأسَّ بالمأموم والمسموم
والــمقتول والمجلوب نحو یزید
الى أن یقول:
سل عن زیادٍ وابنه وارجع الى ** عمروٍ فسل هل عاش بعد سعید
فالشاعر یدعو المتلقی الى الاعتبار وملاحظة ما آلت إلیه حوادث الدهر، ویسوقه الى التأسی بالإمام الحسن بن علی (ع) الذی رحل مسموما عام 50 هـ، وبالإمام الحسین (ع) الذی قضى نحبه شهیدا عام 61 هـ، وبالإمام علی بن الحسین (ع) الذی جلب الى مجلس یزید بن معاویة أسیرا بعد واقعة كربلاء، فهذه الأسماء الخیّرة وما یقابلها من أضداد شرّیرة كانت ولازالت تمثل رجال مسرح الحیاة حیث الصراع بین قوى الفضیلة والرذیلة، فأین الحسین من موقع الحدث وأین یزید؟ فالحسین (ع) سما ذكره بفعاله ومواقفه البطولیة وتهاوى ذكر یزید بجرائره ومواقفه المخزیة.
ولما كان الشعر الحسینی یكثر قراءته من على منابر الخطابة الحسینیة، فان واحدة من شروط عملیة التواصل بین المتلقی والظواهر التربویة فی الشعر الحسینی هو قوة الوسیط أی الخطیب لأن: "إلمام الخطیب بالثقافة التربویة والنفسیة ومعرفته بالدراسات الاجتماعیة والسیاسیة تجعله متمكنا من إبراز الخصائص التربویة للشعر الحسینی، سواء ذلك بتنظیم العرض من على المنبر أو من خلال التدرج بالحدث من حال وقوعه الى الحال الأفضل فی التفكیر والسلوك، فیوفر للمتلقی خیر السبیلین، سبیل تعظیم الشعائر وسبیل الاتعاظ من أحداث التاریخ ومآسیه"، صحیح أن فطرة البشر قد تقود المرء الى ایجابیة السلوك: "إلا أن الخطیب الماهر هو الذی یكمل فاعلیة الحدث الحسینی والأثر الفنی للشعر لتثبیت الخصال التی تقوّم السلوك وتُكسب بموجبها التطبیقات التربویة".
ومثال الخصال الحمیدة "الإخوة والوفاء لها" وتقدسیها، وقد صورها بتعبیر فنی جمیل شاعر القرن الثالث الهجری الفضل بن محمد المطلبی، وهو ینشد:
إنی لأذكر للعباس موقفهُ
بكربلاءَ وهامُ القومِ تُختطَفُ
یحمی الحسین ویحمیه على ظمأٍ
ولا یُولّی ولا یُثنى ولا یَقفُ
ولا أرى مشهداً یوماً كمشهده
مع الحسین علیه الفضل والشرفُ
أكرم به مشهداً بانت فضیلته
وما أضاع له أفعاله خَلَفُ
ففی هذه الأبیات التی تحكی موقف العباس بن علی (ع) الأخ المواسی لأخیه: "صوّر الشعر الحسینی خاصیة الإخاء وعنایة الضمیر بالوفاء للأخوة فی مأساة كربلاء تصویرا جعل منه مصدرا تربویا یقتدى به".
كاتب وموسوعة
وجد الدكتور عبد الحسین عواد ان المنهج الذی ابتدعه الفقیه آیة الله الشیخ محمد صادق الكرباسی فی تألیف موسوعة متكاملة عن النهضة الحسینیة من: "ستین بابا یستوفی الحدیث بها عن السیرة والسیاسة والأدب وعلم النفس والكیمیاء والفیزیاء والفن المعماری واللغة والعروض والصرف وغیرها من الموضوعات الأخرى"، جعلها فریدة من نوعها، وزاد فی تألقها أن الكرباسی ختم كل مجلد بقراءة نقدیة لعلم من العلماء الغرب والشرق ومن جنسیات وأدیان ومذاهب مختلفة: " وهو الأمر الذی برهن على الموضوعیة التی نأت بالنتائج عن الفئویة وجعلتها فی مدارات المنظوم العلمی العام، أی فی المنظور الذی یتعامل مع المادة العلمیة كعنصر موجود خاضع للدراسة الموضوعیة والعلمیة، وهو العامل المهم الذی ضاعف فی اهتمام الدارسین والباحثین فی مدارات المعرفة التی عرضت لها دائرة المعارف الحسینیة".
ولاشك أن مدارات المعرفة هذه: "والأطر المتعددة والمتنوعة التی انتظمت فی تألیف دائرة المعارف الحسینیة منحتها الملكة الإبداعیة والخصائص الأكادیمیة والثراء الثقافی والكم العلمی الذی برهن على ملكة المؤلف لخصائص الصبر والتأنی فی الكتابة والتألیف المتقن. وهی سمات ترتفع بالمؤلِّف والمؤلَّف الى درجة التقدیر ومن ثم الخلود والبقاء والتجدید"، وبتقدیر العواد الذی یشرف على رسائل علمیة فی الدراسات العلیا: "أثبت هذا العمل المنتظم أن المؤلف یمتلك من الإبداع الأكادیمی ما یجعله متمیزا بشهادات ذوی الخبرة العلمیة والأكادیمیة"، ولذلك فلا عجب أن ینال صاحب الموسوعة: "أربع شهادات للدكتوراه من جامعات سوریا ولبنان والولایات المتحدة الأمیركیة".
ولعل ألفاظ التربیة المضغوطة فی أبیات الشعراء هی الأقرب الى النفس المرهفة بعد نصوص القرآن والسنة الشریفة، وهی فی مصاف الحكم الصادرة عن رجال الخیر، على ان الشعر لدى بعض الشعراء هی الحكمة بعینها تندلع من لسان القوافی حروف التربیة الآخذة بمسامع الناس ومشاعرهم نحو التفاعل والانفعال بها منتجة سلوكا واضح المعالم لا یشطط بصاحبه عن جادة الصواب، فلا یظلم نفسه ولا یعتدی على أقرانه، ویتمثل فی حیاته كل قیم الخیر، ویتوسم فیها المقاصد السلیمة الباعثة على الخیر والناهیة عن المنكرات ورفض الخصال السیئة التی تتنكب بصاحبها عن سبیل الرشاد.
ولا یختلف مسرح الحیاة عن خشبة المسرح التی یستعرض فیها المخرج عبر شخصیاته الصراع الخفی والظاهر بین قوى الخیر والشر، بل ان المسرح الفنی هو صورة مصغرة عن مسرح الحیاة الدنیا القائم على ثنائیة الخیر والشر أو الرحمن والشیطان، والشاعر المبدع هو الذی یستعرض ملامح الصراع على مسرح قوافیه، فیتلقى الإنسان الشعر بما یساعده على هضم القیم الصالحة ولفظ الخصال الطالحة. وفی الشعر القریض الذی نظم فی النهضة الحسینیة وما حصل فی كربلاء المقدسة یوم العاشر من محرم عام 61 هـ، الكثیر من الأبیات التی اختزنت فی صدورها وأعجازها قیما ومعانی سامیة، وفیها الكثیر من العادات السالبة التی یختزلها الشاعر فی كلمات جزیلة وهی تدعو المرء الى تجنبها.
الأكادیمی العراقی الدكتور عبد الحسین مهدی عواد، استاذ كلیة التربیة بجامعة البصرة، والمحاضر فی الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة بلندن، وقف على الدواوین الشعریة الصادرة عن المركز الحسینی للدراسات ضمن موسوعة دائرة المعارف الحسینیة لمؤلفها المحقق الشیخ الدكتور محمد صادق محمد الكرباسی، فاستوقفته الظواهر التربویة المبثوثة فی قصائد شعراء النهضة الحسینیة عبر القرون، فأطال النظر عند بعضها لكثرتها، فتناولها فی خمسة فصول فی كتاب صدر العام 2007 عن بیت العلم للنابهین فی بیروت فی 160 صفحة من القطع الوزیری وحمل عنوان: "الظواهر التربویة فی أشعار دائرة المعارف الحسینیة للعلامة الشیخ آیة الله محمد صادق الكرباسی".
وقد تناول الظواهر التربویة بمنظار أكادیمی، فجاءت فصول الكتاب متسلسلة یأخذ بكلیات الأمور لیصل الى جزئیاتها لینتهی بنتائج عامة، ولهذا فان الفصل الأول بحث "التربیة: مفهومها وأسسها"، وبحث فی الفصل الثانی: "أسس التربیة ومفاهیم الأحداث الحیاتیة"، وبحث فی الفصل الثالث: "الإمام الحسین (ع) وكمال التربیة الإنسانیة"، وبحث فی الفصل الرابع: "التهذیب الذاتی وشعر الشعائر الحسینیة"، وحتى تكون الفصول الأربعة تحت مدى منظاره وأفق آرائه وتصوراته، فان الفصل الأخیر تناول: "التطبیقات السلوكیة لفاعلیة الشعر الحسینی التربویة".
مفهوم التربیة وأسسها
لا تختص التربیة بالنظام الإسلامی، لأنها سلوك بشری فطری، یأتی الدین لتشذیبها وتهذیبها، وهی ممارسة یومیة تلاصق الإنسان كظله، ولذلك جاء البحث فی التربیة ومفهومها وفقا لمراحل البشریة لینتهی بالإسلام باعتبار ان محور الحدیث هو الإمام الثالث من أئمة أهل البیت (ع) وسبط النبی محمد (ص)، وما أفرزته الأشعار التی قیلت فیه وفی نهضته المباركة، من ظواهر تربویة وخلقیة. فالتربیة لكونها النشأة السلیمة للإنسان، فإنها تعنی: "عملیة التدریب والاكتساب التی ینمو الكائن البشری بفاعلیتها لیصل الى درجة الكمال الممكن فی جسمه وعقله وروحه وسلوكه الاجتماعیة"، وبناءاً علیه فإنها: "تصوغ الإنسان وتوجه سلوكه نحو الأفضل فی كل نواحی الحیاة"، فهی إذن: "النشاط الحیاتی الذی یكسو الحیاة الخیر والصلاح".
ولان التربیة تعنی بالدرجة الأولى تهذیب النفس البشریة، فان العلاقة جد وثیقة بین علم النفس وعلم النفس التربوی، بلحاظ: "إن علم النفس هو من المعارف ویعتبر من جهة هو أقدم العلوم فی المعارف الإنسانیة"، ولذلك أضحت النفس شعار فلسفة الفیلسوف الیونانی سقراط (Socrates) (470 -399 ق.م)، ومن بعده أفلاطون (Platon) (427-347 ق.م)، وسار أرسطوطالیس (Aristoteles) (384-322 ق.م) على منوال أستاذه أفلاطون، واهتم علماء الغرب بعلم النفس فی مجال التربیة لما توفر من كاشفیة لدى المربی فی سلوك أفضل الطریق وأنجحها لتربیة الفرد البشری.
أما الإسلام فانه أفرد للنفس البشریة مساحة كبیرة، بوصفها مركز الخیر والشر، وعلیها تنعقد كل فعالیات الإنسان، وبالتبع كل فعالیات البشریة، قال تعالى: (ونفس وما سوّاها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكّاها. وقد خاب من دسّاها) الشمس: 7-10، ولأن النفس خطرها عظیم، فان النبی محمد (ص) وصف جهادها وتزكیتها فی میدان معركة السلوك والمعاملة الیومیة بالجهاد الأكبر، فی قبال الجهاد الأصغر فی میدان المعركة العسكریة، وهذا الجهاد یبدأ من الطفولة، فصغار الأمس هم شباب الیوم ورجال الغد، وبالتالی كما یقرر الدكتور العواد انه: "من خلال صقل وترویض وتعلیم الطفل المسلم منذ مراحل نشأته الأولى یمكن تیقظ فطرته السلیمة وإبراز جوانب إنسانیته الحقة. فتكون حصیلة حرص المجتمع الإسلامی على إحراز الفطرة السلیمة والإنسانیة الحقة هی الحصیلة العملیة التربویة حتى لو استخدمت أی من التدریبات التربویة التی هی خلاصة آراء الفلاسفة والمربین".
البیئة والموروث الإنسانی
ویمثل المحیط الإجتماعی الذی تنشد فیه القصائد والخطابات المتضمنة لعیون الشعر الحسینی بیئة خصبة لإظهار الجوانب السلوكیة الطیبة، بخاصة إذا كانت القصائد دافعة للمجتمع لكل ما هو خیر ودافعة عنه كل ما هو شر، وتراكمات القصائد هی فی واقع الأمر موروث حی للأمة جیلا بعد آخر، والفرد الذی ینشأ فی بیئة تخللها المجالس الحسینیة وترتفع فیها أعواد المنابر هی بیئة سلیمة تستحث فی الفرد صغیرا كان أو كبیرا المؤثرات السلوكیة الدافعة بالمرء الى سبیل الخیر، ویأتی الدین لیشد من شبكة المؤثرات ویدعمها.
والخیر الذی تشع خیوطه من واقعة كربلاء وتتمثلها الأشعار هو عنوان عریض یشمل كل منقبة حسیة أو معنویة، وقد وجد المؤلف ان من أهم الظواهر التربویة التی یمكن استقراؤها من القصائد الحسینیة هی:
- خصال البطولة والشجاعة: على اعتبار ان البطولة "صفة جمع لعامة الكمالات"، وهی بذلك: "عنوان المحاسن وشعار الكمال ودلیل الثبات والإیثار والورع والزهد وهی لو اجتمعت فی إنسان لأصبح مصداقا للبطل".
- مبادئ العزم والتصمیم: بلحاظ تحقق خاصیة التلازم بین الشجاعة والبطولة وبین العزم والتصمیم. ولا یخفى: "إن خواص العزم والتصمیم تعنی ملازمة الطریق والحفاظ على العهود"، كما إن: "اطمئنان النفس وتعاظم ثقتها بالوفاء للهدف الذی ارتضته واطمأنت لصحته هی من الأمور المولّدة لخصال العزم"، وهذه المعانی ودلالاتها أهداف تربویة ینشدها كل إنسان.
- مفاهیم التسامی والإباء: وهذه من أشهر السجایا والأخلاق الكریمة، وقد تحققت فی كربلاء وأنشدها الشعراء، ذلك: "إن التسامی والإباء تتحقق كنتیجة لتحقق الشجاعة"، وقد كان الإمام الحسین مثالها: "لذا فان خصلتی التسامی والإباء من مستوحیات شخصیة الحسین (ع) ومكتسباته التربویة من حاضنة الرسول الأعظم (ص)، ناهیك عما جاء من تطبیقاتها فی حادثة استشهاده"، وتأسیسا على ذلك: "لابد لحدیث الخطیب عن حادثة استشهاد الحسین والناظم للشعر عن مآثر الحسین فی حادثة كربلاء من أن یستمد مخیلة أفكاره الخطابیة ومعالم صوره الشعریة من هذه الخصال وما ظهر من تطبیقاتها فی حادثة استشهاد الحسین".
- الإیثار والمواساة: فالخصلة الأولى من إفرازات علو الهمة وعظم النفس، والثانیة من دماثة الخلق ولطافة الشمائل.
أدب العِبرة والعَبرة
یذهب الدكتور عواد الى التأكید بان: "الفاعلیة لأی باعث تربوی تزداد قوة وتتعاظم أثراً إذا تم التعبیر عنها بنظم شعری صادق. ویستمد الشعر فاعلیته من صور موضوعات نظمه.. ویكسب مستمعیه الفهم لخصال من انتظمت القصائد فی مآثره".
ومن هذه الصور ما ینسب الى الإمام علی بن الحسین السجاد (ع) (ت 95 هـ) أو الى أبیه أو الى غیرهما:
قوم إذا نودوا لدفع ملمة
والخیل بین مدعس ومكردس
لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا
یتهافتون على ذهاب الأنفس
فهذه الأبیات كاشفة عن التطبیق العملی لخصال الشجاعة والتصمیم وشدة العزم، وعندما تتناهى الى أسماع المتلقی یستشعرها فی نفسه لیتمثلها فی حیاته الیومیة، وكلما كان الشعر مجیدا وأمكن استخدامه الحسن فی مجالس الخطابة كان نافذا الى القلوب لان: "الشعائر الحسینیة قد تنتظم بما تحتویها كلمتی عِبرة وعَبره"، كما: "إن العَبرة أو البكاء أو النیاح یجب أن یكون بعد استیعاب العِبرة. وبالعنایة بهذا التطبیق نتسامى بالحسین (ع) الى المستوى الذی أهّله له الخالق عز وجل بشهادته ونمتنع من أن نجعل من شهادة الحسین (ع) موضوعا عاطفیا لیس له إلا مظهر العویل والبكاء فقط"، فالعَبرة طریق الى العِبرة والاعتبار وهما أمران متلازمان لا ینفكان، وهذه الملازمة تفضی الى حساب دائرتی الاقتراب والابتعاد من مركز الهدف، وحسب الدكتور عواد: "ولعل الفارق بین الفهم أن الحسین (ع) قد مات بكربلاء والفهم على أنه استشهد هو الذی خلط بین الفهم على أن (البكاء) إنما حصل لحصول الموت، ولیس لمأساة العِبرة منه. وذلك لأن الشهادة هی تعبیر عن رضا الله فلا یُؤسى لها ولا یُبكى على من نالها. وهنا یتضح الفارق بین المعنى لجانب مهم لجوانب (العَبرة) و (العِبرة)".
كما ان الإمام الحسین (ع) كجده الذی قال فیه القرآن الكریم: (لقد كان لكم فی رسول الله أسوة حسنة) الأحزاب: 21، وهذا المعنى یتمثله الشاعر ابن الساعاتی علی بن رستم الخراسانی (ت 604) فی الأبیات التالیة:
ولكلِّ حیٍّ أسوةٌ بمحمدٍ
ومحمدٌ ذو الموقف المحمود
كم فی مصارع آله من عِبرةٍ
سوداء عدّوها من التسوید
فتأسَّ بالمأموم والمسموم
والــمقتول والمجلوب نحو یزید
الى أن یقول:
سل عن زیادٍ وابنه وارجع الى ** عمروٍ فسل هل عاش بعد سعید
فالشاعر یدعو المتلقی الى الاعتبار وملاحظة ما آلت إلیه حوادث الدهر، ویسوقه الى التأسی بالإمام الحسن بن علی (ع) الذی رحل مسموما عام 50 هـ، وبالإمام الحسین (ع) الذی قضى نحبه شهیدا عام 61 هـ، وبالإمام علی بن الحسین (ع) الذی جلب الى مجلس یزید بن معاویة أسیرا بعد واقعة كربلاء، فهذه الأسماء الخیّرة وما یقابلها من أضداد شرّیرة كانت ولازالت تمثل رجال مسرح الحیاة حیث الصراع بین قوى الفضیلة والرذیلة، فأین الحسین من موقع الحدث وأین یزید؟ فالحسین (ع) سما ذكره بفعاله ومواقفه البطولیة وتهاوى ذكر یزید بجرائره ومواقفه المخزیة.
ولما كان الشعر الحسینی یكثر قراءته من على منابر الخطابة الحسینیة، فان واحدة من شروط عملیة التواصل بین المتلقی والظواهر التربویة فی الشعر الحسینی هو قوة الوسیط أی الخطیب لأن: "إلمام الخطیب بالثقافة التربویة والنفسیة ومعرفته بالدراسات الاجتماعیة والسیاسیة تجعله متمكنا من إبراز الخصائص التربویة للشعر الحسینی، سواء ذلك بتنظیم العرض من على المنبر أو من خلال التدرج بالحدث من حال وقوعه الى الحال الأفضل فی التفكیر والسلوك، فیوفر للمتلقی خیر السبیلین، سبیل تعظیم الشعائر وسبیل الاتعاظ من أحداث التاریخ ومآسیه"، صحیح أن فطرة البشر قد تقود المرء الى ایجابیة السلوك: "إلا أن الخطیب الماهر هو الذی یكمل فاعلیة الحدث الحسینی والأثر الفنی للشعر لتثبیت الخصال التی تقوّم السلوك وتُكسب بموجبها التطبیقات التربویة".
ومثال الخصال الحمیدة "الإخوة والوفاء لها" وتقدسیها، وقد صورها بتعبیر فنی جمیل شاعر القرن الثالث الهجری الفضل بن محمد المطلبی، وهو ینشد:
إنی لأذكر للعباس موقفهُ
بكربلاءَ وهامُ القومِ تُختطَفُ
یحمی الحسین ویحمیه على ظمأٍ
ولا یُولّی ولا یُثنى ولا یَقفُ
ولا أرى مشهداً یوماً كمشهده
مع الحسین علیه الفضل والشرفُ
أكرم به مشهداً بانت فضیلته
وما أضاع له أفعاله خَلَفُ
ففی هذه الأبیات التی تحكی موقف العباس بن علی (ع) الأخ المواسی لأخیه: "صوّر الشعر الحسینی خاصیة الإخاء وعنایة الضمیر بالوفاء للأخوة فی مأساة كربلاء تصویرا جعل منه مصدرا تربویا یقتدى به".
كاتب وموسوعة
وجد الدكتور عبد الحسین عواد ان المنهج الذی ابتدعه الفقیه آیة الله الشیخ محمد صادق الكرباسی فی تألیف موسوعة متكاملة عن النهضة الحسینیة من: "ستین بابا یستوفی الحدیث بها عن السیرة والسیاسة والأدب وعلم النفس والكیمیاء والفیزیاء والفن المعماری واللغة والعروض والصرف وغیرها من الموضوعات الأخرى"، جعلها فریدة من نوعها، وزاد فی تألقها أن الكرباسی ختم كل مجلد بقراءة نقدیة لعلم من العلماء الغرب والشرق ومن جنسیات وأدیان ومذاهب مختلفة: " وهو الأمر الذی برهن على الموضوعیة التی نأت بالنتائج عن الفئویة وجعلتها فی مدارات المنظوم العلمی العام، أی فی المنظور الذی یتعامل مع المادة العلمیة كعنصر موجود خاضع للدراسة الموضوعیة والعلمیة، وهو العامل المهم الذی ضاعف فی اهتمام الدارسین والباحثین فی مدارات المعرفة التی عرضت لها دائرة المعارف الحسینیة".
ولاشك أن مدارات المعرفة هذه: "والأطر المتعددة والمتنوعة التی انتظمت فی تألیف دائرة المعارف الحسینیة منحتها الملكة الإبداعیة والخصائص الأكادیمیة والثراء الثقافی والكم العلمی الذی برهن على ملكة المؤلف لخصائص الصبر والتأنی فی الكتابة والتألیف المتقن. وهی سمات ترتفع بالمؤلِّف والمؤلَّف الى درجة التقدیر ومن ثم الخلود والبقاء والتجدید"، وبتقدیر العواد الذی یشرف على رسائل علمیة فی الدراسات العلیا: "أثبت هذا العمل المنتظم أن المؤلف یمتلك من الإبداع الأكادیمی ما یجعله متمیزا بشهادات ذوی الخبرة العلمیة والأكادیمیة"، ولذلك فلا عجب أن ینال صاحب الموسوعة: "أربع شهادات للدكتوراه من جامعات سوریا ولبنان والولایات المتحدة الأمیركیة".
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:39|
بدر شاكر السیاب
بدر شاكر السیاب ولد عام 1926 وتوفی فی 24 كانون
أول دیسمبر عام 1964 شاعر عراقی ولد بقریة جیكور جنوب شرق البصرة. درس
الابتدائیة فی مدرسة باب سلیمان فی أبی الخصیب ثم انتقل إلى مدرسة
المحمودیة وتخرج منها فی 1 أكتوبر 1938م. ثم أكمل الثانویة فی البصرة ما
بین عامی 1938 و 1943م. ثم انتقل إلى بغداد فدخل جامعتها دار المعلمین
العالیة من عام 1943 إلى 1948م، والتحق بفرع اللغة العربیة، ثم الإنجلیزیة.
ومن خلال تلك الدراسة أتیحت له الفرصة للإطلاع على الأدب الإنجلیزی بكل
تفرعاته
البدایة السریعة على امتداد شط العرب إلى الجنوب الشرقی من البصرة، وعلى مسافة تقطعها السیارة فی خمس و أربعین دقیقة تقع أبو الخصیب التی تمثل مركز قضاء تابع للواء البصرة یضم عددا من القرى من بینها قریة لا یتجاوز عدد سكانها ألفا ومائتی نسمة
تقع على ما یسمى نهر أبو فلوس من شط العرب تدعى جیكور تسیر إلیها فی طریق ملتویة تمتد بالماشی مدى ثلاثة أرباع الساعة من أبی الخصیب وهی الزاویة الشمالیة من مثلث یضم أیضا قریتین أخریین هما بكیع وكوت بازل، قرى ذات بیوت من اللبن و الطین، لا تتمیز بشیء لافت للنظر عن سائر قرى العراق الجنوبی
فهی عامرة بأشجار النخیل التی تظلل المسارح المنبسطة ویحلو لأسراب الغربان أن تردد نعیبها فیها، و عند أطراف هذه القرى مسارح أخرى منكشفة تسمى البیادر، تصلح للعب الصبیان ولهوهم فی الربیع والخریف، وتغدو مجالا للنوارج فی فصل الصیف، فكل شخص یعمل فی الزراعة ویشارك فی الحصاد و الدراس، ویستعین على حیاته بتربیة الدجاج والأبقار، و یجد فی سوق البصرة مجالا للبیع أو المقایضة، ویحصل على السكر و البن و الشای وبعض الحاجات الضروریة الأخرى لكی ینعم فی قریته بفضائل الحضارة المادیة، وإذا كان من الطامحین إلى (الوجاهة) فلا بأس أن یفتح دیوانا یستقبل فیه الزائرین من أهل القریة أو من الغرباء لیشاركوه فی فضائل تلك الحضارة المادیة
السیاب - دراسة فی حیاته وشعره
والبلدة التی ولد الشاعر فی إحدى قراها و أكمل دراسته الأولى فیها والتی بقی یتردد إلیها طیلة عمره القصیر، برز فیها شعراء كثیرون، وان لم یشتهروا كشهرته، لضعف وسائل الأعلام ولخلود أكثرهم إلى السكینة ولعزوفهم عن النشر، نذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر الشعراء محمد محمود من مشاهیر المجددین فی عالم الشعر و النقد الحدیث، ومحمد علی إسماعیل، زمیل السیاب فی العالیة وصاحب الشعر الكثیر، وأبوه شاعر مشهور أیضا و اسمه ملا علی إسماعیل، ینظم القریض والشعر العامی، و الشاعر خلیل إسماعیل توفی فی 1961 الذی ینظم المسرحیات الشعریة ویخرجها بنفسه ویصور دیكورها بریشته
و الشاعر مصطفی كامل الیاسین الدكتور و الموظف الكبیر فی الخارجیة وعبد الستار عبد الرزاق الجمعة، وعبد الباقی لفته و عبداللطیف الدلیسی وعبدالحافظ الخصیبی ومؤید العبدالواحد الشاعر الوجدان بالرقیق ومن رواة شعر السیاب، والشاعر الأستاذ سعدی یوسف هو من أبناء أبی الخصیب، ظهرت له عدة دواوین شعریة، ونال شهرة واسعة بین شعراء البلاد العربیة، اشتهر كالسیاب بشعره الحر
ونذكر الشاعر الشعبی عبدالدایم السیاب، من أقارب الشاعر ولشعره شهرة فی المنطقة الجنوبیة، والشاعر الشعبی كذلك عدنان دكسن وهو معلم
ولد السیاب فی منطقة (بكیع) بكاف فارسیة وجیكور محلة صغیرة فیها وهی كلمة فارسیة تعنی (بیت العمیان) وتبعد عن أبی الخصیب بما یقارب الكیلوین و تقع القریة على شط العرب، وأمامها جزیرة جمیلة اسمها (الطویلة) كثیرا ما كان السیاب یقضی الساعات الطوال فیها
و نهر (بویب) الذی تغنى به الشاعر كثیرا، یسیل فی أملاك عائلة السیاب وهو یتفرع من النهر الكبیر إنها قریة صغیرة اسمها مأخوذ من العبارة الفارسیة (جوی كور) أی الجدول الأعمى
و آل السیاب یملكون أراضی مزروعة بالنخیل، وهم مسلمون سنیون عرفتهم جیكور لأجیال عدة. و على الرغم من أنهم لم یكونوا من كبار الملاكین فی جنوب العراق، فانهم كانوا یحیون حیاة لائقة محترمة حسب المعاییر المحلیة
إن أعضاء الأسرة من الذكور لا یزیدون على ثلاثین فی الوقت الحاضر مصطفى السیاب ، فی رسالة إلى المؤلف، بیروت 32 نیسان 1966 لكن الأسرة كان أكبر مما هی الیوم فی أوائل القرن التاسع عشر إذ كانت تصم عائلة المیر
لكن كثیرین من أعضائها ماتوا فی الطاعون الذی انتشر فی العراق سنة 1831 وكان سیاب بن محمد بن بدران المیر أحد أعضائها، وكان قد فقد جمیع أهله الأقربین
وكلمة سیاب بتشدیدها بضم السین أو فتحها : اسم یطلق على البلح أو البسر الأخضر. لكن قصة تروى فی العائلة تزعم أنه دعی بهذا الاسم لأنه فقد جمیع أقربائه وسیب وحیدا. وهی تلفظ سیاب فی اللهجة المحلیة بتسكین السین
وفی عام تزوج شاكر بن عبدالجبار ابنة عمه كریمة،وكانت أمیة فی السابعة عشرة من عمرها. و أسكنها معه فی دار والده على ما تقضی به العادات المرعیة. وفی 1926 ولدت له ابنا دعاه (بدرا). وقد طار به فرحا وسجل تاریخ میلاده حتى یتذكره، لكنه ما لبث أن فقده وبقی تاریخ میلاد بدر مجهول
ولم تكن إدارة البلاد فی ذلك الوقت متفرغة لتنظیم تسجیل الموالید، ولا سیما فی النواحی النائیة. وفی 1928 ولدت له ابنا ثانیا دعاه عبدالله، وفی 1930 ولدت له ابنا ثالثا دعاه مصطفى وكان فخورا بأبنائه الثلاثة، واثقا من أنهم سیكبرون ویساعدونه فی عمله لكن أحدا منهم ما ساعده كما كان ینتظر ویأمل
أما فی البیت فقد كان بدر یلعب مع أصدقائه فیشاركه أخواه الأصغران. وكان الأماكن المحببة للعبهم بیت واسع قدیم مهجور یدعى (كوت المراجیح) باللهجة المحلیة
وكان هذا البیت فی العهد العثمانی یؤوی عبید الأسرة (مصطفى السیاب، من مقابلة مع المؤلف، بیروت 41 حزیران 1966) و من هنا أسمه، إذا معنى (المراجیح) المراقیق أی الرقی أو العبید
وقد دعاه بدر فی شعره فیما بعد (منزل الأقنان) كانوا یلعبون فی فنائه بالقفز على مربعات ودوائر تخطط على الأرض وما شابه ذلك من العاب القفز، واكن یلذ لهم كذلك أن یرووا عنه قصص الأشباح. وقد جعله بدر مقرا لجریدة خطیة كان یصدرها مدة باسم (جیكور) تتناقلها أیدی صبیان القریة، ثم تعود فی ختام المطاف لتجد محلها على الحائط فی غرفة الإدارة
وتشمل ذكریاته أقاصیص جده - على نحو مبهم- وقصص العجائز من عمة وجدة وغیرهما، و من أقاصیصهما حكایة عبد الماء الذی اختطف زینب الفتاة القرویة الجمیلة، وهی تملأ جرتها من النهر، ومضى بها إلى أعماق البحر و تزوجها، و أنجبت له عددا من الأطفال، ثم رجته ذات یوم أن تزور أهلها، فأذن لها بذلك، بعد أن احتفظ بأبنائه لیضمن عودتها، و لكنها لم تعد, فأخذ یخرج من الماء وینادیها ویستثر عاطفتها نحو الأطفال، و لكنها أصرت على البقاء، و أخیرا أطلق أهلها النار على الوحش فقتلوه، أما الأطفال فتختلف روایات العجائز حول مصیرهم
كذلك تشمل ذكریاته لعبه على شاطئ بویب، وهو لا یفتأ یذكر بیتا فی بقیع یختلف عن سائر البیوت، فی أبهائه الرحبة، وحدائقه الغناء، ولكن اشد ما یجذب نظره فی ذلك المنزل الإقطاعی تلك الشناشیل، وهی شرفة مغلقة مزینة بالخشب المزخرف و الزجاج الملون
غیر أن الشاعر حین یتحدث من بعد عن بیت العائلة فی جیكور فإنما یعنی البیت الذی ولد فیه وعاش فیه سنوات طویلة فی ظل أمه، وقضى فترات متقطعة من صباه وشبابه الباكر فی جنباته، وهكذا ینبسط اسم (جیكور) على القریتین إذا لیست بقیع فی واقع الحال الا حلة من جیكور
ولابد لنا من أن نشیر إلى أن بعض الصحفیین زاروا هذا البیت فی عام 1965 وكان مما قالوه فی وصفه : البیت قدیم جدا وعال، وقد تحللت جذور البیت حتى أصبحت كأسفل القبر، والبیت ذو باب كبیر كباب حصن كتب علیه بالطباشیر اسم ؛ عبدالمجید السیاب
وهو الذی یسكن الآن فی الغرفة الوحیدة الباقیة كان البیت قبل عشر سنین یموج بالحركة والحیاة، أما سبب هجر عائلة السیاب لهذا البیت أو بالأحرى لجیكور فهو بسبب ذهاب الشباب إلى المدن بعد توظیفه" جریدة الثورة العربیة، بغداد عدد 184 - 12 شباط 1965
دخل السیاب فی أول مراحله الدراسیة مدرسة باب سلیمان الابتدائیة فی أبی الخصیب، ثم انتقل إلى المحمودیة الابتدائیة التی أسسها المرحوم محمود باشا العبدالواحد فی سنة 1910 فی العهد العثمانی، وبقیت تحمل اسمه حتى الآن و تخرج من هذه المدرسة فی تاریخ 1-10-1938 ولدى مراجعة محمود العبطة سجلات المدرسة المحمودیة ، عثر على معلومات خاصة بالشاعر نقلها من السجل رقم 6 وصفحة السجل 757 و المعلومات هی
معلومات خاصة بالشاعر
قریة جیكور المحلة
1926 تاریخ الولادة
مدرسة باب سلیما آخر مدرسة كان فیها قبل دخوله المحمودیة
1- 10 - 1936 تاریخ دخوله المدرسة
الصف الخامس الصف الذی قبل فیه
1- 10 - 1938 تاریخ الانفصال
أكمل الدراسة الابتدائیة سبب الانفصال
1937 رسب فی الصف السادس سنة
1938 نجح من السادس سنة
ابیض الوجه - أسود العینین صفاتة
جیدة أحواله الصحیة
جیدة سیرته فی المدرسة
عاش بدر طفولة سعیدة غیر إنها قصیرة سرعان ما تحطمت إذ توفیت أمه عام 1932 أثناء المخاض لتـترك أبناءها الثـلاثة وهى فی الثالثة والعشرین من عمرها. وبدا بدر الحزین یتساءل عن أمه التی غابت فجأة، وكان الجواب الوحید: ستعود بعد غد فیما یتهامس المحیطون به: أنها ترقد فی قبرها عند سفح التل عند أطراف القریة
وغابت تلك المرأة التی تعلق بها ابنها الصغیر، وكان یصحبها كلما حنت إلى أمها، فخفت لزیارتها، أو قامت بزیارة عمتها عند نهر بویب حیث تملك بستانا صغیرا جمیلا على ضفة النهر، فكان عالم بدر الصغیر تلك الملاعب التی تمتد بین بساتین جیكور ومیاه بویب وبینها ما غزل خیوط عمره ونسیج حیاته وذكریاته
وما كان أمامه سوى اللجوء إلى جدته لأبیه (أمینة) وفترة علاقته الوثیقة بأبیه بعد أن تزوج هذا من امرأة أخرى سرعان ما رحل بها إلى دار جدیدة بعیدا عن بدر وأخـویه، ومع أن هذه الدار فی بقیع أیضا، غیر أن السیاب أخویه انضموا إلى دار جده فی جیكور
القریة الأم، ویكبر ذلك الشعور فی نفس بدر بأنه محروم مطرود من دنیا الحنو الأمومی لیفر من بقیع وقسوتها إلى طرفه تدسها جدته فی جیبه أو قبلة تطبعها على خده تنسیه ما یلقاه من عنت وعناء، غیر أن العائلة تورطت فی مـشكلات كبیرة ورزحت تحت عبء الدیون، فبیعت الأرض تدریجیا وطارت الأملاك ولم یبق منها إلا القلیل یذكر بالعز القدیم الذی تشیر إلیه الآن أطلال بیت العـائلة الشاهق المتحللة
ویذهب بدر إلى المدرسة، كان علیه أن یسیر ماشیا إلى قریة باب سلیمان غرب جیكور لینتقل بعدها إلى المدرسة المحمودیة الابتدائیة للبنین فی أبی الخصیب التی شیدها محمود جلبی العبد الواحد أحد أعیان أبی الخصیب، وكان بالقرب من المدرسة البیت الفخم الذی تزینه الشرفات الخشبیة المزججة بالزجاج الملون الشناشیل و التی ستكون فیما بعد اسما لمجموعة شعریة متمیزة هی شناشیل ابنة الجلبی- الجلبی لقب للأعیان الأثریاء- وفى هذه المدرسة تعلم أن یردد مع أترابه أهزوجة یرددها أبناء الجنوب عند هطول المطر، ضمنها لاحقا فی إحدى قصائده
یا مطرا یا حلبی عبر بنات الجلبی
یا مطرا یا شاشا عبر بنات الباشا
وفى هذه المرحلة المبكرة بدأ ینظم الشعر باللهجة العراقیة الدارجة فی وصف الطبیعة أو فی السخریة من زملائه، فجذب بذلك انتباه معلمیه الذین شجعوه على النظم باللغة الفصیحة، وكانت العطلة الصیفیة التی یقضیها فی جیكور مجلبة لسروره وسعادته إذ كان بیت العبید الذی غدا الآن مهجورا، المكان المحبب للعبهم برغم ما یردده الصبیة وخیالهم الفسیح عن الأشباح التی تقطنه وكانت محبة جدته أمینة تمنحه العزاء والطمأنینة والعطف غیر انه سرعان ما فقدها إذ توفیت فی أیلول 1942 لیكتب فی رثائها قصیدة
جدتی من أبث بعدك شكوای؟
طوانی الأسى وقل معینی
أنت یا من فتحت قلبك بالأمس لحبی
أوصدت قبرك دونی
فقلیل على أن اذرف الدمع
ویقضى على طول أنینی
وتفاقم الأمر إذ باع جده ما تبقى من أملاكه مرغما، إذ وقع صغار الملاك ضحیة للمالكین الكبار و أصحاب مكابس التمر والتجار والمرابین وكان بدر یشعر بالظلم واستغلال القوى للضعیف وكانت طبیعته الرومانسیة تصور له مجتمعا مثالیا یعیش فیه الناس متساوین یتعاون بعضهم مع بعض بسلام
هذه النظرة المثالیة عمقها شعور بدر بأن أسرته كانت عرضه للظلم والاستغلال فضلا عما لحق به إذ فقد أمه وخسر أباه و أضاع جدته وسلبت حبیبته منه وكان قد بدأ یدرك انه لم یكن وسیما هذا كله احتشد فی أعماق روحه لیندلع فیما بعد مثل حمم بركان هائج تدفق شعرا ملتهبا
فی مدینة بغداد صیف 1943 أنهى بدر دراسته الثانویة، وقـبل فی دار المعلمین العالیة ببغداد (كلیة التربیة) وكان فی السابعة عشرة من عمره لیقضى فیها أربعة أعوام
وعثر (محمود العبطة) على درجات الشاعر فی الصف الثالث من الدار المذكورة فی مكتبة أبی الخصیب وبحیازة مأمورها الأستاذ عبداللطیف الزبیدی، وهی من جملة الوثائق التی أودعتها زوجة المرحوم السیاب ففی المكتبة عندما زار وفد من مؤتمر الأدباء العرب السادس ومؤتمر الشعر العربی، أبی الخصیب وقریة الشاعر جیكور وهی وریقة بحجم الكف مطبوعة على الآلة الكاتبة تشمل المعلومات التالیة
نتائج الطلبة 1946 - 1947
بدر شاكر السیاب اسم الطالب
الثالث - اللغة الإنكلیزیة الصف و الفرع
86 المعدل
ناجح الثانی فی صفه عمید دار المعلمین العالیة
كتب السیاب خلال تلك الفترة قصائد مترعة بالحنین إلى القریة والى الراعیة هالة التی احبها بعد زواج وفـیقة ویكتب قصائده العمودیة أغنیة السلوان و تحیة القریة.. الخ
ویكسب فی بغداد ومقاهیها صداقة بعض من أدبائها وینشر له ناجی العبیدی قصیدة لبدر فی جریدته الاتحاد هی أول قصیدة ینشرها بدر فی حیاته
تكونت فی دار المعلمین العالیة فی السنة الدراسیة 1944-1945 جماعة أسمت نفسها أخوان عبقر كانت تقیم المواسم و الحفلات الشعریة حیث ظهرت مواهب الشعراء الشبان، ومن الطبیعی تطرق أولئك إلى أغراض الشعر بحریة وانطلاق، بعد أن وجدوا من عمید الدار الدكتور متى عقراوی، أول عمید رئیس لجامعة بغداد و من الأساتذة العراقیین والمصریین تشجیعا
كان السیاب من أعضاء الجماعة، كما كانت الشاعرة نازك الملائكة من أعضائها أیضا، بالإضافة إلى شاعرین یعتبران المؤسسین للجماعة هما الأستاذان كمال الجبوری و الدكتور المطلبی، ولم یكن من أعضائها شعراء آخرون منهم الأستاذ حازم سعید من موالید 1924و أحمد الفخری وعاتكة وهبی الخزرجی
ویتعرف بدر على مقاهی بغداد الأدبیة ومجالسها مثل مقهى الزهاوی ومـقـهى ا لبلدیة و مقهى البرازیلیة وغیرها یرتادها مع مجموعة من الشعراء الذین غدوا فیما بعد (رواد حركة الشعر الحر) مثل بلند الحیدری وعبد الرزاق عبد الواحد ورشید یاسین وسلیمان العیسى وعبد الوهاب البیاتی وغیرهم
ویلتقی امرأة یحبها وهی لا تبادله هذا الشعور فیكتب لها
أبی.. منه جردتنی النساء
وأمی.. طواها الردى المعجل
ومالی من الدهر إلا رضاك
فرحماك فالدهر لا یعدل
ویكتب لها بعد عشرین عاما- وكانت تكبره عمرا- یقول
وتلك.. لأنها فی العمر اكبر
أم لأن الحسن أغراها
بأنی غیر كفء
خلفتنی كلما شرب الندى ورق
وفتح برعم مثلتها وشممت ریاها؟
غلام ضاو نحیل كأنه قصبة، ركب رأسه المستدیر كحبة الحنظل، على عنق دقیقة تمیل إلى الطول، وعلى جانبی الرأس أذنان كبیرتان، وتحت الجبهة المستعرضة التی تنزل فی تحدب متدرج أنف كبیر یصرفك عن تأمله العینین الصغیرین العادیتین على جانبیه فم واسع، تبز (الضبة) العلیا منه ومن فوقها الشفة بروزا یجعل انطباق الشفتین فوق صفی الأسنان كأنه عما اقتساری
وتنظر مرة أخرى إلى هذا الوجه الحنطی فتدرك أن هناك اضطرابا فی التناسب بین الفك السفلی الذی یقف عند الذقن كأنه بقیة علامة استفهام مبتورة وبین الوجنتین الناتئتین وكأنهما بدایتان لعلامتی استفهام أخریین قد انزلقتا من موضعیهما الطبیعیین
وتزداد شـهرة بدر الشاعر النحـیل القادم من أقصى قـرى الجنوب، وكانت الفتیات یستعرن الدفتر الذی یضم أشعاره لیقرأنه، فكان یتمنى أن یكون هو الدیوان :
دیوان شعر ملؤه غزل
بین العذارى بات ینتقل
أنفاسی الحرى تهیم على
صفحاته والحب والأمل
وستلتقی أنفاسهن بها
وترف فی جنباته القبل
یقو ل محمود العبطة: عندما أصدر الشاعر دیوانه الأول أزهار ذابلة فی 1947 وصدره بقصیدة من الشعر العمودی مطلعها البیت المشهور
دیوان شعر ملوْه غزل
بین العذارى بات ینتقل
اطلع علی الدیوان الشاعر التقدمی الأستاذ علی جلیل الوردی، فنظم بیتا على السجیة وقال للسیاب ، كان الأولى لك أن تقول
دیوان شعر ملوْه شعل
بین الطلیعة بات ینتقل
وفى قصیدة أخرى یقول
یا لیتنی أصبحت دیوانی
لأفر من صدر إلى ثان
قد بت من حسد أقول له
یا لیت من تهواك تهوانی
ألك الكؤوس ولى ثمالتها
ولك الخلود وأننی فانی؟
ویتعرف السیاب على شعر وود زورت وكیتس وشیلى بعد أن انتقل إلى قسم اللغة الإنجلیزیة ویعجب بشعر الیوت وادیث سیتویل ومن ثم یقرأ ترجمة لدیوان بودلیر أزهار الشر فتستهویه
ویتعرف على فتاة أضحت فیما بعد شاعرة معروفة غیر أن عائق الدین یمنع من لقائهما فیصاب بإحباط آخـر، فیجـد سلوته فی الانتماء السیاسی الذی كانت عاقبته الفـصل لعـام دراسی كامل من كلیته ومن ثم سجنه عام 1946 لفترة وجیزة
أطلق سراحه بعدها لیسجن مرة أخرى عام 1948 بعد أن صدرت مجموعته الأولى أزهار ذابلة بمقدمة كتبها روفائیل بطی أحد رواد قصیدة النثر فی العراق
عن إحدى دور النشر المصریة عام 1947 تضمنت قصیدة هل كان حبا حاول فیها أن یقوم بتجربة جدیدة فی الوزن والقافیة تجمع بین بحر من البحور ومجزوءاته أی أن التفاعیل ذات النوع الواحد یختلف عددها من بیت إلى آخر
وقد كتب روفائیل بطی مقدمة للدیوان قال فیها نجد الشاعر الطلیق یحاول جدیدا فی إحدى قصائده فیأتی بالوزن المختلف وینوع فی القافیة، محاكیا الشعر الإفرنجی، فعسى أن یمعن فی جرأته فی هذا المسلك المجدد لعله یوفق إلى أثر فی شعر الیوم، فالشكوى صارخة على أن الشعر الربی قد احتفظ بجموده فی الطریقة مدة أطول مما كان ینتظر من النهضة الحدیثة
إن هذه الباكورة التی قدمها لنا صاحب الدیوان تحدثنا عن موهبة فیه، وان كانت روعتها مخبوءة فی اثر هذه البراعم - بحیث تضیق أبیاته عن روحه المهتاجة وستكشف الأیام عن قوتها، و لا أرید أن أرسم منهجا مستقبلا لهذه القریحة الأصیلة تتفجر وتفیض من غیر أن تخضع لحدود و القیود، ولكن سیر الشعراء تعلمنا أن ذوی المواهب الناجحین، هم الذین تعبوا كثیرا، وعالجوا نفوسهم بأقصى الجهد، وكافحوا كفاح الأبطال، حتى بلغوا مرتبة الخلود
ویتخرج السیاب ویعین مدرسا للغة الإنجلیزیة فی مدرسة ثانویة فی مدینة الرمادی التی تبعد عن بغداد تسعین كیلومترا غربا، تقع على نهر الفرات. وظل یرسل منها قصائده إلى الصحف البغدادیة تباعا، وفى ینایر 1949
ألقی علیه القـبض فی جـیكور أثناء عطلة نصف السنة ونقل إلى سجن بغداد واستغنی عن خدماته فی وزارة المعارف رسمیا فى25 ینایر 1949 وافرج عنه بكفالة بعد بضعة أسابیع ومنع إداریا من التدریس لمدة عشر سنوات، فعاد إلى قریته یرجو شیئا من الراحة بعد المعاملة القاسیة التی لقیها فی السجن
ثم توجه إلى البصرة لیعمل (ذواقة) للتمر فی شركة التمور العراقیة، ثم كاتبا فی شركة نفط البصرة، وفى هذه الأیام ذاق مرارة الفقر والظلم والشقاء ولم ینشر شعرا قط، لیعود إلى بغداد یكابد البطالة یجتر نهاراته فی مقهى حسن عجمی یتلقى المعونة من أصحابه اكرم الوتری ومحی الدین إسماعیل وخالد الشواف، عمل بعدها مأمورا فی مخزن لإحدى شركات تعبید الطرق فی بغـداد
وهكذا ظل یتنقل من عمل یومی إلى آخر، وفى عام 1950 ینشر له الخاقانی مجموعته الثانیة (أساطیر) بتشجیع من أكرم الوتری مما أعاد إلى روحه هناءتها وأملها بالحیاة، وقـد تصدرتها مقدمة لبدر أوضح فیها مفهومه للشعر الجدید الذی یبشر به ویبدأ بدر بكتابة المطولات الشعریة مثل أجنحة السلام و اللعنات وحفـار القـبور و المومس العمیاء وغیرها
ویضطرب الوضع السیاسی فی بغداد عام 1952 ویخشى بدر أن تطاله حملة الاعتقالات فیهرب متخفیا إلى إیران ومنها إلى الكویت بجواز سفر إیرانی مزور باسم (على آرتنك) على ظهر سفینة شراعیة انطلقت من عبادان فی ینایر 1953، كتب عنها فیما بعد قصیدة اسمها فرار 1953 وهناك وجد له وظیفة مكتبیة فی شركة كهرباء الكویت حیث عاش حیاة اللاجئ الذی یحن بلا انقطاع إلى أهله ووطنه، وهناك كـتب أروع قصائده غریب على الخلیج یقول فیها
مازلت اضرب، مترب القدمین أشعث
فی الدروب تحت الشموس الأجنبیة
مـتخافق الأطمار
أبسط بالسؤال یدا ندیه
صفراء من ذل وحمى
ذل شحاذ غریب بین العیون الأجنبیة
بین احتقار، وانتهار، وازورار.. أوخطیه
والموت أهون من خطیه
من ذلك الإشفاق تعصره العیون الأجنبیة
قطرات ماء.. معدنیة
ویعود إلى بغداد بعد انقضاء عدة اشهر یلتقی بأصدقائه القدامى فی مقهى حسن، ویقطع صلته بالحركة السیاسیة التی كان ینتمی إلیها بعد تجربته المریرة فی الكویت مع بعض رفاقه السابقین الذین عاشوا معه فی بیت واحد. ثم یصدر أمر وزاری بتعیینه فی مدیریة الاستیراد والتصدیر العامة، ویستأجر بیتا متواضعا فی بغداد ویستدعى عمته آسیه لترعى شؤونه الیومیة
تنشر له مجلة الآداب فی یونیو 1954 أنشودة المطر تتصدرها كلمة قصیرة جاء فیها من وحی أیام الضیاع فی الكویت على الخلیج العربی ویكتب بعدها المخبر تلیها الأسلحة والأطفال وفی المغرب العربی و رؤیا فوكای و مرثیة الآلهة و مرثیة جـیكور وینشغل بالترجمة والكتـابة، وتحل سنة1955 حـیث یتزوج من إقبال شقیقة زوجة عمه عبد اللطیف، وهى معلمة فی إحدى مدارس البصرة الابتدائیة
فی العام نفسه نشر ترجماته من الشعر المعاصر فی كتاب سماه قصائد مختارة من الشعر العالمی الحدیث یحتوى على عشرین قصیدة لألیوت وستویل وباوند سبندر ودی لویس، ودی لامیر و لوركا ونیرودا ورامبو وبریفیر، وریلكه طاغـور وناظم حكمت وغیرهم
وتقوم حرب السویس اثر العدوان الثلاثی على مصر عام 1956 لیكتب بعـدها السـیـاب قصیدته بور سعید ألقاها فی اجتماع عقد فی دار المعلمین العالیة ببغداد تضامنا مع شعب مصر وفى،2 دیسمبر 1956 تولد ابنته البكر غیداء، التی ستصبح مهندسة فیما بعد
ویتعرف فی شتاء1957 على مجلة جدیدة ستلعب دورا هاما فی مرحلته الفنیة الجدیدة تلك هی مجلة (شعر) اللبنانیة كان محررها یوسف الخال وسرعان ما أصبح السیاب أحد كتابها العدیدین من دعاة التجدید فی الشعر العربی مثل أدونیس وأنسی الحاج وجبرا إبراهیم جبرا وتوفیق صایغ، لتبدأ قطیعته مع مجلة الآداب التی تبنت نتاجه المدة السابقة
وبدعـوة من المجلة الجدیدة یسافر إلى بیروت لاحیاء أمسیة شعریة تعرف خلالها على أدونیس و أنسی الحاج وشوقی أبى شقرا وفؤاد رفقه ویوسف الخال، ویعود إلى بغداد أشد ثقة بشاعریته. واكثر إحساسا بالغبن فی بلده حیث یجابه وعائلته مصاعب الحیاة براتب ضئیل
وتستهویه الأساطیر التی دلها علیه (الغصن الذهبی) لجو فریزر والذی ترجم جبرا فصلا منه، فیكتب قصائد مثل المسیح بعد الصلب و(جیكور والمدینة) و(سربروس فی بابل) و (مـدینة السندباد) وهى قصائد تمتلئ بالرموز مثل المسیح ویهوذا وتموز وعشتار وسربروس والسندباد، ویجئ یوم 23 نوفمبر 1957 لتكتحل عینا الشاعر بابنه غیلان وقد كثف بدر فرحه بمولوده فی قـصیـدته مرحى غیلان و فیها یقول :
بابا .. بابا
ینساب صوتك فی الظلام إلى كالمطر الغضیر
ینساب من خلل النعاس وأنت ترقد فی السریر
من أی رؤیا جاء؟ أی سماوة؟ أی انطلاق؟
وأظل أسبح فی رشاش منه، أسبح فی عبیر
أن أودیة العراق
فـتـحت نوافـذ من رؤاك على سهادی
كل واد
وهبته عشتار الأزاهر والثمار
كأن روحی
فی تربة الظلماء حبة حنطة
وصداك ماء أعلنت بعثی
یا سماء
هذا خلودی فی الحیاة
تكن معناه الدماء
وتأتى صبیحة 14 یولیو 1958 لتعلن عن نهایة الحكم الملكی على ید الجیش وتنسحب الجمهوریة الولیدة من حلف بغداد تركیا، إیران، باكستان، العراق وتخرج من كتلة الإسترلینی وتعلن قانون الإصلاح الزراعی وتطلق سـراح السجناء السیاسیین، ویحس بدر أن ما تمناه طویلا قد تحقق، غیر أن آمال بدر قد تهاوت اثر الانقسامات والاحترابات التی عصفت بالمجتمع آنذاك
وفى السابع من أبریل 1959 فصل من الخدمة الحكومیة لمدة ثلاث سنوات بأمر وزاری لتبدأ من جدید رحلة التشرد والفقر، كان نتاجها عدد من القصائد مثل العودة لجیكور و رؤیا فی عام 1956 و المبغى
فی یولیو 1960 یذهب إلى بیروت لنشر مجموعة من شعره هناك، وتوافق وجوده مع مسابقة مجلة شعر لأفضل مجموعة مخطوطة فدفع بها إلى المسابقة لیفوز بجائزتها الأولى (1000 ل. ل) عن مجموعته أنشودة المطر التی صدرت عن دار شعر بعد ذلك
وعاد إلى بغداد بعد أن ألغی فصله وعین فی مصلحة الموانئ العراقیة لینتقل إلى البصرة ویقطن فی دار تابعة للمصلحة فی الوقت نفسه بدأت صحته تتأثر من ضغط العمل المضنی والتوتر النفسی، غیر انه اعتقل ثانیة فی 4 فبرایر 1961 لیطلق سراحه فی 20 من الشهر نفسه، و أعید تعیینه فی المصلحة نفسها، غیر أن صحته استمرت بالتدهور فقد بدا یجد صعوبة فی تحریك رجلیه كلتیهما وامتد الألم فی القسم الأسفل من ظهره
فی 7 یولیو 1961 رزق بابنته آلاء فی وقت ساءت فیه أحواله المالیة، وغدا مثل قصبة مرضوضة. وحملته حالة العوز إلى ترجمة كتابین أمریكیین لمؤسسة فرانكلین، جرت علیـه العـدید من الاتهامـات والشكوك ثم تسلم فی العام نفسه دعوة للاشتراك فی (مؤتمر للأدب المعاصر) ینعقد فی روما برعایة المنظمة العالمیة لحریة الثقافة
ویعود إلى بفداد و من ثم إلى البصرة- محلة- المعقل- حیث الدار التی یقطنها منذ تعین فی مصلحة الموانئ، یكابد أهوال المرض إذ لم یعد قادرا على المشی إلا إذا ساعده أحد الناس ولم یعد أمامه سوى السفر وهكذا عاد إلى بیروت فی أبریل 9962 فی 18 أبریل 1962 أدخل مستشفى الجامعة الأمریكیة فی بیروت، وبعد محاولات فاشلة لتشخیص مرضه غادر المستشفى بعد أسبوعین من دخوله إلیه بعد أن كتب قصیدته الوصیة یخاطب فیها زوجته :
إقبال، یا زوجتی الحبیبه
لا تعذلینی، ما المنایا بیدی
ولست، لو نجوت، بالمخلد
كونی لغیلان رضى وطیبه
كونی له أبا و أما وارحمی نحیبه
ویزوره اكـثر من طبیب فی مرضه المیؤوس منه، وتنفد النقود التی تبرع بها أصدقاؤه له، وینشر له أصحابه دیوانه المعبد الفریق عن دار العلم للملایین لكن الدخل الضئیل الذی جناه منه لم یسد نفقات علاجه، وازدادت حاله سوءا وابتدأت فكرة الموت تلح علیه وهو ما نراه فی قصیدة نداء الموت لیعود بعدها مدمرا نهایة سبتمبر 1962 تلاحقه الدیون إلى البصرة، وتكفلت المنظمة العالمیة لحریة الثقافة بنفقاته لعام كامل بعد أن رتبت له بعثة دراسیة
یقول جبرا إبراهیم جبرا
فی أواخر عام 1961 كانت وطأة المرض فی بدء شدتها على الشاعر، حتى أخذ یفكر فی أن لابد له من علاج فی لندن قد یطول. ولما كان قد حصل على زمالة دراسیة، كان الاقتراح أن ینخرط طالبا فی جامعة إنكلیزیة للدراسة من أجل الدكتوراه
فی أثناء ذلك ینصرف أیضا لمعالجة مرضه. وكان عندها أن سعیت له مع صدیقی المفكر العربی الأصل، الأستاذ ألبرت حورانی، الأستاذ فی جامعة أكسفورد لقبوله بأسرع ما یمكن، وكان التأكید على السرعة
فأبدى الأستاذ حورانی حماسة للفكرة، و حاول أن یجد له مكانا فی الجامعة غیر أن قبوله لم یكن لیتم فی الحال - والذین حاولوا أیجاد مكان لهم فی أكسفورد یعلمون بالمدة الطویلة التی لابد من انقضائها أحیانا بین تقدیم الطلب و القبول النهائی- ولما لم یكن ثمة مجال للانتظار
ومرض بدر فی تصاعد سریع أخذ یعیق علیه سیره، استطاع الأستاذ حورانی أن یجد له قبولا فی جامعة درم وهی من جامعات شمال إنكلترا، المعروفة بدراساتها الشرقیة وفی أوائل خریف 1962 سافر در إلى إنكلترا لأول مرة والمرض یكاد یقعده، وتوجه إلى مدینة درم، وهو شدید القلق و المخاوف على حالته الصحیة .
درم مدینة جبلیة صغیرة، ابتنت شهرتا على وجود جامعة فیها هی من أفضل الجامعات البریطانیة. بید أنها رغم جمالها الطبیعی، وجمال كلیاتها التی یتباهى بعضها بروائع هندستها المعماریة، مدینة یلفها الضباب فی معظم أیام السنة، ولقربها من مناجم الفحم المحیط بها من كل صوب، یشتد فیها الضباب قتاما أیام الخریف و الشتاء لدرجة الكآبة
وفی 29 تشرین الثانی 1963 كتب قصیدة أسیر القراصنة یصف فیها حسرته لأنه مشلول، ویتمنى لو كان یستطیع المشی ویفضل ذلك على كونه شاعرا یعزف القیثار باسم الجراح ، ثم یقول لنفسه و أنت فی سفینة القرصان عبد أسیر دونما أصفاد تقبع فی خوف وإخلاد تصغی إلى صوت الوغى والطعان :
سال دم
اندقت رقاب ومال
ربانها العملاق
وقام ثان بعده ثم زال
فامتدت الأعناق
لأی قرصان سیأتی سواه
و أی قرصان ستعلو یداه
حینا على الأیدی ؟
ولیأت من بعدی
من بعدی الطوفان
تسمعها تأتیك من بعد
یحملها الإعصار عبر الزمان
وكان بدر فی غضون ذلك هدفا لحملات صحفیة بسبب تناقضاته السیاسیة فی الماضی وموقفه غیر الملتزم فی الحاضر. وكانت علاقاته بمجلة جوار و المنظمة العالمیة لحریة الثقافة تذكر ضده
وكان معظم الناس یحكم علیه أشد الحكم بناء على ما كتب أو ما كان یكتب ولكن قلائل كانوا یعلمون حقا مبلغ مرضه ومدى ضعفه، إذ كانوا لا یزالون یحسبون أنه عملاق الشعر العربی الحدیث الذی یجب أن یكون دائما عند كلمته بینما لم یكن عند بدر الا أن یندب حظه ویتحسر على عمره الضائع ویرغب فی الموت
قال فی رسالة إلى صدیق : ( لا أكتب هذه الأیام إلا شعرا ذاتیا خالصا. لم اعد ملتزما. ماذا جنیت من الالتزام؟ هذا الفقر وهذا المرض؟ لعلی أعیش هذه الایام آخر أیام حیاتی إننی أنتج خیر ما أنتجته حتى الآن. من یدری؟ لا تظن أننی متشائم، العكس هو الصحیح لكن موقفی من الموت قد تغیر
لم أعد أخاف منه، لیأت متى شاء. أشعر أننی عشت طویلا. لقد رافقت جلقامش فی مغامراته، وصاحبت عولیس فی ضیاعه، و عشت التاریخ العربی كله ألا یكفی هذا؟ تمثال السیاب
وكانت حالته الصحیة تزداد سوءا كل یوم وكاد فقد القدرة على الوقوف الآن كان طریح الفراش فی إجازة مرضیة وقد بدأت تظهر له فی منطقة الألیتین قرحة سریریة جعلت تتوسع لطول رقاده فی السریر
ولم یعد قادرا على ضبط حركتی التبول و إفراغ الأمعاء لضعف الأعصاب الاحساسیة والعضلات الضابطة فی جذعه الأسفل
ومرت بامرأته أیام عصیبة وهی تتفانى فی خدمته وتوفر أسباب الراحة له وعلى الرغم من أنه كان یتمتع بكامل قواه العقلیة فانه كان أحیانا یتهمها بعدم العطف علیه
وفی كانون الثانی 1964 سمع بدر بوفاة الشاعر لویس مكنیس، فكتب قصیدة لهذه المناسبة. ولكنه لم یستطع أن یحجم عن الإشارة إلى مرضه وغربته عن زوجته وتمنى الموت. وكان یدخن كثیرا ویأكل قلیلا جدا
واذا به فی 9 شباط 1964 فی حالة صحیة حرجة استدعت إدخاله إلى مستشفی الموانئ فی البصرة، وهو یعانی ارتفاع حرارته إلى أربعین درجة مئویة، بالإضافة إلى عسر فی التنفس مع ازرقاق الشفتین وسعال شدید
و بعد الفحص تبین أنه مصاب بذات الرئة المزدوجة وبدایة خذلان القلب، وإسهال شدید مع تقیؤ، وقرحة سریرة متعفنة قطرها 25 سنتیمترا فی المنطقة الحرقفیة، بالإضافة إلى شلل أطرافه السفلى وهزاله الشدید
فوضع مدة أسبوع كامل تحت المعالجة الخاصة بالحالات الطارئة الحرجة فی المستشفى الحكومی، وبعد أن زال الخطر عن حیاته مباشرة، وبعد أن بدأت حالة قلبه ورئتیه تتحسن عولج لإزالة الإسهال الذی كان یزید قرحته السریریة سوءا
وعندما بدأ الإسهال یزول اصبح فی الإمكان معالجة قرحته السریریة، فتحسنت حالتها و أصبحت غیر متقیحة. غیر أن التئامها بطریقة نمو الأنسجة الذاتی كان مشكوكا فیه إلا بعملیة رقع الجلد
وقد كتب بدر بهذا الشأن رسالة مؤثرة إلى توفیق صایغ یسأله فیها أن یرسل مسحوقا طبیا لجراح الناغرة و الفاغرة یشتریه له من صیدلیات بیروت
وقد أعطی بدر كمیات كبیرة من الأدویة المقویة ، فضلا عن الكمیات الإضافیة من الحلیب و اللحوم و الأسماك و الفواكه، مع العلم أنه لم یكن فی المستشفى إلا أسرة من الدرجة الثالثة التی لا تقدم لها هذه الأغذیة وبمثل هذه الكمیات
فازداد وزن بدر اكثر من ثمانیة كیلوغرامات، وبوشر باجرء تمارین ریاضیة بسطة لأطرافه السفلى. و كان الطبیب یعلم أن لا علاج لمرض التصلب المنتشر فی النخاع الشوكی المسبب للشلل، ولكنه اقترح أن ینقل بدر إلى أحد مستشفیات بغداد لیوضع تحت إشراف طبیب أخصائی بأمراض الجهاز العصبی
وفی أول نیسان 1964 انتهت المدة التی یحق لبدر فیها أن ینال إجازات مرضیة واجازات اعتیادیة براتب تام 54 دینارا عراقیا، وكذلك المدة التی یحق له فیها أن ینال إجازات مرضیة بنصف راتب، بمقتضى أحكام قانون الخدمة المدنیة رقم 24 لسنة 1960
ولكنه لم یستطع أن یغادر المستشفى لاستئناف العمل فی مصلحة الموانئ. لذلك بدأت مدة الإجازة المرضیة بدون راتب التی یسمح بها القانون، وطولها 180 یوما وفی 8 نیسان 1964 أرسلت جمعیة المؤلفین و الكتاب العراقیین ببغداد، وكان بدر عضوا فیها، رسالة إلى وزارة الصحة العراقیة تتوسط لدیها لمعالجة بدر
وجوابا على استفسارات الوزارة، أرسلت الجمعیة رسالة أخرى فی 26 نیسان 1964 فیها معلومات عن حالة بدر المرضیة و معالجته فی مستشفى الموانئ، مع رجاء حار بسرعة توفیر الأخصائیین الطبیین لمساعدة بدر
ولكن الرسمیات فی الدوائر الحكومیة طالت، بحیث أن شهر حزیران 1964 كاد ینتهی قبل أن تتخذ ترتیبات لنقل بدر بالقطار إلى بغداد لیوضع فی غرفة من الدرجة الأول ویعالج فی مستشفى الشعب ببغداد وصدرت دعوة المستشفى بتاریخ 29 حزیران 1964، ولكنها لم تصل بدرا إلى فی 5 تموز 1964
وكانت ترتیبات خاصة أخرى قد اتخذت قبل ذلك لمعالجة بدر فی الكویت وذلك أن الشاعر الكویتی علی السبتی كان قد نشر نداء موجها لوزیر الصحة الكویتی عبداللطیف محمد الثنیان یناشده فیه معالجة بدر فی الكویت على حساب الحكومة الكویتیة فرحب وزیر الصحة بذلك وكان معجبا بشعر بدر فاتخذت الترتیبات لأن یجئ بدر إلى الكویت بالطائرة لیعالج فی المستشفى الأمیری
فی 5 تموز 1964، كتب بدر كلمة شكر واعتذار على رسالة الدعوة التی جاءت من مستشفى الشعب ببغداد یشرح الترتیبات السابقة مع الحكومة الكویتیة. وفی 6 نموز طار إلى الكویت على إحدى طائرات الخطوط الجویة العراقیة وكان وحده
فاستقبله فی المطار الكویتی صدیقه علی السبتی مع أصدقاء آخرین. وادخل المستشفى الأمیری فی الحال ووضع فی غرفة خاصة و أحیط بكل عنایة واهتمام
غیر أن لا عنایة ولا اهتمام مهما حسنا كان بإمكانهما أن یعیدا الصحة لبدر فقد كانت صحته فی تأخر وانحدار متزایدین، وكان التصلب یسوء صعدا فی نخاعه الشوكی ویزید فی إفساد وظائف جهازه العصبی، وساءت حالة قرحته السریریة بفقدان الإحساس فی جذعه الأسفل وعدم قدرته على السیطرة على البراز و البول وكانت رجلاه الضامرتان بلا قوة، وقد أدى عدم استعمالهما إلى بدایة فساد فی العظام نفسها ولكنه كان متمالكا لجمیع قواه العقلیة، وكان برى أنه یعیش فی حضن الموت
و لم یكن فی حاجة لأن یقول له أحد أن أیامه كانت معدودة. لماذا إذن اذلال الجسد، ولماذا آلام الروح؟ لیأت الموت سریع، ولیأت فجأة
وفی لیلة 9 تموز 1964 كتب قصیدة عنوانها فی غابة الظلام بینما كان ساهرا یفكر بحالته الحزینة وبابنه غیلان یحلم بعودة والده، وختمها بقوله
ألیس یكفی أیها الإله
أن الفناء غایة الحیاه
فتصبغ الحیاة بالقتام ؟
سفینة كبیرة تطفو على المیاه؟
هات الردى ، أرید أن أنام
بین قبور أهلی المبعثرة
وراء لیل المقبرة
رصاصة الرحمة یا اله
لقد بلغ به الیأس مبلغا حتى أنه طلب من الله رصاصة الرحمة، طلب موتا فجائیا ینهی شقاءه برحمة
وكان یزوره فی المستشفى یومیا كثیرون من أصدقائه مثل علی السبتی وناجی علوش، وإبراهیم أبوناب وفاروق شوشه وسلمى الخضراء الجیوسی مع زوجها. وكان وزیر الصحة الكویتی وغیره من كبار الرسمیین الكویتیین یزورونه كذلك، ولم یكن بدر وحیدا ، بل أنه فی الواقع كان ینزعج أحیانا من طول جلسات الشعراء و الكتاب والصحفیین التی كانت تدوم إلى ساعات متأخرة من اللیل
وما أعظم ما كنت سعادته حین تسلم رسالة من زوجته فی 3 آب 1964، فكتب قصیدة عنوانها (رسالة) یصف فیها شعوره بالقلق على أسرته. وفی لیلة 5 آب 1964 كان یفكر مشتاقا بابنتیه غیداء وآلاء وینتظر وصولهما مع غیلان وزوجته إقبال فی الیوم التالی. فكتب قصیدة عنوانها (لیلة انتظار)، وفیها یقول :
غدا تأتین یا إقبال ، یا بعثی من العدم
ویا موتی ولا موت
ویا مرسى سفینتی التی عادت ولا لوح على لوح
ویا قلبی الذی إن مت أتركه على الدنیا لیبكینی
ویجأر بالرثاء على ضریحی وهو لا دمع ولا صوت
أحبینی ، إذا أدرجت فی كفنی .. أحبینی
ستبقى - حین یبلى كل وجهی ، كل أضلاعی
وتأكل قلبی الدیدان ، تشربه إلى القاع
قصائد .. كنت أكتبها لأجلك فی دواوینی
أحبیها تحبینی
ووصلت إقبال و أولادها إلى الكویت فی الیوم التالی ونزلوا فی بیت علی السبتی خلال اقامتهم فی الكویت. وكانت إقبال تزور زوجها فی المستشفى كل یوم فتؤنسه وتخدمه .
البدایة السریعة على امتداد شط العرب إلى الجنوب الشرقی من البصرة، وعلى مسافة تقطعها السیارة فی خمس و أربعین دقیقة تقع أبو الخصیب التی تمثل مركز قضاء تابع للواء البصرة یضم عددا من القرى من بینها قریة لا یتجاوز عدد سكانها ألفا ومائتی نسمة
تقع على ما یسمى نهر أبو فلوس من شط العرب تدعى جیكور تسیر إلیها فی طریق ملتویة تمتد بالماشی مدى ثلاثة أرباع الساعة من أبی الخصیب وهی الزاویة الشمالیة من مثلث یضم أیضا قریتین أخریین هما بكیع وكوت بازل، قرى ذات بیوت من اللبن و الطین، لا تتمیز بشیء لافت للنظر عن سائر قرى العراق الجنوبی
فهی عامرة بأشجار النخیل التی تظلل المسارح المنبسطة ویحلو لأسراب الغربان أن تردد نعیبها فیها، و عند أطراف هذه القرى مسارح أخرى منكشفة تسمى البیادر، تصلح للعب الصبیان ولهوهم فی الربیع والخریف، وتغدو مجالا للنوارج فی فصل الصیف، فكل شخص یعمل فی الزراعة ویشارك فی الحصاد و الدراس، ویستعین على حیاته بتربیة الدجاج والأبقار، و یجد فی سوق البصرة مجالا للبیع أو المقایضة، ویحصل على السكر و البن و الشای وبعض الحاجات الضروریة الأخرى لكی ینعم فی قریته بفضائل الحضارة المادیة، وإذا كان من الطامحین إلى (الوجاهة) فلا بأس أن یفتح دیوانا یستقبل فیه الزائرین من أهل القریة أو من الغرباء لیشاركوه فی فضائل تلك الحضارة المادیة
السیاب - دراسة فی حیاته وشعره
والبلدة التی ولد الشاعر فی إحدى قراها و أكمل دراسته الأولى فیها والتی بقی یتردد إلیها طیلة عمره القصیر، برز فیها شعراء كثیرون، وان لم یشتهروا كشهرته، لضعف وسائل الأعلام ولخلود أكثرهم إلى السكینة ولعزوفهم عن النشر، نذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر الشعراء محمد محمود من مشاهیر المجددین فی عالم الشعر و النقد الحدیث، ومحمد علی إسماعیل، زمیل السیاب فی العالیة وصاحب الشعر الكثیر، وأبوه شاعر مشهور أیضا و اسمه ملا علی إسماعیل، ینظم القریض والشعر العامی، و الشاعر خلیل إسماعیل توفی فی 1961 الذی ینظم المسرحیات الشعریة ویخرجها بنفسه ویصور دیكورها بریشته
و الشاعر مصطفی كامل الیاسین الدكتور و الموظف الكبیر فی الخارجیة وعبد الستار عبد الرزاق الجمعة، وعبد الباقی لفته و عبداللطیف الدلیسی وعبدالحافظ الخصیبی ومؤید العبدالواحد الشاعر الوجدان بالرقیق ومن رواة شعر السیاب، والشاعر الأستاذ سعدی یوسف هو من أبناء أبی الخصیب، ظهرت له عدة دواوین شعریة، ونال شهرة واسعة بین شعراء البلاد العربیة، اشتهر كالسیاب بشعره الحر
ونذكر الشاعر الشعبی عبدالدایم السیاب، من أقارب الشاعر ولشعره شهرة فی المنطقة الجنوبیة، والشاعر الشعبی كذلك عدنان دكسن وهو معلم
ولد السیاب فی منطقة (بكیع) بكاف فارسیة وجیكور محلة صغیرة فیها وهی كلمة فارسیة تعنی (بیت العمیان) وتبعد عن أبی الخصیب بما یقارب الكیلوین و تقع القریة على شط العرب، وأمامها جزیرة جمیلة اسمها (الطویلة) كثیرا ما كان السیاب یقضی الساعات الطوال فیها
و نهر (بویب) الذی تغنى به الشاعر كثیرا، یسیل فی أملاك عائلة السیاب وهو یتفرع من النهر الكبیر إنها قریة صغیرة اسمها مأخوذ من العبارة الفارسیة (جوی كور) أی الجدول الأعمى
و آل السیاب یملكون أراضی مزروعة بالنخیل، وهم مسلمون سنیون عرفتهم جیكور لأجیال عدة. و على الرغم من أنهم لم یكونوا من كبار الملاكین فی جنوب العراق، فانهم كانوا یحیون حیاة لائقة محترمة حسب المعاییر المحلیة
إن أعضاء الأسرة من الذكور لا یزیدون على ثلاثین فی الوقت الحاضر مصطفى السیاب ، فی رسالة إلى المؤلف، بیروت 32 نیسان 1966 لكن الأسرة كان أكبر مما هی الیوم فی أوائل القرن التاسع عشر إذ كانت تصم عائلة المیر
لكن كثیرین من أعضائها ماتوا فی الطاعون الذی انتشر فی العراق سنة 1831 وكان سیاب بن محمد بن بدران المیر أحد أعضائها، وكان قد فقد جمیع أهله الأقربین
وكلمة سیاب بتشدیدها بضم السین أو فتحها : اسم یطلق على البلح أو البسر الأخضر. لكن قصة تروى فی العائلة تزعم أنه دعی بهذا الاسم لأنه فقد جمیع أقربائه وسیب وحیدا. وهی تلفظ سیاب فی اللهجة المحلیة بتسكین السین
وفی عام تزوج شاكر بن عبدالجبار ابنة عمه كریمة،وكانت أمیة فی السابعة عشرة من عمرها. و أسكنها معه فی دار والده على ما تقضی به العادات المرعیة. وفی 1926 ولدت له ابنا دعاه (بدرا). وقد طار به فرحا وسجل تاریخ میلاده حتى یتذكره، لكنه ما لبث أن فقده وبقی تاریخ میلاد بدر مجهول
ولم تكن إدارة البلاد فی ذلك الوقت متفرغة لتنظیم تسجیل الموالید، ولا سیما فی النواحی النائیة. وفی 1928 ولدت له ابنا ثانیا دعاه عبدالله، وفی 1930 ولدت له ابنا ثالثا دعاه مصطفى وكان فخورا بأبنائه الثلاثة، واثقا من أنهم سیكبرون ویساعدونه فی عمله لكن أحدا منهم ما ساعده كما كان ینتظر ویأمل
أما فی البیت فقد كان بدر یلعب مع أصدقائه فیشاركه أخواه الأصغران. وكان الأماكن المحببة للعبهم بیت واسع قدیم مهجور یدعى (كوت المراجیح) باللهجة المحلیة
وكان هذا البیت فی العهد العثمانی یؤوی عبید الأسرة (مصطفى السیاب، من مقابلة مع المؤلف، بیروت 41 حزیران 1966) و من هنا أسمه، إذا معنى (المراجیح) المراقیق أی الرقی أو العبید
وقد دعاه بدر فی شعره فیما بعد (منزل الأقنان) كانوا یلعبون فی فنائه بالقفز على مربعات ودوائر تخطط على الأرض وما شابه ذلك من العاب القفز، واكن یلذ لهم كذلك أن یرووا عنه قصص الأشباح. وقد جعله بدر مقرا لجریدة خطیة كان یصدرها مدة باسم (جیكور) تتناقلها أیدی صبیان القریة، ثم تعود فی ختام المطاف لتجد محلها على الحائط فی غرفة الإدارة
وتشمل ذكریاته أقاصیص جده - على نحو مبهم- وقصص العجائز من عمة وجدة وغیرهما، و من أقاصیصهما حكایة عبد الماء الذی اختطف زینب الفتاة القرویة الجمیلة، وهی تملأ جرتها من النهر، ومضى بها إلى أعماق البحر و تزوجها، و أنجبت له عددا من الأطفال، ثم رجته ذات یوم أن تزور أهلها، فأذن لها بذلك، بعد أن احتفظ بأبنائه لیضمن عودتها، و لكنها لم تعد, فأخذ یخرج من الماء وینادیها ویستثر عاطفتها نحو الأطفال، و لكنها أصرت على البقاء، و أخیرا أطلق أهلها النار على الوحش فقتلوه، أما الأطفال فتختلف روایات العجائز حول مصیرهم
كذلك تشمل ذكریاته لعبه على شاطئ بویب، وهو لا یفتأ یذكر بیتا فی بقیع یختلف عن سائر البیوت، فی أبهائه الرحبة، وحدائقه الغناء، ولكن اشد ما یجذب نظره فی ذلك المنزل الإقطاعی تلك الشناشیل، وهی شرفة مغلقة مزینة بالخشب المزخرف و الزجاج الملون
غیر أن الشاعر حین یتحدث من بعد عن بیت العائلة فی جیكور فإنما یعنی البیت الذی ولد فیه وعاش فیه سنوات طویلة فی ظل أمه، وقضى فترات متقطعة من صباه وشبابه الباكر فی جنباته، وهكذا ینبسط اسم (جیكور) على القریتین إذا لیست بقیع فی واقع الحال الا حلة من جیكور
ولابد لنا من أن نشیر إلى أن بعض الصحفیین زاروا هذا البیت فی عام 1965 وكان مما قالوه فی وصفه : البیت قدیم جدا وعال، وقد تحللت جذور البیت حتى أصبحت كأسفل القبر، والبیت ذو باب كبیر كباب حصن كتب علیه بالطباشیر اسم ؛ عبدالمجید السیاب
وهو الذی یسكن الآن فی الغرفة الوحیدة الباقیة كان البیت قبل عشر سنین یموج بالحركة والحیاة، أما سبب هجر عائلة السیاب لهذا البیت أو بالأحرى لجیكور فهو بسبب ذهاب الشباب إلى المدن بعد توظیفه" جریدة الثورة العربیة، بغداد عدد 184 - 12 شباط 1965
دخل السیاب فی أول مراحله الدراسیة مدرسة باب سلیمان الابتدائیة فی أبی الخصیب، ثم انتقل إلى المحمودیة الابتدائیة التی أسسها المرحوم محمود باشا العبدالواحد فی سنة 1910 فی العهد العثمانی، وبقیت تحمل اسمه حتى الآن و تخرج من هذه المدرسة فی تاریخ 1-10-1938 ولدى مراجعة محمود العبطة سجلات المدرسة المحمودیة ، عثر على معلومات خاصة بالشاعر نقلها من السجل رقم 6 وصفحة السجل 757 و المعلومات هی
معلومات خاصة بالشاعر
قریة جیكور المحلة
1926 تاریخ الولادة
مدرسة باب سلیما آخر مدرسة كان فیها قبل دخوله المحمودیة
1- 10 - 1936 تاریخ دخوله المدرسة
الصف الخامس الصف الذی قبل فیه
1- 10 - 1938 تاریخ الانفصال
أكمل الدراسة الابتدائیة سبب الانفصال
1937 رسب فی الصف السادس سنة
1938 نجح من السادس سنة
ابیض الوجه - أسود العینین صفاتة
جیدة أحواله الصحیة
جیدة سیرته فی المدرسة
عاش بدر طفولة سعیدة غیر إنها قصیرة سرعان ما تحطمت إذ توفیت أمه عام 1932 أثناء المخاض لتـترك أبناءها الثـلاثة وهى فی الثالثة والعشرین من عمرها. وبدا بدر الحزین یتساءل عن أمه التی غابت فجأة، وكان الجواب الوحید: ستعود بعد غد فیما یتهامس المحیطون به: أنها ترقد فی قبرها عند سفح التل عند أطراف القریة
وغابت تلك المرأة التی تعلق بها ابنها الصغیر، وكان یصحبها كلما حنت إلى أمها، فخفت لزیارتها، أو قامت بزیارة عمتها عند نهر بویب حیث تملك بستانا صغیرا جمیلا على ضفة النهر، فكان عالم بدر الصغیر تلك الملاعب التی تمتد بین بساتین جیكور ومیاه بویب وبینها ما غزل خیوط عمره ونسیج حیاته وذكریاته
وما كان أمامه سوى اللجوء إلى جدته لأبیه (أمینة) وفترة علاقته الوثیقة بأبیه بعد أن تزوج هذا من امرأة أخرى سرعان ما رحل بها إلى دار جدیدة بعیدا عن بدر وأخـویه، ومع أن هذه الدار فی بقیع أیضا، غیر أن السیاب أخویه انضموا إلى دار جده فی جیكور
القریة الأم، ویكبر ذلك الشعور فی نفس بدر بأنه محروم مطرود من دنیا الحنو الأمومی لیفر من بقیع وقسوتها إلى طرفه تدسها جدته فی جیبه أو قبلة تطبعها على خده تنسیه ما یلقاه من عنت وعناء، غیر أن العائلة تورطت فی مـشكلات كبیرة ورزحت تحت عبء الدیون، فبیعت الأرض تدریجیا وطارت الأملاك ولم یبق منها إلا القلیل یذكر بالعز القدیم الذی تشیر إلیه الآن أطلال بیت العـائلة الشاهق المتحللة
ویذهب بدر إلى المدرسة، كان علیه أن یسیر ماشیا إلى قریة باب سلیمان غرب جیكور لینتقل بعدها إلى المدرسة المحمودیة الابتدائیة للبنین فی أبی الخصیب التی شیدها محمود جلبی العبد الواحد أحد أعیان أبی الخصیب، وكان بالقرب من المدرسة البیت الفخم الذی تزینه الشرفات الخشبیة المزججة بالزجاج الملون الشناشیل و التی ستكون فیما بعد اسما لمجموعة شعریة متمیزة هی شناشیل ابنة الجلبی- الجلبی لقب للأعیان الأثریاء- وفى هذه المدرسة تعلم أن یردد مع أترابه أهزوجة یرددها أبناء الجنوب عند هطول المطر، ضمنها لاحقا فی إحدى قصائده
یا مطرا یا حلبی عبر بنات الجلبی
یا مطرا یا شاشا عبر بنات الباشا
وفى هذه المرحلة المبكرة بدأ ینظم الشعر باللهجة العراقیة الدارجة فی وصف الطبیعة أو فی السخریة من زملائه، فجذب بذلك انتباه معلمیه الذین شجعوه على النظم باللغة الفصیحة، وكانت العطلة الصیفیة التی یقضیها فی جیكور مجلبة لسروره وسعادته إذ كان بیت العبید الذی غدا الآن مهجورا، المكان المحبب للعبهم برغم ما یردده الصبیة وخیالهم الفسیح عن الأشباح التی تقطنه وكانت محبة جدته أمینة تمنحه العزاء والطمأنینة والعطف غیر انه سرعان ما فقدها إذ توفیت فی أیلول 1942 لیكتب فی رثائها قصیدة
جدتی من أبث بعدك شكوای؟
طوانی الأسى وقل معینی
أنت یا من فتحت قلبك بالأمس لحبی
أوصدت قبرك دونی
فقلیل على أن اذرف الدمع
ویقضى على طول أنینی
وتفاقم الأمر إذ باع جده ما تبقى من أملاكه مرغما، إذ وقع صغار الملاك ضحیة للمالكین الكبار و أصحاب مكابس التمر والتجار والمرابین وكان بدر یشعر بالظلم واستغلال القوى للضعیف وكانت طبیعته الرومانسیة تصور له مجتمعا مثالیا یعیش فیه الناس متساوین یتعاون بعضهم مع بعض بسلام
هذه النظرة المثالیة عمقها شعور بدر بأن أسرته كانت عرضه للظلم والاستغلال فضلا عما لحق به إذ فقد أمه وخسر أباه و أضاع جدته وسلبت حبیبته منه وكان قد بدأ یدرك انه لم یكن وسیما هذا كله احتشد فی أعماق روحه لیندلع فیما بعد مثل حمم بركان هائج تدفق شعرا ملتهبا
فی مدینة بغداد صیف 1943 أنهى بدر دراسته الثانویة، وقـبل فی دار المعلمین العالیة ببغداد (كلیة التربیة) وكان فی السابعة عشرة من عمره لیقضى فیها أربعة أعوام
وعثر (محمود العبطة) على درجات الشاعر فی الصف الثالث من الدار المذكورة فی مكتبة أبی الخصیب وبحیازة مأمورها الأستاذ عبداللطیف الزبیدی، وهی من جملة الوثائق التی أودعتها زوجة المرحوم السیاب ففی المكتبة عندما زار وفد من مؤتمر الأدباء العرب السادس ومؤتمر الشعر العربی، أبی الخصیب وقریة الشاعر جیكور وهی وریقة بحجم الكف مطبوعة على الآلة الكاتبة تشمل المعلومات التالیة
نتائج الطلبة 1946 - 1947
بدر شاكر السیاب اسم الطالب
الثالث - اللغة الإنكلیزیة الصف و الفرع
86 المعدل
ناجح الثانی فی صفه عمید دار المعلمین العالیة
كتب السیاب خلال تلك الفترة قصائد مترعة بالحنین إلى القریة والى الراعیة هالة التی احبها بعد زواج وفـیقة ویكتب قصائده العمودیة أغنیة السلوان و تحیة القریة.. الخ
ویكسب فی بغداد ومقاهیها صداقة بعض من أدبائها وینشر له ناجی العبیدی قصیدة لبدر فی جریدته الاتحاد هی أول قصیدة ینشرها بدر فی حیاته
تكونت فی دار المعلمین العالیة فی السنة الدراسیة 1944-1945 جماعة أسمت نفسها أخوان عبقر كانت تقیم المواسم و الحفلات الشعریة حیث ظهرت مواهب الشعراء الشبان، ومن الطبیعی تطرق أولئك إلى أغراض الشعر بحریة وانطلاق، بعد أن وجدوا من عمید الدار الدكتور متى عقراوی، أول عمید رئیس لجامعة بغداد و من الأساتذة العراقیین والمصریین تشجیعا
كان السیاب من أعضاء الجماعة، كما كانت الشاعرة نازك الملائكة من أعضائها أیضا، بالإضافة إلى شاعرین یعتبران المؤسسین للجماعة هما الأستاذان كمال الجبوری و الدكتور المطلبی، ولم یكن من أعضائها شعراء آخرون منهم الأستاذ حازم سعید من موالید 1924و أحمد الفخری وعاتكة وهبی الخزرجی
ویتعرف بدر على مقاهی بغداد الأدبیة ومجالسها مثل مقهى الزهاوی ومـقـهى ا لبلدیة و مقهى البرازیلیة وغیرها یرتادها مع مجموعة من الشعراء الذین غدوا فیما بعد (رواد حركة الشعر الحر) مثل بلند الحیدری وعبد الرزاق عبد الواحد ورشید یاسین وسلیمان العیسى وعبد الوهاب البیاتی وغیرهم
ویلتقی امرأة یحبها وهی لا تبادله هذا الشعور فیكتب لها
أبی.. منه جردتنی النساء
وأمی.. طواها الردى المعجل
ومالی من الدهر إلا رضاك
فرحماك فالدهر لا یعدل
ویكتب لها بعد عشرین عاما- وكانت تكبره عمرا- یقول
وتلك.. لأنها فی العمر اكبر
أم لأن الحسن أغراها
بأنی غیر كفء
خلفتنی كلما شرب الندى ورق
وفتح برعم مثلتها وشممت ریاها؟
غلام ضاو نحیل كأنه قصبة، ركب رأسه المستدیر كحبة الحنظل، على عنق دقیقة تمیل إلى الطول، وعلى جانبی الرأس أذنان كبیرتان، وتحت الجبهة المستعرضة التی تنزل فی تحدب متدرج أنف كبیر یصرفك عن تأمله العینین الصغیرین العادیتین على جانبیه فم واسع، تبز (الضبة) العلیا منه ومن فوقها الشفة بروزا یجعل انطباق الشفتین فوق صفی الأسنان كأنه عما اقتساری
وتنظر مرة أخرى إلى هذا الوجه الحنطی فتدرك أن هناك اضطرابا فی التناسب بین الفك السفلی الذی یقف عند الذقن كأنه بقیة علامة استفهام مبتورة وبین الوجنتین الناتئتین وكأنهما بدایتان لعلامتی استفهام أخریین قد انزلقتا من موضعیهما الطبیعیین
وتزداد شـهرة بدر الشاعر النحـیل القادم من أقصى قـرى الجنوب، وكانت الفتیات یستعرن الدفتر الذی یضم أشعاره لیقرأنه، فكان یتمنى أن یكون هو الدیوان :
دیوان شعر ملؤه غزل
بین العذارى بات ینتقل
أنفاسی الحرى تهیم على
صفحاته والحب والأمل
وستلتقی أنفاسهن بها
وترف فی جنباته القبل
یقو ل محمود العبطة: عندما أصدر الشاعر دیوانه الأول أزهار ذابلة فی 1947 وصدره بقصیدة من الشعر العمودی مطلعها البیت المشهور
دیوان شعر ملوْه غزل
بین العذارى بات ینتقل
اطلع علی الدیوان الشاعر التقدمی الأستاذ علی جلیل الوردی، فنظم بیتا على السجیة وقال للسیاب ، كان الأولى لك أن تقول
دیوان شعر ملوْه شعل
بین الطلیعة بات ینتقل
وفى قصیدة أخرى یقول
یا لیتنی أصبحت دیوانی
لأفر من صدر إلى ثان
قد بت من حسد أقول له
یا لیت من تهواك تهوانی
ألك الكؤوس ولى ثمالتها
ولك الخلود وأننی فانی؟
ویتعرف السیاب على شعر وود زورت وكیتس وشیلى بعد أن انتقل إلى قسم اللغة الإنجلیزیة ویعجب بشعر الیوت وادیث سیتویل ومن ثم یقرأ ترجمة لدیوان بودلیر أزهار الشر فتستهویه
ویتعرف على فتاة أضحت فیما بعد شاعرة معروفة غیر أن عائق الدین یمنع من لقائهما فیصاب بإحباط آخـر، فیجـد سلوته فی الانتماء السیاسی الذی كانت عاقبته الفـصل لعـام دراسی كامل من كلیته ومن ثم سجنه عام 1946 لفترة وجیزة
أطلق سراحه بعدها لیسجن مرة أخرى عام 1948 بعد أن صدرت مجموعته الأولى أزهار ذابلة بمقدمة كتبها روفائیل بطی أحد رواد قصیدة النثر فی العراق
عن إحدى دور النشر المصریة عام 1947 تضمنت قصیدة هل كان حبا حاول فیها أن یقوم بتجربة جدیدة فی الوزن والقافیة تجمع بین بحر من البحور ومجزوءاته أی أن التفاعیل ذات النوع الواحد یختلف عددها من بیت إلى آخر
وقد كتب روفائیل بطی مقدمة للدیوان قال فیها نجد الشاعر الطلیق یحاول جدیدا فی إحدى قصائده فیأتی بالوزن المختلف وینوع فی القافیة، محاكیا الشعر الإفرنجی، فعسى أن یمعن فی جرأته فی هذا المسلك المجدد لعله یوفق إلى أثر فی شعر الیوم، فالشكوى صارخة على أن الشعر الربی قد احتفظ بجموده فی الطریقة مدة أطول مما كان ینتظر من النهضة الحدیثة
إن هذه الباكورة التی قدمها لنا صاحب الدیوان تحدثنا عن موهبة فیه، وان كانت روعتها مخبوءة فی اثر هذه البراعم - بحیث تضیق أبیاته عن روحه المهتاجة وستكشف الأیام عن قوتها، و لا أرید أن أرسم منهجا مستقبلا لهذه القریحة الأصیلة تتفجر وتفیض من غیر أن تخضع لحدود و القیود، ولكن سیر الشعراء تعلمنا أن ذوی المواهب الناجحین، هم الذین تعبوا كثیرا، وعالجوا نفوسهم بأقصى الجهد، وكافحوا كفاح الأبطال، حتى بلغوا مرتبة الخلود
ویتخرج السیاب ویعین مدرسا للغة الإنجلیزیة فی مدرسة ثانویة فی مدینة الرمادی التی تبعد عن بغداد تسعین كیلومترا غربا، تقع على نهر الفرات. وظل یرسل منها قصائده إلى الصحف البغدادیة تباعا، وفى ینایر 1949
ألقی علیه القـبض فی جـیكور أثناء عطلة نصف السنة ونقل إلى سجن بغداد واستغنی عن خدماته فی وزارة المعارف رسمیا فى25 ینایر 1949 وافرج عنه بكفالة بعد بضعة أسابیع ومنع إداریا من التدریس لمدة عشر سنوات، فعاد إلى قریته یرجو شیئا من الراحة بعد المعاملة القاسیة التی لقیها فی السجن
ثم توجه إلى البصرة لیعمل (ذواقة) للتمر فی شركة التمور العراقیة، ثم كاتبا فی شركة نفط البصرة، وفى هذه الأیام ذاق مرارة الفقر والظلم والشقاء ولم ینشر شعرا قط، لیعود إلى بغداد یكابد البطالة یجتر نهاراته فی مقهى حسن عجمی یتلقى المعونة من أصحابه اكرم الوتری ومحی الدین إسماعیل وخالد الشواف، عمل بعدها مأمورا فی مخزن لإحدى شركات تعبید الطرق فی بغـداد
وهكذا ظل یتنقل من عمل یومی إلى آخر، وفى عام 1950 ینشر له الخاقانی مجموعته الثانیة (أساطیر) بتشجیع من أكرم الوتری مما أعاد إلى روحه هناءتها وأملها بالحیاة، وقـد تصدرتها مقدمة لبدر أوضح فیها مفهومه للشعر الجدید الذی یبشر به ویبدأ بدر بكتابة المطولات الشعریة مثل أجنحة السلام و اللعنات وحفـار القـبور و المومس العمیاء وغیرها
ویضطرب الوضع السیاسی فی بغداد عام 1952 ویخشى بدر أن تطاله حملة الاعتقالات فیهرب متخفیا إلى إیران ومنها إلى الكویت بجواز سفر إیرانی مزور باسم (على آرتنك) على ظهر سفینة شراعیة انطلقت من عبادان فی ینایر 1953، كتب عنها فیما بعد قصیدة اسمها فرار 1953 وهناك وجد له وظیفة مكتبیة فی شركة كهرباء الكویت حیث عاش حیاة اللاجئ الذی یحن بلا انقطاع إلى أهله ووطنه، وهناك كـتب أروع قصائده غریب على الخلیج یقول فیها
مازلت اضرب، مترب القدمین أشعث
فی الدروب تحت الشموس الأجنبیة
مـتخافق الأطمار
أبسط بالسؤال یدا ندیه
صفراء من ذل وحمى
ذل شحاذ غریب بین العیون الأجنبیة
بین احتقار، وانتهار، وازورار.. أوخطیه
والموت أهون من خطیه
من ذلك الإشفاق تعصره العیون الأجنبیة
قطرات ماء.. معدنیة
ویعود إلى بغداد بعد انقضاء عدة اشهر یلتقی بأصدقائه القدامى فی مقهى حسن، ویقطع صلته بالحركة السیاسیة التی كان ینتمی إلیها بعد تجربته المریرة فی الكویت مع بعض رفاقه السابقین الذین عاشوا معه فی بیت واحد. ثم یصدر أمر وزاری بتعیینه فی مدیریة الاستیراد والتصدیر العامة، ویستأجر بیتا متواضعا فی بغداد ویستدعى عمته آسیه لترعى شؤونه الیومیة
تنشر له مجلة الآداب فی یونیو 1954 أنشودة المطر تتصدرها كلمة قصیرة جاء فیها من وحی أیام الضیاع فی الكویت على الخلیج العربی ویكتب بعدها المخبر تلیها الأسلحة والأطفال وفی المغرب العربی و رؤیا فوكای و مرثیة الآلهة و مرثیة جـیكور وینشغل بالترجمة والكتـابة، وتحل سنة1955 حـیث یتزوج من إقبال شقیقة زوجة عمه عبد اللطیف، وهى معلمة فی إحدى مدارس البصرة الابتدائیة
فی العام نفسه نشر ترجماته من الشعر المعاصر فی كتاب سماه قصائد مختارة من الشعر العالمی الحدیث یحتوى على عشرین قصیدة لألیوت وستویل وباوند سبندر ودی لویس، ودی لامیر و لوركا ونیرودا ورامبو وبریفیر، وریلكه طاغـور وناظم حكمت وغیرهم
وتقوم حرب السویس اثر العدوان الثلاثی على مصر عام 1956 لیكتب بعـدها السـیـاب قصیدته بور سعید ألقاها فی اجتماع عقد فی دار المعلمین العالیة ببغداد تضامنا مع شعب مصر وفى،2 دیسمبر 1956 تولد ابنته البكر غیداء، التی ستصبح مهندسة فیما بعد
ویتعرف فی شتاء1957 على مجلة جدیدة ستلعب دورا هاما فی مرحلته الفنیة الجدیدة تلك هی مجلة (شعر) اللبنانیة كان محررها یوسف الخال وسرعان ما أصبح السیاب أحد كتابها العدیدین من دعاة التجدید فی الشعر العربی مثل أدونیس وأنسی الحاج وجبرا إبراهیم جبرا وتوفیق صایغ، لتبدأ قطیعته مع مجلة الآداب التی تبنت نتاجه المدة السابقة
وبدعـوة من المجلة الجدیدة یسافر إلى بیروت لاحیاء أمسیة شعریة تعرف خلالها على أدونیس و أنسی الحاج وشوقی أبى شقرا وفؤاد رفقه ویوسف الخال، ویعود إلى بغداد أشد ثقة بشاعریته. واكثر إحساسا بالغبن فی بلده حیث یجابه وعائلته مصاعب الحیاة براتب ضئیل
وتستهویه الأساطیر التی دلها علیه (الغصن الذهبی) لجو فریزر والذی ترجم جبرا فصلا منه، فیكتب قصائد مثل المسیح بعد الصلب و(جیكور والمدینة) و(سربروس فی بابل) و (مـدینة السندباد) وهى قصائد تمتلئ بالرموز مثل المسیح ویهوذا وتموز وعشتار وسربروس والسندباد، ویجئ یوم 23 نوفمبر 1957 لتكتحل عینا الشاعر بابنه غیلان وقد كثف بدر فرحه بمولوده فی قـصیـدته مرحى غیلان و فیها یقول :
بابا .. بابا
ینساب صوتك فی الظلام إلى كالمطر الغضیر
ینساب من خلل النعاس وأنت ترقد فی السریر
من أی رؤیا جاء؟ أی سماوة؟ أی انطلاق؟
وأظل أسبح فی رشاش منه، أسبح فی عبیر
أن أودیة العراق
فـتـحت نوافـذ من رؤاك على سهادی
كل واد
وهبته عشتار الأزاهر والثمار
كأن روحی
فی تربة الظلماء حبة حنطة
وصداك ماء أعلنت بعثی
یا سماء
هذا خلودی فی الحیاة
تكن معناه الدماء
وتأتى صبیحة 14 یولیو 1958 لتعلن عن نهایة الحكم الملكی على ید الجیش وتنسحب الجمهوریة الولیدة من حلف بغداد تركیا، إیران، باكستان، العراق وتخرج من كتلة الإسترلینی وتعلن قانون الإصلاح الزراعی وتطلق سـراح السجناء السیاسیین، ویحس بدر أن ما تمناه طویلا قد تحقق، غیر أن آمال بدر قد تهاوت اثر الانقسامات والاحترابات التی عصفت بالمجتمع آنذاك
وفى السابع من أبریل 1959 فصل من الخدمة الحكومیة لمدة ثلاث سنوات بأمر وزاری لتبدأ من جدید رحلة التشرد والفقر، كان نتاجها عدد من القصائد مثل العودة لجیكور و رؤیا فی عام 1956 و المبغى
فی یولیو 1960 یذهب إلى بیروت لنشر مجموعة من شعره هناك، وتوافق وجوده مع مسابقة مجلة شعر لأفضل مجموعة مخطوطة فدفع بها إلى المسابقة لیفوز بجائزتها الأولى (1000 ل. ل) عن مجموعته أنشودة المطر التی صدرت عن دار شعر بعد ذلك
وعاد إلى بغداد بعد أن ألغی فصله وعین فی مصلحة الموانئ العراقیة لینتقل إلى البصرة ویقطن فی دار تابعة للمصلحة فی الوقت نفسه بدأت صحته تتأثر من ضغط العمل المضنی والتوتر النفسی، غیر انه اعتقل ثانیة فی 4 فبرایر 1961 لیطلق سراحه فی 20 من الشهر نفسه، و أعید تعیینه فی المصلحة نفسها، غیر أن صحته استمرت بالتدهور فقد بدا یجد صعوبة فی تحریك رجلیه كلتیهما وامتد الألم فی القسم الأسفل من ظهره
فی 7 یولیو 1961 رزق بابنته آلاء فی وقت ساءت فیه أحواله المالیة، وغدا مثل قصبة مرضوضة. وحملته حالة العوز إلى ترجمة كتابین أمریكیین لمؤسسة فرانكلین، جرت علیـه العـدید من الاتهامـات والشكوك ثم تسلم فی العام نفسه دعوة للاشتراك فی (مؤتمر للأدب المعاصر) ینعقد فی روما برعایة المنظمة العالمیة لحریة الثقافة
ویعود إلى بفداد و من ثم إلى البصرة- محلة- المعقل- حیث الدار التی یقطنها منذ تعین فی مصلحة الموانئ، یكابد أهوال المرض إذ لم یعد قادرا على المشی إلا إذا ساعده أحد الناس ولم یعد أمامه سوى السفر وهكذا عاد إلى بیروت فی أبریل 9962 فی 18 أبریل 1962 أدخل مستشفى الجامعة الأمریكیة فی بیروت، وبعد محاولات فاشلة لتشخیص مرضه غادر المستشفى بعد أسبوعین من دخوله إلیه بعد أن كتب قصیدته الوصیة یخاطب فیها زوجته :
إقبال، یا زوجتی الحبیبه
لا تعذلینی، ما المنایا بیدی
ولست، لو نجوت، بالمخلد
كونی لغیلان رضى وطیبه
كونی له أبا و أما وارحمی نحیبه
ویزوره اكـثر من طبیب فی مرضه المیؤوس منه، وتنفد النقود التی تبرع بها أصدقاؤه له، وینشر له أصحابه دیوانه المعبد الفریق عن دار العلم للملایین لكن الدخل الضئیل الذی جناه منه لم یسد نفقات علاجه، وازدادت حاله سوءا وابتدأت فكرة الموت تلح علیه وهو ما نراه فی قصیدة نداء الموت لیعود بعدها مدمرا نهایة سبتمبر 1962 تلاحقه الدیون إلى البصرة، وتكفلت المنظمة العالمیة لحریة الثقافة بنفقاته لعام كامل بعد أن رتبت له بعثة دراسیة
یقول جبرا إبراهیم جبرا
فی أواخر عام 1961 كانت وطأة المرض فی بدء شدتها على الشاعر، حتى أخذ یفكر فی أن لابد له من علاج فی لندن قد یطول. ولما كان قد حصل على زمالة دراسیة، كان الاقتراح أن ینخرط طالبا فی جامعة إنكلیزیة للدراسة من أجل الدكتوراه
فی أثناء ذلك ینصرف أیضا لمعالجة مرضه. وكان عندها أن سعیت له مع صدیقی المفكر العربی الأصل، الأستاذ ألبرت حورانی، الأستاذ فی جامعة أكسفورد لقبوله بأسرع ما یمكن، وكان التأكید على السرعة
فأبدى الأستاذ حورانی حماسة للفكرة، و حاول أن یجد له مكانا فی الجامعة غیر أن قبوله لم یكن لیتم فی الحال - والذین حاولوا أیجاد مكان لهم فی أكسفورد یعلمون بالمدة الطویلة التی لابد من انقضائها أحیانا بین تقدیم الطلب و القبول النهائی- ولما لم یكن ثمة مجال للانتظار
ومرض بدر فی تصاعد سریع أخذ یعیق علیه سیره، استطاع الأستاذ حورانی أن یجد له قبولا فی جامعة درم وهی من جامعات شمال إنكلترا، المعروفة بدراساتها الشرقیة وفی أوائل خریف 1962 سافر در إلى إنكلترا لأول مرة والمرض یكاد یقعده، وتوجه إلى مدینة درم، وهو شدید القلق و المخاوف على حالته الصحیة .
درم مدینة جبلیة صغیرة، ابتنت شهرتا على وجود جامعة فیها هی من أفضل الجامعات البریطانیة. بید أنها رغم جمالها الطبیعی، وجمال كلیاتها التی یتباهى بعضها بروائع هندستها المعماریة، مدینة یلفها الضباب فی معظم أیام السنة، ولقربها من مناجم الفحم المحیط بها من كل صوب، یشتد فیها الضباب قتاما أیام الخریف و الشتاء لدرجة الكآبة
وفی 29 تشرین الثانی 1963 كتب قصیدة أسیر القراصنة یصف فیها حسرته لأنه مشلول، ویتمنى لو كان یستطیع المشی ویفضل ذلك على كونه شاعرا یعزف القیثار باسم الجراح ، ثم یقول لنفسه و أنت فی سفینة القرصان عبد أسیر دونما أصفاد تقبع فی خوف وإخلاد تصغی إلى صوت الوغى والطعان :
سال دم
اندقت رقاب ومال
ربانها العملاق
وقام ثان بعده ثم زال
فامتدت الأعناق
لأی قرصان سیأتی سواه
و أی قرصان ستعلو یداه
حینا على الأیدی ؟
ولیأت من بعدی
من بعدی الطوفان
تسمعها تأتیك من بعد
یحملها الإعصار عبر الزمان
وكان بدر فی غضون ذلك هدفا لحملات صحفیة بسبب تناقضاته السیاسیة فی الماضی وموقفه غیر الملتزم فی الحاضر. وكانت علاقاته بمجلة جوار و المنظمة العالمیة لحریة الثقافة تذكر ضده
وكان معظم الناس یحكم علیه أشد الحكم بناء على ما كتب أو ما كان یكتب ولكن قلائل كانوا یعلمون حقا مبلغ مرضه ومدى ضعفه، إذ كانوا لا یزالون یحسبون أنه عملاق الشعر العربی الحدیث الذی یجب أن یكون دائما عند كلمته بینما لم یكن عند بدر الا أن یندب حظه ویتحسر على عمره الضائع ویرغب فی الموت
قال فی رسالة إلى صدیق : ( لا أكتب هذه الأیام إلا شعرا ذاتیا خالصا. لم اعد ملتزما. ماذا جنیت من الالتزام؟ هذا الفقر وهذا المرض؟ لعلی أعیش هذه الایام آخر أیام حیاتی إننی أنتج خیر ما أنتجته حتى الآن. من یدری؟ لا تظن أننی متشائم، العكس هو الصحیح لكن موقفی من الموت قد تغیر
لم أعد أخاف منه، لیأت متى شاء. أشعر أننی عشت طویلا. لقد رافقت جلقامش فی مغامراته، وصاحبت عولیس فی ضیاعه، و عشت التاریخ العربی كله ألا یكفی هذا؟ تمثال السیاب
وكانت حالته الصحیة تزداد سوءا كل یوم وكاد فقد القدرة على الوقوف الآن كان طریح الفراش فی إجازة مرضیة وقد بدأت تظهر له فی منطقة الألیتین قرحة سریریة جعلت تتوسع لطول رقاده فی السریر
ولم یعد قادرا على ضبط حركتی التبول و إفراغ الأمعاء لضعف الأعصاب الاحساسیة والعضلات الضابطة فی جذعه الأسفل
ومرت بامرأته أیام عصیبة وهی تتفانى فی خدمته وتوفر أسباب الراحة له وعلى الرغم من أنه كان یتمتع بكامل قواه العقلیة فانه كان أحیانا یتهمها بعدم العطف علیه
وفی كانون الثانی 1964 سمع بدر بوفاة الشاعر لویس مكنیس، فكتب قصیدة لهذه المناسبة. ولكنه لم یستطع أن یحجم عن الإشارة إلى مرضه وغربته عن زوجته وتمنى الموت. وكان یدخن كثیرا ویأكل قلیلا جدا
واذا به فی 9 شباط 1964 فی حالة صحیة حرجة استدعت إدخاله إلى مستشفی الموانئ فی البصرة، وهو یعانی ارتفاع حرارته إلى أربعین درجة مئویة، بالإضافة إلى عسر فی التنفس مع ازرقاق الشفتین وسعال شدید
و بعد الفحص تبین أنه مصاب بذات الرئة المزدوجة وبدایة خذلان القلب، وإسهال شدید مع تقیؤ، وقرحة سریرة متعفنة قطرها 25 سنتیمترا فی المنطقة الحرقفیة، بالإضافة إلى شلل أطرافه السفلى وهزاله الشدید
فوضع مدة أسبوع كامل تحت المعالجة الخاصة بالحالات الطارئة الحرجة فی المستشفى الحكومی، وبعد أن زال الخطر عن حیاته مباشرة، وبعد أن بدأت حالة قلبه ورئتیه تتحسن عولج لإزالة الإسهال الذی كان یزید قرحته السریریة سوءا
وعندما بدأ الإسهال یزول اصبح فی الإمكان معالجة قرحته السریریة، فتحسنت حالتها و أصبحت غیر متقیحة. غیر أن التئامها بطریقة نمو الأنسجة الذاتی كان مشكوكا فیه إلا بعملیة رقع الجلد
وقد كتب بدر بهذا الشأن رسالة مؤثرة إلى توفیق صایغ یسأله فیها أن یرسل مسحوقا طبیا لجراح الناغرة و الفاغرة یشتریه له من صیدلیات بیروت
وقد أعطی بدر كمیات كبیرة من الأدویة المقویة ، فضلا عن الكمیات الإضافیة من الحلیب و اللحوم و الأسماك و الفواكه، مع العلم أنه لم یكن فی المستشفى إلا أسرة من الدرجة الثالثة التی لا تقدم لها هذه الأغذیة وبمثل هذه الكمیات
فازداد وزن بدر اكثر من ثمانیة كیلوغرامات، وبوشر باجرء تمارین ریاضیة بسطة لأطرافه السفلى. و كان الطبیب یعلم أن لا علاج لمرض التصلب المنتشر فی النخاع الشوكی المسبب للشلل، ولكنه اقترح أن ینقل بدر إلى أحد مستشفیات بغداد لیوضع تحت إشراف طبیب أخصائی بأمراض الجهاز العصبی
وفی أول نیسان 1964 انتهت المدة التی یحق لبدر فیها أن ینال إجازات مرضیة واجازات اعتیادیة براتب تام 54 دینارا عراقیا، وكذلك المدة التی یحق له فیها أن ینال إجازات مرضیة بنصف راتب، بمقتضى أحكام قانون الخدمة المدنیة رقم 24 لسنة 1960
ولكنه لم یستطع أن یغادر المستشفى لاستئناف العمل فی مصلحة الموانئ. لذلك بدأت مدة الإجازة المرضیة بدون راتب التی یسمح بها القانون، وطولها 180 یوما وفی 8 نیسان 1964 أرسلت جمعیة المؤلفین و الكتاب العراقیین ببغداد، وكان بدر عضوا فیها، رسالة إلى وزارة الصحة العراقیة تتوسط لدیها لمعالجة بدر
وجوابا على استفسارات الوزارة، أرسلت الجمعیة رسالة أخرى فی 26 نیسان 1964 فیها معلومات عن حالة بدر المرضیة و معالجته فی مستشفى الموانئ، مع رجاء حار بسرعة توفیر الأخصائیین الطبیین لمساعدة بدر
ولكن الرسمیات فی الدوائر الحكومیة طالت، بحیث أن شهر حزیران 1964 كاد ینتهی قبل أن تتخذ ترتیبات لنقل بدر بالقطار إلى بغداد لیوضع فی غرفة من الدرجة الأول ویعالج فی مستشفى الشعب ببغداد وصدرت دعوة المستشفى بتاریخ 29 حزیران 1964، ولكنها لم تصل بدرا إلى فی 5 تموز 1964
وكانت ترتیبات خاصة أخرى قد اتخذت قبل ذلك لمعالجة بدر فی الكویت وذلك أن الشاعر الكویتی علی السبتی كان قد نشر نداء موجها لوزیر الصحة الكویتی عبداللطیف محمد الثنیان یناشده فیه معالجة بدر فی الكویت على حساب الحكومة الكویتیة فرحب وزیر الصحة بذلك وكان معجبا بشعر بدر فاتخذت الترتیبات لأن یجئ بدر إلى الكویت بالطائرة لیعالج فی المستشفى الأمیری
فی 5 تموز 1964، كتب بدر كلمة شكر واعتذار على رسالة الدعوة التی جاءت من مستشفى الشعب ببغداد یشرح الترتیبات السابقة مع الحكومة الكویتیة. وفی 6 نموز طار إلى الكویت على إحدى طائرات الخطوط الجویة العراقیة وكان وحده
فاستقبله فی المطار الكویتی صدیقه علی السبتی مع أصدقاء آخرین. وادخل المستشفى الأمیری فی الحال ووضع فی غرفة خاصة و أحیط بكل عنایة واهتمام
غیر أن لا عنایة ولا اهتمام مهما حسنا كان بإمكانهما أن یعیدا الصحة لبدر فقد كانت صحته فی تأخر وانحدار متزایدین، وكان التصلب یسوء صعدا فی نخاعه الشوكی ویزید فی إفساد وظائف جهازه العصبی، وساءت حالة قرحته السریریة بفقدان الإحساس فی جذعه الأسفل وعدم قدرته على السیطرة على البراز و البول وكانت رجلاه الضامرتان بلا قوة، وقد أدى عدم استعمالهما إلى بدایة فساد فی العظام نفسها ولكنه كان متمالكا لجمیع قواه العقلیة، وكان برى أنه یعیش فی حضن الموت
و لم یكن فی حاجة لأن یقول له أحد أن أیامه كانت معدودة. لماذا إذن اذلال الجسد، ولماذا آلام الروح؟ لیأت الموت سریع، ولیأت فجأة
وفی لیلة 9 تموز 1964 كتب قصیدة عنوانها فی غابة الظلام بینما كان ساهرا یفكر بحالته الحزینة وبابنه غیلان یحلم بعودة والده، وختمها بقوله
ألیس یكفی أیها الإله
أن الفناء غایة الحیاه
فتصبغ الحیاة بالقتام ؟
سفینة كبیرة تطفو على المیاه؟
هات الردى ، أرید أن أنام
بین قبور أهلی المبعثرة
وراء لیل المقبرة
رصاصة الرحمة یا اله
لقد بلغ به الیأس مبلغا حتى أنه طلب من الله رصاصة الرحمة، طلب موتا فجائیا ینهی شقاءه برحمة
وكان یزوره فی المستشفى یومیا كثیرون من أصدقائه مثل علی السبتی وناجی علوش، وإبراهیم أبوناب وفاروق شوشه وسلمى الخضراء الجیوسی مع زوجها. وكان وزیر الصحة الكویتی وغیره من كبار الرسمیین الكویتیین یزورونه كذلك، ولم یكن بدر وحیدا ، بل أنه فی الواقع كان ینزعج أحیانا من طول جلسات الشعراء و الكتاب والصحفیین التی كانت تدوم إلى ساعات متأخرة من اللیل
وما أعظم ما كنت سعادته حین تسلم رسالة من زوجته فی 3 آب 1964، فكتب قصیدة عنوانها (رسالة) یصف فیها شعوره بالقلق على أسرته. وفی لیلة 5 آب 1964 كان یفكر مشتاقا بابنتیه غیداء وآلاء وینتظر وصولهما مع غیلان وزوجته إقبال فی الیوم التالی. فكتب قصیدة عنوانها (لیلة انتظار)، وفیها یقول :
غدا تأتین یا إقبال ، یا بعثی من العدم
ویا موتی ولا موت
ویا مرسى سفینتی التی عادت ولا لوح على لوح
ویا قلبی الذی إن مت أتركه على الدنیا لیبكینی
ویجأر بالرثاء على ضریحی وهو لا دمع ولا صوت
أحبینی ، إذا أدرجت فی كفنی .. أحبینی
ستبقى - حین یبلى كل وجهی ، كل أضلاعی
وتأكل قلبی الدیدان ، تشربه إلى القاع
قصائد .. كنت أكتبها لأجلك فی دواوینی
أحبیها تحبینی
ووصلت إقبال و أولادها إلى الكویت فی الیوم التالی ونزلوا فی بیت علی السبتی خلال اقامتهم فی الكویت. وكانت إقبال تزور زوجها فی المستشفى كل یوم فتؤنسه وتخدمه .
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:38|
ان كل انسان یستطیع ان یحكی لك حكایه او یقص علیك حادثه فی
الطریق او وقعت له ، ای ان الاستعداد القصصی خاصیه انسانیه یشترك فیها جمیع
الناس ، ولكن كاتب القصه یختلف عن كل انسان فی انه ینظر الى الاشیاء
الواقعه نظره خاصه . فهو لایقف منها عندالسطح ، ولكنه یتعمقها و یفرز علیها
من افكاره و خیاله ، ویجعل لها تكوینا ً آ خر و فلسفه اخرى ، ثم هو یختزن
كل ذلك فی نفسه لیستقله فی یوم من الایام .
وحین یعود لنفسه لیستمد من ذلك المخزون فإنه لا یستمدمنه اعباطا ً و لكنه یستمد ماله اهمیه خاصه .
لذلك كانت مادة العمل القصص الناجح دائما ماده لها هذه الصفه , صفة الاهمیه .
و لیس كل القصص التی تتناول الحوادث الكبیره ذا قیمه ادبیه , و لكن القیمه تأتی من ان الكاتب قد تعمق هذه الحادثه و نظر إلیها من جوانبها المتعدده .
و بعباره عامه نقول : قد اكسبها قیمه انسانیه خاصه .
و اذا قلنا ان الكاتب یختار الحادثه المهمه -- صغیره كانت ام كبیره -- فاننا نقدر قیمة الاختیار فی العمل الادبی .
(( و تدل كتب الامثال على ان العرب عرفوا فن القصه منذ اقدم العصور و كانت القصه فی اول امرها عباره عن اخبار تروى ,
تمتزج فیها الحقیقه بالخیال و التاریخ بالاسطوره .
و حین ظبطت الروایه و احكمت شروطها , و كثر التدوین فی العلوم الانسانیه ,
تمیزت الاخبار عن التاریخ ,
فحفلت كتب الادب بالاخبار عن المشاهیر و غیر المشاهیر .
ولم یقصد بهذا النوع اعلام القارئ بحقیقه تاریخیه , انم تساق فی ثنایا الكتب للتفكه حینا و للعضه حینا آخر .
و یعزى فضل الریاده فی هذا الفن الى كاتب مصری هو محمد تیمور و آخر لبنانی هو میخائیل نعیمه ))
.. تعریف القصه و الحكایه ..
القصــــــــــــــه :
سرد واقعی او خیالی قد یكون نثراً او شعرا ً یقصد به اثارة الاهتمام و الامتاع
او تثقیف السامعین و القراء .
و یقول ( روبرت لویس ستیفنسون ) و هو من رواد القصص المرموقین :
لیس هناك إلا ثلاث طرق لكتابة القصه , فقد یأخذ الكاتب الحبكه ثم یجعل الشخصیات ملائمه لها , او یأخذ شخصیه و یختار الاحداث و المواقف التی تنمی تلك الشخصیه , او قد یأخذ جوا ً معینا ً و یجعل الفعل و الاشخاص تعبر عنه و تجسده .
تعریفات حول القصه و الحكایه
القصه القصیره :سرد قصصی قصیر نسبیا ً ( قد یقل عن عشرة آلاف كلمه ) یهدف الى احداث تأثیر مهیمن و یمتلك عناصر الدراما . وفی اغلب الاحیان ترتكز القصه القصیره على شخصیه واحدة فی موقف واحد فی لحضه واحدة .
و حتى اذا لم تتحقق هذه الشروط فلا بد ان تكون الوحده هی المبدأ الموجهه لها. و الكثیر من القصص القصیره تتكون من شخصیه ( او مجموعه من شخصیات ) تقدم فی مواجهة خلفیه او وضع , و تنغمس خلا الفعل الذهنی او الفیزیائی فی موقف .
و هذا الصراع الدرامی ای اصطدام قوه متضادة ماثل فی قلب الكثیر من القصص القصیرة الممتازة .
فالتوتر من العناصر البنائیه للقصه القصیره كما ان تكامل الانطباع من سمات تلقیها بالاضافه الى انها كثیرا ً ما تعبر عن صوت منفرد لواحد من جماعه مغموره .
# ویذهب بغض الباحثین الى الزعم بأن القصه القصیره قد وجدت طوال التاریخ بأشكال مختلفه مثل قصص العهد القدیم عن الملك داوود , و سیدنا یوسف و راعوث , و كانت الأحدوثه و قصص القدوة الاخلاقیه فی زعمهم هی اشكال العصر الوسیط للقصه القصیره .
و لكن الكثیر من الباحثین یعتبرون ان المسأله اكبر من اشكالمختلفه للقصه القصیره , فذلك الجنس الادبی یفترض تحرر الفرد العادی من ربقة التبعیات القدیمه و ظهوره كذات فردیه مستقله تعی حریاتها الباطنه فی الشعور و التفكیر , و لها خصائصها الممیزه لفردیتها على العكس من الانماط النموذجیه الجاهزه التی لعبت دور البطوله فی السرد القصصی القدیم .
# و یعتبر ( إدجار الن بو ) من رواد القصة القصیرة الحدیثة فی الغرب .
وقد ازدهر هذا اللون من الادب فی انحاء العالم المختلفه , طوال قرن مضى على ایدی ( موباسان وزولا وتورجنیف و تشیخوف و هاردی و ستیفنسن ) , و مئات من فنانی القصه القصیره .
وفی العالم العربی بلغت القصة القصیرة درجه عالیه من النضج على ایدی
یوسف ادریس فی مصر , و زكریا تامر فی سوریا , و محمد المر فی دولة الامارات .
# ان للقصه القصیره انواع او انماط عدیده ..
اذكر بعضها للفائده .. و هی الانماط الاكثر تداولا ً و انتشارا ً
1= المیثو لوجیـــــــــــــا ..
هو مزج بین الاساطیر و الزمن المعاصر .. دون التأثر بما شكلته لنا الاساطیر من سحر و جمال .. او حتى التقید بازمنتها و امكنتها .
2= التسجیلیـــــــــــــــــة ..
لا تعنی الخواطر و الوجدانیات .. او حتى الكتابه الانشائیه .. بل هی قصص فی اطارها المألوف .. و لكن بإضافات ابداعیه جدیده .. تتضمن للكاتب الحریه و الوجدانیه معا ً .
3= السیكولوجیـــــــــــــة ..قصص .. تطمح الى تصویر الانسان ..و عكس افكاره الداخلیه .. تصل الى المستوى النفسی للانسان .. و تفند احاسیسه ومشاعره .. وتتكلم دائما عن اشیاء خفیه فی النفس البشریه .
4= الفانتازیــــــــــــــــــــا ..اعتبره اشرس انواع القصة القصیرة .. فهو ذو طابع متمرد .. متمیز بالغربه و الضیاع .. هو اسلوب ثوری على الاسالیب التقلیدیه .. وخروج غیر مألوف عن الدارج بحیث یطغى على الماده .. یهدف كاتب هذه النوعیه من القصص الى ابراز مدى الفوضه الفكریه و الحضاریه .. لدى انسان هذا العصر .. و حیاته .. فهو یرفض التقلید او الرضوخ للواقع .
الحكـــــــــــــــــــــایة :
سرد قصصی یروی تفصیلات حدث واقعی او متخیل , وهو ینطبق عادة ً على القصص القصیره ذات الحبكه المتراخیة الترابط -- مثل : حكایة الف لیلة و لیلة .
الحكــــــــایة الشعبیــــــــــــه :خرافه ( او سرد قصصی ) تضرب جذورها فی اوساط شعب و تعد من مأثوراته التقلیدیة . وخاصه فی التراث الشفاهی .
و یغطی المصطلح مدى ً واسعا ً من المواد ابتداء ً من الاساطیر السافرة الى حكایات الجن .
و تعد الف لیلة و لیلة مجموعة ذائعة الشهره من هذه الحكایات الشعبیه .
عناصـــــــــر العمــــــــل القصصــــــــی :
1-- الحـــــــــادثة :الحادثه فی العمل القصصی مجموعه من الوقائع الجزئیه مرتبطه و منظمه على نحو خاص و هو مایمكن ان نسمیه ( الأطار ) , ففی كل القصص یجب ان تحدث أشیاء فی نظام معین , وكما انه یجب ان تحدث اشیاء فأن النظام هو الذی یمیز أطار عن الآخر , فالحوادث تتبع خطا فی قصة و خطا آخر فی قصه أخرى .
و الحادثه الفنیه هی تلك السلسله من الوقائع المسروده سردا فنیا , التی یضمها اطار خاص .
واذا كنا هنا نتحدث عن عنصر الحادثه فینبغی ان نذكر بأن هناك نوعا ً من
القصص یعنى عنایة خاصة بالحادثة و سردها و تقل عنایته بالعناصر القصصیه الاخرى . و یسمى هذا النوع ( قصة الحادثه ) او ( القصة السردیة ) وفی القصة السردیة تكون ( الحركة ) هی الشئ الرئیسی .
فالحركه عنصر أساسی فی العمل القصصی و هی نوعان : حركة عضویة , و حركة ذهنیة .
و الحركة العضویة تتحقق فی الاحداث التی تقع , و فی سلوك الشخصیات , وهی بذلك تعد تجسیما ً للحركه الذهنیه التی تتمثل فی تطور الفكره العامه نحو الهدف الذی تهدف الیه القصة .
2 -- الســـــــــــــرد :هو نقل الحادثه من صورتها الواقعه الى صوره لغویه , فحین نقرأ مثلا ً
(( و جرى نحو الباب و هو یلهث , و دفعه فی عنف , و لكن قواه كانت قد خارت , فسقط خلف الباب من الأعیاء )) ..
نلاحظ الافعال >> جرى , یلهث , خار , سقط .. فهذه الافعال هی التی تكون فی اذهاننا جزیئات الواقعه , و لكن السرد الفنی لا یكتفی عادة بالافعال كما یحدث فی كتابة التاریخ , بل نلاحظ دائما ان السرد الفنی یستخدم العنصر النفسی الذی یصور به هذه الافعال
(( وهو یلهث , فی عنف , من الاعیاء --- فی المثال السابق )) وهذا نتج شأنه ان یكسب السرد حیویة , ویجعله لذلك فنیا ً .
و لكاتب القصة ان یختار كیفیة كتابة قصته من بین ثلاث طرق :
الطریقة المباشرة او الملحمیة , وطریقة السرد الذاتی , و طریقة الوثائق .
الطریقه الاولى مألوفه اكثر من غیرها و فیها یكون الكاتب مؤوخا یسرد من الخارج .
و فی الطریقة الثانیة یكتب على لسان المتكلم . وهو بذلك یجعل من نفسه و أحد شخوص القصه شخصیه واحدة . و هو بذلك یقدم ترجمه ذاتیه خیالیه .
وفی الطریقه الثالثة تتحقق القصه عن طریق الخطابات او الیومیات او الحكایات و الوثلئق المختلفة .
3 -- البنــــــــــــــــــاء :هناك صور عده لبناء الحادثه القصصیة بناء ً فنیا ً , و یمكن ان یقال ان كل قصة لها صوره بنائیه خاصه بها , و مع ذلك فقد امكن ضبط مجموعه من الصور البنائیه العامه , وهناك -- بصفه عامه -- صورتان لبناء الحبكه القصصیة هما :
صورة البناء و الصورة العضویه ,
وفی الاولى لاتكون بین الوقائع علاقه كبیره ضروریه او منتضمه . و عند اذن تعتمد وحدة السرد على شخصیة البطل الذی یربط بشخصه النواه الشخصیه المركزیه بین العناصر المتفرقه . و قصص المغامرات بعامه تمثل هذا النوع .
اما فی الصوره البنائیه العضویه فأن القصه مهما امتلات بالحوادث الجزئیه المنفصله الممتعه فأنها تتبع ( تصمیما ) عاما معقولا و فی خلال هذا التصمیم تقوم كل حادثه تفصیلیه بدور حیوی واضح .
فهناك شئ اكثر من مجرد الفكره العامه فی سیر القصه , فالخطه كلها لابد ان تعد بصوره مفصله , وان تنضم الشخصیات و الحوادث بحیث تشغل اماكنها المناسبه , وان تؤدی كل الخطوط الى النهایه .
و ینبغی ان یكون واضحا ً ان الصوره البنائیه تختلف من نوع قصصی الى آخر ,
فالصوره البنائیه التی تتمثل فی الروایه لا یمكن ان تصلح لبناء قصه قصیره . او ابسط صوره لبناء القصه -- و هی الصوره المأ لوفه بصفه عامه -- هی تلك التی تتمثل بین طرفی الصراع , و هما الهدف و النتیجه .
4 -- الشخصیـــــــــــــة : القصه معرض لأشخاص جدد یقابلهم القارئ لیتعرف علیهم و یتفهم دورهم , و یحدد موقفهم .
و طبیعی انه من الصعب ان نجد بین انفسنا و الشخصیه التی لم نعرفها ولم نفهمها نوعا ً من التعاطف . ومن هنا كانت اهمیة التشخیص فی القصه , فقبل ان یستطیع الكاتب ان یخعل القارئ یتعاطف وجدانیا ً مع الشخصیه , یجب ان تكون هذه الشخصیه حیه . فالقارئ یرید ان یراها وهی تتحرك , و ان یسمعها وهی تتكلم , یرید ان یتمكن من رؤاها رؤى العین .
و هناك نوعا ً من القصص یسمى ( قصة الشخصیة ) و یكون فیها الاهتمام بالشخصیه اولا ً و من ثم الحادثه .
و هناك ایضا ً انواع للشخصیات ذاتها فی القصه :
( الشخصیه الجاهزه ) وهی الشخصیة المكتملة التی تظهر فی القصه -- حین تظهر -- دون ان یحدث فی تكوینها ای تغیر ,
و انما یكون التغیر فی علاقتها بالشخصیات الآخرى فحسب . ای تصرفاتها لها طابع واحد .
النوع الثانی ( الشخصیة النامیة )وهی الشخصیة التی یتم تكوینها بتمام القصة , فتتطور من موقف الى موقف , وفی كل موقف یكون لها تصرف جدید یكشف لنا جانبا ً منها .
و الذوق الحدیث یفضل النوع الثانی من الشخصیة كما انه لكل قصّـاص طریقته الخاصه فی رسم الشخصیات ,
فبعضهم یستعیتن بوصف الملامح الخارجیه او الداخلیه او هما معا ً , وبعضهم یدع الحوادث و الحركات ترسمهـــــــــــــا .
5 -- الزمــــان و المكــــان :كل حادثه تقع لابد ان تقع فی مكان معین وفی الزمان ذاته , و هی بذلك ترتبط بظروف وعادات و مبادئ خاصه بالزمان و المكان اللذین وقعت فیهما , الارتباط بكل ذلك ضروری لحیویة القصة , لانه یمثل البطانه النفسیة للقصة , و یسمى هذا العنصر (( SETTING )) , و یقوم بالدور الذی تقوم به المناظر على المسرح بوصفها شیئا ً مرئیا ً یساعد خیال القارئ .
و تزداد عندما یساعد على فهم الحاله النفسیه للقصة او الشخصیة , فهو هنا یقوم بنفس الدور الذی تقوم به الموسیقى المصاحبه للمسرحیه او القصه السینمائیه ,
واخیرا ً یصبح التصویر مهما ً احیانا حتى انه یكاد ان یقوم بدور الممثل فی القصة , او تكون له قوه درامیه .
6 -- الفكــــــــــــــــــــــرة :یتحدث القارئ المتوسط عن ( الأطار ) فی القصه , وهو عادة ًیعنی بذلك ماذا حدث ؟ , وعندما نحلل القصه لایكون لهذا السؤال من اهمیه مایكون سؤالنا : لماذا حدث ؟ صحیح ان نهایة كل قصة تعطی نوعا ً من النتیجه فهناك شئ یحدث فعلا ً و لكن اسباب هذه النتیجه اكثر اهمیه من الحوادث الواقعه ذاتها .
فخلف الحوادث یقع المعنى , و هذا المعنى یقبله القارئ و یرفضه معتمدا ً على ما اذا كان المؤلف قادرا ً على اقناعه بأن النتیجه تتفق مع خبرته بالحیاه او الحیاه كما یصورها المؤلف .
فالقصة إذا ً انما تحدث لتقول شیئا ً , لتقرر فكره .. فالفكره هی الاساس الذی یقوم علیه البناء الفنی للقصة .
و الموضوع الذی تبنى علیه القصة لایكون دائما ً ایجابیا فی اثره
فمع انه یجب ان یقرر بطریقه مباشره او غیر مباشره عن الحیاة او السلوك الانسانی فإنه غیر محتاج لأن یحل مشكله .
وقد بین كاتب القصة الروسی العضیم ( تشیكوف ) لصدیق شاب ان هناك فرقا بین حل المشكله و وضعها وضعا ً صحیحا ً ,
فیكفی الفنان ان یصور مشكلته تصویرا ً صحیحا ً .
وحین نبحث عن سبب اعجابنا بقصة قرأناها سنجد ان فكرتها كان لها اثر فی هذا الاعجاب ,
ولكن هل نقرأ العمل الفنی لفكرته و حسب ؟
ان القصة هی صورة الحیاة و نحن نعرف الحیاة معرفه جیدة
و ننتظر من القصة دائما ً ان تكون صادقه حیه , مقنعة كالحیاة الواقعه , و لكن القصة تمتاز عن الحیاة بأن لها صوره فنیه خاصة فالكاتب یقدم لنا قصه -- و قصة بالذات -- حین یقدم لنا فكرة , كما ان مصدر اعجابنا لایمكن ان یحدد دائما ً بقاعدة لأننا فی كل قصه یـُــكشف لنا شئ جدید
و لكن من المؤكد ان القصه -- ككل عمل فنی -- لا یتحدد لها شكل حتى تتحقق فیها فكرة الكــــــــــــــــاتب .
>>>> الانواع القصصیه الرئیسیة هی .. ..الأقصوصه , القصة القصیرة , القصة , الروایه .. ..
ویغلو بعض كتاب القصص فی هذه الایام فی اتجاهیین :
الاتجاه الى الصراع الاجتماعی , و الاتجاه الى التحلیل النفسی , و لیس لنا ای اعتراض على ای اتجاه , مادام لایؤثر فی سمة العمل الانسانیه ولایطغى على الحقائق الفنیه .
(((( المصادر )))) :
التحلیل الأدبی
المعاجم العربیة
معجم المصطلحات الأدبیه / إبراهیم فتحی
الأدب و فنونه / عز الدین إسماعیل
النقد الأدبی : أصوله و مناهجة / سید قطب
وحین یعود لنفسه لیستمد من ذلك المخزون فإنه لا یستمدمنه اعباطا ً و لكنه یستمد ماله اهمیه خاصه .
لذلك كانت مادة العمل القصص الناجح دائما ماده لها هذه الصفه , صفة الاهمیه .
و لیس كل القصص التی تتناول الحوادث الكبیره ذا قیمه ادبیه , و لكن القیمه تأتی من ان الكاتب قد تعمق هذه الحادثه و نظر إلیها من جوانبها المتعدده .
و بعباره عامه نقول : قد اكسبها قیمه انسانیه خاصه .
و اذا قلنا ان الكاتب یختار الحادثه المهمه -- صغیره كانت ام كبیره -- فاننا نقدر قیمة الاختیار فی العمل الادبی .
(( و تدل كتب الامثال على ان العرب عرفوا فن القصه منذ اقدم العصور و كانت القصه فی اول امرها عباره عن اخبار تروى ,
تمتزج فیها الحقیقه بالخیال و التاریخ بالاسطوره .
و حین ظبطت الروایه و احكمت شروطها , و كثر التدوین فی العلوم الانسانیه ,
تمیزت الاخبار عن التاریخ ,
فحفلت كتب الادب بالاخبار عن المشاهیر و غیر المشاهیر .
ولم یقصد بهذا النوع اعلام القارئ بحقیقه تاریخیه , انم تساق فی ثنایا الكتب للتفكه حینا و للعضه حینا آخر .
و یعزى فضل الریاده فی هذا الفن الى كاتب مصری هو محمد تیمور و آخر لبنانی هو میخائیل نعیمه ))
.. تعریف القصه و الحكایه ..
القصــــــــــــــه :
سرد واقعی او خیالی قد یكون نثراً او شعرا ً یقصد به اثارة الاهتمام و الامتاع
او تثقیف السامعین و القراء .
و یقول ( روبرت لویس ستیفنسون ) و هو من رواد القصص المرموقین :
لیس هناك إلا ثلاث طرق لكتابة القصه , فقد یأخذ الكاتب الحبكه ثم یجعل الشخصیات ملائمه لها , او یأخذ شخصیه و یختار الاحداث و المواقف التی تنمی تلك الشخصیه , او قد یأخذ جوا ً معینا ً و یجعل الفعل و الاشخاص تعبر عنه و تجسده .
تعریفات حول القصه و الحكایه
القصه القصیره :سرد قصصی قصیر نسبیا ً ( قد یقل عن عشرة آلاف كلمه ) یهدف الى احداث تأثیر مهیمن و یمتلك عناصر الدراما . وفی اغلب الاحیان ترتكز القصه القصیره على شخصیه واحدة فی موقف واحد فی لحضه واحدة .
و حتى اذا لم تتحقق هذه الشروط فلا بد ان تكون الوحده هی المبدأ الموجهه لها. و الكثیر من القصص القصیره تتكون من شخصیه ( او مجموعه من شخصیات ) تقدم فی مواجهة خلفیه او وضع , و تنغمس خلا الفعل الذهنی او الفیزیائی فی موقف .
و هذا الصراع الدرامی ای اصطدام قوه متضادة ماثل فی قلب الكثیر من القصص القصیرة الممتازة .
فالتوتر من العناصر البنائیه للقصه القصیره كما ان تكامل الانطباع من سمات تلقیها بالاضافه الى انها كثیرا ً ما تعبر عن صوت منفرد لواحد من جماعه مغموره .
# ویذهب بغض الباحثین الى الزعم بأن القصه القصیره قد وجدت طوال التاریخ بأشكال مختلفه مثل قصص العهد القدیم عن الملك داوود , و سیدنا یوسف و راعوث , و كانت الأحدوثه و قصص القدوة الاخلاقیه فی زعمهم هی اشكال العصر الوسیط للقصه القصیره .
و لكن الكثیر من الباحثین یعتبرون ان المسأله اكبر من اشكالمختلفه للقصه القصیره , فذلك الجنس الادبی یفترض تحرر الفرد العادی من ربقة التبعیات القدیمه و ظهوره كذات فردیه مستقله تعی حریاتها الباطنه فی الشعور و التفكیر , و لها خصائصها الممیزه لفردیتها على العكس من الانماط النموذجیه الجاهزه التی لعبت دور البطوله فی السرد القصصی القدیم .
# و یعتبر ( إدجار الن بو ) من رواد القصة القصیرة الحدیثة فی الغرب .
وقد ازدهر هذا اللون من الادب فی انحاء العالم المختلفه , طوال قرن مضى على ایدی ( موباسان وزولا وتورجنیف و تشیخوف و هاردی و ستیفنسن ) , و مئات من فنانی القصه القصیره .
وفی العالم العربی بلغت القصة القصیرة درجه عالیه من النضج على ایدی
یوسف ادریس فی مصر , و زكریا تامر فی سوریا , و محمد المر فی دولة الامارات .
# ان للقصه القصیره انواع او انماط عدیده ..
اذكر بعضها للفائده .. و هی الانماط الاكثر تداولا ً و انتشارا ً
1= المیثو لوجیـــــــــــــا ..
هو مزج بین الاساطیر و الزمن المعاصر .. دون التأثر بما شكلته لنا الاساطیر من سحر و جمال .. او حتى التقید بازمنتها و امكنتها .
2= التسجیلیـــــــــــــــــة ..
لا تعنی الخواطر و الوجدانیات .. او حتى الكتابه الانشائیه .. بل هی قصص فی اطارها المألوف .. و لكن بإضافات ابداعیه جدیده .. تتضمن للكاتب الحریه و الوجدانیه معا ً .
3= السیكولوجیـــــــــــــة ..قصص .. تطمح الى تصویر الانسان ..و عكس افكاره الداخلیه .. تصل الى المستوى النفسی للانسان .. و تفند احاسیسه ومشاعره .. وتتكلم دائما عن اشیاء خفیه فی النفس البشریه .
4= الفانتازیــــــــــــــــــــا ..اعتبره اشرس انواع القصة القصیرة .. فهو ذو طابع متمرد .. متمیز بالغربه و الضیاع .. هو اسلوب ثوری على الاسالیب التقلیدیه .. وخروج غیر مألوف عن الدارج بحیث یطغى على الماده .. یهدف كاتب هذه النوعیه من القصص الى ابراز مدى الفوضه الفكریه و الحضاریه .. لدى انسان هذا العصر .. و حیاته .. فهو یرفض التقلید او الرضوخ للواقع .
الحكـــــــــــــــــــــایة :
سرد قصصی یروی تفصیلات حدث واقعی او متخیل , وهو ینطبق عادة ً على القصص القصیره ذات الحبكه المتراخیة الترابط -- مثل : حكایة الف لیلة و لیلة .
الحكــــــــایة الشعبیــــــــــــه :خرافه ( او سرد قصصی ) تضرب جذورها فی اوساط شعب و تعد من مأثوراته التقلیدیة . وخاصه فی التراث الشفاهی .
و یغطی المصطلح مدى ً واسعا ً من المواد ابتداء ً من الاساطیر السافرة الى حكایات الجن .
و تعد الف لیلة و لیلة مجموعة ذائعة الشهره من هذه الحكایات الشعبیه .
عناصـــــــــر العمــــــــل القصصــــــــی :
1-- الحـــــــــادثة :الحادثه فی العمل القصصی مجموعه من الوقائع الجزئیه مرتبطه و منظمه على نحو خاص و هو مایمكن ان نسمیه ( الأطار ) , ففی كل القصص یجب ان تحدث أشیاء فی نظام معین , وكما انه یجب ان تحدث اشیاء فأن النظام هو الذی یمیز أطار عن الآخر , فالحوادث تتبع خطا فی قصة و خطا آخر فی قصه أخرى .
و الحادثه الفنیه هی تلك السلسله من الوقائع المسروده سردا فنیا , التی یضمها اطار خاص .
واذا كنا هنا نتحدث عن عنصر الحادثه فینبغی ان نذكر بأن هناك نوعا ً من
القصص یعنى عنایة خاصة بالحادثة و سردها و تقل عنایته بالعناصر القصصیه الاخرى . و یسمى هذا النوع ( قصة الحادثه ) او ( القصة السردیة ) وفی القصة السردیة تكون ( الحركة ) هی الشئ الرئیسی .
فالحركه عنصر أساسی فی العمل القصصی و هی نوعان : حركة عضویة , و حركة ذهنیة .
و الحركة العضویة تتحقق فی الاحداث التی تقع , و فی سلوك الشخصیات , وهی بذلك تعد تجسیما ً للحركه الذهنیه التی تتمثل فی تطور الفكره العامه نحو الهدف الذی تهدف الیه القصة .
2 -- الســـــــــــــرد :هو نقل الحادثه من صورتها الواقعه الى صوره لغویه , فحین نقرأ مثلا ً
(( و جرى نحو الباب و هو یلهث , و دفعه فی عنف , و لكن قواه كانت قد خارت , فسقط خلف الباب من الأعیاء )) ..
نلاحظ الافعال >> جرى , یلهث , خار , سقط .. فهذه الافعال هی التی تكون فی اذهاننا جزیئات الواقعه , و لكن السرد الفنی لا یكتفی عادة بالافعال كما یحدث فی كتابة التاریخ , بل نلاحظ دائما ان السرد الفنی یستخدم العنصر النفسی الذی یصور به هذه الافعال
(( وهو یلهث , فی عنف , من الاعیاء --- فی المثال السابق )) وهذا نتج شأنه ان یكسب السرد حیویة , ویجعله لذلك فنیا ً .
و لكاتب القصة ان یختار كیفیة كتابة قصته من بین ثلاث طرق :
الطریقة المباشرة او الملحمیة , وطریقة السرد الذاتی , و طریقة الوثائق .
الطریقه الاولى مألوفه اكثر من غیرها و فیها یكون الكاتب مؤوخا یسرد من الخارج .
و فی الطریقة الثانیة یكتب على لسان المتكلم . وهو بذلك یجعل من نفسه و أحد شخوص القصه شخصیه واحدة . و هو بذلك یقدم ترجمه ذاتیه خیالیه .
وفی الطریقه الثالثة تتحقق القصه عن طریق الخطابات او الیومیات او الحكایات و الوثلئق المختلفة .
3 -- البنــــــــــــــــــاء :هناك صور عده لبناء الحادثه القصصیة بناء ً فنیا ً , و یمكن ان یقال ان كل قصة لها صوره بنائیه خاصه بها , و مع ذلك فقد امكن ضبط مجموعه من الصور البنائیه العامه , وهناك -- بصفه عامه -- صورتان لبناء الحبكه القصصیة هما :
صورة البناء و الصورة العضویه ,
وفی الاولى لاتكون بین الوقائع علاقه كبیره ضروریه او منتضمه . و عند اذن تعتمد وحدة السرد على شخصیة البطل الذی یربط بشخصه النواه الشخصیه المركزیه بین العناصر المتفرقه . و قصص المغامرات بعامه تمثل هذا النوع .
اما فی الصوره البنائیه العضویه فأن القصه مهما امتلات بالحوادث الجزئیه المنفصله الممتعه فأنها تتبع ( تصمیما ) عاما معقولا و فی خلال هذا التصمیم تقوم كل حادثه تفصیلیه بدور حیوی واضح .
فهناك شئ اكثر من مجرد الفكره العامه فی سیر القصه , فالخطه كلها لابد ان تعد بصوره مفصله , وان تنضم الشخصیات و الحوادث بحیث تشغل اماكنها المناسبه , وان تؤدی كل الخطوط الى النهایه .
و ینبغی ان یكون واضحا ً ان الصوره البنائیه تختلف من نوع قصصی الى آخر ,
فالصوره البنائیه التی تتمثل فی الروایه لا یمكن ان تصلح لبناء قصه قصیره . او ابسط صوره لبناء القصه -- و هی الصوره المأ لوفه بصفه عامه -- هی تلك التی تتمثل بین طرفی الصراع , و هما الهدف و النتیجه .
4 -- الشخصیـــــــــــــة : القصه معرض لأشخاص جدد یقابلهم القارئ لیتعرف علیهم و یتفهم دورهم , و یحدد موقفهم .
و طبیعی انه من الصعب ان نجد بین انفسنا و الشخصیه التی لم نعرفها ولم نفهمها نوعا ً من التعاطف . ومن هنا كانت اهمیة التشخیص فی القصه , فقبل ان یستطیع الكاتب ان یخعل القارئ یتعاطف وجدانیا ً مع الشخصیه , یجب ان تكون هذه الشخصیه حیه . فالقارئ یرید ان یراها وهی تتحرك , و ان یسمعها وهی تتكلم , یرید ان یتمكن من رؤاها رؤى العین .
و هناك نوعا ً من القصص یسمى ( قصة الشخصیة ) و یكون فیها الاهتمام بالشخصیه اولا ً و من ثم الحادثه .
و هناك ایضا ً انواع للشخصیات ذاتها فی القصه :
( الشخصیه الجاهزه ) وهی الشخصیة المكتملة التی تظهر فی القصه -- حین تظهر -- دون ان یحدث فی تكوینها ای تغیر ,
و انما یكون التغیر فی علاقتها بالشخصیات الآخرى فحسب . ای تصرفاتها لها طابع واحد .
النوع الثانی ( الشخصیة النامیة )وهی الشخصیة التی یتم تكوینها بتمام القصة , فتتطور من موقف الى موقف , وفی كل موقف یكون لها تصرف جدید یكشف لنا جانبا ً منها .
و الذوق الحدیث یفضل النوع الثانی من الشخصیة كما انه لكل قصّـاص طریقته الخاصه فی رسم الشخصیات ,
فبعضهم یستعیتن بوصف الملامح الخارجیه او الداخلیه او هما معا ً , وبعضهم یدع الحوادث و الحركات ترسمهـــــــــــــا .
5 -- الزمــــان و المكــــان :كل حادثه تقع لابد ان تقع فی مكان معین وفی الزمان ذاته , و هی بذلك ترتبط بظروف وعادات و مبادئ خاصه بالزمان و المكان اللذین وقعت فیهما , الارتباط بكل ذلك ضروری لحیویة القصة , لانه یمثل البطانه النفسیة للقصة , و یسمى هذا العنصر (( SETTING )) , و یقوم بالدور الذی تقوم به المناظر على المسرح بوصفها شیئا ً مرئیا ً یساعد خیال القارئ .
و تزداد عندما یساعد على فهم الحاله النفسیه للقصة او الشخصیة , فهو هنا یقوم بنفس الدور الذی تقوم به الموسیقى المصاحبه للمسرحیه او القصه السینمائیه ,
واخیرا ً یصبح التصویر مهما ً احیانا حتى انه یكاد ان یقوم بدور الممثل فی القصة , او تكون له قوه درامیه .
6 -- الفكــــــــــــــــــــــرة :یتحدث القارئ المتوسط عن ( الأطار ) فی القصه , وهو عادة ًیعنی بذلك ماذا حدث ؟ , وعندما نحلل القصه لایكون لهذا السؤال من اهمیه مایكون سؤالنا : لماذا حدث ؟ صحیح ان نهایة كل قصة تعطی نوعا ً من النتیجه فهناك شئ یحدث فعلا ً و لكن اسباب هذه النتیجه اكثر اهمیه من الحوادث الواقعه ذاتها .
فخلف الحوادث یقع المعنى , و هذا المعنى یقبله القارئ و یرفضه معتمدا ً على ما اذا كان المؤلف قادرا ً على اقناعه بأن النتیجه تتفق مع خبرته بالحیاه او الحیاه كما یصورها المؤلف .
فالقصة إذا ً انما تحدث لتقول شیئا ً , لتقرر فكره .. فالفكره هی الاساس الذی یقوم علیه البناء الفنی للقصة .
و الموضوع الذی تبنى علیه القصة لایكون دائما ً ایجابیا فی اثره
فمع انه یجب ان یقرر بطریقه مباشره او غیر مباشره عن الحیاة او السلوك الانسانی فإنه غیر محتاج لأن یحل مشكله .
وقد بین كاتب القصة الروسی العضیم ( تشیكوف ) لصدیق شاب ان هناك فرقا بین حل المشكله و وضعها وضعا ً صحیحا ً ,
فیكفی الفنان ان یصور مشكلته تصویرا ً صحیحا ً .
وحین نبحث عن سبب اعجابنا بقصة قرأناها سنجد ان فكرتها كان لها اثر فی هذا الاعجاب ,
ولكن هل نقرأ العمل الفنی لفكرته و حسب ؟
ان القصة هی صورة الحیاة و نحن نعرف الحیاة معرفه جیدة
و ننتظر من القصة دائما ً ان تكون صادقه حیه , مقنعة كالحیاة الواقعه , و لكن القصة تمتاز عن الحیاة بأن لها صوره فنیه خاصة فالكاتب یقدم لنا قصه -- و قصة بالذات -- حین یقدم لنا فكرة , كما ان مصدر اعجابنا لایمكن ان یحدد دائما ً بقاعدة لأننا فی كل قصه یـُــكشف لنا شئ جدید
و لكن من المؤكد ان القصه -- ككل عمل فنی -- لا یتحدد لها شكل حتى تتحقق فیها فكرة الكــــــــــــــــاتب .
>>>> الانواع القصصیه الرئیسیة هی .. ..الأقصوصه , القصة القصیرة , القصة , الروایه .. ..
ویغلو بعض كتاب القصص فی هذه الایام فی اتجاهیین :
الاتجاه الى الصراع الاجتماعی , و الاتجاه الى التحلیل النفسی , و لیس لنا ای اعتراض على ای اتجاه , مادام لایؤثر فی سمة العمل الانسانیه ولایطغى على الحقائق الفنیه .
(((( المصادر )))) :
التحلیل الأدبی
المعاجم العربیة
معجم المصطلحات الأدبیه / إبراهیم فتحی
الأدب و فنونه / عز الدین إسماعیل
النقد الأدبی : أصوله و مناهجة / سید قطب
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:37|
حیاته:
هو جریر بن عطیة، ینتهی نسبة إلى قبیلة"تمیم" نشأ فی الیمامة ومات فیها
ودفن.
كان من أسرة عادیة متواضعة.. وقف فی الحرب الهجائیة وحده أمام ثمانین شاعرًا، فحقق علیهم النصر الكبیر،ولم یثبت أمامه سوى الفرزدق والأخطل.
كان عفیفًا فی غزله،متعففًا فی حیاته، معتدلا بعلاقاته وصداقاته..
كما كان أبیًا محافظًا على كرامته، لاینام على ضیم، هجاء من الطراز الأول، یتتبع فی هجائه مساوىء خصمه، وإذا لم یجد شیئًا یشفی غلته، اخترع قصصًا شائنة وألصقها بخصمه، ثم عیره بها..
اتصل بالخلفاء الأمویین، ومدحهم ونال جوائزهم،..
سلك فی شعره الهجاء والمدیح والوصف والغزل..
عاش حوالی ثمانین سنة.
اختلف المؤرخون فی تحدید تاریخ وفاة جریر، على أنه فی الأغلب توفی سنة 733م/144ه وذلك بعد وفاة الفرزدق بنحو أربعین یومًا، وبعد وفاة الأخطل بنحو ثلاث وعشرین سنة.
المدیح عند جریر
أكثر جریر من المدیح ، وكانت نشأته الفقیرة، وطموح نفسه، وموهبته المواتیة، وحاجة خلفاء بنی أمیة إلى شعراء یدعون لهم، ویؤیدون مذهبهم، كان كل ذلك مما دفعه إلى الإكثار من المدح والبراعة فیه. وكان أكثر مدائحه فی خلفاء بنی أمیة وأبنائهم وولاتهم، وكان یفد علیهم من البادیة كل سنة لینال جوائزهم وعطایاهم.
وكان مدیحه لهم یشید بمجدهم التلید ویروی مآثرهم ومكارمهم، ویطیل فی الحدیث عن شجاعتهم، ویعرض بأعدائهم الثائرین علیهم، وبذلك كان یظهر اتجاهه السیاسی فی ثنایا مدحه لهم، وكان إذا مدح، استقصى صفات الممدوح وأطال فیها، وضرب على الوتر الذی یستثیره ولم یخلط مدائحه وبلغت غایتها من التأثیر فی النفس.
وفی الحق أنه ما كان لجریر من غایة غیر التكسب وجمع المال، فلم یترفع عن مدح أی شخص أفاض علیه نوافله، حتى أنه مدح الموالی..
ذلك أن طمع جریر وجشعه وحبه للمال كانت أقوى من عصبیته القبلیة، ولم یكن لرهطه من الشرف والرفعة مثل ما لرهط الفرزدق، لهذا شغل الفرزدق بالفخر بآبائه وعشیرته، وقال أكثر مدائحه فی قبیلته، وحتى فی مدائحه لبنی أمیة لم ینس الفخر بآبائه وأجداده.
..
فهو إذا مدح الحجاج أو الأمویین بالغ فی وصفهم بصفات الشرف وعلو المنزلة والسطوة وقوة البطش، ویلح إلحاحا شدیدا فی وصفهم بالجود والسخاء لیهز أریحیتهم، وقد یسرف فی الاستجداء وما یعانیه من الفاقة..
وتكثر فی أمادیحه لهم الألفاظ الإسلامیة والاقتباسات القرآنیة.. ولا یسعنا إلا الاعتراف بأن جریرًا كان موفقا كل التوفیق، حین صور منزلة الأمویین وجودهم بقوله:
ألستم خیر من ركب المطایا **** وأندى العالمین بطون راح
جریر مفاخرًا هاجیًا
عاصر الشاعر "عبید الراعی" الشاعرین جریرًا والفرزدق، فقیل إن الراعی الشاعر كان یسأل عن هذین الشاعرین فیقول:
- الفرزدق أكبر منهما وأشعرهما.
فمرة فی الطریق رآه الشاعر جریر وطلب منه أن لا یدخل بینه وبین الفرزدق، فوعده بذلك.. ولكن الراعی هذا لم یلبث أن عاد إلى تفضیل الفرزدق على جریر، فحدث أن رآه ثانیة، فعاتبه فأخذ یعتذر إلیه، وبینما هما على هذا الحدیث، أقبل ابن الراعی وأبى أن یسمع اعتذار أبیه لجریر، حیث شتم ابن الراعی الشاعر جریرًا وأساء إلیه..
وكان من الطبیعی أن یسوء ذلك جریرًا ویؤلمه، فقد أهین إهانة بالغة ، فذهب إلى بیته، ولكنه لم یستطع النوم فی تلك اللیلة، وظل قلقا ساهرا ینظم قصیدة سنورد بعض أبیاتها بهذه المناسبة، فلما أصبح الصباح ، ألقاها الشاعر جریر فی "المربد" على مسمع من الراعی والفرزدق والناس، فكانت القصیدة شؤما على بنی نمیر حتى صاروا إذا سئلوا عن نسبهم لا یذكرون نسبهم إلى "نمیر" بل إلى جدهم عامر.. هذا وقد سمى جریر قصیدته هذه" الدامغة" لأنها أفحمت خصمه:
أعــد الله للشعـراء منی **** صواعـق یخضعون لها الرقابا
أنا البازی المطل على نمیر *** أتیح من السماء لها انصبابا
فلا صلى الإلـه على نمـیر **** ولا سقیت قبورهم السحابا
ولو وزنت حلوم بنی نمیر **** على المیزان ما وزنت ذبـابا
فغض الطرف إنك من نمیر **** فلا كعبا بلغت ، ولا كـلابا
إذا غضیت علیك بنو تمیـم **** حسبت النـاس كلهم غضـابا
معانی البیات واضحة سهلة، تتصف بهجاء الخصم وإلحاق العیوب والمساوىء به، كما أنها تتصف أیضا بفخر الشاعر بنفسه، عدا عن أن الشاعر یتهكم بخصمه وبقومه، فیسخر من عقولهم الصغیرة كعقول الذباب، ثم یطلب الشاعر من خصمه أن یتوارى عن الأنظار ویخجل من نفسه هو وقومه. ویختتم القصیدة ببیت رائع شهیر بالفخر.
فالفخر هو الوجه الآخر للهجاء، فالطرف الذی یتلقى الهجاء من الشاعر، یجده فخرًا بالنسبة لنفسه ولقومه..
فهنا یفاخر جریر بمجده ومجد قومه فخرًا جاهلیًا، یعتز فیه ببطولتهم وأیامهم القدیمة وما ورثوا من مجد، فهو قد هیأ هجاءه لكل الشعراء الذین تحدثهم نفسهم بالتعرض بأننی سأقضی علیهم وأحطم عزهم.. أو یكف الشعراء بعد أن قلت كلمتی الفاضلة، أم یطمعون فی التعرض لی، لیقاسوا من هجائی نارًا تلفح وجوههم لفحًا؟
فالهجاء عند جریر شدید الصلة بالفخر، فهو إذا هجا افتخر، وجعل من الفخر وسیلة لإذلال خصمه.
أما موضوع فخره فنفسه وشاعریته، ثم قومه وإسلامه.
فإذا هجا الفرزدق اصطدم بأصل الفرزدق الذی هو أصله، فكلاهما من"تمیم" ، وإذا هجا الأخطل فخر بإسلامه ومضریته، وفی مضر النبوة والخلافة:
إن الذی حرم المكارم تغلبا **** جعل الخلافة والنبوة فینا
هذا وكان لجریر مقدرة عجیبة على الهجاء، فزاد فی هجائه عن غیره طریقة اللذع والإیلام.. فیتتبع حیاة مهجویه وتاریخ قبیلتهم، ویعدد نقائصهم مختلفا، مكررا، محقرا، إلا أنه لم یستطع أن یجعل الفخر بآبائه موازیا لفخر الفرزدق.
كان من أسرة عادیة متواضعة.. وقف فی الحرب الهجائیة وحده أمام ثمانین شاعرًا، فحقق علیهم النصر الكبیر،ولم یثبت أمامه سوى الفرزدق والأخطل.
كان عفیفًا فی غزله،متعففًا فی حیاته، معتدلا بعلاقاته وصداقاته..
كما كان أبیًا محافظًا على كرامته، لاینام على ضیم، هجاء من الطراز الأول، یتتبع فی هجائه مساوىء خصمه، وإذا لم یجد شیئًا یشفی غلته، اخترع قصصًا شائنة وألصقها بخصمه، ثم عیره بها..
اتصل بالخلفاء الأمویین، ومدحهم ونال جوائزهم،..
سلك فی شعره الهجاء والمدیح والوصف والغزل..
عاش حوالی ثمانین سنة.
اختلف المؤرخون فی تحدید تاریخ وفاة جریر، على أنه فی الأغلب توفی سنة 733م/144ه وذلك بعد وفاة الفرزدق بنحو أربعین یومًا، وبعد وفاة الأخطل بنحو ثلاث وعشرین سنة.
المدیح عند جریر
أكثر جریر من المدیح ، وكانت نشأته الفقیرة، وطموح نفسه، وموهبته المواتیة، وحاجة خلفاء بنی أمیة إلى شعراء یدعون لهم، ویؤیدون مذهبهم، كان كل ذلك مما دفعه إلى الإكثار من المدح والبراعة فیه. وكان أكثر مدائحه فی خلفاء بنی أمیة وأبنائهم وولاتهم، وكان یفد علیهم من البادیة كل سنة لینال جوائزهم وعطایاهم.
وكان مدیحه لهم یشید بمجدهم التلید ویروی مآثرهم ومكارمهم، ویطیل فی الحدیث عن شجاعتهم، ویعرض بأعدائهم الثائرین علیهم، وبذلك كان یظهر اتجاهه السیاسی فی ثنایا مدحه لهم، وكان إذا مدح، استقصى صفات الممدوح وأطال فیها، وضرب على الوتر الذی یستثیره ولم یخلط مدائحه وبلغت غایتها من التأثیر فی النفس.
وفی الحق أنه ما كان لجریر من غایة غیر التكسب وجمع المال، فلم یترفع عن مدح أی شخص أفاض علیه نوافله، حتى أنه مدح الموالی..
ذلك أن طمع جریر وجشعه وحبه للمال كانت أقوى من عصبیته القبلیة، ولم یكن لرهطه من الشرف والرفعة مثل ما لرهط الفرزدق، لهذا شغل الفرزدق بالفخر بآبائه وعشیرته، وقال أكثر مدائحه فی قبیلته، وحتى فی مدائحه لبنی أمیة لم ینس الفخر بآبائه وأجداده.
..
فهو إذا مدح الحجاج أو الأمویین بالغ فی وصفهم بصفات الشرف وعلو المنزلة والسطوة وقوة البطش، ویلح إلحاحا شدیدا فی وصفهم بالجود والسخاء لیهز أریحیتهم، وقد یسرف فی الاستجداء وما یعانیه من الفاقة..
وتكثر فی أمادیحه لهم الألفاظ الإسلامیة والاقتباسات القرآنیة.. ولا یسعنا إلا الاعتراف بأن جریرًا كان موفقا كل التوفیق، حین صور منزلة الأمویین وجودهم بقوله:
ألستم خیر من ركب المطایا **** وأندى العالمین بطون راح
جریر مفاخرًا هاجیًا
عاصر الشاعر "عبید الراعی" الشاعرین جریرًا والفرزدق، فقیل إن الراعی الشاعر كان یسأل عن هذین الشاعرین فیقول:
- الفرزدق أكبر منهما وأشعرهما.
فمرة فی الطریق رآه الشاعر جریر وطلب منه أن لا یدخل بینه وبین الفرزدق، فوعده بذلك.. ولكن الراعی هذا لم یلبث أن عاد إلى تفضیل الفرزدق على جریر، فحدث أن رآه ثانیة، فعاتبه فأخذ یعتذر إلیه، وبینما هما على هذا الحدیث، أقبل ابن الراعی وأبى أن یسمع اعتذار أبیه لجریر، حیث شتم ابن الراعی الشاعر جریرًا وأساء إلیه..
وكان من الطبیعی أن یسوء ذلك جریرًا ویؤلمه، فقد أهین إهانة بالغة ، فذهب إلى بیته، ولكنه لم یستطع النوم فی تلك اللیلة، وظل قلقا ساهرا ینظم قصیدة سنورد بعض أبیاتها بهذه المناسبة، فلما أصبح الصباح ، ألقاها الشاعر جریر فی "المربد" على مسمع من الراعی والفرزدق والناس، فكانت القصیدة شؤما على بنی نمیر حتى صاروا إذا سئلوا عن نسبهم لا یذكرون نسبهم إلى "نمیر" بل إلى جدهم عامر.. هذا وقد سمى جریر قصیدته هذه" الدامغة" لأنها أفحمت خصمه:
أعــد الله للشعـراء منی **** صواعـق یخضعون لها الرقابا
أنا البازی المطل على نمیر *** أتیح من السماء لها انصبابا
فلا صلى الإلـه على نمـیر **** ولا سقیت قبورهم السحابا
ولو وزنت حلوم بنی نمیر **** على المیزان ما وزنت ذبـابا
فغض الطرف إنك من نمیر **** فلا كعبا بلغت ، ولا كـلابا
إذا غضیت علیك بنو تمیـم **** حسبت النـاس كلهم غضـابا
معانی البیات واضحة سهلة، تتصف بهجاء الخصم وإلحاق العیوب والمساوىء به، كما أنها تتصف أیضا بفخر الشاعر بنفسه، عدا عن أن الشاعر یتهكم بخصمه وبقومه، فیسخر من عقولهم الصغیرة كعقول الذباب، ثم یطلب الشاعر من خصمه أن یتوارى عن الأنظار ویخجل من نفسه هو وقومه. ویختتم القصیدة ببیت رائع شهیر بالفخر.
فالفخر هو الوجه الآخر للهجاء، فالطرف الذی یتلقى الهجاء من الشاعر، یجده فخرًا بالنسبة لنفسه ولقومه..
فهنا یفاخر جریر بمجده ومجد قومه فخرًا جاهلیًا، یعتز فیه ببطولتهم وأیامهم القدیمة وما ورثوا من مجد، فهو قد هیأ هجاءه لكل الشعراء الذین تحدثهم نفسهم بالتعرض بأننی سأقضی علیهم وأحطم عزهم.. أو یكف الشعراء بعد أن قلت كلمتی الفاضلة، أم یطمعون فی التعرض لی، لیقاسوا من هجائی نارًا تلفح وجوههم لفحًا؟
فالهجاء عند جریر شدید الصلة بالفخر، فهو إذا هجا افتخر، وجعل من الفخر وسیلة لإذلال خصمه.
أما موضوع فخره فنفسه وشاعریته، ثم قومه وإسلامه.
فإذا هجا الفرزدق اصطدم بأصل الفرزدق الذی هو أصله، فكلاهما من"تمیم" ، وإذا هجا الأخطل فخر بإسلامه ومضریته، وفی مضر النبوة والخلافة:
إن الذی حرم المكارم تغلبا **** جعل الخلافة والنبوة فینا
هذا وكان لجریر مقدرة عجیبة على الهجاء، فزاد فی هجائه عن غیره طریقة اللذع والإیلام.. فیتتبع حیاة مهجویه وتاریخ قبیلتهم، ویعدد نقائصهم مختلفا، مكررا، محقرا، إلا أنه لم یستطع أن یجعل الفخر بآبائه موازیا لفخر الفرزدق.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:36|
سأظل أذكركم إذا جن الدُجى.... أو أشرقت شمس على
الأزمان
سأظل أذكر إخوة وأحبة..... هم فی الفؤاد مشاعل الإیمان
سأظل أذكركم بحجم محبتی... فمحبتی فیض من الوجدان
فلتذكرونی بالدعاء فإننی...... فی حبكم أرجوا رضى الرحمن
.....................................................................................................................................سأظل أذكر إخوة وأحبة..... هم فی الفؤاد مشاعل الإیمان
سأظل أذكركم بحجم محبتی... فمحبتی فیض من الوجدان
فلتذكرونی بالدعاء فإننی...... فی حبكم أرجوا رضى الرحمن
ثلاث یعز الصبر عند
حلولها ویذهب عنها عقل كل لبیب
خروج اضطرار من بلاد تحبها وفرقة خلانٍ وفقد
حبیب
................................................................................................................................
................................................................................................................................
سأرحل عن دیاركم برغم
محبتی لكم
وأبنی داری فی وطن به الأخلاق والشیم
فقد ثارت براكین وغطت أرضنا الحمم
ولم تنهض فوراسنا ولم تتجاوز القمم
شبیبتنا أخاطبكم فهل أعراكم الصمم
سأرحل رغم أنفكم فأنتم معشر قزم
.......................................................................................................................................................................
شَیئانِ لَو بَكَتِ الدِماءَ عَلَیهِما******عَینایَ حَتّى تَأذَنا بِذِهابِ
لَم تَبلُغِ المِعشارَ مِن حَقَّیهِما******فَقدُ الشَبابِ وَفُرقَةُ الأَحبابِ
وأبنی داری فی وطن به الأخلاق والشیم
فقد ثارت براكین وغطت أرضنا الحمم
ولم تنهض فوراسنا ولم تتجاوز القمم
شبیبتنا أخاطبكم فهل أعراكم الصمم
سأرحل رغم أنفكم فأنتم معشر قزم
.......................................................................................................................................................................
شَیئانِ لَو بَكَتِ الدِماءَ عَلَیهِما******عَینایَ حَتّى تَأذَنا بِذِهابِ
لَم تَبلُغِ المِعشارَ مِن حَقَّیهِما******فَقدُ الشَبابِ وَفُرقَةُ الأَحبابِ
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:35|
وُلد فی الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة 1889، فی 'عزبة الكیلو'
قرب مغاغة، بالصّعید المصری الأوسط، ونشأ فی الریف ضعیف البنیة كأنّه
'الثُّمامة'، لا یستطیع ما یستطیعه النّاس، ولا ینهض من الأمر لما ینهض له
النّاس، ترأف به أمّه دائما وتهمله أحیانا، ویلین له أبوه تارة ویزور عنه
طورا، ویشفق علیه إخوته إشفاقا یشوبه احتیاط فی معاملتهم إیّاه، وشیء من
الازدراء.
توفّی فی الثّامن والعشرین من شهر أكتوبر سنة 1973 بالقاهرة، وقد استطاع ما لم یستطعه كثیر من المبصرین، فتناقلت خبر وفاته العواصم وحزن لفقدانه الأدباء والباحثون والعلماء.
'أخذ العلم بأُذُنَیْه لا بأصابعه' فقهر عاهته قهرا، محروما یكره أن یشعر بالحرمان وأن یُرَى شاكیا متبرّما، جادّا متجلّدا مبتسما للحیاة والدّرس والبحث، حتّى انتهى غلى حال العلماء المبَرَّزِینَ ومراتب الأدباء المفكّرین، فشغل النّاس ولن یزال.
فقد بصره طفلا : 'اصابه الرّمد فأُهمل أیّاما، ثمّ دُعی الحلاّق فعالجه علاجا ذهب بعینیه'. وحفظ القرآن فی كُتّاب القریة وهو فی التّاسعة، فأصبح 'شیخا'، كذا كان أبوه یدعوه، وأمّه، 'وسیّدنا' مؤدّب الصّبیان.
وقدم القاهرة سنة 1902 للتعلم فی الأزهر، فدخله والقلبُ ممتلئ خشوعا والنّفس ممتلئة إجلالا. وأنفق فیه ثمانی سنین لم یظفر فی نهایتها بشهادة 'العالمیّة'، لأن 'القوم كانوا مؤتمرین به لیسقطوه' ! نبأ عجیب حمله غلیه شیخه سیّد المرصفی لیلة الامتحان، بعد أن صُلِّیَتِ العِشَاءُ... وفارق الأزهر وقد ارابه منه أمر، شدید الضّیق به وبأهله. وخاب أمل أبیه، فلن یرى ابنه من بین علماء الأزهر ولا 'صاحب عمود فی الأزهر ومن حوله حلقة واسعة بعیدة المدى' وأُتیحتْ للفتى حیاة أخرى...
فما إن أُنشئت الجامعة المصریّة (الأهلیة) سنة 1908 حتّى انتسب إلیها الطّالب الأزهری، ولكنّه ظلّ مقیّدا فی سجلاّت الأزهر : وقضى سنتین (1908-1910) یحیا حیاة مشتركة، یختلف إلى دروس الازهر مصبحا وإلى دروس الجامعة مُمْسِیًا. وما لبث أن وجد فی الجامعة روحا للعلم والبحث جدیدة و'طعما للحیاة جدیدا' فشغف بالدّرس والتّحصیل حتّى نال درجة 'العالمیّة' (الدكتوراه) سنة 1914 برسالة موضوعها 'ذكرى أبی العلاء'، فكانت 'أوّل كتاب قُدّم إلى الجامعة، وأوّل كتاب امتُحِنَ بین یدی الجمهور، وأول كتاب نال صاحبه إجازة علمیّة منها'.
ثمّ سافر الفتى إلى فرنسا لمواصلة التّعلّم، فانتسب إلى جامعة مونبیلیى حیث قضّى سنة دراسیّة (1914-1915) ذهب بعدها إلى باریس، وانتسب إلى جامعة السّوربون حیث قضى أربع سنوات (1915-1919). وما كاد یختلف إلى دروس التاریخ والأدب فیها 'حتّى أحسّ أنّه لم یكن قد هیّئ لها... وأنّ درسه الطویل فی الأزهر وفی الجامعة (المصریّة) لم یهیّئه للانتفاع بهذه الدّروس'. فأقبل على قراءة الكتب المقرّرة فی المدارس الثانویّة، ولم یجد بدّا من أن یكون 'تلمیذا ثانویا فی بیته وطالبا فی السّوربون'.
أرسل لیدرس التّاریخ فی السّوربون، فما لبث أن أیقن بأنّ الدرجات العلمیّة لا تعنی شیئا إن هی لم تقم على أساس متین من الثقافة. ولیس غلى ذلك من سبیل سوى إعداد 'اللیسانس'. وقد صرّح بذلك فی الجزء الثالث من كتاب الأیّام، قال : 'كان (الفتى' قد أزمع أن یظفر قبل كل شیء بدرجة 'اللیسانس' ثم یتقدّم لدرجة الدكتوراه بعد ذلك. ولم یكن الطلاّب المصریون - إلى ذلك الوقت - یحاولون الظفر بدرجة اللیسانس هذه، لأنّها كانت تكلّف الذین یطلبونها عناء ثقیلا'.
وأحرز طه حسین درجة 'اللیسانس فی التّاریخ' سنة 1917، فكان أوّل طالب مصرین ظفر بهذه الشهادة من كلیّة الآداب بالجامعة الفرنسیّة.
إنّ أمر هذا الفتى عَجَبٌ ! فهو قد كان یتهیّأ لامتحان اللیسانس ویعدّ فی المدّة نفسها رسالة 'دكتورا جامعة' باللّغة الفرنسیّة موضوعها : 'دراسة تحلیلیّة نقدیّة لفلسفة ابن خلدون الاجتماعیّة' (Etude analytique et critique de la philosophie sociale d'Ibn Khaldoun).
إنّ أمر هذا الفتى عجب ! فهو لم یكد یفرغ من امتحان الدكتورا حتّى نشط لإعداد رسالة أخرى، فقد صحّ منه العزم على الظفر 'بدبلوم الدّراسات العلیا' (Diplôme d'Etudes Superieures) وهو شهادة یتهیّأ بها أصحابها للانتساب إلى دروس 'التبریز فی الآداب'. وما هی إلاّ أن أشار علیه أُستاذه بموضوع عسیر مُمْتع مریر، وهو : 'القضایا التی أقیمت فی روما على حكّام الأقالیم الذین أهانوا جلال الشّعب الرّومانی، فی عهد تباریوس، كما صوّرها المؤرّخ تاسیت' (La loi de lèse-majesté, sous Tibère, d'après Tacite) فقبله الطالب 'طائعا قلقا مستخذیا'، ومارسه بالصّبر على مشقّة البحث وبالمثابرة على الفهم حتّى ناقشه ونجح فیه نُجْحًا حسنا سنة 1919.
عاد طه حسین إلى وطنه، فلم تُمهله الجامعة المصریّة وعیّنته مباشرة أستاذا للتاریخ القدیم (الیونانی والرّومانی)، فظلّ یُدرّسه طیلة ستّ سنوات كاملات (1919-1925).
بعد اكثر من قرن كامل على میلاده، و27 عاما على وفاته، ما زال عمید الادب العربی الدكتور طه حسین احد الاركان الاساسیة فی تكوین العقل العربی المعاصر، وصیاغة الحیاة الفكریة فی العالم العربی، وملمحاً أساسیاً من ملامح الادب العربی الحدیث... بل ان الاجیال الجدیدة من ابناء الامة العربیة لا تزال تكتشف جوانب جدیدة من القیمة الفكریة والانسانیة لاحد رواد حركة التنویر فی الفكر العربی... وما زالت اعمال طه حسین ومعاركه الادبیة والفكریة من أجل التقدم والتخلی عن الخرافات والخزعبلات التی حاصرت وقیدت العقل العربی لعدة قرون، من اهم الروافد التی یتسلح بها المفكرون العرب فی مواجهة الحملات الارتدادیة التی تطل برأسها فی عصرنا.
وما زالت السیرة الذاتیة لطه حسین وما تجسده من كفاح انسانی وفكری مدرسة هامة ما اشد حاجة الاجیال الجدیدة للتعلم منها والتأمل فیها.
من عزبة صغیرة (اصغر من القریة) فی صعید مصر بدأت رحلة طه حسین، فقد ولد عمید الادب العربی فی تلك البقعة الصغیرة التی تقع على بعد كیلو متر واحد من مغاغة بمحافظة المنیا فی وسط صعید مصر... كان ذلك فی الرابع عشر من نوفمبر عام 1889م، وكان والده حسین علی موظفاً فی شركة السكر وانجب ثلاثة عشر ولداً كان سابعهم فی الترتیب 'طه' الذی اصابه رمد فعالجه الحلاق علاجاً ذهب بعینیه (كما یقول هو عن نفسه فی كتاب 'الایام').
وفی عام 1898 وبینما لم یكن قد اكمل السنوات العشر كان طه حسین قد اتم حفظ القرآن الكریم... وبعد ذلك بأربع سنوات بدأت رحلته الكبرى عندما غادر القاهرة متوجها الى الازهر طلباً للعلم. فی عام 1908 بدأت ملامح شخصیة طه حسین المتمردة فی الظهور حیث بدأ یتبرم بمحاضرات معظم شیوخ الازهر فاقتصر على حضور بعضها فقط مثل درس الشیخ بخیت ودروس الادب... وفی العام ذاته انشئت الجامعة المصریة، فالتحق بها طه حسین وسمع دروس احمد زكی (باشا) فی الحضارة الاسلامیة واحمد كمال (باشا) فی الحضارة المصریة القدیمة ودروس الجغرافیا والتاریخ واللغات السامیة والفلك والادب والفلسفة على اساتذة مصریین واجانب.
فی تلك الفترة اعد طه حسین رسالته للدكتوراه نوقشت فی 15 أیار 1914م. هذه الرسالة (وكانت عن ذكرى ابی العلاء) اول كتاب قدم الى الجامعة واول رسالة دكتوراه منحتها الجامعة المصریة، واول موضوع امتحن بین ایدی الجمهور.
ومثلما كانت حیاته كلها جرأة وشجاعة واثارة للجدل فقد احدث نشر هذه الرسالة فی كتاب ضجة هائلة ومواقف متعارضة وصلت الى حد طلب احد نواب البرلمان حرمان طه حسین من حقوق الجامعیین 'لأنه الف كتابا فیه الحاد وكفر'!، ولكن سعد زغلول رئیس الجمعیة التشریعیة آنذاك اقنع النائب بالعدول عن مطالبه.
الرحلة الثانیة
اذا كانت الرحلة الاولى ذات الاثر العمیق فی حیاة طه حسین وفكره هی انتقاله من قریته فی الصعید الى القاهرة... فإن الرحلة الاخرى الاكثر تأثیراً كانت الى فرنسا فی عام 1914 حیث التحق بجامعة مونبلییه لكی یبعد عن باریس احد میادین الحرب العالمیة الاولى... وهناك درس اللغة الفرنسیة وعلم النفس والادب والتاریخ. ولاسباب مالیة اعادت الجامعة المصریة مبعوثیها فی العام التالی 1915 لكن فی نهایة العام عاد طه حسین الى بعثته ولكن الى باریس هذه المرة حیث التحق بكلیة الاداب بجامعة باریس وتلقى دروسه فی التاریخ ثم فی الاجتماع حیث اعد رسالة اخرى على ید عالم الاجتماع الشهیر 'امیل دوركایم' وكانت عن موضوع 'الفلسفة الاجتماعیة عند ابن خلدون' حیث اكملها مع 'بوجلیه' بعد وفاة دوركایم وناقشها وحصل بها على درجة الدكتوراه فی عام 1919م ثم حصل فی العام ذاته على دبلوم الدراسات العلیا فی اللغة اللاتینیة، وكان قد اقترن فی 9 اغسطس 1917 بالسیدة سوزان التی سیكون لها اثر ضخم فی حیاته بعد ذلك.
فی عام 1919 عاد طه حسین الى مصر فعین استاذاً للتاریخ الیونانی والرومانی واستمر كذلك حتى عام 1925 حیث تحولت الجامعة المصریة فی ذلك العام الى جامعة حكومیة وعین طه حسین استاذاً لتاریخ الادب العربی بكلیة الآداب.
أولى المعارك
رغم تمرده على الكثیر من اراء اساتذته الا ان معركة طه حسین الاولى والكبرى من اجل التنویر واحترام العقل تفجرت فی عام 1926 عندما اصدر كتابه 'فی الشعر الجاهلی' الذی احدث ضجة هائلة بدأت سیاسیة قبل ان تكون ادبیة. كما رفعت دعوى قضائیة ضد طه حسین فأمرت النیابة بسحب الكتاب من منافذ البیع واوقفت توزیعه... ونشبت معارك حامیة الوطیس على صفحات الصحف بین مؤیدین ومعارضین لهذا الكتاب.
وفی عام 1928 وقبل ان تهدأ ضجة كتاب الشعر الجاهلی بشكل نهائی تفجرت الضجة الثانیة بتعیینه عمیداً لكلیة الآداب الامر الذی اثار ازمة سیاسیة اخرى انتهت بالاتفاق مع طه حسین على الاستقالة فاشترط ان یعین اولاً. وبالفعل عین لیوم واحد ثم قدم الاستقالة فی المساء وأعید 'میشو' الفرنسی عمیداً لكلیة الآداب، ولكن مع انتهاء عمادة میشو عام 1930 اختارت الكلیة طه حسین عمیداً لها ووافق على ذلك وزیر المعارف الذی لم یستمر فی منصبه سوى یومین بعد هذه الموافقة وطلب منه الاستقالة.
الازمة الكبرى
وفی عام 1932 حدثت الازمة الكبرى فی مجرى حیاة طه حسین... ففی شباط 1932 كانت الحكومة ترغب فی منح الدكتوراه الفخریة من كلیة الآداب لبعض السیاسیین... فرفض طه حسین حفاظاً على مكانة الدرجة العلمیة، مما اضطر الحكومة الى اللجوء لكلیة الحقوق...
ورداً على ذلك قرر وزیر المعارف نقل طه حسین الى دیوان الوزارة فرفض العمل وتابع الحملة فی الصحف والجامعة كما رفض تسویة الازمة الا بعد اعادته الى عمله وتدخل رئیس الوزراء فأحاله الى التقاعد فی 29 آذار 1932 فلزم بیته ومارس الكتابة فی بعض الصحف الى ان اشترى امتیاز جریدة 'الوادی' وتولى الاشراف على تحریرها، ثم عاد الى الجامعة فی نهایة عام 1934 وبعدها بعامین عاد عمیداً لكلیة الاداب واستمر حتى عام 1939 عندما انتدب مراقباً للثقافة فی وزارة المعارف حتى عام .1942
ولأن حیاته الوظیفیة كانت دائماً جزءاً من الحیاة السیاسیة فی مصر صعوداً وهبوطاً فقد كان تسلم حزب الوفد للحكم فی 4 شباط 1942 ایذاناً بتغیر آخر فی حیاته الوظیفیة حیث انتدبه نجیب الهلالی وزیر المعارف آنذاك مستشاراً فنیاً له ثم مدیراً لجامعة الاسكندریة حتى احیل على التقاعد فی 16 تشرین الاول 1944 واستمر كذلك حتى 13 حزیران 1950 عندما عین لاول مرة وزیراً للمعارف فی الحكومة الوفدیة التی استمرت حتى 26 حزیران 1952 وهو یوم احراق القاهرة حیث تم حل الحكومة.
وكانت تلك آخر المهام الحكومیة التی تولاها طه حسین حیث انصرف بعد ذلك وحتى وفاته عام 1973 الى الانتاج الفكری والنشاط فی العدید من المجامع العلمیة التی كان عضواً بها داخل مصر وخارجها
توفّی فی الثّامن والعشرین من شهر أكتوبر سنة 1973 بالقاهرة، وقد استطاع ما لم یستطعه كثیر من المبصرین، فتناقلت خبر وفاته العواصم وحزن لفقدانه الأدباء والباحثون والعلماء.
'أخذ العلم بأُذُنَیْه لا بأصابعه' فقهر عاهته قهرا، محروما یكره أن یشعر بالحرمان وأن یُرَى شاكیا متبرّما، جادّا متجلّدا مبتسما للحیاة والدّرس والبحث، حتّى انتهى غلى حال العلماء المبَرَّزِینَ ومراتب الأدباء المفكّرین، فشغل النّاس ولن یزال.
فقد بصره طفلا : 'اصابه الرّمد فأُهمل أیّاما، ثمّ دُعی الحلاّق فعالجه علاجا ذهب بعینیه'. وحفظ القرآن فی كُتّاب القریة وهو فی التّاسعة، فأصبح 'شیخا'، كذا كان أبوه یدعوه، وأمّه، 'وسیّدنا' مؤدّب الصّبیان.
وقدم القاهرة سنة 1902 للتعلم فی الأزهر، فدخله والقلبُ ممتلئ خشوعا والنّفس ممتلئة إجلالا. وأنفق فیه ثمانی سنین لم یظفر فی نهایتها بشهادة 'العالمیّة'، لأن 'القوم كانوا مؤتمرین به لیسقطوه' ! نبأ عجیب حمله غلیه شیخه سیّد المرصفی لیلة الامتحان، بعد أن صُلِّیَتِ العِشَاءُ... وفارق الأزهر وقد ارابه منه أمر، شدید الضّیق به وبأهله. وخاب أمل أبیه، فلن یرى ابنه من بین علماء الأزهر ولا 'صاحب عمود فی الأزهر ومن حوله حلقة واسعة بعیدة المدى' وأُتیحتْ للفتى حیاة أخرى...
فما إن أُنشئت الجامعة المصریّة (الأهلیة) سنة 1908 حتّى انتسب إلیها الطّالب الأزهری، ولكنّه ظلّ مقیّدا فی سجلاّت الأزهر : وقضى سنتین (1908-1910) یحیا حیاة مشتركة، یختلف إلى دروس الازهر مصبحا وإلى دروس الجامعة مُمْسِیًا. وما لبث أن وجد فی الجامعة روحا للعلم والبحث جدیدة و'طعما للحیاة جدیدا' فشغف بالدّرس والتّحصیل حتّى نال درجة 'العالمیّة' (الدكتوراه) سنة 1914 برسالة موضوعها 'ذكرى أبی العلاء'، فكانت 'أوّل كتاب قُدّم إلى الجامعة، وأوّل كتاب امتُحِنَ بین یدی الجمهور، وأول كتاب نال صاحبه إجازة علمیّة منها'.
ثمّ سافر الفتى إلى فرنسا لمواصلة التّعلّم، فانتسب إلى جامعة مونبیلیى حیث قضّى سنة دراسیّة (1914-1915) ذهب بعدها إلى باریس، وانتسب إلى جامعة السّوربون حیث قضى أربع سنوات (1915-1919). وما كاد یختلف إلى دروس التاریخ والأدب فیها 'حتّى أحسّ أنّه لم یكن قد هیّئ لها... وأنّ درسه الطویل فی الأزهر وفی الجامعة (المصریّة) لم یهیّئه للانتفاع بهذه الدّروس'. فأقبل على قراءة الكتب المقرّرة فی المدارس الثانویّة، ولم یجد بدّا من أن یكون 'تلمیذا ثانویا فی بیته وطالبا فی السّوربون'.
أرسل لیدرس التّاریخ فی السّوربون، فما لبث أن أیقن بأنّ الدرجات العلمیّة لا تعنی شیئا إن هی لم تقم على أساس متین من الثقافة. ولیس غلى ذلك من سبیل سوى إعداد 'اللیسانس'. وقد صرّح بذلك فی الجزء الثالث من كتاب الأیّام، قال : 'كان (الفتى' قد أزمع أن یظفر قبل كل شیء بدرجة 'اللیسانس' ثم یتقدّم لدرجة الدكتوراه بعد ذلك. ولم یكن الطلاّب المصریون - إلى ذلك الوقت - یحاولون الظفر بدرجة اللیسانس هذه، لأنّها كانت تكلّف الذین یطلبونها عناء ثقیلا'.
وأحرز طه حسین درجة 'اللیسانس فی التّاریخ' سنة 1917، فكان أوّل طالب مصرین ظفر بهذه الشهادة من كلیّة الآداب بالجامعة الفرنسیّة.
إنّ أمر هذا الفتى عَجَبٌ ! فهو قد كان یتهیّأ لامتحان اللیسانس ویعدّ فی المدّة نفسها رسالة 'دكتورا جامعة' باللّغة الفرنسیّة موضوعها : 'دراسة تحلیلیّة نقدیّة لفلسفة ابن خلدون الاجتماعیّة' (Etude analytique et critique de la philosophie sociale d'Ibn Khaldoun).
إنّ أمر هذا الفتى عجب ! فهو لم یكد یفرغ من امتحان الدكتورا حتّى نشط لإعداد رسالة أخرى، فقد صحّ منه العزم على الظفر 'بدبلوم الدّراسات العلیا' (Diplôme d'Etudes Superieures) وهو شهادة یتهیّأ بها أصحابها للانتساب إلى دروس 'التبریز فی الآداب'. وما هی إلاّ أن أشار علیه أُستاذه بموضوع عسیر مُمْتع مریر، وهو : 'القضایا التی أقیمت فی روما على حكّام الأقالیم الذین أهانوا جلال الشّعب الرّومانی، فی عهد تباریوس، كما صوّرها المؤرّخ تاسیت' (La loi de lèse-majesté, sous Tibère, d'après Tacite) فقبله الطالب 'طائعا قلقا مستخذیا'، ومارسه بالصّبر على مشقّة البحث وبالمثابرة على الفهم حتّى ناقشه ونجح فیه نُجْحًا حسنا سنة 1919.
عاد طه حسین إلى وطنه، فلم تُمهله الجامعة المصریّة وعیّنته مباشرة أستاذا للتاریخ القدیم (الیونانی والرّومانی)، فظلّ یُدرّسه طیلة ستّ سنوات كاملات (1919-1925).
بعد اكثر من قرن كامل على میلاده، و27 عاما على وفاته، ما زال عمید الادب العربی الدكتور طه حسین احد الاركان الاساسیة فی تكوین العقل العربی المعاصر، وصیاغة الحیاة الفكریة فی العالم العربی، وملمحاً أساسیاً من ملامح الادب العربی الحدیث... بل ان الاجیال الجدیدة من ابناء الامة العربیة لا تزال تكتشف جوانب جدیدة من القیمة الفكریة والانسانیة لاحد رواد حركة التنویر فی الفكر العربی... وما زالت اعمال طه حسین ومعاركه الادبیة والفكریة من أجل التقدم والتخلی عن الخرافات والخزعبلات التی حاصرت وقیدت العقل العربی لعدة قرون، من اهم الروافد التی یتسلح بها المفكرون العرب فی مواجهة الحملات الارتدادیة التی تطل برأسها فی عصرنا.
وما زالت السیرة الذاتیة لطه حسین وما تجسده من كفاح انسانی وفكری مدرسة هامة ما اشد حاجة الاجیال الجدیدة للتعلم منها والتأمل فیها.
من عزبة صغیرة (اصغر من القریة) فی صعید مصر بدأت رحلة طه حسین، فقد ولد عمید الادب العربی فی تلك البقعة الصغیرة التی تقع على بعد كیلو متر واحد من مغاغة بمحافظة المنیا فی وسط صعید مصر... كان ذلك فی الرابع عشر من نوفمبر عام 1889م، وكان والده حسین علی موظفاً فی شركة السكر وانجب ثلاثة عشر ولداً كان سابعهم فی الترتیب 'طه' الذی اصابه رمد فعالجه الحلاق علاجاً ذهب بعینیه (كما یقول هو عن نفسه فی كتاب 'الایام').
وفی عام 1898 وبینما لم یكن قد اكمل السنوات العشر كان طه حسین قد اتم حفظ القرآن الكریم... وبعد ذلك بأربع سنوات بدأت رحلته الكبرى عندما غادر القاهرة متوجها الى الازهر طلباً للعلم. فی عام 1908 بدأت ملامح شخصیة طه حسین المتمردة فی الظهور حیث بدأ یتبرم بمحاضرات معظم شیوخ الازهر فاقتصر على حضور بعضها فقط مثل درس الشیخ بخیت ودروس الادب... وفی العام ذاته انشئت الجامعة المصریة، فالتحق بها طه حسین وسمع دروس احمد زكی (باشا) فی الحضارة الاسلامیة واحمد كمال (باشا) فی الحضارة المصریة القدیمة ودروس الجغرافیا والتاریخ واللغات السامیة والفلك والادب والفلسفة على اساتذة مصریین واجانب.
فی تلك الفترة اعد طه حسین رسالته للدكتوراه نوقشت فی 15 أیار 1914م. هذه الرسالة (وكانت عن ذكرى ابی العلاء) اول كتاب قدم الى الجامعة واول رسالة دكتوراه منحتها الجامعة المصریة، واول موضوع امتحن بین ایدی الجمهور.
ومثلما كانت حیاته كلها جرأة وشجاعة واثارة للجدل فقد احدث نشر هذه الرسالة فی كتاب ضجة هائلة ومواقف متعارضة وصلت الى حد طلب احد نواب البرلمان حرمان طه حسین من حقوق الجامعیین 'لأنه الف كتابا فیه الحاد وكفر'!، ولكن سعد زغلول رئیس الجمعیة التشریعیة آنذاك اقنع النائب بالعدول عن مطالبه.
الرحلة الثانیة
اذا كانت الرحلة الاولى ذات الاثر العمیق فی حیاة طه حسین وفكره هی انتقاله من قریته فی الصعید الى القاهرة... فإن الرحلة الاخرى الاكثر تأثیراً كانت الى فرنسا فی عام 1914 حیث التحق بجامعة مونبلییه لكی یبعد عن باریس احد میادین الحرب العالمیة الاولى... وهناك درس اللغة الفرنسیة وعلم النفس والادب والتاریخ. ولاسباب مالیة اعادت الجامعة المصریة مبعوثیها فی العام التالی 1915 لكن فی نهایة العام عاد طه حسین الى بعثته ولكن الى باریس هذه المرة حیث التحق بكلیة الاداب بجامعة باریس وتلقى دروسه فی التاریخ ثم فی الاجتماع حیث اعد رسالة اخرى على ید عالم الاجتماع الشهیر 'امیل دوركایم' وكانت عن موضوع 'الفلسفة الاجتماعیة عند ابن خلدون' حیث اكملها مع 'بوجلیه' بعد وفاة دوركایم وناقشها وحصل بها على درجة الدكتوراه فی عام 1919م ثم حصل فی العام ذاته على دبلوم الدراسات العلیا فی اللغة اللاتینیة، وكان قد اقترن فی 9 اغسطس 1917 بالسیدة سوزان التی سیكون لها اثر ضخم فی حیاته بعد ذلك.
فی عام 1919 عاد طه حسین الى مصر فعین استاذاً للتاریخ الیونانی والرومانی واستمر كذلك حتى عام 1925 حیث تحولت الجامعة المصریة فی ذلك العام الى جامعة حكومیة وعین طه حسین استاذاً لتاریخ الادب العربی بكلیة الآداب.
أولى المعارك
رغم تمرده على الكثیر من اراء اساتذته الا ان معركة طه حسین الاولى والكبرى من اجل التنویر واحترام العقل تفجرت فی عام 1926 عندما اصدر كتابه 'فی الشعر الجاهلی' الذی احدث ضجة هائلة بدأت سیاسیة قبل ان تكون ادبیة. كما رفعت دعوى قضائیة ضد طه حسین فأمرت النیابة بسحب الكتاب من منافذ البیع واوقفت توزیعه... ونشبت معارك حامیة الوطیس على صفحات الصحف بین مؤیدین ومعارضین لهذا الكتاب.
وفی عام 1928 وقبل ان تهدأ ضجة كتاب الشعر الجاهلی بشكل نهائی تفجرت الضجة الثانیة بتعیینه عمیداً لكلیة الآداب الامر الذی اثار ازمة سیاسیة اخرى انتهت بالاتفاق مع طه حسین على الاستقالة فاشترط ان یعین اولاً. وبالفعل عین لیوم واحد ثم قدم الاستقالة فی المساء وأعید 'میشو' الفرنسی عمیداً لكلیة الآداب، ولكن مع انتهاء عمادة میشو عام 1930 اختارت الكلیة طه حسین عمیداً لها ووافق على ذلك وزیر المعارف الذی لم یستمر فی منصبه سوى یومین بعد هذه الموافقة وطلب منه الاستقالة.
الازمة الكبرى
وفی عام 1932 حدثت الازمة الكبرى فی مجرى حیاة طه حسین... ففی شباط 1932 كانت الحكومة ترغب فی منح الدكتوراه الفخریة من كلیة الآداب لبعض السیاسیین... فرفض طه حسین حفاظاً على مكانة الدرجة العلمیة، مما اضطر الحكومة الى اللجوء لكلیة الحقوق...
ورداً على ذلك قرر وزیر المعارف نقل طه حسین الى دیوان الوزارة فرفض العمل وتابع الحملة فی الصحف والجامعة كما رفض تسویة الازمة الا بعد اعادته الى عمله وتدخل رئیس الوزراء فأحاله الى التقاعد فی 29 آذار 1932 فلزم بیته ومارس الكتابة فی بعض الصحف الى ان اشترى امتیاز جریدة 'الوادی' وتولى الاشراف على تحریرها، ثم عاد الى الجامعة فی نهایة عام 1934 وبعدها بعامین عاد عمیداً لكلیة الاداب واستمر حتى عام 1939 عندما انتدب مراقباً للثقافة فی وزارة المعارف حتى عام .1942
ولأن حیاته الوظیفیة كانت دائماً جزءاً من الحیاة السیاسیة فی مصر صعوداً وهبوطاً فقد كان تسلم حزب الوفد للحكم فی 4 شباط 1942 ایذاناً بتغیر آخر فی حیاته الوظیفیة حیث انتدبه نجیب الهلالی وزیر المعارف آنذاك مستشاراً فنیاً له ثم مدیراً لجامعة الاسكندریة حتى احیل على التقاعد فی 16 تشرین الاول 1944 واستمر كذلك حتى 13 حزیران 1950 عندما عین لاول مرة وزیراً للمعارف فی الحكومة الوفدیة التی استمرت حتى 26 حزیران 1952 وهو یوم احراق القاهرة حیث تم حل الحكومة.
وكانت تلك آخر المهام الحكومیة التی تولاها طه حسین حیث انصرف بعد ذلك وحتى وفاته عام 1973 الى الانتاج الفكری والنشاط فی العدید من المجامع العلمیة التی كان عضواً بها داخل مصر وخارجها
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:35|
أبو العتاهیة
(748-825/130-210)
1ً
مكانه من عصره : امتاز مطلع العهد العباسی بمجرى خلاعة , و مجرى زهد كان
ردة فعل للمجرى الاول , وصدى من اصداء الحكمة التی اندفقت آنذاك على بلاد
العرب .
2ً حیاته : ولد فی قریة تدعى عین التمر وتعاطى بیع الفخار ثم قصد بغداد و تقرب الى الخلیفة المهدی , و حظی لدیه , وعلق جاریة اسمها عتبة و اكثر من التشبیب بها . ثم مال الى دراسة مذاهب المتكلمین و الزهاد , الى ان زهد بالدنیا قولا و معیشة . ولكن ولعه بالمال لم یبارحه فظل یتنقل من قصر الى قصر , فقر به الرشید و قر به المأمون من بعده . و فد توفی فی بغداد و دفن فیها .
3ً آثاره : لأبی العتاهیة دیوان طبع سنة 1886 , و فیه قسمان كبیران : قسم للزهدیات , و قسم لسائر فنون الشعر .
4ً فنون شعره :
1- الغزل : یحمل شعره الغزلی صورة نفسه , نابضاً بحرارة قلب متیم . هو غزل الحب المثالی المتألم الذی لا یخرج فی معانیه عن القدیم المعروف , ولكن الشاعر یسوقه فی بحور رشیقة مطربة .
2- المدح : كان مدحه تجاریاً و احسنه ما قیل فی المهدی و الرشید . و قد سلك فیه الشاعر مسلك البراعة فارضى نفسه و ارضى ممدوحیه . اما الطریقة فتقلیدیة و معانیه قدیمة أفرغها فی قالب شخصی جمع السهولة و الرشاقة و العذوبة . ومدحه لا یخلو من غلو التملیق .
3- الشكر و العتاب : أدخل علیهما نغمة جدیدة من التظرف فیها حذق و حلاوة .
4- الرثاء : اسلوبه فیه اسلوب المدیح و الزهد .
5- الهجاء : فیه براعة و مقدرة عجیبة على خلق الفكرة الشائكة الجارحة . وهو من نوع الشعر اللین السهل .
5ً ابو العتاهیة شاعر الزهد : تضاربت الآراء فی صدق أبی العتاهیة فی زهده . والارجح انه ظل متأرجحاً بین رغبته فی الحیاة المثلى و ضعفه الذی یجرفه نحو الاباطیل . و كان مذهبه فی زهدیاته الاغراق فی ازدراء الدنیا و الدعاء الى القناعة . و فی زهدیاته دروس قیمة لا تخلو من مغالاة و تشاؤم و زهدیات الشاعر موجهة الى العقل اكثر منها الى العاطفة , و قد اخرجها فی قالب زاهی الالوان , رائع السلالة و العذوبة و الانسجام .
6ً ابو العتاهیة الشاعر المجدد : كان ابو العتاهیة مجددا فی معانیه فقد توفر على تصویر ناحیة الجد من عصره , وكان مجددا فی فنه فامتاز شعره بالطبیعة , و سهولة اللفظ , و الموسیقى العذبة الساحرة , على ما هنالك من رتابة .
2ً حیاته : ولد فی قریة تدعى عین التمر وتعاطى بیع الفخار ثم قصد بغداد و تقرب الى الخلیفة المهدی , و حظی لدیه , وعلق جاریة اسمها عتبة و اكثر من التشبیب بها . ثم مال الى دراسة مذاهب المتكلمین و الزهاد , الى ان زهد بالدنیا قولا و معیشة . ولكن ولعه بالمال لم یبارحه فظل یتنقل من قصر الى قصر , فقر به الرشید و قر به المأمون من بعده . و فد توفی فی بغداد و دفن فیها .
3ً آثاره : لأبی العتاهیة دیوان طبع سنة 1886 , و فیه قسمان كبیران : قسم للزهدیات , و قسم لسائر فنون الشعر .
4ً فنون شعره :
1- الغزل : یحمل شعره الغزلی صورة نفسه , نابضاً بحرارة قلب متیم . هو غزل الحب المثالی المتألم الذی لا یخرج فی معانیه عن القدیم المعروف , ولكن الشاعر یسوقه فی بحور رشیقة مطربة .
2- المدح : كان مدحه تجاریاً و احسنه ما قیل فی المهدی و الرشید . و قد سلك فیه الشاعر مسلك البراعة فارضى نفسه و ارضى ممدوحیه . اما الطریقة فتقلیدیة و معانیه قدیمة أفرغها فی قالب شخصی جمع السهولة و الرشاقة و العذوبة . ومدحه لا یخلو من غلو التملیق .
3- الشكر و العتاب : أدخل علیهما نغمة جدیدة من التظرف فیها حذق و حلاوة .
4- الرثاء : اسلوبه فیه اسلوب المدیح و الزهد .
5- الهجاء : فیه براعة و مقدرة عجیبة على خلق الفكرة الشائكة الجارحة . وهو من نوع الشعر اللین السهل .
5ً ابو العتاهیة شاعر الزهد : تضاربت الآراء فی صدق أبی العتاهیة فی زهده . والارجح انه ظل متأرجحاً بین رغبته فی الحیاة المثلى و ضعفه الذی یجرفه نحو الاباطیل . و كان مذهبه فی زهدیاته الاغراق فی ازدراء الدنیا و الدعاء الى القناعة . و فی زهدیاته دروس قیمة لا تخلو من مغالاة و تشاؤم و زهدیات الشاعر موجهة الى العقل اكثر منها الى العاطفة , و قد اخرجها فی قالب زاهی الالوان , رائع السلالة و العذوبة و الانسجام .
6ً ابو العتاهیة الشاعر المجدد : كان ابو العتاهیة مجددا فی معانیه فقد توفر على تصویر ناحیة الجد من عصره , وكان مجددا فی فنه فامتاز شعره بالطبیعة , و سهولة اللفظ , و الموسیقى العذبة الساحرة , على ما هنالك من رتابة .
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:34|
أبو نواس
عرف الحسن أبو بشعر الخمریات
، فالبرغم من حدیث الأقدمین عن الخمر إلا أن ذلك كان للفخر والتمدح بالكرم
والجود ، فجاء وصفهم لطعمها ولونها والنشوة التی تحدثها فی انفس شاریبها ،
إلا ، وصف الخمر لم یكن فناً مستقلاً من فنون الشعر .
لما انتشرت الحریة والترف فی العصر العباسی بشكل كبیر مع انتشار الحانات ودور اللهو ، أغرق الناس فی حب الخمر والمجاهرة بتعاطیها بشكل أكبر عما كان عند قبلهم .
نشأ أبو نواس فی البصرة مركز الثقافة والعلم فأكب أبو نواس على العلم واللغة حتى حصل ثقافة واسعة ، وبما أن البصرة كانت مركزاً للهو أیضاً فتعرف أبو نواس وهو ما یزال شاباً على والبة بن الحباب الذی نقل إلیه الكثیر من أخلاقه الردیئة ووضعه فی مجالس الخمر لیصبح فیما بعد أمیرها .
وهكذا جمع أبو نواس اللهو والعلم ، فقد استطاع أن یقوم لسانه على لغة عربیة خالصة بعد أن أقام سنة فی البادیة ثم اتجه إلى بغداد حیث المال والجاه .
اتصل أبو نواس كما حال شعراء عصره بالخلفاء والعظماء ، إلا أن حیاته الشاذة وتطرفه جعلت مقامه بینهم قصیراً ، فقد اتصل بالرشید ، إلا أن الخلیفة اضطر لسجنه مدة وصلت إلى 14 شهر . بعد أن تطاول على بنی عدنان فهو كعادته أبداً مستهتر عدیم المسؤولیة لا یأبه ولا یكترث لشیء .
تجول أبو نواس فی البلاد المختلفة ، إلا أن حیاته ظلت واحدة من سكر واستهتار ومجون .
عاش أجمل أیامه فی كنف الأمین الذی تعرف علیه أیام طلبه العلم ، فعندما أصبح الأمین خلیفة قربه إلیه واتخذه ندیماً له ، عندئذ أخذ حریته الكاملة فی اللهو والعبث حتى ذاع أمره وانتشر خاصة بعد مقولته :
ألا فاسقنی خمراً وقل لی هی الخمر ولاتسقنی سراً إذا أمكن الجهر
لكن مع بدء الخلاف بین الأمین والمأمون نها الخلیفة الأمین أبو النواس عن المغالاة حتى لا تنفر الرعیة من خلیفتهم وتساند المأمون .
أخل نجم الأمین ومعه انطفئ أبو نواس وأخذ یشعر بالندامة والتحسر على حیاة عابثة أخذت كل قویة وحدت جسمه وقد روى الشافعی أنه لما زار أبا نواس سأله عما أكد لملاقاة ربه فأنشد أبو نواس :
تعاظمنی ذنبی قلما قرنته بعفوك ربی ، كان عفوك أعظما
أبو نواس كبشار بن برد ، جمع بین التقلید والتجدید فالتقلید كان إرضاء لذوی السلطان لنیل ودهم وبالتالی هباتهم ، فجاء شعره التقلیدی متكلفاً أورثه السأم والضجر :
دعانی إلى وصف الطول مسلط یضیق ذراعی أن أرد له أمراً
فسمعاً أمیر المؤمنین وطاعةً وإن كنت قد جشمتنی مركباً وبحرا
إلا أن إطلاعه الواسع على اللغة وشعر الأقدمین ساعده كثیراً فی شعره ، فكان مدیحه مشابهاً لمدح الشعراء السابقین ولا سیما الأمویین منهم من وقوف على الأطلال والبكاء علیها ثم وصف الناقة حتى یصل إلى الممدوح فیبالغ فی مدحه وأسلوبه الذی استعمله له ألفاظاً ضخمة مع أوزان طویلة لتلاءم تصنعه فی العاطفة ومغالاته فیها ، إلا أن الممدوح إذا قربه وألفه عندئذ یكون شعره أكثر حریة خاصة فی مدحه للأمین :
هناك الوصف والهجاء وقلیل من الرثاء ، الذی لا یناسب طبیعة أبی نواس اللاهیة المستهترة اتبع فیه أیضاً طرق الأقدمین فی الأسلوب والمعنى .
أما التجدید فهو ما یناسب أبو نواس تماماً ، ففیه حطم القیود وأطلق نفسه على سجیتها لتنشد ما تحب وتشتهی ، فأبو نواس یحب الفلسفة وحدیث الآراء والمذاهب وهذا لم یكن محبباً عند الأقدمین ، مذهبه مصلحته ، ولما كان الخلاف شدیداً بین العرب والشعوبیین المحتقرین للعرب أعطى الشعوبیون الكثیر من الحریات ومرافق الترف واللهو مما لا یحبذه العرب المتمسكون بعاداتهم ودینهم فمال أبو نواس إلى الشعوبیین فهو مغمور النسب أصلاً لا یقیده إیثار عرقی وإنما المغریات المقدمة .
تجلى شعره المجدد فی عدة مظاهر وهی :
1- الهجاء :
لم یكون أبو نواس ذلك الناقم على الجنس البشری ، همه الأوحد فضح العیوب وهتك المستور كبشار مثلاً ومع ذلك فقد عمد إلى الهجاء أحیاناً فكان إما حربیاً لیدافع عن نزعة سیاسیة أو عقیدة أدبیة ، توجه نقده للعرب عموماً وللأعراب القدماء خصوصاً ، لیظهر بذلك میله الفارسی ولیهجو العقلیة التی تعیش حیاة الخشونة والجفاء هجاؤه قد یكون انتقاصیاً لنفسه من خصومه ومنتقدیه بطریقة حادة مؤلمة وإن لم ینطو على نقمة عمیقة .
فی كل الأحوال ما جمع شعره فی هذا المجال هو الواقعیة اللاهیة ورشاقة الأسلوب ومدح الأعاجم لاسیما الفرس منهم ، هجاؤه كان مقلداً بحریر من ناحیة قذف المهجر بعبارات رزینة محكمة تتضمن معانی القذع والتعریض بالمهجر جاعلاً منه أضحوكة على ألسن الناس .
2- الطردیات أو وصف الصید :
أصبح هذا الفن قائماً بذاته فی عهد أبی نواس فقد نال هذا الفتى اهتمام أبی نواس لأنه ولع الأمراء فكان شاعرنا یرافقهم مما ساعده على الإتیان بصور واقعیة متقنة كصور آلات الصید والطرائد والتی استعان فیها بالصور البدیعة من استعارات وتشابیه خیالیة .
3- الزهدیات :
وهی قصائد أبی نواس فی آخر أیامه بعد أن تحطمت قواه ، فانكفأ على نفسه متبصراً المعاصی الكثیرة التی ملأت حیاته ، جاءت هذه القصائد أبعد ما تكون عن العظات فهی أقرب إلى الشعر الغنائی المعبر عن نغمات شجیة من قلب متألم فی عبارات صادقة ، عمیقة العاطفة فكانت من أجمل شعر أبی نواس .
4- الغزل :
جاء غزله متصنعاً فعشقه الوحید كانت المتعة والعبث فلا مكان للعواطف الصادقة لتغزو قلبه أما التغزل بالكلمات والكلامیات فهو ما برع به أبو نواس والذی اعتبره كثیر من دارسی الأدب وصمة فی تاریخ العرب .
5- الخمریات :
فیها تجلت عبقریة أبو نواس وأكثر ما اشتهر به ، فكانت الخمرة عشقه ومعبوده فهی أشبه بإنسان نبه الشاعر كل هواه .
الشعر عند أبی نواس هو لوصف الواقع كما هو ، دون الحاجة لأسلوب الأقدمین ، فكان وصفه للخمرة حسیاً فیما یتعلق برائحتها ومذاقها وألوانها وتأثیرها فی الحس والنفس .
من لاف كأنا كل شیء یتمنى مخیر أن یكونا
أكل الدهر ما تجسم فیها وتبقى لبائها مكنونا
فإذا ما اجتلیتها فهباء تمنع الكف ما تبیح العیونا
ما یمیز كلامه على الخمرة هو التشخیص والظرف التی فیها خفة روح الشاعر وصدقه فی حبه للخمرة فجاء أسلوبه موسیقیاً سلسلاً فی رشیق وقافیة خفیفة .
ما یمیز شعر أبی نواس هو بعده عن التكرار والجحود فكان شعره متنوع المعانی والصور فی أسلوبه الشعر الوصفی الخطابی والغنائی والقصصی .
أما لغته فهی سلسلة ،غنیة واضحة عبرت عن عاطفة رقیقة فیها سذاجة من أعجب بنفسه بكل ما فیها من نزعات وشذوذ :
مازلت أستل رووح الدن فی لطف وأستقی دمه فی جوف مجروح
حتى انثنیت ولی روحان فی جسد والدن منطرح ، جسماً بلا روح
تتمثل شاعریة أبی نواس بقدرته التی تصل إلى حد العبقریة وجمال تشخیصه ولوحاته الزاهیة التی عبرت عن شخصیة تلقائیة .
لما انتشرت الحریة والترف فی العصر العباسی بشكل كبیر مع انتشار الحانات ودور اللهو ، أغرق الناس فی حب الخمر والمجاهرة بتعاطیها بشكل أكبر عما كان عند قبلهم .
نشأ أبو نواس فی البصرة مركز الثقافة والعلم فأكب أبو نواس على العلم واللغة حتى حصل ثقافة واسعة ، وبما أن البصرة كانت مركزاً للهو أیضاً فتعرف أبو نواس وهو ما یزال شاباً على والبة بن الحباب الذی نقل إلیه الكثیر من أخلاقه الردیئة ووضعه فی مجالس الخمر لیصبح فیما بعد أمیرها .
وهكذا جمع أبو نواس اللهو والعلم ، فقد استطاع أن یقوم لسانه على لغة عربیة خالصة بعد أن أقام سنة فی البادیة ثم اتجه إلى بغداد حیث المال والجاه .
اتصل أبو نواس كما حال شعراء عصره بالخلفاء والعظماء ، إلا أن حیاته الشاذة وتطرفه جعلت مقامه بینهم قصیراً ، فقد اتصل بالرشید ، إلا أن الخلیفة اضطر لسجنه مدة وصلت إلى 14 شهر . بعد أن تطاول على بنی عدنان فهو كعادته أبداً مستهتر عدیم المسؤولیة لا یأبه ولا یكترث لشیء .
تجول أبو نواس فی البلاد المختلفة ، إلا أن حیاته ظلت واحدة من سكر واستهتار ومجون .
عاش أجمل أیامه فی كنف الأمین الذی تعرف علیه أیام طلبه العلم ، فعندما أصبح الأمین خلیفة قربه إلیه واتخذه ندیماً له ، عندئذ أخذ حریته الكاملة فی اللهو والعبث حتى ذاع أمره وانتشر خاصة بعد مقولته :
ألا فاسقنی خمراً وقل لی هی الخمر ولاتسقنی سراً إذا أمكن الجهر
لكن مع بدء الخلاف بین الأمین والمأمون نها الخلیفة الأمین أبو النواس عن المغالاة حتى لا تنفر الرعیة من خلیفتهم وتساند المأمون .
أخل نجم الأمین ومعه انطفئ أبو نواس وأخذ یشعر بالندامة والتحسر على حیاة عابثة أخذت كل قویة وحدت جسمه وقد روى الشافعی أنه لما زار أبا نواس سأله عما أكد لملاقاة ربه فأنشد أبو نواس :
تعاظمنی ذنبی قلما قرنته بعفوك ربی ، كان عفوك أعظما
أبو نواس كبشار بن برد ، جمع بین التقلید والتجدید فالتقلید كان إرضاء لذوی السلطان لنیل ودهم وبالتالی هباتهم ، فجاء شعره التقلیدی متكلفاً أورثه السأم والضجر :
دعانی إلى وصف الطول مسلط یضیق ذراعی أن أرد له أمراً
فسمعاً أمیر المؤمنین وطاعةً وإن كنت قد جشمتنی مركباً وبحرا
إلا أن إطلاعه الواسع على اللغة وشعر الأقدمین ساعده كثیراً فی شعره ، فكان مدیحه مشابهاً لمدح الشعراء السابقین ولا سیما الأمویین منهم من وقوف على الأطلال والبكاء علیها ثم وصف الناقة حتى یصل إلى الممدوح فیبالغ فی مدحه وأسلوبه الذی استعمله له ألفاظاً ضخمة مع أوزان طویلة لتلاءم تصنعه فی العاطفة ومغالاته فیها ، إلا أن الممدوح إذا قربه وألفه عندئذ یكون شعره أكثر حریة خاصة فی مدحه للأمین :
هناك الوصف والهجاء وقلیل من الرثاء ، الذی لا یناسب طبیعة أبی نواس اللاهیة المستهترة اتبع فیه أیضاً طرق الأقدمین فی الأسلوب والمعنى .
أما التجدید فهو ما یناسب أبو نواس تماماً ، ففیه حطم القیود وأطلق نفسه على سجیتها لتنشد ما تحب وتشتهی ، فأبو نواس یحب الفلسفة وحدیث الآراء والمذاهب وهذا لم یكن محبباً عند الأقدمین ، مذهبه مصلحته ، ولما كان الخلاف شدیداً بین العرب والشعوبیین المحتقرین للعرب أعطى الشعوبیون الكثیر من الحریات ومرافق الترف واللهو مما لا یحبذه العرب المتمسكون بعاداتهم ودینهم فمال أبو نواس إلى الشعوبیین فهو مغمور النسب أصلاً لا یقیده إیثار عرقی وإنما المغریات المقدمة .
تجلى شعره المجدد فی عدة مظاهر وهی :
1- الهجاء :
لم یكون أبو نواس ذلك الناقم على الجنس البشری ، همه الأوحد فضح العیوب وهتك المستور كبشار مثلاً ومع ذلك فقد عمد إلى الهجاء أحیاناً فكان إما حربیاً لیدافع عن نزعة سیاسیة أو عقیدة أدبیة ، توجه نقده للعرب عموماً وللأعراب القدماء خصوصاً ، لیظهر بذلك میله الفارسی ولیهجو العقلیة التی تعیش حیاة الخشونة والجفاء هجاؤه قد یكون انتقاصیاً لنفسه من خصومه ومنتقدیه بطریقة حادة مؤلمة وإن لم ینطو على نقمة عمیقة .
فی كل الأحوال ما جمع شعره فی هذا المجال هو الواقعیة اللاهیة ورشاقة الأسلوب ومدح الأعاجم لاسیما الفرس منهم ، هجاؤه كان مقلداً بحریر من ناحیة قذف المهجر بعبارات رزینة محكمة تتضمن معانی القذع والتعریض بالمهجر جاعلاً منه أضحوكة على ألسن الناس .
2- الطردیات أو وصف الصید :
أصبح هذا الفن قائماً بذاته فی عهد أبی نواس فقد نال هذا الفتى اهتمام أبی نواس لأنه ولع الأمراء فكان شاعرنا یرافقهم مما ساعده على الإتیان بصور واقعیة متقنة كصور آلات الصید والطرائد والتی استعان فیها بالصور البدیعة من استعارات وتشابیه خیالیة .
3- الزهدیات :
وهی قصائد أبی نواس فی آخر أیامه بعد أن تحطمت قواه ، فانكفأ على نفسه متبصراً المعاصی الكثیرة التی ملأت حیاته ، جاءت هذه القصائد أبعد ما تكون عن العظات فهی أقرب إلى الشعر الغنائی المعبر عن نغمات شجیة من قلب متألم فی عبارات صادقة ، عمیقة العاطفة فكانت من أجمل شعر أبی نواس .
4- الغزل :
جاء غزله متصنعاً فعشقه الوحید كانت المتعة والعبث فلا مكان للعواطف الصادقة لتغزو قلبه أما التغزل بالكلمات والكلامیات فهو ما برع به أبو نواس والذی اعتبره كثیر من دارسی الأدب وصمة فی تاریخ العرب .
5- الخمریات :
فیها تجلت عبقریة أبو نواس وأكثر ما اشتهر به ، فكانت الخمرة عشقه ومعبوده فهی أشبه بإنسان نبه الشاعر كل هواه .
الشعر عند أبی نواس هو لوصف الواقع كما هو ، دون الحاجة لأسلوب الأقدمین ، فكان وصفه للخمرة حسیاً فیما یتعلق برائحتها ومذاقها وألوانها وتأثیرها فی الحس والنفس .
من لاف كأنا كل شیء یتمنى مخیر أن یكونا
أكل الدهر ما تجسم فیها وتبقى لبائها مكنونا
فإذا ما اجتلیتها فهباء تمنع الكف ما تبیح العیونا
ما یمیز كلامه على الخمرة هو التشخیص والظرف التی فیها خفة روح الشاعر وصدقه فی حبه للخمرة فجاء أسلوبه موسیقیاً سلسلاً فی رشیق وقافیة خفیفة .
ما یمیز شعر أبی نواس هو بعده عن التكرار والجحود فكان شعره متنوع المعانی والصور فی أسلوبه الشعر الوصفی الخطابی والغنائی والقصصی .
أما لغته فهی سلسلة ،غنیة واضحة عبرت عن عاطفة رقیقة فیها سذاجة من أعجب بنفسه بكل ما فیها من نزعات وشذوذ :
مازلت أستل رووح الدن فی لطف وأستقی دمه فی جوف مجروح
حتى انثنیت ولی روحان فی جسد والدن منطرح ، جسماً بلا روح
تتمثل شاعریة أبی نواس بقدرته التی تصل إلى حد العبقریة وجمال تشخیصه ولوحاته الزاهیة التی عبرت عن شخصیة تلقائیة .
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:34|
عصر النهضة ( 1798 إلى الوقت الحالی )
انتشر الجهل فی المشرق العربی المغلق على نفسه بشكل یكون تاماً ، فكان احتكاك الشرق بالغرب من أهم مقدمات النهضة ، فظهر هذا الاحتكاك بشكل خاص فی لبنان ومصر دون سواهم من البلاد العربیة .
فكانت لبنان محط أنظار الغربیین فاتصلوا بأمرائهم الذین شجعوا بدورهم هجرة الغربیین .
أما مصر فكان اتصالها من خلال الحملة الفرنسیة بقیادة نابلیون بونابرت الذی ضم فی حملته مجموعة من العلماء والصناع ، كذلك جهز حملته بمطبعة عربیة مع مراجع وكتب من مصر ، فأنشأ مجمعاً علمیاً وأصدر صحیفتین بالفرنسیة .
بعد جلوس محمد علی على عرش مصر أكمل الرحلة العلمیة التی بدأت فی مصر .
بدأت الحیاة تدب فی أوصال البلاد العربیة فكانت المدارس التی ساعدت على رقی البلاد ونشر العلم فیها كالأزهر فی مصر وعین ورقة فی لبنان .
أما الطباعة فقد جعلت المعارف للجمیع فصنع عبد الله الزاخر الحروف العربیة لمطبعة حلب ثم لمطبعة دیر الشویر .
ساعدت الطباعة على تنشیط الصحافة وانتشارها ، فكانت مصر المهد الأول للصحافة العربیة بدءاً من جریدة الوقائع المصریة فی عهد محمد علی .
ظهرت الجمعیات العلمیة والأدبیة التی ساعدت العلماء والأدباء على التكتل وتبادل الأبحاث لترقیة العلوم ونشر الفنون فكانت الجمعیة السوریة فی لبنان .
بعد دمار الكثیر من المكتبات التی ضمت أمهات الكتب ، عمد المثقفون نتیجة اتصالهم وتأثرهم بالغرب على إنشاء المكتبات العامة والخاصة واعتماد الأسالیب الحدیثة فی تنظیمها ونشر الفهارس كالمكتبة الظاهریة بدمشق .
نتیجة اجتماع هذه العوامل وغیرها ،كانت النهضة العربیة والتی مرت بمرحلتین أساسیتین :
1- مرحلة التقلید :
لم یلقى الشعر من الاهتمام ما لاقته العلوم الأخرى ، فكان الشعر ركیكاً ضعیفاً ، فكانت هذه المرحلة صلة الوصل بین الانحطاط والنهضة .
ومع تحسن الأحوال الاجتماعیة والثقافیة فی منتصف القرن التاسع عشر ، عاد الأدباء العرب إلى معین اللغة العربیة فدرسوها ودرسوا أسباب ضعفها محاولین تقلید من سبقهم وخاصة العباسیین منهم فكانت المتانة اللغویة والدقة فی التعبیر ، دون التخلص تماماً من الأسالیب البدیعیة والأسالیب الأخرى من مخلفات عصر الانحطاط ، من شعراء هذه الفترة محمود سامی البارودی .
2- مرحلة التجوید :
لما قوی اتصال الشرق بالغرب وتعرف أبناء الشرق على ثقافات وحضارة الغرب ، ظهرت عندهم نزعة التحرر من القدیم بكل ما یمثله من جهل وتخلف ، فالعصر الذی یعیشون فیه مختلف تمام الاختلاف عن عصر مما سبقوهم ولذا كان على الأدب أن یمثل العصر الجدید بكل ما فیه ولیس القدیم الذی ولى ، فهم یتطلعون إلى الأمام الذی یمثل المستقبل النیر .
فكان من الأدباء من أراد التجدید ولكن ضمن أسس الأدب العربی القدیم ، فالحدیث هو امتداد للقدیم واستفادة من الأدب الغربی الحدیث بما یتلاءم والثقافة العربیة .
إلا أن فئة أخرى نادت وخاصة بعد الحرب العالمیة الأولى بدأت تنادی بالتخلص من كل ما هو قدیم وتقلید الغرب بكل ما فیه تقلیداً أعمى فكانت النزعة الرومنطیقیة التی أرادت أ، تعبر عن الذات والواقع بشكل أكبر .
كذلك ظهرت المدرسة الرمزیة كرد فعل على الرومنطیقیة ، غالت هذه المدرسة فی استعمال الرموز والتعبیر المعقد وغیبت بالألفاظ السهلة مما جعلها عرضة للأخطاء اللغویة .
أما المدرسة الثالثة فقد عنیت بالنزعة الإنسانیة للأدب والتركیز على الكیان الاجتماعی .
أما موضوعات الشعر فقد تركزت على الشعر السیاسی المنادی بالاستقلال والدیمقراطیة . والشعر الاجتماعی الذی دعا للتحرر من قیود الماضی والتخلص من الأمراض الاجتماعیة ، فنادى إلى تحریر المرأة ورفع شأنها . وأیضاً الشعر التمثیلی القصصی والذی یعمد الشعراء فیه للتعبیر عن نزعة اجتماعیة أو فلسفیة .
المبنى الشعری متفاوت بین الأدباء فمنهم من حافظ على الأوزان القدیمة ولكن القصیرة منها والخفیفة ، ومنهم من سلك أسلوب الموشحات التی لا تلتزم قافیة واحدة .
أما البعض منهم فأراد الشعر أن یكون ما یعرف بالشعر المنثور .
من أعلام هذه المرحلة : أحمد شوقی وحافظ إبراهیم وخلیل مطران .
ونبدأ بمرحلة التقلید لنتحدث فیها عن محمود سامی البارودی كمثال عن هذه المرحلة .
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:33|
العهد العباسی ( 132 – 656 هجری )
بعد انتقال الخلافة إلى بنی عباس عم الرسول محمد صلى الله علیه و سلم , أصبح مركز الخلافة فی بغداد . و لما كان الفرس و الشعوبیون من أكبر المساندین لبنی العباس فی انقلابهم , كانت لهم مكانةً كبیرة عند الخلفاء و أصبح العرب عنصراً من العناصر الكثیرة التی احتوتها الإمبراطوریة الإسلامیة .
انفتح العرب على حضاراتٍ أخرى و خاصةً الفارسیة , فأخذ العرب الكثیر من عاداتهم و تقالیدهم , و ظهر مبدأ التخیر , أی اختیار أفضل ما فی الحضارات القدیمة و العمل بها .
لا شك أن الخلافة الإسلامیة عاشت عصراً ذهبیاً فی ظل العباسیین , فكانت الثروات و الازدهار الاقتصادی الذی أدى إلى الترف و الانحطاط الأخلاقی فی بیئةٍ لم تعد بالعربیة و إنما ضمت فرساً و أتراكاً و برابرة . فأصبحت مجالس اللهو و الغناء أمراً شائعاً بین الناس . و بما أن الشعر هو مرآة عصره , فقد اصطبغت أغراض الشعر باهتمامات الناس و نمط حیاتهم الذی تمیز بالتجدد و التنوع كتنوع الثقافات التی احتوتها دولة الإسلام . فالتجدید و لیس الإنقلاب هو ما یمیز الأغراض الشعریة فی هذا العصر .
فقد أهمل الشعر السیاسی لقلة الحاجة إلیه , و اختنق الغزل العذری فی جو الفساد و المجون , و قد انتابت شعر الفخر و الحماسة الذی ارتبط فیما مضى بالعصبیة القبلیة نفس الحالة .
ما میز هذا العصر هو الشعر الفلسفی الذی تمیز بنظرةٍ تحلیلیة لكل ما حوله , إضافةً إلى الشعر الصوفی الذی سمى إلى جو الروحانیات و التأمل فی الله و كماله و صفاته .
كما أصبح الشعر وسیلةً تعلیمیةً یستعمله أصحابه لتسهیل الحفظ و إیصال الفكرة إلى الطلاب , فكان الشعر التعلیمی كقصائد الفقه و كتاب كلیلة و دمنة القصة التی نظمت شعراً , و هناك أیضاً الشعر التكهمی و الهزلی , و ظهر باب الزهد بنزعته الفلسفیة , كما ظهر شعر تغزلٍ بالخمر و المجون .و لكن أبرز الفنون كانت المدح و الرثاء , فلكل أمیرٍ صفاتٌ فائقةٌ فی الحرب و شدة البأس و السخاء , و لكل عالمٍ أبحرٌ من صفات العقل و المعرفة , فلكل ممدوحٍ نفس الصفات إلا ما تجود به قریحة الشاعر و أقواله . و من الجدیر بالذكر أنه قد ازداد إقبال الناس على الشعر عندما أصبح وسیلةً للتكسب .
وكذلك الهجاء زاد عندما زاد النافس بین العظماء فكان وسیلة لرزق كما فی المدح وله استعملت أفظع الألفاظ وأشنعها فی غیر ما نعومة ولا لطافة إلا نادراً .
لانتشار الحكمة الفلسفیة وظهر ما عرف بالشعر الحكمی الذی أصبح عمیقاً فی معناه وتحلیله .
أما العزل فأصبح الفحش والمجون دون أی خجل هو ما میز شعر هذا العهد ما زاده سوءاً توفر الإماء الأجنبیات ومجالس اللهو .
أما الوصف فقد غذته مشاهد الحضارة الجدیدة فذكرت المبانی والمصنوعات كالبركة وأنواع الطعام ، دون نسیان القصور المحفوفة بالبساتین .
رقم التجدد فی أغراض الشعر إلا أن بناء القصیدة حافظ على الأوضاع الموروثة عن الأقدمین كالتزام البحر الواحد وبدء القصیدة بالغزل وذكر الدیار .
كتمهید للمدح أو الهجاء أو غیرهما ، رغم تجدیدهم أحیاناً وذلك بذكر القصور والخمور بدل الأطلال ، ومراعاة ترابط القصیدة الشیء الذی افتقدته بمراحلها السابقة ، كما ركزوا على البحور الخفیفة وابتداع بحور أخرى ومراعاة الترتیب فی التركیب والابتعاد عن كل ما هو غریب لتأتی ألفاظهم عذبة وائحة غنیة بأسالیب البیان والبدیع ، إلا أن هذه الزخرفة والصنعة أخذت مع مرور الأیام تحتل مكانة أكبر من عمق المعنى .
وبالمجمل یمكن تقسم الأدب العباسی إل ثلاثة أقسام :
1- أدب التجدید :
امتد من فجر العهد العباسی إلى أوائل القرن الثالث الهجری ، والذی تمیز بمحاولات جرئیة للتجدید فی أغراض الشعر المختلفة كالهجاء والمجون .
( بشار بن برد ) ، فی الخمر أبو نواس ، فی الزهد ( أبو العتاهیة ) .
2- أدب الحركة المعاكسة :
امتد من أوائل القرن الثالث الهجری إلى أوائل الرابع الهجری ، حیث ارتد الشعراء عن حركة التجدید التی سادت بین من جاء قبلهم ، فعاد شعراء هذا لعصر إلى كل ما هو قدیم وأصیل لیس فقط فی الأدب وإنما فی العلوم الدینیة أیضاً بعد أن احتل علم الكلام والفلسفة مكانة بارزة بین من سبقهم ، لكن هذا الرجوع دمج القدیم مع الجدید كأبی تمام والبحتری .
3- أدب الانحدار الصنعة الأدبیة :
والذی یمتد إلى آخر العهد العباسی هذا العصر كثر شعراؤه وقل مبدعوه من أشهر شعراءه : المتنبی وأبو فراس الحمدانی وأبو العلاء المعری .
شیئاً فشیئاً بدأت الامبراطوریة الكبرى بالانحلال وطمع العدیدین بالملك كالاخشیدیین فی مصر والقرامطة فی البحرین .
أدى الفساد السیاسی وضعف مركز الخلافة إلى فساد فی الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة فانتشرت الثورات وعم الظلم .
أما الحالة الفكریة فكان القرن العاشر أزهى عصور العلم فازدهرت العلوم المختلفة ، ومما ساعد على رواجها تنافس الأمراء لنیل المجد العلمی فظهرت عواصم الثقافة مثل حلب والقاهرة وقرطبة وجرجان .
أما الحالة الأدبیة فقد كثر فیها الأدباء مع نزعة شدیدة إلى التقلید وصلت إلى حد الجمود ، فكثرت السرقة الأدبیة كأنه لم یعد من جدید یقال ، ولم یفلت من هذه الآفة إلا القلیل فأقدموا على تجدید أبواب شعر لم تكن مزدهرة قبلاً بسبب البیئة ، من هذه الأبواب : الشعر الصوفی الذی ازدهر مع النزعة الفلسفیة والتصرف ، كذلك الشعر الفخری والحماسی فكان نابضاً بالحیاة مندفعاً یعبر عن اضطراب الأحوال وكثرة الغارات على البلاد الإسلامیة .
أما الدهریات فكانت نتاج تشكی الناس منكل ما یحیط بهم من مشاكل واضطراب فجاءت إما ضمن أبیات مستقلة أو ضمن قصیدة ذموا فیها الدهر وقسوته .
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:33|
العهد الأندلسی (138-897 هـ )
أطلق اسم الأندلس على البلاد
التی افتتحها العرب فی جزیرة ایبیریة ،جاء اسم الأندلس اشتقاقاً من كلمة
فندال وهم القبائل الذین غزوا إسبانیة فیالقرن الخامس للمیلاد ،فلما دخل
العرب أطلقوا الاسم على جمیع البلاد الواقعة فی حوزتهم .
فی الأندلس اجتمع الجمال بطبیعتها الخضرة ومیاهها الغزیرة مع الثراء بازدهار التجارة وتشیید المدن والقصور الفخمة من أشهرها قصر الزهراء .
أما الحیاة الاجتماعیة فجاءت مزیجاً من تأثر العرب بیادات وأخلاق السكان مع محاكاتهم للشرق ، فكان هم خلفاء الأندلس مضاهاة العباسیین ومنافستهم فكانوا یسمون غرناطة دمشق والشاعر ابن زیدون بالبحتری .
ظلت اللغة العربیة هی اللغة الرسمیة فی بلاد الأندلس ، فأنشئت معاهد كثیرة للعلم واهتم الأمراء بجمع الكتب ونسخها وضبطها فانتشر العلم بین الناس وبرزت مدن العلم كقرطبة وإشبیلة .
أما الشعر الأندلسی فقد مر بعدة مراحل وهی :
1- شعر التقلید :
عندما دخل العرب إلى الأندلس ظلوا محافظین على تقالیدهم لا یجیدون عنها بشیء وكذلك كان الحال بالنسبة للشعر الذی جاء شرقیاً أمویاً ، وهذا ما نراه فی شعر ابن *** وابن شهید .
2- حركة التحرر بدأت فی القرن الخامس الهجری ، وهنا بدأ الشعراء یستلهمون شعرهم من بیئتهم مفتتنین ببیئتهم الجدیدة وجمالها ، لكن دون إهمال نزعتهم التقلیدیة وهذا ما نراه فی شعر ابن زیدون والمعتمد بن عباد .
3- حركة التجدید :
بلغت أوجها فی القرن السادس للهجرة حیث صور الشعراء الأندلس تملؤهم نزعتهم للتحرر والتجدید فأخذ كل شاعر یصف إقلیمه وجمال بلاده التی عاش فیها فكان الأندلسیون مقرمین بالبحر الأنهار بعد أن عرف عن العرب نفورهم منها كقول ابن خفاجة فی وصف نهر :
وغدت تحف به الغصون كأنها هدب یحف بمقلة زرقاء
والریح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصیل على لجین الماء
برز فی هذا العصر ابن خفاجة وابن حمدیس الصقلی تعددت أغراض الشعر الأندلسی وفنونه فهناك :
1- الوصف :
كان له مكانة كبیرة بین الشعراء الذی عبروا فیه عن بیئتهم بكل ما فیها من مظاهر طبیعیة ، كذلك قاموا بوصف حیاتهم الاعتیادیة كالمآكل والزینة والمعارك .
2- رثاء الممالك :
نتیجة الانقلاب وزوال الدول عمد الشعراء لندب المجد الزائل والتأمل بحال الدهر وغدره فندب أبو البقاء الزندی حظ الأندلس بعد أن ذهبت للأبد من أیدی العرب .
3- الشكوى :
نظم هذا الشعر من الوزراء وأرباب السلطة بعد أن خانهم الدهر وانقلبوا أذلة بعد عز فقاموا بندب ماضیهم والتشكی مما آلت إلیه حیاتهم .
4- الاستنجار :
جاء من ضعف وخوف من الأعداد الذین أصبحوا أكثر من الأصدقاء فعمد الشعراء إلى الالتجاء إلى الأولیاء والأعوان سائلین النجدة .
5- نظم العلوم والفنون :
كثرت هذه الظاهرة لتسهیل الحفظ فكانت اللامیة الرائیة للشاطبی فی القراءات ورسم المصحف .
وكمثال عن مراحل الشعر العربی فی الأندلس نبدأ بشعراء مرحلة التقلید وهما ابن هانئ وابن شهید
فی الأندلس اجتمع الجمال بطبیعتها الخضرة ومیاهها الغزیرة مع الثراء بازدهار التجارة وتشیید المدن والقصور الفخمة من أشهرها قصر الزهراء .
أما الحیاة الاجتماعیة فجاءت مزیجاً من تأثر العرب بیادات وأخلاق السكان مع محاكاتهم للشرق ، فكان هم خلفاء الأندلس مضاهاة العباسیین ومنافستهم فكانوا یسمون غرناطة دمشق والشاعر ابن زیدون بالبحتری .
ظلت اللغة العربیة هی اللغة الرسمیة فی بلاد الأندلس ، فأنشئت معاهد كثیرة للعلم واهتم الأمراء بجمع الكتب ونسخها وضبطها فانتشر العلم بین الناس وبرزت مدن العلم كقرطبة وإشبیلة .
أما الشعر الأندلسی فقد مر بعدة مراحل وهی :
1- شعر التقلید :
عندما دخل العرب إلى الأندلس ظلوا محافظین على تقالیدهم لا یجیدون عنها بشیء وكذلك كان الحال بالنسبة للشعر الذی جاء شرقیاً أمویاً ، وهذا ما نراه فی شعر ابن *** وابن شهید .
2- حركة التحرر بدأت فی القرن الخامس الهجری ، وهنا بدأ الشعراء یستلهمون شعرهم من بیئتهم مفتتنین ببیئتهم الجدیدة وجمالها ، لكن دون إهمال نزعتهم التقلیدیة وهذا ما نراه فی شعر ابن زیدون والمعتمد بن عباد .
3- حركة التجدید :
بلغت أوجها فی القرن السادس للهجرة حیث صور الشعراء الأندلس تملؤهم نزعتهم للتحرر والتجدید فأخذ كل شاعر یصف إقلیمه وجمال بلاده التی عاش فیها فكان الأندلسیون مقرمین بالبحر الأنهار بعد أن عرف عن العرب نفورهم منها كقول ابن خفاجة فی وصف نهر :
وغدت تحف به الغصون كأنها هدب یحف بمقلة زرقاء
والریح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصیل على لجین الماء
برز فی هذا العصر ابن خفاجة وابن حمدیس الصقلی تعددت أغراض الشعر الأندلسی وفنونه فهناك :
1- الوصف :
كان له مكانة كبیرة بین الشعراء الذی عبروا فیه عن بیئتهم بكل ما فیها من مظاهر طبیعیة ، كذلك قاموا بوصف حیاتهم الاعتیادیة كالمآكل والزینة والمعارك .
2- رثاء الممالك :
نتیجة الانقلاب وزوال الدول عمد الشعراء لندب المجد الزائل والتأمل بحال الدهر وغدره فندب أبو البقاء الزندی حظ الأندلس بعد أن ذهبت للأبد من أیدی العرب .
3- الشكوى :
نظم هذا الشعر من الوزراء وأرباب السلطة بعد أن خانهم الدهر وانقلبوا أذلة بعد عز فقاموا بندب ماضیهم والتشكی مما آلت إلیه حیاتهم .
4- الاستنجار :
جاء من ضعف وخوف من الأعداد الذین أصبحوا أكثر من الأصدقاء فعمد الشعراء إلى الالتجاء إلى الأولیاء والأعوان سائلین النجدة .
5- نظم العلوم والفنون :
كثرت هذه الظاهرة لتسهیل الحفظ فكانت اللامیة الرائیة للشاطبی فی القراءات ورسم المصحف .
وكمثال عن مراحل الشعر العربی فی الأندلس نبدأ بشعراء مرحلة التقلید وهما ابن هانئ وابن شهید
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:32|
التجدید العروضی الغنائی فی
شعر الموشحات الأندلسیة
احتاجت الدولة العربیة فی الأندلس إلى قرنین أو ثلاثة قرون من تأسیسها حتى تستقر أركانها وتثبت دعائمها. وعندئذ مال الناس إلى الترف واللهو فی حیاتهم، وكان من آثار ذلك انتشار الغناء ودواعی الطرب، وزیادة الاهتمام بالألحان، والموسیقا وآلاتها.
ولاشك أن لهذه الحال الاجتماعیة أثراً كبیراً فی نشأة الموشحات وشیوعها، لأن الموشحات عامة تدخل فی إطار الاتجاه الشعبی الذی هیأ له نمو الشخصیة الأندلسیة وإسهام الأندلسیین فی إنشاد الشعر والإصغاء إلى ألحانه فی مجالسهم وأسمارهم.
وهذه الصلة الوثیقة بین الموشحات والغناء تبدو فی اعتماد لغة الموشحات على الألفاظ الرقیقة الغزلة الهزازة والمعانی الطریفة، على ما فیها من سطحیة، وبموضوعاتها التی تناسب جو الغناء والمرح من غزل ووصف خمر وطبیعة ساحرة عرفت بها بلاد الأندلس ومرابعها العامرة.
وعلى الرغم من قوة الصلة بین الموشحات وبین الموسیقا وطریقة الغناء، فإننا لا نعلم شیئاً عن النظریة الإیقاعیة التی قامت علیها الموشحات، ولا عن كیفیة أدائها وتلحینها وإنشادها، ولكن الراجح أنها كانت تصاغ على نهج معین لتتسق مع النغم المنشود، وأنها كانت تغنى بطریقة فردیة، لا بطریقة "الكورس"، وأن الوشاح هو الملحن غالباً، وقد یكون غیره. أما المغنی فهو شخص آخر. وأغلب الظن أن بواكیر الموشحات عاشت زمناً بین الناس مسموعة لا مقروءة. ولم یعمد أحد إلى تدوینها فی بادئ الأمر. ولیس معنى ذلك أن الموشحات جمیعاً كانت تغنى، إذ لا شك أن كثیراً منها نظم لغیر غرض الغناء والتلحین، ولاسیما تلك التی لا تتصل مناسبتها ولا موضوعها بهذا الجانب: كالهجاء والرثاء والزهد.
وهذا كله یعنی أن الموشح فن أندلسی أصیل ابتدعه العرب فی ظل ظروف اجتماعیة خاصة، وهذا ما أكده المؤلفون العرب من أندلسیین ومشارقة، كابن خلدون فی مقدمته، وابن بسام فی ذخیرته، وابن دحیة فی "المطرب"، والمقری فی نفح الطیب، وابن سناء الملك فی "دار الطراز"، وغیرهم، وإن كانت هناك أقوال یسیرة تنسب ظهور بدایات هذا الفن إلى المشارقة.
أما الأثر المتبادل بین فن الموشحات وشعر التروبادور Troubaours، فما زال یفتقر إلى مزید من المناقشة والتثبت والتمحیص، وإلى القول الفصل فی مدى التأثیر والتأثر بینهما(2). فالموشحات إذن هی عربیة الأرومة، وفن جدید فی الشعر الأندلسی، لأن البیئة فی الأندلس كانت مواتیة للتجدید أكثر من المشرق، ویمكن أن نحدد الموشح بأنه قالب شعری عربی وشكل مستحدث للقصیدة شذ فیه الأندلسیون عن مأثور نظامها الموسیقی الموروث فی الوزن الواحد، والقافیة الواحدة، إلى نظام آخر یحمل خصائص معینة.
وأهم هذه الخصائص –مما یدخل فی نطاق بحثنا هذا- خروج الموشح على نظام القافیة الواحدة فی القصیدة، واللجوء إلى التنویع فی القوافی والتوزیع الإیقاعی وفق نسق معین یجعل الموشح حقاً أشبه بالوشاح المزین المزركش الذی رصعته الجواهر المتلألئة، وزینته الزخارف والنمنمات الملونة، فضلاً عن "الخرجة" التی تأتی فی خاتمة الموشح زینة أخرى متمیزة، عندهم، بخصائص ینبغی للوشاح مراعاتها.
ومن هذا المنطلق، منطلق التجدید العروضی الإیقاعی، والموسیقی الغنائی، نشیر إلى أن الوشاحین الأندلسیین –على كثرتهم- لم یبینوا لنا بصورة واضحة قواعد الموشح وأسس بنائه ومصطلحاته، وإن كنا نجد هنا وهناك بعض الإشارات إلى أصول هذا الفن. وربما كان ابن سناء الملك، المصری، (608ه/1212م) أول من حاول أن یحدد قواعد هذا الفن الشعری وأوزانه، ویبیّن لنا خصائصه وطرق نظمه، وذلك فی كتابه القیّم "دار الطراز فی عمل الموشحات". وتكونت نتیجة لذلك كله جملة من التقسیمات والتصنیفات التی حملت مصطلحات مختلفة، ومتضاربة فی دلالاتها أحیاناً. إلا أننا سنقتصر على أیسرها وأقربها منالاً، مما لا یتعب القارئ فی استیعابه وتفهمه:
إن أهم أقسام الموشح وعناصره هی: القفل، والبیت، والغصن، والخَرْجة. وهذا ما نوضحه فی بعض مقاطع الموشح التالی لابن زُهر الأندلسی (595ه/1199م):
حَیِّ الوجوه المِلاحا
وحیِّ نُجلَ العیونْ
هل فی الهوى من جُناحِ
أم فی ندیمٍ وراحِ؟
رام النصیحُ صلاحی
وكیف أرجو صَلاحا
بین الهوى والمجون؟
أبكی العیونَ البواكی
تذكارَ أختِ السِّماكِ
حتى حَمامُ الأراكِ
بكى شجونی وناحا
على فروعِ الغصونْ(3)
افتتح هذا الموشح بالبیت الأول وهو المطلع، ویسمى قفلاً. وهو على البحر المجتث (مستفعلن فاعلاتن) بضرب مقصور (فاعلاتن). وعلى وزنه هذا، وقافیتی صدره وعجزه توالت بعده الأقفال كلها، ویضم هذا الموشح ستة أقفال، یبدأ بقفل وینتهی بقفل، ویسمى عندئذ "التام".
والأقفال أساسیة فی الموشح، وبدونها لا تكون المنظومة موشحاً، وهی الوحدة الأولى فیه. ویسمى كل شطر من شطری القفل: غصناً.
أما الوحدة الثانیة فی الموشح فهی التی تلی القفل، وتتألف هنا فی موشح ابن زهر من ثلاثة أشطر أو أغصان وزن كل منها (مستفعلن فاعلاتن) أیضاً، تسمى بمجموعها "بیتاً". وعددها خمسة "أبیات". وهی جمیعاً تتفق فیما بینها فی الوزن ولكنها تختلف فی القوافی. وهذا النظام هو الغالب فی الموشح عامة، وهو المسمى "بالتام" ویكون مؤلفاً –كما نرى- من ستة أقفال، وخمسة "أبیات". وكلها ذات وزن عروضی واحد. فإذا لم یبدأ بقفل، بل ب "بیت"- وهذا قلیل- سمی الموشح "أقرع".
ولا یقتصر القفل فی الموشح على بیت شعری واحد ذی شطرین أو غصنین، بل قد یكون أكثر من ذلك، وكذا "البیت" بین القفلین یمكن أن یكون مؤلفاً من عدة أغصان، تكتب على نسق شاقولی (عمودی)، أو أفقی فی سطر واحد.
أما "الخَرْجة" فهی القفل الأخیر من الموشح –كما قال ابن سناء الملك فی كتابه "دار الطراز"- وإذا كان القفل الأول فی الموشح لیس عنصراً رئیسیاً، فإنه فی غایة الأهمیة عندما یكون فی خاتمة الموشح، وهو الذی یعرف بالخَرْجة، وهی ركن أساسی یولیه الوشاحون عنایة خاصة، ولها شروط تنسجم مع جو الطرب والغناء المواتی للموشحات.
والموشح، بعد هذا، بأقفاله و"أبیاته" وأغصانه وخرجته یؤلف وحدة كاملة مترابطة فیما بینها فی المعنى، كما الأبیات كلها فی القصیدة العربیة الموروثة، وهذا التقسیم الاصطلاحی الإیقاعی لأجزاء الموشح لا یعنی أنها منفصلة فیما بینها من حیث الأفكار والمعانی.
وبعد هذه الوقفة عند أجزاء الموشح وعناصره التی تؤلف بنیته ووحدته، یحسن بنا أن نتحدث عن وزنه العروضی أو التفعیلی، ومدى ما فیه من تجدید أو تقلید فی هذا الجانب. وفی هذا السیاق الغنائی القائم على التلحین والوزن یمكن أن نقسم الموشحات إلى خمسة أقسام:
1-قسم یلتزم بالبحور الشعریة الستة عشر الموروثة، التزاماً تاماً، من حیث أوزانها المعروفة، أما فیما عدا ذلك فإنها تختلف فی شكلها الفنی وتوزیعها الإیقاعی عن شكل القصیدة، وقلیل من الوشاحین من یلتزمون بنظام الشطرین وحده فی الموشح –على طریقة القصیدة العربیة –لكنهم حتى فی هذه الحالة یحافظون على طریقة الأقفال و "الأبیات" دون مراعاة الخرجة.
ومن هذا القبیل موشحة ابن سهل الإشبیلی (649ه/1251م) التی بدأها بقفل مؤلف من أربعة أشطر، على بحر الرمل:
هل درى ظبیُ الحِمى أنْ قد حمَى
قلبَ صَبِّ حلّه عن مكنسِ؟
فهو فی حَرٍّ وخفْقٍ مثلما
لعبتْ ریحُ الصَّبا بالقَبس
وختمها بهذا القفل الأخیر:
قلتُ، لمّا أن تبدّى مُعْلَما
وهو من ألحاظِهِ فی حَرس
أیُّها الآخِذُ قلبی مَغْنَما
اجعلِ الوصلَ مكانَ الخُمُس
وما بین القفلین، الأول والأخیر، تأتی "الأبیات" وعددها خمسة، على وزن الرمل أیضاً، ولكن قوافیها تختلف من "بیت إلى آخر" وكل بیت مؤلف من ستة أشطر، وأوّلها بعد المطلع (القفل الأول) وقافیته راء ساكنة:
یا بدوراً أشرقتْ یومَ النوى
غرراً تَسلكُ بی نهجَ الغرَرْ
ما لنفسی فی الهوى ذنبٌ سوى
منكم الحسنُ، ومن عینی النظَرْ
أجتنی اللذّاتِ مكلومَ الجَوى
والتذاذی مِن حبیبی بالفِكَرْ(4)
ثم تتوالى "الأبیات" بین الأقفال على هذا النسق.
وأما النوع الآخر من الموشحات الجاریة على الأوزان الموروثة فإن الوشّاح لا یلتزم نظام الشطرین المتقابلین، بل ینوع فی بناء الموشح من حیث الالتزام بالشطرین معاً فی الأقفال، وبشطر واحد أو أكثر فی "الأبیات".
ومثال ذلك موشح ابن زُهر الأندلسی (595ه/1199م) وهو موشح تام على بحر الرمل، ذو ستة أقفال وخمسة "أبیات"، وكل بیت مؤلف من ثلاثة أشطار، والقفلان الأولان یأتیان على النمط التالی، مع القفل الواقع بینهما، وتتبعهما بقیة الأقفال والأبیات على النمط نفسه، مع اتفاق فی قافیة الأقفال، واختلاف فی قوافی "الأبیات":
أیها الساقی إلیك المشتكى
قد دعوناكَ وإن لم تسمعِ
وندیمٍ هِمتُ فی غُرّتهِ
وبشربِ الراح من راحتِه
كلما استیقظَ من سكرتهِ
جذبَ الزقّ إلیه واتّكا
وسقانی أربعاً فی أربعِ(5)
2-قسم یظهر فیه التجدید على استحیاء، وهو ما یفعله بعض أصحاب الموشحات من ابتعاد موشحاتهم قلیلاً عن البحر التقلیدی، وذلك بتعدیل بعض تفعیلاته، أو إدخال شیء من الزیادة أو النقصان فی حركاته وكلماته، أو فی تقفیة حشو الأبیات فی موضع معین للتزیین والزخرفة، ومثال ذلك الموشح التام –الذی سبق- لابن زهر وأوله:
حَیّ الوجوهَ المِلاحا
وحَیِّ نُجل العیونْ
هل فی الهوى من جُناحِ
أو فی ندیمٍ وراح؟
رام النصیحُ صلاحی
وكیف أرجو صَلاحا
بین الهوى والمجونْ؟
فهذا الموشح یقوم فی أصله على وزن البحر المجتث (مستفعلن فاعلاتن)، ولكن ابن زُهر لم یبق الضرب فی الأقفال كلها على فاعلاتن بل جعله "مقصوراً" بحذف ساكن السبب الخفیف فی آخره وتسكین ما قبله فصار (فاعلاتْ = فاعلانْ). وهذا التغییر لا وجود له فی وزن المجتث الموروث.
ومن هذا القبیل موشح أبی بكر بن بقی (540ه/1145م) وأوله:(6)
یا ویحَ صبٍّ إلى البرق
له نظَرُ
وفی البكاء معَ الوُرْقِ له وطرُ
من أجل بُعدٍ عن صَحْبی
بكیتُ دمَا
كم لی هنالكَ من سِرْبِ
ووصْلِ دُمى
وعسكرُ اللیلِ فی الغربِ
قد انهزَما
والصبحُ قد فاضَ فی الشرقِ
له نهَرُ
وسال من أنجُمِ الأُفْقِ دمٌ كدِرُ
فهذا الموشح من وزن البسیط التام، ولكن الوشّاح التزم قافاً مكسورة فی وسط الحشو من شطری الأقفال جمیعاً، وبذلك بناها على أربع قوافٍ یُتوقّف عندها فی القراءة أو الإنشاد بما یجعل القفل خارج البحر البسیط من حیث الظاهر.
أما "الأبیات" فقد جعل أغصانها شطراً من البحر البسیط، ولكنه جعل لكل غصن قافیتین (ب +ما) بحسب الظاهر مع أن تفعیلات الغصن كلها متتابعة فی الوزن (مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن) ثم نوّع هذه القوافی فی سائر أغصان "الأبیات" ضمن الموشح كله.
3-ونوع ثالث من الموشحات الموزونة، وهو ما اشترك فیه أكثر من وزن واحد، ویكون ذلك بإحدى طریقتین:
آ- استخدام بحر واحد فی موشح واحد كامل، وذلك بتوظیف حالاته المختلفة من زحافات وعلل، وأعاریض وأضرب، وتام ومجزوء، ومشطور ومنهوك ضمن الموشح نفسه، لا یخرج فی ذلك كله عن بحر واحد داخل الموشح المنشود، كأن تأتی أشطار على الرمل التام، وأخرى على مجزوء الرمل.. أی یتفاوت عدد التفعیلات وأشكالها.
ب- أن یجمع صاحب الموشح بحرین اثنین فی موشح واحد بحیث یأتی بأشطرٍ على بحر ما، تام، أو مجزوء، أو منهوك، ثم یعدل عنه فی أشطر تالیة إلى بحر آخر مختلف التفعیلات، وذلك فی حال تنقله من القفل إلى البیت. أما الأقفال أو الأبیات فیبقى كل منها ملتزماً وحدة البحر مع نظائره فی الموشح نفسه، من أقفال و"أبیات"، إضافة إلى وحدة القافیة بین الأقفال، أو فی حشو الأقفال و "الأبیات" المقفّاة" فی حشوها. ومثال ذلك موشح للأعمى التُّطیلی (القرن 3ه = 9م) یقول فیه(7):
المطلع (القفل الأول)
ضاحكٌ عن جُمانْ
سافرٌ عن بَدرِ
ضاق عنه الزمانْ
وحواهُ صَدری
* *
البیت الأول
آهِ مما أجِدْ
شفّنی ما أجِدْ
قام بی وقَعدْ
باطشٌ مُتَّئدْ
كلّما قلتُ قدْ
قال لی: أینَ قد؟
* *
القفل الثانی
وانثنى خوطَ بانْ
ذا مَهَزٍّ نَضْرِ
عابثَتْهُ یَدانْ
للصَّبا والقَطْرِ
وهكذا دوالیك..
وقد جاءت التفعیلات فی هذا الموشح على الوجه التالی:
المطلع (القفل الأول)
فاعلن فاعلانْ
فاعلن مفعولنْ
فاعلن فاعلانْ
فعلن مفعولنْ
البیت الأول:
فاعلن فاعلن
فاعلن فاعلن
فاعلن فعِلن
فاعلن فاعلن
فاعلن فاعلن
فاعلن فاعلن
القفل الثانی:
فاعلن فاعلانْ
فاعلن مفعولنْ
فاعلن فاعلانْ
فاعلن مفعولنْ
4-وقسم من الموشحات له أوزان وتفعیلات خاصة یدركها السامع عند القراءة أو السماع، ویستعذبها الذوق ولكنها لا تنطبق على شیء من أوزان الشعر العربی الموروثة.
وقد حاول بعضهم حصر الأوزان والتفعیلات التی بُنی علیها هذا النوع من الموشحات وجهدوا فی أن یردّوها إلى نظام الأوزان العروضیة التی حصرها الخلیل الفراهیدی ومَن بَعدهُ فی البحور الستة عشر، وفروعها، حتى أوصلوها إلى نحو 150 وزناً أو بحراً مخترعاً، لا عهد للشعر العربی بها، ولكن محاولاتهم هذه اتسمت بشیء كبیر من التكلف والافتعال، فضلاً عن أنها لم تستقص أوزان الموشحات كافة، فما زالت هناك موشحات خارج تلك الأوزان ولكن الإیقاع فیها –على كل حال- هو عربی خالص، وتفعیلاتها متناسقة مع اختلاف تنویعاتها، وإن كانت لا یمكن أن تنتمی إلى بحر معین كالبسیط أو مجزوء الكامل.. الخ فالوزن العربی لم یُقفل بابه على مر العصور، ولیس هناك ما یحول بین الشاعر المجدّد وبین استخراجه ما یریده من أوزان، إذا جرى فی الاستخراج على قاعدة سلیمة فی التقفیة والإیقاع.
ومثال هذا النوع قول ابن اللَّبانة (507ه/1113م):
القفل الأول
كم ذا یؤرّقنی ذُو حَدقِ
مَرضَى صِحاحِ
لا بُلینَ بالأرَقِ(8)
البیت الأول
قد باح دمعی بما أكتمُه
وحنَّ قلبی لِمنْ یَظلِمُهُ
رشَا تمرَّن فی "لا" فَمُهُ
كم بالمُنى أبداً ألثِمُه
القفل الثانی
یفترُّ عن لؤلؤٍ فی نَسقِ
منَ الأقاحی
بنَسیمهِ العَبِقِ
وجاء الوزن فیه على الوجه التالی:
القفل (1)
مستفعلن فعِلن مفتعلن
مستفعلن متفْعلن مفاعلَتن
البیت (1)
مستفعلن فاعلن مفتعلن
متفْعلن فاعلن مفتعلن
متفعلن فعلن مفْتعلن
مستفعلن فعلن مفتعلن
القفل (2)
مستفعلن فاعلن مفتعلن
متفْعلن مفتعلن مفاعلتن
5-والقسم الخامس والأخیر من الموشحات ما لیس له وزن یدركه السمع عند قراءته أو إنشاده، ولا یوزن إلا بالتلحین وذلك بمد حرف، وقصر آخر أو خطف حركته، وإدغام حرف فی حرف، وغیر ذلك من فنون التلحین.
وهذا النوع –كما قال ابن سناء الملك –لا یدخل شیء منه فی أوزان العرب، وهو النمط الذی یسود أكثر نماذج الوشاحین فی الأندلس، وعدده لا یقع تحت حصر، ولا یستقصیه إحصاء، لأنه قائم على التلحین فقط، ولا میزان له إلا الضرب على العود أو النفخ فی الأرغن، ولا ضابط له سوى النغم والإیقاع عن طریق مد الصوت بالإنشاد والغناء، أو قصره وحبسه، حتى ینسجم مع اللحن العام الذی یسود الموشح المغنّى.
وهذا یؤكد التلازم والتواشج الوثیق بین التوشیح والغناء، وما كان من هذا النمط فإنه لا یعلم صالحه من مختله إلا بمیزان الغناء والتلحین الذی یجبر كسره، ویقوّم معوجّه، ویردّه صحیحاً. ولكن هذا لا یمنع من ورود بعض الكلمات أو التراكیب فیه موزونة أحیاناً على بعض التفعیلات.
ومثال هذا النوع قول ابن القزاز فی مطلع موشح له(9):
رُحْ للراح وباكِرْ
بالمُعْلَمِِ المَشُوفْ
غَبوقا وصَبوحْ
على الوتَرِ الفصیحْ
لیس اسمُ الخمرِ عندی
مأخوذاً فاعلَمْ
إلاّ مِن خاءِ الخَدِّ
ومیمِ المَبْسِمْ
وَراءِ ریقِ الشَّهْدِ
العاطِرِ الفَمْ
فكُنْ للهم هاجِرْ
وصِلْ هذی الحُروفْ
كی تَغدو وتَروحْ
بجسمٍ فیه رُوحْ
* * *
أخیراً، إن الموشحات فن شعری أندلسی، وهو فن جدید مستقل بمفرده، ونماذجُه المختلفة لا تتفق مع القصیدة الشعریة الموروثة فی جوانب كثیرة، أبرزها الشكل، واللغة، والقافیة، والوزن، كما أنها تتصل اتصالاً قویاً بفن الموسیقا وطرائق الغناء فی الأندلس.
ولاشك أن هذا الفن اكتسب على مدى الأیام قیمة كبیرة، ومكانة سامیة فی میدان الغناء والطرب، حتى إنه استهوى المشارقة، فراح عدد منهم ینظم الموشحات كابن سناء الملك، وابن نُباتة المصری، وصفی الدین الحلی، وتابعهم آخرون حتى العصر الحدیث كالشاعر أحمد شوقی الذی نظم موشحته "صقر قریش" على طریقته الخاصة، وقبله سلیمان البستانی فی ترجمته لإلیاذة هومیروس، فبرهنا بذلك على مطاوعة هذا الفن لنظم الملاحم.
وبذلك تكون الموشحات الأندلسیة منعطفاً بارزاً فی مسیرة الشعر العربی، لأنها أول محاولة تجدیدیة فی الشعر العربی على الإطلاق، والذی عرف بتقالیده الفنیة الراسخة، وعراقة تلك التقالید وقوتها، لذلك لو لم یكن للموشحات إلا أنها كسرت هذا الطوق، وانطلقت منه إلى نظام شعری جدید، لكفى أن تلتفت إلیها الأنظار، ویُبحث عن دواعیها ونتائجها، وإن كان هذا النظام الجدید مرتبطاً بإطار التقفیة والتنویع فی الوزن والإیقاع الموسیقی، وتنوع الأجواء الفنیة الخارجیة دون أن یتعداها إلى المضمون المرتبط برؤیا الشاعر إلى الوجود، والمتصل بمنابع الثقافة الفكریة، وآرائه فی الحیاة الاجتماعیة، وسبر أغوار النفس.
ولاشك أن فن التوشیح كان نقطة انطلاق حثیث إلى السیر فی طریق التجدید العروضی والإیقاعی النغمی فی الشعر العربی الحدیث الذی بدأ یتحرر من رتوب القافیة، ویخرج على توازن الأشطار فی القصیدة العربیة، ویبتعد عن التكلف والتصنع فی اللغة والأسلوب، مما ساعد على ولوج الشعراء مجالات أخرى فی فنون القول: كالقصص الشعریة، والملاحم، والأدب التمثیلی، وكذلك كان فن التوشیح مرتكزاً للتجدید فی الشعر التفعیلی المعاصر، وأنماطه الإیقاعیة المختلفة عند الشعراء فی المشرق وفی المهجر، من أمثال خیر الدین الزركلی، وخلیل مردم والأخطل الصغیر، وعمر أبو ریشة، ونازك الملائكة، وفدوى طوقان، وصلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطی حجازی، وعبد الوهاب البیاتی، والیاس فرحات، والشاعر القروی، وفوزی المعلوف وشفیق المعلوف وغیرهم.
المصادر والمراجع
1-أبو نواس الأندلس، ابن سهل الإسرائیلی: محروس منشاوی الجالی- القاهرة 1986م.
2-الأدب الأندلسی: مصطفى الشكعة –بیروت 1983م.
3-أدباء العرب: بطرس البستانی –بیروت 1937م
4-تاریخ الأدب الأندلسی "عصر الطوائف والمرابطین": إحسان عباس –بیروت 1962م,
5-تاریخ الأدب العربی (الجزء الخامس): عمر فروخ –بیروت 1982م.
6-دار الطراز فی عمل الموشحات: ابن سناء الملك –تح. جودة الركابی- دمشق 1977م.
7-دراسات أدبیة فی الشعر الأندلسی: سعد إسماعیل شلبی –القاهرة 1972م.
8-دیوان ابن سهل الأندلسی: جمعه وشرحه: أحمد حسنین القرنی –القاهرة 1926م.
9- دیوان الأعمى التُّطیلی: تح. إحسان عباس- بیروت 1963م
10-الشعر فی عهد المرابطین والموحّدین بالأندلس، محمد مجید السعید –بیروت 1985م.
11-الشعر والبیئة فی الأندلس: میشال عاصی- بیروت 1970م.
12-فی الأدب الأندلسی: جودة الركابی –دمشق 1955م.
13-مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون- طبعة دار الشعب –القاهرة
14-ملامح الشعر الأندلسی: عمر الدقاق –بیروت 1972م.
15-موسیقا الشعر العربی: محمود فاخوری –حلب 1981م.
16-الموشحات والأزجال: مصطفى عوض الكریّم –القاهرة 1965م.
________________________________________
* مدرّس فی كلیة الآداب بجامعة حلب.
(2) ممّن تناول هذا الموضوع بالبحث: میشال عاصی فی كتابه "الشعر والبیئة فی الأندلس" ص112-114 وسعد إسماعیل شلبی فی كتابه "دراسات أ دبیة فی الشعر الأندلسی" ص90-95.
(3) ملامح الشعر الأندلسی، د.عمر الدقاق، ص 355.
(4) دیوان ابن سهل الأندلسی: جمعه أحمد حسنین القرنی –القاهرة 1344ه، 1926م، ص 53-55.
(5) أدباء العرب: بطرس البستانی 3/77، وتاریخ الأدب العربی: د.عمر فروخ 5/540.
(6) ملامح الشعر الأندلسی: د.عمر الدقاق، ص341.
(7) دیوان الأعمى التطیلی: تحقیق د.إحسان عباس –بیروت 1963م. ص253.
(8) الموشحات والأزجال: مصطفى عوض الكریّم –ص55.
(9) الموشحات والأزجال، مصطفى عوض الكریّم، ص54.
مجلة التراث العربی-مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 85
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:31|
الاغتراب -ظاهرةً- قدیمةٌ قدم الإنسان فی هذا الوجود. فمنذ أن
تكونت المجتمعات الأولى نشأت معها وفی ظلها الأزمات التی كانت تتمخض -بشكل
أو بآخر- عن أنواع من الاغتراب عانى منها الفرد، وواجهها على وفق حجم
طاقاته العادیة والروحیة، فقد تقوده إلى التمرد والعصیان، مثلما قد تفضی به
إلى الاستسلام والانعزال والانكفاء على الذات.
ویبدو أن الاغتراب قدر الشعراء العرب القدامى:
فقد تغرب امرؤ القیس حین أنكر علیه أبوه قول الشعر وخرج مغضوباً علیه فی نفر من شذاذ طیء وكلب بعد أن شبب بإحدى نساء أبیه. كما عانى طرفة بن العبد من الاغتراب حین خرج على مجتمعه وتمرد على قیم القبیلة فتحامته العشیرة. وعرف عنترة العبسی الاغتراب بسبب لونه ونسبه لأمّه وهی الأمَةَ الحبشیة وكان ذو الرمة ضحیة الاغتراب الاجتماعی بسبب مرضه العصبی، ثم العاطفی حین أحب ((میّة)) قرابة عشرین عاماً.
وعانى أبو تمام من اغترابات شتى: مكانیة واجتماعیة ونفسیة حتى آمن بأن الاغتراب هو التجدد. وارتبط الاغتراب بحیاة أبی الطیب المتنبی أیما ارتباط فكان نسیج وحده، افرده الهّم مثلما افرده الحسد. وكان لأبی فراس الحمدانی اغترابه هو الآخر: بسبب مرارة الأسر وعذابات الشوق والحب، وعاش الشریف الرضی اغترابات حادة على رأسها اغترابه الروحی الذی تلبسه بسبب مآسی سلالته الهاشمیة.
فإذا ما اقتربنا من أبی العلاء المعری أطْللْنا على ذروة اغتراب النفس، واغتراب المكان واغتراب الجسد. وهكذا یتكشف لنا الاغتراب من خلال أولئك الشعراء وسواهم عن نفوس طامحة وأرواح مجنحّة تاقتْ إلى العلو، ووجدت فی الأرض جحیماً لا یُطاق.
وقد بات الاغتراب قضیةً تناولها الفلاسفة والمفكرون بالتحلیل وتعقبّوها بالبحث والاستقصاء بعد نشوء المجتمع الصناعی من جهة، وقیام الحربین الكونیتین وما رافقهما من مآسٍ وویلات من جهة أخرى حتى لیصح أن یقال إنَّ فی كل إنسان مغترباً.
ولقد عانى الإنسان العربی بعامة والمثقّف بخاصّة، من اغترابات شتى، واتسمت ردود فعله بأشكال شتى تراوحت بین الانسحاب من الواقع إلى هامش الحیاة، أو الرضوخ للنظام القائم والاندماج فی مؤسساته، أو التمرد بنوعیه: الفردی والثوری الجماعی، أو الهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل فی الحیاة.
ولابد من الإشارة إلى سببین جوهریین وراء اغتراب المثقف: یتصل الأول بقضیة الحریة وما یتعلق بها من مداخلات السلطة السیاسیة والاجتماعیة، ویتعلق الثانی بصدمة المثقف بسبب تعثّر المشروع النهضوی القومی.
وإذا انعطفنا نحو الشاعر العربی المعاصر، سنجد أنّ انعكاس الاغتراب علیه بات طردیاً مع تعقید الحیاة وتعفّن أوضاع المجتمع، فالشاعر أسرع من غیره إلى الإصابة بهذا الداء لأنه یتمتع بقدر عال من الحساسیة والتوتر والرهافة، ولهذا فقد عاش فی اغتراب مركب لأنه ((إنسان جمعی یستطیع أن ینقل ویشكل اللاشعور أو الحیاة الروحیة للنوع البشری)) مثلما یقول (یونج).
ولا شك فی أن اغتراب طلیعة الشعراء فی هذا القرن وفی الحقب اللاحقة، قادهم إلى محاكاة الرومانسیة الغربیة، یستوی فی ذلك شعراء الوطن العربی والشعراء العرب فی المهاجر، فاتخذوا من اللیل أنیساً، وتاقوا إلى حیاة الكوخ، واعتزلوا المدینة، وتغنوا بالألم، وصار الحزن ندیماً لهم.
ومن هنا فقد وجد الشعراء، وبخاصة منهم الرواد: بدر شاكر السیاب ونازك الملائكة، وعبد الوهاب البیاتی، وبلند الحیدری، أنفسهم فی عالم مقفر، تراجعت فیه المثل الروحیة، وافتُقِدَت أواصر الحب الإنسانی الذی یتشوفون إلیه، فعانوا من الاغتراب أیما معاناة، وحاولوا -كل على وفق طاقاته المادیة والروحیة- مواجهته والرد علیه، ومن هنا بدأت أتحسس -بصفتی شاعراً- عمق تجربتهم الإبداعیة التی رسمتها وبدقة تجربتهم الحیاتیة مثلما قادنی ذلك إلى فحص منجزهم الشعری بحثاً عن الثیمات الاغترابیة فیه، قصد الإحاطة بمكوناتها، ومن ثم الوقوف على المناهج التعویضیة التی اعتمدوها، فكانت هذه الدراسة المتواضعة التی اشتملت على أربعة فصول:
اختص الفصل الأول بأنماط الاغتراب التی عاشها الشعراء الرواد الأربعة: بدر شاكر السیاب، ونازك الملائكة، وعبد الوهاب البیاتی وبلند الحیدری وهی: الاغتراب الاجتماعی والعاطفی، والسیاسی والمكانی، والروحی، ثم استعرضت المنهج التعویضی الذی استعان به الشعراء للرد على الاغتراب، والذی اشتمل على العودة إلى الطفولة والماضی، وتأسیس المدن الحلمیة واستلهام التراث فضلاً عن صیغ أخرى تفرد بها الشعراء.
وحمل الفصل الثانی عنوان ((البنیة اللغویة))، وقد تحدثت فیه عن القصیدة موضوعاً لغویاً، وعن مكونات المعجم الشعری عند الرواد، وهی ألفاظ الغربة، وألفاظ الطبیعة وألفاظ الصوت، فضلاً عن ظاهرة التجسید والتشخیص، وختمت الفصل بالحدیث عن مستویی الأداء اللغوی عند الرواد، وهما: الأداء بالكلام المحكی والأداء بالموروث على صعید اللفظة وعلى صعید التركیب.
أما الفصل الثالث فقد خصص للبنیة التصویریة، وقد تناولت فی مستهله المهاد النظری للصورة الشعریة، وموقع الصورة فی البناء الشعری وعلاقتها بكل من المجاز والخیال، والرمز الأسطولی، وختمت الفصل بأمثلة تطبیقیة على التشكیل بالقصة، والتشكیل بالموروث، والتشكیل بالرمز الأسطوری والتشكیل بالرمز الأدبی والتشكیل بالقناع.
وفی الفصل الرابع الذی اختص بالبنیة الإیقاعیة، تحدثت عن أثر الموسیقى فی البناء الفنی ودورها فی تثبیت الانفعال، وكیف تتعامل الشعراء الرواد فی موضوع الاغتراب مع الإیقاع الداخلی، عبر وسائل تحقیقه وهی:
تكرار الأصوات، وأصوات ..؟.، والتدویم، وتجزئة الوزن العروضی وإلباس الألفاظ إیقاع النواة، وكذلك من خلال موسیقى الإطار، ودور الوزن فی البناء الشعری، مثلما تحدثت عن أثر القافیة الموسیقی، وموقف الشعراء الرواد منها، مستشهداً بأمثلة تطبیقیة محددة.
وفی ختام الفصل تناولت ظاهرتین موسیقیتین لفتتا نظری تلكما هما: تنوع الأوزان، وتناوب شعر البیت وشعر التفعیلة فی القصیدة الواحدة، لضرورات فنیة وانفعالیة، اجتهدت فی تفسیرها بعدد من الأمثلة التطبیقیة.
أزعم أنی استخدمت المنهج التحلیلی الفنی، مركزاً على النص بالدرجة الأولى، مع الاستعانة -كلما دعت الحاجة- بأقاویل الشاعر ونقاده، فی تحلیل النص وفهمه، أو فی تحلیل الموقف وفهمه، شریطة أن لا یتعارض ذلك مع روح النص الذی هو جوهر العملیة النقدیة، بما یمتلكه من عناصر التكامل اللغوی والفنی والجمالی.
ولا أزعم -بعد ذلك- أنی استكملت الموضوع، فما زال فیه الكثیر مما لم یُدرس، أو مما لم یُتَعَّمق فی دراسته، وحسب هذا البحث أن یكون لبنة فی بناء یتكامل تباعاً.
ویبدو أن الاغتراب قدر الشعراء العرب القدامى:
فقد تغرب امرؤ القیس حین أنكر علیه أبوه قول الشعر وخرج مغضوباً علیه فی نفر من شذاذ طیء وكلب بعد أن شبب بإحدى نساء أبیه. كما عانى طرفة بن العبد من الاغتراب حین خرج على مجتمعه وتمرد على قیم القبیلة فتحامته العشیرة. وعرف عنترة العبسی الاغتراب بسبب لونه ونسبه لأمّه وهی الأمَةَ الحبشیة وكان ذو الرمة ضحیة الاغتراب الاجتماعی بسبب مرضه العصبی، ثم العاطفی حین أحب ((میّة)) قرابة عشرین عاماً.
وعانى أبو تمام من اغترابات شتى: مكانیة واجتماعیة ونفسیة حتى آمن بأن الاغتراب هو التجدد. وارتبط الاغتراب بحیاة أبی الطیب المتنبی أیما ارتباط فكان نسیج وحده، افرده الهّم مثلما افرده الحسد. وكان لأبی فراس الحمدانی اغترابه هو الآخر: بسبب مرارة الأسر وعذابات الشوق والحب، وعاش الشریف الرضی اغترابات حادة على رأسها اغترابه الروحی الذی تلبسه بسبب مآسی سلالته الهاشمیة.
فإذا ما اقتربنا من أبی العلاء المعری أطْللْنا على ذروة اغتراب النفس، واغتراب المكان واغتراب الجسد. وهكذا یتكشف لنا الاغتراب من خلال أولئك الشعراء وسواهم عن نفوس طامحة وأرواح مجنحّة تاقتْ إلى العلو، ووجدت فی الأرض جحیماً لا یُطاق.
وقد بات الاغتراب قضیةً تناولها الفلاسفة والمفكرون بالتحلیل وتعقبّوها بالبحث والاستقصاء بعد نشوء المجتمع الصناعی من جهة، وقیام الحربین الكونیتین وما رافقهما من مآسٍ وویلات من جهة أخرى حتى لیصح أن یقال إنَّ فی كل إنسان مغترباً.
ولقد عانى الإنسان العربی بعامة والمثقّف بخاصّة، من اغترابات شتى، واتسمت ردود فعله بأشكال شتى تراوحت بین الانسحاب من الواقع إلى هامش الحیاة، أو الرضوخ للنظام القائم والاندماج فی مؤسساته، أو التمرد بنوعیه: الفردی والثوری الجماعی، أو الهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل فی الحیاة.
ولابد من الإشارة إلى سببین جوهریین وراء اغتراب المثقف: یتصل الأول بقضیة الحریة وما یتعلق بها من مداخلات السلطة السیاسیة والاجتماعیة، ویتعلق الثانی بصدمة المثقف بسبب تعثّر المشروع النهضوی القومی.
وإذا انعطفنا نحو الشاعر العربی المعاصر، سنجد أنّ انعكاس الاغتراب علیه بات طردیاً مع تعقید الحیاة وتعفّن أوضاع المجتمع، فالشاعر أسرع من غیره إلى الإصابة بهذا الداء لأنه یتمتع بقدر عال من الحساسیة والتوتر والرهافة، ولهذا فقد عاش فی اغتراب مركب لأنه ((إنسان جمعی یستطیع أن ینقل ویشكل اللاشعور أو الحیاة الروحیة للنوع البشری)) مثلما یقول (یونج).
ولا شك فی أن اغتراب طلیعة الشعراء فی هذا القرن وفی الحقب اللاحقة، قادهم إلى محاكاة الرومانسیة الغربیة، یستوی فی ذلك شعراء الوطن العربی والشعراء العرب فی المهاجر، فاتخذوا من اللیل أنیساً، وتاقوا إلى حیاة الكوخ، واعتزلوا المدینة، وتغنوا بالألم، وصار الحزن ندیماً لهم.
ومن هنا فقد وجد الشعراء، وبخاصة منهم الرواد: بدر شاكر السیاب ونازك الملائكة، وعبد الوهاب البیاتی، وبلند الحیدری، أنفسهم فی عالم مقفر، تراجعت فیه المثل الروحیة، وافتُقِدَت أواصر الحب الإنسانی الذی یتشوفون إلیه، فعانوا من الاغتراب أیما معاناة، وحاولوا -كل على وفق طاقاته المادیة والروحیة- مواجهته والرد علیه، ومن هنا بدأت أتحسس -بصفتی شاعراً- عمق تجربتهم الإبداعیة التی رسمتها وبدقة تجربتهم الحیاتیة مثلما قادنی ذلك إلى فحص منجزهم الشعری بحثاً عن الثیمات الاغترابیة فیه، قصد الإحاطة بمكوناتها، ومن ثم الوقوف على المناهج التعویضیة التی اعتمدوها، فكانت هذه الدراسة المتواضعة التی اشتملت على أربعة فصول:
اختص الفصل الأول بأنماط الاغتراب التی عاشها الشعراء الرواد الأربعة: بدر شاكر السیاب، ونازك الملائكة، وعبد الوهاب البیاتی وبلند الحیدری وهی: الاغتراب الاجتماعی والعاطفی، والسیاسی والمكانی، والروحی، ثم استعرضت المنهج التعویضی الذی استعان به الشعراء للرد على الاغتراب، والذی اشتمل على العودة إلى الطفولة والماضی، وتأسیس المدن الحلمیة واستلهام التراث فضلاً عن صیغ أخرى تفرد بها الشعراء.
وحمل الفصل الثانی عنوان ((البنیة اللغویة))، وقد تحدثت فیه عن القصیدة موضوعاً لغویاً، وعن مكونات المعجم الشعری عند الرواد، وهی ألفاظ الغربة، وألفاظ الطبیعة وألفاظ الصوت، فضلاً عن ظاهرة التجسید والتشخیص، وختمت الفصل بالحدیث عن مستویی الأداء اللغوی عند الرواد، وهما: الأداء بالكلام المحكی والأداء بالموروث على صعید اللفظة وعلى صعید التركیب.
أما الفصل الثالث فقد خصص للبنیة التصویریة، وقد تناولت فی مستهله المهاد النظری للصورة الشعریة، وموقع الصورة فی البناء الشعری وعلاقتها بكل من المجاز والخیال، والرمز الأسطولی، وختمت الفصل بأمثلة تطبیقیة على التشكیل بالقصة، والتشكیل بالموروث، والتشكیل بالرمز الأسطوری والتشكیل بالرمز الأدبی والتشكیل بالقناع.
وفی الفصل الرابع الذی اختص بالبنیة الإیقاعیة، تحدثت عن أثر الموسیقى فی البناء الفنی ودورها فی تثبیت الانفعال، وكیف تتعامل الشعراء الرواد فی موضوع الاغتراب مع الإیقاع الداخلی، عبر وسائل تحقیقه وهی:
تكرار الأصوات، وأصوات ..؟.، والتدویم، وتجزئة الوزن العروضی وإلباس الألفاظ إیقاع النواة، وكذلك من خلال موسیقى الإطار، ودور الوزن فی البناء الشعری، مثلما تحدثت عن أثر القافیة الموسیقی، وموقف الشعراء الرواد منها، مستشهداً بأمثلة تطبیقیة محددة.
وفی ختام الفصل تناولت ظاهرتین موسیقیتین لفتتا نظری تلكما هما: تنوع الأوزان، وتناوب شعر البیت وشعر التفعیلة فی القصیدة الواحدة، لضرورات فنیة وانفعالیة، اجتهدت فی تفسیرها بعدد من الأمثلة التطبیقیة.
أزعم أنی استخدمت المنهج التحلیلی الفنی، مركزاً على النص بالدرجة الأولى، مع الاستعانة -كلما دعت الحاجة- بأقاویل الشاعر ونقاده، فی تحلیل النص وفهمه، أو فی تحلیل الموقف وفهمه، شریطة أن لا یتعارض ذلك مع روح النص الذی هو جوهر العملیة النقدیة، بما یمتلكه من عناصر التكامل اللغوی والفنی والجمالی.
ولا أزعم -بعد ذلك- أنی استكملت الموضوع، فما زال فیه الكثیر مما لم یُدرس، أو مما لم یُتَعَّمق فی دراسته، وحسب هذا البحث أن یكون لبنة فی بناء یتكامل تباعاً.
+درج شده توسط مترجم عربی - دکتر مهدي شاهرخ در شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹و ساعت 19:31|